رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الوضع الحالي لواقع الاقتصاد العربي بصفة عامة وقطاع صناعة التأمين (التجاري- الإسلامي) بصفة خاصة يتطلب النظر بمنظار جديد على قدرة شركات خدمات التأمين في خلق العناصر والأسباب المساعدة على نمو عمليات وخدمات التأمين وزيادة الطلب عليه وهو أمر يتطلب الاهتمام بأحد متطلباته المتعلقة بفن الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي لتحديد مواضيع المشكلات والضعف وعدم التطور في صناعة التأمين التي تتبلور في عدة أسباب وبالطبع منها ضعف الاستثمار في (إدارة وتنظيم وتطوير وتنمية) الموارد البشرية وتأهيلها ضمن برامج واضحة ومحددة لخدمة أهداف الشركات المستقبلية وخدمة قطاع التأمين كاملا في الدول، لذلك يجب الاهتمام وزيادة الاستثمار في برامج التنمية والتدريب والتأهيل لخلق ملكات فنية متخصصة وإعداد الصف الثاني من القيادات والتركيز على توطين قطاع خدمات التأمين التي تعد تنمية الموارد البشرية وتطوريها من القضايا الملحة للمؤسسات باختلاف أنواعها سواء المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كل المستويات ومن ضمنها شركات التأمين الإسلامية باعتبارها من المؤسسات المالية الصاعدة في الانتشار والتوسع وأخذت مكانة واسعة للعناية بتنمية الموارد البشرية بأفضل السبل وأكثرها جدوى ومكانة على اعتبار أن الإنفاق على هذه التنمية التي تحصل نتيجة العولمة والأزمات المالية التي انعكست على مختلف قطاعات العمل بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص وبالوقت نفسه لتحقيق أهداف العاملين والعمل على ترفيههم في إطار ظروف عمل منشطة تحفزهم على أداء العمل بإتقان وفعالية، فالموارد البشرية خصوصا في شركات التأمين التكافلية مورد من أهم مواردها ومن الأصول التي تمتلكها حيث لا يحقق أهداف الشركة بدون هذه الموارد التي يجب أن تسعى دائما للاهتمام بها وتطويرها وتنمية مهاراتها وكفاءتها لتكون قادرة على تحقيق أهدافها بفعالية وتساعدها على مواجهة التغيرات والتحديات في صناعة التأمين الإسلامي خاصة والتجاري عامة لذلك يهدف التقرير إلى التعرف على تنمية الموارد البشرية ودورها في تطوير صناعة التأمين في شركة التأمين الإسلامية التكافلية والتحقق من مدى توظيف متطلبات تنمية الموارد البشرية وأثرها الفاعل في إعداد الموظف الكفء القادر والفعال والمدرب والمعد إعدادا جيدا مبني على أسس علمية وعملية قوية وفق المحاور التالية:- أولا: معنى إدارة الموارد البشرية (HRM)المقصود بإدارة الموارد البشرية هو جميع الأنشطة بما فيها الأنشطة التي تدار بواسطة الموظفين أنفسهم والتي تهدف إلى الاستخدام الأمثل لموظفي المؤسسة ورفاهيتهم وتوفِّر سياسة الموارد البشرية الاستراتيجيات والأهداف سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى التي يجب تحقيقها حتى يتم تحسين النظام العام للشركة كما يجب على إدارة الموارد البشرية تحديد الأنشطة الخاصة بمداخل ومخارج النظام التي تحتاجها لتدير العاملين طبقاً للسياسة العامة والهيكل الإداري وعقد تأسيس المؤسسة الخدمية. ثانيا: المفهوم العام لتنمية الموارد البشرية (HRD)يمثل المنهج الذي تتخذه الشركة وفق تحويل الفرد الذي يمتلك صفات أفضل ويكون قادرا على تحقيق أهداف الوظيفة بالمستوى المطلوب وذلك من خلال اجتيازه مرحلة التدريب والتعلم للحصول على أفراد أكفاء في مختلف الوظائف والمحافظة على استمراريته وزيادة رغبتهم في العمل بالنهوض بأعباء الوظائف الحالية مع الأخذ بنظر الاعتبار الأداء الحالي وقدراتهم المستقبلية وفق مجموعة من الاعتبارات منها:-* الموارد البشرية شريك أساسي ومحور إستراتيجي في رؤية الشركة الناجحة وخططها المستقبلية. * تعتبر تنمية الموارد البشرية مدخلا مهما من مداخل التحسين المستمر للأداء. * عملية مستمرة يتكامل فيها دور الفرد والمجتمع مع إدارة المؤسسة للوصول إلى الأهداف. * الهيئات المهنية وظهورها فلها أثر بارز في تطوير الموارد البشرية ووضع الموظف تحت أنظمتها وقوانينها وسياستها. ثالثا: إستراتيجية تخطيط الموارد البشرية في شركات التأمين تخطيط الموارد البشرية تمثل عملية تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والتأكيد على أن الشركة تمتلك العدد المناسب من الأفراد المؤهلين في الوظائف المناسبة وفي الوقت المناسب وبالتكاليف الأدنى. رابعا: وظائف عملية تخطيط الموارد البشرية في شركات التأمين الاهتمام بعملية تخطيط الموارد البشرية في شركات التأمين التكافلي لأنه يعد النشاط الحاسم في زيادة فعالية إدارة الموارد البشرية وزيادة مساهمتها في تحقيق فاعلية الشركة ويمكن تحديد أهمية هذا النشاط الخدمي من خلال التالي: -* نشاط تخطيط الموارد البشرية يخدم أهدافا متعددة خاصة بشركة التأمين والمجتمع فعلى صعيد الفرد يحقق مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وعلى صعيد الشركة تحقق الموائمة الداخلية بعدم وجود عجز أو فائض في الموارد البشرية، أما على صعيد المجتمع فإن تحقيق الاستخدام الكامل والصحيح للموارد البشرية في الشركات يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل الأفضل للموارد البشرية بأفضل استخدام ممكن وبأقل وقت وتكلفة. * تقليل تكاليف نشاطات إدارة الموارد البشرية الأخرى من توظيف وتدريب ومتابعة وصيانة الموارد البشرية ثم المتابعة ومراقبة الأداء والتقييم. خامسا: إدارة التدريب والتطوير في شركات التأمين التدريب هو الجهود الهادفة إلى تزويد الفرد العامل في الشركة بالمعلومات التي تكسبه مهارة أداء العمل أو تنمية ومعارف وخبرات باتجاه زيادة كفاءة الفرد للعمل الحالية والمستقبلية، أما التطوير فهو عملية تزويد العاملين بالمهارات والمعارف التي يستخدمها الآن أو المستقبل ويركز التطوير بشكل عام على وظائف المستقبل والشركة معا فهو مهتم بالتعليم من تدريب العامل على عمل محدود فعندما تتطور وظيفة العامل لذلك يستدعي اقتناء مهارات ومعارف جديدة، كما يعرف التدريب بأنه العملية التي يتم من خلالها تزويد الموظفين الجدد أو الحاليين بالمهارات المطلوبة لأداء أعمالهم ضمن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد واتجاهات لتحسين أداء الفرد، وتقع المسؤولية الأولى لتدريب الموظفين على إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة، فالتطوير يعني التعليم الرسمي والتجارب الوظيفية والعلاقات وتقدير الشخصية والقدرات التي تساعد العاملين في تجهيز المستقبل، إن نمو الموارد البشرية يكون من خلال تدريبها وتطويرها كما يلعب دورا في تعزيز الالتزام العالي إذ إن التركيز على استخدام نماذج إدارة الموارد البشرية التي تسعى لتحقيق الالتزام للعاملين تجاه المنظمة وأهدافها من خلال التدريب الفاعل والتطوير والمستمر.سادسا: أنـواع التدريب TYPES OF TRAINING* (التدريب المباشر) يتم نقل المهارات الأساسية في المجالات المختلفة للاتصالات إلى المتدربين بما في ذلك المهارات رفيعة المستوى مثل التكنولوجيات الحديثة التي لا تتصل مباشرة بأداء مهام معيَّنة. * (التدريب الموجَّه) نحو العمل والذي يتم إعداده لتدريب المتدرب على كيفية تنفيذ المهام المطلوبة لأداء عمل معيَّن كالتدريب على الوظائف الفنية حيث يتعلَّم المتدربون كيف ينفِّذون المهام لكل عمل على حدة أو التدريب على الأعمال الإدارية التي تركز على مسؤوليات الوظيفة وطرق الإدارة والوظائف والقياسات وتحليل النتائج والتوصيات والمعالجات الحالية والمستقبلية. * (التدريب والتنمية) فيها يتم توسيع مدارك الأفراد لخلق تطلعات أفضل لديهم ولجعل العاملين بالمؤسسة أكثر حركة ونشاطاً أثناء فترة عملهم بالمؤسسة ولتشجيعهم على التقدم في السلم الوظيفي لعملهم.سابعا: الأهداف العامة للموارد البشرية إدارة وتنظيم الموارد البشرية علم حديث النشأة أو على الأقل أسلوب جديد لما كان يُسمى سابقاً باسم إدارة شؤون الموظفين والأفراد في المؤسسات والهيئات والحكومات ويتضمن هذا الأسلوب الجديد جميع الأنشطة التي تتعلق بتنمية الأفراد في مؤسسة ما، ومن جهة أخرى يتضمن هذا الأسلوب إدارة شؤون العاملين بمعنى جميع الأنشطة الموجهة نحو نجاح المؤسسة وتعتمد جودة نظام الموارد البشرية في مؤسسة ما مباشرة على التوازن الدقيق بين تنمية الأفراد وإدارة علاقات شؤون الأفراد، ومن وجهة النظر الفلسفية يجب أن يتذكر مدير الموارد البشرية دائماً أن الفرد الذي كرمه الله تعالى دائماً موضع احترام وتقدير والذي يمكن تقويمه فقط هو الأنشطة الإنسانية وليس الإنسان ذاته.ثامنا: الوظائف الرئيسية بتنمية الموارد البشرية بشركات التأمين التكافلي لكي تحقق شركة التأمين التكافلية أهدافها لابد أن تمارس إدارة تدريب وتطوير الموارد البشرية الوظائف الأساسية فيما يتعلق بالتوظيف وما يتطلبه من تحليل وتخطيط استراتيجي ووظيفي وفقا للاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية ومن الاختيار والتعيين والتوظيف ومنها ما يتعلق بالجانب التطويري والتدريبي والتنموي كأنشطة التدريب والتطوير وتوجيه العاملين بالشركة وتطوير مساراتهم الوظيفي وتقييم الأداء وتصميم نظام جديد للتحفيز وبالتالي امتلاك الشركة لقوة واستثمار أصول بشرية للقيام بالأعمال والمهام الوظيفية التي يتم من خلالها الحصول على الأفراد والمهارات والمعارف والخبرات وملاءتهم مع كل وظيفة من وظائف الشركة وحسب اختصاصهم وترجمة خطط الموارد البشرية إلى إجراءات فعلية وعملية سريعة ومخططة.تاسعا: الأسباب والدوافع لتنمية الموارد البشرية في شركات التأمين صناعة التأمين مجموعة من الإجراءات يتم بموجبها تحويل القسم الأكبر من عبء خطر معين من شخص طبيعي أو اعتباري هو المؤمن له إلى شخص اعتباري، يسمى المؤمن ممثلا بالشركة وهو فيما يعرف بالتأمين التجاري أو الانتقال لمجموعة من أفراد حقيقيين أو اعتباريين الذين يكونون مؤمنين تعاونا كما في نظام التأمين الإسلامي التكافلي ويكون أكثرة مقدرة للتعاون والتحمل ويترجم هذا التحمل من خلال دفع قسط التأمين وعند وقع الخطر المؤمن ضده مقابل صرف التعويض عند تحقيق الخطر ولذلك مهمة تنمية الموارد البشرية هنا مهمة للأسباب منها: -* مواكبة التحولات الخاصة بالانتقال من نشاط الوظائف إلى قطاع الصناعة والتأمين والخدمات* توجيه الأفراد وتعريفهم لأنواع الأنشطة والوظائف وتعليمهم وإرشادهم عن الأداء المتوقع منهم. * تحسين مهارات وزيادة قدرات الأفراد ورفع مستوى الأداء بما يتطابق مع معايير الأداء المحددة. * تهيئة الموارد البشرية لتتبوأ وظائف مستقبلية لمواجهة التغيرات التكنولوجية والمعلوماتية والتسويقية (العالمية - المحلية)التي تؤثر على إنتاجهم وأدائهم في الشركة. * تهيئة الموارد البشرية لمواجهة التحديات التي تفرضها التأثيرات الخارجية على المؤسسات في عدة مجالات منها عولمة اليد العاملة وانتشار المساحات التنفسية بين الخدمات وذات المواصفات والمزايا من تصاميم ونوعيات مختلفة.
5238
| 13 ديسمبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تقتضي الأهمية الاقتصادية للمشاركة والتنسيق في إدارة النشاط المالي والاقتصادي بين القطاعين العام والخاص من جهة ضمن تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي على أساس حشد وتعبئة كل الطاقات والموارد للقطاعين معا، وجنبا إلى جنب بوسائل وأساليب متنوعة منها التحول إلى نوعية الشركات المساهمة العامة التي يتم فيها فتح المجال ليساهم فيها الأفراد والشركات والمجتمع ككل، لذلك حظي أسلوب تحول الشركات (الخاصة- المختلطة) إلى مساهمة عامة باهتمام كبير من قبل الاقتصاديين والحكومات يتم ذلك بالطبع بعد إجراء الاختبار والتقييم والتأكيد بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على كل من القطاعين العام والخاص في إنشاء وتشغيل المشاريع المتنوعة.. فالسمة المميزة لاقتصاديات معظم الدول هو الاتجاه نحو تحديد دور القطاع العام في إدارة النشاط المالي والاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع القومية خاصة الدول التي تتجه حديثا لتحرير الاقتصاد واقتصاديات السوق والتي تتصف بالأسواق الناشئة لأسواقها المالية بها، فالتطوير الاقتصادي يتطلب تبني الإصلاحات الاقتصادية لكلا القطاعين معا والتي تتمثل إحدى آلياتها هو أسلوب التحول من الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة مدرجة بالأسواق المالية خاصة وما يعود من فوائد كبرى لهذه الأسواق على اقتصاد الدول وفق آلياتها ونظمها المعتمدة بالدول، فتسمح بأن يساهم القطاع الخاص بخبراته وموارده في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال فكرة التحول إلى الشركات المساهمة التي تعد من الأساليب المهمة في خلق الإجراءات التي تسمح للقطاع الخاص بتعزيز دوره في النشاط المالي والاقتصادي الوطني بجانب القطاع العام وهدف تحقيق التنمية المستدامة خاصة الدول التي يحتل بها القطاع العام الهيمنة الكاملة على إدارة النشاط المالي والاقتصادي.. وفي ضوء الأهمية الاقتصادية لتحويل الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة إلى عامة ومدرجة بالأسواق المالية يعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج ومصاريف التشغيل مما يؤدي بالطبع إلى زيادة العوائد النهائية والإيرادات المتحققة التي تصب في النهاية لروافد وموارد الاقتصاد الوطني وهو موضوع هذا التقرير: أولا: تعريف شركة المساهمة العامة تمثل الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يكون كل شريك فيها مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم ولا تقترن باسم أحد الشركاء، وإنما يكون لها اسم يشتق من الغرض من إنشائها. ثانيا: شركة المساهمة العامة في فقه المعاملات الإسلامية شركة المساهمة ذات الأعمال المباحة والتي لا تتعامل بالربا جائزة شرعاً وتنطبق عليها قواعد شركتي العنان والمضاربة في الفقه الإسلامي، لأن تقديم الحصص بالأسهم واختلاط الأموال وقيام مجلس الإدارة المنتخب من المساهمين بالتصرف في أموال الشركة بصيغة الوكالة عن الشركاء واشتراك المساهم في الجمعية العمومية ومناقشة نتائج الأعمال ومراقبة مجلس الإدارة وعزله إذا اقتضى الأمر كل هذا شرعيا مع ضرورة الأخذ في الاعتبار:* الغرض الذي قامت من أجله الشركة مشروعاً ووسائل تمويلها مشروعة، فإذا تعاملت في محرم بيعاً أو شراءً أو بالفائدة (مدين –دائن) فإنه يحرم الاشتراك فيها من خلال تملك أسهمها.* النصوص والإجراءات تتوافق مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية التي تحرم الظلم وأكل أموال الناس بالباطل مثل تحمل الشركاء لخسائر تفوق ما يملكونه من أسهم وطريقة إجراء التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين على القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة ليكون لكل مساهم صوت واحد مهما بلغ عدد الأسهم التي يملكها.ثالثا: الخصائص الرئيسية لشركات المساهمة العامة للشركة المساهمة خصائص رئيسية تميزها عن غيرها من الشركات فرأسمال شركة المساهمة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول كما أن كل شريك لا يكون مسؤولا عن ديون الشركة إلا بمقدار ما يملكـه مـن أسهم، وعليه لا يُسأل الشركاء عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، وهو ما يعني أن لشركة المساهمة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، وبالتالي لا يترتب علي انقضاء الشركة المساهمة وفلاسها إفلاس الشركاء فيها كما لا تعنون الشركة المساهمة باسم الشركاء ولا باسم أحدهم وذلك لأن شخصية الشريك ليس لها اعتبار في تكوينها، والشركاء فيها مجهولون ولا يعرف بعضهم بعضاً، وأخيرا للشركة المساهمة مجلس إدارة مفوض في إدارتها، ويخضع هذا المجلس لإشراف الجمعية العامة العادية للمساهمين التي تنعقد مـرة على الأقل في السنـة، والتي تناقش المركز المالي ونتائج الأعمال، وتناقش السلبيات، وتقرير مراقبي الحسابات، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتراقب أعماله والنظر في عزل أعضائه إذا اقتضى الأمر ذلك، والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية والموافقة على الأرباح. رابعا: متطلبات التحول لشركات مساهمة عامة لأجل دعم القطاع الخاص وفسح المجال أمامه في التحويل لشركات مساهمة عامة ومدرسة بالأسواق المالية والعمل بدون مشكلات لابد من إقرار مجموعة من الإجراءات المالية والاقتصادية والقانونية لتشجيع القطاع الخاص وشركات المساهمة الخاصة الفعالة ومنها:* مجموعة من السياسات والإجراءات المحفزة التي تحقق تكامل القطاعين العام والخاص مع الأهداف العامة للمجتمع في تحقيق العوائد والأهداف المجتمعية والاستثمار والتنمية.. * مجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والعام والمساهمين وأفراد المجتمع مع إجراء التعديلات المطلوبة وفقا للمتغيرات السياسية والاقتصادية وفقا للنظام العام. * رسم خطط وبرامج خاصة بالتنمية وتأمين ما يتطلبه القطاع الخاص لتعزيز دوره الفعال في النشاط الاقتصادي. * تأمين وتخفيف تكلفة المخاطر المصاحبة للأعمال والعمل على معالجتها وتحمل نتائج الأنشطة. * تهيئة المناخ المالي والاقتصادي المناسب للاستثمار فيما يسمى البيئة الجاذبة للاستثمار مثل الاستقرار الأمني والسياسي وتحرير الأسواق وتشجيع المنافسة والضمانات والدعم الآمن للمستثمر الخاص لتشجيع الاستثمارات. * تهيئة البنية التحتية بصورة عامة للشركات المطلوب تحويلها والتي تحتاج لاستثمارات لغرض تمويلها وتطويرها وتجديدها بما يتلاءم بالهيكلة الجديدة للشركات المساهمة. * معالجة أي تحديات تشريعة واقتصادية وقانونية واجتماعية تعارض مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمار بهذه الشركات العامة. خامسا: معايير التحول لشركات مساهمة عامة معايير اختيار الشركات العامة لغرض تحويلها إلى شركات مساهمة عامة لابد من توافر مجموعة من المعايير حتى تكون مهيأة لعرض تحويلها من حيث دراسة كل ما يتعلق بالشركة من ناحية الطلب المستقبلي والتكاليف والإيرادات المتوقعة ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية ومن هذه المعايير * تكون الشركات في حالة إنتاجية وتشغيلية جيدة نسبيا وذات إيرادات جاذبة للمستثمرين. * تكون أصول الشركة العامة ذات قيمة عالية جدا مما يستوجب استثمارات كبيرة مما يضر المستثمر الخاص بالاستثمار في مثل هذه المشاريع من حيث صعوبة وطول مدة استرداد رأسمالها. * الخدمات والمشاريع التي لا يمكن للدولة إنشاؤها لأسباب تتعلق غالبا بالخبرة والتمويل التي تتوفر بالشركات الخاصة. * التحول إلى شركات مساهمة يتوقع أن تؤدي إلى زيادة مستويات الخدمات والسلع وجودتها مقارنة من ذي قبل. * الشركات والمشاريع الربحية التجارية والتي تدار على أسس تجارية تتوافق واتجاهات القطاع الخاص التي تعتبر عوامل جذب للمستثمرين. * الشركات ذات الأهداف الاجتماعية التي تتعلق بالخدمات الأساسية ومستوى تقديم الخدمات ومواصفات المستثمر * اختيار المستثمرين وفق مبادئ الكفاءة الاقتصادية والمركز المالي والأعمال المماثلة وأي صفات أخرى تعزز قوة المستثمر كشريك محتمل. * قابلية المستثمر الخاص على تقديم السلع والخدمات ضمن الشروط والمواصفات المطلوبة ومدى المعرفة والخبرة المتوفرين. * توافر الحافز والرغبة لدى المستثمر الخاص وأفراد المجتمع للمساهمة في هذه الشركات .سادسا: المزايا والمنافع نتيجة التحول إلى شركات مساهمة مما تقدم يتضح أن تحول الشركات الخاصة والمختلطة إلى شركات مساهمة عامة يحقق كل متطلبات التطوير من جهة، وتعبئة الادخارات المحلية باتجاه تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على المنافسة في السوق من جهة ثانية، ويضمن في الوقت نفسه صيغة جديدة للإدارة تقوم على مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة كما يضمن فرص استثمار للمستثمر الذي يريد الربح بدلاً من الفائدة المصرفية الربوية المحرمة وأيضا يؤدي جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة وما تحمله من خبرات إدارية ومعرفة فنية فضلا عن استقطاب كفاءات بشرية عالية وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع القاعدة الاقتصادية بالمحافظة على استمرارية المؤسسات الاقتصادية، ثم تعزيز البناء المؤسسي للقطاع الاقتصادي ومفهوم العمل الجماعي مع تنظيم القطاع الخاص وقطاع الأعمال إضافة لدعم السوق الأولية التي تعد ركيزة نمو الأسواق المالية وتطورها والأهم من كل ذلك حشد موارد القطاع الخاص بما في ذلك صغار المستثمرين والمدخرين وتوظيفها في عملية التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
1082
| 06 ديسمبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إن الاقتصاد الإسلامي قادر على التكيف مع المتغيرات المحيطة به دون الخروج عن ثوابته الأساسية، بل إن نجاح الابتكارات التي قدمها للسوق المالية العالمية ودرجة الإقبال عليها دراسة وتطبيقاً تشهد على ذلك. وعليه فإن نموذج الربح المقترح هو معيارٌ كافٍ وفعالٌ لمؤشرات الأداء ويحل بفعالية وكفاءة محل معيار الفائدة الربوية، مما يثبت بجدارة استقلالية منهج الاقتصاد الإسلامي ومفاهيمه عن غيره من الأنظمة.وعلى كل حال، ينبغي على الباحثين والعاملين في مجال الإدارة والاقتصاد الإسلامي الاستمرار بطرح حلول إسلامية بديلة في الأسواق العالمية التي تسعى جاهدة في الوصول إلى بدائل تمكنها من الخروج من أزماتها. بحيث تكون خالية من الشبهات الربوية وقادرة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية.العلاقة بين الاستثمار و الإنتاج والمخاطرالمستثمرون قسمان قسم مسالم لا يحب المخاطرة وقسم مغامر. فالأول يتطلع دوماً إلى استثمارات تخلو من المخاطر أو أنها تكون في حدودها الدنيا على الأقل كالاستثمار في الإيجار. أما المغامر فإنه على استعداد لتحمل نتائج المخاطر. لذلك نجده يسعى إلى تحقيق نسب عالية من الأرباح لتغطية عنصر المخاطرة، وذلك شأن شركات التنقيب عن النفط مثلاً. وقد يحجم المستثمر عن الإقدام إذا علم بضخامة حجم المخاطر المحيطة باستثماره.وضع الفكر الاقتصادي التقليدي لكل عنصر من عناصر الإنتاج عائداً يقابله. فالأجر يقابل العمل، والإيجار يقابل الأرض، والفائدة الربوية تقابل رأس المال، والربح يقابل التنظيم أو الإدارة. أما الإسلام فإنه جزّأ عناصر الإنتاج إلى عمل ورأسمال لأن الأرض هي شكل من أشكال المال، ولا يختلف عمل الإدارة عن عمل العمال، وهذا ما قامت علبه شركات المضاربة، وعليه فإن عوائد عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي هي:أولاً: عوائد العمل (الأصول البشرية) 1- الأجر (الإجارة) 2- جُعل (جُعالة) 3- ربح (مُضاربة)ثانياً: رأس المال (الأصول المادية): 1- أصول عينية: - إيجار (إجارة)- ربح (مساقاة / مزارعة) 2- أصول نقدية: (ربح) 3- أصول معنوية (الضمان: ربح شركات الضمان) القرارات الاستثمارية الصحيحة في القطاع المصرفي إن اتخاذ القرارات المناسبة في الشركات والمؤسسات يجب أن يتبع منهجاً علمياً لتحقيق أهدافها بدقة وفي الوقت المناسب فأولاً لابد من توافر بيانات تمثل المدخلات الأساسية للمعالجة، ويشكل كل المحاسبة والإحصاء أداتان هامتان في جمع هذه البيانات. فالميزانية مثلاً تمثل من حيث النتيجة قيداً مزدوجاً لإغلاق جميع الأرصدة المفتوحة في نهاية الدورة المالية وهو يعبّر عن معادلة رياضية صفرية متوازنة الطرفين. ومن هذه المعادلة يمكن اشتقاق نسب تُظهر العلاقات القائمة بين أرقامها وتقدم تفسيرات وتوضيحات، وقد أثبتت الخبرة أن هناك علاقة تناسبية بين عناصر القوائم المالية المختلفة يُعبَّر عنها بنسب معينة، هذه النسب تتشابه في المنشآت التي تعمل في قطاع اقتصادي معين، وإذا ما توافرت هذه النسب على الوجه المفروض لها اعتبر ذلك دليلاً على نجاح المنشأة وتوازنها ثم تأتي المعالجة (اليدوية أو الآلية سواء استخدمت فيها الآلات والتجهيزات أو لم تستخدم) لتُنتِج مخرجات تسمى معلومات تمييزاً لها عن البيانات لأنها أكثر دلالة منها.تطبيقات مؤشرات الأداء بالمؤسسات المصرفية الإسلاميةتهدف عملية تقييم الأداء إلى المفاضلة بين الاستثمارات وقياس مدى نجاحها بتحقيق أهدافها من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، فمؤشرات تقييم الأداء هي أدوات لدراسة وتحليل واكتشاف مواطن الخلل والانحراف وبيان أسباب هذه الانحرافات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيحها وتجنبها في المستقبل كما تُستخدم مؤشرات قياس الأداء في توابع الهندسة المالية الإسلامية لابتكار وتحسين منتجات مالية أكثر تطوراً بينما تستخدمها معايير دراسات الجدوى الاقتصادية بدل سعر الخصم إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وبدل سعر الخصم في احتساب فترة الاسترداد وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي، وللتنبؤ بمدى فاعلية أداء المشروعات المراد إقامتها والحكم على جدواها واتخاذ قرارات الاستثمار الأنسب. لأن معيار قياس الأداء المقترح يمثل تكلفة فرصة التمويل وتكلفة الفرصة المضاعة للاستثمار وبناء على ما سبق، يمكن احتساب مؤشر أداء لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد بنفس الأسلوب وبناء على أرباح شركات ذاك القطاع، مما يساعد في إجراء دراسات ومقارنات أكثر دقة وواقعية ويمكن إجمال جميع المؤشرات بمؤشر واحد للدلالة على الحالة العامة للاقتصاد وتستخدم مؤشرات الأداء المقترحة ضمن مؤشرات المحاسبة الإدارية والتحليل المالي لتقديم معلومات أساسية لاتخاذ قرارات إدارية وبذلك يكون معيار قياس الأداء المقترح قد استند إلى معيار الربح الجاري لمؤسسات تعمل في السوق فعلاً مما سيعكس الواقع الفعلي للسوق في كل فترة يتم فيها قياسه. المؤشرات المالية والنظم المحاسبية إن جميع هذه المؤشرات تشكل أساساً علمياً وعملياً في ترشيد قرارات الاستثمار رغم مزايا ومحاذير ومحددات كل منها. كما أن أغلبها يعتمد سعر الفائدة الجاري في السوق المالية (بشكل مباشر أو غير مباشر) سواء كأساس للمقارنة والحكم أو للحساب وصولاً إلى مؤشر يساعد في ترشيد قرار الاستثمار.تستخدم المؤشرات والنسب في مجالات عدة، فهي أداة للتحليل المالي وأداة للمراجعة والرقابة. وتساعد في دراسة مؤشرات الربحية القومية والربحية التجارية.مؤشرات الربحية القومية للمشروع (معدل الخصم الاجتماعي) وهو المعدل الذي به تتناقص على مرّ الزمن القيمة التي يعطيها المجتمع للمنافع والتكاليف المستقبلية. وتنشأ الحاجة إلى إجراء مثل هذا التقدير من ضرورة تجميع القيمة الحالية للتكاليف والمنافع الاجتماعية لمشروع يمتد عبر فترة زمنية طويلة. (القيمة المضافة أو التقييم الاقتصادي) للمؤشرات حسب طريقة التأثيرات، وهي تتكون من جزأين رئيسين هما: الأجور والفائض الاجتماعي. فالأجور تعني عمالة أكبر ودخلاً أعلى وزيادة في القوة الشرائية، أما الفائض الاجتماعي فيقابل التوزيعات من الضرائب والربح الصافي والفوائد على المال ومخصصات التوسع والاحتياطيات، حيث يجب حساب جميع التكاليف والمنافع الناجمة عن تحقيق مشروع ما بأسعار السوق ثم احتساب تأثيراته على مختلف قطاعات الاقتصاد، فالمؤشر الأساس في هذه الطريقة هو القيمة المضافة وبالتالي تقييم المشروع من خلال مساهمته في زيادة الناتج المحلي.(مؤشرات الربحية التجارية للمشروع): وفيها نميز بين ظروف عدم التأكد وظروف التأكد التام. ومن مؤشرات ظروف عدم التأكد تحليل نقطة التعادل، وتحليل الحساسية. أما مؤشرات ظروف التأكد التام فهناك تحليل ربحية الاستثمار وفيه طرق تحليل بسيطة كعائد الاستثمار وفترة الاسترداد وأخرى تعتمد القيمة الحالية للنقود كصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي. وهناك تحليل مالي كنسب السيولة ومؤشرات دراسة هيكل رأس المال.(تحليل نقطة التعادل في قياس حساسية متغير محدد) كمستوى الطاقة أو حجم المبيعات للمساعدة في اتخاذ قرار بدء التشغيل رغم أن القيمة الدقيقة لهذا المتغير قد لا يمكن الجزم بشأنها على وجه اليقين.(تحليل الحساسية) فيبين كيف تتغير قيمة معيار كفاءة مشروع ما (كصافي القيمة الحالية أو القيمة المضافة القومية الصافية أو أي معيار آخر يستخدم لقياس الكفاءة) نتيجة لتغير قيمة أحد المتغيرات (مثل حجم المبيعات، سعر بيع الوحدة، تكلفة الوحدة،..الخ).(عائد الاستثمار) البسيط فهو نسبة الربح الصافي في سنة عادية إلى الاستثمار الإجمالي (رأسي المال الثابت والعامل). ويقارن هذا المعدل بسعر الفائدة فإذا تجاوزها كان مؤشرا لجودة المشروع.(فترة الاسترداد) فهي طريقة تقيس الوقت اللازم للمشروع ليسترد جملة استثماراته من خلال منافعه الصافية المحسوبة في صورة صافي الإيرادات النقدية السنوية.(القيمة الحالية الصافية للمشروع) فهي الفارق بين القيمة الحالية لتدفقاته النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة. مما يعني خصم جميع التدفقات المستقبلية إلى النقطة الزمنية صفر أي بدء التنفيذ على أساس خصم محدد مسبقاً ويتم احتسابه على أساس سعر الفائدة الجارية.(معدل العائد الداخلي أو عائد الاستثمار الداخلي) فيكون معدل الخصم مجهولاً على خلاف طريقة صافي القيمة الحالية، فهو عبارة عن معدل الخصم الذي يخفض صافي القيمة الحالية للمشروع إلى الصفر. والمعدل الحاسم للعائد يساوي سعر الفائدة الفعلي على القروض طويلة الأجل في السوق المالية أو سعر الفائدة الذي يدفعه المقترض حيث يتم اختيار المشروع ذو المعدل الأعلى.(اعتبارات تحليل السيولة) فإنها تتجه إلى الأوضاع النقدية المتعلقة بالعمليات المالية كمتطلبات الإيفاء بالدين لسداد الأصل والفوائد وتسديد أقساط التأمين إضافة إلى النفقات النقدية الأخرى. فبعد تقدير الربحية الاستثمارية وأخذ تلك العمليات بعين الاعتبار نستطيع أن نحكم على مقدرة المشروع من حيث السيولة.(اعتبارات تحليل هيكلية رأس المال) تبحث في تغطية التمويل طويل الأجل لتكاليف المشروع من الاستثمارات الثابتة ورأس المال العامل المقدر ويأتي هذا التمويل على صورة مساهمات أو ائتمان طويل الأجل، حيث لا تصلح القروض قصيرة الأجل في تغطية الأصول الثابتة لأنها ستثقل الميزان النقدي.
2130
| 01 ديسمبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تساهم تطورات تكنولوجيا المعلومات في رسم سیاسة الأداء في النظام المالي والاقتصادي وتعكس السمة الممیزة لعالم الیوم وتعد مؤشرا لبقاء ونجاح المؤسسات والهيئات والمالية والاقتصادية لكل الدول لذلك أصبحت أمن وسرية المعلومات من المواضیع الحیویة التي انتشرت مؤخرا في شتى المجالات وعلى جميع المستويات وأصبح استخدام الحاسب الآلي لمعالجة المعلومات خطوة ضرورية وهامة لإنتاج واستهلاك المعلومات لجميع الدول ولكن نتج عن تطبيق هذه التكنولوجيا العديد من المشاكل بمختلف أنواعها وارتبطت العديد من المفاهيم والمصطلحات التي أدت لتطورها وتحسينها ومنها تطبيقات الحوكمة فيما بعد نتيجة لهذا التكامل بين تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحوكمة وأصبح من المفاهيم الحيوية والهامة في مجالات المجتمع وما صاحبه من عديد المزايا والمنافع وبالطبع له تحديات أهمها المخاطر التي تتعلق بسرية وأمن المعلومات والبيانات وسبل معالجتها فظهرت تطبيقات حوكمة تكنولوجيا المعلومات للحد من المخاطر المالية والألكترونية المحتملة والمتعلقة بحماية الأصول والموجودات ذات القيمة للشركة ضد الخسارة والفقدان والإفصاح غير المصرح به لجميع البيانات والمعلومات المسجل والمعالجة والمخزنة والموزعة والمستردة من الوسائل الألكترونية بقصد حماية المعلومات والبيانات من القدم أو الفساد الذي يقود بدوره إلى الخسارة وهذه الحماية مشتركة بين السلطات الحكومية والسلطات غير الحكومية ما یتطلب إنشاء نظام فاعل لحمایة المعلومات خاصة في منظمات الأعمال التي تواجهه عرض نموذج مقترح تضمن خطوات إنشاء النظام والإجراءات المتبعة لمواجهة تهدیدات النظام كمتطلبات لتطبیق آلیة حمایة المعلومات في منظمات من أجل ضمان سریة المعلومات وتكاملها وتوافرها وسلامة محتواها وتحدید مسؤولیة المتصرف بها وعلى الرغم من زيادة التوجيه أو الاهتمام بتطبيقاتها فإنه لم يتم إصدار معايير أو دليل لمخاطر أمن المعلومات سواء من الجهات الإشرافية والتنظيمية أم الجهات غير الحكومية ذات الصلة وذلك على الرغم من التوصيات من نقابات المهنية والجمعيات المختصة حول قواعد تحليل المخاطر إلا أنه لا توجد لغة متفق عليها فيما بين الأطراف ذات العلاقة لقياس وإدارة سرية المعلومات كما لا توجد طريقة رسمية أومثالية يمكن تطبيقها لترشيد مخاطر أداء الإدارة حول تطبيقات سرية تكنولوجيا المعلومات وهو محاور التقرير كالتالي :-أولا : أنواع مخاطر تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتأغلب قوائم تصنیف المخاطر یعتمد معیار موضوع المعلومات من النظام والتي صنفت المخاطر إلى ثلاثة أنواع وهي :* المخاطر التي تتعرض لها المعلومات في مرحلة خلق واسترجاع وتعدیل وإلغاء المعلومات وجمعها بوجود المعلومات داخل النظام .* المخاطر التي تتعرض لها المعلومات في مرحلة النقل والتبادل بین أنظمة والشبكات.* المخاطر التي تتعرض لها المعلومات في مرحلة التخزین على وسائط خارج النظام.ثانيا : المخاطر في بیئة تكنولوجيا المعلوماتالاتجاه المتزاید نحو تكدیس المعلومات الحساسة داخل أوعیة مركزیة عرفت بقواعد البیانات أدت إلى زیادة المخاطر التي تتعرض لها هذه المصادر لذلك تقوم استراتیجیة أمن المعلومات على تحلیل المخاطر وتوزيعها في بیئة المعلومات تمثل مكونات تقنیة المعلومات وهي:* الأجهزة والأدوات. * البرامج والتطبيقات .* المعطیات والبيانات. * شبكات الاتصالات. ثالثا : مفهوم تطبيقات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتحوكمة تكنولوجيا المعلومات تعني استخدام مجموعة من الآليات والمبادئ والمعايير في وضع سياسات وإجراءات لتحسين عمليات وأنشطة تكنولوجيا المعلومات والرقابة وهي مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل إدارات المؤسسة وموظيفها فهي جزء مكمل من تطبيقات حوكمة الجهات الرقابية والإشرافية المركزية التي تتآلف من القيادات والهيكليات التنظيمية والعمليات التي تضمن أن تكنولوجيات المعلومات المؤسسة تساند وتبرز أهداف وخطط وسياسات المؤسسة بل القطاع المالي والاقتصادي كاملا. رابعا: أهمية تطبيقات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتالهدف من ضمان أمن وسرية تكنولوجيا المعلومات هو حمایة أنظمة المعلومات ووسائل الاتصال التي تحتوي على هذه المعلومات وحمایة مصالح المعتمدین على هذه المعلومات من أي ضرر قد ینتج في حالة اختراق سریة المعلومات أو سلامة محتواها ومن أهميتها الأمثلة التالية :-.* تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والفحص التشغيلي والإستراتيجي.* تطوير وإدارة نظم تكنولوجيا المعلومات.* السرية والأمن لمشروعات الأعمال وتأكيد استكمالها.* تحديد الأساليب والوسائل والعمليات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.* تحديد التكالبف والعوائد لممارسات مجال التطورالتكنولوجي.* إدارة تنمية وتطوير التطبيقات التكنولوجية للمعلومات.* فعالية خدمات تكنولوجيا المعلومات الإستراتيجية لأنشطة الأعمال وكفاءة الإنتاجية.* تطوير مؤشرات تقييم وفعالية الأداء الرئيسية.* زيادة قدرة تكنولوجيا المعلومات لجلب الابتكارات والتطورات الحديثة.خامسا : مبادئ الحوكمة في تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتتتمثل مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات والتي أقرها معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المبادئ الأساسية التالية: الانسجام والتوافق بين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، القيمة المضافة، إدارة وتنظيم المخاطر، إدارة الموارد والاستخدامات، إدارة وتقييم ومتابعة الأداء. سادسا : مقومات تطبيقات حوكمة تكنولوجيا المعلومات تحتاج تطبيقات حوكمة تكنولوجيا المعلومات إلى عدة مقومات تتكامل مع بعضها لنجاح تطبيقها في أي قطاع مالي واقتصادي تتمثل :-* إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات * إدارة استخدام تكنولوجيا المعلومات * إدارة مشروع أوعملية تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة سابعا : برامج وسياسات الإدارة للتخطيط لأمن وسرية المعلوماتالإدارة مسؤولة عن سياسات التخطيط لأمن وسرية المعلومات في المؤسسة المالية والاقتصادية وهي إحدى وظائفها المهمة من أجل توفير معلومات فعالة تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة إضافة إلى وضوح مسؤولية الإدارة عن الواجبات والمسئوليات وتحديد مدى تغير المعلومات التي تمتلكها المؤسسة والتي تظهر من تكنولوجيا المعلومات فالإدارة عندما تتخذ أي قرار فإنها تنظر أولا إلى محاولة تخفيف المخاطر وخصوصا في مجال تكنولوجيا سرية المعلومات من خلال التكلفة والعائد وعلى الإدارة مراقبة أعمال ونشاطات المؤسسة والتخطيط لها بدقة وإدراك التغيرات التي تطرأ عليها.. ثامنا : دور السلطات الرقابية والتنظيمية المركزية لأمن وسرية تكنولوجيا المعلومات هناك جهات حكومية رقابية وتنظيمية مختصة في إصدار قوانين تظهر مدى أهمية مواكبة القواعد القانونية المتصلة بالنظام المالي والاقتصادي للتطورات والتغيرات وتحديد بالاحتياجات المستجدة بالتشريع وتعديله أو تغييره ليعتبر نتاجا لحركة المجتمع بشكل عام وانعكاسا للتطور في القطاعات المختلفة الذي يصبح التشريع الجديد مطلبا وتعديل أو تغيير القديم فاستحدثت التشريعات بشكل عام وجودها من بيئتها التي فرضتها عبر التجربة وتراكم العادة وتبلورما يشبه الإجماع لذوي العلاقة في معالجة قضاياهم وفيما يتعلق بالتشريعات الحكومية يجب على الجهات التنظيمية والحكومية مع كل الجهات المختصة من الناحية المهنية في إصدار قوانين وتشريعات تتعلق بمهام المحافظة على أمن وسرية المعلومات الخاصة بالنظام المالي والاقتصادي ككل.
9996
| 22 نوفمبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تواجه المؤسسات المصرفية ( الإسلامية – التجارية) تحديات المنافسة التي أصبحت تتخذ طابعاً عالمياً والتي نتجت عن مجموعة من المتغيرات على الساحة الدولية كالاتجاه نحو تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية الاتجاه الكامل نحو تكنولوجيا المعلومات واقتصاد السوق الحر وسياسة الانفتاح والتحرر الاقتصادي في الوقت الحاضر وما يرافق ذلك من إزالة القيود أمام الاستثمار وشروع المصارف الخاصة بعملها ألزمت المصارف المحلية بضرورة مواكبة التطورات وإعداد نفسها على جميع الأصعدة وذلك بالعمل دائماً على نظم الإدارة الحديثة وتطوير الأنظمة المحاسبية وبصفة خاصة البنية المالية والمحاسبية والتسويقية والبحث عن الوسائل الممكنة لتخفيض تكاليف الخدمات المصرفية وتحقيق عوائد مرتفعة للمصرف وهذا يؤدي إلى ضرورة الاهتمام بالوظيفة الائتمانية المؤسسة للمصرفية على اعتبار أن المركز المالي لأيّ مؤسسة يتأثر بمتغيرات وعناصر كثيرة إلا أن محفظة الائتمانية بشكل خاص تحتل موقعاً هاماً ضمن بنود المركز المالي فسلامة محفظة الائتمان تؤدي إلى تحقيق عوائد مرتفعة للمصرف عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر المصاحبة لقرارات منح الائتمان ولذلك جاءت سياسات التصنیف الائتماني كأسلوب لتقویم جدارة العملاء ائتمانیا سواء حكومات أو مؤسسات أو شركات وذلك باستخدام مجموعة من تقویم العملاء واتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة وكذلك یمكن أن یستفاد من التصنیف الائتماني في الحد من الخسائر المستقبلیة التي یمكن أن تتعرض لها المؤسسة المصرفية نتیجة منح الائتمان ویساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار من خلال معرفة الجدارة الائتمانیة للشركة مصدرة الأسهم مثلا إذ یعد التصنیف الائتماني ( خارجي – داخلي ) من الأدوات التي تساعد على تقویم المخاطر ومراقبة هذه المخاطر والتحوط لها ویمكن للمصرف أن یختار النوع الذي یناسب إمكانیة المصرف وحجم العملیات المصرفیة التي یقوم بها. یجب على المصرف أن یقوم بعملیة التصنیف الائتماني التي تكون سهلة ومفهومة وبسیطة لموظفي المؤسسة المصرفية للمحافظة على عملائها وهناك جملة من العوامل التي یجب على المصرف أن یأخذها بنظر الاعتبار ویعمل تجاوزها والتحوط لها خاصة تلك التي تطرقت لها اتفاقیة ومقررات لجان بازل والمتمثلة بالمخاطر التشغیلیة الناتجة عن الأعمال التي یقوم بها المصرف وممارسات إرشادیة صادرة عن المصارف المركزية التي تؤثر في تطبیق نظام التصنیف الائتماني والتي على المصارف أن تأخذها بنظر الاعتبار لنجاح عملیة التصنیف الائتماني وهو ما تشمله محاورالتقرير:-أولا : مفهوم الائتمان المصرفييعرف الائتمان المصرفي على أنه علاقة مديونية تقوم على أساس الثقة بين الدائن المؤسسة المصرفية والمدين مستخدم الائتمان تنشأ نتيجة استخدامه إحدى الصيغ الشرعية بالمعاملات يتمكن من خلالها المدين في الحصول على مبلغ معين أومقابل ضمانات يوفرها المصرف للعملاء وفقاً لشروط معينة أو لتحقيق أغراض محددة مقابل تعهد المدين بإرجاع الأصل مع العوائد المتفق عليها حسب شروط ونوع الصيغة الشرعية وفي الموعد المحدد.ثانيا : هيكل المحفظة الائتمانية يعتمد نجاح المؤسسات المالية الإسلامية في أعمالها بدرجة كبيرة على جودة حجم المحفظة الائتمانية لذا لابد من توجيه معظم مصادرها نحو إدارة ورقابة ومتابعة المحفظة الائتمانية حيث إنها تشكل الجزء الرئيسي من الموجودات المنتجة للدخل وتعبر عن تركيبة الائتمانات المصرفية بشكل واضح وصريح. ثالثا: هيكل المحفظة الائتمانية في صدارة بنود المركز المالي للمؤسسة المصرفية التصنیف الائتماني صورة للوضع المالي العام للمؤسسة المصرفية ومدى نجاح السیاسة الائتمانیة المتبعة فیه والتي تعد مؤشر لنجاح عملیة التصنیف الائتماني وكذلك لغرض الوقوف على كیفیة التحكم برأس مال المؤسسة المصرفية. رابعا : مفهوم التصنیف الائتمانيالتصنیف الائتماني هو الترتیب أو المرتبة التي تحصل علیها المؤسسة المصرفية من وكالات التصيف العالمية أو الإسلامية كعملیة تقویم درجة الملاءة والقدرة على الوفاء بالالتزامات للغیر والتي تكون هي المرشد الرئیسي لرؤوس الأموال العالیة في الأسواق المختلفة وهو یؤكد توفیر أقصى مستویات الكفاءة والدقة وتعتبر بالنسبة للربحیة وترسيخ نشاطها بالنمو والتوسع ویبرز جهود ما جاء في مقررات لجان بازل حيث یتعین الوقوف على هذه العوامل ومدى تأثیرها في عملیة التصنیف الائتماني كمقیاس بالقدرة أو مقیاس لقدرة الجهة المدينة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة الدائنين ( مانحي التسهيلات) بالمؤسسات المصرفية الإسلامية بالإضافة لمخاطر عدم السداد للمدين أو مصدر السند الشرعي على سبيل المثال من الوفاء بالتزاماته فیما يتعلق بالائتمان الممنوح وعائده (للدائن ) صاحب السند.خامسا : فوائد سياسات التصنیف الائتمانيتصاعدت أهمیة التصنیف الائتماني مع توجهات ومقررات لجان بازل الجدیدة والتي تقتضي بإحداث معاییر جدیدة لكفایة رأس المال مع الأخذ في الاعتبار أنواع جدیدة من المخاطر.سادسا : العوامل المؤثرة في تكوين هيكل المحفظة الائتمانية بالمؤسسة المصرفية ( درجة السيولة) التي تتمتع بها المؤسسة المصرفية حالياً وقدرتها على توظيفها ومفهوم السيولة يعني قدرة المصرف على مواجهة التزاماته والتي تتمثل بصفة أساسية في عنصر تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع وأيضاً تلبية طلبات الائتمان أي التسهيلات الممنوحة لتلبية احتياجات المجتمع. سابعا : فوائد سياسات التصنیف الائتمانيتوفر سياسات التصنيف الائتماني كمیة وفیرة من المعلومات التي تخص بجودة الائتمان في ترتیب بسیط ودقیق من خلال نظام مبسط منه نظام التصنیف الائتماني والذي یعد تقویما دقیقا لمخاطر الائتمان ومن الخصائص التي یتضمنها التصنیف الائتماني يكون صورة واضحة أمام الجهات العلیا الإدارية أثناء اتخاذ القرارات الائتمانية الصحیحة. ثامنا : الوظائف الرئيسية لوكالات التصنیف الائتماني تقوم وكالات التصنیف العالمیة والإسلامية بتقيیم الاستثمارات وتحدید مخاطر الائتمان والمخاطرالشرعية حسب تصنیفهم بحیث لدیها القدرة على الاطلاع الجاد والمستمر على فرص الاستثمار في المشاریع المختلفة فهي تعمل على تحدید ونخفیف حدة المخاطر التي یتعرض لها المستثمر في الأسواق المالیة المختلفة وتحدید مدلولات هذه المخاطر.
2012
| 15 نوفمبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المشاركة بين القطاعين العام والخاص يحظي باهتمام كبيرمن قبل الحكومات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص معا للتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني نظم المشاركة التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشاركي تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة لذلك تساهم أدوات المشاركة بكل أشكالها بين القطاعاتُ للخروج بالحلول المناسبة لأوجه القصور في توفير الخدمات المجتمعية كما تعطي الفرصة للقطاع العام للاستفادة من الأساليب التقنية والمعرفية وطرق الإدارة الحديثة التي يتميز بها القطاع الخاص بعيدا عن الإجراءات الروتينية التي تسود القطاع العام والشركات الحكومية الأمر الذي يساعد على زيادة الرغبة في تقديم خدمات مرموقة بفعل المنافسة مع السعي الدءوب لتحقيق أعلى معدل استفادة من الموارد الاقتصادية للمجتمع ومن جهة أخرى فإن فتح مجالات اقتصادية جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام سيحد من سياسة الاندفاع لتحقيق الأرباح وبذلك يعطي بعدا اجتماعيا ممتزج بالنشاط الاقتصادي كما يضبط روح الاحتكار لدى القطاع العام بالمشاركة الفعالة التي تؤدي في المستقبل القريب لترشيد وكفاءة استخدام موارد المجتمع الاقتصادية والمالية عن طريق الرغبة في الحصول على خدمات أفضل وبكفاءة أعلى إضافة إلى الحاجة إلى مصادر إضافية للتمويل تدفع الحكومات بشكل متزايد إلى تبني شراكة القطاع العام والخاص لتقديم هذه الخدمات لذا سيشرح التقرير على تعريفها ومبررات اللجوء إليها ومتطلبات نجاحها وأنواعها ومزاياها وذلك من خلال المحاور التالية: أولا: تعريف القطاع العام والخاص القطاع العام يمثل القطاعات التي ترجع للسيطرة الكاملة لأجهزة الدولة بوصفها وحدة اقتصادية تقوم بأنشطة اقتصادية مناظرة لأنشطة القطاع الخاص إضافة للأنشطة الاقتصادية العامة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الخطط والبرامج الاقتصادية والقطاع الخاص عنصر أساسي ومنظم في النشاط الاقتصادي يقوم بمباشرة العملية الإنتاجية بناء على نظام السوق والمنافسة يتسم النشاط فيه بالمبادرة الخاصة وتحمل مخاطر القرارات والأنشطة المتخذة إذ أنه وفي ظل اقتصادات السوق الذي يقوم على أساس نشاط اقتصادي قوامه القطاع الخاص فإن آلية السوق وفي ظل نظام المنافسة الذي يحدد ما ينتجه وما يستهلكه حيث يشمل القطاع المجتمع ككل سواء كانوا أفرادا أو جماعات ورجال الأعمال تقبل تحمل المخاطرة من خلال ممارسة نشاط ما لأجل تحقيق أرباح وعوائد وهو ما يمثل تعظيم المصلحة الخاصة. ثانيا: مفهوم المشاركـة بين القطاعين العام والخاص المشاركة نشاط مشترك ينفذه مجموعة من الأطراف في قطاع اقتصادي أو مالي متنوع يساهم مباشرة في إجمالي مشروع الأعمال لمجتمع ما يتميز بالكفاءة بإنتاج سلع وخدمات ذات جودة مرتفعة لأن الهدف منها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والاجتماعية إذ يبرز دور أجهزة الدولة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات أما دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشاريع والشراكة مع القطاع العام في إدارتها استنادا لعدم كفاءة تنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية إذا اقتصرت على أحد القطاعين بشكل منفرد ومن وجهة نظر الهيئات الدولية فالمشاركة تعني: -* دور أجهزة الدولة مكمل وداعم لدور القطاع الخاص..* دور الدولة يمكن تحديده بالنشاطات التي تتضمن تهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمواصلات. الطاقة والمياه.وتحسين وتطوير مستوى التعليم والخدمات الصحية.* دور أجهزة الدولة استراتيجي يزداد بدور القطاع الخاص بالمشاريع المرتبطة بها متعاقد ومستثمر.ثالثا: أنواع المشاركة بين القطاع العام والخاص تتضمن المشاركة بين القطاعين تكوين علاقة تعاونية بين الجهات الحكومية وشريك أو أكثر من القطاع الخاص كما أن الشراكة قد تكون من خلال تنظيم الأدوار بين القطاعين بحيث يكون لكل شريك دور خاص ولكن يكمل بعضهما الآخر في إطار تنموي واحد للمجتمع وتأخذ الشكل التالي:- (شراكات تعاونية) تدور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بين القطاعين العام والخاص حيث تتصف الشراكة بعلاقات أفقية بين أطراف الشراكة ويتم اتخاذ القرار بالإجماع ويشترك جميع الشركاء بأداء المهام والواجبات ولا يوجد إشراف منفرد لأي طرف بموجب القواعد التي يفرضها.( شراكات تعاقدية ) هي ترتيبات توصيل الخدمات بموجب عقد بين طرفين وتكون العلاقات بين أطراف المشاركة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة تمارس الرقابة والسيطرة على النشاط وعلى الأطراف الأخرى المساهمة وهذه الجهة لا تمارس أداء المهام بل تعتمد على الأطراف الأخرى في ذلك وتكون قادرة على إنهاء الشراكة استناداً لمعيار العقد الذي يحكم العلاقة بين القطاعين من الناحية التنظيمية والقانونية رابعا: أدوات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لا يوجد أسلوب موحد لتحقيق المشاركة يمكن تطبيقة على جميع الحالات إذ يخضع للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل دولة فضلا عن تنوع أساليب الشراكة استنادا إلى درجة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع المشاركة والمهام المكلف بها طبقا لكل أسلوب وتندرج الأساليب بدءاً بعقود الخدمات التي تقوم أجهزة الدولة فيها بتحمل المسؤولية الكاملة في التمويل والمخاطر واستثمارات التنفيذ إلى أساليب المشاركة الأخرى التي يتحمل فيها القطاع الخاص مسؤولية البناء والتشغيل والإدارة بصورة تامة انتهاء بتحويل الملكية إلى الدولة بانتهاء المدة العقدية المحددة للمشروع ويمكن تحديد أساليب المشاركة مع القطاع الخاص من خلال أساليب وأدوات متنوعة مثل (عقود الخدمة- التشغيل والإدارة - عقود الإيجار- عقود الامتياز)خامسا: قوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشاركة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون لها فوائد عديدة منها مثلا:(الوفورات بالتكاليف) يمكن للجهات الحكومية المعنية مع وجود المشاركة أن تحقق وفورات في التكلفة في مجالي إنشاء المشروعات الرأسمالية وتشغيل الخدمات وصيانتها ويمكن للمشارك الخاص تخفيض تكلفة تشغيل البنى التحتية والأنظمة وصيانتها عن طريق الوفورات الكبيرة المتحققة من العمل أو الإنتاج بكميات كبيرة والتقنيات الابتكارية أو المرونة في الشراء وترتيبات التعويض أو تخفيض المصاريف الإدارية.(توزيع المخاطر) مع وجود المشاركة يمكن للجهات الحكومية اقتسام المخاطر التي تتمثل في تجاوزات في التكاليف أو في عدم القدرة على الوفاء بجداول أو مواعيد تسليم الخدمات أو الصعوبة في الالتزام بالتشريعات الخاصة بالبيئة وغيرها أو الخطورة في أن تكون الإيرادات غير كافية لدفع التكاليف التشغيلية والرأسمالية.(جودة مستويات الخدمة) المشاركة يمكن أن تأتي بالاختراعات والإبداع في تنظيم تأدية الخدمات ويمكن للشراكة كذلك إدخال تقنيات جديدة وإحداث الوفورات الكبيرة التي غالباً ما تخفض التكاليف أو تحسن من جودة الخدمة ومستواها.(تنمية الإيرادات) يمكن المشاركة أن تضع رسوماً على المستخدمين تعكس التكلفة الحقيقية لتقديم خدمة معينة كما تمنح الفرص لإدخال خدمات عن طريق مصادر دخل مبتكرة (الكفاءة بالتنفيذ) يمكن تحقيق الكفاءة من خلال الجمع بين الأنشطة المختلفة مثل التصميم والإنشاء ومن خلال المرونة في التعاقد والشراء والاعتماد الأسرع للتمويل الرأسمالي والكفاءة الأكثر في عملية اتخاذ القرار فتقديم الخدمات بكفاءة لا يسمح بحصول المستخدمين على الخدمات بسرعة فقط بل يساعد على تخفيض التكاليف. (الفوائد المالية والاقتصادية والمجتمعية) الدخول المتزايد للجهات الحكومية في المشاركة يساعد على تحريك الشريك الخاص والإسهام في التوظيف بصورة أكبر والنمو الاقتصادي فالشركات المحلية التي تصبح أكثر قدرة على العمل بنظام المشاركة يمكنها تصدير خبراتها وتحقيق دخل إضافي (تخفيض البطالة) توجه مشاريع المشاركة فرص عمل تجارية أكبر للشريك الخاص ما يسمح لذلك القطاع بالإبداع وتنويع أنشطته وزيادة مجالاته التجارية وكسب خبرات جديدة مبتكرة (المصالح العامة) يستفيد المواطنون كثيراً عندما تتكامل جهود وخبرات الجهات الحكومية مع التقنية ومصادر القطاع الخاص لتقديم الخدمات للجمهور فالمصلحة العامة أمر تسعى إليه الحكومة وتهتم به ويمكن تحقيقه من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.سادسا: تطبيقات المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوابة التنمية الشاملة يتزايد اهتمام الدول التي اعتمدت مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع القطاع الخاص على توفير أصول البنية التحتية والخدمات القائمة على أساسها المجتمعات وتشير تجارب البلدان المختلفة إلى أن مشاريع البنية التحتية الاقتصادية هي المرشحة في العادة للمشاركة بين القطاعين كمشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم والنقل وذلك في الحالات التالية: (الحالة الأولى) المشاريع التي تتمتع بالسلامة المالية وتعالج اختناقات واضحة في مسار البنية التحتية مثل مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة هي على الأرجح المشاريع ذات معدلات العائد المرتفعة وبالتالي تتمتع بالجاذبية للقطاع الخاص. (الحالة الثانية) رسوم الاستخدام غالبا ما تكون مجدية ومحبذة أكثر في مشاريع البنية التحتية الاقتصادية.(الحالة الثالثة) مشاريع البنية التحتية الاقتصادية عادة ما تحظى بأسواق أكثر تطورا تجمع بين التشييد وتوفير الخدمات ذات الصلة مثل بناء وتشغيل وصيانة طريق برسوم مرور مقارنة بمشاريع البنية التحتية الاجتماعية
5906
| 11 نوفمبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعتبر الوحدة المالية والاقتصادية مهما كان شكلها القانوني نظامًا كليًا للمعلومات يتكون من عدد من النظم الفرعية، منها النظام المحاسبي والمالي والإنتاجي والتسويقي، إضافة لنظام المشتريات والتخزين، فضلا عن نظام الموارد البشرية والعاملين، فكل هذه النظم تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة وبتنسيق متبادل في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ترمي إليها الوحدة الاقتصادية، سواء مؤسسة أو شركة ككل.وبذلك يشكل نظام المعلومات المحاسبية نظامًا فرعيا ضمن نظام المعلومات المتكامل في الوحدة الاقتصادية يتطلب منه التنسيق والتكامل مع نظم المعلومات الفرعية الأخرى، خاصة في حالات المنافسة بين الشركات كافة وعمى مختلف المستويات أصبح لازماً على كل شركة ضرورة العمل على الاستمرار في التحسين لأدائها لكي تستطيع مواجهة تلك المنافسة والبقاء في السوق لأجل تحقيق ذلك، لابد أن تعتمد الشركة على معلومات محاسبية أكثر دقة وملاءمة وقدم في الوقت المناسب لغرض استخدامها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المناسبة، سواء منها المالي والاستثماري، لذلك لابد من وجود نظم معلومات تساعد الإدارة بعملية التطوير والتحسين المستمر لأداء الشركات بشكل عام وهذا ما تحتاجه الشركات، خصوصا المدرجة ببورصة الأوراق المالية والتي تأخذ شكل المساهمة العامة التي تنفصل فيها الإدارة عن الملكية، فلقد تم اختيار نظام الإدارة على أساس الأنشطة ونظام الموازنات المالية المعدة على أساس الأنشطة كأدوات للتحسين والتطوير المستمرين لأداء الشركات وتطوير نظم المحاسبة، خاصة الإدارية والتكاليف منها ساعد في ظهور ما يعرف بالإدارة عملي أساس الأنشطة الذي يُعد نموذجاً لتحميل الأنشطة الإدارية بهدف تخفيض التكاليف واستخدام معموماتهُ في إعداد الموازنات الأمر الذي استلزم أيضاً وجود نظام موازنات، معتمداً على نموذج إدارة الأنشطة، فكان نظام الموازنات المُعدة على أساس الأنشطة وليس المُعدة على أساس الأقسام أو المنتجات وفقا للأسلوب التقليدي في إعداد الموازنات، نظرا لأهمية كل من نظامي الموازنات والإدارة المبنيين على أساس الأنشطة في أي شركة بشكل عام وفي الشركات المساهمة بشكل خاص، فقد جاء هذا التقرير لبيان كيفية مساهمتهما في التطوير والتقييم المستمر في محاوره التالية: - أولا: مفهوم المحاسبة الإدارية تمثل أداة لتوفير البيانات والمعلومات إلى المستويات المختلفة في الإدارة الداخلية للوحدة المالية والاقتصادية لاستخدامها في أغراض تخطيط ورقابة العمليات المختلفة على أن يتم توفير البيانات والمعلومات بشكل مستمر للمساعدة في اتخاذ القرارات الروتينية وغير الروتينية وحل المشاكل والتحديات التي تواجه الإدارة التنفيذية في أعمال الشركة اليومية. ثانيا: أهداف تطبيقات المحاسبة الإدارية تحتاج المسؤولية الإدارية وعلى مختلف مستويات الإدارة العليا معلومات كمية تفصيلية من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف لكي يقوم المحاسب الإداري على تصنيف وتبويب هذه المعلومات لاستخلاص المفيد والنافع منها، لتقديمه إلى الجهات الإدارية المختلفة بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين نظام المعلومات المحاسبية والإدارية الأخرى في الوحدة المالية والاقتصادية لذلك لابد من دراسة وتوضيح أهداف تطبيقات العمليات الإدارية، ومنها: (التخطيط والعمليات) يشمل وضع الأهداف والمعايير ورسم السياسات والإجراءات وإعداد الموازنات وكتابة الجدول الزمني.(التنظيم) يشمل الهيكل والمهام والعلاقات الخارجية والداخلية ثم اختيار المناسبين لشغل المناصب (التوجيه والإشراف) يشمل التحفيز الدائم والمستمر والقيادة والاتصال لكل أقسام الوحدة.(الرقابة وكفاءة الأداء) تشمل تحديد المعايير الرقابية وقياس الأداء وتشخيص المشكلات وعلاجها بالقرارات الصائبة. ثالثا: تطبيقات أنظمة الموازنات في الرقابة نظام الموازنات يقوم على أساس وضع جداول لتجميع الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج معين متضمناً أيضاً جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك البرنامج وتعتبر الموازنات وسيلة من الوسائل الفاعلة في التخطيط والإدارة والتنسيق والتواصل بين أقسام وأنشطة الشركة كما تُعد من الأدوات الرئيسية لتحفيز الموظفين وتقييم الأداء وتعتبر الموازنات من أحد مظاهر نجاح الشركة، لذلك فالموازنة هي ترجمة مالية لخطط الشركة في استخدام مواردها المتاحة لفترة مستقبلية محددة تكفل للإدارة التنفيذية القيام بوظيفة التخطيط والرقابة والتنسيق والتحفيز وتقييم الأداء لكل الأعمال الإدارية. رابعا: تطبيقات أنظمة التخطيط في التنبؤيعد التحليل الإستراتيجي الأساس لكل أنواع التخطيط، سواء كان تخطيطا طويل الأجل أم قصير الأجل أم متوسط الأجل وهذه الخطط هي التي تقود بالنتيجة إلى إعداد الموازنات ويكون عمل الموازنات بتجزئة خطط الشركة الرئيسية إلى فترات طويلة أو قصيرة الأجل، كما تستخدم الموازنات كأسلوب للتنبؤ بالمستقبل لتحديد النتائج المتوقعة وتقسم الخطط لتحديد أسلوب الأداء المستهدف من قبل الشركة بشكل عام إلى: -* خطط تشغيلية قصيرة الأجل ترتبط بتحقيق أهداف مرحلية. * خطط إدارية وهي خطط تكتيكية تهتم بهيكلية الشركة وتحديد مستوى الأداء الملائم لإنجاز المهام الإدارية. * خطط إستراتيجية تهتم بالتطوير طويل الأجل لإستراتيجية الشركة وتكون ذات خطوط عريضة الاتجاه لرؤى الشركة.خامسا: تطبيقات أنظمة التنسيق والمتابعة في التقييم بعد عملية التخطيط تأتي عملية التنسيق كعملية خلق المواءمة بين كافة عوامل متغيرات الإنتاج وأقسام الشركة بالشكل الذي يمكن من تحقيق الأهداف، فالموازنة تسعى للتوفيق بين مختلف قرارات الشركة لما هو في مصلحتها ذاتها بدلاً من مصلحة كل قسم على حدة، كما تساهم الموازنة في الرقابة على كل الأنشطة وتحديد المسؤول عنها وتساعد الإدارة في معرفة الانحرافات والفروقات من خلال المقارنة للنتائج المتحققة مع المخطط ولكل نشاط من أنشطة الشركة، خاصة تلك المتعلقة بالإنفاق. إن عملية الرقابة تلحق بعملية التخطيط وتتكون من ثلاث مراحل هي:* تسجيل الأداء الفعلي * مقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المتوقع وتسجيل الفروقات. * التغذية المرتجعة لمناطق الضعف والمشكلات. سادسا: استخدام نظم المحاسبة الإدارية الحديثة في تقييم أداء شركات المساهمة العامةبهدف الوفاء بالمتطلبات الإدارية للوحدة المالية والاقتصادية، فيتطلب الأمر من المحاسبين التعرف على أبعاد العملية الإدارية من خلال وظائفها الإدارية بهدف التعرف على البيانات والمعلومات المتعلقة بكل وظيفة وحاجة كل مستوى من المستويات الإدارية المحددة في الهيكل التنظيمي لتلك الوحدة الاقتصادية وبما يتناسب مع نوعية القرارات التي يمكن أن تتخذ في ذلك المستوى والتي تقع ضمن صلاحيته، وبذلك يتطلب الأمر من المحاسبين الآتي: (أولا) تعرف العملية الإدارية بأنها طريقة منظمة لتفكير تعاون الإدارة في إرشاد الوحدة الاقتصادية نحو أهدافها تتكون هذه الطريقة المنطقية للتفكير من مجموعة وظائف يمكن أن تتواجد في أي وحدة اقتصادية من خلال ممارسة المديرين لعملهم الإداري فيها وبما يؤدي إلى خدمة تلك الوحدة الاقتصادية، فيمكن الحكم على درجة ملاءمة المعلومات لمتطلبات الإدارة من جهتين: * من ملاءمتها للمستوى الإداري الموجهة له.* من ملاءمتها للشخص الذي يقوم باتخاذ القرارات. (ثانيًا) تحديد القرارات التي يمكن اتخاذها عند كل مستوى من المستويات الإدارية، يلاحظ أن الحاجة إلى البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بكل من وظيفتي التخطيط والرقابة هي حاجة متداخلة ولجميع المستويات الإدارية في الهيكل التنظيمي للوحدة المالية والاقتصادية، حيث إن أي مدير متخذ قرار في الوحدة الاقتصادية يحتاج إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالوظيفتين معًا ولكن بصورة متباينة وحسب موقعه في الهيكل التنظيمي الذي يحدد طبيعة المستويات الإدارية التي يتم على أساسها تحديد الاحتياجات من المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المختلفة وبصورة عامة يمكن تقسيم الهيكل التنظيمي لأي وحدة مالية واقتصادية إلى ثلاثة مستويات إدارية هي:* مستوى الإدارة العليا والتنفيذية أو المستوى الإستراتيجي* مستوى الإدارة الوسطى أو الإشرافي المستوى التكتيكي * مستوى الإدارة التشغيلية أو المستوى الفني.
8017
| 01 نوفمبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم تعد الموارد البشرية وإدارتها أحد عوامل الإنتاج فحسب بل أصبحت تحتسب كاستثمارات حاضرة ومستقبلية مثل حاجة المؤسسات المالية والاقتصادية لرأسمالها تماما.. لذلك أصبح هناك اهتمام متزايد للإدارة المعاصرة بالموارد البشرية فالاستثمار في تنمية الموارد البشرية أمر ضروري لما للموارد البشرية من أهمية قصوى، فهي الثروة الحقيقية والرئيسة للدول فأحسنت التخطيط السليم والإستراتيجي لها ونفذت برامج التدريب والتطوير لتنمية هذه الثروة..ولقد أصبح واضحا بكل المعاييرأن أي مؤسسة (عامة – خاصة) وهي بسبيل تحقيق الأهداف لكل أنشطتها وخدماتها أن توفر مجموعة من الموارد تساعدها على تحقيق هذه الأهداف ومن هذه الموارد بصفة أساسية هي الموارد البشرية والمالية والمادية والتكنولوجية التي يجب توفرها بما يتناسب ونشاط المؤسسة ووفقا لمبادئ ومعايير تطبيقات الجودة الشاملة التي هي أحد المفاهيم الإدارية الحديثة الموجهة وهي أيضا تمزج بين الوسائل الإدارية والأعمال الابتكارية من جهة، وبين المهارات الفنية ذات التخصص الدقيق وذلك من أجل إسناء مستويات الإدارة وحظيت إدارة الجودة الشاملة بالاهتمام (محليا - عالميا ).وأوصت معظم الدراسات الإدارية والأبحاث الحديثة لتطبيقات إدارة الجودة الشاملة ومعاييرها لأنه ينعكس بشكل إيجابي على أداء أي مؤسسة تطبق مبادئها ومعاييرها لذلك فانخفاض التكاليف وتحسن الأداء وتحسين العلاقة بين العاملين وارتفاع مستوى الرضا الوظيفي بينهم وهو من أهم أهداف المؤسسات المالية والاقتصادية فمن مهمات إدارة الجودة الشاملة خصوصا في أداء الأعمال ترفع الكفاية الأعمال في أداء في أي مؤسسة أو منظمة أو إدارة حكومية.. ومن هنا لا بد لهذه المؤسسات أن تواجه الصعوبات والتحديات التي تقف عائقا أمام التطوير والتحسين ويكون ذلك بتطبيق مفهوم إدارة الجودة وتميز هذه المؤسسة عن غيرها من المؤسسات المشابة لها وذلك بوساطة تحقيق زيادة الإنتاج وتخفيض الكلفة في الأداء وتحسين مستوى الجودة للخدمة المقدمة في ضوء ذلك كان ذا أثر بليغ في مؤسسات المال والأعمال والاقتصاد والإدارة بسبب بسيط وهو ارتباط هذه المؤسسات وجودتها مع المجتمع ونموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي والتعليمي وهوما سيشمله التقرير من المحاورالتالية:أولا: المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية (HRM)يتلخص المنطق الأساسي لإدارة الموارد البشرية الجديدة في ضرورة احترام الإنسان واستثمار قدراته وطاقاته بتوظيفها في مجالات العمل الأنسب له واعتباره شريكا في العمل، وليس مجرد أجير.. وفي ذلك فإن مفاهيم إدارة الموارد البشرية الجديدة تختلف جذريا عن مفاهيم إدارة الأفراد أو إدارة الموارد البشرية التقليدية فإدارة الموارد البشرية تمثل المحور الأساس في تنظيم العلاقة بين المنظمة والعاملين وترمي إلى تحقيق أهدافها وأهدافه ويتم ذلك من خلال مجموعة أنشطة وبرامج خاصة بالحصول على الموارد البشرية وتنميتها وتوظيفها وتقويم أدائها وصيانتها والاحتفاظ بها بشكل فعال وهي من هذا المنطلق تعد إدارة إستراتيجية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.. ثانيا: مخاطرعدم الإدارة والتنظيم في قطاع الموارد البشرية (RM)تطورت وظيفة إدارة الموارد البشرية، فبعد أن كان دورها التقليدي مقصورا على القيام باستقطاب اليد العاملة والتعيين وصرف الأجور ومنح الإجازات أخذ دورها يتسع ليصبح أكثر شمولا وتخصصًا وأصبح لإدارة الموارد البشرية دور إستراتيجي يتطلب توافر كفاءات متخصصة وإستراتيجية إلى جانب المهام التنفيذية لأن ذلك يؤدي للحد من المخاطرمنها:* المخاطر نتيجة لعدم القدرة على دراسة واختيار العمليات الاستثمارية الملائمة* المخاطر نتيجة عدم الاستخدام الأمثل لموظفي المؤسسة ورفاهيتهم.* المخاطر نتيجة لعدم قدرة الموارد على متابعة أداء وتقييم العمليات الاستثمارية والخدمات * المخاطر نتيجة لعدم القدرة على ابتكار حلول للمشكلات في التطبيق العملي.ثالثا: المقصود بتنمية قطاع الموارد البشرية (HRD) تمثل كل أنشطة إدارة الموارد البشرية المصممة لتنمية المهارات والاتجاهات المثلي للمواقف العملية والفنية ذات المتطلبات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة والتي تكوِّن جزءاً من المفهوم الشامل لإدارة الموارد البشرية وهي تضع أهمية على أنشطة التدريب كما تغطى جوانب أخرى مثل التدرج الوظيفي ودوران العمل والإحلال والترقي وهكذا.رابعا: قطاع التدريب والتطوير(D&TM) تشمل كلا من إنجاز أهداف التدريب المرغوبة للمؤسسة داخل مجموعة التدريب والتطوير بصفة خاصة والمؤسسة بصفة عامة وفي بيئة تساعد على إحداث هذا الإنجاز، وبأخذ هذه المفاهيم في الاعتبار يمكن القول إن هدف الإدارة العامة للمؤسسة هو التحقق من المعلومة التي ستمكنِّ من اتخاذ القرارات على المدى ( قصير- متوسط - طويل) لتحقيق أقصى تنمية ممكنة للمؤسسة ويجب أن تكون هذه العناصر الثلاثة متناسقة تماماً لضمان تطبيقات الجودة الشاملة لكل من الإستراتيجات والأهداف وفقا لسياسة المؤسسة الموضوعة بالميزانية العامة وتغطي الإدارة الاقسام الآتية ( الإدارة الماليـة- الإدارة الفنيـة - إدارة الموارد البشرية)... خامسا: أهداف إدارة الموارد البشرية (HRMO)تشتمل إدارة الموارد البشرية على جميع الأنشطة المطلوبة لتزويد المؤسسة بالكادر الوظيفي ذي الكفاءة والقدرة العالية على أداء المهمات والأعمال الموكلة لهم بعد تزويدهم بالمعلومات والمهارات المطلوبة عن طريق ( قطاع التدريب والتطوير) في الوقت المناسب والمكان المناسب.. ويوجد نوعان من الأهداف مثل:(المشاركة) تتمثل في استقطاب واختيار الموارد البشرية القادرة على تحقيق أهداف المؤسسة وكذلك التعريف بها وأنشطتها بشكل سليم بحيث يرغب طالبو العمل في الانضمام إلى طاقم عملها مع الاحتفاظ بالأفراد الناجحين في عمليات الاختيار واستقرار القوي العاملة في المؤسسة..(الفعالية) تمثل دفع القوى العاملة لتنجز ما يطلب منها بنجاح ومثابرة وهي مرتبطة بعدة عوامل منها كتحفيز الأفراد تطوير قدراتهم ومهاراتهم مدهم بمهارات جديدة والمواد الكفيلة لتحقيق ذلك، وكذلك مساعدتهم على التوصل إلى الأداء المرغوب فيه. سادسا: مسؤوليات قطاع الموارد البشرية في المؤسسة تشكَّل كل الأقسام نظام فرعياً ومركباً لقطاع الموارد البشرية له عناصره الداخلية بأهدافها وأنشطتها النوعية الخاصة التي يجب أن تكون متناسقة وفق معايير الجودة الشاملة بالتطبيق ومنها:* تحليل العمل المرتبط بعملية تهدف إلى تجميع المعلومات عن خصائصها الوظيفية والتي تميزها عن غيرها من الوظائف، أي تحديد الأنشطة المكونة للمهام، المكونة للوظيفة ووضع ذلك في توصيف متكامل وتحديد لمواصفات شاغل الوظيفة.* تخطيط الموارد البشرية لتحديد أعداد ونوعيات الموارد البشرية المطلوبة خلال فترة الخطة.* الاختيار والتعيين تشمل المراحل أو العمليات المختلفة للبحث عن المرشحين الملائمين للوظائف.* تصميم نظام هيكل الأجور والرواتب وتحديد الأهمية النسبية لكل وظيفة ودرجات ترقيات نظامية. * الحوافز والمكافآت هي الوسائل المختلفة التي تستخدمها الإدارة لحث الموارد البشرية وتشجيعهم على زيادة الإنتاج بشكل أو بآخر والوصول بمعدلاته وأرقامه إلى ما هو مخطط له مما يدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق أهداف المؤسسة المالية والاقتصادية.* تقييم الأداء الوظيفي مثل نظام يتم من خلاله تحديد مدى كفاءة أداء العاملين لأعمالهم.* قطاع التدريب والتطويرز.. هي تلك العملية المستمرة والتي تهدف إلى رفع كفاءة ومعارف ومهارات العاملين وتوجيه اتجاهاتهم نحو أنشطة المؤسسة.* تخطيط وتنمية المسار الوظيفي كتحقيق التوافق والتطابق بين إدارات المؤسسة وبين الوظائف من خلال وظائف إدارة الموارد البشرية، أي هي العملية التي تؤديها إدارة الموارد البشرية لتمكين المؤسسة من الحصول على الأفراد المناسبين واستمرارهم ومساعدتهم على التقدم المهني بالمستوى المطلوب من الإنتاجية والرضا.سابعا: تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم قطاع الموارد البشرية تنمية الموارد البشرية لها مكانة واسعة من الاهتمام بوصفها من أعلى درجات الاستثمار على مستوى عالمي ومحلي خصوصا العناية بتنمية الموارد البشرية والتدريب المستمر دوريا، فأحدث الأبحاث في مجال تنمية الموارد البشرية لإحدي الجامعات البريطانية في عام 2015 م أوصت بأن ارتباط مستوى كفاءة وفعالية عناصر الموارد البشرية يمكن لنظم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المؤسسات المالية والاقتصادية أن يؤثر على تنميتهم من خلال تأثيره على مجموعة من الأبعاد منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية فاهتمت الدول بالتنمية الاقتصادية عبر تحقيق التقدم لها وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة تعليميا في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وبجودة عالية والتدريب المستمر سيحافظ على الدقة في العمل ويزيد من فرص التعليم الجيد ويحافظ على الوقت واستثمار الزمن.ثامنا: الإستراتيجيات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية تتجه المؤسسات العالمية الحديثة إلى إعداد إستراتيجية عامة للموارد البشرية تتضمن الغايات والأهداف والسياسات والتوجهات الرئيسية التي تعتمدها الإدارة في مجالات الموارد البشرية ثم يكون للمؤسسة مجموعة متكاملة من الإستراتيجيات الفرعية تنبع جميعها من الإستراتيجية العامة للموارد البشرية وإن كانت كل منها تختص بأحد المجالات المتخصصة ذات الأهمية الخاصة بها وبذلك تكون وفق الإستراتيجيات التالية:* استقطاب وتكوين أقسام الموارد البشرية * إدارة الأداء وأفراد قطاع الموارد البشرية* تدريب وتطوير وتنمية أفراد قطاع الموارد البشرية * إستراتيجية تعويض ومكافأة وحوافز أفراد قطاع الموارد البشرية
5164
| 26 أكتوبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); التأمين الإسلامي أو التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات على تحقيق مصلحة أو دفع أضرار فالمبدأ التكافلي للتأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها قدر الإمكان لأنه يركز على التعاون وعلى أساس الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين وبين عمليات المساهمين وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق فأعمال التأمين الإسلامي تختلف عن طرق وأساليب التأمين التجاري إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية بحيث يستثمر المساهمون الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل وعليه تتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات كذلك الحال لإعادة التأمين التكافلي التي تشكل جزءا أساسيا من أعمال التأمين التكافلي فلها الأثر الكبير على البيانات المالية فالإدارة التنفيذية الفعالة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي هي المفتاح للأفضلية في المنافسة والنمو المستمر عن طريق الاستثمار الجيد لأموال الصندوق الذي يعتبر عملية إدارية لها أهدافها ووسائلها تتطلب استخدام إستراتيجيات وقدرة كبيرة على قراءة التوجيهات المستقبلية وهي برغم ذلك تحتاج التعرف على القدرات والخبرات والاحتياجات الذاتية وكأي عملية إدارية أحرى فالاستثمار لحاجة إلى التخطيط وإلى ضرورة التقدم بخطوات مدروسة ومحسوبة بعناية والأخذ بعين الاعتبار عوامل المخاطرة وظروف عدم التأكد في البيئة المحيطة بعملية اتخاذ القرار فأبسط قواعد الاستثمار الناجح هو تكوين محفظة منوعة لشكل جيد فالاستثمار يجب أن يكون موزعا بين مجموعة أصول ولا يتركز في أصل واحد ويساعد التنويع إلى حد كبير في تقليص حجم المخاطر إلى مستويات مقبولة لذا فإن على المستثمر (فرد- شركة) أن يتعلم كيف يدير المحفظة الاستثمارية وكيف يبدأ التخطيط للاستثمار واتخاذ القرار الاستثماري وفق خطوات محدودة ومدروسة بعناية وبشكل أكثر شمولا فإن على كل فرد أن يتعلم أساسيات التخطيط المالي وذلك كطريقة تساعده في تنظيم حياته وتجنبه الكثير من التحديات المستقبلية وهو ما تشمله محاور التقرير كالآتي: - أولا: مفهوم المحفظة الاستثمارية للشركاتأداة مركبة من أدوات الاستثمار وذلك لأنها تتركب من أصليين أو أكثر يتم التفرقة بين محفظة وأخرى بسبب نوعية الاستثمارات التي تحتويها من مجموع القيم المنقولة المتمثلة في الأسهم السندات المشروطة والتي تكون بحوزة الشركة المستثمرة وهي تمتاز باختلاف أصولها من حيث النوع كما تختلف من حيث الجودة فمن حيث النوع يمكن أن تحتوي على أصول حقيقية وهي الأصول التي لها قيمة اقتصادية ملموسة مثل العقارات والذهب والفضة والمشاريع الاقتصادية وعلى أصول مالية مثل الأسهم والسندات وسندات الخزينة وذلك لتحقيق هدفين رئيسين. تحقيق العائد المترتب عن الاستثمار في الأوراق المالية وخلافه. تحويل تلك الأوراق والأصول إلى سيولة جاهزة بأي وقت حسب الحاجة.ثانياً: مراحل تكوين المحفظة الاستثمارية للشركاتتشمل مراحل إدارة المحفظة الاستثمارية بداية تحديد السياسة الاستثمارية أو تخطيط الاستثمار يتبعها دراسة الأسواق والأداء المتوقع للاتجاهات المستقبلية أما المرحلة الثالثة هي تكوين وتأسيس المحفظة الاستثمارية وأخيرا مرحلة نشاط المتابعة والتقييم للأداء والنتائج والتوصيات في عمليات إدارة المحفظة الاستثمارية لذلك تكوين المحفظة الاستثمارية أو تشكيل محفظة الاستثمار وباستخدام بيان السياسة الاستثمارية للمستثمر وتنبؤات السوق المالي كمدخلات يتم تطبيق إستراتيجية الاستثمار وتحديد كيفية تخصيص الأموال المتوفرة بين فئات الأصول والأوراق المالية المختلفة لبناء المحفظة التي تقلل المخاطر وبالوقت نفسه تحقق الاحتياجات المحددة في بيان السياسة الاستثمارية.ثالثاً: الأهداف الرئيسية للمحافظ الاستثمارية للشركاتأهداف المحافظ الاستثمارية مزيج بين العائد والمخاطر والسيولة والأمان نظرا لأن العلاقة بين العائد والمخاطر فيجب ألا يعبر عن الهدف الاستثماري بالعائد فقط لأن ذلك يؤدي إلى أداء غير ملائم كاستخدام إستراتيجيات استثمارية ذات مخاطر عالية أو استخدام سياسة التحرك السريع بين الاستثمارات لمحاولة الشراء بسعر الرخيص والبيع بسعر عال فهدف العائد بالنسبة للاستثمار يمكن أن يوضع علي شكل رقم مطلق أو نسبة مئوية ولكنه أيضا على شكل هدف عام مثل: -(المحافظة على رأس المال) يعني أن المستثمر يرغب بأقل كم ممكن من المخاطر وعادة هو يرغب بالمحافظة على القوة الشرائية لاستثماره بمعنى أن العائد المطلوب ليس أقل من معدل التضخم وبشكل عام فهذه الإستراتيجية المستثمر شديد التجنب للمخاطر أو إستراتيجية الفرد الذي يحتاج إلى الأموال في المدى القصير. (المحافظة على عائد جارٍ ودوري) عندما يكون الهدف هو الدخل الجاري فإن المستثمر يرغب بتركيز محفظته الاستثمارية على الأصول التي تولد دخلا أكثر من تلك التي تحقق أرباحا رأسمالية وهذه الإستراتيجية تلائم أحيانا المستثمرين الذين يرغبون لأن تكون محافظهم الاستثمارية مكملة للدخل وذلك لتوليد دخل قابل للإنفاق إضافيا.(زيادة رأس المال وحقوق الملكية) يمثل هدفا مناسبا للمستثمر الذي يريد لمحفظته الاستثمارية أن تنمو نموا حقيقيا عبر الزمن وذلك لمقابلة احتياجاته المستقبلية وفي ظل هذه الإستراتيجية فإن النمو يحصل بشكل أساس من خلال الأرباح الرأسمالية وهذه إستراتيجية الفرد الذي يكون مستعدا لتحمل المخاطر لتحقيق الأهداف مثل المستثمر طويل الأمد. (الحصول على عائد إجمالي مرتفع) هدف هذه الإستراتيجية مشابه لإستراتيجية زيادة رأس المال حيث يرغب المستثمر أن تنمو محفظته عبر الزمن لمقابلة احتياجاته المستقبلية وزيادة تحقيق الأرباح الرأسمالية بشكل أساس من خلال زيادة القيمة الكلية للمحفظة وإعادة استثمار الدخل الجاري وبما أن الدخل الإجمالي مكون من دخل جار وأرباح رأسمالية فإن درجة المخاطر تندرج بين استراتيجية الدخل الجاري واستراتيجية زيادة رأس المال. رابعاً: الضوابط الشرعية للاستثمار في قطاع التأمين الإسلامي الاستثمار في الوجوه المشروعة فلا تستثمر في الاستثمار المحرم وفي المضاربات غير المشروعة أو حتى المساهمة في الشركات غير المشروع أعمالها كالبنوك الربوية أو ما فيه الشبهة وما يؤول إليه. تلتزم في استثماراتها لأحكام المبادئ الشرعية فلا تتعامل بالربا وما يؤول إليه أو الغرر مع الالتزام بالقواعد الشرعية في المعاملات والعقود والأنشطة. ضرورة وجود هيئة رقابة وتدقيق شرعية لتقييم معاملاتها وأنشطتها وحتى تكون في دائرة المشروعية بصفة دورية. تحرص على الجانب الأصلي في عملياتها وهو الجانب التكافلي التعاوني ولا يكون الجانب الأهم هو تحقيق العوائد والأرباح مع الأخذ بالاعتبار فائدة العوائد في شركات التأمين التكافلي لتحقيق الاستمرارية والتقدم والنمو لعمليات التنمية الاقتصادية للمجتمع ولكن مراعاة الآداب الإسلامية في التعاملات دون أي أضرار لأموال الغير. المفاضلة والاختيار بين العاملين المؤمنين برسالة التأمين التكافلي القائم علي التكافل والتعاون والقيام بالتدريب والتطوير المستمر لتحقيق المهنية العالية في العلوم المالية والشرعية معا والأخلاق الإسلامية. التزام شركات التأمين التكافلي بالتعامل لإعادة أقساط التأمين لدى شركات إعادة التامين الإسلامية قدر الإمكان وحرمة التعاون مع الأصل والتبع في جواز إعادة التأمين لدى الشركات التجارية لأنها من جنس شركات التامين طبقا لمبدأ الضرورات والحاجة الملحة لما فيه الغرر والجهالة والربا.خامساً: ضوابط الهيكلة المالية للاستثمار في قطاع التأمين الإسلاميالهيكلة المالية تمثل التغيرات المعتبرة في هيكل رأسمال الشركة ومنها كالتالي:(تقييم الأصول) إعادة تقييم الأصول جميعها أو بعضها بما يعكس قيمتها السوقية حيث إن زيادة هذه القيمة عن القيمة الدفترية يؤدي إلى تحسين نسبة المديونية بالنسبة لحقوق الملكية الأمر الذي يتيح للمنظمة مجالاً أوسع للتمويل.(هيكلة الديون من دون إضافة) يساعد الشركة في أن تتفاهم مع دائنيها على أحد أو بعض هذه الأمور كتحويل الديون القصيرة إلى ديون طويلة الأجل مما يتيح للشركة فترة أطول لاستثمار هذه الديون وقف سداد أقساط الدين مؤقتاً أو إعطاء فترة سماح جديدة ويساعد ذلك في وقف جزء من التدفقات النقدية الخارجية مؤقتاً لحين تحسن الأحوال تخفيض تكلفة التمويل أو التنازل عن العوائد المستحقة مبادلة المديونية بالملكية إذ يتم تحويل كل أو جزء من الديون الحالية إلى مساهمات في رأسمال الشركة مثلا عن طريق إصدار أسهم ملكية بما يعادل قيمة هذه الديون وكذلك الملاك حيث سيكون للملاك الجدد تأثير مباشر على إدارة الشركة.(زيادة رأس المال) تلجأ الشركة إلى إصدار أسهم جديدة لتوفير بعض السيولة وعلى الأخص إذا كان بإمكانها تحقيق أرباح مستقبلا في ضوء توفير السيولة وذلك عن طريق زيادة رأس المال بإصدارات أسهم جديدة ولكن يواجه هذا البديل بعض الانتقادات منها أنه لا يصلح إلا في حالات التعثر المالي أو المؤقت ولا تجد الأسهم الجديدة إقبالاً من قبل المساهمين لخوفهم من حالة الشركة وظروفها المستقبلية هذا بالإضافة أن حملة الأسهم يمثلون قيداً جديداً على الإدارة يقلل من قدرتها على التحرك بمرونة كافية.(زيادة التدفقات النقدية الداخلة) يمكن تحقيق ذلك من خلال العديد من الاستراتيجيات أو التصرفات المطلوبة التي تؤثر إيجاباً على النقدية الداخلة ومن ذلك زيادة الخدمات لزيادة إيرادات الشركة تغيير استراتيجيات التحصيل لديون الشركة ومنح بعض خصومات تعجيل الدفع التخلص من بيع وإعادة استئجار بعض الأصول غير الرئيسية.(خفض التدفقات النقدية الخارجة) تستطيع الشركة أن تخفض مدفوعاتها النقدية أو تؤجل بعضها للتغلب على بعض الصعوبات المالية ومن الوسائل الممكن استخدامها في ذلك الاتفاق مع الدائنين على تأجيل سداد بعض الأقساط دون زيادة أو مرابحة التمويل والتفاوض مع الموردين الحصول على فترات سماح جديدة من الدائنين تأجيل سداد الالتزامات قصيرة الأجل أو تحويلها إلى التزامات طويلة الأجل من دون زيادة كذلك خفض كمية المصروفات ومحاولة البحث عن طرق بديلة أقل تكلفة من الحالية.سادساً: مخاطر المخالفات الشرعية للاستثمار الإسلامي المتعارف عليه أن الخطر يتعلق بالجوانب المالية للاستثمار مثل المخاطر الائتمانية ومخاطر سعر الصرف وما إلى ذلك ولكن كنا بصدد الحديث عن محافظ الاستثمار بالشركات الإسلامية فيحسن الإشارة إلى أن مفهوم المخاطرة يمكن أن يكون أوسع مما ذكر أعلاه بإدخال الجوانب الشرعية المتعلقة في محافظ الاستثمار في قياس المخاطر لماذا يتفادى الناس المخاطر لأن وقوع المكروه يؤدي إلى انخفاض قيمة الاستثمار بالخسارة أو عدم تحقق الربح الذي يكافئ الفرصة المضاعة ولا ريب أن مخالفة المعايير الشرعية يؤدي إلى اكتساب ربح غير حلال يلزم على المستثمر التخلص منه فيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة استثماره وإلى عدم تحقق أهدافه الاستثمارية فضلا عن ضياع الوقت والجهد ثم صرف الأرباح المتحققة بأوجه الخير.
3139
| 19 أكتوبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يتميز عالمنا المعاصر بدرجة عالية من التعقيد والتشابك والتغير خاصة في الأمور الاقتصادية والمالية والمحاسبية وتدقيق الحسابات وذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتلاحقة في أساليب وأدوات الإنتاج وأساليب ووسائل الاتصال ونظم المعلومات ونقلها إضافة إلى ظهورالأشكال التنظيمية الجديدة والشركات المتعددة الاشكال التنظيمية ( خاصة - عامة - محدودة - أموال وهكذا ) مما زاد من حدة المنافسة وخطورتها الأمر الذي يستلزم اتخاذ قرارات سريعة وفاعلة حتى تتمكن المنظمة من الاستمرارفي التنافس والحفاظ على ميزاتها في السوق مما يتطلب توفر معلومات حديثة ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة إن هذا الأمر يتطلب بناء نظام معلومات يهدف إلى تحديد نوع وحجم البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتحليلها ووجود الرقابة الفاعلة عليها وتدقيق مخرجاتها عندما تتحول البيانات الخام إلى معلومات مفيدة وموثوق بها لاتخاذ القرارات وتقييم الأداء وتأسيسا على ذلك تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف الهامة في الشركات خاصة المساهمة العامة نظرا للتوسع الكبير في الملكية وفي حجم الأعمال والتطورات الكبيرة التي تحدث في المجالات المالية والإدارية وزيادة حدة المنافسة بين الشركات وبالتالي عدم قدرة وتفرغ الإدارة للقيام بالوظائف الرقابية والتدقيقية المنوط بها وفي الوقت نفسه يمكن القول أن أنظمة ادارة الجودة الشاملة قد يكون لها تأثير كبير على المدقق الداخلي حيث أن التوجه نحو المعايير المحددة في شهادات الجودة سوف يزيد من أدوارمدققي الجودة الداخليين لضبط الجودة ومسؤولياتهم الأمر الذي يؤثر على أعمال المدققين الداخليين اذا اتسعت دائرة عمل مدققي الجودة الداخلين لتشمل تقييم فاعلية وكفاءة أنظمة الجودة بمؤسسات المال والأعمال بشكل كلي وصولا إلى نقطة إدارة الرقابة الداخلية والتعامل مع الاستخدام الفاعل والاقتصادي للموارد وتحقيق الأهداف الموضوعة للعمليات والبرامج الأمر الذي سينعكس على التطور الحاصل في أدوار ومسؤوليات المدققين الداخليين وعليه سيكون محاورالتقدير كالتالي :-أولا : مفهوم الضوابط والنظم الرقابية في الشركة هي الخطط التنظيمية والطرق والأساليب التي تتبعها المؤسسات المالية ومنها لحماية أصولها والتأكد من دقة الاعتماد على البيانات والمعلومات المحاسبية في تزويد الإدارة بما يجعلها على بينة واطلاع على السياسات التشغيلية وكفاءة الأداء وتعد النظم الرقابية في هذا المجال الإطار العام الذي يحدد نوعية التدقيق من حيث الشمول والاختصار ولذلك فإن معرفة المدقق للبيئة الرقابية يمكنه من تحديد مهمته بالصورة المطلوبة.لقد برز الاهتمام المتزايد بالتدقيق الداخلي وأنظمة الرقابة الداخلية ودورهما في منظمات الأعمال الحديثة لهذه الشركات بشكل كاف على وظيفة التدقيق الداخلي وعدم إعطائها الأهمية لدور هذه الوظيفة كأداة تسعى ضمن ما تسعى إليه لتفعيل النظم الرقابية. ثانيا : مفهوم التدقيق الداخلي تمثل خطة التنظيم وجميع الطرق والمقاييس المتبناة داخل منظمة الأعمال من أجل حماية أصولها وفحص دقة وموثوقية بياناتها المحاسبية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتشجيع الالتصاق والتقيد بالسياسات الإدارية الموضوعة مسبقا ويجب أن يأخذ أسلوب التدقيق أهمية نظم المعلومات والهياكل الرقابية وحسب تعريف معهد المدققين الداخليين الأمريكي نشاط تأميني واستشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة القيمة وتحسين عمليات المنظمة عبر مساعدتها في تحقيق أهدافها بواسطة إكساب المنظمة آلية منظمة ومنهجا انضباطيا لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وعمليات حوكمة الشركة.ثالثا : إدارة جودة تطبيقات التدقيق الداخلي تطبيقات الجودة هي مجموعة من خصائص المنتج تحدد مدى ملاءمة المنتج لكي يقوم بتأدية الوظيفة المطلوبة منه كما يتوقعها المستهلك أما ضبط الجودة وتدقيق الجودة الداخلي فحص منظم ومستقل لتحديد فيما إذا كانت نشاطات الجودة ونتائجها ذات العلاقة تتطابق مع ما هو مخطط له، يتم تطبيقه بشكل فاعل يحقق الأهداف الموضوعة ولذلك لا يمكن إنجازه بدون توثيق وتحديد الوضع الذي ينبغي أن يكون من خلال دليل الجودة.رابعا: وظائف دائرة التدقيق الداخلي وظيفة التدقيق الداخلي من أهم الوظائف التي تتميز بها شركات المساهمة ولا شك أن أهمية التدقيق الداخلي تكمن في مدى قدرة هذه الوظيفة على إضافة القيمة حيث نص التعريف الذي وضعه معهد المدققين الداخليين بوضوح على أن قيام التدقيق الداخلي بدوره الاستشاري والتأميني إنما يهدف بالأساس إلى إضافة القيمة للشركة ووضعه المعهد كهدف نهائي واستراتيجي لوظيفة التدقيق الداخلي وأشار المعهد إلى أن إضافة القيمة يتم من خلال تحسين وزيادة فرص إنجاز أهداف المنظمة وتحسين الإجراءات والعمليات وتخفيض المخاطر إلى مستويات مقبولة.خامسا: أهداف دائرة التدقيق الداخلي الهدف العام للتدقيق الداخلي إلى فحص الأنظمة المحاسبية وإجراءاتها والسياسات الإدارية المرسومة بهدف التحقق من تنفيذها طبقا لما هو مخطط لها واكتشاف أي انحرافات عن التنفيذ كما أن المدقق الداخلي معني بالفحص ضد الأخطاء والتلاعب في الدفاتر وفحص وتقييم وسائل الرقابة الداخلية بقصد تدعيمها وتحسينها واقتراح ما يراه كفيلا لتعديلها وتطويرها وآلية عملها لتحقيق أهداف الدائرة وهي:-( الهدف الأول) التدقيق في الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المؤسسة المالية والاقتصادية وخاصة إجراءات الضبط والرقابة. ( الهدف الثاني) تقييم هذه الأنظمة في ضوء المقاصد الفنية والمالية التي يهدف من حيث المبدأ إلى ضمان الجودة في الأنظمة الداخلية وضمان عدم الوقوع في المخالفات المالية والنظم المحاسبية التشغيلية للهيكل والنظام الأساسي لإنشاء المؤسسة المالية والاقتصادية.( الهدف الثالث) تقديم الحلول الملائمة لطبيعة العمل المالي والاقتصادي في حال وجود خلل في هذه الأنظمة. سادسا : مجالات عمل خدمات التدقيق الداخلي أصبحت ثورة المعلومات والتكنولوجيا وصناعة المعلومات أحد أهم الصناعات الحديثة في الوقت الحاضر فهي تقف وراء نجاح الشركات وتعطيها القوة والاستمرارية والمنافسة مما أثار الحاجة إلى ضوابط رقابية للحد من المخاطر الجديدة الناجمة عن التطورات الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات ومن أجل نجاح عمليات التدقيق والضوابط الرقابية فلا بد من تكامل الخدمات التدقيقية والضوابط الرقابية في بيئة نظم وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال المجالات التالية تدقيق تكنولوجيا المعلومات- التشغيلي - المالي- الالتزام - تقييم المخاطر- مراجعة الرقابة الداخلية - رقابة التقدير الذاتي - مساعدة التدقيق الداخلي والخارجي - النظام المحاسبي - تقييم نظام المعلومات المحاسبية وتصميمه وتطبيقه.سابعا: المهام الرئيسية لدائرة التدقيق الداخلي في المؤسسة أن دائرة التدقيق الداخلي لها أثر واضح في عملية تطوير أداء شركات المال والأعمال لتواكب التطور الحاصل في نشاطاتها وتقييم الأنظمة الداخلية أي أن مسؤولية المدقق الداخلي في تقييمه للأنظمة الداخلية لا تقتصر فقط على أهداف الشركة فقط أو مصلحته الخاصة وإنما هنالك أطراف أخرى يجب أن تدخل في حسابات هذا التقييم ولتوضيح الصورة أكثر يجب أن نعلم إبتداء أن الشركة لها أهداف خاصة تتمثل في تعظيم ربحيتها ضمن الضوابط والنظم ولها أهداف عامة تتمثل في المساهمة في تنمية المجتمع المحلي والمساهمة في الخطط العامة للدولة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ومن هذه المهام :- إعداد وتقييم الفحوصات الرقابية للوحدات. القيام بمراجعة مستقلة للأنظمة في الوحدات للتأكد من أن الإجراءات الرقابية فعالة وتعمل بالشكل الصحيح. تزويد دائرة مخاطر العمليات بنتائج فحوصاتها وأي ضعف أو نقص في هذه الإجراءات. تضمين تقرير التدقيق عن وحدات الشركة المختلفة ملخصاً للبيئة الرقابية بالوحدة بالاعتماد على فحص نظام وكذلك معيار التقييم.
4932
| 11 أكتوبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اتسمت البيئة الاقتصادية المحلية والدولية في الفترة الأخيرة بالاهتمام بعالم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية وهذا لأجل تحقيق المنفعة العامة والخاصة لذلك لا تزال المشاريع على اختلاف أنواعها وأحجامها وتسمياتها تشكل حافزا وفرصا هامة لدى المؤسسة والفرد على حد سواء.. فالمؤسسة مهما كان حجمها ونوع نشاطها فهي تسعى جاهدة إلى امتلاك المزيد من المشاريع خاصة منها ذات العائد الكبير..وبالتالي فهي لا تتردد في تسخيرمواردها وتكييف نشاطاتها مع ما يتناسب وتلبية حاجيات وأهداف مشاريعها من هذا المنطلق، فالمؤسسة والفرد المهتمون بالمشاريع الاستثمارية يشكلان معا الجزء الهام والكبير للاقتصاد وحركته الإنتاجية.. ونظرا للمجال الواسع للمهتمين بالمشاريع الاستثمارية وحب الدراسة والبحث في كل الإستراتيجيات والقرارات المتخذة.. وللدقة سوف يتم التحليل الكمي للوصول إلى الترجمة الفورية للمعطيات والبيانات من أجل اتخاد قرار سليم فعملية اتخاد القرار الاستثماري تعتبر مشكلا جد معقد وكل طريقة أومنهجية علمية ستوضح القرار وتسهل المقارنة مع عدة مشاريع فالمشاريع على حسب أنواعها كثيرة وأهميتها هي التي تعبر عن رأسمال المستثمر لذلك فالتحليل والتخطيط المالي هو علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاغها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما فمثلا العلاقة بين الأصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الأجل على المنشأة والعلاقة بين أموال الملكية والالتزامات طويلة الأجل بالإضافة إلى العلاقة بين الإيرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها والبحث عن أسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالإضافة إلى تقييم أنظمة الرقابة ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذلك في الوقت المناسب ومن أهم مرتكزات البرامج التطبيقية كل من الربح الناتج من قائمة الدخل والتدفقات النقدية التشغيلية الناتجة من قائمة التدفقات النقدية، وهي أيضا أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في برامج التحليل والتخطيط المالي من قبل المستثمرين ( فرد- مؤسسة) والمحللين الماليين وهو ما يتضمنه محاور هذا التقرير كما يلي:التحليل الأساسي أولا: مفهوميرتكز التحليل الأساسي على استخدام القوائم المالية للشركة للتوصل إلى قيمتها السوقية على ضوء النمو المتوقع في الأرباح وبالتالي القيمة السوقية لأسهمهما، وذلك يتطلب البدء بالتحليل الاقتصادي على المستوى الكلي حيث يتطرق إلى النمو الاقتصادي المتوقع ومعدل التضخم ومستوى التوظيف ومستوى واتجاهات أسعار الفائدة وصولاً إلى إجمالي الناتج المحلي من السلع والخدمات، حيث تستخدم تلك التنبؤات كأساس للتوصل إلى المستوى المتوقع لمبيعات مختلف الصناعات ومن ثم الوصول إلى المبيعات والأرباح المتوقعة لمختلف الشركات داخل الصناعة المعنية. ثانيا: مفهوم التحليل الفنيالتحليل الفني لا يركزعلى العوامل الأساسية الخاصة بالشركة والبيئة الاقتصادية وينصرف اهتمامه في الأساس إلى تتبع وتسجيل حركة الأسعار وحجم التداول في الماضي في رسوم بيانية على أمل اكتشاف نمط لتلك الحركة يعد مؤشراً يعتمد عليه في التنبؤ باتجاه الحركة السعرية في المستقبل ورغم وجود خلاف حول أهمية التحليل الفني إلا أن شركات السمسرة على سبيل المثال تعتمد على المعلومات المستمدة من التحليل الفني في اختيار الأسهم التي يتم التعامل عليها. ثالثا: دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية دراسة فكرة مشروع جديد لأجل إدراك وتحليل إمكانية تطبيق المشروع ونجاحه وأن دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع مثل قوانين الدولة والمنافسة التطور التكنولوجي كما أنها تعبر عن الوسيلة المثلى لمعرفة مدى توافر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع وتسويق إنتاجه، إذا فدراسة الجدوى تقتصرعلى العموم على مجالين بصورة مبسطة وميسرة منها: * معرفة ما نحتاجه لمشروعك وفرص نجاحه مستقبلا.* الإثباث للممولين أن هدا المشروع يتوقع له النجاح وتحقيق عائد استثماري جيد. رابعا: الأهداف الإستراتيجية لبرامج التحليل والتخطيط المالي يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى أداء المنشآت واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الأغراض التالية كما يلي:(التحليل الائتماني) الذي يقوم بهذا التحليل هم المقرضون، وذلك بهدف التعرف على الأخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها.(التحليل الاستشاري) الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من أفراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما أن هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفاءة الإدارة في خلق مجالات استثمار جديدة، بالإضافة إلى قياس ربحية وسيولة المنشأة.(تحليل الاندماج والشراء) يستخدم هذا النوع من التحليل أثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الأداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.(التخطيط المالي) يعتبر التخطيط المالي من أهم الوظائف للإرادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور بأداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب أدوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الأداء السابق وتقدير الأداء المتوقع في المستقبل.(الرقابة المالية) تعرف الرقابة المالية بأنها تقييم ومراجعة للأعمال للتأكد من أن تنفيذها يسير وفقا للمعايير والأسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الأخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب.(تحليل تقييم الأداء) يعتبر تقييم الأداء في المنشأة من أهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية إعادة التقييم الحكم على مستوى الأرباح وقدرة المنشأة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالإضافة إلى تقييم الموجودات، أما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي إدارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية. خامسا: القرار الاستثماري في المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلاميةقرار الاستثمار في الفكر التجاري بأنه القرار الذي ينطوي على تخصيص قدر معلوم من أموال المنشأة في الوقت الراهن على مدار فترة زمنية طويلة نسبياً بغية تحقيق ربح في المستقبل ويكون عرضه لدرجات مختلفة من المخاطرة وعدم التأكد وتمر عملية اتخاذ القرار الاستثماري بصفة عامة بعدة مراحل ابتداء من ظهور فكرة أو مقترح استثمارى معين حتى يتم وضع الموازنة التخطيطية الاستثمارية وتنفيذها يمكن إيجازها فيما يلي:(تقييم المقترحات الإسلامية) تتمثل هذه المرحلة في إجراء الدراسات اللازمة لاكتشاف الفرص الجديدة المتاحة للاستثماروالتنمية ودراسة شرعيتها وجدواها الفنية والاقتصادية حيث يتم في هذه المرحلة دراسة الجدوى المبدئية الإسلامية والعامة لكل مقترح استثماري على حدة، وكذلك دراسة الجدوى التفصيلية القانونية والتسويقية والفنية والمالية والاقتصادية وتنتهي هذه المرحلة بتصنيف المقترحات الاستثمارية المتاحة إلى مقترحات استثمارية مرغوب فيها مقترحات استثمارية غير مرغوبة ومرفوضة.(إعداد الخطة الاستثمارية) تتمثل هذه المرحلة في اختيار توليفة أو تشكيلة الاستثمارات الملائمة والممكنة من بين الفرص الاستثمارية المتاحة والتي ثبت جدواها ووضع الخطة الاستثمارية في ضوء القيود المختلفة تمويلية وفنية وغيرها التي قد ترد على القرار الاستثماري في هذه المرحلة. (الرقابة وتقويم الأداء) تتمثل هذه المرحلة في الرقابة على الخطة الاستثمارية بصفة عامة ومتابعة تنفيذ كل وحدة نشاط استثماري على حدة، ومن ثم إبداء الرأي العام فيما إذا كان النشاط الاستثماري قد تم بطريقة مرضية في ضوء الأهداف المخططة له وهو ما يطلق عليه البعض التقييم اللاحق للاستثمارات. سادسا: المعايير المالية للاستثمار الإسلاميتقوم المعايير المالية للاستثمار الإسلامي على منهج المحافظة على المال وتنميته في ضوء المعايير الاجتماعية والاقتصادية السابق، وذلك لأن عدم تحقيق الضمان لأصحاب الأموال وتحقيق عائد مناسب لهم ربما يؤدى إلى تقليص قاعدة الاستثمار الإسلامي وعدم إمكانية التوسع فيه، وفيما يلى أهم المعايير المالية التي يجب أخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. ( معيار تحقيق الربحية التجارية المناسبة) تحقيق الربح من أهم مقاييس النفع لأصحاب الأموال فالربح يقى رأس المال من النقصان الظاهرى بسبب الزكاة ويساعد على تنميته وزيادته كما أنه يمكن من مواجهة مخاطر المستقبل بتكوين الاحتياطيات اللازمة ولذا يمثل معيار تحقيق الربحية التجارية المناسبة أحد المعايير الهامة للاستثمار الإسلامي فمن غير المقبول إسلاميا الاستثمار فى عمليات خاسرة أو متوقعة الخسارة، حيث إن تحصيل بعض الربح يعتبرهدفا إسلاميا هاما للمشاريع الخاصة وأن عدم تحقيق الخسارة يعتبرهدفا إسلاميا هاما لتلك المشاريع العامة التى تبيع إنتاجها وتنقسم أساليب تحليل ربحية الاستثمار إلى مجموعتين هما مجموعة المعايير التقليدية التي لا تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود وتتمثل في فترة الاسترداد ومعدل العائد على الاستثمار مجموعة معايير الخصم التي تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود وتتمثل في صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخل ودليل الربحية.(معيار المخاطر) المخاطر من المعايير المالية الهامة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية لمعرفة ما قد يصيب المشروع الاستثماري من خسائر نتيجة تعرضه للمخاطر المختلفة خلال عمره الإنتاجي بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها كهدف ودوافع للاستثمارالإسلامي والمخاطرة قد ترجع إلى طبيعة المشروع نفسه أو إلى أخطاء فى تقديرالتدفقات النقدية الخارجة والداخلة خلال عمرالمشروع وهناك مداخل مختلفة لتحليل المخاطرة وعدم التأكد في المشروعات الاستثمارية ويعتبرالمدخل الكمى من أهم المداخل التى يمكن الاعتماد عليها فى تحليل المخاطرة حيث يقوم هذا المدخل على فكرة أوتوماتيكية قرار الاستثمار ويركزعلى إخضاع عوامل المخاطرة وعدم التأكد للقياس الكمي وذلك من خلال وصف المخاطرة الداخلة في أي بديل استثماري بتوزيع احتمالي للنتائج المتوقعة المرتبطة بالاستثمار وتحديد الجدوى من بدائل الاستثمار في ضوء مدى من النواتج المتوقعة والبيئة التي يتم فيها صنع القرار..
5096
| 04 أكتوبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); التسهيلات الائتمانية والمصرفية من أكثر الفعاليات جاذبية لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية والتجارية على حد سواء وبالوقت نفسه من أكثر الأدوات الاقتصادية حساسية، إذ لا تقف تأثيراتها على مستوى المؤسسة التمويلية فقط والمؤسسات المالية ذات العلاقة وإنما تصل بأضرارها إلى الاقتصاد المحلي إذا لم يحسن استخدامها، فالتسهيلات الائتمانية تعتبر ذراع الاستثمار والتمويل الأكثر تأثيرا على إدارة المؤسسة التنفيذية نظراً للمخاطر العالية التي قد تؤدي إلى أكبر المشكلات فيما بعد وهو في ذات الوقت الأكثر جاذبية للمؤسسة والذي يمكن من خلالها تحقيق الجزء الأكبر من (الأرباح – الأمان – السيولة) وبدونها تفقد المؤسسة المالية والاقتصادية دورها كوسيط تمويلي في الاقتصاد وللحد من آثار هذه المخاطر تسعى السلطات الإشرافية إلى وضع ضوابط لمنح التسهيلات الائتمانية واستخدامها ومتابعتها ومدى تركزها ونوعية الضمانات والمعلومات الواجب توافرها قبل منحها أو تجديدها فالكثير من المؤسسات المالية والاقتصادية لا تتوخى الدقة والحذر في تقييم محافظ التسهيلات الائتمانية ولا تعمل بالتالي على تكوين المخصصات الكافية لمقابلة مخاطر تلك المحافظ وتقوم في الوقت نفسه بمعالجة الأرباح على بعض التسهيلات غير القابلة للتحصيل كإيرادات ويساهم ذلك الأمر في تحقيق أرباح وهمية يتم توزيعها على المساهمين ويؤدي إلى تراكم الديون المتعثرة لدى هذه المؤسسات وحيث إنه لم يتم تكوين المخصصات الكافية وعدم سلامة الوضع المالي لتلك الجهات والمؤسسات المالية ونظرًا لصعوبة اتخاذ إجراءات تصحيحية آنية فعالة فإن من شأن ذلك أن تنعكس آثاره سلبًا على وضع الجهاز المالي والمصرفي برمته ومن ثم على الوضع الاقتصادي المحلي ولذلك فإن نجاح المؤسسات التمويلية في الاحتفاظ بموجودات جيدة يعتمد أساسًا على مدى نجاحها في ترشيد المخاطر المرتبطة بالمحفظة والتسهيلات الائتمانية، حيث إنه قد ينتج عن عدم سداد أصل الائتمان تعرض تلك المؤسسات والجهات المرتبطة بها إلى المخاطر وتشمل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات التمويلية في مجال منح الائتمان تلك المتعلقة بالمتمول عدم مقدرته على إدارة أعماله والوفاء بالتزاماته والمخاطر المتعلقة بالضمانات المقدمة منه من حيث قابليتها للتسييل في آجال مناسبة ومدى تعرض قيمتها السوقية للانخفاض والمخاطر الخاصة بطبيعة نشاط العميل المرتبط بالمناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العام، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتركز الائتماني، سواء بالنسبة لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد، شاملا الأطراف ذات العلاقة المشتركة أو الممنوحة لنشاط إنتاجي أو خدمي أو تلك الممنوحة لمنطقة جغرافية معينة ويتضمن تقييم مخاطر التسهيلات الائتمانية والتعامل مع تلك المخاطر من خلال تصنيف ومتابعة المستحقات والمتأخرات وفي هذا الإطار تبرز أهمية وضع سياسات موحدة لتصنيف الأصول والالتزامات وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة تدني قيمتها بما يحقق كفاية الأصول لمقابلة الالتزامات على المؤسسة التمويلية وهو ما تشمله محاور التقرير الاقتصادي:أولا: فوائد التسهيلات الائتمانيةتعتبر التسهيلات الائتمانية المصدر الأساسي لإيرادات المؤسسة التمويلية، لذا نجد توجيه الإدارة العليا في المؤسسات المالية للاهتمام بوضع السياسات الائتمانية الجيدة والتي يراعى من خلالها تحقيق أهداف المؤسسة وترضي متطلبات العملاء والقوانين والتشريعات المصرفية، لذلك يمكن التأكيد على أن التسهيلات الائتمانية تلعب دوراً فريداً في الحياة الاقتصادية ومن خلاله يتمكن أن يضمن مستويات من النمو والاستقرار وفق ما يقدمه من مهام للاقتصاد منها:* تصبح عملية المفاضلة بين المصادر المالية داخل الاقتصاد مقيدة، كما أن فوائض الوحدات الاقتصادية المدخرة لن تتدفق بكفاءة إلى الاستخدامات الأكثر إنتاجية.* أساس لتنظيم عملية إصدار النقود القانونية فالمصارف المركزية عندما تشرع في وضع سياسة للإصدار تضع في اعتبارها حجم الائتمان المنتظر من النظام المصرفي في نطاق الخطط العامة، فالنقود تخرج للتداول بصفة أساسية عن طريق قيام الوحدات الإنتاجية بصرف ما هو مخصص لها من ائتمان وبهذا يعمل على تدعيم الوحدة النقدية.* يؤدي سحب التسهيلات الائتمانية من قبل الممولين إلى زيادة حجم المعروض النقدي ولهذا فالائتمان المصرفي يعتبر عاملا مهما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد حجم الإنفاق والقوة الشرائية المتاحة داخل الاقتصاد. * التسهيلات الائتمانية أداة بيد الدولة تستخدمها في الرقابة على نشاط المشروعات وذلك من خلال استخدامها للأرصدة الائتمانية المخصصة لها.* لها تأثير مباشر على زيادة الادخار والحد من الاستهلاك وذلك لأن المؤسسات المالية تعمل على تشجيع الأفراد على الادخار لتوفير موارد للتسهيلات الائتمانية، الأمر الذي يحد من الاستهلاك.ثانيا: إدارة وتنظيم تطبيقات تصنيف التسهيلات الائتمانية في القطاع التمويلي تتم عمليات تصنيف التسهيلات الائتمانية بصورة مستمرة ودورية ولذلك يقوم به مسؤولون من المؤسسة المالية، فضلا عن عرض نتائجها مباشرة على مجلس الإدارة واللجان المنبثقة أو أحد مسؤولي الإدارة التنفيذية العليا الذي لا تتضمن اختصاصاته منح الائتمان كما يجب أن تشمل ملفات الائتمان البيانات الكافية اللازمة لفحص وتصنيف الديون بصورة جيدة وكحد أدنى يتعين أن يتضمن ملف العميل طلب العميل دراسة التسهيلات الائتمانية والغرض من الائتمان والموافقة على منح التمويل ومصادر السداد وأي ضمانات متاحة كما يجب أن يتم تقييم الضمانات مع أهمية توفر كافة المستندات القانونية المؤيدة لها.ثالثا: القواعد الرئيسية لتصنيف التسهيلات الائتمانية(القاعدة الأولى) يتم تصنيف التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بشكل عام خلال فترات دورية لا تتجاوز ستة أشهر مثلا كالتسهيلات المنتظمة الجيدة، تمثل التسهيلات الائتمانية التي تتصف بالثبات في التزام العميل بالشروط المتفق عليها عند منح الائتمان وذلك باستمرار التدفقات النقدية إلى الحساب بشكل يوفر الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات في مواعيد استحقاقها مع توفر البيانات المالية الدورية والضمانات الكافية لاسترداد الدين.والنوع الآخر كالتسهيلات غير المنتظمة، يتم تقسيم التسهيلات غير المنتظمة إلى ثلاثة أنواع رئيسية على الأقل يتم تحديدها بناءً على توافر شروط معينة وذلك على النحو التالي: دون المستوى - مشكوك في تحصيلها – رديئة. (القاعدة الثانية) من الضروري تحديد مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المؤسسات التمويلية في ضوء الزيادة المضطردة في حجم الإقراض الدولي للجهات الحكومية وشبه الحكومية وذلك نظرًا لاختلاف المخاطر المحيطة بها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الجغرافية وفي هذا الصدد يتعين وضع إطار عام لاحتساب المخصصات اللازمة والمطلوبة في حالة كل دولة وذلك عن طريق نظام للاحتساب حسب التشريعات التنظيمية والرقابية والإشرافية المعتمدة لديها.(القاعدة الثالثة) تكوين المخصصات للتسهيلات الممنوحة للعملاء وفقًا للنسب المقررة كحد أدنى كمخصصات محددة على سبيل المثال (دون المستوى – مشكوك بتحصيلها – رديئة) وكمخصصات عامة للتسهيلات المنتظمة وتحتسب المخصصات على صافي رصيد المديونية القائمة بعد استبعاد الضمانات المقابلة في حالة توفر ضمانات عينية أو مصرفية عالية الجودة وقابلة للتسييل في آجال ومستوفية للشروط القانونية. (القاعدة الرابعة) المعالجة المحاسبية للإيرادات على الديون غير المنتظمة يتم قيدها على الديون التي مضى على موعد استحقاقها ثلاثة أشهر مثلا ولم تدفع في حساب دائن معلق وبحيث تتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء ولكن لا تتم تعليتها على حساب الأرباح والخسائر وعندها يعامل الحساب على الأساس النقدي، كما أن كل الإيرادات المستحقة غير المحصلة من تاريخ التصنيف على الأقل تستبعد من الإيرادات.(القاعدة الخامسة) إجراءات تصنيف التسهيلات الائتمانية وتكوين المخصصات اللازمة لها يجب على المؤسسات التمويلية أن تقوم بفحص وتصنيف التسهيلات الائتمانية وتكوين كامل المخصص اللازم وبناء على ذلك، فإن على هذه المؤسسات أن تفحص وتصنف حسب السياسة المعتمدة لديها ما يزيد من الأرصدة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة سنويا ويجب تكوين المخصص على فترات دورية منتظمة لا تتجاوز نهاية السنة المالية وأن يتم إبلاغ المصرف المركزي بنتيجة التصنيف.رابعا: تطبيقات أنظمة الاستعلام الائتماني ترجع أهمية أنظمة الاستعلام المصرفي في ظل غياب المؤسسات المتخصصة في جمع المعلومات والبيانات حول الأفراد وشركات الأعمال الطالبة للتسهيلات الائتمانية لذلك فالاستعلام المصرفي له الدور الأكبر في الحصول على المعلومات اللازمة لتحديد شخصية العميل وسلوكه المصرفي والاستعلام المصرفي هو جزء لا يتجزأ من عملية التحليل الائتماني تقوم به دائرة ووحدة إدارية مستقلة في المؤسسة التمويلية تكون مهمتها جمع المعلومات من كافة المصادر بغية تحليلها وتلخيصها ضمن استنتاج يعطي دلالة واضحة على مكانة العميل الأدبية والتجارية والمالية بخلاف إدارة الائتمان التي تمثل بشكل عام والدائرة الخاصة بالاستعلام بشكل خاص تهتم بالحصول على المعلومات التي ترغب بها من مصادر عديدة ويمكن عرض هذه المصادر (العميل طالب الائتمان - مصادر داخلية - مصادر خارجية).خامسا: دور إدارة التسهيلات الائتمان في التحقق والاستعلام الهدف الرئيسي لإدارة التسهيلات الائتمانية إضافة قيمة إضافية للشركة عن طريق منح تسهيلات ائتمانية لعملاء موثوق بهم في قلب النظام المالي والاقتصادي ألا وهو نظام الائتمان والتي تقوم المؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية باتخاذ قرارات حول الائتمان والمصداقية الافتراضية للمقترضين، فالمؤسسة التمويلية تقوم باتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية بعد دراسة المركز المالي للعملاء وبعد التأكد من سمعتهم المالية ونيته السداد، إلا أنه من واجب مسؤولي التسهيلات الائتمانية بالمؤسسة التمويلية أن يستمروا في متابعة التغيرات التي تقع على العميل أو على مركزه المالي والتي قد تؤثر في قدرته على السداد، ويهدف ذلك إلى: * التحقق من مدى تنفيذ السياسة التي تضعها المؤسسات التمويلية، خاصة فيما يتعلق بحجم التسهيلات وتوزيعها على الأنواع المختلفة ومدى الالتزام بالضوابط الموضوعة لمنح الائتمان تمهيداً لإدخال التعديلات على هذه السياسة.* الاطمئنان لمدى تنفيذ الشروط الموضوعة للتسهيلات المصرح بها للعملاء، خاصة من حيث الالتزام بالحدود المصرح بها وحصول المؤسسة المالية على الضمانات المطلوبة واحتساب النسب الائتمانية وسقوفها لها، وفقاً للقواعد والنظم والتشريعات. * العقبات التي قد تعترض الممولين في الوقت المناسب بما يسمح باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المؤسسة التمويلية ومساعدة العملاء على تخطي هذه المشاكل من جهة أخرى تفادياً للخسائر التي قد تلحق المؤسسة المالية إذا تعثر العملاء في الوفاء بالتزاماتهم.
1576
| 27 سبتمبر 2015
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
13593
| 20 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1797
| 21 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1173
| 20 نوفمبر 2025

شهدت الجولات العشر الأولى من الدوري أداءً تحكيميًا...
1128
| 25 نوفمبر 2025

في مدينة نوتنغهام الإنجليزية، يقبع نصب تذكاري لرجل...
1047
| 23 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
996
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
918
| 20 نوفمبر 2025

أصبحت قطر اليوم واحدة من أفضل الوجهات الخليجية...
726
| 25 نوفمبر 2025

حينما تنطلق من هذا الجسد لتحلّق في عالم...
702
| 21 نوفمبر 2025

في زمن تتسارع فيه المفاهيم وتتباين فيه مصادر...
699
| 25 نوفمبر 2025
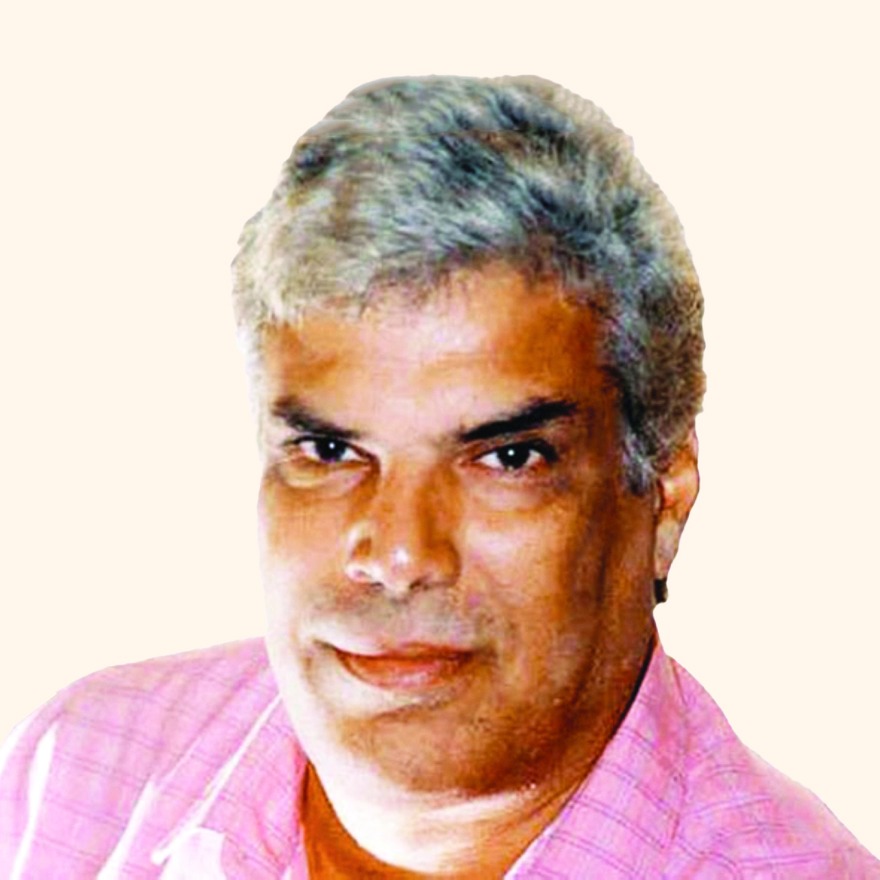
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
657
| 20 نوفمبر 2025
مع إعلان شعار اليوم الوطني لدولة قطر لعام...
624
| 19 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







