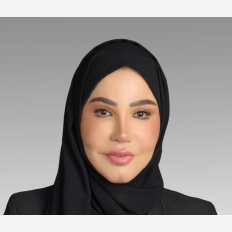رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في زمن تتسارع فيه المفاهيم وتتباين فيه مصادر التأثير، لم يعد سؤال (من يصنع القيم في المجتمع سؤالًا فلسفيًا، بل سؤال دولة تبحث عن تماسكها وهويتها وسط عولمة جارفة. فالقيم اليوم لا تُلقَّن… بل تُدار، وتُحكم، وتُصنع عبر منظومة متشابكة من الجهات. وهنا يظهر مفهوم الحوكمة المجتمعية بوصفه (الإطار الذي ينظم هذه المنظومة) ويمنحها الاتجاه الصحيح لضمان أن يبقى المجتمع ثابتًا رغم تغيّر العالم من حوله. الحوكمة الأسرية: الأسرة ليست مؤسسة صغيرة كما تبدو، بل هي أوّل نظام حوكمة يواجهه الإنسان في حياته. فيها يتعلم الاحترام، حدود الحرية، معنى المسؤولية، وكيف يُدار الخلاف. لكن المؤثرات الحديثة من الإعلام الرقمي إلى الألعاب الإلكترونية جعلت دور الأسرة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. لذلك تأتي الحوكمة هنا عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة التي يقع على عاتقها بناء برامج دعم للأسرة، وتطوير سياسات للحماية الرقمية، وتقديم إرشادات عملية تعيد للوالدين القدرة على قيادة السلوك، فالأسرة المحكومة بوعي، تنتج مجتمعًا محكومًا بالقيم. الحوكمة التعليمية: المدرسة والجامعة مصانع لإعادة تشكيل العقل والقيم والانتماء. تتمثل الحوكمة التعليمية في إدماج القيم في المناهج عبر تجارب تطبيقية، وتدريب المعلمين على أن يكونوا قدوات قبل أن يكونوا ناقلي معرفة، وتقييم الأنشطة المدرسية والجامعية كأدوات لبناء السلوك. ويظهر دور مجلس الشورى هنا كجهة تشريعية تراقب سياسات التعليم، وتضمن أن مخرجاته تتوافق مع الاحتياجات الوطنية ومعايير الهوية. الحوكمة الإعلامية: الإعلام لم يعد ناقلًا للخبر، بل صانعًا للاتجاهات والقيم الجديدة. وتحتاج حوكمة الإعلام إلى سياسات تحمي المجتمع من المحتوى الهادم والهش، وآليات لمراقبة الانحرافات الرقمية، وتشجيع الابتكار الإيجابي في صناعة المحتوى. وهذا ما يقع ضمن مسؤوليات وزارة الإعلام التي تقود التوازن بين الحرية والهوية، وبين الإبداع وضبط التأثير. الحوكمة الدينية: القيم الدينية هي الأساس الذي يقوم عليه الضمير الأخلاقي للمجتمع. وتتجلى حوكمة الأوقاف في خطب معاصرة تربط القيم بالواقع، وبرامج شبابية تمنح روح الدين بُعدًا إيجابيًا، وإعداد كوادر دينية قادرة على التأثير بلغة يفهمها الجيل الجديد. الدين حين يُحكم بوعي… يصبح عامل وحدة لا عامل خوف. الحوكمة الثقافية: الثقافة ليست فعاليات أو احتفالات، بل هي الذاكرة الجمعية للمجتمع. وتقود وزارة الثقافة حوكمتها عبر دعم التراث واللغة العربية، وإنتاج محتوى ثقافي ينافس عالميًا، وأنشطة تعزز الانتماء وتعيد الاعتزاز بالهوية القطرية. الحوكمة التشريعية: لا يمكن لأي منظومة قيم أن تستمر دون تشريعات. ومجلس الشورى هو الضامن لوجود قوانين تحمي الأسرة، وتنظم التعليم والإعلام، وتدعم الثقافة، وتراقب تنفيذ السياسات. إنه الحارس التشريعي للهوية والقيم واستدامتها. القيم لا تُصنع بجهة واحدة، ولا تُدار بالعاطفة. إنها مشروع وطني وعندما تعمل هذه المنظومة بتناغم… ينهض المجتمع بقيمه، ويواجه العالم بثقة، ويحمي هويته من التشتت والذوبان.
834
| 25 نوفمبر 2025
تحمل كلمة «الحوكمة» في المخيال الشعبي العربي قدراً من الغموض والالتباس. يربطها كثيرون بالبيروقراطية وتعقيد الإجراءات، ويختزلونها في لوائح جامدة تعطل الإنجاز. لكن تعريف الحوكمة يوضح أنها مجموعة من القواعد والمعايير والسياسات والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المنظمة والعاملين فيها وأصحاب المصلحة لتحقيق العدالة، والشفافية، والمصداقية، والاستدامة. الهدف إذن ليس تقييد المؤسسات، بل تحريرها من الفوضى وتحويلها إلى كيانات مسؤولة تستجيب لمطالب المجتمع. يعود جزء من سوء الفهم إلى التركيز على الجانب التنظيمي وإهمال روح الحوكمة. في قطاع التدريب مثلاً يعتقد البعض أن الحوكمة تعني تشديد الرقابة على الدورات وحصرها في قوالب جامدة. غير أن الخبراء يوضحون أن حوكمة التدريب لا تقتصر على ضبط السياسات والإجراءات، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تعزز المساءلة، وتربط أهداف التدريب مباشرة بالرؤية المؤسسية، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد التدريبية. إن تبني إطار متكامل يربط التدريب بالأهداف الإستراتيجية، ويقيس أثره على الأداء، يحوّل التدريب من نشاط تكميلي إلى أداة لتحسين الأداء وتطوير الكفاءات. وفي التعليم، يُعد تطبيق الحوكمة أساساً للنهوض بالمدارس والجامعات. إذ تعرف بأنها النظام الذي يوجّه ويُدير ويُراقب القطاع التعليمي لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة وشفافية ومساءلة. تتضمن الحوكمة التعليمية عناصر مثل الشفافية والمشاركة والمحاسبة والكفاءة. فهي تتيح لأولياء الأمور والطلاب والإداريين المشاركة في صنع القرار، وتضمن أن الموارد تُستخدم بفعالية، وأن النتائج التعليمية تُقاس وتُعلَن بشفافية. تكشف الدراسات أن الأنظمة التعليمية التي تبنت حوكمة فعالة شهدت تحسناً في جودة المخرجات وتقليصاً للهدر والفساد. أما القطاع الصحي، فبعض العاملين فيه يرون الحوكمة عبئاً إضافياً على العمل الطبي. لكن الحقيقة أن الحوكمة الصحية تعني ضمان إدارة الخدمات الصحية بشفافية ومسؤولية وعدالة. تقوم على مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة والعدالة، وتستخدم أدوات تقنية مثل أنظمة المعلومات الصحية لتسجيل البيانات وتحليلها وتحسين الأداء. بتطبيقها، يمكن تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين توزيع الموارد، وضمان حصول جميع المرضى على رعاية عادلة، بعيداً عن الولاءات والمحسوبية. وفي البيئة، تشير الحوكمة إلى مجموعة الإجراءات التي ترشد تعامل الإنسان مع بيئته للحفاظ على الموارد الطبيعية. فهي تتخطى الإدارة التقليدية التي تركز فقط على حماية الطبيعة، لتشمل الأبعاد الإنتاجية والاجتماعية وتحفّز المشاركة والمسؤولية المشتركة. هذه الحوكمة تدعو إلى صياغة سياسات واضحة لإدارة المياه والطاقة والنفايات، وإشراك المجتمع المدني في مراقبة تنفيذها. عندما تصبح حماية البيئة جزءاً من ثقافة المجتمع ومنظومة المؤسسات، يتحول الحديث من منع التلوث إلى تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. القطاع الاجتماعي أو غير الربحي يقدم مثالاً آخر لكيفية تحرير الحوكمة للعمل الخيري. فالقواعد المعتمدة لتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية تهدف إلى تطوير أدائها وتعزيز مساهمة الأفراد والداعمين ورفع كفاءة الشفافية والإفصاح. وهي تضمن أن التبرعات تُستخدم كما ينبغي، وأن القرارات تُتخذ بشكل تشاركي، ما يعزز ثقة المجتمع في العمل الخيري ويشجع المزيد من العطاء. إن الحوكمة إذن ليست قيداً، بل أداة تمكين. فهي تحرر المؤسسات من الشخصنة والفوضى، وتمنح أصحاب المصلحة الحق في الشفافية والمساءلة. من التعليم إلى التدريب، ومن الصحة إلى البيئة والقطاع الاجتماعي، تبرهن الحوكمة على قدرتها في تحسين الأداء وتعزيز العدالة. والمطلوب منا اليوم تغيير ثقافتنا، والانفتاح على هذا المفهوم باعتباره مدخلاً لتطوير مؤسساتنا وفتح آفاق جديدة للتنمية، لا كعبء بيروقراطي يرهقها.
168
| 20 نوفمبر 2025
على مدى أكثر من ستة عقود، تستثمر الدولة في الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها. تستثمر في صحته ليكون معافى قادرًا على العطاء، وفي تعليمه ليكون وعيه أساس البناء، وفي تأهيله المهني ليقود عجلة الإنتاج، وفي دعمه النفسي والاجتماعي ليبقى متوازنًا فاعلًا في مسيرة الوطن. لقد كان - وما زال - الاستثمار في الإنسان هو الخيار الإستراتيجي الأذكى الذي صاغ ملامح النهضة الحديثة للدولة، ورسّخ مكانتها بين الأمم من خلال الإيمان بأن التنمية تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه. غير أن مرحلة التقاعد، على أهميتها، تحوّلت لدى كثير من الأفراد إلى نقطة توقف لا انتقال. فبعد سنوات طويلة من الخبرة والعطاء، يُحال الموظف إلى التقاعد لينسحب بهدوء من المشهد العملي والمجتمعي، فتُطوى معه خبرات ميدانية متراكمة وذاكرة وطنية غنية بالتجارب. إن ما نملكه اليوم من طاقات بشرية متقاعدة يشكّل رصيدًا وطنيًا غير مستثمر يحتاج إلى آلية منهجية لإعادة دمجه في دورة التنمية. وفي خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أُشير بوضوح إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الضمانة الأولى لمستقبل الدولة. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة استثمار طاقات المتقاعدين لا تُعد ترفًا اجتماعيًا، بل ركيزة من ركائز التنمية البشرية المستدامة. التقاعد في جوهره ليس نهاية الخدمة، بل بداية مرحلة جديدة من العطاء، غير أن كثيرًا من المتقاعدين يواجهون تحديات معقدة في هذه المرحلة. فمنهم من يشعر بفقدان الهوية المهنية بعد أن كان اسمه مرتبطًا بوظيفة أو منصب رسمي، ومنهم من يعيش فراغًا يوميًا بعد عقود من الالتزام والانضباط، ومنهم من يواجه تراجعًا في المكانة الاجتماعية أو شعورًا بانقطاع الدور. وهذه التحديات لا تمس المتقاعد وحده، بل تمتد آثارها إلى المجتمع، إذ يخسر المجتمع خبرة تراكمية ضخمة. اتجاهات مقترحة لإعادة توظيف المتقاعدين: 1. مبادرة “المدرب المجتمعي”: تأهيل المتقاعدين ليكونوا مدربين في مجالات القيم، والهوية الوطنية، والتنمية الشخصية والمهنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ليصبحوا جسورًا تربط الأجيال وتغذي المجتمع بخبرات حقيقية. 2. مراكز “حاضنة القيم”: إنشاء حاضنات مجتمعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تعمل على استثمار المتقاعدين كموجهين ومرشدين للأسر والشباب، بما يعزز الترابط الاجتماعي وينقل الخبرة الإنسانية إلى المجال التطبيقي. 3. العمل التطوعي المؤسسي: إدماج المتقاعدين ضمن المنظومة الوطنية للتطوع ببرامج نوعية، بحيث يتم توظيف خبراتهم في المبادرات المجتمعية والتنموية، مما يمنحهم قيمة إضافية ويعزز رأس المال الاجتماعي للوطن. إن التقاعد لا يعني نهاية الدور، بل بداية فصل جديد من العطاء، والدولة التي تستثمر في الإنسان منذ أكثر من ستين عامًا قادرة على أن تحوّل هذه الخبرات إلى قوة تنموية ناعمة ترفد المجتمع بخبرة، وتثري الأجيال الجديدة بوعي وتجربة. إن إعادة استثمار المتقاعدين ليست مسألة إنسانية بل خيار تنموي إستراتيجي ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويؤكد أن الإنسان القطري يظلّ شريكًا في التنمية مهما تقدّم به العمر.
4884
| 11 نوفمبر 2025
من الطرائف العجيبة أن تجد اسمك يتصدر أجندة مؤتمر لم تُدعَ إليه أصلًا، وتكتشف أنك فجأة “قصة نجاح ملهمة” ضمن برنامج لم تسمع عنه. نعم، نحن في زمنٍ صار فيه (الاستعارة) أسلوب إدارة، و(الانتحال) وسيلة للتنظيم، والسطو على الأسماء أقصر طريق لرفع مستوى حدثٍ بائس لا يجد ما يقدمه سوى الظلال. لكن الأكثر غرابة أن تفاجأ بعد انتهاء الملتقى بأن اسمك كان في أجندة اليوم الأول، وأن الحضور كانوا ينتظرونك! يتصل البعض مستفسرًا “ليش ما التزمتِ بالحضور؟ كنا نبي نسمع قصة نجاحج ؟ وها أنا أمام مشهدٍ عبثي: ملتقيات تنشر اسمك دون إذن، ثم تُحمّلك مسؤولية الغياب! أي عبث هذا الذي يحوّل غياب الدعوة إلى (تقصير شخصي) ويجعل من الضحية موضع تساؤل؟ إنه ليس مجرد سوء تنظيم، بل تشويه للسمعة تحت غطاء الاحتفاء. ما حدث ليس خطأ بروتوكوليًا عابرًا، بل فوضى مهنية تُمارس بلباقة شكلية، خلفها عقل تنظيمي يعتقد أن وضع اسم معروف على غلاف الملتقى يكفي لتلميعه. هذه ليست شراكة، بل قرصنة ناعمة على الرصيد المهني للآخرين. هل يعقل أن يصبح اسم المتحدث جزءًا من الديكور الإعلامي؟ يوضع إلى جانب الشعار والموسيقى الافتتاحية؟! وكأن الحضور مجرد ديكور شرفي لحدثٍ لا يعرف معنى التنظيم، ولا يفرّق بين التكريم والاستغلال. الغريب أن هذه الجهات نفسها تتحدث في بياناتها عن تمكين الكفاءات، والتميز المهني والقيم المؤسسية، بينما تفشل في أبسط مظاهر الاحترافية: التواصل الرسمي والدعوة الصريحة. كيف نثق بملتقى لا يعرف كيف يرسل دعوة؟ كيف نقنع الجيل الجديد أن النزاهة هي أساس العمل، وهم يرون بعض المؤسسات تقتبس النجاحات وتلصقها بلا خجل؟ المؤتمرات لا تُقاس بعدد الأسماء اللامعة في جدولها، بل بصدق الفكرة، ودقة التنظيم، واحترام العقول. فالمشكلة ليست في الحدث نفسه، بل في العقلية التسويقية التي تعتقد أن النجاح يمكن استعارته مثل صورة من الإنترنت. كلمة “ملتقى” يجب أن تعني التقاء الفكر لا التقاء الشعارات. والتنظيم لا يعني تكديس فقرات وكلمات وتصفيقات، بل إدارة واعية تعرف متى تدعو، ومتى تعتذر، ومتى تصمت. رسالتي إليهم: إذا كنتم تبحثون عن الحضور الإعلامي، فابنوه بأنفسكم. لا تستوردوا قصص نجاح الآخرين لتلميع فعالياتكم. فالنجاح لا يُستعار، ولا يُستنسخ، ولا يُستخدم لتغطية سوء التنظيم. وشكرًا على المشاهدة… حتى وإن لم أحضر!.
1383
| 04 نوفمبر 2025
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6819
| 27 أكتوبر 2025
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتصارع فيه المفاهيم، باتت القيم المجتمعية في كثيرٍ من المجتمعات العربية أقرب إلى «غرفة الإنعاش» منها إلى الحياة الطبيعية. القيم التي كانت نبض الأسرة، وعماد التعليم، وسقف الخطاب الإعلامي، أصبحت اليوم غائبة أو في أحسن الأحوال موجودة بلا ممارسة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يُعلن حالة الطوارئ لإنقاذ القيم قبل أن تستفحل الأزمات؟ أولاً: التشخيص: القيم تختنق بين ضجيج المظاهر وسرعة التحول: لم يعد ضعف القيم مجرد ظاهرة تربوية؛ بل أزمة مجتمعية شاملة فنحن أمام جيلٍ محاط بالإعلانات والمحتوى السريع، لكنه يفتقد النماذج التي تجسّد القيم في السلوك الواقعي. ثانياً: الأدوار المتداخلة: من المسؤول؟ إنها مسؤولية تكاملية: - وزارة التربية والتعليم: إعادة بناء المناهج والأنشطة اللاصفية على قيم العمل والانتماء والمسؤولية، وربط المعرفة بالسلوك. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: تجديد الخطاب الديني بلغة العصر وتحويل المساجد إلى منصات توعية مجتمعية. - وزارة الثقافة: تحويل الفنون والمهرجانات إلى رسائل تُنعش الوعي وتُعيد تعريف الجمال بالقيمة لا بالمظهر. - وزارة الإعلام: ضبط المحتوى المرئي والرقمي بما يرسّخ الوعي الجمعي ويقدّم نماذج حقيقية. - وزارة التنمية الاجتماعية: تمكين المجتمع المدني، ودعم المبادرات التطوعية، وترسيخ احترام التنوع الثقافي باعتباره قيمة لا تهديدًا. ثالثاً: الحلول: نحو حاضنات وطنية للقيم: إن مواجهة التراجع القيمي لا تكون بالشعارات، بل بإنشاء حاضنات للقيم الوطنية تعمل مثل حاضنات الأعمال، لكنها تستثمر في الإنسان لا في المال. هذه الحاضنات تجمع التربويين والإعلاميين والمثقفين وخبراء التنمية لتصميم برامج عملية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب تُترجم القيم إلى ممارسات يومية، وتنتج مواد تعليمية وإعلامية قابلة للتكرار والقياس. كما يمكن إطلاق مؤشر وطني للقيم يُقاس عبر استطلاعات وسلوكيات مجتمعية، لتصبح القيم جزءًا من تقييم الأداء الوطني مثل الاقتصاد والتعليم. رابعا: تكامل الوزارات:غرفة عمليات مشتركة للقيم: لا بد من إطار حوكمة ؛ • إنشاء مجلس وطني للقيم يُمثّل الوزارات والجهات الأهلية، يضع سياسة موحّدة وخطة سنوية ملزِمة. مؤشرات أداء مشتركة • تُدرج في اتفاقيات الأداء لكل وزارة • منصة بيانات موحّدة لتبادل المحتوى والنتائج تُعلن للناس لتعزيز الشفافية. • حملات وطنية متزامنة تُبث في المدارس والمساجد والمنصات الرقمية والفنون، بشعار واحد ورسائل متناسقة. • عقود شراكة مع القطاع الخاص لرعاية حاضنات القيم وبرامج القدوة، وربط الحوافز الضريبية أو التفضيلية بحجم الإسهام القيمي. الختام..... من يُعلن حالة الطوارئ؟ إنقاذ القيم لا يحتاج خطابًا جديدًا بقدر ما يحتاج إرادة جماعية وإدارة محترفة. المطلوب اليوم حاضنات قيم، ومجلس تنسيقي، ومؤشرات قياس، وتمويل مستدام. عندها فقط سننقل القيم من شعارات تُرفع إلى سلوك يُمارس، ومن دروس تُتلى إلى واقع يُعاش؛ فيحيا المجتمع، وتموت الأزمات قبل أن تولد.
6570
| 24 أكتوبر 2025
ليس الفراغ في الأماكن، بل في الأشخاص الذين لم يتقنوا الجلوس في أماكنهم. كم من مقعدٍ امتلأ جسدًا، وظلّ فارغًا فكرًا، وإحساسًا، وموقفًا. الكرسي لا يمنح الهيبة، بل من يجلس عليه هو من يمنح المكان معناه. المدرب… حين يغيب التأثير: المدرب الذي لا يملأ مقعده، هو من يكرّر المعلومات دون أن يُحدث تحولًا في العقول. يشرح بجمود، ويتحدث بثقة زائفة، ثم يغادر دون أن يترك بصمة. الحل أن يفهم أن التدريب رسالة لا مهنة، وأن حضوره يقاس بتغيير الفكر والسلوك بعده. وعندما يغيب هذا الإدراك، يتحول التدريب إلى ترفٍ ممل، ويفقد المجتمع طاقاته الواعدة التي تحتاج إلى من يشعل فيها شرارة الوعي. المدير… حين يغيب القرار: المدير الذي لا يملأ كرسيه، يهرب من المسؤولية بحجة المشورة، ويُغرق فريقه في اجتماعات لا تنتهي. الحل: أن يدرك أن القرار جزء من القيادة، وأن التردد يقتل الكفاءة. وعندما يغيب المدير الفاعل، تُصاب المؤسسة بالجمود، وتتحول بيئة العمل إلى طابور انتظار طويل بلا توجيه. القائد… حين يغيب الإلهام: القائد الذي لا يملك رؤية، لا يملك أتباعًا بل موظفين. الحل: أن يزرع في فريقه الإيمان لا الخوف، وأن يرى في كل فرد طاقة لا أداة. غياب القائد الملهم يعني غياب الاتجاه، فتضيع الجهود، ويضعف الولاء المؤسسي، ويختفي الشغف الذي يصنع التميز. المعلم… حين يغيب الوعي برسالته: المعلم الذي يجلس على كرسيه ليؤدي واجبًا، لا ليصنع إنسانًا، يفرغ التعليم من رسالته. الحل: أن يدرك أنه يربّي أجيالًا لا يلقّن دروسًا. وحين يغيب وعيه، يتخرّج طلاب يعرفون الحروف ويجهلون المعنى، فيُصاب المجتمع بسطحية الفكر وضعف الانتماء. الإعلامي… حين يغيب الضمير: الإعلامي الذي لا يملأ كرسيه بالمصداقية، يصبح أداة تضليل لا منبر وعي. الحل: أن يضع الحقيقة فوق المصلحة، وأن يدرك أن الكلمة مسؤولية. وعندما يغيب ضميره، يضيع وعي الجمهور، ويتحول الإعلام إلى سوقٍ للضجيج بدل أن يكون منارة للحق. الطبيب… حين يغيب الإحساس بالإنسان: الطبيب الذي يرى في المريض رقمًا لا روحًا، ملأ كرسيه علمًا وفرّغه إنسانية. الحل: أن يتذكر أن الطب ليس مهنة إنقاذ فقط، بل مهنة رحمة. وحين يغيب هذا البعد الإنساني، يفقد المريض الثقة، ويصبح الألم مضاعفًا، جسديًا ونفسيًا معًا. الحاكم أو القاضي… حين يغيب العدل: الحاكم أو القاضي الذي يغفل ضميره، يملأ الكرسي رهبة لا هيبة. الحل: أن يُحيي في قراراته ميزان العدالة قبل أي شيء. فحين يغيب العدل، ينهار الولاء الوطني، ويُصاب المجتمع بتآكل الثقة في مؤسساته. الزوج والزوجة… حين يغيب الوعي بالعلاقة: العلاقة التي تخلو من الإدراك والمسؤولية، هي كرسيان متقابلان لا روح بينهما. الحل: أن يفهما أن الزواج ليس عقداً اجتماعياً فحسب، بل رسالة إنسانية تبني مجتمعاً متماسكاً. وحين يغيب الوعي، يتفكك البيت، وينتج جيل لا يعرف معنى التوازن ولا الاحترام. خاتمة الكرسي ليس شرفًا، بل تكليف. وليس مكانًا يُحتل، بل مساحة تُملأ بالحكمة والإخلاص. فالمجتمعات لا تنهض بالكراسي الممتلئة بالأجساد، بل بالعقول والقلوب التي تعرف وزنها حين تجلس… وتعرف متى تنهض.
5169
| 20 أكتوبر 2025
المعرفة التي لا تدعم بالتدريب العملي تصبح عرجاء. فالتعليم يمنح الإطار، بينما التدريب يملأ هذا الإطار بالحياة والفاعلية. في الجامعات تحديدًا، ما زال كثير من الطلاب يتخرجون وهم يحملون شهادات مليئة بالمعرفة النظرية، لكنهم يفتقدون إلى الأدوات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بثقة. هنا تكمن الفجوة بين التعليم والتدريب. فبدلاً من أن يُترك الخريج يبحث عن برامج تدريبية بعد التخرج، من الأجدى أن يُغذّى التعليم الجامعي بجرعات تدريبية ممنهجة، وأن يُطرح مسار فرعي بعنوان «إعداد المدرب» ليخرّج طلابًا قادرين على التعلم وتدريب الآخرين معًا. تجارب ناجحة: - ألمانيا: اعتمدت نظام التعليم المزدوج، حيث يقضي الطالب جزءًا من وقته في الجامعة وجزءًا آخر في بيئة العمل والنتيجة سوق عمل كفؤ، ونسب بطالة في أدنى مستوياتها. - كوريا الجنوبية: فرضت التدريب الإلزامي المرتبط بالصناعة، فصار الخريج ملمًا بالنظرية والتطبيق معًا، وكانت النتيجة نهضة صناعية وتقنية عالمية. -كندا: طورت نموذج التعليم التعاوني (Co-op) الذي يدمج الطالب في بيئة العمل خلال سنوات دراسته. هذا أسهم في تخريج طلاب أصحاب خبرة عملية، ووفّر على الدولة تكاليف إعادة التأهيل بعد التخرج. انعكاسات التعليم بلا تدريب: 1. اقتصاديًا: غياب التدريب يزيد الإنفاق الحكومي على إعادة التأهيل. أما إدماج التدريب، فيسرّع اندماج الخريج في السوق ويضاعف الإنتاجية. 2. مهنيًا: الطالب المتدرب يتخرج بخبرة عملية وشبكة علاقات مهنية، ما يمنحه ثقة أكبر وفرصًا أوسع. 3. اجتماعيًا: حين يتقن الشباب المهارات العملية، تقل مستويات الإحباط، ويتحولون من باحثين عن وظيفة إلى صانعين للفرص. حلول عملية مقترحة لقطر: 1. دمج التدريب ضمن المناهج الجامعية: أن تُخصص كل جامعة قطرية 30% من الساعات الدراسية لتطبيقات عملية ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص واعتماد التدريب كمتطلب تخرج إلزامي لا يقل عن 200 ساعة. 2. إنشاء مجلس وطني للتكامل بين التعليم والتدريب: يضم وزارتي التعليم والعمل وممثلي الجامعات والقطاع الخاص، ليضع سياسات تربط بين الاحتياج الفعلي في السوق ومخرجات التعليم. 3. تفعيل مراكز تدريب جامعية داخلية: تُدار بالشراكة مع مراكز تدريب وطنية، لتوفير بيئات تدريبية تحاكي الواقع العملي. 4. تحفيز القطاع الخاص على التدريب الميداني. منح حوافز ضريبية أو أولوية في المناقصات للشركات التي توفر فرص تدريب جامعي مستدامة. الخلاصة التعليم بلا تدريب يظل معرفة ناقصة، عاجزة عن حمل الأجيال نحو المستقبل. إنّ إدماج التدريب في التعليم الجامعي، وإيجاد تخصصات فرعية في إعداد المدربين، سيضاعف قيمة التعليم ويحوّله إلى أداة لإطلاق الطاقات لا لتخزين المعلومات. فحين يتحول كل متعلم إلى مُمارس، وكل خريج إلى مدرب، سنشهد تحولًا حقيقيًا في جودة رأس المال البشري في قطر، بما يواكب رؤيتها الوطنية ويقودها نحو تنمية مستدامة.
2940
| 16 أكتوبر 2025
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
7995
| 13 أكتوبر 2025
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
9222
| 09 أكتوبر 2025
كثير من المراكز التدريبية اليوم وجدت سلعة سهلة الترويج، برنامج إعداد المدربين، يطرحونه كأنه عصا سحرية، يَعِدون المشترك بأنه بعد خمسة أيام أو أسبوع من «الدروس» سيخرج مدربًا متمكنًا، يقف على المنصة، ويُدير القاعة، ويعالج كل التحديات، كأن التدريب مجرد شهادة تُعلق على الجدار، أو بطاقة مرور سريعة إلى عالم لم يعرفه الطالب بعد. المشكلة ليست في البرنامج بحد ذاته، بل في الوهم المعبأ معه. يتم تسويقه للمشتركين على أنه بوابة النجومية في التدريب، بينما في الواقع هو مجرد خطوة أولى في طريق طويل. ليس أكثر من مدخل نظري يضع أساسيات عامة: كيف تُصمم عرضًا؟ كيف ترتب محتوى؟ كيف تُعرّف التدريب؟. لكنه لا يمنح المتدرب أدوات مواجهة التحديات المعقدة في القاعة، ولا يصنع له كاريزما، ولا يضع بين يديه لغة جسد قوية، ولا يمنحه مهارة السيطرة على المواقف. ومع ذلك، يتم بيعه تحت ستار «إعداد المدربين» وكأن من أنهى البرنامج صار فجأة خبيرًا يقود الحشود. تجارب دولية متعمقة في دول نجحت في بناء مدربين حقيقيين، نرى الصورة مختلفة تمامًا: • بريطانيا: لدى «معهد التعلم والأداء» (CIPD) برامج طويلة المدى، لا تُمنح فيها شهادة «مدرب محترف» إلا بعد إنجاز مشاريع تدريبية عملية وتقييم صارم من لجنة مختصة. • الولايات المتحدة: تقدم «جمعية تطوير المواهب – ATD» مسارات متعددة، تبدأ بالمعارف، ثم ورش تطبيقية، تليها اختبارات عملية، ولا يُعتمد المدرب إلا بعد أن يُثبت قدرته في جلسات تدريب واقعية. • فنلندا: يمر المدرب ببرنامج يمتد لأشهر، يتضمن محاكاة واقعية، مراقبة في الصفوف، ثم تقييما شاملا لمهارات العرض، إدارة النقاش، والقدرة على حل المشكلات. هذه التجارب تثبت أن إعداد المدرب يتم عبر برامج متعمقة، اجتيازات، وتدرّج عملي. المجتمع يجب أن يعي الحقيقة: الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن TOT ليس نقطة الانطلاق، بل الخطوة المعرفية الأولى فقط. المدرب الحقيقي لا يُصنع في أسبوع، بل يُبنى عبر برامج تخصصية أعمق مثل «اختصاصي تدريب»، التي تغوص في تفاصيل لغة الجسد، السيطرة على الحضور، مواجهة المواقف الحرجة، وبناء الكاريزما. هذه هي المراحل التي تُشكل شخصية المدرب، لا مجرد ورقة مكتوب عليها «مدرب معتمد». لكي نحمي المجتمع من أوهام «الشهادات الورقية»، يجب أن يُعتمد مبدأ الاختبار قبل الدخول، بحيث لا يُقبل أي شخص في برنامج إعداد مدربين إلا بعد اجتياز اختبار قبلي يقيس مهاراته الأساسية في التواصل والعرض. ثم، بعد انتهاء البرنامج، يجب أن يخضع المتدرب لاختبار عملي أمام لجنة تقييم مستقلة، ليُثبت أنه قادر على التدريب لا على الحفظ. الشهادة يجب أن تكون شهادة اجتياز، لا مجرد «شهادة حضور». هل يُعقل أن يتحول من حضر خمسة أيام إلى «قائد قاعة»؟ هل يكفي أن تحفظ شرائح عرض لتصير مدربًا؟ أين الارتباك والتجربة والخطأ؟ أين الكاريزما التي تُبنى عبر سنوات؟ أم أن المسألة مجرد صور على إنستغرام تُوهم الناس بأنهم أصبحوا «مدربين عالميين» في أسبوع؟ TOT مجرد مدخل بسيط للتدريب، فالتدريب مهنة جادة وليس عرضا استهلاكيا. المطلوب وعي مجتمعي ورقابة مؤسسية وآليات صارمة للاجتياز، فمن دون ذلك سيبقى سوق التدريب ساحة لبيع الوهم تحت عناوين براقة.
7281
| 06 أكتوبر 2025
في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة يمكن وصفها بـ «استيراد المعلّب»، حيث يتم استقدام برامج أو قوالب تدريبية جاهزة من بعض الدول الخليجية المجاورة لعرضها على وزارات أو مؤسسات في قطر، رغم وجود كفاءات محلية وجهات تدريبية قادرة على تقديم محتوى أكثر أصالة وفاعلية. الفكرة بحد ذاتها ليست إشكالية، فالتبادل المعرفي مطلوب، والتعاون الخليجي قيمة مضافة. لكن الإشكال يكمن في الاختزال: أن يكون الخيار الأول هو الحل المستورد، بينما تبقى القدرات المحلية في موقع المتفرج. أين الخلل؟ حين تأتي وفود خارجية وتعرض برامج جاهزة، غالبًا ما يتم التعامل معها باندفاع هذا المشهد قد يعطي انطباعًا مضللًا بأن ما تم تقديمه هو «ابتكار خارجي» لا يمكننا بلوغه داخليًا، بينما الحقيقة أن في قطر كفاءات بشرية ومؤسسات تدريبية تمتلك القدرة على الإبداع والتطوير. والمفارقة أن لدينا في قطر جهات رسمية مسؤولة عن التدريب وتحت مظلتها عشرات المراكز المحلية، لكن السؤال: لماذا لا تقوم هذه المظلات بدورها في حماية القطاع؟ لماذا تُترك الوزارات لتتسابق نحو البرامج المستوردة من الخارج، بل إن بعضها يُستورد دون أي اعتماد دولي حقيقي، غياب هذا الدور الرقابي والحامي يفتح الباب واسعًا أمام تهميش الكفاءات الوطنية. وتزداد الصورة حدة حين نرى المراكز التدريبية الخارجية تتسابق في نشر صورها مع المسؤولين عبر المنصات الاجتماعية، معلنةً أنها وقّعت اتفاقيات مع الوزارة الفلانية لتقديم برنامج تدريبي أو تربوي، وكأن الساحة القطرية تخلو من المفكرين التربويين أو من الكفاءات الوطنية في مجال التدريب. هذا المشهد لا يسيء فقط إلى مكانة المراكز المحلية، بل يضعف ثقة المجتمع بقدراته الذاتية. منطق الأولويات الأصل أن يكون هناك تسلسل منطقي: 1. أولًا: البحث عن الإمكانات المحلية، وإعطاء الفرصة للكوادر القطرية لتقديم حلولهم وبرامجهم. 2. ثانيًا: إن لم تتوفر الخبرة محليًا، يتم النظر إلى الاستعانة بالخبرة الخليجية أو الدولية كخيار داعم لا كبديل دائم. بهذا الترتيب نحافظ على مكانة الكفاءات الوطنية، ونعزز من ثقة المؤسسات بقدراتها، ونوجه السوق نحو الإبداع المحلي. انعكاسات «استيراد المعلّب: - اقتصادياً: الاعتماد المفرط على الخارج يستنزف الموارد المالية ويضعف من استدامة السوق المحلي للتدريب. - مهنياً: يحبط الكفاءات المحلية التي ترى نفسها مهمشة رغم جاهزيتها. - اجتماعياً: يرسخ فكرة أن النجاح لا يأتي إلا من الخارج، في حين أن بناء الثقة بالمؤسسات الوطنية هو أحد ركائز الاستقلال المجتمعي. ما الحل؟ الحل ليس في الانغلاق، بل في إعادة ضبط البوصلة: وضع آلية واضحة في الوزارات والمؤسسات تقضي بطرح أي مشروع تدريبي أولًا على المراكز المحلية. - تمكين المظلات المسؤولة عن التدريب من ممارسة دورها في حماية المراكز ومنع تجاوزها. - جعل الاستعانة بالبرامج المستوردة خيارًا تكميليًا عند الحاجة، لا قرارًا تلقائيًا. الخلاصة: «استيراد المعلّب» قد يكون مريحًا على المدى القصير، لكنه على المدى البعيد يضعف مناعة المؤسسات ويعطل القدرات الوطنية. إننا بحاجة إلى عقلية ترى في الكفاءة القطرية الخيار الأول، لا الأخير. فالطموح الحقيقي ليس في أن نستحسن ما يأتي من الخارج ونستعجل نشر صورته، بل في أن نُصدر نحن للعالم نموذجًا فريدًا ينبع من بيئتنا، ويعكس قدرتنا على بناء المستقبل بأيدينا.
5067
| 02 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1818
| 21 نوفمبر 2025

عندما أقدم المشرع القطري على خطوة مفصلية بشأن...
1467
| 25 نوفمبر 2025

أصبحت قطر اليوم واحدة من أفضل الوجهات الخليجية...
1455
| 25 نوفمبر 2025

شهدت الجولات العشر الأولى من الدوري أداءً تحكيميًا...
1269
| 25 نوفمبر 2025

في مدينة نوتنغهام الإنجليزية، يقبع نصب تذكاري لرجل...
1089
| 23 نوفمبر 2025

في زمن تتسارع فيه المفاهيم وتتباين فيه مصادر...
834
| 25 نوفمبر 2025

حينما تنطلق من هذا الجسد لتحلّق في عالم...
792
| 21 نوفمبر 2025

الصداقة من خلال الرياضة.. الشعار العالمي للمجلس الدولي...
747
| 24 نوفمبر 2025

عَبِقٌ هُو الياسمين. لطالما داعب شذاه العذب روحها،...
546
| 21 نوفمبر 2025

حين ينضج الوعي؛ يخفت الجدل، لا لأنه يفقد...
510
| 23 نوفمبر 2025

* يقولون هناك مدير لا يحب تعيين المواطن...
507
| 24 نوفمبر 2025

منذ فجر الحضارات الفرعونية والرومانية وبلاد ما وراء...
468
| 24 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية