رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تلعب الأعراف دورا أساسيا في تنظيم حياة الأفراد والجماعات، لأنها مستمدة من صميم طبيعة علاقاتهم ويرتضون انتشارها بينهم لأنهم يعتبرونها جزءا من ثقافتهم وهويتهم، لدرجة أن أصبحت بعض المجتمعات تنظم حياة أفرادها عن طريق الأعراف دون الاحتكام إلى القوانين المكتوبة. ويعد مجال التجارة من أكثر المجالات التي تعرف انتشارا واسعا للأعراف، بالنظر لخصوصية المعاملات التجارية التي تفرض المرونة والدقة في سن القواعد، والتي تعرف اختلافا جوهريا عن المعاملات المدنية يقتضي بالتبعية عدم ملاءمة بعض القواعد والنصوص المكتوبة، التي إن تم الاحتكام إليها قد تعطل إتمام المعاملة أو قد تؤدي إلى نتائج مخالفة لإرادة الأطراف ولطبيعة المجال التجاري. والمقصود من العرف التجاري هو كل عادة أو سلوك تواتر التجار على اتباعه فيما يتعلق بأعمالهم التجارية مع شعورهم بإلزاميته وأن مخالفته يترتب عليها جزاء قانوني، أي أن هذه الأعراف حتى يعتد بها فيما بين التجار وجب أن تكون عادة مستمرة ومتكررة الحدوث مع انتشار فكرة وجوب إتيان هذه العادة، حتى تترسخ بين التجار وتصبح عرفا تجاريا، كما أن هذا العرف التجاري يجب ألا يكون منصوصا عليه ضمن التشريعات المكتوبة، وإلا اعتبر نصا قانونيا تجاريا وليس عرفا. وتبرز أهمية العرف التجاري ومكانته البارزة ضمن المجال التجاري لما نص على ضرورة اتباعه المشرع القطري ضمن القانون رقم 27 لسنة 2006 بشأن قانون التجارة، وذلك وفقا للمادة 2 التي ورد فيها: «تسري على المسائل التجارية الأحكام الواردة في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص يطبق العرف التجاري». وهكذا نجد المشرع قد خرج عن المألوف في القواعد التشريعية المعمول بها، إذ إنه من المستقر عليه أنه في حالة عدم وجود نص قانوني خاص يطبق النص القانوني العام، لكن قانون التجارة اعتبر أنه بالنسبة للمسائل التجارية تطبق القواعد القانونية المتعلقة بالتجارة، وفي حالة عدم وجود نص لا يطبق النص القانوني العام، بل تطبق قواعد العرف التجاري، وفي رأينا فقد أحسن المشرع صنيعا، لأن مجال التجارة له قواعده الخاصة المستمدة من المعاملات بين التجار التي أفرزت عن قواعد وأحكام مستقرة فيما بينهم، وأصبحت أعرافا تجارية ملزمة، وبالتالي يكون العرف التجاري عند غياب نص قانوني صريح أولى بالتطبيق من قواعد القانون المدني مثلا باعتباره الشريعة العامة للقوانين. وهكذا، فإن العرف التجاري يحتل المكانة الثانية بعد القواعد القانونية المكتوبة عند الفصل في المسائل التجارية، وهي مكانة بالغة الأهمية تستدعي تحري الدقة عند اعتبار عادة معينة على أنها عرف تجاري والبحث في مدى استيفائها للشروط المتطلبة من أجل ذلك، ومن قبيل الأعراف التجارية مثلا: تحديد سعر السوق لبضاعة معينة، تحديد مكان وزمان التسليم والاستلام، قابلية معاينة البضاعة والاحتفاظ بها قبل الشراء.
96
| 05 يناير 2026
إذا كان المشرع قد أعطى الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بتحقيق العدالة، فإنه نظم ذلك الحق وقيده بمجموعة من الشروط من بينها احترام قواعد الاختصاص القضائي. ويقصد بالاختصاص القضائي توزيع العمل بين المحاكم والجهات القضائية المختلفة لتحديد المحكمة المخولة بنظر الدعوى بناء على معيار نوع الدعوى أو قيمة الطلب أو موطن أطراف الخصومة. يعتبر الاستناد إلى معيار نوع الدعوى أو ما يسمى الاختصاص النوعي هو سلطة المحكمة بما لها من ولاية في نظر نوع محدد من القضايا حسب التصنيف الذي أقرته التشريعات الإجرائية، مثل اختصاص محاكم الجنايات في نظر الدعاوى المتعلقة بجرائم المخدرات والقتل، واختصاص المحاكم المدنية في الفصل في القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية، ففي هذه الحالة إذا عرضت على محكمة الجنايات قضية مدنية صرفة أقرت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا في نظر تلك الدعوى، والعكس صحيح كذلك. وبشأن الاختصاص القيمي للدعوى، فقد أقرت المواد من 22 إلى 24 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كيفية انعقاد الاختصاص للمحكمة بحسب تقدير قيمة الدعوى، وهكذا حددت المادة 22 أن الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة الطلبات فيها خمسمائة ألف ريال تنظر فيها المحكمة الابتدائية بهيئة قضائية مشكلة من قاض فرد ويشار إليها باسم «المحكمة الجزئية»، في حين أن الدعاوى التي تتجاوز قيمة الطلب فيها خمسمائة ألف ريال والدعاوى غير محددة القيمة تنظرها المحكمة الابتدائية بهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة وتسمى «المحكمة الكلية». ويثار أيضا في التشريعات المقارنة ما يصطلح عليه بـ»الاختصاص المحلي» أو الاختصاص المكاني وهو ولاية المحكمة بنظر الدعوى المعروضة عليها استنادا إلى الحيز الجغرافي للمحكمة المختصة نوعيا وقيميا، وذلك عندما تتعدد المحاكم بالمدن داخل البلد الواحد، لذلك فإن الحديث عن الاختصاص المحلي غالبا في دولة قطر ليس واردا بحكم وجود محكمة ابتدائية واحدة، لكن لو تعددت المحاكم بمدن أخرى داخل البلد كان سيتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة بالنظر إلى عنوان سكنى أطراف الدعوى أو محل موضوع الدعوى. والدفع بإعمال قواعد الاختصاص أمام المحاكم يجب إثارته من قبل أطراف الدعوى قبل أي دفع أو دفاع تحت طائلة سقوط الحق فيما يبدى منها، لأن هذا الدفع من الدفوع الشكلية الواجب تقديمها في بداية الدعوى، لكن استثناء من ذلك يحق للمحكمة أن تدفع بعدم اختصاصها لنظر الدعوى من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى نظرا لتعلق هذا الدفع بقواعد النظام العام.
444
| 29 ديسمبر 2025
يعتبر عقد الترخيص التجاري من العقود التجارية المستحدثة التي فرضتها السوق الاقتصادية الدولية، فهو عقد يبرم بين طرفين يسمى أحدهما "مانح الترخيص" والآخر "المرخص له" يسمح بمقتضاه الأول للثاني باستعمال علامته التجارية أو اسمه التجاري أو هما معا في منطقة جغرافية ومدة زمنية معينتين بشروط محددة ومقابل مادي متفق عليه. ويصطلح عليه أيضا "عقد الامتياز التجاري" أو "عقد الفرانشايز"، وشاع التعامل به بداية في الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح من عقود التوزيع الأكثر تداولا عبر العالم، لكن بالرغم من ذلك لم يتناوله المشرع القطري بالتنظيم وهو نفس التوجه الذي سارت عليه أغلب التشريعات التجارية المقارنة. ومن خلال الممارسات العملية في مجال عقد الترخيص التجاري يتبين أنه عقد يرتكز على فكرة مفادها قيام صاحب مشروع اقتصادي ناجح ومشهور بالترخيص لشخص يرغب في افتتاح مشروع اقتصادي في نفس مجال عمله بأن يستخدم العلامة التجارية المملوكة له أو اسمه أو شعاره أوغير ذلك من العلامات المميزة من أجل الاستفادة من الأرباح التي حققها المشروع الأصلي، دون الحاجة إلى البدء من الصفر وابتكار اسم وعلامة تجارية جديدة تحتمل مستقبلا النجاح أو الفشل. لكن فكرة عقد الترخيص التجاري لا تقتصر فقط على السماح باستغلال علامة نظير مقابل مادي، بل إن العقد يلقي على عاتق الطرفين التزامات أكثر عمقا تستمر طيلة مدة تنفيذ العقد، فالمرخص له يلتزم باستعمال العلامة التجارية أو الاسم بنفس الشروط والمواصفات المستخدمة من قبل مانح الترخيص وبنفس النشاط التجاري الممارس من قبله وفي بعض الأحيان يتعدى الأمر إلى الالتزام باستخدام نفس الألوان والزينة والتصميم المعماري ونفس المنتجات والطراز المستخدمين في المشروع الأصلي حفاظا على المميزات الأصلية للعلامة التجارية، وغالبا ما يتضمن العقد شرطا يسمح لمانح الترخيص بممارسة رقابة دورية على المرخص له للتأكد من مدى مطابقته للمعايير والشروط اللازمة، وفي حالة مخالفة ذلك يمكنه سحب الترخيص منه مع إمكانية المطالبة بالتعويض. وفي المقابل يكون مانح الترخيص ملزما بتقديم المعرفة العلمية للمرخص له بشأن المشروع وكيفية استعمال العلامة التجارية ومواصفات المشروع وجميع المقومات التي من شأنها السماح له بالاستغلال وفق العقد المبرم بين الطرفين. ويعد عقد الترخيص التجاري من العقود الدولية التي تبرم غالبا بين طرفين من دولتين مختلفين، ويتسم بخاصية الإذعان، لأن مانح الترخيص يكون في الغالب في مركز اقتصادي أقوى من المرخص له، وبالتالي يفرض عليه شروطا مجحفة يضطر إلى الإذعان لها من أجل إبرام العقد، كما أن مانح الترخيص لا يضمن للمرخص له نجاح المشروع أو تحقيق الأرباح عقب استخدام العلامة التجارية، بل يضمن له فقط السماح بالاستغلال وتقديم المساعدة الفنية.
141
| 15 ديسمبر 2025
تلتفت أنظار العالم باهتمام خلال الفترة الراهنة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب فيفا 2025 لكرة القدم الاحترافية، التي استعدت دولة قطر لهذا الحدث من جميع المستويات، وسخرت جميع امكانياتها لنجاح هذه البطولة سواء من حيث التجهيزات أو التدابير المختلفة، كما قدّمت دولة قطر نموذجًا متميزًا في استضافة هذه الفعاليات الرياضية، حيث سخّرت إمكاناتها اللوجستية والتنظيمية لضمان نجاح هذا الحدث على أعلى مستوى. فقد جهّزت ملاعب عالمية بتقنيات حديثة، وطوّرت البنية التحتية للنقل والمواصلات لتسهيل تنقل الجماهير والمنتخبات. كما اعتمدت قطر على أنظمة تنظيمية متقدمة في الأمن وإدارة الجماهير والخدمات الطبية، إضافةً إلى توفير متطوعين مدرّبين أسهموا في تحسين تجربة الحضور. ولم تقتصر الجهود على الجانب الرياضي فحسب، بل شملت إبراز الثقافة العربية وتعزيز روح الوحدة بين الشعوب العربيه مما جعل هذه البطولة حدثًا استثنائيًا يعكس قدرة قطر على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بكفاءة واقتدار وأيضا من خلال إصدار قوانين تنظم مجموعة من التصرفات التي ستفرضها هذه المناسبة، وأيضا قوانين تحكم تواجد بعض المؤسسات الأجنبية داخل البلاد. ولاشك أيضا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بصفته أعلى مؤسسة دولية تنظم هذه الرياضة له كامل الحق في مراقبة مدى التزام البلد المستضيف بالمعايير والشروط اللازمة لمرور بطولة كأس العرب 2025 في الأجواء المناسبة، وأن يحل بالبلد المضيف خلال سائر فترة هذه البطولة. لذلك، وتجنبا لتضارب المصالح واختلاف القوانين، كان لابد من إصدار قوانين جديده تنظم تدابير استضافة كأس العرب فيفا قطر 2025 وتم ذلك من خلال القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي أنشأ إبان كأس العالم 2022 حزمة من التدابير والتنظيمات التي تهم انجاح هذه البطولات وجميع العلاقات المتداخلة، وخصوصا حقوق الفيفا خلال تواجدها بالدولة خلال هذه الفترة. وبالرجوع للمواد من 14 إلى 26 من القانون المذكور فقد أقر المشرع للفيفا حقوق الملكية الفكرية، بحيث تكون لها طوال فترة استضافة البطولة حقوق لا يجوز تقليدها أو المساس بها من قبيل شعارها، اسمها، علاماتها المميزة، إعلاناتها، رموزها الخاصة بها، ابتكاراتها وإعلاناتها التسويقية وغير ذلك من الحقوق المرتبطة بها والتي تعود ملكيتها إليها. وتهدف هذه القوانين إلى ضمان أن تتم استضافة البطولات وفق أعلى المعايير الدولية وبما يحقق السلامة وجودة التنظيم ويعكس صورة قطر كوجهة رياضية عالمية، وأهم حقوق تتمتع بها الفيفا بدولة قطر خلال فترة البطولة الراهنة هي حقوقها التجارية، التي تخولها استخدام حقوق ملكيتها الفكرية المذكورة بسائر دولة قطر، واختيار شركائها التجاريين والراعين الرسميين لأنشطتها، واختيار طريقة التسويق والإعلان لمنتجاتها وتوزيعها، والسماح لها بإقامة أنشطة على أرض الدولة، وهو ما نراه مجسدا على أرض الواقع في مناطق مشجعي الفيفا، ومهرجان مشجعي الفيفا. كما يحق لها عرض المباريات والمواد الإعلانية عبر وسائل الاتصال والتواصل السمعية البصرية بالطريقة التدبيرية التي تناسبها، وكذلك تفرض شروطها من حيث بيع تذاكر المباريات وغيرها، وتفرض أيضا منصات بيعها، لأن لها الحق الحصري المنفرد في الاستفادة التجارية من الخدمات والمنتوجات المذكورة. ويعتبر أي مساس بتلك الحقوق خلال فترة استضافة البطولة بمثابة منافسة غير عادلة تستلزم المساءلة القانونية وفقا للقانون المعمول به داخل دولة قطر.
174
| 09 ديسمبر 2025
تعتبر مهنة المحاماة من أقدم المهن عبر التاريخ، وفي بداية ظهورها لم تكن مهنة تهدف إلى تحقيق الربح بقدر ما كانت تكليفا (لنبلاء) القوم من أجل الدفاع عن مصالح الضعفاء، إلى أن تطورت في شكلها الحالي وأصبحت قطاعا مهنيا قائما بذاته، وأساسا للمساهمة في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات. إن مزاولة المحامي لمهنته تقوم على (الأمانة والعدالة)، فهما الركيزتان الأساسيتان اللتان تمنحان هذه المهنة قيمتها الحقيقية. فالمحامي يحمل رسالة سامية تقوم على حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين وفق القانون والضمير. ومع كل قضية يتولاها، يثبت أن العدل لا يتحقق إلا بجهد نزيه وفهم دقيق وإخلاص في أداء الواجب. فالمحاماة ليست مجرد وظيفة، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب شجاعة وثباتًا في قول الحق، ويخضع تنظيم مزاولة مهنة المحاماة في قطر للقانون رقم 23 لسنة 2006 المتعلق بإصدار قانون المحاماة. وقد احتوى هذا القانون على 77 مادة موزعة على 9 فصول أحاطت بالتنظيم كل ما يتعلق بمهنة الدفاع من حيث مهام المحامين والمؤسسات التي يخضعون لرقابتها والعلاقة بينهم وبين الموكلين وشروط مزاولة مهنة المحاماة. بالرجوع إلى الفصل الأول من قانون المحاماة نجد أنه من أجل مزاولة مهنة المحاماة يشترط في الشخص أن يكون محاميا مرخصا له بالاشتغال من طرف لجنة قبول المحامين لدى وزارة العدل، وعليه من أجل الحصول على ترخيص مزاولة المحاماة يجب أن يستوفي الشخص الشروط المنصوص عليها ضمن المادة 13 من نفس القانون، وهي سبعة شروط أولها شرط الجنسية، إذ يلزم أن يكون المحامي قطري الجنسية أو مواطنا لإحدى دول مجلس التعاون، ثم شرط المؤهل العلمي أي الحصول على شهادة في القانون أو في الشريعة بالنسبة لمن سبق لهم امتهان القضاء أو النيابة العامة لأكثر من سنتين، وشرط تمام الأهلية وبلوغ سن 21 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة، ثم الحصول على شهادة بحسن السيرة والسلوك، إلى جانب شرطين أساسيين هما قضاء فترة تدريب لمدة سنتين بين مركز الدراسات القانونية والقضائية ومكتب محاماة مشتغل لمدة لا تقل عن 5 سنوات، واجتياز مقابلة شخصية واختبارات تحت إشراف لجنة قبول المحامين. إذا استوفى الشخص كل الشروط المذكورة سابقا جاز له الحصول على ترخيص من وزارة العدل بمزاولة المهنة، ويحق له عندئذ فتح مكتب محاماة باسمه. واستثناء من ذلك يجوز مزاولة المحاماة دون التقيد بالشروط سالفة الذكر بالنسبة للأجانب الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة في بلدانهم، شريطة تقييدهم على مكتب محاماة قطري مشتغل، تنحصر مهاهم عندئذ في الدفاع عن مصالح الموكلين باسم المكتب الذي يشتغلون به، ويجوز أيضا لأعضاء هيئة التدريس القطري الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون الحصول على ترخيص مزاولة المحاماة دون تقيد بتلك الشروط. وحاصل القول، إذا كان المشرع قد حدد الشروط والمعايير اللازمة في الشخص من أجل منحه ترخيصا بمزاولة مهنة المحاماة، فإن أهم الشروط تبقى رهينة بالشخص ذاته، لأنه الوحيد القادر على تحديد تواجدها من عدمه، ويمكن اختزالها في شرط الضمير النزيه الذي يخول صاحبه مزاولة المهنة بحس شفاف وصادق، وشرط القدرة على تحمل متاعب المهنة وتحدياتها.
192
| 01 ديسمبر 2025
عندما أقدم المشرع القطري على خطوة مفصلية بشأن التقاضي في مجال التجارة والاستثمارات وذلك بإصدار القانون رقم 21 لسنة 2021 المتعلق بإنشاء محكمة الاستثمار مختصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية لتبت فيها وفق إجراءات وتنظيم يتناسب مع طبيعة هذه النوعية من القضايا. وتعكس هذه الخطوة القانونية الهامة حرص المشرع القطري على تطوير المناخ التشريعي في مجال المال والأعمال، وتيسير الإجراءات في القضايا التجارية التي تتطلب في العادة سرعة البت بها مع وجود قضاة متخصصين ملمين بطبيعتها، وهذه المميزات يصعب للقضاء العادي توفيرها بالنظر لإكراهات عديدة مثل الكم الهائل للقضايا المعروضة على المحاكم وعدم وجود قضاة وكادر إداري متخصص في هذا النوع من الدعاوى. وجاء القانون الجديد مكونا من 35 مادة نظمت المقتضيات القانونية للتقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة، ويساعد على سرعة الفصل في القضايا التجارية وضمان حقوق أطراف الدعوى كما بينت لنا المادة 19 من نفس القانون، أنه يجب على المدعى عليه خلال ثلاثـين يوماً من تـاريخ إعلانه، أن يقدم رده إلكترونياً وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانـت بلغة أجنبية، من أسماء وبيانات الشهود ومضمون شهاداتهم، وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى، ويجب أن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال. وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان المدعي أو من يمثله إلكترونياً برد المدعى عليه خلال ثـلاثـة أيام ولكن المادة 20 توضح لنا أنه للمدعي أن يُعقب على ما قدّمه المدعى عليه من رد وذلك خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ إعلان المدعي برد المدعى عليه إلكترونياً. ويكون للمدعى عليه حق التعقيب على تعقيب المدعي (خلال عشرة أيام على الأكثر) من تـاريخ إعلانه إلكترونياً وبعدها يُحال ملف الدعوى إلكترونياً للدائرة المختصة في أول يوم . لانتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المواد (17)، (19)، (20) من هذا القانون، وعلى الدائرة إذا قررت إصدار حكم تمهيدي في الدعوى أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة، ليتضح لنا اهتمام المشرع بضمان تحقيق العدالة الناجزة. وتتألف هذه المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، وهيئ لها مقر مستقل ورئيس ذو خبرة في مجال الاستثمار والتجارة كما هيئ لها موازنة خاصة وهيكل إداري منظم، وسينعقد الاختصاص الولائي لها حسب المادة 7 في نزاعات محددة على سبيل الحصر تدور كلها في فلك القطاع التجاري والاستثماري. وإيمانا منه بطابع السرعة الذي تتطلبه النزاعات التجارية كما حدد هذا القانون مددا قصيرة للطعون، إذ بخلاف المدد الزمنية للطعن بالاستئناف في القضايا العادية أصبح ميعاد الاستئناف أمام هذه المحكمة (15 يوما) من تاريخ الإعلان، و7 أيام بالنسبة للمسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية، (و30 يوما بالنسبة للطعن بالتمييز). ومن أهم الميزات التي جاء بها أيضا قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ما سمته المادة 13 «النظام الإلكتروني» والذي بموجبه سيكون أي إجراء يتخذ في الدعوى يتم إلكترونيا سواء تعلق بتقييد الدعوى أو إيداع طلب أو سداد رسوم أو إعلان أو غيره، وذلك تعزيزا للرقمنة في المجال القضائي التجاري، وتحقيقا للغاية المنشودة من إحداث قضاء متخصص يستجيب لرؤية قطر المستقبلية. ونؤكد ختاما أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بالمنازعات الاستثمارية والتجارية في دولة قطر يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني منها العوامل التي جعلت دولة قطر وجهة استثمارية مميزة على مستوى المنطقة والعالم وجعلها تتمتع ببيئة تشريعية قوية متقدمة تدعم الاستثمارات وتحمي حقوق المستثمرين. وتساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتعزز من مكانتها الدولية في المجال الاقتصادي لكن هذا المولود القضائي يجب أن يستفيد من التجارب المقارنة في المحاكم التجارية بالبلدان الأخرى لتفادي الإشكالات والصعوبات التي قد تطرح مستقبلاً ليكون رمزاً للعدالة الناجزة التي تسعى إليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1845
| 25 نوفمبر 2025
من المعلوم أنه بمجرد رفع الدعوى أمام المحكمة، يكون المدعي قد وضع نطاقاً لموضوعها، وحدد الطلبات الواردة فيها، والتي لا يجوز الخروج عنها سواء من قبله أو من قبل المدعى عليه، وحتى من قبل المحكمة، إذ تكون هذه الأخيرة ملزمة بالنظر في حدود موضوع الدعوى الماثلة أمامها، وأي تجاوز لذلك يعد بمثابة مخالفة لصريح القانون. لكن ذلك لا يعني أن الأطراف غير قادرين على كسر تلك القاعدة، بل يحق للمدعي أو المدعى عليه توسيع أو تضييق نطاق موضوع الدعوى حسب ما يستجد لديهما من وقائع مرتبطة بالدعوى. هذا الحق ضمنه لهما المشرع بموجب ما يسمى بالطلب العارض، الواردة أحكامه ضمن المواد من 79 إلى 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويمكن تعريف الطلبات العارضة بأنها تلك التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه بعد تقديم الدعوى بطلباتها الأصلية يكون الغاية منها تعديل موضوع الدعوى إما من أجل تدارك طلب لم يقدم ضمن الطلب الأصلي أو مواجهة ظروف جديدة طرأت أثناء سير القضية أو طلبات أخرى مرتبطة بموضوع الدعوى. وحسب المادة 79 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن إجراءات تقديم الطلب العارض مبسطة ويكفي من أجل قبوله أي يتم رفعه أمام المحكمة خلال تداول الدعوى إما قبل الجلسة أو يوم انعقادها بواسطة طلب شفاهي يثبت في محضر الجلسة، وجرت العادة أن يتم تقديم الطلبات العارضة سواء من طرف المدعي أو المدعى عليه بواسطة مذكرة كتابية يثبت مضمونها ضمن المحضر. وجدير بالذكر أن الطلب العارض يجب أن يكون مرتبطاً بموضوع الدعوى الأساسي، إذ لا تقبل المحكمة طلباً عارضاً يختلف مع موضوع الدعوى الأصلي، ويتعلق بموضوع آخر، مثل أن يكون موضوع الدعوى المطالبة بتعويض عن المسؤولية المدنية، ثم يقدم أحد الأطراف في جلسة لاحقة طلباً عارضاً موضوعه قسمة عقار مملوك بين الطرفين على الشياع، ففي هذه الحالة موضوع الطلبين يختلف اختلافاً جوهرياً، ولا يجوز قبول الطلب العارض، بل يمكن تقديم دعوى منفصلة في موضوعه. لكن في نفس المثال إذا قدم أحد الأطراف طلباً عارضاً بإضافة خصم جديد في الدعوى أو بتعديل قيمة التعويض المطلوب، فإن الطلب العارض يكون مبنياً على أساس سليم ويجوز قبوله لأنه مرتبط بالموضوع الأصلي. وقد حددت المادة 80 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نوعية الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها، إذ يحق له طلب تعديل موضوع الدعوى أو سببها أو إكمال ما اعترى الطلب الأصلي من نقائص أو تقديم طلب الأمر بإجراء وقتي مستعجل، وغير ذلك من الطلبات التي تسمح المحكمة بتقديمها ارتباطاً بالموضوع الأصلي للدعوى. أما المدعى عليه، فيجوز له بحسب المادة 81 من نفس القانون تقديم طلبات عارضة تتعلق بالمقاصة بين الدين موضوع الدعوى ودين يدعيه أو طلب تعويض عن ضرر لحقه من موضوع الدعوى الأصلي، أو أي طلب مرتبط بالدعوى أو طلب الغاية منه عدم الحكم بطلبات خصمه، وغير ذلك من الطلبات التي تسمح المحكمة بتقديمها، بشرط أن تكون مرتبطة بالموضوع الأصلي. هذا ويجب الإشارة إلى أن تقديم الطلبات العارضة يجب أن يتم قبل إقفال باب المرافعة، بحيث لا تقبل بعد حجز الدعوى للحكم، حتى ولو كان الطلب العارض مستوفياً لجميع الشروط الموضوعية والشكلية الأخرى.
195
| 17 نوفمبر 2025
عندما يقرر أي شخص اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بحق يدعيه، يكون ملزما بتوفير الإثباتات الكافية التي تدعم موقفه وإلا كان مصير دعواه الرفض لعدم الثبوت، وتتعدد وسائل الإثبات المعمول بها أمام القضاء، وقد حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة للدعاوى ذات الطبيعة المدنية وخصص لها كتابا كاملا في المواد من 211 إلى 361، والمراد من ذلك أن يكون بين القاضي والأطراف المختصمة تشريع يبين كيفية تأييد الادعاءات والمزاعم المنتجة في الدعوى، وعدم ترك الفصل في الدعاوى رهينا بهوى كل طرف أو بالعلم الشخصي للقاضي. بالرجوع لوسائل الإثبات المعمول بها في أصول التقاضي نجد أنه يتم بواسطة الوثائق المكتوبة، وعن طريق شهادة الشهود أو استجواب الأطراف المعنية، أو إجراء خبرة فنية على موضوع الدعوى، أو وجود قرائن مثبتة للحق المتداعى فيه، أو إقرار الأطراف بذلك الحق، أو حلفهم اليمين على صحته أو عدمها. لكن الأسئلة التي قد تجول في ذهن المتقاضي بهذا الشأن، هل جميع هذه الوسائل يجب أن تتوفر قبل أن يلجأ إلى المحكمة؟ هل يمكنه إثبات حقه بأي وسيلة من هذه الوسائل؟ وفي حالة تعارض أي وسيلة إثبات مع أخرى أيهما أولى بالإعمال؟ وهل القاضي مقيد بوسيلة الإثبات التي يطرحها مقدم الطلبات؟ مبدئيا إذا توفر الخصم الذي يدعي حقا على دليل يدخل في خانة إحدى الوسائل المذكورة أعلاه يعتبر ذلك حجة على خصمه، ويكون منتجا في جدية دعواه ومطالبه، وليس بالضرورة توافر جميع تلك الوسائل في نزاع واحد، فالحالة التي يكون فيها المدعي حائزا لدليل كتابي في مواجهة خصمه يكون ذلك كافيا للقول بصحة ما يدعيه، ولا يلزمه أن يؤيد ذلك الدليل الكتابي مثلا بشهادة الشهود أو إقرار الخصم، إلا في حالات استثنائية مثل حالة إنكار الخصم لصحة ذلك المحرر، بحيث يتم اللجوء إلى إجراءات إثبات أخرى، من قبل إجراء خبرة على ذلك المحرر المكتوب أو طلب استجواب الأطراف بشأنه. والخطأ الشائع الذي يقع فيه أغلب المتقاضين عند تقديم دعوى خالية من وسيلة إثبات قوية مثل المستند الكتابي الذي يؤيد مزاعمهم، يلجؤون إلى تضمين مذكرات دعاواهم بطلبات موجهة إلى القاضي بإعمال وسيلة إثبات أخرى، مثل سماع أقوال الأطراف أو ندب خبير لإنجاز تقرير فني في الدعوى أو توجيه اليمين المتممة أو الحاسمة إلى الخصم، ويعتقدون أن المحكمة ملزمة بمسايرة وسيلة الإثبات التي تم اختيارها من قبلهم، ويتفاجؤون أن القاضي حكم في الموضوع ورفض إعمال تلك الوسيلة للإثبات، أو أنه أمر تمهيديا بإجراء وسيلة إثبات مغايرة للوسيلة التي تم التنصيص عليها في ختام طلبات دعواهم، ويعتبرون في ذلك مخالفة للقانون وسببا للطعن في حكم المحكمة. في حقيقة الأمر، القاضي ليس ملزما باتباع طلبات الأطراف فيما يتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى واستجلاء غموضها، بمعنى أن الخصم الذي لا يقدم دليلا قطعيا على صحة طلباته لا يكون القاضي ملزما بوسيلة الإثبات المقترحة من طرفه، فمثلا قد يطلب رافع الدعوى توجيه اليمين الحاسمة لخصمه في حين يرفض القاضي ذلك ويصدر أمره مثلا بندب خبير لإعداد تقرير بطبيعة العلاقة بين الأطراف وتصفية الحساب بينهما، أو قد يحكم القاضي في الموضوع مباشرة برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت إذا تبين له من أوراق القضية وحسب قناعته وطبقا للقانون أن المدعي ليس محقا في طلباته، ولا تستحق الدعوى إطالة أمدها بإجراء وسيلة إثبات غير ذات جدوى في النزاع. ولكن رغم ذلك، فإذا طلب المدعي بالحق أن يتم اللجوء إلى وسيلة من وسائل الإثبات، مثل الخبرة أو اليمين أو غيرهما يكون القاضي ملزما بالرد على طلبه حتى وإن رفض اللجوء إليه، بحيث يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن إليه رافع الدعوى بشأن الأسباب التي جعلت المحكمة ترفض الالتزام بتلك الوسيلة من أجل الإثبات، وإلا كان ذلك سببا للطعن بجميع أوجه الطعن المسموح بها قانونا، حتى الطعن بالتمييز، لأن ذلك من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز.
594
| 10 نوفمبر 2025
من الحقوق العينية التي ترد على العقارات، ويكثر التعامل بها في الزمن المعاصر الحق الذي يخوله عقد الرهن الرسمي، ويقصد به ذلك العقد الذي يبرم بين طرفين أحدهما يسمى الدائن المرتهن والآخر المدين الراهن، وبموجبه يكتسب المرتهن حقا على عقار يخصص للوفاء بدين لفائدته في ذمة المدين الراهن، ويعتبر الرهن الرسمي بالنظر إليه من زاوية الحقوق العينية حقا عينيا تبعيا وليس أصليا، بمعنى أنه ليس كحق الملكية قائما بذاته ويرد على العقار دون حق آخر، بل إن الرهن الرسمي حق عيني تبعي يستند في وجوده إلى حق شخصي مرتبط به، بمعنى أن اكتساب الشخص لحق الرهن الرسمي على عقار يمتلكه شخص آخر بالضرورة أن يكون نتيجة حق شخصي بينهما سابق لذلك الرهن، مثل قرض سابق أو مديونية أو غير ذلك. وقد نظم القانون القطري أحكام عقد الرهن الرسمي ضمن المواد من 1058 إلى 1127 من القانون المدني، معتبرا إياه بمثابة تأمين عيني يرد على العقار ضمانا للوفاء بحق معين، وأفرد أحكاما خاصة بكيفية إنشاء هذا العقد والآثار القانونية المترتبة وكيفية انقضائه، وأقر في المادة 1059 من نفس القانون شكلية انعقاده، بحيث ألزم الأطراف بشكلية الكتابة بواسطة ورقة رسمية حسب ما يقرره القانون، وبالتالي فإن الرهن الرسمي لا ينعقد ويعتبر باطلا إذا لم يرد مكتوبا ضمن ورقة رسمية وفق ما يتطلبه القانون. إن الدائن المرتهن يكون دائما مستحقا لدين ثابت في ذمة الطرف الثاني، وضمانا لسداد ذلك الدين يحصل على رهن رسمي بعقار يملكه المدين أو كفيله، يكون له حق استخلاص دينه من ذلك العقار في حالة عدم الوفاء به ضمن المواعيد والشروط المحددة، حيث تترتب للدائن المرتهن بموجبه حقوق ممتازة على ذلك العقار، إذ إن دينه يكون الأولى بالاستيفاء عند بيع ذلك العقار ويقدم على باقي أنواع الديون الأخرى، ويسمى في هذه الحالة حق التقدم، كما أن انتقال العقار من حائز لآخر لا يمنع الدائن المرتهن من التنفيذ على العقار المرهون إذ حل أجل الوفاء بالدين، وذلك ما يخوله حقا يسمى حق التتبع. والمدين الراهن قد يكون دائنا للطرف الآخر ويمتلك عقارا، فيبرم معه عقد رهن رسمي على ذلك العقار ضمانا للوفاء بالدين في مواعيده، وإن خالف شروط الوفاء بالدين جاز للدائن المرتهن التصرف في العقار من أجل استيفاء حقه، وقد يكون المدين الراهن ليس دائنا للطرف الآخر، إنما مجرد كفيل لشخص مدين للدائن المرتهن، فيقدم هذا الكفيل عقارا يمتلكه بمثابة تأمين للوفاء بذلك الدين فيصبح مدينا راهنا في هذه الحالة. بموجب عقد الرهن الرسمي لا يحوز الدائن المرتهن العقار ولا يجوز له التصرف فيه طالما أن ميعاد الوفاء بالدين الناتج عن الحق الشخصي لم يحل بعد، بحيث تظل طيلة تلك الفترة حيازة العقار لدى المدين الراهن، ويتصرف فيه تصرف الرجل العادي المحتاط، ويحق له الحصول على كل ما يجنيه ذلك العقار من محصول أو إنتاج أو غيره، وفي نفس الوقت يكون ملزما بالمحافظة عليه وعدم الإهمال أو التقصير، بحيث يمكن للدائن المرتهن أن يحمله المسؤولية عن أي تقصير أو إهمال. ينقضي عقد الرهن الرسمي عند انقضاء الدين الذي أبرم العقد من أجله، مثل قيام المدين الراهن بسداد ما بذمته من دين للدائن المرتهن، عندئذ ينقضي الرهن الرسمي ويتم تطهير العقار، بعودته في ملكية الراهن دون أن يكون مثقلا بالرهن. كما ينقضي كذلك عند حلول ميعاد سداد الدين وعدم استيفاء المرتهن لحقه، بحيث يستوفي المرتهن حقه بقيمة دينه من ثمن بيع العقار المرهون عن طريق المزاد العلني.
309
| 03 نوفمبر 2025
يُعرف عقد الهبة بأنه اتفاق يبرم بين طرفين، أحدهما الواهب والآخر هو الموهوب له، على أن يتم تمليك الأخير مالاً أو حقاً مالياً بدون عوض حال حياة الأول، من خلال هذا التعريف يتبين أن عقد الهبة هو تصرف يجريه الشخص على مال يملكه، وينقل ملكيته لشخص آخر على وجه التبرع وبدون مقابل مادي يتناسب مع قيمة المال الموهوب، وعقد الهبة من التصرفات التي ارتبطت بالإنسان منذ التاريخ وأقرته مختلف التشريعات المقارنة، ونظم أحكامه المشرع القطري ضمن المواد من 492 إلى 512 من القانون المدني. ويشترط في عقد الهبة لصحة نفاذه كباقي العقود، استيفاء الأركان القانونية اللازمة من الأهلية والمحل والسبب، ويفرض على طرفيه التزامات وحقوقا متبادلة، لكن التزامات الواهب هي المؤثرة في صحة نفاذ عقد الهبة، لأن الموهوب له في الأصل، غير ملزم بتنفيذ أي التزام مترتب عن هبة المال لفائدته. وعليه يكون الواهب ملزما عند إبرام عقد الهبة أن يكون مالكاً للشيء الموهوب، لأنه لا يجوز التصرف بالهبة في مال مملوك للغير، إلا إذا أقره المالك الحقيقي، كما يلتزم الواهب أيضا بتسليم المال الموهوب للموهوب له، فلا يكفي مجرد إبرام عقد بذلك، بل يفترض وفاء الواهب بالتزامه عند التنفيذ العيني أي بالتسليم الفعلي للمال موضوع الهبة. وإذا كان الأصل أن الهبة من العقود الملزمة لجانب واحد هو الواهب، ولا يرتب ثمة التزامات على عاتق الموهوب له، فإنه استثناء قد يشترط الواهب من أجل نفاذ عقد الهبة تنفيذ الموهوب عملاً معيناً، أو تقديم مقابل لا يصل لدرجة التناسب مع الشيء الموهوب، مثل أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يقيم بشخصه في العقار موضوع الهبة طوال حياته، ففي هذه الحالة إذا انتقل الموهوب له للعيش في مكان آخر غير العقار الموهوب اعتبر مخلا بالتزاماته في العقد، وجاز للطرف الآخر الرجوع في الهبة. ومن أجل استقرار المعاملات، وحماية حقوق الموهوب له من تراجع الواهب في قراره دون مبرر، منع القانون الرجوع في الهبة كمبدأ أصلي ترد عليه بعض الاستثناءات، ومن أوجه الاستثناء التي تجيز للواهب الرجوع في الهبة أن يكون الموهوب له ابن أو بنت الواهب، ما عدا إذا كان ذلك الابن أو البنت يتامى الأب في حال كانت الواهبة هي الأم، ويجوز أيضاً الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له بذلك. وأيضا يجوز للواهب الرجوع في هبته إذا كان لديه عذر مقبول، ويتم ذلك عن طريق تقديم دعوى قضائية للمطالبة باسترجاع المال الموهوب مع بيان العذر الاستثنائي المبرر لطلبه، مثل أن يصبح واهبا دون مسكن يؤويه والموهوب له ميسور قادر على توفير سكن آخر، ففي هذه الحالة يحق للواهب طلب الرجوع في الهبة لوجود عذر منطقي مقبول. هذا وإنه لا يجوز الرجوع في الهبة بين الزوجين حال قيام العلاقة الزوجية، ولا بعد وفاة الواهب أو الموهوب له، وإذا هلك المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له بالبيع مثلا، كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تمت على وجه التبرع الخيري.
267
| 27 أكتوبر 2025
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ويقول أيضا: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). ويستدل من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوصى الأزواج بتمكين زوجاتهم من المهر أو الصداق، الذي يعتبر مالا يقدم من الرجل إلى المرأة تعبيرا عن الرغبة في الزواج منها، وهو ليس له حد أدنى أو أقصى، يشترط فقط أن يكون مما يجوز التعامل به شرعا. وقد سار قانون الأسرة القطري في نفس النهج بشأن تنظيم أحكام المهر، إذ بالرجوع إلى القانون المذكور نجده قد جعل المهر حقا للزوجة وواجبا على الزوج، يكون مستحقا لها حسب الاتفاق بين الطرفين، ويجوز تعجيله أو تأجيله إما كله أو جزء منه. وتتسلمه الزوجة بنفسها، ولها أن تتصرف فيه وفق ما تبتغي دون إلزامها بوجه صرف معين. والمهر يجب أن يكون معينا بالذات، ومنصوصا عليه كتابة ضمن وثيقة الزواج، ويجب أيضا التنصيص على مقدار المعجل منه والمؤخر، وبيان استلام الزوجة له من عدمه، وذلك حماية لحق الزوجة في الاستفادة من مهرها، وتحسبا لأي نزاع محتمل بين الطرفين بشأنه. أما في حالة نشوب نزاع بين الزوجين بشأن قبض المهر أو قيمته أو مدى أحقية الزوجة في الاحتفاظ به، فقط تطرق قانون الأسرة لذلك وفصل في أحكام منازعات المهر ضمن المواد من 37 إلى 41 منه. وهكذا، إذا تم الاختلاف في تحديد مقداره، وجب على الزوجة أن تقدم إثباتا لذلك وإلا تقضي المحكمة بمقداره حسب أقوال الزوج بعد حلفه اليمين، إلا إذا صرح بمهر لا يصلح الالتزام به، ففي تلك الحالة يحكم القاضي للزوجة بمهر المثل أي المهر المحدد حسب الأعراف والتقاليد المعمول بها في مجتمع الزوجين. وإذا نشب نزاع بشأن المقدار المقبوض وغير المقبوض من طرف الزوجة، وذلك بأن يدعي الزوج أنه مهر وتدعي الزوجة أنه هدية أو وديعة حينها تقضي المحكمة لفائدة من يقدم إثباتا على صحة ادعائه، وإذا عجز الطرفان معا عن الإثبات تقضي المحكمة وفقا للأعراف السائدة، أي إذا كان الشيء المتنازع فيه متعارفا على أنه مهر اعتبرته المحكمة كذلك، وإذا كان من الأشياء المتعارف عليها في المجتمع على أنها تقدم هدية وليس مهرا حكمت المحكمة لصالح الزوجة، أما إذا لم يسعف العرف في إثبات المهر وكانت الزوجة تدعي أنه هدية والزوج يعتبره مهرا قضت له المحكمة بقوله بعد حلفه اليمين القانونية. أما إذا وقع الطلاق بين الطرفين بعد الدخول بالزوجة، أو حدوث الخلوة الشرعية الصحيحة استحقت الزوجة كامل مهرها معجله ومؤخره، في حين إذا وقع الطلاق قبل الدخول ودون وقوع الخلوة الشرعية تستحق نصفه فقط حسب المادة 39 من قانون الأسرة.
675
| 20 أكتوبر 2025
تتطلب إجراءات التحقيق في بعض الجرائم بقاء المتهم رهن إشارة العدالة، وذلك إما لكون المشتبه فيه ليست لديه ضمانات كافية للمثول أمام جهات التحقيق، وإما لكون الجريمة من الخطورة بمكان يصعب ترك المتهم فيها طليقا، لأن من شأن ذلك التأثير سلبا في سير مجريات التحقيق. ولأجل ذلك أقر قانون الإجراءات الجنائية تدبيرا احتياطيا يتم اللجوء إليه في هذه الحالات يسمى بالحبس الاحتياطي. والحبس الاحتياطي ليس إجراء يأمر به عضو النيابة العامة المكلف بالتحقيق في القضية أو أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة حسب الحالات، يهدف إلى تقييد حرية المتهم عن طريق إيداعه خلال فترة التحقيق في الجريمة داخل مكان مخصص للحبس، وذلك بسبب وجود أدلة قوية على نسبة الجريمة إليه أو لعدم توافر ضمانات كافية يتأكد معها تعاونه مع التحقيقات المجراة أو عدم هروبه إذا تم التحقيق معه في حالة سراح، وعند تحقق الحالتين معا، أي عدم وجود ضمانات كافية للمثول أمام العدالة وتوافر أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم. وبمطالعة قانون الإجراءات الجنائية فقد ورد تنظيم قواعد الأمر بالحبس الاحتياطي ضمن المواد من 110 إلى 118 ومن 157 إلى 161، وأحاطت بالتنظيم كل ما يتعلق بالحبس الاحتياطي من شروطه، مدده القانونية، الجهات المخولة بإصداره، طرق الطعن فيه وغير ذلك من القواعد. ولكي يتم الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات اشترط القانون أن يتم استجواب المتهم والتأكد من توافر قرائن كافية تدينه في الجريمة المشتبه ارتكابه إياها، كما يجب التأكد من أن المتهم لن يتعاون مع العدالة، وهنالك احتمالية واضحة لهروبه، كما يشترط أيضا أن تكون الجريمة موضوع التحقيق جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية تزيد على ستة أشهر حبسا. ويتم إصدار الأمر عند تحقق الشرطين من قبل عضو النيابة العامة المكلف بإيداع المتهم رهن الحبس الاحتياطي مدة أربعة أيام يجوز تمديدها لنفس المدة أي بإجمالي ثمانية أيام قيد الحبس الاحتياطي، باستثناء جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام التي يجوز أن تصل فترة الحبس الاحتياطي فيها إلى مدة أقصاها ستة عشر يوما، وفي جميع الأحوال يلزم إخطار المتهم المحبوس احتياطيا بطبيعة الإجراء المتخذ في حقه وأسباب حبسه والتهمة المسندة إليه، مع إخطاره بحقه في الاتصال بأحد معارفه والاستعانة بمحام. وإذا تطلبت إجراءات التحقيق استمرار المتهم رهن الحبس الاحتياطي، يجوز تمديد المدة المذكورة أعلاه من خلال عرض الموضوع على قاضي الحبس الاحتياطي بالمحكمة الابتدائية من طرف عضو النيابة العامة المكلف، وعقب البت في الموضوع يحكم القاضي إما برفض تجديد الحبس الاحتياطي مع الإفراج المؤقت بضمانة أو دون ضمانة حسب الأحوال، أو يقضي بحبس المتهم احتياطيا لمدة أقصاها ثلاثون يوما يمكن تجديدها لمدد أخرى، على ألا يتجاوز سقف مدد الحبس الاحتياطي في جميع الأحوال ستة أشهر، مع مراعاة إلزامية الإفراج عن المتهم إذا قضى في محبسه مدة تعادل نصف مدة العقوبة المقررة للجريمة موضوع التحقيق، بمعنى إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة موضوع الحبس الاحتياطي ثمانية أشهر كحد أقصى فإن فترة الحبس الاحتياطي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر. هذا وإن الحكم القضائي الصادر بتجديد الحبس الاحتياطي ليس نهائيا بل يجوز للمتهم أو دفاعه الطعن فيه بالاستئناف وذلك في ظرف 24 ساعة من صدوره، عن طريق إيداع تقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة، ويتم نظر الطعن المقدم خلال جلسة أمام هيئة استئنافية خلال ميعاد لا يتجاوز المقرر ثلاثة أيام من تاريخ الطعن بالاستئناف، ويكون الحكم الصادر عن الهيئة الاستئنافية إما بإلغاء الحكم القاضي بالحبس الاحتياطي مع الإفراج المؤقت عن المؤقت، وإما يكون بتأييد حكم محكمة أول درجة.
822
| 13 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية

غدًا، لن نخوض مجرد مباراة في دور الـ16...
1632
| 04 يناير 2026

كنت أقف عند إشارة المرور حين فُتح شباك...
807
| 31 ديسمبر 2025

لا شكّ أن الجهود المبذولة لإبراز الوجه الحضاري...
717
| 04 يناير 2026

يشتعل العالم، يُسفك الدم، يطحن الفقر الملايين، والحروب...
645
| 05 يناير 2026

عندما نزلت جيوش الروم في اليرموك وأرسل الصحابة...
540
| 04 يناير 2026

لا تمثّل نهاية العام مجرد انتقال زمني، بل...
510
| 31 ديسمبر 2025

في بيئة العمل، لا شيء يُبنى بالكلمة بقدر...
501
| 01 يناير 2026

الطفل العنيد سلوكه ليس الاستثناء، بل هو الروتين...
486
| 02 يناير 2026

كما هو حال العالم العربي، شهدت تركيا هي...
441
| 05 يناير 2026

مغالطات وتجاوزات تخالف عقيدتنا، وتزدري هويتنا، تحولت إلى...
432
| 01 يناير 2026
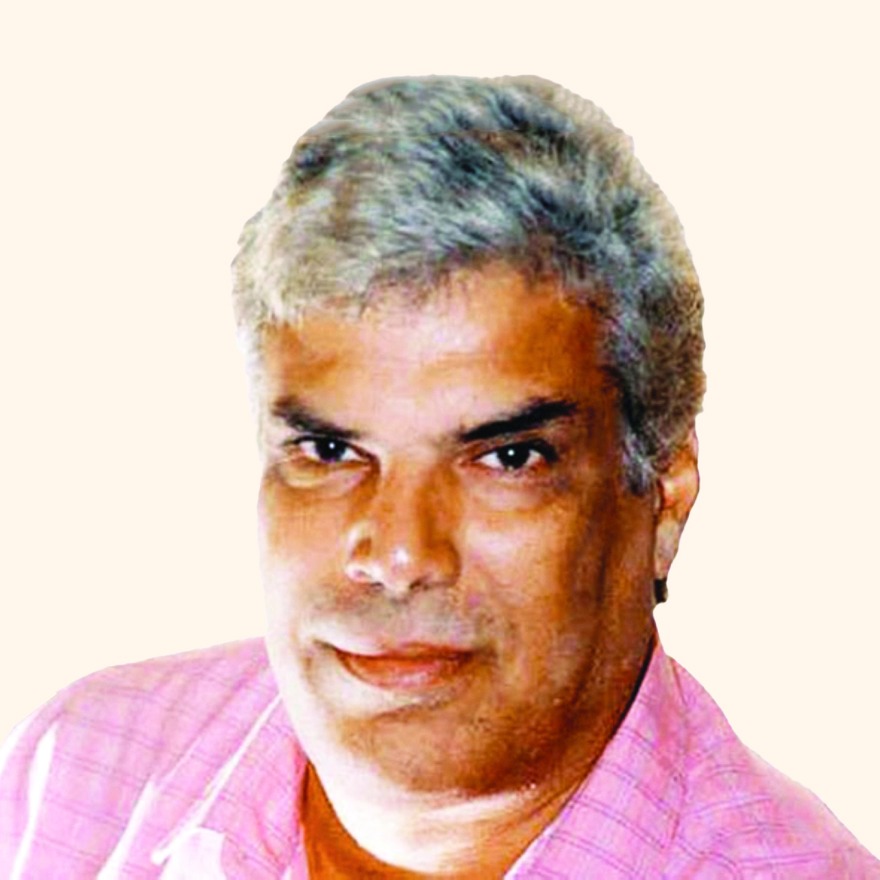
مهما غبت عن غزة وما يحدث فيها كتابة،...
420
| 01 يناير 2026

بعودة مجلة الدوحة، التي تصدرها وزارة الثقافة، إلى...
420
| 06 يناير 2026
مساحة إعلانية







