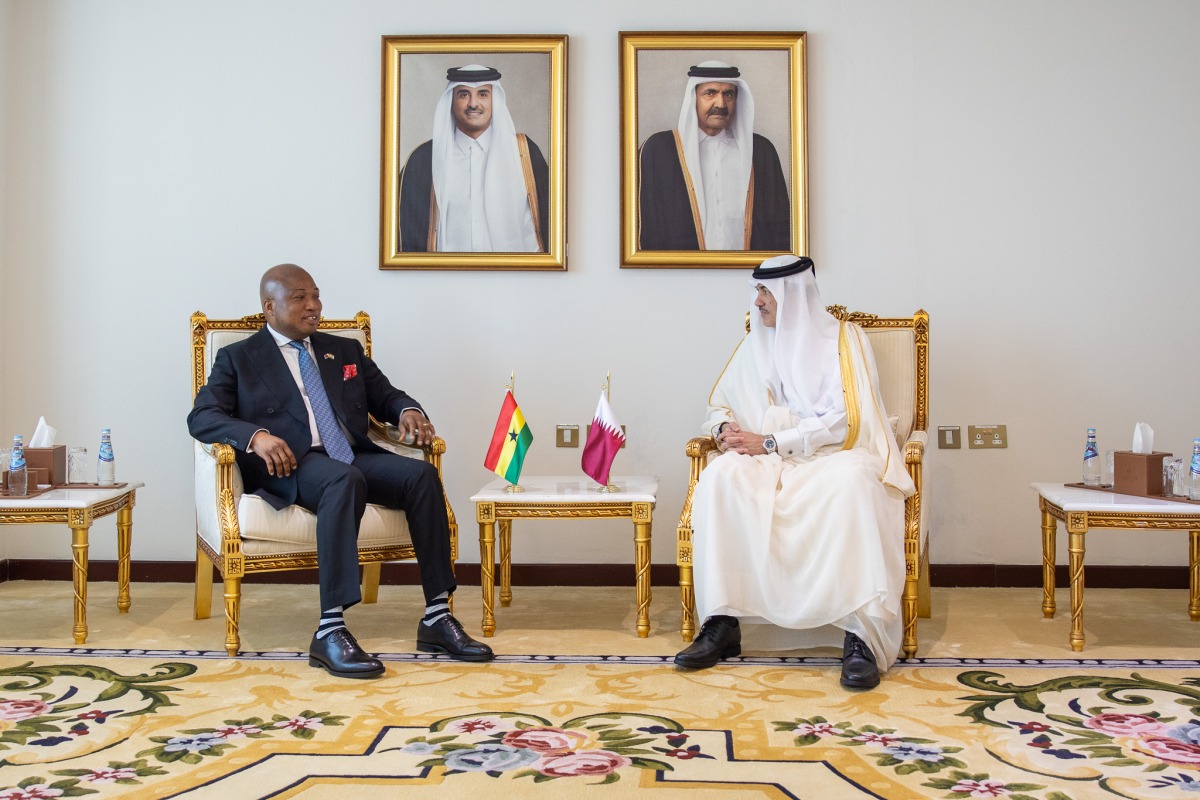رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حديث كثيف وجهير يمور هذه الأيام على خشبة المسرح السياسي السوداني، ودعوات تترا لعقد مصالحة سياسية بين حكام اليوم وحكام الأمس، أو ما يطلق عليهم «الإسلاميون»، وقد لا يكون التعبير دقيقاً؛ إذ إن ما يعرف بالإسلاميين ليسوا هم حزب الرئيس البشير الذي كان حاكماً قبل الإطاحة به في ثورة شعبية، فهم طيف واسع متعدد بل إن جزءاً مقدراً منهم كان فاعلاً ضمن القوى الثورية التي هبت في أبريل 2019، بعض الأوساط الإعلامية والسياسية تحدثت عن جولات سرية من المحادثات تجري لأجل عقد مصالحة بين السلطة الانتقالية الحالية ورموز وقيادات النظام السابق ممن هم في الصف الثاني وما قبله. والهدف المعلن هو الوصول إلى صيغة وربما تسوية سياسية، تضمن مشاركة الصف الثاني في العملية السياسية في مقابل وقف المعارضة الشرسة والتصعيد تجاه الحكومة الانتقالية المترنحة، ومن ثمّ الوصول في نهاية المطاف إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة تضمن استقرار البلاد، وتأتي مصالحة الإسلاميين في سياق مشهد سياسي جديد بتوقيع عدد من الحركات المسلحة لاتفاق سلام أفضى إلى تعديل الوثيقة الدستورية - الدستور المؤقت - الذي يحكم الفترة الانتقالية. ويبدو أن هذا المشهد السياسي الجديد مُهيئٌ لتوسيع وعاء الشراكة في إدارة المرحلة الانتقالية التي مددت وفقا للتعديلات الدستورية، فقد يصل الأمر إلى مصالحة تشمل الإسلاميين المحسوبين على نظام البشير السابق. وهناك ثمة دواع منطقية تدفع من يتبنون ويروجون للمصالحة مع الإسلاميين؛ فالبلاد دخلت في نفق مظلم لا تكاد ترى في نهايته بصيص ضوء، فالاقتصاد المنهار والضيق المعيشي والتدهور الذي اعترى كل مناحي الحياة، فضلاً عن تآكل النسيج الاجتماعي وضعف الأحزاب والقوى السياسية وارتباكها، كل ذلك جعل المقارنة بين العهدين وسط عامة الشعب تميل لصالح كفة النظام الذي أقامه الإسلاميون لمدة 3 عقود برئاسة البشير. وهناك من يرى أنه طالما قَبل تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التحالف مع اللجنة الأمنية للنظام السابق، والتي نفذت عزل البشير استجابة للضغوط الشعبية، فما الذي يمنع القبول بـمشاركة أي جهة سياسية حتى لو كانت الإسلاميين أنفسهم، كما أن معظم ذات القوى التي تشكل تحالف قوى الحرية والتغيير كانت متحالفة مع زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، باسم تحالف «قوى الإجماع الوطني»، مكون من 17 حزباً إذ ضم أحزاباً يسارية وليبرالية لمناهضة حكم البشير. ومع كون أن المصالحة مع الإسلاميين ينظر لها كطوق نجاة للسلطة الانتقالية الحالية، التي بدأ التراشق بين مكونيها المدني والعسكري يطفو للسطح، إلا أن هناك عدم اتفاق بين الحاكمين حول هذه المصالحة من حيث المبدأ، وما يثير الدهشة أن الحركات المسلحة التي كانت تقاتل النظام السابق تبدو هي الأكثر حماساً لعقد هذه المصالحة، بينما ما زالت بعض الأحزاب السياسية غارقة في ترديد الشعارات والخطب الديماغوجية، دون أن يكون لها مشروع متكامل للحكم والإصلاح حتى بعد وصولها إلى سدة الحكم. ويقول رئيس الحركة الشعبية قطاع شمال: «أتينا لنضع أيدينا مع الجميع، «لأن هدفنا هو بناء الدولة السودانية، ويشمل ذلك حتى الإسلاميين»، مردفا: «هنالك إسلاميون معتدلون ولديهم رؤية للدولة السودانية»، بينما قال نائبه من قبل إنه «لا أحد يستطيع اجتثاث الإسلاميين، ودعاهم إلى مراجعة برنامجهم ومشروعهم القديم»، أما رئيس حركة العدل والمساواة الدارفورية فقد دعا إلى تحقيق وفاق وطني شامل طالب بنبذ الصراع الأيديولوجي بين الإسلاميين والشيوعيين. وبدا الحزب الشيوعي أعلى الأحزاب الرافضة صوتاً، وقال على لسان أحد قيادييه إن الحديث عن المصالحة مع الإسلاميين يخصم كثيراً من رصيد الحكومة الحالية، وإن أي شخص يتحدث عنها يضع نفسه في خانة العداء للشعب السوداني على حد تعبيره، بل اعتبر شيوعي آخر أن الأجندة التي تسعى إلى جعل الإسلاميين جزءاً من الحكم الانتقالي هي مشروع أمريكي يطلق لتحقيق (الهبوط الناعم) للإسلاميين، بيد أن حزب الأمة القومي تحدث عن مصالحة وطنية يحدث من خلالها إصلاح سياسي وصولا إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكم، ولو بتحقيق الحد الأدنى للإجماع الوطني. ومع كل هذا الجدل بدا من الصعوبة معرفة رأي الإسلاميين أنفسهم، فلا يعلم ما هو رأيهم بل يبدو أن الغموض سيد الموقف، وهناك بعض الأصوات تشير إلى زهدهم في أن يكونوا جزءاً من الحكم الانتقالي المحفوف بالإخفاقات وعدم الاستقرار، ويبدو أن أفضل الخيارات لمستقبلهم السياسي أن يحتفظوا برصيد إنجازاتهم لاستخدامه وقوداً في معركة انتخابية ينتظرونها عقب الفترة الانتقالية. في ظل حكم البشير خاصة العقد الأخير وربما منذ انقسام الإسلاميين في 1999، أخذت الحركة الإسلامية مكاناً قصياً وأضحت شلوا ممزقا يعيش على رصيف الفعل السياسي، وفي ذات الوقت دفعت ثمن إخفاقات نظام البشير، وتقول بعض النخب الإسلامية التي عارضت البشير، إن حكم الحركة الإسلامية تم اختطافه من قبل البشير معه قلة قليلة من السياسيين والعسكريين أصحاب المصلحة الشخصية، ولعله كان من أبرز ملامح فكر زعيم الإسلاميين حسن الترابي ما يسميه البعض بالمرونة الأيديولوجية والسياسية، فقد سعى إلى توسيع قاعدة الدعم للحركة عبر التخفيف من شروط العضوية وعقد التحالفات مع قوى سياسية غير إسلامية وأحيانا غير مسلمة. على العقل السياسي الحاكم في السودان أن يفسح الباب أمام التغيير والإصلاح عبر الوفاق الوطني وليكن قيام انتخابات حرة ونزيهة هدفاً للجميع، أما سياسة سد المنافذ أمام الراغبين في المشاركة السياسية السلمية، قد يدفع بهم للوقوع في شرك خيارات مدمرة.
2448
| 12 ديسمبر 2020
بدا نظر حزب المحافظين البريطاني الحاكم قصيراً، حينما وضع كل بيضه في سلة الرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب؛ فرهن مستقبل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي باتفاق تجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة على حساب اتفاق خروج آمن وسلس ومجزٍ لكل الأطراف من الاتحاد الأوروبي، لكن رياح التغيير السياسي في الولايات المتحدة وانتخاب جون بايدن بعد فوزه على ترامب، جاءت بما لا تشتهي سفن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيس حزب المحافظين الذي خطط ودبّر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً من العضوية الملتزمة والمؤثرة. فغدا سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق كما يهدد جونسون، كارثياً بسبب العواقب الاقتصادية، وجهر محافظ بنك إنجلترا بالقول وهو يؤكد أنّ التكلفة الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ستكون أكبر على المدى الطويل من الضرر الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد، ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن فشل التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، من شأنه أن يتسبب في تعطيل التجارة عبر الحدود، ويلحق الضرر بالنوايا الحسنة بين لندن وبروكسل لبناء شراكة اقتصادية مستقبلية، وساد الهلع كذلك وسط مصنعي السيارات مع اقتراب الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث لجأوا إلى مراكمة مخزونات إضافية من السيارات وقطع الغيار للتأكد من عدم تضررها من الرسوم الجمركية إذا فشلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على صفقة تجارية، حيث ستصبح أكثر تكلفة بنسبة 10% بين عشية وضحاها إذا تم فرض التعريفات بموجب نظام منظمة التجارة العالمية. وكان خيار مغادرة الاتحاد الأوروبي قد أحدث جدلاً وانقساماً كبيرين في المجتمع البريطاني، إذ صوتت كل من اسكتلندا، وإيرلندا الشمالية للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وربح مؤيدو الخروج عام 2016 بفارق ضئيل بحجة أن مغادرة الاتحاد ستعيد سيطرة بريطانيا على حدودها، بينما ظل جونسون وحزبه يعزفون على أسطوانة أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتماشى مع أحلام البريطانيين، ويؤكد حتمية الانفصال، ويرى أن مستقبل بريطانيا سيكون أفضل بعد بريكست. صحيفة الغارديان البريطانية نقلت عن الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن أنه لن يوقع أي اتفاقيات جديدة حتى تصبح الولايات المتحدة أكثر تنافسية، وهذا يعني أن آمال بريطانيا في الحصول على صفقة تجارية مبكرة مع الولايات المتحدة قد تبددت بسبب هذا التحذير الذي جهر به بايدن. وكانت لندن تقترب من صفقة تجارية مع إدارة ترامب المنتهية ولايته، وقد كان الخصم الشرس للاتحاد الأوروبي وأراد بهذا الاتفاق أن يحرج الاتحاد الأوربي ويضعف موقفه التفاوضي مع بريطانيا، بيد أن العكس حدث تماماً لبريطانيا التي اليوم أمام تحدٍ جدي للحصول اتفاق تجاري بديل بعد خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية بنهاية ديسمبر الحالي. ومعلوم أنه خلال الفترة الانتقالية، ستواصل بريطانيا الامتثال لقواعد الاتحاد، ودفع مساهمات له، كما ستبقى أغلب الأمور على حالها، فيما عدا سبعة أشياء مثل سقوط عضوية أعضاء برلمان الاتحاد من البريطانيين وعددهم 73 عضواً، إلا أنه ومع نهاية الفترة الانتقالية، تتوقف بريطانيا عن تطبيق القواعد الأوروبية ولا تعود جزءاً من السوق الموحدة. وكان جونسون وقد زادته وعود ترامب صلفاً، قد اشترط "تغيراً جوهرياً في النهج" من جانب الأوروبيين لمواصلة المفاوضات التجارية بشأن مرحلة ما بعد بريكست، وأمعن في التهديد بالخروج من الاتحاد "من دون اتفاق" شاء من شاء وأبى من أبى، وكان ذلك فقط في أكتوبر الماضي قبيل هزيمة صديقه ترامب وتبخر آماله في الحصول على ولاية رئاسية ثانية، وظل حزب المحافظين البريطاني يماطل ثمانية أشهر بعد قرار الخروج من الاتحاد بشأن الاتفاق مع شركاء الأمس بتشجيع وتحريض من ترامب، واليوم تزداد ورطة حكومة جونسون ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 تطلب تنازلات من جانب لندن للتوصل إلى اتفاق تبادل حرّ قبل العام المقبل، موعد وقف تطبيق القواعد الأوروبية في بريطانيا. وهددت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بقولها على لندن تحمل عواقب ضعف علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن "المملكة المتحدة هي من أرادت مغادرة الاتحاد الأوروبي"، وهي "بحاجة لاتفاق أكثر منا"، وقال مستاءً "نتعثر بشأن كل شيء" مع البريطانيين وليس فقط بشأن الصيد، حيث يهدد البريطانيون بمنع الصيادين من الاتحاد الأوروبي من الصيد في المياه الإقليمية البريطانية، وتدور الخلافات بين الجانبين حول ثلاثة مواضيع؛ هي حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة وطريقة حلّ الخلافات في الاتفاق المستقبلي. إن التبادل التجاري بين الطرفين؛ بريطانيا من جانب والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، كبير جداً، حيث تبلغ صادرات بريطانيا للاتحاد نحو 274 مليار جنيه استرليني، وهذا يمثل نحو 44% من صادرات بريطانيا، بينما تبلغ وارداتها من الاتحاد نحو 341 مليار جنيه استرليني أي نحو 53% من الواردات البريطانية، ويقوم هذا التبادل الضخم بصورة أساسية على الميزات التي تتمتع بها بريطانيا بسبب عضويتها في الاتحاد، ولذا تأتي أهمية اتفاق الخروج لكونه يوفر بديلاً لبريطانيا عقب خروجها النهائي. ورطة جونسون تبدو في أن الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن قطع بايدن الطريق أمام اتفاق تجاري بريطاني أمريكي غير مستعد لتقديم المزيد من التنازلات لبريطانيا، حتى لا يشجع ذلك دولاً أخرى على الانسحاب عبر الباب لتعود عبر النافذة لتحصل على نفس الميزات التجارية، وتكسب التنصل من الاستحقاقات السياسية والقانونية الأخرى، كما يهدف حزب المحافظين في بريطانيا، ويبدو أن جونسون وحزبه على موعد مع تراجع سياسي قد يفسح الطريق مستقبلاً أمام حزب العمال المعارض. [email protected]
2167
| 05 ديسمبر 2020
لعل أول ظهور لمفهوم التسويق السياسي كفن للاقناع، كان مع ظهور فلاسفة اليونان خاصة أرسطو تلميذ الفليسوف أفلاطون. فقد شكّلت كتابات كل منهما بداية متواضعة لدراسة ظاهرة "الرأي العام"، وأكد كلاهما على ضرورة وجود الحكومة الرشيدة القوية الخاضعة للقانون. فالدولة بالنسبة إليهما يجب أن تقوم على مبدأ الديمقراطية: على أن تقوم على مشاركة الشعب في السلطة وخضوعه للقانون. يقول وليم شكسبير في إحدى مسرحياته إن الرأي العام هو الجواد الذي يمتطي الحاكم صهوته. ويعتبر الرأي العام أو حـرفياً "الشارع"، قوة ذات أثر كبير في حياة الناس اليومية. فهو الذي يبني الشهرة ويهدمها. ويؤازر هيئات الخدمة العامة ويضع القوانين ويلغيها، كما هو الذي يرعى التقاليد الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية أو يتنكر لها، وينفخ في الروح المعنوية أو يُثبّطها. وفي الجزيرة العربية شكل سوق عُكاظ الشهير قديما صورةً حيةً من صور مؤسسات الرأي العام كوعاءٍ أوسع يجمعُ كل عرب الجزيرة العربية، وتذكر المصادر التاريخية أن النشاط الأدبي والسّياسي تغلّب على التجارة في ذلك السوق. وكان سوقا حددت قريش زمانه ومكانه بعد أن رأت أن الخطر يهددها من الأحباش وغيرهم. وأراد زعماؤهم جمع العرب على كلمة واحدة لأجل هذا الغرض بعد عام الفيل. وعُكاظ كان كذلك ندوة سياسيّة كبرى تقضى فيها أمور كثيرة بين القبائل: فمن أراد إعلان حربٍ على قومٍ أعلنها في هذا السوق. وفي عصرنا هذا أصبح التسويق السياسي جزءاً لا يتجزأ من الاتصال السياسي، حيث إنه عملية تشمل مفهوم التسويق في عمومه من دراسة مبدئية للسوق (الجمهور المستهدف) واختباره واستهدافه. فهو نشاط أو مجموعة أنشطة تستهدف تعظيم وتنظيم عدد المؤيدين لمرشح سياسي أو لحزب معين. ولا يبدو أن العلاقة بين الإعلام والفعاليات السّياسية والديمقراطية في حال كونها شراكة نزيهة، قابلة للانفصام بأي حال من الأحوال، بل تقوم على التكامل والتفاعل المستمر والتأثير المتبادل، مما يجعلها تشكّل فيما ما بينها مثلثاً متساوي الأضلاع والأهمية. فالإعلام جزءٌ لا يتجزأ من العملية الديمقراطية، وضمانة أساسية لقيام وحيوية النهج الديمقراطي واستمراره في المجتمع. والنظم السّياسية أو الحزبية تعتبر الوسيلة الأهم لتنظيم الجماهير وحشدها لاتخاذ مواقف محددة تجاه قضايا مجتمعية مشتركة. لكن في عصر ما بعد الحقيقة يبرز الإعلام باعتباره أهم أدوات الصراعات السياسية. ففي هذا العصر المأزوم تبدو الحقائق الموضوعية أقل تأثيرا في تشكيل الرأي العام مقارنة بالشحن العاطفي والمعتقدات الشخصية. وفي هذا العصر يحل الكذب محل الصدق، والعاطفة محل الحقيقة، والتحليل الشخصي محل المعلومة، والرأي الواحد محل الآراء المتعددة. وقد يغدو التضليل الذي يمارسه الإعلام أحيانا بمثابة حرب نفسية تشنّ على المتلقي لإحداث أكبر قدر من التأثير السالب. إن حالة صناعة التضليل الإعلامي عبر الحملات الدعائية تمس في كثير من الأحيان مبادئ المجتمع وقيمه، وهي بالضرورة حالة تبتعد عن أخلاقيات مهنة الإعلام. في العام 1928 اشتكى تجار التبغ في الولايات المتحدة الأمريكية من كساد البضاعة وانخفاض المبيعات فقصدوا إدوارد بيرينز أحد دهاقنة الحملات الدعائية، والذي فكر في طريقة ينقذ بها هذه الشركات فوجد ضالته في تدخين النساء، والذي كان حينئذ مرفوضاً في المجتمع الأمريكي وعادة مستهجنة. فما كان من بيرينز إلا استغلال عارضات الأزياء، وملكات الجمال، للسير في أكبر شوارع نيويورك طالبا منهن حمل مشعل الحرية باليد اليمنى، والسجائر باليسرى، وحشد وسائل الإعلام لتغطية الحدث باعتباره يمثل قدرة المرأة على كسر عادة اجتماعية فرضها المجتمع فلماذا لا تعيش المرأة بحرية دون إملاء؟!. وكتبت حينها صحيفة نيويورك تايمز عنوانا شهيرا ذاع صيته: "مجموعة من الفتيات نفثن السجائر في سبيل الحرية". فكسر بيرينز بذلك المحظور وتضاعفت مبيعات شركات التبغ. فقد عزف بيرينز على وتر الحرية الذي كان موضوعاً ساخناً في تلك الأثناء مع تزايد الدعوات إلى وجوب مساواة المرأة بالرجل في الحقوق. وبالنسبة للتسويق السياسي فإن المستهلك مواطن عادي، يسعى المسوقون لجلب انتباهه ثم تجنيده، عن طريق معلومات يوحون بأنها تهم مستقبله وكذا مستقبل عائلته، ومدينته، ومنطقته، ومستقبل وطنه أيضاً. ويفترض في إطار المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام أن يتم ذلك عبر إعلانات نزيهة خالية من الأخطار، وبعيدا عن الكذب أو الديماغوجية. ومن جهة أخرى تلعب استطلاعات الرأي العام أهمية كبرى في قياس الرأي العام بالنسبة للسياسيين، ففي الولايات المتحدة يتمُّ قياس شعبية الرئيس بمعدل الرضا عن أدائه في منتصف العام الذي تُجرى فيه الانتخابات، كما يتمُّ قياس الحالة العامة للاقتصاد في الربع الثاني لسنة الانتخابات بالنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، ففي غالب الأمر يكون لهذه المؤشرات تأثير كبير على أصوات الناخبين، وما إذا كانت هناك فرصة لمنح حزب الرئيس ولاية أخرى في حالة الرضا عن أداء الرئيس أم إنه لا مجال لذلك وحان الوقت للتغيير واختيار مرشح الحزب المنافس. بيد أن هناك ثمة تضليل ما، يعنينا نحن في الدول الأخرى، لاسيما في العالم العربي، فالحكومة الأمريكية تستند في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية على وسائل غير ديمقراطية، حيث لا يجد المواطن الأمريكي العادي مفرّاً من الموافقة عليها لعدم درايته بمجرياتها، وغالبًا ما تكون آراؤه تجاه قضاياها سطحية وعاطفية ومتطرفة، ويدعم الإعلام الأمريكي حالة الانغماس في الشأن الداخلي ويساعد على الإبقاء عليها، وهي حالة من الغموض والضبابية وعدم الوضوح في مُحدِّدات السياسة الخارجية. غير أن السياسيين الأمريكيين يجيدون استخدام آلية استطلاع الرأي العام لمصلحتهم الخاصة؛ ففي انتخابات 2008 على سبيل المقال؛ حين أظهرت نتائج الاستطلاعات المبكِّرة قلق الناخبين من محدودية خبرة المرشح الديمقراطي حينها باراك أوباما، بقضايا السياسة الخارجية، قام أوباما بتعيين جوزيف بايدن، ذي الخبرة الممتدة لثلاثين عاماً في الشؤون الخارجية نائباً له. [email protected]
1243
| 07 نوفمبر 2020
في تصاعد جديد وخطير للتوترات القبلية في شرق السودان قتل 8 أشخاص بينهم عنصر أمني، بينما جرح العشرات في اشتباكات بين محتجين قبليين وقوات الأمن في مدينة كسلا، مما دعا الحكومة السودانية لفرض حالة الطوارئ في المدينة لمدة 3 أيام. وجاء ذلك إثر إقالة والي ولاية كسلا الذي لم يستطع تسلم مهام عمله منذ تعيينه في يوليو الماضي ضمن 18 واليا مدنيا خلفا للولاة العسكريين الذين ظلوا يديرون أمر الولايات عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019. وواجه تعيين والي كسلا الجديد احتجاجات عنيفة من مكون قبلي (الهدندوة) رأى أحقيته بالمنصب وأن الوالي المعين يمثل قبيلة منافسة (البني عامر) التي لها تداخل مع دولة مجاورة. هذه الاحتجاجات منعت الوالي الجديد من ممارسة عمله في عاصمة الولاية وظل يمارس مهامه من الخرطوم، وانصاعت الحكومة المركزية في نهاية الأمر وأقالت الوالي، بيد أن مناصريه (البني عامر) ثاروا غاضبين مما أسفر عن صدامات نهاية الأسبوع المنصرم. لكن القلق وسط الكثيرين يتصاعد من تكرار الأحداث الدامية التي شهدها في السابق إقليم دارفور. المحير أنه حسب اتفاق السلام الأخير الموقع في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان يفترض إقالة جميع الولاة الذين لم يمض ِ على تعيينهم بضعة أشهر، فما هي دواعي استعجال إقالة والي كسلا طالما لم تستجب الحكومة لإقالته في حينه مع بداية الاحتجاجات عليه؟!. فالإقالة في هذا السياق قد لا تثير غضب المؤيدين وتشفي صدور المعارضين. ولعل نقص الدربة السياسية للحاكمين اليوم في التعاطي مع فسيفساء التكوينات القبلية أسهم في إشعال الحريق؛ فلو أن الوالي المـُقال كان قد تحلى بالمسؤولية السياسية والوطنية واستقال طائعا مختارا ربما خفف من غضبة عشيرته، فالإقالة في هذه الأجواء المشحونة تبدو استفزازا لقبيلة الوالي وانتصارا للمكون القبلي الآخر، ولطالما لم يتحل بذلك، فلماذا لم ينصحه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ويطلب منه ذلك طوعا؟!.. لكن الرجل نفسه بدا غاضبا وأقرب لتحريض مناصريه عقب إقالته من خلال ما ينشره عبر حسابه على الفيس بوك، فقد اتهم الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. ولأن المحتجين لهم امتداد قبلي داخل دولة مجاورة، فيخشى من تأثير خارجي يستغل الظرف الأمني الحساس وقد يكون التأثير عسكريا أو على الأقل استخباراتيا وعليه لابد للدولة من الانتباه والتيقظ ومعالجة الأمر بحكمة، فليس هناك اليوم أولى من استتباب الأمن والاستقرار في تلك الربوع. إن اشتعال الشرق ينذر بكارثة أمنية وسياسية واقتصادية في آن واحد؛ فقد أدت الاحتجاجات إلى غلق الطرق الرئيسية المؤدية إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، وقد تفوق آثار ذلك تداعيات أزمة دارفور، إذ يمثل الشرق مجالا لوجستيا وإستراتيجيا مهما، فضلا عن أنه قريب جدا من المركز إذا ما قورن بدارفور. ويبدو بالإضافة إلى ضعف خبرة السلطة الحاكمة وضعف قبضتها أن ثمة اختراقات وأيادٍ مخابراتية متعددة تشعل الأوضاع في شرق البلاد خدمة لأجندات خارجية، مما يستدعي من الحكومة المركزية إغلاق الحدود مع الدول المجاورة ذات الصلة بالأزمة وبسط الهيمنة والسيادة على الإقليم بحسم. تاريخيا بنت التنظيمات الجهوية والقبلية لاسيما في الشرق خطابها السياسي على المطالب التنموية ذات العلاقة بنطاقها الجغرافي؛ فقد ركز مؤتمر البجا في ميثاقه في نهاية خمسينيات القرن الماضي على ضرورة استغلال ثروات شرق السودان المعدنية بالتصنيع، وتطبيق الحكم اللامركزي، وإقامة المستشفيات وإقامة السدود والآبار الجوفية، وأن كل مهن شرق السودان حق مكتسب لقبائل البجا. والمطالبة ببقاء معلمي البجا في شرق السودان، فضلا عن مطالب المشاركة في السلطة المركزية. وكان ذلك بعد ما عرف بثورة أكتوبر 1964. بيد أن العبث السياسي في الشأن القبلي ألبس أبناء القبائل الوادعة شيعا يذيق بعضهم بأس بعض، ومن عجائب تطورات صراع قبيلتين في العهد السابق بغرب البلاد أن أصدرت مجموعة من أبناء إحداهما منشورا تم توزيعه في إحدى مدن دارفور، يعلن تهجير جميع أبناء القبيلة الأخرى المقيمين بالمدينة على أساس انتقائي عنصري وعرقي وهدد المنشور بقتل كل أبناء القبيلة الأخرى الذين لا يغادرون المدينة الضعين (24) ساعة كمهلة. إن مصطلح "القبِيلة" يشير إلى كيان اجتماعي حامل للقيم ورابط بين الجماعة يوفر لها الحماية والمصالح؛ أما مصطلح "القبَلية" فينطوي على عصبية، بحيث يصبح مدلول هُـوية، ليعطي عضو القبيلة إحساساً وإدراكاً بأنها تشكل له هُوية تطغى على الهُويات الأخرى بما فيها الهُوية الوطنية. وعملت التدخلات السياسية على تسييس القبيلة، مما أحدث استقطابا سياسيا وتوظيفا للصراع القبلي في اتجاهات عديدة. ولسوء الحظ فقد أخذ الصراع القبلي يتحول من نزاع اجتماعي إلى صراع مسلح يتجاوز طبيعة النزاع القبلي التقليدي، الذي يتم احتواؤه عادة بالأعراف القبلية أو ما يعرف في السودان بنظام الإدارة الأهلية. لقد غدت القبيلة لا هي منظمة حديثة بقواعدها الحديثة، ولا هي بتقليدية بتقاليدها التليدة، فغابت عنها مميزات الطرفين. والنتيجة المركبة فوضى في النشاط السياسي المليء بالأحزاب السياسية القبلية وبالقبائل الحزبية. فالتدخل السياسي أدى إلى إضعاف ميكانيزمات المجتمع فانهارت عناصر الضبط الاجتماعي. وكل ذلك يحدث في ظل مناخ سياسي مضطرب بدأ ينتشر فيه السلاح بشكل فوضوي. وفي حالة الجيش فإن الأمر يكون كارثيا. وإن لم يبد حتى الآن شيء للعيان من تمكن فيروس القبلية في هذه المؤسسة الخطيرة، إلا أن ما يعرف بقوات الدعم السريع على سبيل المثال قد نشأت على أساس قبلي. النتيجة العاصفة أن السودان أصبح دولة تفتقر إلى سلطة وطنية تحقق التوافق الوطني وتبسط هيبة الدولة وبالضرورة توفر حقوق وأمن مكوناته القبلية المختلفة. ولن تتحقق أركان السلام الاجتماعي ما لم تحسن الدولة إدارة التعدد الاثني والعرقي والديني بما يزيل البغض والعداء بين أفراد المجتمع. ولا يتحقق السلام والأمن بعقد اتفاقات يعود ريعها لأمراء الحرب. [email protected]
2273
| 17 أكتوبر 2020
هناك في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وفي محيط مقبرة زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، توقد اليوم الشموع، وتتعانق كؤوس الفرح، احتفالا بتوقيع اتفاق المسارات الخمسة، وهو في الحقيقة اتفاق تقطيع أوصال السودان وتقسيمه لخمس دويلات. بيد أن النخب السياسية السودانية التي أدمنت الفشل ورهن إرادتها للإستراتيجيات الدولية، تغني مرددة نحن على "أعتاب سلام شامل يؤسس لاستقرار البلاد وتحقيق التحول الديمقراطي"، ما أسهل تنميق العبارات وتصدير المزاعم!، فبالأمس زعموا أنه "اتفاق نيفاشا للسلام الشامل" فذهب جنوب البلاد وتحول لدولة همها تقسيم ما تبقى. هذا الاتفاق قام وتأسس على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتا جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان، وفيما يدور الصراع المسلح في أقاليم دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان؛ فإنه لا يوجد صراع مسلح في باقي الأقاليم الثلاثة لاسيما شمال ووسط السودان، حيث تم إقحامها إقحاما حتى يحفر في العقل الباطن السوداني هذا التقسيم الآثم ويفرض فرضا. ومع كل هذا الزخم، لم يشمل هذا الاتفاق فصيلين مسلحين، أحدهما في منطقة جبال النوبة بجنوب كردفان، والآخر في إقليم دارفور، وبالتالي فهو ليس كما زعموا أنه "اتفاق سلام شامل يؤسس لاستقرار في البلاد". والطامة ليست في تقسيم البلاد سياسيا عبر المسارات الخمسة فحسب، وإنما يتضمن الاتفاق الكارثي تفكيك الجيش القومي، وإعادة هيكلته بشكل جهوي ومناطقي، وهنا بيت القصيد؛ فعلى مدى أكثر من 6 عقود أعقبت استقلال البلاد عن بريطانيا، ظل الجيش السوداني أحد أهم عناصر الحفاظ على الدولة، ومن الطبيعي أن من أراد استهداف كيان الدولة عليه أن يستهدف الجيش. اليوم تستبد بالواقع السوداني المضطرب مخاوف جدية، تقف شاخصة من خلال تكرار تجربة المعارضات العربية التي تسنمت السلطة بعد الاطاحة بالديكتاتوريات العسكرية، وكانت سبب تدهور الأوضاع المروع في العراق واليمن وليبيا. وتبين فيما بعد أن الديكتاتورية في العراق كانت أفضل من الديمقراطية التي جاءت بالمعارضين على ظهور الدبابات الأمريكية، وهكذا الحال في ليبيا واليمن، وفي حالتي العراق وليبيا لم يتحول الحكم الشمولي إلى ديمقراطية زاهية، أو حتى الحفاظ على ما تحقق في السابق من تنمية واستقرار. لعل جوبا اليوم تلعب دورا خبيثا ضمن مخطط تقطيع أوصال السودان؛ فرغم الانفصال ما زالت النخبة الحاكمة هناك تسمي نفسها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" أي تحرير السودان من العرب والثقافة العربية، وكان زعيمها جون قرنق يقول إن كان العرب والمسلمين خرجوا من الأندلس قبل 500 عام بعد أن دخلوها في 1492م فما الذي يمنع خروج العرب والمسلمين من السودان. لقد بنت الحركة الشعبية مشروعها السياسي الذي كانت ثمرته الانفصال في يوليو 2011، على محاربة ما تسميه بالمشروع (الاسلاموعروبي) في السودان. ليس هذا فحسب، بل إن الحركة الشعبية تزعم أنها تقود الافارقة ضد هذا المشروع وترى أنه الذي اتخذ من السودان منصة لغزو القارة الأفريقية. وكان واضحا جدا أن الهدف النهائي الذي ظلت تتعهده الحركة الشعبية هو تمكين السودانيين الذين تعتبرهم أفارقة من السلطة، لاعتقادها أن دولة ما بعد الاستقلال 1956م دولة - حسب زعمها - مفبركة، وقائمة على نظام وأطر مؤسسية شوفينية عرقياً ودينياً. وعليه عقدت الحركة العزم - حتى بعد الانفصال - على إنهاء ما تسميه بالنموذج العربي الإسلامي وإعادة بناء (السودان الجديد) عن طريق الإحلال والإبدال بين النموذجين. وظل التناقض الأساسي في طرح قادة الحركة متمثلا في تحويل مطالب التنمية (كما في خطابهم السياسي المنطلق من مانفستو الحركة) إلى معاداة العرق واستبطان دعوة خفية للانقلاب على القبائل العربية في السودان، التي تزعم استحواذها حكم السودان وهي تمثل ما تسميه بـ (السودان القديم). ومن الحماقات التي ارتكبتها جوبا بُعيد الانفصال رفضها إدراج العربية كلغة رسمية ثانية في الدستور، مبررة ذلك بأن جنوب السودان لا تربطها علاقة مباشرة مع العالم العربي؛ لأنها لا تقع في محيطه، وأثارت الخطوة جدلا كثيفا في الأوساط الشعبية، فغالبية السكان يتحدثون العربية وهي لغة التواصل بين مختلف قبائل دولة الجنوب. ولذا فإن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تستخدم هذه اللغة كواحدة من وسائط التواصل واسعة الانتشار، وعوضا عن العربية لم تعتمد جوبا لغة محلية تعزيزا للإرث الوطني والثقافة القومية بل استبدلت العربية باعتبارها لغة أجنبية بلغة أجنبية أخرى، وهي اللغة الانجليزية حيث أقرتها لغة رسمية في البلاد. واليوم وقد سحبت جوبا البساط من تحت أقدام القاهرة وأصبحت كعبة يحج إليها السياسيون السودانيون المغرر بهم؛ كانت مصر داعما رئيسيا للحركة الشعبية الحاكمة إبان خوضها حربا ضد الجيش السوداني ما قبل 2005، الأمر الذي عزز مآل انفصال هذا الجزء من السودان، وبلغ الدعم السياسي المصري للحركة حدا أن سُمح بمكتب تمثيلي للحركة في القاهرة، وأتاحت لزعيم الحركة جون قرنق حينذاك منبرا إعلاميا من القاهرة يبث من خلاله خطابه المعادي للعروبة. لقد كان لجوبا موقف صادم للعرب بامتناعها عن التصويت خلال الجلسة التى أجريت في ديسمبر 2017 بالأمم المتحدة لرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل والتي أدت إلى موافقة 128 دولة على القرار مقابل امتناع 35 دولة عن التصويت منها خمس دول أفريقية من بينها جنوب السودان، وهو ما اعتبرته الدول العربية مواقف مخزية ضد مشروع القرار العربي. إن الحقيقة الماثلة أن السودان ليس معبرا للثقافة العربية والإسلامية نحو أفريقيا، باعتبار موقعه تاريخياً في الدائرة الأفريقية والعربية والإسلامية فحسب، بل هو جسر ذو اتجاهين؛ ناقل للمؤثرات العربية الإسلامية للقارة الأفريقية وفي ذات الوقت ناقل للثقافة الأفريقية للمجال العربي. [email protected]
2673
| 03 أكتوبر 2020
لا يبدو أن الهدف التكتيكي للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو من دعم أوكرانيا في الحرب الحالية مع روسيا وعلى المدى المتوسط هو أكثر من إخراج روسيا من أوكرانيا، ومن ثمّ تهيئة الأجواء لانضمامها لحلف الناتو. أما القضاء الكلي على الدُّب الروسي فهو هدف استراتيجي غير أن وقته لم يحن بعد ولا يجب أن يتم عن طريق حرب عالمية ثالثة يكون الكل فيها خاسرا بما في ذلك المنتصر. ولذا سارعت واشنطن بالتأكيد على عدم منح أوكرانيا أسلحة وصواريخ بالستية بعيدة المدى قد تضرب العمق الروسي. وكانت موسكو قد حذرت واشنطن بأنها ستصبح طرفاً في النزاع، حال قررت تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وفي خلد الولايات المتحدة وحليفاتها أنه كما تم تفكيك الاتحاد السوفييتي السابق بالقوة الناعمة المحروسة بالقوة العسكرية فيمكن تكرار ذات السيناريو. واليوم تتوجس موسكو مما عرف بـ "وثيقة كييف الأمنية" باعتبارها مدخلا لإحلال التفاوض بديلا للبندقية، وترى فيها مشروعا لتحضير كييف للانضمام لحلف الناتو، وهو الأمر الذي بسببه شنت روسيا حربها على أوكرانيا باعتبار ذلك تهديدا استراتيجيا لوجودها. وفي الطبيعة يُعرف عن الدب الأبيض شراسته النمطيّة، إلا أنه عادةً ما يكون حذرا في مواجهة مصدر الخطر، حيث يفضل التراجع عوضا عن القتال. لكنه صياد ماكر، فهو يصطاد عن طريق التسلل والتربص، وفي العادة لا يُشعر طريدته بوجوده إلا بعد أن يهاجمها. وسواء كان التراجع الأخير للجيش الروسي في شرق أوكرانيا عملية كرٍّ أم فرٍّ، فإن الجيش الأوكراني تلقى من حلف الناتو دعما معلوماتيا وبأسلحة نوعية غير مسبوق، باعتراف الأمين العام للحلف، مما أحدث فرقا على أرض المعركة. لكن الروس يزعمون أن الكَرَّة الأوكرانية الأخيرة عليهم حققت فقط انتصارا إعلاميا إذ أن الفَرَّ الروسي لم يكن إلا انسحابا ضمن خطة معدة تحت ظروف معينة. فهل حقا تعمدت روسيا التراجع أم أن الناتو قد أجبرها على التراجع عبر الأداة الأوكرانية وبدأ فصل جديد من فصول الصراع بين القوتين العُظميين؟. ربما بالفعل تراجعت روسيا تكتيكيا وهي تحاول امتصاص ضربات الدعم الغربي النوعي لأوكرانيا، وهو دعم في المحصلة ليس لأجل عيون كييف ولكن لأهداف استراتيجية بعيدة المدى. فثمة من يعتقد أن روسيا ستركز على سلاح الغاز مع اقتراب فصل الشتاء وستنظر ماذا فاعلة أوروبا التي تشكل العضوية الغالبة للناتو، فمن بين 30 دولة في الحلف، هناك 27 دولة أوروبية. وتعول موسكو على فشل كل محاولات أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي الرخيص، وقد دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى خفض استهلاك الكهرباء في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وإلى فرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة، في مواجهة ارتفاع الأسعار. وأحيط البرلمان الأوروبي علما بإن أسعار الغاز والكهرباء سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ بدء الحرب على أوكرانيا. في حين تعثرت خططا غربية بشأن وضع سقف لأسعار الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تهديدات روسية باتخاذ المزيد من العقوبات تجاه أوروبا. اليوم يحتاج كل الخبراء والمحللين السياسيين والعسكريين لوقفات مَليّة لمحاولة فهم ما يجري في تلك المنطقة؛ فمن قبل كادوا أن يجمعوا على أن هناك تحولاً عميقا في حركية العقل الروسي وإستراتيجيته تجاه الفضاء الجيوسياسي المحيط، وفي ما أبعد من الفضاء المحيط. بل أن كاتبا في مجلة فوربس الأمريكية زعم أنه في حال قررت روسيا مهاجمة دول البلطيق فيمكنها احتلالها بالكامل خلال 2 – 3 أيام، ولن يستطيع حلف الناتو خلال هذا الوقت الاستجابة سريعا باتخاذ قرار منسق مؤكدا أن هذا الأمر ظل يشكل قلقا لواشنطن. وربما الذي يشكل نوعا من التوازن بين القوتين على المدى المنظور هو موقف بكين من النزاع في أوكرانيا ونظرتها لروسيا باعتبارها شريكا استراتيجيا يحاول الحد من هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها. وربما تخشى الصين في أن أي خلل في هذا التوازن قد يعيق هدفها أن تصبح "دولة اشتراكية حديثة عظيمة" بحلول الذكرى المئوية لجمهورية الصين الشعبية في عام 2049. لعل الخاسر الأكبر على المدى القصير والبعيد هي أوكرانيا؛ فسواء احتلتها روسيا وفرضت عليها رؤاها السياسية، أو تمكنت هي من إخراج روسيا من أراضيها وإنزال رؤى وأهداف الناتو على أراضيها ومن ثمّ الانضمام إلى الحلف، فإن أوكرانيا لن تعد أوكرانيا وستتحول إلى بلد محطم ومنهك في مواجهة تهديد روسي مستمر ولا يتوقع أن يكون الاندفاع لإعمارها كما هو الحال حين دعمها أثناء العمليات العسكرية في مواجهة روسيا. إن أوكرانيا محايدة هي الصيغة الأذكى للتعاطي مع تعقيدات الصراع الدولي بين القوتين العظميين بسبب وضعها الجيوسياسي الحساس، وقد كان الحياد مثمرا في حالة السويد وفنلندا رغم موقعيهما الأقل حساسية. لكنهما للأسف تخلتا عن ذلك الحياد وانضمتا إلى الناتو في لحظات ضعف وخوف وتحريض. في ذلك اليوم خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامل زينته من اجتماع ضم رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي، وقد برقت عيناه بنصر مُعلنا أن السويد وفنلندا تستوفيان "كل المعايير" للانضمام إلى حلف الناتو. فذلك النصر الجزئي قابله العالم بقلق عميق بسبب تخلي السويد وفلندا عن حيادهما طويل الأمد، إذ أسهمت تلك الخطوة الانفعالية في تكريس حالة حافة الهاوية بسبب الحرب في أوكرانيا. اليوم ورغم مظاهر الاحتفاء الأوكراني بدحر القوات الروسية الأخير فهي لا تستطيع اخفاء خوفها وقلقها، وتوجسها، فهي واقعة بين مطرقة وسندان، عملاقين متنافسين متباغضين، وتستشعر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو حساباتهم تقوم على مصالحهم أولا، وليس على أساس نجدة الملهوف والغريق.
267
| 17 سبتمبر 2020
قد يكون الجيش في دولة من الدول بمثابة جماعة ضغط في صناعة القرارات، وقد يتعدّى هذا الدور إلى فرض النظام الذي يعتقد أنه مناسب للدولة، وذلك عبر آلية الانقلاب العسكري، مرتكزا على إيديولوجيا وحيدة هي أن الجيش هو الدولة. والجيش في أفريقيا والعالم الثالث عموما له دور سياسي لا يستطيع أحد التغاضي عنه، ولا مجال للحكم على دور الجيش هناك بمعيار وضعية جيوش العالم الأول في ظل ديمقراطيات عريقة، وعليه لا يمكن تصور حدوث أي تحول سياسي في العالم الثالث سواء من ديكتاتورية الى ديمقراطية أو العكس، من ديمقراطية الى ديكتاتورية إلا بمساهمة وتدخل الجيش. في السودان على سبيل المثال تم الانحياز للثورة الشعبية في ابريل 2019 من قبل الجيش بطلب من الثوار اعترافا بدوره، وبمباركة السياسيين الانتهازيين، في حين اعتبر البعض ذلك انقلابا عسكريا. الواقعيون يرون أن التزام ناصية الواقعية خطوة حتمية للانتقال الى وضعية الجيش في الديمقراطيات العريقة، وما هو معلوم أن الديمقراطيات العريقة سواء في فرنسا او بريطانيا أو امريكا لم تصل الى ما هي عليه من تماسك الا بعد سنوات عجاف من الحروب الأهلية المتطاولة، فالعالم الثالث يحتاج لتجسير بين واقعين؛ حالي مأزوم ومرفوض وآخر مرجو ومأمول. ويبدو أن حالة العداء للجيش أو التحالف معه، في أوساط القوى المدنية أمر مرتبط بتحقق المصلحة السياسية التي تتقزم أمام المصلحة الوطنية العليا. فإن عقدنا على سبيل المثال، مقارنة بين علاقة الجيش بالقوى السياسية في كل من مصر والسودان، وقسمنا القوى السياسية في كلا البلدين إلى يمين ويسار، سنجد أن اليمين في مصر يتوجس خيفة وريبة من الجيش الذي صيغ وأسس بنيانه منذ أمد بعيد على العلمانية التي تصب في بحيرة اليسار، بينما نجد اليمين في السودان يعتبر عقيدة الجيش في عمومها تصب في بحيرة اليمين، مع الاشارة إلى أن ذلك ليس صحيحا مائة بالمائة على الأقل في بعض الفترات الزمنية، بيد أن الثلاثين سنة الاخيرة يمكن التأكيد على أن صياغة الجيش السوداني غدت تصب في بحيرة اليمين، ولذلك تختلف نظرة القوى السياسية الى الجيش في كل من مصر والسودان في اطار هذه المحاولة التوصيفية الاجتهادية. إن الجدل الحالي في السودان حول شركات الجيش السوداني تبدو دوافعه سياسية بحتة، فاليسار الذي يتولى هذه الحملة يعمل على شيطنة المؤسسة العسكرية السودانية سعيا لتفكيكها لصالح حلفائه من الحركات المسلحة المتمردة، لاعتقاده بأن الجيش بوضعيته الحالية يصب في صالح اليمين، فهذه الحملة تريد تحويل الجيش السوداني من اليمين الى اليسار وهذا يعني استمرار ادخال الجيش في اللعب السياسي غير الحميد. وما يشير إلى خطل حملة اليسار السوداني ضد الجيش أن استثمارات الجيش ليست بدعا؛ فالجيش الأمريكى يستثمر 44 مليار دولار بالإنشاءات، و"أوياك" التركية تمتلك متاجر تجزئة ضخمة، و"كانتين الهندية" تبيع 23% من سيارات البلاد، والجيش الإيطالى يورد "الماريجوانا" لشركات الدواء، أما الجيش المصري فيتحكم في نحو 40% من الاقتصاد. إن اليسار السوداني لا سيما الحزب الشيوعي ينطلق في حملته الشرسة ضد الجيش من رؤية منظّر الشيوعية فلاديمير لينين الذي يرى ضرورة أن يأخذ الجيش زمام المبادرة السياسية، قطعاً للطريق على البرجوازية التي تريد تحييده. لكن بغض النظر عن هذه النظرة أو تلك فإن الجيوش لابد وأن تكون أكبر من التصنيفات السياسية ولابد من أن تتمتع باعتباريتها ووضعيتها ومكانتها الاستراتيجية في بناء وهيكل الدولة، بينما تبقى القوى السياسية متنافسة ومتدافعة في اطار الحكومات المحدودة بحيز زماني وفق تفويض جماهيري لا يتمتع بالديمومة إلا في اطار تجديد الثقة عبر آليات التبادل السلمي للسلطة. حملة اليسار السوداني جعلت رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد الأعلى للجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان ينتفض غضبا وهو يخاطب جنود وضباط الجيش بمناسبة العيد الـ66 للجيش قائلا: "ظللنا نتابع المحاولات الحثيثة من قبل البعض لتشويه سمعة القوات المسلحة وشيطنة قوات الدعم السريع ومحاولة الفتنة بينهما لكننا نقول لهم نحن متحدون ومتماسكون ويد واحدة وعهدنا مع الشعب أن نقف معه ومع ثورته". مضيفا أن: "الجيش في رهن إشارة الشعب كما استجبنا له في ابريل". ما لا يعلمه اليسار المتنمر أو يتجاهله متعمدا أن للجيش أهمية وربما قدسية في كافة المجتمعات، يعزز ذلك طبيعته النظامية، وهيكليته المؤسساتية، وانضباطه مما يؤدي إلى تحقيق أهدافه التي بالضرورة هي جزء لا يتجزأ من أهداف المجتمع والدولة. ولربما افتقدت قيادة الجيش السوداني الحالية إلى الكاريزما المرتبطة بدور بطولي مرتبط بالحروب أو الأزمات التي يبرز فيها دور الجيش، ولذلك حاول البرهان في انتفاضته تلك أن يستدعي ما يجلب له دور البطل، معلنا أن الجيش لن يتراجع حتى يتم رفع علم السودان في مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع مصر. لعل الأزمة السياسية التي تعمقت في السودان بعد سقوط النظام السابق سببها فشل المدنيين والعسكريين في الوصول إلى معادلة المصلحة المتبادلة، فالسياسي لا يستطيع تحقيق استقرار حكمه دون دعم الطرف العسكري ومساندته، كما أن العسكري يعتمد في الوقت نفسه على السياسي للبقاء في منصبه، وضمان استمرارية هيبة المؤسسة العسكرية وقوتها. اليوم يبدو الجيش السوداني أمام تحد وجودي كبير لاسيما الانفلات الأمني في بعض الولايات والانهيار الاقتصادي الماثل، فهو المسؤول عن الحفاظ عن وطن يقف على حافة الهاوية. وليس من المنطق أن يرهن مصير الاستقرار السياسي على شريكه تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك التي لم تعد تتمتع بسند جماهيري بسبب فشلها في تحقيق كل ما أوكل إليها. فالجيش لا خيار له إلا إعادة صياغة تحالفه مع المدنيين بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وفق برنامج وطني جامع. [email protected]
2392
| 29 أغسطس 2020
كان نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير كلما ضاقت به الأزمة السياسية والاقتصادية واستحكمت حلقاتها يظن أن في تغيير الحكومة كليا أو جزئيا فرجا ومخرجا، لكن الأزمة تستمر رغم التفكيك وإعادة التركيب المتكرر للحكومات. فتتعدد المسميات والوصفات والداء واحد باق، فمن حكومة عريضة إلى أخرى رشيقة وتارة حكومة وفاق وطني. فالذي لم يكن ليتغير المنهج الذي تدار به الدولة وكان نهجا عقيما لا يلامس عصب الإشكال السياسي الذي كان يترتب عليه بالضرورة إشكالات اقتصادية. اليوم يبدو رئيس الحكومة الانتقالية الحالية عبد الله حمدوك وحاضنته السياسية (تحالف قوى الحرية والتغيير) أمام خيار إجراء تعديل وزاري محدود بعد أن أفقدتهم تظاهرات 30 يونيو الأسبوع الماضي تماسكهم وجَلَدَهم فكانت استفتاءً لأداء حكومي ضعيف ومرتبك عمّق الأزمة الاقتصادية وفشل في إنجاز الملفات السياسية فكان أن رفعت المظاهرات الضخمة شعار تصحيح مسار الثورة. وعشية التظاهرات المعلنة التي رفعت عاليا درجة التوتر بين الطواقم الأمنية والسياسية المتنفذة، حاول حمدوك في خطاب له امتصاص حدة الغضب الجماهيري وتقديم تبريرات لفشل حكومته الذي استدعى تنظيم هذه التظاهرات. وقال حمدوك: "مما لا يخفى عليكم أن التوازن الذي تقوم عليه المرحلة الانتقالية التي تحاول حكومة الثورة إدارتها، هو توازن حساس وحرج. وأنه يمر بين كل حين وآخر بكثير من المصاعب والهزات التي تهدد استقراره، وتتربص به قوى كثيرة داخل وخارج البلاد تحاول إعادة مسيرتنا إلى الوراء". هذه الفقرة من خطاب حمدوك حملت الكثير من الخوف وربما الإحباط فلم يبح من قبل في كل خطاباته ذات الوقع الحالم بمثل هذا البوح. فقد ألمح حمدوك إلى التجاذبات بين طرفي السلطة الانتقالية (المكون العسكري والمكون المدني)، فوصف التحالف بين المكونين بأنه يقوم على توازن حساس متهما جهات داخلية وخارجية بالتربص به. ولا يبدو للمتابع أن سبب الخلافات التي تعتري ذلك التحالف السلطوي هو تربص المتربصين كما حاول حمدوك أن يبرر، وإنما السبب الخلافات المحتدمة حول الملفات السياسية مثل تعيين ولاة الولايات واستكمال الهياكل التشريعية ومفاوضات السلام مع الحركات المسلحة وإعادة هيكلة المنظومات العسكرية والأمنية، بينما لا يجد ملف الأزمة الاقتصادية الاهتمام الكافي من طرفي السلطة. ففي هذا الملف بدت مقارنة مدهشة؛ فبينما كانت توصف حكومة البشير بالفاسدة لكنها كانت تدعم المحروقات والسلع الاستهلاكية الأساسية وغادرت الحكم وسعر الدولار مقابل العملة المحلية يساوي نحو 70 جنيها، بينما حكومة حمدوك توصف بأنها حكومة الثورة - غير الفاسدة - لكنها رفعت الدعم عن المحروقات والسلع الاستهلاكية الأساسية فسحقت الطبقة المسحوقة التي جاءت بها إلى سدة الحكم بينما عانق الدولار سقف 136 جنيها. وما تشهده البلاد من تضخم مخيف بلغ 114% وفقا للجهاز المركزي للإحصاء، يسميه أهل الاقتصاد بالتضخم الحلزوني، حيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تُنتج المزيد من التضخم، وخطورة هذا النوع من التضخم أنه يغذي نفسه بنفسه. ومع الوقوف عند قول اتحاد العمال السوداني إبان العهد السابق بأن الأجر الذي يتقاضاه العامل حينها لا يكفي إلا بمقدار 10% من تكلفة المعيشة، فما بال الحال اليوم. وما يؤكد حالة التدهور المخيف إصدار البنك الدولي تصنيفا جديدا للسودان للعام 2020-2021 باعتباره دولة منخفضة الدخل بعد أن كان تصنيفه دولة متوسطة الدخل بينما حدث العكس في دول أخرى مثل بنين وتنزانيا ونيبال. وحدد البنك الدولي متوسط دخل الفرد في السودان في تقريره بتاريخ الأول من يوليو الحالي بمبلغ 590 دولارا. بينما كان متوسط دخل الفرد في تقرير نفس الفترة من العام 2019 مقدر بمبلغ 1560 دولارا. وفور انتهاء التظاهرات لم يجد حمدوك وحكومته بدّا من إصدار قرارات متعارضة تماما مع مطالب المتظاهرين، منها قرارا بإنتاج الخبز التجاري في ولاية الخرطوم لتباع قطعة الخبز الواحدة بأكثر من 10 جنيهات، فيما يتوقع ارتفاع سعر لتر البنزين من 26 جنيها إلى 60 جنيها. أما سياسيا فبدلا من استعجال إنهاء عمل لجنة فض اعتصام قيادة الجيش العام الماضي الذي سالت فيه دماء غزيرة أصدر حمدوك قرارا بتمديد عمل اللجنة لـثلاثة أشهر على الرغم من مطالب المتظاهرين بالقصاص لضحايا فض الاعتصام. فهل سيجدي مع كل التحديات الماثلة مجرد إحداث تعديل وزاري كما ينوي حمدوك؟. هذا لا يبدو منطقيا فالمنطق أن يتحلى حمدوك بالشجاعة الكافية ويقدم استقالة حكومته كاملة لإفساح المجال أمام حكومة جديدة. فقد كان تشكيل حكومة تحالف الحرية والتغيير برئاسة حمدوك متعارضا مع الوثيقة الدستورية إذ أنها نصت على تشكيل حكومة كفاءات بينما شُكّلت حكومة حمدوك على أساس محاصصات حزبية وضمت وزراء قليلي الخبرة فجاء أداؤهم ضعيفا ليس على قدر تحديات الفترة الانتقالية. حتى حمدوك نفسه بدا ضعيفا يفتقر إلى الحضور السياسي ومستسلما تماما لتجاذبات تحالف الحرية والتغيير الذي لم يكن على قلب رجل واحد ولم يجمع أعضاء هذا التحالف برنامج وطني بل كان اتفاقهم الوحيد على إسقاط نظام البشير، وحين سقط انكشفت عورة هذا التحالف فانعكس ذلك على الأداء الهزيل لحكومة حمدوك. إن لم يتنبه الساسة السودانيون لخطورة الأوضاع في بلادهم فإن رؤية المخابرات الأمريكية التي أفصحت عنها صحيفة واشنطن بوست يناير الماضي ستصبح واقعا، فهي ترى أن الوقت مناسب الآن لتنزيل خطة تقسيم السودان إلى عدة دول بفرضية أن البلاد اليوم في أضعف حالاتها سياسيا واقتصاديا.
1236
| 04 يوليو 2020
خيبة أمل عظيمة ظل وقعها يزداد على السودانيين، مع اطراد تصاعد الضائقة المعيشية على الطبقة المسحوقة، وهم الغالبية العظمى من المواطنين، وقد اختفت الطبقة الوسطى تماما، فالمواطنون اليوم فئتان؛ قلة قليلة جدا بيدها الثروة، وغالبية غالبة لا تملك شيئا وتعيش تحت خط الفقر المدقع. لقد توقّع الناس في السودان أن يتحسّن وضع الاقتصاد بعد سقوط نظام عمر البشير في ابريل 2019 لا سيما وأن الثورة التي أطاحت بالنظام كانت اسبابها اقتصادية بحتة وانطلقت من الولايات قبل العاصمة حيث الواقع المعيشي أكثر قتامة. في العاصمة الخرطوم ينتظر الناس ساعات طويلة في طابور زاحف لتعبئة سيّاراتهم بالوقود، وساعات أخرى للحصول على الخبز وغاز الطبخ وليس هذا فحسب إذ يقطع التيار الكهربائي عن المنازل لساعات طوال يومياً وبشكل رتيب. يقول أحد الساخرين: "عندما تُوفي توماس أديسون أُطفئت جميع مصابيح الولايات المتحدة تكريما له، والآن وبعد 89 عاماً السودان يخلد ذكراه يوميا في الخرطوم". في ظل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بات الوضع اليوم معقدا وصعبا لدرجة بعيدة، خاصة في ظل رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية بقرارات سياسية مرتبكة جدا. لقد وجدت الحكومة في اجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا قشة فتعلقت بها، ومكنتها من حصر وتقييد الاحتجاجات الشعبية وعبر لجنة الطوارئ الصحية، وللمرة الرابعة تم تمديد أسابيع الحظر وتعطيل الحياة الاقتصادية، حيث لا يسمح بالحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحاً للثالثة عصراً، فأوصد ذلك الأبواب أمام العمال البسطاء الذين يعتمدون على حركة السوق لكسب قوتهم اليومي. إن حقيقة حجم الانهيار الاقتصادي لم تصدع به معارضة سياسية قد يشكك في أغراضها، لكن الجهاز المركزي للإحصاء وهو جهة حكومية أفصح عن الحقيقة المرة معلنا أن التضخم في شهر مايو الماضي قد بلغ نسبة 114%، بزيادة أكثر من 15% عن الشهر السابق وهي نسبة تشير إلى مرحلة انهيار الاقتصاد. وقال الجهاز المركزي للإحصاء ان ارتفاع معدل التضخم يعزى لارتفاع أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والالبان والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن نسبة لارتفاع غاز الطهي، الفحم النباتي، حطب الوقود، وتكاليف صيانة المسكن، وأيضاً ارتفاع أسعار مجموعة النقل. كما أكد صندوق النقد الدولي ذات الحقيقة في تقرير له، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات الاسعار بلغ 700% للسلع الأساسية اليومية. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في أواخر نظام الرئيس البشير نحو 80 جنيهاً، لكن اليوم تجاوز الدولار حاجز 150 جنيهاً. ويشير هذا التردي إلى دخول البلاد مرحلة التضخم المفرط وهو أقسى وأخطر أنواع التضخم، حيث تصبح النقود بلا قيمة تقريباً، وهذا التضخم يكون مُرتفعا جداً. ارتفاع الدولار جعل نائب رئيس مجلس السيادة والذي يرأس في نفس الوقت اللجنة الاقتصادية يتوعد المضاربين في سوق العملات ويؤكد أن زيادة المرتبات مقابل ارتفاع الدولار لا معنى لها، وبذلك يعلن فشل سياسة زيادة المرتبات التي أعلنها وزير المالية مع العلم أن الفئات المستفيدة من هذه الزيادة تشكل نسبة ضئيلة من مجموع السكان. فكيف يقوم وزير المالية بهذه الزيادة الكبيرة فى الرواتب ولا تملك الدولة موارد حقيقية ثابتة؟. في ذات الوقت لا يتراجع سعر الدولار بمجرد اطلاق التهديدات بمعاقبة تجار السوق السوداء؛ فالمشكلة أعمق ومتعلقة بزيادة الناتج القومي وبتغييرات هيكلية في اقتصاد البلاد، الذي من مشكلاته أنه اقتصاد تابع ومرتبط بالاقتصاد الاقليمي الخليج ومصر على سبيل المثال، وبالتالي يصيبه نصيب غير يسير من التراجع الذي تعاني منه اليوم الاقتصادات الاقليمية. والمفارقة المدهشة أن تجار العملة هم احدى الأدوات التي توفر العملات الحرة للدولة نفسها خاصة في ظل سريان العقوبات الأمريكية. من الناحية النظرية تبدو سيمفونية التحرير الاقتصادي هي الحل والمخرج بيد أن ذلك يحتاج لارادة سياسية تشجع الإنتاج والصادر في ظل استقرار سياسي عزيز المنال، ومن دون توفر شروط رفع الدعم السلعي عزفت حكومة حمدوك سيمفونية التحرير الاقتصادي فرفعت الدعم عن المحروقات تماماً، وصار جالون البنزين بسعر 126 جنيهاً بدلا عن 28 جنيهاً، ومع ذلك وفي ظل تدني اسعار البترول عالميا عجزت الدولة عن توفير وقود المركبات ووقود محطات الكهرباء، حيث عم قطع الكهرباء بكثافة. وقد رأى وزير المالية ان الدعم المباشر للفقير بتسليمه المال من خلال زيادة المرتبات افضل من الدعم غير المباشر، عبر دعم الدولة للوقود بيد أن الفقير قبض نقودا بلا قيمة، حيث اختفت السلع التي من أجلها طبعت النقود. على الرغم من أن السودان قُطرٌ شاسع وغني بالموارد الطبيعية؛ الزراعية، والحيوانية، والمعدنية، والنباتية، والمائية، لكن نخبه السياسية فشلت في ادارة هذه الموارد واستثمارها، وحتى ازدهار الاقتصاد السوداني في العشرية الأولى من القرن الحالي كان على خلفية إنتاج النفط، وارتفاع أسعاره، وليس بسبب استثمار موارد البلاد الزراعية المتجددة، وبُدّدت عوائد البترول تبديدا عوضا عن توظيفها في الإنتاج الزراعي الذي يوظف 80% من قوة العمل ويساهم في ثلث الناتج المحلي الإجمالي. [email protected]
2670
| 20 يونيو 2020
قالت ناشطة سياسية سودانية اشتهرت ببث مقاطع صوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في آخر تسجيلاتها وهي تخاطب ابناء وطنها: "علينا أن نودع بعضنا فلا ندري فقد لا نلتقي في القريب كسودانيين يضمنا الوطن بحدوده المعروفة". وعلى الرغم من أن حديث تلك الناشطة يبدو كنوع من الفن المسرحي التراجيدي أو نوع من الكاريكاتور الصوتي الساخر، إلا أن ما ذهبت إليه نتيجة منطقية لحالة عبثية تعيشها البلاد حيث تبدو الدولة غائبة وفاقدة للسيطرة على الرقعة الجغرافية التي تسمى السودان. والدولة الغائبة التي تمسك بتلابيبها القبلية، تفشل في تكوين المؤسسات الرسمية والشعبية، وتعجز عن اجتراح صيغة توافقية بين القوى الاجتماعية والسياسية لتنمية الولاء القومي على حساب الولاء الجزئي والقبلي في سياسات تعليمية وإعلامية متفق عليها، وفي التوافق على قيود فاعلة للحيلولة دون نفوذ القبيلة في مؤسسات الدولة. لا يمر يوم في السودان إلا ونسمع عن اشتباكات قبلية وعرقية شرقا وغربا وجنوبا؛ آخرها ما شهدته منطقة جبال النوبة المحاذية لدولة جنوب السودان من انهيار أمنى كبير وأحداث قتل ونهب وسلب في الطرقات والمنازل تحت سمع وبصر حكومة ولاية جنوب كردفان، وبلغ من السوء أن حوصر الوالي في منزله الأحد الماضي وفاق ما تم حصره من جرحى وضحايا المائة شخص. وتعود القصة لتمرد كتيبة تتبع للجيش قوامها إحدى قبائل النوبة كانوا قد انسلخوا في أواخر التسعينات من الحركة الشعبية وانضموا للجيش. وجاء تمردها إثر نهب مسلح راح ضحيته أحد أفراد الكتيبة أثناء النزاع مع أحد العناصر من قبيلة أخرى، فكانت ردة الفعل من قيادة الكتيبة حرق وضرب وقتل في وسط عاصمة الولاية وداخل السوق على أساس الجنس واللون. "داحس وغبراء" جاهلية العرب قصص تتكرر في البلاد؛ ففي 2015 دارت معارك بين قبيلتين في ولاية شرق دارفور حيث مئات القتلى والجرحى في إحدى معارك القبيلتين. معركة استخدمت فيها، أسلحة ثقيلة متنوعة مثل صواريخ الكاتيوشا وقذائف (آر بي جى). المدهش أن تلكُم المعركة دارت في ظل حكومة مركزية كانت أكثر سيطرة من الحالية فأعدت قوة جرارة للفصل بين القبيلتين قبل أن تتحول ديارهما إلى ديار خراب، وحوض يباب. التساؤل المـُلح؛ كيف لحكومة منوط بها إيجاد الأمن للناس، أن تسمح باستمرار التوترات القبلية والمجتمعية المسلحة مهما كانت الظروف، ومهما كانت المبررات؟. وكيف يتسنى لحكم انتقالي ضعيف إدارة دولة بها تنوع ثقافي وإثني ومناخي جعله يحتضن معظم المجموعات العرقية الموجودة في قارة افريقيا، فهو يضم 518 مجموعة قبلية تتحدث بأكثر من 119 لغة؟. وبدلا من أن يكون هذا التنوع مصدر قوة إلا أن النظام السياسي في السودان فشل في إدارته ومن ثمّ تحول هذا التعدد إلى عامل ضعف وانطبقت عليه مقولة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة التي قال فيها: (الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة، والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، وان وراء كل رأي منها هوى وعصبية تمانع دونها فيكثر الانتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت). إن مصطلح "القبيلة" يشير إلى كيان اجتماعي حامل للقيم ورابط بين الجماعة يوفر لها الحماية والمصالح. أما مصطلح "القبلية" فهو ينطوي على عصبية، حيث يصبح مدلول هُـوية، ليعطي عضو القبيلة احساساً وإدراكاً بأنها تشكل له هُوية تطغى على الهُويات الأخرى بما فيها الهُوية الوطنية. فتغدو نزعة، بل تشكل لأعضائها تصورا بوجود حدود اجتماعية وحدتها الأساسية القبيلة. وتجتمع القبيلة على قلب رجل واحد للوقوف في وجه خطر يهددها تدفعها إلى ذلك غريزة البقاء، أو السعي للمحافظة على وضعها في مواجهة القبائل والجماعات الأخرى. وتكون القبيلة أكثر حساسية حينما تكون أقلية في مجتمع تسيطر عليه قبائل أخرى. لقد ألبس العبث السياسي في الشأن القبلي أبناء القبائل الوادعة شيعا يذيق بعضهم بأس بعض. ولسوء الحظ فقد أخذ الصراع القبلي في السودان يرتبط ببنية الدولة ونظامها السياسي، وبالضرورة بخطابها السياسي. فتحول النزاع الاجتماعي إلى صراع مسلح. وغدا النزاع ظاهرة قابلة للتطور وصولا إلى حالة الصراع (النزاع المسلح) بفعل الخطل السياسي، فيصبح ظاهرة ومعضلة تتجاوز طبيعة النزاع القبلي التقليدي، الذي يتم احتواؤه عادة بالأعراف القبلية أو ما يعرف في السودان بنظام الإدارة الأهلية. لقد عملت التدخلات السياسية على تسييس القبيلة، مما أحدث استقطابا سياسيا وتوظيفا للصراع القبلي في اتجاهات عديدة. وأيقظت عودة الجهوية ما كان نائماً من فتنة الصراع القبلي الدامي في أرجاء عديدة من البلاد. ولم تعد مؤسسة القبيلة التقليدية صاحبة النفوذ الواقعي موجودة. وأصبحت القبيلة لا هي منظمة حديثة، بقواعدها الحديثة، ولا هي تقليدية، بتقاليدها التليدة. والنتيجة المركبة فوضى في النشاط السياسي المليء بالأحزاب السياسية القبلية وبالقبائل الحزبية. فقد أدى التدخل السياسي إلى إضعاف ميكانيزمات المجتمع فانهارت عناصر الضبط الاجتماعي. النتيجة العاصفة أن السودان أصبح اليوم دولة تفتقر إلى سلطة وطنية تحقق التوافق الوطني وتبسط هيبة الدولة وبالضرورة توفر حقوق وأمن مكوناته القبلية المختلفة. ولن يتحقق أركان السلام الاجتماعي ما لم تحسن الدولة إدارة التعدد الإثني والعرقي والديني بما يزيل البغض والعداء بين أفراد المجتمع. ولا يتحقق السلام والأمن بعقد اتفاقات يعود ريعها لأمراء الحرب. فالتنوع عرفته المجتمعات البشرية منذ زمن بعيد، وهو قيمة ومصدر قوة إن تمكن السياسيون من إدارتها إدارة سليمة.
983
| 16 مايو 2020
المظاهرات أربكت الأجهزة الأمنية بدقة التنظيم والحماية فاكتفت بالمراقبة الحكومة أمام اختبار حقيقي والاستهانة بالحراك الحالي تفاقم الأزمة الفشل الاقتصادي والسياسي هو المحرك للشارع ومؤشرات السيطرة على الوضع محدودة بعد مرور عام على إسقاط نظام الرئيس عمر البشير تصاعدت نهاية الأسبوع الماضي حدة المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية في السودان. المحتجون الغاضبون طالبوا بإجراء إصلاحات اقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية، ورفض التدخل الإقليمي في شؤون البلاد. المظاهرات رفعت درجة التوتر لدى حكومة رئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك ليس بسبب توقيتها فحسب، ولكن بسبب مستوى التنظيم الدقيق الذي صاحبها من حيث الحماية الذاتية للمواكب وفاعلية الوحدات الصحية والتأمينية والسياسية والإدارية التي أدت مهامها بكفاءة، الأمر الذي أربك الأجهزة الأمنية وحدّ من هامش المناورة لديها فاكتفت بالمراقبة والمتابعة لاسيما وأنه لم تسجل أي خروقات أو تخريب من جانب المحتجين. ومن الواضح أن تلك المظاهرات لم تكن سوى بداية لا يجب الاستهانة بها كما استهانت حكومة الرئيس البشير بالتظاهرات التي تطورت مع مرور الوقت حتى أطاحت بها وجعلتها جزءاً من التاريخ، وعليه يجب على حكومة حمدوك الانتباه ومعالجة الاختلالات عوضا عن دفن الرؤوس في رمال العقل الباطن الرافض والمكذب لواقع لا يمكن التغاضي عنه وإنكاره، فقد أصدر تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك بيانا غاضبا ألقى فيه باللوم على الشرطة مطالبا إياها بحسم المتظاهرين دون اعتبار لحق التعبير والتظاهر المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية التي تمثل دستوراً مؤقتاً للفترة الانتقالية. ومثلما أخرجت الضائقة الاقتصادية والمعيشية الجموع ضد البشير فقد خرجت تلك التظاهرات بعد فشل حكومة حمدوك في حل الضائقة المعيشية أو على الأقل وقف التدهور المستمر حيث زادت الأوضاع سوءاً على سوء. وفيما طالب المتظاهرون الجيش بالتدخل بدا مستعصما بدور المراقب وتأمين مدخل قيادته العامة بالأسلاك الشائكة ونشر آلياته ومدرعاته، لكن هناك في الأفق يشتد الصراع السياسي بين حكومة حائرة تعوزها البرامج الاقتصادية والاجتماعية وبين شعب ثائر ملّ الوعود والنفاق السياسي النخبوي وهو يتوق لرفع إصر الأغلال المعيشية عن كاهله. لقد مثلت مظاهرات خواتيم الأسبوع المنصرم أكبر تحدٍ لحكومة حمدوك بل لكامل النظام الذي يحكم بعد إسقاط النظام السابق. رغم التأييد غير المسبوق الذي حظي به حمدوك داخلياً وخارجياً، فإن الجماهير لم تمنحه شيكاً على بياض، إذ إن تلك الحفاوة والتأييد كانا مرهونين بالإنجاز في ملف الاقتصاد. وبدلا من أن يقدم حمدوك حلولاً للأزمة الاقتصادية عاد ليضع الكرة في ملعب من وضعوا فيه آمالا عراضا. فكانت فكرة "حملة القومة للسودان" التي طلب فيها حمدوك من الشعب التبرع للحكومة لأجل اجتياز الضائقة الاقتصادية وكانت التظاهرات قد استنكرت هذه الفكرة ضمن الشعارات الغاضبة التي رفعت. ولم تكتف حكومة حمدوك بطلب عون الشعب فحسب بل أقدمت على رفع الدعم السلعي فيما يخص الوقود ورغيف الخبز، في الوقت الذي بلغ فيه سعر الدولار مقابل العملة الوطنية رقماً فلكياً ليصل إلى ضعف سعره في آخر عهد النظام السابق. وكان وزير الطاقة قد عزا تمدد أزمة الوقود نتيجة للأزمة المالية في البلاد والتي وصفها بالسيئة. وقال الوزير إن وزارة المالية والبنك المركزي ليس لديهما احتياطات من العملات الأجنبية، وأضاف إن الخزانة العامة خاوية من النقد الأجنبي، مضيفا إن هناك بواخر محملة بالوقود في الميناء ومن لديه مال يمشي يفرغها. ولعل ما يؤخذ كذلك على حكومة حمدوك إدارتها السيئة لملف قضية المدمرة الأمريكية كول، حيث وعد حمدوك إبان زيارته للولايات المتحدة أسر ضحايا المدمرة بدفع حكومة السودان تعويضات لهم وبذلك أقر بضلوع السودان في تفجير المدمرة كول على السواحل اليمنية رغم أن المحاكم الأمريكية كانت قد برأت السودان من هذه التهمة، وتحدثت تقارير صحفية محلية عن دفع هذه التعويضات من مال مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي المؤسسة المعنية بمعاشات واستحقاقات الموظفين. ويخشى أن يؤدي هذا الأمر لفتح شهية ضحايا سفارتي شرق أفريقيا ونشوء رأي عام في الولايات المتحدة يطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة السودانية اشتراط رفع العقوبات عنها بدفع المزيد من التعويضات. ومعلوم أن السودان لم يخطط ولم يشارك بأي صورة من الصور ولا يتحمل أي مسؤولية تجاه أحداث المدمرة كول والسفارتين في نيروبي ودار السلام. وكانت سياسة الحكومة السابقة أن تتم مفاوضات التسوية مع الحكومة الأمريكية وليس مع أسر الضحايا ومحاميهم وأن تتولى الحكومة الأمريكية بعد ذلك إقناع الأسر بمبالغ التسوية، وتأمين حصانة السودان بإلغاء كافة الدعاوى و الأحكام القضائية الصادرة ضده وقفل الباب أمام قيام أي دعاوى جديدة في المستقبل، كذلك تتم جدولة المبالغ المتفق عليها دون أن يؤثر ذلك على عملية رفع اسم السودان من القائمة أي أن يكون السودان مؤهلًا لرفع اسمه من القائمة بإتمام الاتفاق حول بند التسوية وليس بالضرورة إكمال عملية الدفع. يبدو للمراقب أن حكومة حمدوك الغارقة في وحل الفشل السياسي والاقتصادي قد استنفدت كذلك محاولات إلهاء الناس مثل محاولة اغتيال حمدوك ثم إعلان تحالف الحرية والتغيير عن محاولة انقلاب وشيك يدبره الإسلاميون. فقد غادر فريق الـ(FBI) الأمريكي الخرطوم دون التوصل لأدلة بشأن محاولة الاغتيال المعلن عنها، أما بشأن محاولة الانقلاب فقد نفاها الناطق الرسمي باسم الجيش. [email protected]
4320
| 11 أبريل 2020
تحول وباء فيروس كورونا إلى القضية السياسية والاقتصادية الأولى في العالم، بل القضية المركزية لوسائل الإعلام الدولية. ولعل الوقت ما زال مبكرا لظهور دراسات علمية تقويمية للتعاطي الاعلامي مع جائحة كورونا، بيد أنه من الممكن طرح ملاحظات وابداء تفسيرات لما يجري ويدور بشأن تفاعلات وسائل الإعلام مع هذه الجائحة. ولعل أبرز الملاحظات أن ضخامة الحدث ووقع المصيبة وانتشارها قلبت المسلمات وربما شكلت تحديا للنظريات الإعلامية. فما هو معلوم أنه في عصر ما بعد الحقيقة يبرز الإعلام باعتباره أهم أدوات الصراعات الدولية. ففي هذا العصر، كانت الحقائق الموضوعية تبدو أقل تأثيرا في تشكيل الرأي العام في مقابل الشحن العاطفي وتأثير المعتقدات الشخصية. وعصر ما بعد الحقيقة ظل عصرا يحل فيه الكذب محل الصدق، والعاطفة محل الحقيقة، والتحليل الشخصي محل المعلومة، والرأي الواحد محل الآراء المتعددة. غير أن جائحة كورونا عدلت هذه الصورة المقلوبة وفرضت تعطيلا ولو مؤقتا لواحدة من نظريات الاعلام المهمة. فوفقا لنظرية دوامة الصمت Spiral of Silence Theory، فإن هناك توظيفا سياسيا منفلتا لوسائل الإعلام في إطار هذه النظرية التي تنطلق من فكرة أن وسائل الإعلام تمثل المصدر الأول للمعلومات في المجتمع وتعكس الرأي الشائع أو المُجمع عليه، أي ما يتصوره الناس على أنه "الرأي السائد" في زمن معين تجاه قضية معينة. وتشير مُعطيات هذه النظرية إلى أنه كلما تبنّت وسائل الإعلام اتجاهاً ثابتاً ومتسقاً من إحدى القضايا لبعض الوقت، فإن الرأي العام يتحرك في اتجاه وسائل الإعلام نفسها. أي إن الأهمية الفعلية للحدث لا تضع أجندة وسائل الإعلام بل يتم توجيه الرأي العام ربما قسرا نحو وجهة بعينها تقف من ورائها مصالح سياسية واقتصادية. في شأن كورونا اليوم يبدو أن وسائل الاعلام تستجيب مرغمة لكارثة كورونا على نحو موضوعي، أي إن هذه الكارثة تحدد أجندة الإعلام وليس العكس. فهي مدفوعة وبصورة مطلقة بمدى قوة قضية كورونا، حيث يبدو الأمر خطيرا ومرعبا، بل ومحبطا في آن واحد. وعليه فبإمكان وسائل الإعلام التأثير على القرارات السياسية والاقتصادية، وبالطبع إنقاذ الأرواح ووقف عبث السياسيين وأصحاب المصالح التي تقف حجر عثرة أمام قيام وسائل الاعلام بدور ايجابي يرفع عن المجتمع الدولي إصر هذه الكارثة. لقد كان التركيز في الكوارث السابقة في حال انتفاء النوايا السيئة، على الاحداث الهامشية وابرازها بشكل درامي تشويقي بعيدا عن ابراز واقع الكارثة بنهج كلي وشامل. فعلى سبيل المثال عند تغطية كارثة فيضانات؛ يتصدر المشهد صور درامية لطائرات هليكوبتر تنقل ضحايا إلى أماكن آمنة وقصة امرأة تضع مولودها تحت شجرة في انتظار عمال الانقاذ. اليوم وبكل صراحة نحتاج لتغيير هذا النمط من المعالجات الانصرافية والمساعدة في التركيز على الوقاية وليس العلاج فحسب، من خلال الانذار المبكر والشرح، وعلى الجهود التالية بشأن إعادة البناء والتعافي. الصورة المعدّلة اليوم كشفت لنا من خلالها وسائل الإعلام عن أن الحروب المقبلة ليست حروباً تقليدية عبر إطلاق الصواريخ والمدافع والطائرات الحربية وارتداء الزي العسكري، والاشتباك بالأسلحة عن قرب؛ بل هي حروب بيولوجية بإعمال البحث العلمي والتقنيات الحديثة. فضلا عن الكشف عن وضع الاقتصاد العالمي بالأرقام والتحليلات؛ فالدول التي تعاني أعلى خسائر في التصدير بسبب تداعيات فيروس كورونا هي الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ الخسائر نحو 15.6 مليار دولار، والولايات المتحدة 5.8 مليارات دولار واليابان 5.2 مليارات دولار وكوريا الجنوبية 3.8 مليارات دولار وتايوان 2.7 مليار دولار وفيتنام 2.3 مليار دولار. ووسائل الاعلام اليوم أمام تحدي رغبة المجتمع الدولي - ولا تمثله هنا الحكومات - في تحديد مسؤولية انتشار فيروس كورونا ومدى تقصير وتجاهل الحكومات لوضع أنظمة إنذار مبكر ضد مثل هذه الاخطار. فهذه مجالات تمثل أهمية بالنسبة للصحفيين للبحث والتقصي، لأنها تسهم في جهود منع وقوع مثل هذه الكارثة لاحقا والتخفيف من آثارها بقدر الامكان حال وقوعها في المستقبل. وعلى المؤسسات الاعلامية أن تستشعر الحاجة لضمان وصول المساعدات لمن يستحقونها، وتأتي مساءلة المسؤولين ضمن الاغراض الاساسية لوسائل الإعلام التي تعمل بشكل مهني، مع الاشارة إلى أن زيادة معدلات الكوارث، تستدعي ضرورة التنبّه إلى الاحتياط باعتماد المزيد من الاجراءات من جانب الحكومات للقيام بالانذار المبكر والوقاية، وعليه فإن الحد من مخاطر الكوارث يصبح قضية سياسية ملحة في المستقبل القريب. إن من الحقائق التي تتكشف يوما بعد يوم أن مفهوم الحرية والديمقراطية في النظم الإعلامية المختلفة لا سيما الغربية يبدو ذا طابع جدلي نتيجة لتحديات ومحكات ماثلة، ولذا يبدو النظام الإعلامي الليبرالي من خلال مزاعم المسؤولية الاجتماعية مثاليا لا واقعيا. ويحضرني هنا قول المفكر الأمريكي الراحل إدوارد سعيد في مؤلفه عن "الموضوعية في الإعلام": "إنه من البديهي أن الاتهامات التي وجهت للإعلام الغربي بشأن التغطية الأحادية يمكن أن توجه أيضا للإعلام الأمريكي"، وجوهر حجة إدوارد سعيد أنه على الرغم من العدد الضخم للصحف والمجلات والمحطات التلفزيونية والإذاعية وحرية التعبير، إلا أن الإعلام الأمريكي كله يلتزم بوجهة نظر معينة، وعليه فإن هذه المؤسسات تخدم وتروج لسياسات ورؤى مرتبطة بالشركات الكبرى التي تسيطر على السياسيين، وهذا هو العامل الأساسي الذي يقرر ما الذي يصبح خبرا وكيف يتعين تقديمه.
4782
| 28 مارس 2020
مساحة إعلانية

ليش ما يمديك؟! بينما ممداني زهران، الشاب ذو...
17460
| 11 نوفمبر 2025

العلاقة العضوية بين الحلم الإسرائيلي والحلم الأمريكي تجعل...
10035
| 10 نوفمبر 2025

في عالم تتسابق فيه الدول لجذب رؤوس الأموال...
9717
| 13 نوفمبر 2025

ماذا يعني أن يُفاجأ أولياء أمور بقرار مدارس...
8130
| 11 نوفمبر 2025

على مدى أكثر من ستة عقود، تستثمر الدولة...
4755
| 11 نوفمبر 2025

تستضيف ملاعب أكاديمية أسباير بطولة كأس العالم تحت...
3570
| 11 نوفمبر 2025

تشهد الصالات الرياضية إقبالا متزايدا من الجمهور نظرا...
2139
| 10 نوفمبر 2025

وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام...
1818
| 16 نوفمبر 2025

تحليل نفسي لخطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن...
1662
| 11 نوفمبر 2025

في بيئتنا الإدارية العربية، ما زال الخطأ يُعامَل...
1122
| 12 نوفمبر 2025
يبدو أن البحر المتوسط على موعد جديد مع...
1122
| 12 نوفمبر 2025

يحتلّ برّ الوالدين مكانة سامقة في منظومة القيم...
1050
| 14 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل