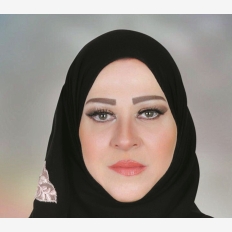رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تناقشتُ أمس «اليوم» مع صديقٍ عزيز أفتخر بمعرفته؛ هو مستشار ومثقف، وبين ثنايا الحديث قال عبارة قصيرة لكنها عميقة: «الحياة رحلة فردية». صمتُّ أمامها، لا لأنني لم أفهمها، بل لأنني شعرت بثقل معناها. توقفت لحظة، وتأملت… كيف يمكن لعبارة بسيطة أن تفتح هذا الكم من الأسئلة داخلنا؟ الحياة رحلة فردية، رحلة لا تشبه أي رحلة أخرى، رغم التشابه الظاهري بين تجارب الناس. قد نسير في الطرق نفسها، ونمر بمحطات متقاربة، لكن كل واحد منا يحمل حقيبته الخاصة؛ تجاربه، أحلامه، مخاوفه، وآلامه. كل إنسان يكتب قصته بنفسه، ولا يمكن لأحد أن يعيشها عنه أو يكمل فصولها بالنيابة عنه. حين تأملت هذه العبارة، شعرت بثقل المسؤولية، لكنها كانت في الوقت نفسه فرصة عظيمة. فرصة لأن أعي أن اختياراتي، وطريقتي في التعامل مع الحياة، هي ما تصنع مساري الحقيقي. يمكن للآخرين أن يشاركوني النصيحة، أن يقترحوا الطريق، أن يحذروني من العثرات، لكن السير… السير لي وحدي. الرحلة الفردية لا تعني الانعزال أو القطيعة مع الآخرين، لكنها تعني تحمّل المسؤولية عن النفس أولًا. تعني أن أتوقف عن مقارنة حياتي بحياة غيري، لأن المقارنة ظلم صريح. نحن لا نرى إلا الواجهة؛ لا نرى الليالي الطويلة من القلق، ولا القرارات الصعبة، ولا الخسارات الصامتة التي سبقت أي نجاح نراه. في هذه الرحلة، أدركت أن الأخطاء ليست عدوًا، بل معلم صادم. كل فشل مررت به كان درسًا قاسيًا أحيانًا، لكنه ضروري. علّمني الصبر، وعلّمني أن النضج لا يأتي سريعًا، وأن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس بسرعة الوصول، بل بالقدرة على الاستمرار رغم التعب والخذلان. هذه الرحلة تدعونا أيضًا إلى الاستماع لأنفسنا بصدق. أن نسأل: ماذا نريد حقًا؟ ماذا يناسبنا نحن، لا ما يُفرض علينا؟ اكتشاف الذات ليس رفاهية، بل ضرورة؛ أن نعرف قدراتنا وحدودنا، نقاط قوتنا وضعفنا، وأن نختار الطريق الذي يمنحنا السلام الداخلي لا التصفيق المؤقت. وفي النهاية، نعم… الحياة رحلة فردية، لكنها ليست رحلة وحيدة. يمكن أن نشارك الآخرين بعض الطريق، نتبادل الدعم، نتعلم من التجارب، نخفف عن بعضنا ثقل المسير. لكن جوهر الرحلة، ومعناها الحقيقي، يبقى في الداخل. الحياة ليست مجرد الوصول إلى هدف، بل هي كل خطوة نخطوها، وكل درس نتعلمه، وكل أثر نتركه خلفنا. وحين ندرك ذلك، نتعلم أن نستمتع بالرحلة نفسها، لا أن نؤجل الحياة حتى نصل.
210
| 25 يناير 2026
للأسف، جميعنا نمرّ بلحظات جميلة في حياتنا، لحظات كان من المفترض أن تترك أثرًا دافئًا في قلوبنا، لكننا كثيرًا ما نمرّ بها مرور العابرين. لا لأن اللحظة لم تكن جميلة، بل لأننا لم نمنحها انتباهنا الكامل، وانشغلنا بتوثيقها أكثر من عيشها. نعيش زمنًا غريبًا؛ نرفع الهاتف قبل أن نرفع رؤوسنا، ونوثّق اللحظة قبل أن نشعر بها، ونلتقط الصورة قبل أن يلتقطنا الإحساس. لم نعد نعيش اللحظة كما هي، بل كما ستبدو على الشاشات. كأن وجودنا الحقيقي مؤجّل، مرتبط بعدسة كاميرا، أو فيديو قصير، أو منشور ننتظر صداه. نخشى أن تمر اللحظة دون أن نُثبتها، وكأنها لا تكتمل إلا إذا شاهدها الآخرون وتفاعلوا معها. كم مرة حضرنا مناسبة جميلة؛ فرحًا، لقاءً عائليًا، أو جلسة بسيطة مع من نحب، لكن عيوننا كانت في الشاشة، وأصابعنا تبحث عن الزاوية الأفضل والإضاءة الأجمل، بينما القلب كان غائبًا عن المشهد؟ نضحك، لكن بوعيٍ ناقص، ونبتسم ونحن نفكر: هل التُقطت الصورة؟ هل وثّقنا اللحظة كما ينبغي؟ نذهب إلى المطعم، أو نسافر إلى مكان انتظرناه طويلًا، فننشغل بالتصوير أكثر من التذوّق، وبالتوثيق أكثر من الدهشة. نرتّب الأطباق لا لنستمتع بطعمها، بل لتبدو جميلة على صفحاتنا، ونصوّر الطريق والمنظر والغرفة، بينما الإحساس الحقيقي يمرّ بجانبنا بصمت. نملأ صفحاتنا بالصور، لكننا نفرّغ اللحظة من معناها، ونغادر المكان وقد وثّقناه جيدًا… دون أن نكون قد عِشناه حقًا. صرنا نعيش الحدث لنُريه للآخرين، لا لنعيشه لأنفسنا. نقيس جمال اللحظة بعدد الإعجابات، وقيمتها بعدد المشاهدات، ونشعر أحيانًا بخيبة إن لم تلقَ ما توقعناه من تفاعل. وكأن اللحظة خذلتنا، لا لأننا لم نشعر بها، بل لأن الآخرين لم يصفّقوا لها كما أردنا. ونسينا أن بعض اللحظات لا تُقاس بالأرقام، بل تُحَسّ في القلب. توثيق اللحظات ليس خطأ، فالذاكرة تخون أحيانًا، والسنوات تمضي، والصورة قد تحفظ ملامح ووجوهًا وأماكن نحب العودة إليها. لكن الخطأ حين تصبح الكاميرا حاجزًا بيننا وبين الشعور، وحين نغادر اللحظة قبل أن نصل إليها، وحين ينشغل عقلنا بالشكل بينما يفوتنا الجوهر. الأجمل أن نعيش أولًا. أن نضحك بعمق دون التفكير كيف ستبدو الضحكة في الصورة، أن نتأمل بصدق دون استعجال، وأن نشعر بكامل حضورنا. ثم – إن شئنا – نلتقط صورة للذكرى، لا أن نختصر الذكرى في صورة. بعض اللحظات خُلقت لتُعاش لا لتُوثّق، لتسكن القلب لا الذاكرة الرقمية. فلنمنح أنفسنا حق الاستمتاع، وحق الغياب المؤقت عن الشاشات، فالعمر ليس ألبوم صور، بل إحساس يتراكم… وإن فات، لا تُعيده ألف صورة.
876
| 13 يناير 2026
وصلتني صورتان؛ تختلفان في المكان، لكنهما تتفقان في المعنى، وتكشفان واقع حياتنا اليوم. الأولى في صالة انتظار بمطار؛ أطفال وكبار، أشخاص من أعمار وثقافات مختلفة، لكن المشهد واحد: الجميع يحمل هاتفًا، والأطفال ممسكون بأجهزة الآيباد، رؤوس منحنية، وعيون غارقة في الشاشات. توقفت عند الصورة طويلًا. لم تكن مجرد لقطة عابرة، بل مرآة صادقة لحياتنا اليومية. مشهد مزدحم بالناس… لكنه فارغ من التواصل. في الماضي، كانت صالات الانتظار مساحة للحديث، لأسئلة الأطفال، لضحكات عفوية، للتعارف، أو حتى للصمت المشترك الذي يحمل دفئًا إنسانيًا. أما اليوم، فنحن ننتظر معًا جسديًا، لكن كلٌّ منا يعيش في عالمه الخاص. المنظر الثاني: مشهدٌ مؤلم… وصادق. نذهب يوم الجمعة للغداء في أحد المطاعم، فنجد كل طاولة تضم عائلة كاملة؛ الأم، الأب، والأبناء… لكن الجميع ممسكون بالهواتف، عيونهم إلى الشاشات، ينتظرون تجهيز الطعام. لا لغة حوار، لا ضحكة مشتركة، لا سؤال حقيقي، فقط صمتٌ رقميّ ثقيل. هنا يتسلّل السؤال بهدوء موجع: لماذا خرجوا من المنزل أصلًا؟ خرجوا بأجسادهم لا بأرواحهم، طلبًا للتغيير، لكنهم حملوا معهم العزلة ذاتها. كأن المكان تغيّر، لكن الغياب بقي واحدًا. الأسرة لا تُقاس بعدد المقاعد حول الطاولة، بل بعمق الحضور الإنساني. وجبة بلا حديث ليست اجتماعًا، وجلوس بلا تواصل ليس دفئًا. الأخطر أن هذين المشهدين يبدوان عاديين، بينما ينحتان فجوة صامتة في العلاقات، خصوصًا مع الأبناء الذين يتعلمون أن الصمت هو اللغة، وأن الشاشة أهم من الوجه. التكنولوجيا لم تدخل حياتنا بهدوء، بل تسللت إلى تفاصيلنا الصغيرة، وسرقت منا لحظات كان يمكن أن تتحول إلى ذكريات. الأطفال في الصورتين ليسوا مختلفين عن غيرهم، يجلسون قرب آبائهم، لكن بلا حوار، يحملون أجهزة تفوق أعمارهم، ويتعلمون مبكرًا أن الترفيه يأتي من شاشة، لا من إنسان. لسنا ضد التكنولوجيا، فهي سلاح ذو حدّين. إن أحسنّا استخدامها، فتحت أبواب المعرفة، وسهّلت التعلم، وقربت البعيد. لكن إن أسأنا استخدامها، عزلتنا عن بعضنا، وأضعفت مهارات التواصل، وسرقت من أطفالنا أهم ما يملكون: الطفولة والتفاعل الإنساني. ما يؤلم في الصورتين ليس وجود الهواتف، بل غياب النظرات، غياب الحديث، وغياب اللحظة المشتركة. كبرنا ونحن نلعب مع بعضنا، نتشاجر ونتصالح، نحكي ونستمع، أما كثير من أطفال اليوم، فيتعلمون الصمت الرقمي قبل أن يتقنوا لغة الحوار. الآن أصبحنا نمنح أبناءنا الأجهزة بدافع الراحة أو لإسكات الملل، وننسى أن كل دقيقة صامتة هي فرصة ضائعة لبناء علاقة، أو تعزيز ثقة، أو زرع قيمة. هاتان الصورتان، للأسف، تعبران عن خسارة: خسارة للتواصل، خسارة للطفولة، وخسارة للإنسان فينا. جمعة واحدة بلا هواتف… قد تعيد للأسرة ما لا تعوضه ألف رسالة. توصيات لاستعادة ما فقدناه: • اجعلوا للتواصل أولوية: خصصوا أوقاتًا خالية من الشاشات ولو قصيرة للحوار الحقيقي. • كونوا قدوة لأطفالكم: فالطفل يقلّد السلوك أكثر من سماع النصائح. • عَلِّموا أبناءكم أن التكنولوجيا وسيلة لا بديلًا: نستخدمها للتعلم، لا للهروب من الواقع. • أعيدوا إحياء اللحظات البسيطة: حديث، لعبة، سؤال، ضحكة… تصنع فرقًا كبيرًا. • تذكروا أن الحضور أهم من الاتصال: التواصل الإنساني لا يُقاس بسرعة الإنترنت، بل بصدق الوجود. أخيرًا… لن نستطيع إلغاء التكنولوجيا، لكننا نستطيع إعادة التوازن، وحماية إنسانيتنا قبل أن تذوب الكلمات والضحكات في صمت الشاشات، وقبل أن تصبح لحظات الحياة الحقيقية مجرد صور مرّت… دون أن نعيشها.
552
| 06 يناير 2026
في الثامن عشر من ديسمبر، يحتفي العالم باليوم العالمي للغة العربية، لغة الضاد، ولغة القرآن الكريم، لغة لم تكن يومًا مجرد وسيلة تواصل، بل وعاء فكر، وهوية أمة، وذاكرة حضارية حيّة تسكن الكلمات قبل أن تُكتب. لكن السؤال الحقيقي الذي يجب أن نواجه به أنفسنا ليس: كيف نحتفل باللغة العربية؟ بل: كيف نعيش بها في بيوتنا، وفي تفاصيل يومنا، وفي قلوب أبنائنا، كل يوم؟ في زمنٍ صارت فيه الكلمات تُكتب بنصفها عربي ونصفها أجنبي، وفي بيوتٍ ينادي فيها الطفل أمه بلهجة ليست له، نسأل بهدوء موجع: هل نخسر لغتنا، أم نتركها تبتعد بصمت؟ العولمة لم تطرق الباب، بل دخلت دون استئذان، من شاشة الهاتف، ومن لعبة إلكترونية، ومن أغنية يحفظها أطفالنا أكثر مما يحفظون نشيدهم الصباحي، ومن مدارس أجنبية صارت هي الخيار الأسهل. لسنا ضد الانفتاح، ولا نخاف من تعلّم اللغات الأخرى، فاللغة جسر لا غنى عنه في عالم مفتوح، لكن الخوف الحقيقي أن نُزيّن الجسر وننسى الجذر. العربية ليست مادة دراسية ولا دفتر واجب، هي صوت الأم حين تحكي، ونبرة الأب حين ينصح، وحكاية الجدة التي تختصر التاريخ في دعاء. لنكن صادقين مع أنفسنا: لغتنا ليست بخير. ولن ينقذها احتفال سنوي، ولا منشور نكتبه مرة ثم ننسى. العولمة لم تسرق لغتنا، بل عرضت خيارات، ونحن اخترنا الأسهل. اخترنا أن نخاطب أبناءنا بلغة هجينة، أن نضحك حين يُخطئون في العربية، ونفخر حين ينطقون كلمة أجنبية. هكذا نُربك الطفل، ثم نلومه حين يعجز عن التعبير، أو يشعر أن لغته أقل قيمة. اللغة ليست حروفًا تُحفظ، بل أداة تفكير، ومن يفكر بلغة ضعيفة، يفكر بوعي مرتبك.الخلل بدأ من البيت، حين ظن بعض الآباء أن العربية صعبة، وأن مخاطبة الطفل بلغة أجنبية تعني وعيًا وتقدمًا. الطفل لا يولد كارهاً للغته، نحن من نزرع ذلك حين نجعل العربية لغة أوامر وتصحيح وعقاب. اللغة التي لا نضحك بها، ولا نُخطئ فيها بأمان، لن يحبها الطفل أبدًا. ثم جاءت المدرسة، بمناهج مثقلة، وقواعد تُلقَّن بلا معنى، ونصوص بعيدة عن حياة الطفل، وتقييم يقيس الحفظ لا الفهم. كيف نطلب من الطفل أن يحب لغة تُقدَّم له كاختبار دائم؟ العربية ليست مادة دراسية، بل هوية معرفية.أما الإعلام، فمسؤوليته لا تقل خطورة، حين يقدّم لغة مكسّرة، ومحتوى سطحيًا، ويُسوّق للغربة اللغوية وكأنها أناقة. العولمة ليست العدو، لكن الخطر حين يتعلّم الطفل لغة العالم قبل أن يُحسن لغة نفسه. ويزداد الخطر على الأطفال ذوي صعوبات التعلّم، وذوي الإعاقات اللغوية، وأطفال التوحد، فاللغة عندهم ليست ترفًا ثقافيًا، بل أمان نفسي، وكل ارتباك لغوي هو ارتباك داخلي.نحمي لغتنا حين نتحدث بها في البيت بلا تكلّف، حين نُعيد الكلمة الخاطئة بحنان، حين نقرأ لأطفالنا قبل النوم، وحين نُشعرهم أن العربية لغة فخر لا لغة عقاب، لغة حكاية لا لغة اختبار. فضفضة أخيرة… اللغة التي لا نعيش بها، لن يعيش بها أبناؤنا. لغتنا قد لا تموت فجأة، لكنها قد تذبل بصمت… وهذا أخطر.
282
| 30 ديسمبر 2025
في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن، الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في القلوب مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة قطر، ونستحضر مسيرة وطنٍ بُني على القيم، والعدل، والإنسان، وكان ولا يزال نموذجًا في احتضان أبنائه جميعًا دون استثناء. فالولاء للوطن ليس شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية ومسؤولية نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر، ليكبروا وهم يشعرون بأن هذا الوطن لهم، وهم له. ويأتي الحديث عن أبنائنا من ذوي الإعاقة تأكيدًا على أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع القطري، لهم الحق الكامل في أن يعيشوا الهوية الوطنية ويفتخروا بانتمائهم، ويشاركوا في بناء وطنهم، كلٌ حسب قدراته وإمكاناته. فالوطن القوي هو الذي يؤمن بأن الاختلاف قوة، وأن التنوع ثراء، وأن الكرامة الإنسانية حق للجميع. إن تنمية الهوية الوطنية لدى الأبناء من ذوي الإعاقة تبدأ من الأسرة، حين نحدثهم عن الوطن بلغة بسيطة قريبة من قلوبهم، نعرّفهم بتاريخ قطر، برموزها، بقيمها، بعَلَمها، وبإنجازاتها، ونُشعرهم بأنهم شركاء في هذا المجد، لا متلقّين للرعاية فقط. فالكلمة الصادقة، والقدوة الحسنة، والاحتفال معهم بالمناسبات الوطنية، كلها أدوات تصنع الانتماء. كما تلعب المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة دورًا محوريًا في تعزيز هذا الانتماء، من خلال أنشطة وطنية دامجة، ومناهج تراعي الفروق الفردية، وبرامج تُشعر الطفل من ذوي الإعاقة أنه حاضر، ومسموع، ومقدَّر. فالدمج الحقيقي لا يقتصر على الصفوف الدراسية، بل يمتد ليشمل الهوية، والمشاركة، والاحتفال بالوطن. ونحن في مركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة نحرص على تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال احتفال وطني كبير نجسّد فيه معاني الانتماء والولاء بصورة عملية وقريبة من قلوبهم. حيث نُشرك أبناءنا في أجواء اليوم الوطني عبر ارتداء الزي القطري التقليدي، وتزيين المكان بأعلام دولة قطر، وتوزيع الأعلام والهدايا التذكارية، بما يعزز شعور الفخر والاعتزاز بالوطن. كما نُحيي رقصة العرضة القطرية (الرزيف) بطريقة تتناسب مع قدرات الأطفال، ونُعرّفهم بالموروث الشعبي من خلال تقديم المأكولات الشعبية القطرية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة وطنية تفاعلية تشجّع المشاركة، وتنمّي روح الانتماء بأسلوب مرح وبسيط. ومن خلال هذه الفعاليات، نؤكد لأبنائنا أن الوطن يعيش في تفاصيلهم اليومية، وأن الاحتفال به ليس مجرد مناسبة، بل شعور يُزرع في القلب ويترجم إلى سلوك وهوية راسخة. ولا يمكن إغفال دور المجتمع والإعلام في تقديم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز نماذج ناجحة ومُلهمة منهم، مما يعزز شعورهم بالفخر بذواتهم وبوطنهم، ويكسر الصور النمطية، ويؤكد أن كل مواطن قادر على العطاء حين تتوفر له الفرصة. وفي اليوم الوطني المجيد، نؤكد أن الولاء للوطن مسؤولية مشتركة، وأن غرس الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا من ذوي الإعاقة هو استثمار في مستقبل أكثر شمولًا وإنسانية. فهؤلاء الأبناء ليسوا على هامش الوطن، بل في قلبه، يحملون الحب ذاته، ويستحقون الفرص ذاتها، ويشاركون في مسيرته كلٌ بطريقته. حفظ الله قطر، قيادةً وشعبًا، وجعلها دائمًا وطنًا يحتضن جميع أبنائه… لكل القدرات، ولكل القلوب التي تنبض بحب الوطن كل عام وقطر بخير دام عزّها، ودام مجدها، ودام قائدها وشعبها فخرًا للأمة.
1176
| 22 ديسمبر 2025
في هذا الزمن الذي ارتفعت فيه الأسعار، وضاقت فيه الأرزاق، صار كثيرون يخلطون بين البخل والشطارة، حتى أصبح البخيل يلبس ثوب الذكاء المالي، ويبرّر شحّه بأنه “حسن تدبير”. تسمعه يقول بثقة: أنا ما أضيع ريالا بلا فايدة، أنا إنسان شاطر! لكن حين تقترب من حياته، تكتشف أن ما يسميه شطارة ليس سوى خوف متخفٍّ، وبخل يختبئ خلف أقنعة المنطق والحذر. البخل والشطارة بينهما شعرة… تلك الشعرة اسمها النية. الشاطر يُمسك ماله بعقل، أما البخيل فيُمسك به بخوف. الأول يرى المال وسيلة للحياة، والثاني يراها الحياة ذاتها. الشاطر يوازن بين الصرف والادخار، أما البخيل فيختصر كل شيء إلى كلمة واحدة: “لا”. لا يشتري، لا يُكرم، لا يُفرح من حوله، حتى نفسه لا يمنحها حقها من الراحة والبهجة. البخل لا يظهر في المال فقط، بل في كل زاوية من زوايا الحياة. البخل في المشاعر حين يُخفي الإنسان محبته خشية أن “يتعلق به الآخر”. البخل في الكلمة الطيبة حين يتردد أن يقول “شكرًا” أو “أحسنتِ” وكأنها تكلّفه ذهبًا. البخل في الوقت حين يبخل على أسرته بلحظات دافئة بحجة الانشغال أو التعب. والبخل في الروح حين يخاف أن يعطي لأن العطاء في نظره نقص، لا فضيلة. أما الشطارة الحقيقية فهي أن تعرف كيف تُنفق دون أن تُسرف، وأن تُمسك دون أن تبخل. أن تشتري ما تحتاجه وتُهدي ما يسعد غيرك، وتستثمر في الخير قبل أن تستثمر في البنوك. الشطارة ليست أن تجمع المال، بل أن تجعل المال يخدمك لا أن تخدمه. هي أن تبني بيتك بالحب، وتُحافظ على بركة رزقك بالرضا، وتتعامل مع النعمة كأمانة، لا كغنيمة. كم من بخيلٍ عاش يجمع ويكدّس، فلما رحل لم يترك إلا أرقامًا جامدة لا دفء فيها. وكم من شاطرٍ عاش معتدلًا، فأنفق بحكمة، فبارك الله في رزقه، وجعل ذكره طيبًا بعد رحيله. المال الذي لا يُسعدك ولا يُسعد من حولك، يتحول عبئًا لا بركة فيه. ومن ظنّ أن البخل يحفظ له ماله، نسي أن البركة وحدها هي التي تحفظ وتُضاعف. الحياة ليست اختبارًا في التوفير فقط، بل في الموازنة بين الأخذ والعطاء. اعرف متى تمسك ومتى تُعطي، ومتى تقول “يكفي” ومتى تقول “يستحق”. فلا تجعل خوفك من الغد يسرق منك متعة اليوم، ولا تجعل الحرص يغلب الكرم في قلبك. الشطارة أن تعرف قيمة المال دون أن تنسى قيمة الإنسان، وأن تُدير أمورك بعقلٍ دون أن تُطفئ حرارة القلب. أما البخل، فهو موت بطيء للروح، وإن كان الجيب ممتلئًا. الفرق بين البخل والشطارة… شعرة، يفصلها النُّبل، وتكشفها المواقف، ويُحددها القلب قبل العقل. من القلب… كلمة ووعي.
426
| 16 ديسمبر 2025
بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، 5 ديسمبر، نحتفل بكل يد ممتدة وعطاء صادق يغير حياة الآخرين. هذا اليوم ليس مجرد تاريخ على التقويم، بل هو تذكير بأن لكل منا القدرة على صنع فرق في المجتمع، سواء بزرع بسمة على وجه طفل محتاج، أو مساعدة مسن، أو حماية بيئتنا. فالتطوع يجعلنا أكثر قربًا من الآخرين، ويمنح حياتنا معنى أعمق، ويؤكد أن السعادة الحقيقية تأتي حين نمنح بلا مقابل. في كل يد تمدّ الخير، وفي كل ابتسامة تُهدى من القلب، يكمن سر كبير للتغيير. العمل التطوعي يمنحنا فرصة لنكون جزءًا من حياة الآخرين، أن نشعر بما يشعرون به ونشاركهم لحظات الفرح والحزن. قد يكون التطوع بسيطًا كزيارة دار للمسنين، أو تعليم طفل محتاج، أو المشاركة في حملة نظافة بالحيّ الذي نعيش فيه، لكنه يحمل أثرًا أكبر مما نتخيل. الأمر الجميل في التطوع أنه يغيّرنا قبل أن يغيّر العالم. ففي كل مرة نمد يدنا للمساعدة، نتعلم الصبر، ونكتسب الإحساس بالمسؤولية، ونكتشف قوة القلب البشري على التضحية والعطاء. إنه شعور يجعلنا أكثر امتنانًا لما نملك، وأكثر تفهمًا لمعاناة الآخرين. والأجمل أن العمل التطوعي يربط القلوب ببعضها البعض. فالشباب، كبار السن، وحتى الأطفال يمكنهم أن يكونوا جزءًا من رحلة العطاء، فتتحول المجتمعات الصغيرة إلى مجتمع كبير نابض بالحب والاهتمام. وكل مبادرة مهما كانت صغيرة، تحمل رسالة تقول: “أنا هنا، أرى، أسمع، وأشارك”. العمل التطوعي.. قيمة وفوائد العمل التطوعي هو القيام بأعمال وخدمات مجتمعية دون انتظار مقابل مادي، بهدف مساعدة الآخرين والمساهمة في تطوير المجتمع. يعتبر التطوع من أسمى صور العطاء، حيث يجمع بين الخير للفرد وللآخرين على حد سواء. أهمية العمل التطوعي: 1. تنمية المهارات الشخصية: تطوير القيادة، التواصل، وتنظيم الوقت. 2. تعزيز الروابط الاجتماعية: بناء علاقات قوية وتعزيز التعاون. 3. المساهمة في تحسين المجتمع: دعم الفئات المحتاجة، مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. 4. تعزيز القيم الإنسانية: غرس قيم العطاء، الرحمة، والتفاني في خدمة الآخرين. مجالات العمل التطوعي: • التعليم: تعليم الأطفال المحتاجين أو تقديم الدروس الخصوصية. • الصحة: المشاركة في حملات التوعية أو مساعدة المرضى. • البيئة: تنظيف الحدائق، التشجير، وحماية الحياة البرية. • الأنشطة الاجتماعية: زيارة دور الأيتام والمسنين، والمشاركة في الفعاليات الخيرية. دور الشباب في التطوع الشباب هم قوة دافعة للعمل التطوعي، يمتلكون الطاقة والحماسة لتقديم المبادرات الجديدة، كما تكسبهم المشاركة خبرة عملية وتزيد وعيهم بحاجات المجتمع. إذاً....العمل التطوعي ليس مجرد نشاط وقت الفراغ، بل هو رسالة إنسانية لبناء مجتمع متعاون. ومن يمارس التطوع يجد نفسه أكثر قربًا من الآخرين وأكثر قدرة على العطاء والالتزام بالقيم الإنسانية.
477
| 08 ديسمبر 2025
اليوم العالمي للإعاقة 3 ديسمبر 2026: من الرعاية إلى الريادة ويتم الاحتفال به سنويًا منذ عام 1992 بهدف دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وهذا العام سيكون شعاري....، كيف نصنع جيلاً يقود لا جيلاً يُقاد؟ اليوم العالمي للإعاقة… لحظة للتفكير هو اليوم الذي نتذكر فيه أننا جميعًا بحاجة إلى من يرى جمالنا قبل احتياجنا. في كل عام نحتفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم هو: هل نريد لهم حياة “جيدة”… أم حياة “عظيمة”؟ لسنوات طويلة ركّزت المجتمعات على الرعاية والخدمات، لكن العالم الآن يتغير. لم يعد التحول الحقيقي في عدد المراكز أو الأجهزة، بل في صناعة الفرص، وفي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أصحاب قرار، مبتكرين، قادة رأي، وروّاد أعمال. حكايات بصمت أحيانًا أجلس مع نفسي وأسأل: هل نحتاج يومًا عالميًا كي نلتفت لقلوب كان يجب أن نلتفت لها كل يوم؟ قلوب تعبر بصمت، وتحب بصمت، وتكبر رغم كل شيء… بصمت. في هذا اليوم، لا أتحدث عن الإعاقة كملف أو قضية أو ورقة عمل. أريد أن أتحدث عنها كحكايات… كوجوه أعرفها… كأيدٍ صغيرة تمسكت بأصابعي وهي تبحث عن طمأنينة، وكعيون كبار رأيت فيها قوة تفوق كل التحديات. الإعاقة لم تعد قضية “عطف”، بل أصبحت قضية ابتكار وتنمية. سر من القلب وفي خضم كل هذا، أسمح لقلبي أن يبوح بسرٍ صغير: 3 ديسمبر بالنسبة لي ليس مجرد يوم عالمي. إنه يوم ميلاد ابنتي دانيا… ملهمتي الأولى، التي علمتني أن القدرة قد تكون أعمق من الكلام، وأن القوة تظهر في أبسط التفاصيل، وأن الاحتواء ليس شعارًا… بل طريقة حياة. وفي اليوم نفسه، وُلد مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكأن القدر أراد أن يخبرني بأن رسالتي لن تكون مجرد مهنة، بل امتدادًا لنبض دانيا… ومسارًا ستقوده كل خطوة قبل أن أدركه أنا. 3 ديسمبر بالنسبة لي… ميلادان: ميلاد روح وميلاد رسالة. القوة والتمكين في هذا اليوم، لا أحتفل بالإنجازات فقط، بل أحتفل بالفكرة التي تغيّر العالم: أن كل إنسان يحمل في داخله قوة… تحتاج فقط من يصدقها. لسنا هنا لنمنحهم صوتًا—فهم يملكون أصواتًا عالية—بل لنمنحهم منبرًا. لسنا هنا لنسير عنهم، بل لنمهد الطريق ليقودوا هم أنفسهم. هناك حقيقة لا نقولها كثيرًا: أقسى إعاقات البشر ليست في الجسد… بل في القلوب التي لا ترى، والعقول التي لا تفهم، والنفوس التي لا تحتضن. الأشخاص ذوو الإعاقة لم يطلبوا يومًا معاملة خاصة، هم فقط يريدون مساحة يتنفسون فيها بكرامتهم. يريدون أن نقابل قدراتهم قبل إعاقاتهم، وأن نسمع أصواتهم قبل أن نتحدث بالنيابة عنهم. الشكر للأمهات والآباء والأخصائيين قلبي يميل إلى الأمهات… إلى تلك التي تخبّئ دمعتها لتستيقظ أقوى، وتبتسم رغم خوفها، وتصبح مدرسة وممرضة ومعلمة حياة في آن واحد. وإلى الآباء… أولئك الذين يخفون تعبهم في الجيب الخلفي للصلابة. وإلى الأخصائيين الذين يزرعون بذورًا صغيرة من الأمل كل يوم، وإلى المراكز التي تحتضن وتعمل جاهدة من أجل التطوير، وإلى المجتمعات التي بدأت—أخيرًا—تفهم أن الدمج ليس بابًا يُفتح… بل قلب يُفتح. يوم للتذكير بأننا بحاجة للتغيير اليوم العالمي للإعاقة ليس يومًا لنذكرهم بما ينقصهم، بل يوم لنتذكر نحن ما ينقصنا نحن: الصبر، والاحترام، والذوق، والرحمة، والإنسانية. هو يوم نسأل فيه أنفسنا: هل نعاملهم كأفراد كاملين؟ هل نسألهم رأيهم؟ هل نعطيهم فرصة؟ هل نصنع لهم طريقًا… أم نكتفي بالكلام؟ الاحتواء أسلوب حياة أكتب وكأن قلبي يقول لي: “أجمل ما في الإعاقة… أنها تكشف أجمل ما في الإنسان.” تكشف الرحمة، والصبر، والقوة، وتُظهر أن النجاح ليس سباقًا بين من يصل أولًا… بل بين من لا يتوقف رغم كل شيء. العالم لا يحتاج مزيدًا من الشعارات، بل يحتاج مزيدًا من الإنسان. الدول تتقدم عندما تنتقل من سؤال: كيف نساعد؟ إلى سؤال: كيف نمكّن؟ وفي قطر… تعلمنا أن الدمج ليس قانونًا يُكتب، بل ثقافة تُمارس، وحياة تُبنى، وفرص تُمنح. وفي اليوم العالمي للإعاقة، نعيد الوعد: لن نصنع مستقبلًا للناس… بل معهم. وفي هذا اليوم… أتعهد لنفسي قبل أن أتعهد للعالم: أن أرى القدرة قبل الإعاقة، والقلب قبل التحدي، والإنسان قبل كل مسمياته. هذا وعد… من قلب يفضفض، ويدرك أن الاحتواء ليس مناسبة… الاحتواء أسلوب حياة.
423
| 03 ديسمبر 2025
هناك أشخاص يرحلون… لكن أثرهم يبقى في الأماكن، وفي تفاصيل الذاكرة، وفي نظرة العيون حين نذكرهم. منذ أن وصلنا خبر وفاة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد بن علي آل ثاني – رحمها الله – خيّم شعور ثقيل على القلب، كأننا فقدنا سندًا كان وجوده يمنح الاطمئنان ويُشعرنا بأن العمل الإنساني ما زال بخير. رحلت امرأة كان الحضور بحد ذاته رسالة، وكانت الابتسامة فعلًا من أفعال الخير، والكلمة منها كانت دعمًا وبابًا يُفتح. الشيخة حصة لم تكن مجرد اسم رسمي أو منصب رفيع؛ كانت روحًا تشتغل بصمت، وتعمل بمحبة، وتمنح وقتها وطاقتها لكل ما يخص الإنسان أينما كان… فهي المبعوث الخاص السابق لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية للإغاثة الإنسانية، حملت هذا التكليف بثقل الأمانة وبصدق المسؤولية، وجعلت من وجودها صوتًا للضعفاء، ويدًا للخير، وواجهة مشرّفة للمرأة القطرية والعربية على السواء. مسيرة من نور عرفناها مبادِرَة، حاضرة، قريبة من كل مشروع يخدم الإنسان. كانت تؤمن بأن العمل الإنساني ليس مجرد واجب وظيفي؛ بل هو رسالة حياة. شاركت في مؤتمرات عربية ودولية، ودفعت بقوة نحو تمكين المجتمعات، ودعم النساء، والدفاع عن حقوق الأطفال، وإغاثة المنكوبين في مناطق الأزمات. لم تكن تتردد في أن تكون في الصفوف الأولى، تبذل وتساند وتدعم. وجودها معنا… كان يكبر به الحدث وأنا شخصيًا… كانت لي معها محطات لن تُنسى. شاركت في عدد من فعالياتي ومؤتمراتي التي نظمتها، وكانت دائمًا بالنسبة لنا أكثر من ضيفة شرف؛ كانت قيمة مضافة، وهيبة هادئة، وكرم حضور يرفع من شأن أي فعالية تشارك فيها. كنتُ كل مرة أراها أدرك أن العمل الإنساني لا يحتاج ضجيجًا… بل يحتاج نفوسًا نادرة مثلها، تترك أثرًا دون أن تبحث عن مجد شخصي أو ظهور. دموعنا يوم رحلت… حين وصل خبر وفاتها… لم يكن مجرد إعلان وفاة. كان خبرًا يمس القلب مباشرة. دمعت عيوننا، ليس فقط لأننا فقدنا شخصية كبيرة، بل لأننا فقدنا إنسانة كانت برحمتها وخلقها وصدقها قريبة منا جميعًا. شعور الفقد لم يكن رسميًا… كان إنسانيًا جدًا. كأن جزءًا من ذاكرة مؤتمراتنا، وضحكات الكواليس، ولقاءات الاستراحة، وكلمات التشجيع التي كانت تقولها لنا… غاب فجأة. رحلت… لكنها تركت لنا إرثًا إنسانيًا تركت لنا درسًا في أن الخير لا يحتاج إعلانًا، وأن المناصب تُصنع قيمتها بما يحمله الإنسان من ضمير، وأن المرأة القطرية قادرة على أن تكون في الصف الأول بكل قوة وثقة واحترام. نحن اليوم نفتقدها، ونفتخر بها، وندعو لها بكل الصدق الذي في قلوبنا: اللهم اغفر لها، وارحمها، واجعل عملها الإنساني شفيعًا لها، وافتح لها أبوابًا من نور لا تُغلق. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجبر كسر قلوب محبيها.
534
| 01 ديسمبر 2025
في زمن أصبحت فيه حياتنا تُرى من خلال شاشات صغيرة، باتت الصورة هي اللغة الأكثر تداولًا، والأسرع وصولًا، والأقوى تأثيرًا. نرى الوجوه، الألوان، اللحظات اللامعة، فنصدق أنها الحقيقة الكاملة. لكن ما يغيب عنا دائمًا هو أن خلف كل صورة… حقيقة بتوجع؛ حقيقة قد لا تُلتقط، ولا تُروى، ولا يرغب صاحبها أن يعرفها أحد. الصورة التي تبدو مشرقة قد تخفي خلفها حياة مزدحمة بالوجع. فالشخص الذي يلتقط صورة وهو يضحك ربما كان قبل دقائق يعيش لحظة انكسار، لكنه اضطر لوضع ابتسامة تحفظه من أسئلة الآخرين. والمرأة التي تظهر في كامل أناقتها قد تكون تخوض معركة صامتة مع خوف لا يهدأ أو تعب نفسي لا يراه أحد. والأسرة التي تبدو مثالية في صورة واحدة قد تكون في الحقيقة تحاول بكل جهد أن تُخفي ألمًا مشتركًا، أو قلقًا عميقًا يهدد تماسكها. العجيب أن الصور غالبًا ليست انعكاسًا لحقيقتنا، بل للنسخة التي نريد أن يراها الآخرون. فالرجل الذي ينشر صورة نجاحه قد مرّ على طريق مليء بالإخفاقات، لكنه لم يصوّر إلا لحظة التتويج. والفتاة التي تبتسم وسط صديقاتها قد تكون أكثر شخص يشعر بالوحدة. وحتى تلك الصور التي تبدو عفوية، كثيرًا ما تُلتقط بعد محاولات عديدة لإخفاء التعب، ومسح الدموع، وضبط زاوية تُظهر شيئًا جميلًا رغم كل ما يؤلم الروح. وأحيانًا، ما يزيد ألمنا أننا نقارن حياتنا الواقعية بكل فوضاها وحزنها بحياة الآخرين المصقولة خلف عدسات الهواتف. نحكم على أنفسنا لأننا لا نعيش «الكمال» الذي نراه أمامنا. ننسى أن الصورة مجرد لحظة، بينما الحقيقة رحلة طويلة مليئة بالتفاصيل التي لا تُظهرها الكاميرا. ننسى أن الصورة تختار ما يُظهر الجمال وتخفي ما يُرهق الروح. وربما أكثر ما يوجع هو أن لا أحد تقريبًا ينشر حقيقة حزنه. فهناك من يلتقط صورة في مكان جميل بينما قلبه مهزوم. هناك من يبتسم في مناسبة وهو يشعر أنه غير مرئي. وهناك من يكتب تعليقًا لطيفًا وهو يتمنى لو أن أحدًا يلتفت إليه ويسأله بصدق: «هل أنت بخير؟». نحن نتقن فن الإخفاء… أكثر بكثير مما نتقن فن البوح. وبين الصورة والحقيقة… قلب يتألم بصمت وسط هذا العالم السريع، تبقى مساحة صغيرة لكنها ثمينة للتعاطف. أن نتذكر أن ما نراه ليس كل شيء، وأن نعامل الناس بلطف لأننا لا نعرف ما يخفونه خلف ابتساماتهم. أن نفهم أن لكل إنسان قصة تستحق الصبر قبل الحكم، وحزنًا يستحق الاحتواء قبل المقارنة. وأن نُدرك أن ما نراه من حياة الآخرين هو مجرد واجهة… والواجهات دائمًا أجمل من الداخل. وفي النهاية، لعل أجمل ما يمكن أن نمنحه لأنفسنا هو أن نتوقف عن تصديق أن الصور هي الحقيقة. أن نسمح لقلوبنا بأن ترى أبعد من الفلاتر، وأعمق من العدسات. أن نفهم أن الجمال الحقيقي لا يحتاج تعديلًا، وأن الألم الحقيقي لا يحتاج إعلانًا. فخلف كل صورة… وجع لا يُرى، وقصة لا تُحكى، وقلب يتمنى لو يُفهَم. فلا تنخدعي بصورة… ولا تقسي على قلبك بمقارنة، فالله وحده يعلم ما تخبئه الأرواح خلف الأطر اللامعة.
456
| 27 نوفمبر 2025
وراء كل نجاح قصةُ حب وإيمان، ووراء كل موهبة لابنٍ من ذوي الإعاقة، أسرة آمنت بقدرته واحتضنت حلمه قبل أن يراه الآخرون. الإبداع لا يولد من فراغ، بل ينمو في بيئة مليئة بالاحتواء والدعم، حيث تُصغي الأسرة لما تقوله الأفعال أكثر مما تسمع من الكلمات. فالميول الفنية لا تُكتشف صدفة، بل تُلاحظ بعين صبورة وقلب مُحب. كثيرًا ما نتساءل: كيف يمكن للأسرة أن تكتشف الميول الفنية لدى أبنائها من ذوي الإعاقة؟ الإجابة تكمن في الملاحظة المستمرة، وفي منح الطفل مساحة حرة ليعبر عن نفسه دون خوف أو تصحيح دائم. نجربتي الشخصية أتذكر حين كانت ابنتي دانية التي وُلدت بإعاقة سمعية عقد تمسك الألوان منذ طفولتها بشغف جميل. كانت تمزجها وتعيد ترتيبها وكأنها تتحدث من خلالها. لاحظتُ أنها تنغمس في الرسم أكثر من اللعب العادي، فشعرت أن في داخلها حسًّا فنيًا خاصًا. تركتُ لها الحرية لتعبر كما تشاء، ثم التحقت بمعلمة متخصصة في الفن التشكيلي ساعدتها على تنمية موهبتها بثبات وثقة. وبعد فترة، اكتشفت ميلها إلى الموسيقى والعزف على البيانو، فبدأت رحلة جديدة مع الإيقاع والأنغام. ومع الوقت، أصبح الفن بالنسبة لها أكثر من مجرد هواية، أصبح لغتها الخاصة للتعبير عن ذاتها، ومتنفّسًا لمشاعرها التي قد لا تقدر على قولها بالكلمات. وانا اقول لكل اسرة: طريق الموهبة ليس سهلًا، فالأسرة التي تحتضن ابنًا مبدعًا من ذوي الإعاقة تواجه تحديات كثيرة: قلة البرامج المتخصصة، وضعف الوعي المجتمعي بأهمية الفن في بناء الشخصية، إضافة إلى النظرة السطحية أو الشفقة التي قد تُطفئ الحماس. وأحيانًا يكون عبء التكاليف أو قلة الفرص للمشاركة في المعارض والدورات عقبة أخرى، لكن رغم كل ذلك، تبقى ابتسامة الابن حين يُبدع أعظم مكافأة، لأنها لحظة يشعر فيها أنه قادر ومقدَّر. رسالتي لكل أسرة رسالتي لكل أسرة: أنتم النور الذي يضيء طريق أبنائكم، والنبض الذي يمنحهم الأمان في عالم مزدحم بالتحديات. امنحوهم الفرصة ليحلموا، وليرسموا، وليعبروا عن أنفسهم بطريقتهم الخاصة. احتفلوا بكل إنجاز مهما كان بسيطًا، فكل خطوة تبني بداخلهم الثقة والإيمان بالذات. لا تمنحوهم شفقة، بل إيمانًا. ولا تنظروا إلى إعاقتهم، بل إلى قدراتهم. فحين يجد ذوو الإعاقة من يقدر موهبتهم، يتحول الفن إلى جسر يربطهم بالمجتمع، ويُثبت أن الاختلاف ليس عائقًا، بل مصدر إلهام وجمال. وتذكروا دائمًا: وراء كل ابن مبدع.. أسرة آمنت به يوم لم يره أحد. فليكن شعارنا جميعًا: نرى القدرات لا الإعاقات.
594
| 18 نوفمبر 2025
تحليل نفسي لخطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية – ٤ نوفمبر في لحظة من لحظات الفخر، تابعتُ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، فوجدت نفسي أتأمل كلماته لا بعين المتخصصة فقط، بل بقلب الإنسان الذي يؤمن أن التنمية ليست مجرد خطط ومؤشرات، بل هي نبض حياة يبدأ من داخلنا نحن. قالها صاحب السمو ببساطة وعمق: «التنمية تبدأ من الإنسان» في كل مرة يتحدث فيها سمو الأمير، نجد أن كلماته لا تقتصر على السياسة أو الاقتصاد، بل تلامس الوجدان الإنساني بصدقٍ واتزان. وها هو اليوم يقدّم خطابًا يحمل بين سطوره روح القيادة الحكيمة، والعقل الهادئ، والقلب الإنساني الذي يشعر بآلام العالم قبل أن ينطق بها. من منظورٍ نفسي، جاء الخطاب مفعمًا بالثقة الهادئة التي تعكس شخصية قيادية تعرف قيمة الإنسان، وتؤمن أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالأرقام فقط، بل بكرامة الإنسان وشعوره بالأمان والعدالة والمساواة. هذه النظرة تجسّد ما يسميه علم النفس بـ «الذكاء العاطفي القيادي» — أي قدرة القائد على الموازنة بين المنطق والعاطفة، بين الرؤية المستقبلية والإحساس بالواقع. في حديثه عن العمل الجماعي والتضامن الدولي، خاطب سموه الضمير العالمي بلغةٍ راقية خالية من الانفعال، لكنها مشبعة بالمسؤولية. فهو لا يدعو إلى تنمية اقتصادية فحسب، بل إلى نمو وجداني عالمي، حيث يصبح التعاون حاجة إنسانية قبل أن يكون سياسية. وهذه اللغة المتزنة تعكس نضجًا نفسيًا ووعيًا بالذات، فالقائد الناضج هو من يسعى للتقريب لا للفرقة، وللإصلاح لا للمكايدة. وفي حديثه عن فلسطين ودارفور، تجلى الجانب الإنساني في أبهى صوره؛ إذ خرجت كلماته من ضميرٍ حيٍّ يرفض الظلم، ويشعر بمعاناة الشعوب قبل أن يتحدث عنها. إنها لحظة يلتقي فيها العقل الحكيم بالقلب الرحيم، في مشهدٍ يجمع بين الحزم والرحمة. أما داخليًا، فقد أبرز الخطاب رؤية قطر الواضحة في الانتقال من «الرعاية إلى التمكين»، وهو توجه نفسي عميق يدل على إيمان القيادة بقدرات الإنسان، ورغبتها في منحه الأدوات لا المعونة فقط — أي تحويل الضعف إلى قوة، والاعتماد إلى استقلال. وهذه، في جوهرها، هي فلسفة النمو الإنساني في علم النفس. وفي ختام الخطاب، حضرت نغمة الأمل بثقةٍ وهدوء، إذ شدد سموه على أن التنمية لا تزدهر في بيئة بلا سلام، وأن السلام لا يقوم إلا على أرض العدالة. إنها كلمات تُعيد الطمأنينة إلى النفوس، وتذكّرنا بأن الإنسان هو محور التنمية لا وسيلتها. من منظور نفسي خالص، كان الخطاب مرآة لقائدٍ ناضج وجدانيًا، مستقرٍ انفعاليًا، ومُلهمٍ إنسانيًا. قائد يستخدم الكلمة كأداة بناء نفسي ومعنوي، لا كبيانٍ سياسي، ويجمع بين الفكر والعاطفة، بين الواقعية والطموح الأخلاقي. هو نموذجٌ للقائد الذي يزرع في النفوس الثقة والأمل بمستقبلٍ أكثر عدلًا وتماسكًا. وأنا أعمل مع ذوي الإعاقة منذ سنوات، وجدت في حديث سموه عن «الانتقال من الرعاية إلى التمكين» رسالة عميقة لكل أسرةٍ ومؤسسةٍ وإنسانٍ يملك قلبًا حيًا: أن التنمية لا تكتمل إن تُرك أحد في الهامش، وأن الإيمان بالقدرات هو بداية كل نهضة. لقد خرجت من سماع الخطاب بشعورٍ عميق بالمسؤولية. شعرت أن التنمية الحقيقية ليست في الأبراج العالية أو المؤتمرات المبهرة، بل في الإنسان الذي يدرك أن وجوده في هذا العالم له معنى ورسالة. فكلما نمّينا إنسانيتنا، ازدهرت أوطاننا. وكلما آمنا بأن الخير يبدأ من الداخل، أصبحنا جميعًا شركاء في بناء عالمٍ أكثر رحمة وعدلًا وسلامًا. «فضفضة قلب… حديث من الوجدان إلى الوجدان»
1800
| 11 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية

في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من...
4524
| 20 يناير 2026

التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم...
756
| 20 يناير 2026

في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف...
732
| 20 يناير 2026

المتأمِّل الفَطِن في المسار العام للسياسة السعودية اليوم...
672
| 21 يناير 2026

برحيل والدي الدكتور والروائي والإعلامي أحمد عبدالملك، فقدت...
657
| 25 يناير 2026

يُعدّ مبدأ العطاء أحد الثوابت الإنسانية التي تقوم...
612
| 22 يناير 2026

لا أكتب هذه السطور بصفتي أكاديميًا، ولا متخصصًا...
531
| 22 يناير 2026

عاش الأكراد والعرب والأتراك في سوريا معًا لأكثر...
513
| 20 يناير 2026

بحكم أنني متقاعدة، وبحكم أكبر أنني ما زلت...
462
| 25 يناير 2026

«التعليم هو حجر الزاوية للتنمية… ولا وجود لأي...
459
| 21 يناير 2026

أضحى العمل التطوعي في دولة قطر جزءاً لا...
447
| 19 يناير 2026

عن البصيرة التي ترى ما لا يُقال! بعض...
435
| 19 يناير 2026
مساحة إعلانية