رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لابد أن جرى على مسامعكم من أحد الفتية أو الفتيات اليوم، أو من خلال ما يسمى بالجيل «زد z” أو بتسمية أخرى الـ» زومرز» Zoomers والذي يمتد ما بين ١٩٩٧ إلى ٢٠١٢. وجاءت التسمية بعد استنفاد جيل الحرف واي Y ، فكان طبيعياً أن تنتقل التسمية إلى الحرف Z زد وهذا هو الجيل الذي يعتبر المواطن الرقمي الأصيل. حيث نشأوا بالكامل في عالم الإنترنت، والهواتف الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي. يتميزون بالسرعة في معالجة المعلومات، والتعبير عن الذات ببراعة عبر المنصات الرقمية، والعملية، كما أنهم الأكثر تنوعاً عرقياً وثقافياً في التاريخ. إن التقسيم الحديث للأجيال هو بالأساس ظاهرة غربية، بدأت مع مطلع القرن العشرين، لكنها اكتسبت شهرتها الواسعة مع تحديد جيل “مولودي الانفجار السكاني Baby “Boomers والذي كان ما بين ١٩٤٦ إلى ١٩٦٤م ولكن من الذي صنف الأجيال بهذه الطريقة؟ يعود تحديد الأمر في القرن العشرين وأتت تسميات الأجيال من الولايات المتحدة، ينسب غالبًا إلى المنظرين «نيل هاو وويليام شتراوس»، من خلال دراستهما “الأجيال” التي نُشرت عام 1991 والتي أطلقا فيها على الجيل الذي خاض الحرب العالمية الثانية اسم “جيل جي آي” (Government Issue). لكن اسم “الجيل الأعظم” شاع بعد إصدار توم بروكاو كتابًا يحمل نفس الاسم. يعتبر ابن خلدون أب علم الاجتماع، وهو اول من صنف وربط الأجيال عبر التاريخ. ولكن تصنيفه ثلاثياً وكان رأسياً، أي ما يعرف «بقاعدة الأجيال الثلاثة» حيث يكون الجيل الأول جيل المؤسسين والقوة «جيل البداوة»، والجيل الثاني جيل بداية الاستقرار والمحافظة « جيل التحضر الأول»، والجيل الثالث جيل الترف والانحلال « جيل الانغماس في التحضر». إن تصنيف ابن خلدون ليس مجرد رؤية تاريخية قديمة، بل هو عدسة لتحليل المجتمعات الحديثة. إنه يذكرنا بأن قوة الأمة لا تُقاس بثروتها المادية أو تطورها التقني فحسب وهو ما قد يراه جيل Z اليوم، بل بقوة الروابط الاجتماعية والأخلاقية التي تربط أفرادها. ولكن دعوني أعزائي القراء؛ نستعرض بعض هذه سمات هذه الأجيال حسب تصنيفها وتسمياتها وأهم ما يميزها. جيل «مولودي الانفجار السكاني» Baby Boomers والذي سُمي بهذا الاسم نتيجة الزيادة الهائلة في المواليد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وهذا الجيل نشأ في فترة ازدهار اقتصادي ورفاه نسبي في الغرب. واما « الجيلX» يمتد تقريباً ما بين ١٩٦٥م وإلى ١٩٨٠م. وكانت التسمية بالأساس فيها من الغموض الذي يبدو مقصوداً ويشير إلى جيل «المجهول» أو «غير مُحدد» الهوية، حيث جاء بعد الازدهار الكبير للجيل الذي سبقه. وقد اكتسبت التسمية شعبية بعد رواية تحمل هذا الاسم. يتميز هذا الجيل بالاعتماد على الذات، والمرونة، والتشكيك في الثوابت وهم أول من عاصروا الثورة الرقمية المبكرة. أما «جيل Y» او ما يسمى بالميلينيالز Millennials» وهو الجيل الحالي الذي اصبح في سن الرشد. ويمتد ما بين الأعوام ١٩٨١ إلى العام ١٩٩٦م. واكثر ما يميز هذا الجيل هو التأقلم الفوري مع التغيير والتقنيات الحديثة والطارئة، ويسعون الى التوازن بين الحياة والعمل، ولهم حس عال بالقضايا الاجتماعية والعالمية. وأما جيل عنوان المقال؛ فلهم تسمية أخرى «الـزومرز Zoomers» وامتدادهم الزمني ما بين ١٩٩٧ إلى العام ٢٠١٢م. فهم يتميزون بالسرعة في معالجة المعلومات، والتعبير عن الذات ببراعة عبر المنصات الرقمية، والعملية، كما أنهم الأكثر تنوعاً في التاريخ. وختاماً الجيل «الفا Alpha Generation» وبدايته من العام ٢٠١٣ وما بعده. وهو أول جيل يتم تسميته باستخدام الأبجدية اليونانية، في إشارة إلى بداية دورة جديدة بعد استنفاد اللاتينية. إنهم أطفال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و«الإنترنت المحيط». وهو الجيل الذي يتوقع له أن يكون الأكثر تعليماً وتأثراً بالتغييرات التي قد تحدث في العالم في المستقبل القريب. في النهاية؛ قد يظن البعض أن مع انتشار الانحلال الأخلاقي بين الناس وحول العالم حتى أصبحت الفطرة السليمة امراً بعيداً مع الانغماس اكثر في العالم المعلوماتي والمرئي. إن الأجيال ستواجه عالماً كارثياً شديد السواد مع ما نسمعه عن ظلال الحروب والقتل والإبادات الجماعية حول العالم. ولكن لم يأت جيل بني إسرائيل المسلم الصالح الذي فتح القدس إلى من بعد تيه قوم موسى بعد أربعين سنة، كما قال تعالى {قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ } المائدة ٢٦.
228
| 23 نوفمبر 2025
في الثامن والعشرين من أبريل المنصرم، ضرب ظلام دامس مدينة مالقا الإسبانية. حيث لا تكاد تسمع إلا زَجِّير الموج على سواحل المدينة المعتم جراء انقطاع الكهرباء، والذي كان انقطاعا هائلا ضرب دولتين من الاتحاد الأوروبي وهما إسبانيا والبرتغال. فكانت الحادثة كأنها ومضة من نهاية العالم. حصل الحادث جراء عطل فني عابر، ولكن النتائج كانت ستكون كارثية. حيث كانت تلك اللحظات من الظلام الدامس والفوضى الشاملة بمثابة لمحة صادمة عن هشاشة وجودنا الرقمي والحضاري. لقد غابت الكهرباء والإنترنت والاتصالات الهاتفية عن الملايين لساعات طويلة، مما أدى إلى شلل المطارات، وتوقف المترو، وتعطيل العمليات الحيوية في المستشفيات التي اعتمدت على مولدات الطوارئ. وشوهدت طوابير الأعداد الهائلة من الناس الساعية لأخذ النقود الممكنة من أجهزة الحاسب الآلي المعطلة، والمتاجر المغلقة وهذا ما يدعى بالهشاشة المتسلسلة؛ أي لمحة من «الانهيار الكبير» الممكن حدوثه بأي مكان في عالمنا المعاصر. إن الذي كشفت عنه الحادثة، يُرجح سببه إلى ظاهرة نادرة الحدوث لـفرط الجهد الكهربائي المتسلسل في الشبكة الأوروبية، وهذا ما يبين مدى اعتمادنا الكلي على شريان حياة واحد، ألا وهو الكهرباء. ففي غياب هذا الشريان، توقفت الحياة المدنية الحديثة. وتحول السفر إلى جحيم على عابري السبيل، وتأجلت عمليات زرع الأعضاء في المستشفيات، والأدهى من ذلك، حدوث وفيات مباشرة وغير مباشرة، بعضها نتيجة الاختناق جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون من المولدات البديلة، وبعضها الآخر بسبب الحرائق الناجمة عن استخدام الشموع. حيث كان شراء الشموع بشكل جنوني بسبب العتمة من السكان في ذلك المكان. إن هذه الكارثة أثبتت أن «نهاية العالم» لا يجب أن تأتي بصورة نيزك أو حرب نووية؛ بل قد تبدأ بـخلل بسيط في البنية التحتية، يتضخم ليتحول إلى «انهيار متسلسل» يطيح بأسس مجتمعنا التكنولوجي. إن العبرة المستخلصة بالنسبة لدولتنا الحبيبة قطر، التي تعد مركزاً حيوياً عالمياً وذات بنية تحتية فائقة الحداثة، فإن درس مالقا يتجاوز حدود الجغرافيا. حيث من الضروري توفر فن إداري لإدارة المخاطر يسمى «بالمرونة الموزعة». حيث يجب أن تعتمد شبكة الطاقة على أكثر من مصدر رئيسي مركزي، مع نظام فصل وحماية متقدم يمنع الانهيار المتسلسل كالذي حصل بمالقا. ويجب أن تكون الأنظمة الحيوية، كالرعاية الصحية والمطارات، مجهزة بمولدات طوارئ لا تعمل فحسب على الكهرباء، بل يتم اختبارها بحلول طاقة ذاتية وبانتظام تحت حمل كامل مستقل. كما أن الأمن السيبراني يعتبر من الأولويات القصوى، بالرغم من أن السبب المبدئي كان فنياً، إلا أن خطر الهجمات السيبرانية على شبكات الكهرباء يبقى تهديداً وجودياً. ويجب على وكالة الأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة أن تحصن البنية التحتية ضد أي اختراق يمكن أن يسبب هكذا كارثة. ونصيحة للجهات الإعلامية والتعليمية بتوعية الجمهور وتجهيز الورش التطبيقية بسبل البقاء والأمن والسلامة، فيجب تفعيل حملات توعية جادة تجهز المواطنين والمقيمين للتعامل مع انقطاعات طويلة الأمد، بدءاً من تخزين المياه والطعام وصولاً إلى الاستخدام الآمن للمصابيح اليدوية بالطاقات البديلة والمولدات لتفادي الحوادث المأساوية التي شهدتها إسبانيا. في النهاية، فإن حادثة مالقا تذكرنا بأننا نعيش في عصر من الوهم والهشاشة العظمى، وإن قوتنا الحقيقية لا تكمن في كمية الطاقة التي ينتجها الإنسان، بل في قدرتنا على التأقلم مع الحياة التي خلقها الخالق سبحانه وتعالى بما يرضيه. وأن العمل لن يتوقف عندما تنتهي هذه الطاقة فجأة، سيكون هناك من يأتي مرة أخرى ليقوم على إصلاح العطل وتعود الحياة لسابق عهدها. وهذه حال حياتنا الدنيا. قال تعالى {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} الحديد ٢٠
447
| 16 نوفمبر 2025
كان يا مكان في زمانٍ ما، ما يسمى بالأسرة الممتدة. والآن أعزائي القراء إذا سألت أحد الأجيال المعاصرة لزماننا فقد لا يعرف لفظة هذا الاسم فضلاً عن معناه، وحتى بعض من مرت عليه اللفظة في منهج علم الاجتماعيات فلا يتذكر! وهو عبارة عن أم وأب وجد وجدة وجد وجدة من الجهة الأخرى، وخالات وأخوال وعم وعمات والتفرعات من أبناء عمومة وأبناء خالة ومثيلاتها من صلة القرابة وهي الأسرة المثالية الصحية والتي تسمى بذلك الاسم. فهي التي كانت تحمي، فإذا ضعف الأب يقوم العم من دون أن يطلب أحد منه ذلك. فإذا ضعفت الأم تفزع الخالة وتقوم أو الخال، فللابن أو الابنة أكثر من ام وأكثر من أب، فآباؤه كلهم أعمامه وعماته، وأخواله وخالاته امهاته. بالإضافة إلى جداته وأجداده. فيكون الطفل محميا من عاقبة الأخطاء. ومع الثورة الصناعية من قبل والثورة المعلوماتية منذ بدء التسعينات من القرن الماضي وحتى ذروتها الآن، فإن حمل هذه العائلة الممتدة أصبح ثقيلا على المجتمع! فإن متطلبات البنى التحتية للحياة الصناعية من الشكل التخطيطي للمدن الحديثة كالمجمعات السكنية والفلل والشقق السكنية. فمن قبل الثورة الصناعية والحالة المعلوماتية لوسائل التواصل الاجتماعي الآن أو ما يحلو لي تسميتها بوسائل التباعد الاجتماعي! والتي أصبحت زوراً وبهتاناً مثالية لاستقلالية أو ما ظهر لاحقاً بمسمى الأسرة النووية من أب وأم وأبناء، بل التي مزقت تلك الأسرة الطيبة الممتدة والتي هي سائدة الآن والتي تشجع وما زالت تشجع تفاقم ظواهر قطيعة الرحم في مجتمعاتنا الآن. فإن تأكيد ديننا الحنيف على الرحم ليست من عبث. فلم ولن تكون تلك المواعظ من أشرف الخلق الا لمصلحة الإنسان وليست من فراغ. فغاية المولى سبحانه ورسوله هي غايات تحفظ الانسان وتحميه وتحمي ذريته من بعده. وذلك بوجود تلك الحصون المنيعة حوله. فكان الأولى الحرص على وجود تلك الأسرة وحمايتها من الانقراض من المجتمع للأبد! ومع ظهور الأسرة النووية، يأتي العم ليتدخل؛ ليُجَاب «بعدم التدخل في شؤون الأسرة إذا سمحت»! فتأتي الخالة لتتدخل؛ فتجاب « أنا أدرى بشؤون أبنائي. فيأتي العم أو الخال في مجلس فيرى أبناء اخته أو أخيه ما يكره من الأدب والأخلاق، فيرمقه بنظرة ليربيه كما كانت في عهود الأسرة الممتدة. فيقوم أخ أو أخت العم أو الخالة ولا يتعنى ليقابل ويتواصل عبر وسائل التواصل فيقول بعبارة خالية من المشاعر؛ «ما هو شأنك في أبنائي! فلا تعقدهم بكلامك الذي لا جدوى منه فأبنائي تربيتهم صالحة، ولا تتدخل في شؤنهم! وبذلك إذا سقط الأب سواءً لفاقة أو دين أو مرض أو موت تيتموا الأبناء بشكل مضاعف. إن من فوائد هذه الأسرة المنيعة ضد كل أنواع الإشكالات الأسرية عند حصول الخلافات الأسرية فإنها تحمي من الشقاق ودمار نواة تلك الأسرة الممتدة الا وهي النووية. حيث قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} ٣٥ النساء وليس الذهاب إلى القضاء عند أدنى خلاف أسري! حيث كانت تلك القلعة الشماء تحافظ على عادات وتراث التقاليد الاجتماعية والدينية في المجتمع من التأثيرات السلبية للعولمة في الثورة المعلوماتية الحالية. كما تتيح الفرصة لتصبح درعًا منيعاً ضد الأمراض النفسية والآثار السلبية لفساد المجتمع أخلاقياً. خلاصة القول؛ يجب علينا وعلى الدولة السعي لإعادة إنشاء الأسرة الممتدة مرة أخرى. فهي تلعب دورا رئيسيا في خضم الحروب العلنية والخبيثة غير العلنية من الفئات غير الإنسانية وضد الفطرة الإنسانية لزعزعة المفاهيم الطبيعية والحقيقية لأصل الخليقة الإنسانية للأسرة. فأكثر المقاصد الشيطانية هي التفريق بين المرء وزوجه سواء عن طريق السحر وغيره من الوسائل. قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناه منه منزلة أعظمه فتنة. رواه مسلم.
411
| 09 نوفمبر 2025
كلنا يرجو العافية من البشر أحبابي القراء، ولكن ما هي العافية؟ فهي تعني الصحة الجسدية والعقلية والنفسية الكاملة، كما تعرف العافية في اللغة، بسلامة الإنسان من الأسقام أي الأمراض والبلايا والآفات، وتتجاوز اصطلاحاً مجرد انعدام المرض لتشمل الرفاهية العامة والنشاط والسعادة. بينما في المفهوم الحديث هي حالة شاملة تشمل جميع جوانب حياة الفرد، مثل الصحة الجسدية، والراحة النفسية، والعلاقات الاجتماعية، والنمو الفكري. وهي من المنظور المعاصر حالة شاملة تتجاوز غياب المرض لتشمل الرفاهية وتحسين نوعية الحياة بشكل عام. في دراستي لمرحلة الأستاذية في مجال إدارة الأعمال، سأل المرشد عن ماهية العافية فذكرت كل ما سبق ولكن مع إضافة الناحية الروحية. وقد فرح بتعريفي وهو من الجنسية الأسكتلندية. وهي بذلك تتكون من الروح والجسد والنفس. فهذه الثلاثية يمكن ان تجد فيها من البحوث ولا تنتهي من ذلك. ولكن يختلف البشر في اثبات الروح. فمنهم من ينفيها ويجعل العافية جزءا من الحالة النفسية والعقلية للإنسان، كالفئات العلمانية التي لا تؤمن بدين، وذلك مع نفي الروح بالكلية. ولكن الديانات المختلفة تختلف في تعريفها لماهية الروح بل وتتطرف بأن تجعل الروح تدخل وتخرج بين الأجساد ما بين الجمادات والحيوانات والنباتات والبشر أيضاً! وذلك عبر العصور كالحضارة الفرعونية والحضارات الآسيوية القديمة. وبل تتجاوز ذلك إلى التجسد اللاهوتي (أي الإله داخل الجسد)؟ ومن الأمثلة الغريبة أن روح الإنسان قد تدخل في فراشة بعد موته! ولكننا في مقالي لن نتطرق لمفهوم الروح في العقائد والديانات الأخرى، بل سوف نتقيد بمفهوم العافية في ديننا الإسلامي الحنيف. قال تعالى: {ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} (٨٥) الإسراء فالروح مرتبطة بأمر الخالق، وهي من علمه ومن أمره. وهي التي تجعل الجسد والنفس يمتلآن بالحياة. وهي ليست الجسد ولا النفس. وهي بالتالي ليست مرتبطة باختيار الإنسان. وهي مرتبطة بالأمر الغيبي وليس المشاهد. ولكن الروح هي المكملة لحياة الجسد الذي هو من ماء وطين، وبدونه لا جدوى منه وهي أحد أضلاع العافية. واما ارتباط النفس بالروح أنها جزء لا يتجزأ من الروح. وهذه أضلاع العافية الأخرى. ولكن كيف يصل الإنسان إلى كمال العافية؟ فهذا السؤال كل البشر يصبون لها ولكنهم متفاوتون في السعي لها، وقد يظنون أنهم قد وصلوا لها ولكنهم قد يكونون في وهم عظيم! إن هذا الجسد والنفس هي امانة من عند الله سبحانه، ويجب على الإنسان الأخذ على عاتقه أن يصون هذه الأمانة. فإن للنفس والبدن حقاً على الله. تجد في ظاهرة مرضية تُعرّف بـ «كاروشي» وهي الموت بالإرهاق! وتنجم من ضغط العمل الطويل مما يسبب سكتات قلبية ودماغية، بالإضافة إلى حالات نفسية مؤدية إلى الانتحار بسبب ساعات العمل الطويلة والضغط الكبير. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو وقد بلغه أنه يقوم الليل كله، ويصوم الدهر كله، ويختم القرآن في كل ليلة فقال: فلا تفعل، قم ونم، وصم وأَفطِر، فإنَّ لِجَسَدك عَليْك حَقًّا، وإنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وإنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وإنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . هناك مفهوم «التوازن بين العمل والحياة» والذي ظهر في عام ١٨١٧ من خلال روبرت أوين والذي دعا إلى ثماني ساعات من العمل وثماني ساعات من الترفيه. والذي يفصل بين العمل والحياة الشخصية للإنسان. وهو مفهوم يعني توزيع طاقتك بشكل متساوٍ بين جوانبها المختلفة مثل العمل، العلاقات، الصحة الجسدية والعقلية، والهوايات، لتحقيق الاستقرار النفسي والإنتاجية. وختاماً أعزائي فإن «العقل السليم في الجسم السليم» كما يقول المثل. فيجب أن يوازن الإنسان بين الاعتناء بالجسد من حيث الرياضة البدنية «فالوقاية خيرٌ من العلاج» والعقل غذاؤه العلم بالقراءة وطلب العلم المستمر. «فالعلم من المهد إلى اللحد». والعبادة والقرآن هي غذاء النفس والروح. وبذلك تتم العافية حيث يجب أن يوازن الإنسان في يومه بالحقوق وأن يبذل اقصى جهده بأن يوازن بين العمل وحقوق نفسه وأهله وكذلك العبادة. ويمكن ذلك بالانضباط في كل ذلك حتى يصل إلى كمال العافية. حيث كل حياة الإنسان عبادة وخير العبادة (أدومها وإن قل) رواه البخاري.
603
| 02 نوفمبر 2025
عزيزي القارئ لا تخف من العنوان واطمئن. فلست أتحدث عن أعياد الهالووين الوثنية والتي تحدث مع نهاية كل شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وترى وجه اليقطين المخروق والمحشو بإضاءة الشموع والذي من المفترض أن يكون مُخيفاً للأطفال. وتراهم في أزيائهم التنكرية ذات الطابع المخيف. وذلك في بعض الدول التي يطوفون فيها لأخذ الحلويات، وهو طقس من الثقافة الإيرلندية انتقل إلى الولايات المتحدة ليتم انتشاره بين العالم بقدرة الآلة الإعلامية الأمريكية الضخمة. ولكن ما هو هذا الأمر الذي يحدث في الماضي والحاضر والمستقبل، أي إنه أمر اعتيادي لا يدعو للقلق والتوتر. وانما هو الهدف الرئيسي لمسوقِّيه! فتسويق الخوف إستراتيجية تستخدم لإثارة مشاعر التوتر والقلق بين الناس، وذلك للتأثير على قراراتهم، وجعلهم يتخذون قرارات محددة، مثل شراء المنتجات أو الخدمات، أو حتى تغيير السلوكيات لأسباب معينة ومقصودة وعادةً ما تكون متعلقة بأمور مصيرية. في كل حقبة زمنية تجد أشخاصا من الناس في هذا العالم الذي نعيش فيه، يقومون بنشر النبوءات المغلوطة دون تحقق من مصداقيتها، والتي تتحول إلى شائعات تنتشر بين الآفاق. ففي نهاية الألفية الأولى الميلادية انتشرت مخاوف بين الأوساط النصرانية الأوربية بقرب حدوث يوم القيامة! وقد حدثت أحداث مماثلة مع نهاية الألفية الثانية. وكذلك في عام ٢٠١٢م عندما فسرت خرافة عن قرب نهاية العالم بناءً على دراسة لتقويم حضارة المايا القديمة. أو حتى تسويق الخوف من خلال نبوءات كالتي كانت عن ٢٠٢٢م بنهاية الكيان! والتي لم تحدث في نهاية المطاف. من مقاصد تسويق الخوف في العالم الأسباب الاقتصادية، فترى بعض شركات الأسهم حول العالم تبث شائعات الخوف بين المساهمين بناءً على دراسات بحثية مختلفة، وذلك وفق العوامل المؤثرة في سوق الأسهم. فقصة شراء عائلة «روتشيلد» للأسهم في إنجلترا ترتبط بشكل أساسي بحرب «نابليون» ومعركة «واترلو»، حيث استغل «ناثان ماير روتشيلد» نفوذه وسمعته المالية لتغيير مسار سوق السندات البريطانية. في عام 1815، وتسربت له الأنباء عن انتصار بريطانيا في واترلو قبل الإعلان الرسمي، فبدأ في بيع السندات. عندما تبعته السوق في هذا البيع وأدت إلى انهيار الأسعار، فقام بشراء جميع السندات بأسعار منخفضة للغاية، ليحقق ربحًا هائلاً بعد تأكيد النصر البريطاني وارتفاع الأسعار مرة أخرى، مما رسخ سيطرته على السوق المالية في لندن! ومن ضمن المظاهر الأخرى لتسويق الخوف الظاهرة المعروفة بـ»فوموFOMO»، وهي خلق شعور نفسي بالإلحاح بالشيء، من خلال كلمات إعلانية مثل «سارع قبل فوات الأوان» أو «الكمية محدودة» لاستغلال الخوف من ضياع الفرصة. وهي عادة تكون في المنتجات التي تتناول جميع الفئات الاستهلاكية بالسوق. وذلك من خلال عرض البضائع أو الخدمات على أنها الحل الوحيد للتخلص من التهديدات أو المخاطر التي يتم تسليط الضوء عليها من قبل المتحكمين والنافذين في الأسواق الاقتصادية. دائماً عند الكوارث والأزمات كالحروب والزلازل والأعاصير والجائحات المرضية والانهيارات الاقتصادية يكثر تسويق الخوف بين الناس، ولكن من يقود الأمر ووقوده هم الناس بأنفسهم! حيث يصدقون هذه الحملات الإعلانية والتسويقية عبر وسائل الإعلام المختلفة. وخصوصاً بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان. ولكن الأمر سهل عند الانتباه له، وعدم الانسياق وراء تلك الحملات المزيفة أيا كان شكلها ومظاهرها. وذلك من خلال التفريق بين ما هو حقيقي ووهم كاذب. فعندنا حواس وعقول للتفريق بين الغث والسمين. فيجب علينا أن نكون منتبهين لكل ما يعرض علينا عبر تلك الوسائل ونغربلها غربلة حكيمة وواعية دون جزع أو خوف. فعندنا من الحكمة الكثير في كتاب ربنا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لستُ بالخبُ، ولا الخبُ يخدعني». قال تعالى { قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} التوبة ٥١.
363
| 26 أكتوبر 2025
إنها ليست ألعاب الخفة، ولا ألعاب السحر أعزائي القراء. إنما هو مصطلح اقتصادي، كنت أتساءل في مرحلة دراستي لمادة الاقتصاد عن ماهية اليد الخفية؟ حيث إنه اسم غريب يثير الريبة لمن يسمعه للوهلة الأولى. أول من أطلق هذا المصطلح هو الاقتصادي «آدم سمث». والذي عرف المصطلح على انه سعي الأفراد لتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة في اقتصاد السوق، والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمع ككل بحسب رأيه. تتجسد هذه النظرية في آلية عمل العرض والطلب التي تنظم الأسعار وتوزع الموارد بكفاءة، حيث يدفع المنافسة بين المنتجين لتقديم منتجات أفضل وبأسعار أقل، مما يفيد المستهلكين وينمي الاقتصاد. فيما رأى «جون ماينارد كينز» أن فكرة «اليد الخفية» لا تضمن تحقيق التوظيف الكامل، خاصة خلال فترات الركود الاقتصادي كما يحدث في عالمنا اليوم، وذلك بسبب ما أسماه بـ «نقص الطلب الكلي» يدعو كنيز إلى تدخل الدولة في الاقتصاد لتحفيز الإنفاق، وتوفير فرص العمل، والحد من البطالة من خلال سياسات مثل الاستثمار الحكومي وتخفيض الضرائب وتوفير شبكات للأمان اجتماعي. ولكن هل في عالم العولمة والتي تحوم حوله أشباح الحرب العالمية الثالثة من خلال النزاعات المسلحة المتواصلة من خلال سياسة الدول الكبرى، والحروب الاقتصادية والعقوبات الدولية على الدول الكبرى والمتوسطة والصغرى من رسوم جمركية مجحفة ومنع مسيس للمنتجات الحيوية بين الدول بسبب المواقف السياسية والتحالفات الدولية المتغيرة، هل ما زال يمكن لليد الخفية أن تلعب دورها، أو هي أساس المشكلة؟ في سنة ١٩٤٤ ميلادي جرى مؤتمر عالمي تمخض عنه اتفاقية «بريتون وودز» والتي صنعت المال في عصرنا الحديث. حيث أعادت بناء الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تم من خلاله إنشاء نظام النقد العالمي الجديد. والذي ربط معظم عملات العالم بالدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ربط الدولار نفسه بالذهب بسعر ثابت هو (٣٥ للأوقية)، مما جعل الدولار عملة الاحتياط الرئيسية في العالم. والذي نتج عن هذا الاتفاق إنشاء مؤسستين ماليتين عالميتين: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن خلال هذا الاتفاق منع تداول الذهب كعملة في أي سوق بعد إذ كان! وأصبح لزاما على كل الدول في العالم والتي وافقت على هذا الاتفاق ارسال ذهبها الوطني الى الولايات المتحدة الامريكية، وذلك في خزائن البنك الفدرالي. ما عدا الرئيس الفرنسي «شاردي غول» والذي عارض الاتفاقية، معتبرًا أن اعتماد نظامها على الدولار الأمريكي خلق ميزة غير عادلة للولايات المتحدة رأى ديغول أن النظام يمنح أمريكا القدرة على الاقتراض بسهولة من دول أخرى من خلال طباعة الدولارات، واقترح أن التجارة يجب أن تستند إلى الذهب لأنه عملة ذات قيمة ثابتة ولا تخضع لعملة دولة واحدة. ونتيجة لذلك، بدأت فرنسا في استبدال دولاراتها بالذهب، مما يمثل تحديًا مباشرًا للنظام. مطالبة الولايات المتحدة بتسليم احتياطاتها من الذهب مقابل الدولار في البنك المركزي الفرنسي، مما ساهم في الضغط على النظام وأضعفه لاحقًا. حيث انهار هذا النظام في عام ١٩٧١م عند اعلان الرئيس الأمريكي « ريتشارد نيكسون» انهاء هذا النظام للأبد، والذي سمي بـ “صدمة نيكسون» أو « إغلاق نافذة الذهب». ختاماً؛ إن كثرة الأيادي الخفية والعوامل الاقتصادية والسياسية كالتي عصفت بالنمور الآسيوية في عام ١٩٩٧م، قد تعصف بالعالم ككل ولكن بشكل طبيعي تلقائي بسبب التدافع الحضاري. حيث شاع تورط «المضارب اليهودي» جورج سوروس» بشكل مباشر في الأزمة، بعد أن ضارب على بعض العملات الآسيوية، خاصة وأن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا اتهمه بذلك. أما اليوم، فإنك ترى تدافع الناس على شراء الذهب لمن يستطيع بشكل ملحوظ بسبب القلق العالمي. مما أدى إلى اعلان الصين المرشح الاقتصادي العالمي بامتياز لخلافة الولايات المتحدة الى الإعلان عن براءة اختراع لسبيكة ذهبية عيار ٩٩.٩. وتجد الولايات المتحدة بالمقابل تحاول تغيير سعر الذهب الثابت في دفاترها لموازنة الدين العام. كل ذلك الجنون الاقتصادي المتحارب يدعوني لأدعوكم في التفكر، وخصوصاً أن نحو ٧٠٠ مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع. والذي يمثل حوالي ٨.٥.% من سكان العالم. وفي المقابل، تتركز الثروة بيد خفية بنسبة ١ % من البالغين أي حوالي ٥٠% من الثروة العالمية، بينما يمتلك ١٠% حوالي ٨٥% من الثروة. فهل الحل فيما يحدث أم في قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}.
351
| 19 أكتوبر 2025
هل نَستَمِعُ حقاً للحديث أم ننتظر حتى ينتهي الآخر منه؟! هناك دائماً ثلاثية للاتصال والتواصل بغض النظر عن المكان أو نوع المنبر الذي تستمع منه، فلن يكون حديثٌ إلا برسالة ما بين مُلقِي ومُتَلقِي. ويستطيع الإنسان استغلال عضوه المخصص للاستماع بالكفاءة اللازمة للتعقل والتفكر والتدبر والتفقه والتحصيل، ألا وهو الأُذن. ولكن ما هو الفرق بين الاستماع والإنصات يا ترى؟ هناك أربع مفردات لغوية أعزائي القراء يجب التعرف عليها قبل التعرف على خماسية فن الإنصات، وهي السمع والاستماع والإنصات والإصغاء. والسمع هو أحد الحواس الخمس المسؤول عنها الإنسان، وهي اللفظة التي تعني عموم معنى اللفظ. وأما الاستماع فهو السمع مع إدراك المسموع والزيادة في شدة الانتباه مع قوة التركيز. ومن ثم فإن معنى الإنصات يأتي من خلال الاستماع مع السكوت، أي اقتران الاستماع بالإنصات كما في قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف 204. وأخيراً وليس آخراً فإن المرادف الرابع هو الإصغاء، أي الميل بسمع الشخص نحوه. وينقسم المعنى إلى شقين؛ فإذا مال الإنسان بسمعه فقط فقد أوعى سمعه بعقله، وإذا مال بقلبه فقد أصغى قلبه وهي الرغبة نحو الاستماع. وقد يحصلان كلاهما معاً. وقد يدخل القلب والفؤاد في الإصغاء ولكن الأعجب هو أن العقل يغيب عن الإصغاء في بعض الأحيان بالرغم من حضور القلب! فالمستوى الأول من فنون الإنصات وعادة ما يكون بين الخصوم أو الآراء المتجادلة، ويكون التركيز ذاتياً. فيكون الإلقاء بعد انتظار الحديث. وتراه واضحاً في المناظرات العلمية عند مناقشة بعض جزئيات الدراسات العليا أو المناظرات السياسية التي تراه في الإعلام أو بين المفاوضين الدبلوماسيين أو بين مساومات التجار في الأسواق الاقتصادية المختلفة. فأنت تنتظر فقط لأنك تفكر في الذي سوف تقوله لاحقاً. وهدفك المجادلة لإفْحام حجة المقابل بحق أو بدون وجه حق. وأما المستوى الثاني فالاستماع للكلمات ولكن مع التشتت. فتلتقط جزءًا من المحادثة، لكن انتباهك قد ينحرف. وهو غياب القلب عن الإصغاء كما بيناه. ويحدث ذلك عند الاستماع للخطيب من خلال منابر أو عند الحضور والاستماع لدروس العلم عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية من خلال شاشات الأجهزة المختلفة. ويحصل التشتت أيضاً لكثرة استخدام تلك الوسائل، مما يؤثر على كفاءة العقل بالتحصيل ويسبب سلبية الشعور اتجاه المتحدث والجهد والمرض. ولكن قد يكون إيجابيا إذا كان القصد هادفاً عند الحوار مع المقابل لقصد نبيل سامٍ كدعوة للحق والسلام. والبحث وغربلة الحديث في الذهن عما هو حق وترك ما هو باطل. وفي المستوى الثالث يكون فقه الرسالة، فكل حديث هو خطاب للمتلقي. والتركيز فيه لازم لعمق فهم المخاطب. حيث لا تسمع الكلمات فحسب، بل ما تعنيها. وأنت تستمع للفهم وليس للرد. وذلك يكون عند المحاضرات الأكاديمية والتدريبية أو الاستماع للمسؤولين وولاة الأمر. وفي المستوى الرابع يضاف إليه مستوى التعرف على المشاعر من وراء الحديث. أي التعاطف مع المتحدث، لتذهب أعمق، وتشعر بحالة مشاعرهم وتدرك كيف يشعرون وليس فقط ما يقولونه. ويكون غالباً المتحدث يعيش الواقع المأساوي. ومثال ذلك عندما ترى من يتحدث من أماكن النكبات كحال قطاع غزة. وختاماً فإن المستوى الخامس لفنون الإنصات، هو سماع ما لم يُقَل من خلال الحديث. أي تصل من خلال المتحدث عبر الحضور الكامل بالمستويات السابقة المذكورة، لتلتقط المعنى الأعمق للأشياء التي يكافح الخطيب للتعبير عنها ومما يحتاج المتلقون إلى سماعه ولم يذكر. أي بتعبير آخر استنتاج النوايا والمقاصد والمضمون من وراء الحديث. فكثير من الحديث في جميع الآفاق هو من اللغو أي الحديث الذي لا فائدة منه أو من الكذب. فلا يطلب منك أن ترعيه كامل إنصاتك. وكثير من الناس يتحدث في ما يعنيه وما لا يعنيه. ولكن الواجب علينا أن نقولَ (خيراً أو لنصمت) رواه مسلم.
270
| 12 أكتوبر 2025
شكرا لكل العاملين في شتى مجالات تنمية الإنسان في دولتي الحبيبة قطر. وشكراً سمو الأمير الذي يستحق أن يشكره كل إنسان في هذا العالم عموماً، وخصوصاً الجهود التي تبذل لمنع استمرار سفك الدم الفلسطيني. إنه لأمر يدعو للفخر حقاً. إن من المهم الاستثمار في الانسان قبل البناء. كيف يحلو لمحللي السياسة التعجل بالحديث عن الاعمار دون ضمان الحاجات الأساسية للإنسان؟! إنه للعجب العجاب. وكأن الإنسان حاله حال الموارد التي يمكن استغلالها والتجارة فيها كما يحلو لهم، أو ليس للإنسان كرامة. لذا ابديت تحفظي على لفظة الموارد البشرية في مقالٍ سابق بالرغم من أنه في مجال خبرتي الإدارية السابقة. إن توفر الحاجات الأساسية للإنسان لهو أولى الأولويات من هواء وماء وغذاء وآمن، ومن ثم يأتي السكن. فكيف يتم الحديث عن إعمار غزة قبل ضمان هذه الأساسيات! يضع مان فريد ماكس الاحتياجات الإنسانية الأساسية وفقا لمدرسة «تنمية المقياس البشري» وغيره « كأنطونيو إليزا دي ومارتن هوبنهاين»، اعتبار الوجودية ناجمة من حالة خلقه كإنسان وهي مقاييس قليلة، بل محدودة وقابلة للتصنيف (والتي تتميز عن المفهوم التقليدي للحاجات الاقتصادية التقليدية)، وهي غير محصورة وجشعة في مقابل المنظور الإيماني الديني. ولكنها ثابتة لجميع الثقافات البشرية وعبر فترات زمنية تاريخية متفاوتة. والتي قد تتغير عبر الزمن وبين الثقافات المختلفة وهي الاستراتيجيات التي من خلالها تُشبَع هذه الاحتياجات. من المهم أن تفهم عزيزي القارئ أن احتياجات الإنسان كنظام مترابط ومتفاعل. وفي هذه الحالة، لا يوجد تسلسل هرمي للاحتياجات، وبصرف النظر عن أولوية الحاجات الأساسية لمعيشة الإنسان أو البقاء على قيد الحياة، فإن افتراض علماء النفس الغربيين «كاماسلو»، يجعل حدوداً، مثال التزامن والتكامل والمبادلات وهي من أبرز ملامح عملية تلبية الاحتياجات. ولكن تبقى حقيقة استغلال تلك الإستراتيجيات من قبل الدول لدمار الإنسان. فهذه الحاجات والعجز بتلبيتها عن طريق عوامل القهر كالحروب والصراعات التي تواجه الدول المنكوبة، لهو أمر واقعيٌ قاسٍ لا يمكن معالجته بتلك النظريات فحسب. إن الاستثمار في الإنسان يجب أن يكون قبل البنيان في منطقة كمنطقة قطاع غزة. لذا رأيت مبادرة أسطول الصمود لكسر الحصار الجائر على إخواننا المنكوبين في قطاع غزة من جميع الفئات حول العالم وكثير منهم من المشاهير العالميين لهو أمر يدعو للتفاؤل. فبعضهم باع ما يملك لشعوره الإنساني البحت ويشارك مع هذه المبادرة. فكيف يكون هناك كرامة وشرف وإنسانية لمن يتحدث عن إعادة الإعمار قبل إعادة إعمار الإنسان؟ إن ما يحدث هو مثال حي للاستغلال السياسي المحض للإنسان من قبل الكيان. وهو يستخدم الأساليب السياسية الدولية وقواعد الترهيب بهدف تعظيم وترسيخ مبدأ الشرعية الدولية وفرض الهيمنة على المجتمع الإنساني داخل القطاع، والذي يغلب على سكانه نكبة الحرب والدمار والنزوح والجوع الذي يستغله النظام السياسي الصهيوني لتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية غير المشروعة بمنتهى التوحش واللاإنسانية. في نهاية المطاف نرى بارقة الأمل قريبا للفرج الذي نتمنى أن يدوم على أعزائنا المنكوبين في قطاع غزة. فيجب على الأمة التكاتف والتناصر وبذل الجهد ولو بالقليل وإن كان بالدعاء لنصرة المظلومين هناك. مصداقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّىّّ) رواه مسلم.
354
| 05 أكتوبر 2025
أُنّشِئت الأمم المتحدة في العام ١٩٤٥م بعد الحرب العالمية الثانية، وهي فكرة طرحت أول مرة للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط ١٧٩٥م. وذلك للسيطرة على الصراع وتعزيز السلام الدولي. هل تعلم عزيزي القارئ أن الأمم المتحدة كانت تعرف فيما سبق بمسمى آخر وهو «عصبة الأمم» بعد الحرب العالمية الأولى، وكان مقرها في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري وذلك لاستغلال الدولة السويسرية مكانة الحياد بين الدول المتصارعة، وتتكون المنظمة من تلك الدول المنتصرة في الحرب وهي إنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان. وهي المنظمة التي اتخذت قراراً دولياً في عام ١٩٢١م يُشَرّع للحكومة البريطانية الانتداب على الأراضي الفلسطينية. والذي أعطى الولاية الدولية بإقامة وطن قومي لليهود في ذلك الوقت. وهو الوعد الذي سهل لعرابيه ومهندسيه كتابة بنود قرار إنشاء الكيان وهما اليهوديان «روتشيلد» و «وايزمان». وهو الامر الجلي الذي بَيّن انحياز منظمة عصبة الأمم إلى الحركة الصهيونية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعامين، وتحديداً في العام ١٩٤٨م تم الاعتراف بالكيان الصهيوني. ولكن العجيب في الأمر أن ما يسمى دولة إسرائيل نشأت بقرار من المنظمة نفسها، وهو القرار الوحيد في تاريخ المؤسسات الدولية لحصول هكذا حدث! بل والأعجب والأمر من ذلك؛ أن الكيان هو أكثر دولة حصولاً للفيتو « أي حق النقض أو منع إجراء القرار». والذي منع أي قرار يدينه إن كان للأمر فائدة من ذلك. فكما كانت عصبة الأمم تتكون من الدول المنتصرة في الحرب فإن مجلس الأمن يتكون من الأعضاء الدائمين وهي الدول المنتصرة في الحرب وهي الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي (يعرف فيما سبق بالاتحاد السوفيتي)، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين. وهي الدول الوحيدة صاحبة حق النقض أيضاً. فها هو التاريخ يعيد نفسه، ولكن يبقى السؤال عن ماهية أسباب إنشاء المنظمة هل من أجل السلم أو السيطرة الدولية لتلك الدول على الدول الأقل حجماً من حيث النفوذ والسلطة والسطوة وهو سؤال يدعو للتفكر. فإن حقيقة الأمر الذي سهل سلب الحقوق العربية عموماً والفلسطينية خاصة، هو الأمر الذي يجعل وَهْم عدم إغضاب الرأي العام العالمي، غاية من الخيال لا يمكن تحقيقها إلا بالخضوع لهيمنة الكيان والمصالح الاستعمارية للدول الكبرى في مجلس الأمن كالمملكة المتحدة صاحبة وعد بلفور (صاحب وعد إنشاء وطن قومي لليهود) والولايات المتحدة وريث الإمبراطورية البريطانية التي سهلت وباركت حصول هذا الأمر وما زالت. فهل أصبح حال العالم مع المنظمة، حال الغارق المتمسك بقشة! تعتمد منظمة الأمم المتحدة اعتمادا أساسيا على مساهمات الدول الأعضاء من التمويل، إذاً فإن شبح توقف تمويل المنظمة إن أرادت الدول الكبرى ذلك قد يسبب انهيار هذه المنظمة، وبالتالي تعتبر هذه إشكالية حقيقية لتحقيق أهداف هذه المنظمة من التنمية والسلم المزعوم حول العالم. ومثال ذلك قرارات وقف تمويل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة. ولذا فإن أقصى ما يمكن تأمله من هذه المنظمة هو الخطابات الرسمية الرنانة واستعراض المواقف الدولية دون تحقيق تغير جذري للواقع على الأرض. إن اعلان الدولة الفلسطينية الذي تم مؤخراً، هل سينهي معاناة الشعب الفلسطيني؟ لا أعتقد ذلك. فإن استمرارية حدوث شتى أنواع الاعتداء بأشكاله من النزوح، والتهجير، واغتصاب الأراضي، والقتل، والتعدي على عاصمة الدولة القدس أو ما يسمى بالقدس الشرقية كما يقال أو انتهاك حرمة المسجد الأقصى. لا تزال تحدث عبر السنين منذ إنشاء الكيان. بل حتى المفاوضات والمطالبات من رئيس الدولة الفلسطينية تطالب بنزع سلاح المقاومة في غزة! فكيف لدولة منزوعة السلاح تستطيع حماية الدولة فضلاً عن حماية شعبها؟! إنه أمر لا يقبله عقل ولا منطق. فما بالك وجارة هذه الدولة هي دولة نووية مدججة بأحدث الأسلحة والتقنية الحربية تتصف بالعداء المزمن المتوحش منزوع الإنسانية! فهل سيصدق شخص محايد أن هذا كله يعقل؟ وخلاصة القول إن كل ما يحدث؛ لذر الرماد في العيون.
1227
| 28 سبتمبر 2025
ولا حياة مع اليأس، هناك حكمة يابانية تقول إن المشكلة التي ليس لها حل لا داعي من التفكير فيها. فالقلق والتوتر لن يساعدا في حلها، فالتركيز على البحث عن الحل واتخاذ الإجراءات اللازمة هو الحل الأفضل. قلما تجد إنسانا عنده إيمان، ويكون في حالة من اليأس. غالباً ما يكون اليأس ناتجا عن أمر حدث ويفكر فيها الإنسان من الماضي، ويسبب التوتر. أو أمر آخر يفكر فيها من أمور الغيب التي لم تحدث بعد من المستقبل، وهي تسبب القلق. ولذلك تجد من يقدم على الانتحار، فاقداً للإيمان وكان يفكر في مآسي الماضي ويأس من المستقبل. بل يجب عليك أن تعمل لدنياك « كأنك تعيش أبدا، واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا» كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، أي أن يركز المرء في يومه فقط. ولكن لا مانع من التفكير والتخطيط للمستقبل، ولكن في وقت متفرغ ومعين لإشغال العقل في ذلك حصراً. وليس القلق والتوتر من الماضي الممرض أو المستقبل المجهول المخيف الذي لا يعلمه أحد. فمن الناس من يتبع دجاجلة هذا الزمان عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي! وهم إذا صدقوا في أحداث فقد أخطأوا في أحداث أخرى كثيرة. «كذب المنجمون وإن صدقوا». فهم وإن صدقوا فهي ليست من علوم الغيب ولكنها من علوم الخطط الكونية للدول العظمى والمنظمات العابرة للقارات. فهي فعلاً نظرية المؤامرة، بل وحقيقة المؤامرة ولكن يبقى خيار الإنسان للتعامل معها. فسوف تجد كل آيات محكم التنزيل تحذر من حقيقة المؤامرة على الإنسان. ولكن أعظم نعمة ونقمة في نفس الأمر هي نعمة الاختيار. فالإنسان في هذه الحياة مخير لكل ما هو مسير فيه. فليست الاقدار ثابتة كما يبدو بل هي متغيرة في حياة الإنسان وثابتة في علم الله فقط. فممكن للإنسان ان يغير مستقبله ان أراد ذلك وهو مكفولٌ في رزق الله له، ولكن حسب سعيه واجتهاده. {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ} النجم ٣٩. يقول إديسون مخترع المصباح الكهربائي؛ « لم أفشل، بل وجدت ١٠،٠٠٠ طريقة لا تعمل»! فلا بأس أن تفشل الخطط، فليست هناك خطة تنجح مائة بالمائة وإلا فهي ليست خطة. فدائماً ما تكون هناك مساحة للخطأ وعدم الكمال. فالكمال فقط للخالق سبحانه. فلكم ان تتخيلوا أيها السيدات والسادة نسبة فشل المشاريع حول العالم بنسبة تسعين بالمائة وأكثر من ذلك! حيث لا تستمر لأكثر من ثلاث إلى خمس سنوات. فهذه حالة أي خطة لفرد أو مؤسسة حول العالم. ولكن هل يعني ذلك عدم التخطيط للأمور. طبعاً لا أعزائي الكرام، بل من شروط التوكل التخطيط السليم للأمور وإلا أصبحت تواكلا وهو مدعاة للكسل والتقاعس والخذلان والفشل. قال صلى الله عليه وسلم (اعقلها وتوكل) رواه الترمذي. آخر رسالة لكم أعزائي القراء، مهما كانت الأحداث مأساوية من حولنا، أو كانت صعبة وشديدة فهذه من طبيعة الحياة. فالواجب علينا عدم اليأس أبداً، والعمل على التخطيط الحكيم والعمل السديد لتحقيق الأهداف. والتفكر بحكمة ومنطقية وفق فقه الواقع، وكل ذلك في يوم الإنسان فقط وليلته وأن يوازن في حياته بين العمل والراحة والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية حسب ما تفضل الله عليه من رزقه. ويغلق البابين في أول النهار، فلا يفكر في ماضيه في هذا الوقت ولا يفكر في مستقبله في ليلته في نهاية اليوم. وإنما يحصر التفكر بالتخطيط برمي تلك الأفكار في سلة الكتابة ويركز فقط بالهم في اتقان عمل اليوم عبر الخطوات اللازمة لتحقيق الخطة الكبرى لحياته في يومه فقط. ويتجنب التخطيط الغبي، يقول أينشتاين في تعريفه للغباء؛ « هو فعل الشيء بنفس الطريقة ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة» فاللبيب من اتعظ بغيره لا بنفسه.
300
| 21 سبتمبر 2025
يقول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا هذه عادتهم في الاجرام والخيانة . ولكن نزعت المهابة من قلوب أعدائنا فاعتدوا علينا، وسيبقون ما دامت الأمور محصورة بين الشجب والتنديد فقط. فلنا في موقف رسول الله الثابت أسوة حسنة. فمن الأمة من يدافع عن هؤلاء الغادرين. وأصبح الوهن عاماً في أمتنا لنبحث عن الشماعات التي نعلق عليها المسؤولية بين العلماء والحكام، وكأنه ليس لنا دور لنصبح نشابه هؤلاء في حب الدنيا وكراهية الآخرة التي هي مقر الحصاد. فتاريخ ومنهج العهد الجديد لهؤلاء هي الحركة الصهيونية في هذا الزمان وخاتمتهم معروفة لنا . إن إشكالية اتخاذ التحالف مع دول الغرب الداعم لهم تكمن في أن أولويتهم لم ولن تكون لنا . فما بالك وقد غدروا بالرسول المفاوض ووضعوه في مكان الخصم؟ فمائدة المفاوضات يجب ان تغير البوصلة وتفتح الخيارات الممكنة على مصراعيها لإعادة دراسة التحالفات السياسية والاقتصادية بعد ما حدث حين قصفت دولة قطر، حفظها الله، من قبل الكيان الصهيوني. وذلك وفق الوسع الممكن لرد الاعتبار والردع لما حدث ويمكن ان يحدث في المستقبل. ويجب ان يكون أساس الفكر سبل الأمان القومي والوقاية مما حدث، ولا يكون ذلك إلا بالعودة للثوابت دون تمييع. لا أدري ما الداعي من الخوف من عدم التصنيع الدفاعي في دولنا العربية؟ فهي حقاً معضلة إستراتيجية مصيرية لكل شعوبنا وهذا التهديد الوجودي الذي تأكد بعد الحادثة المشؤومة التي تداخل فيه الدم القطري مع الدم الفلسطيني بعد استشهاد أحد أبنائنا ونال شرف الشهادة مع إخوته الفلسطينيين ضمن أفراد الوفد المفاوض. يجب أن يكون من الخيارات الممكنة للدولة لرد الاعتبار تفعيل قانون مقاطعة الكيان الصادر عام ١٩٦٣م. فكيف يكذب الصهاينة ومن عاونهم ويغدرون بالدولة المستضيفة والتي قبلوا ووافقوا ابتداءً بإجراء هذه المفاوضات برعاية الولايات المتحدة الضامن للأمن الدفاعي للدولة من خلال الاتفاقية الأمنية المشتركة، ولكنها جريمة الغدر والخيانة والانتهاك للسيادة متكاملة الأطراف أيها السيدات والسادة. يجب على مجلس التعاون الخليجي أولاً ومن ثم جامعة الدول العربية والدول الإسلامية الأخرى التركيز على دعم خيارات الصناعات الدفاعية ذاتياً وتغيير التفوق الحربي الجوي والصاروخي والراداري لدول الغرب الداعم للكيان الصهيوني، فشبهة التلاعب بأسلحة الغرب حين الضربة قائمة. فعندنا من العقول التي يمكن أن تدعم هذه الصناعات الدفاعية. وخصوصاً في القمة الاستثنائية القادمة في الدوحة لدعم دول المجلس وخصوصاً دولة قطر. ولكن يبقى مراقبة وتجسس تلك الدول لعدم تغيير هذا التفوق لدولة الكيان معضلة إستراتيجية أخرى. في النهاية؛ يجب أخذ الحيطة والحذر من توغل الجواسيس بيننا. وإعادة النظر في الديمغرافية السكانية وفق الدول المتحالفة مع دولة الكيان. فلا يمكن الوثوق واحتمالية تجنيد جواسيس من تلك الدول ليس بالأمر الصعب. فمن الضرورة بمكان على الدول الإسلامية والعربية عدم ترك دولتنا الحبيبة دون الدعم المطلوب حتى لا يقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. خصوصاً بعد هذا الإعلان الوقح لتغيير خريطة الشرق الأوسط بما يسمى إسرائيل الكبرى. حفظ الله قطر أميرها وشعبها.
315
| 14 سبتمبر 2025
هل ما زال العقار هو الابن البار كما يقال؟ قد يظن القارئ أنها الفيَّلة في الطبيعة أو حديقة الحيوان! بل هي تلك المباني الخالية دون إشغال أو ربح. في بداية دراستي لعلوم الإدارة في مرحلة الكلية، تذكرت نقاشي مع مدرس التسويق الإداري الذي كان من الجنسية الكندية، حيث قلت له عن مدى تطور البلاد بالمباني أو الأبراج التي تطلق عليها ناطحات السحاب. فرد بأنها الفيَّلة البيضاء! وكان أول مرة يدق المصطلح على مسمعي. وهي بالمعنى الاقتصادي غالباً ما يطلق على الممتلكات العقارية التي لا يُرغَب فيها، لعدم جدواها وفائدتها، وتكون باهظة الثمن أو تتطلب الكثير من العمل لصيانتها والحفاظ عليها ولا تستحق الجهد. وأكثر ما يتم استخدام المصطلح على تلك العقارات غير المأهولة وغير المربحة لغلاء سعر أُجرتها. في بداية القرن الحالي وتحديداً بعد عام ٢٠٠٦م وحدث الأسياد، قد كانت هناك شكاوى كثيرة من المقيمين داخل الدولة عن أسعار إيجارات العقارات الغالية، حينها بدأ التشجيع المفرط للاستثماري العقاري في البلاد وذلك لغاية زيادة معروض الخيارات العقارية السكنية المتاحة في السوق، وخفض ثمن الأجرة. ولكن الأمر لم يحدث بالشكل المتوقع المطلوب، بل الذي حدث هو زيادة في المعروض دون الزيادة بالطلب، بل إن الأسعار بقيت ثابتة ومتذبذبة دون الحصول على الانخفاض الجذري المطلوب. وتوالت الأحداث الكبرى داخل البلاد كالبطولات الآسيوية والأحداث الرياضية الكبرى حتى كأس العالم ٢٠٢٢م. وكانت الحركة العقارية تنتعش قليلاً ومن ثم تهبط بشكل جذري بعد انتهاء الحدث، وذلك لأن دورة الاقتصاد لا تتأثر بالاقتصاد «الجزئي» المحلي فقط، بل إن هناك عوامل خارجية مؤثرة وهي الاقتصاد «الكلي» أي الدولي العالمي. فالتنافسية الإقليمية والعوامل الاقتصادية للدخل القومي من صادرات النفط والطاقة والتوترات السياسية كأزمة الحصار ٢٠١٧م والتوترات الإقليمية والعالمية الأخرى لها دور جوهري في هذا السياق. تَعَقّد الأمر في الاقتصاد المحلي بشكل أكبر في عام ٢٠٠٨م عند حدوث الأزمة المالية العالمية. والتي تأثر العالم كله بها بالرغم من تأثيرها الطفيف على اقتصادنا المحلي. ولكن العامل الرئيس هو الكساد الخفي الذي بدأ يدب في السوق العقاري خلال السنين الفائتة.فالأزمة المالية العالمية التي حدثت في أمريكا كانت أزمة عقارية بامتياز، ولها دور رئيس لما يحصل في الحركة العقارية داخل البلاد اليوم. حيث كانت الأزمة هي الأسوأ منذ الانهيار الاقتصادي منذ الكساد الكبير في بداية القرن الفائت، وبدأت بسبب انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة نتيجة لإقراض القروض عالية المخاطر وتوريقها في سندات مالية تم تداولها بين المؤسسات المالية. الأمر الذي أدى إلى تفاقم هذه المشكلة وفشل المؤسسات المالية الكبرى، وركود الاقتصادي العالمي، وتزايد نسب البطالة حول العالم، وانخفاض حاد في قيمة الأصول العقارية بعد ذلك. يتبين أهمية تحديد شرائح المستهلكين ومستوى القوة الشرائية للمعروض العقاري. فأغلب سكان البلاد هم من فئتين رئيسيتين، هم الفئات المشبعة المالكة للأصول العقارية والضامنة للامتلاك العقاري أو الفئات غير القادرة إلا عن طريق الخيارات التمويلية للمصارف البنكية، والتي تُفاقم مستوى تطور دخل الفرد من الناحية الاقتصادية. والأخرى غير القادرة على امتلاك العقارات بالكلية وهي المصدرة لأغلب الأموال الصادرة خارجة البلاد! كما أن حجم السكان والسوق المحدود داخل البلاد يمثل تحديا يتطلب تعاون الجهات المعنية بالتخطيط المدني والاقتصادي والمالي لإعادة رسم السياسات التي تستهدف زيادة عدد السكان عن طريق قنوات التجنيس والإقامة الدائمة لجذب الاستثمارات العقارية الداخلية والخارجية خصوصا في المناطق المسموح بها، وإعادة دراسة إشكالات عزوف الشراء العقاري داخل البلاد ليتم زيادة المستوى العقاري الاقتصادي بما يتناسب ورؤية الدولة ٢٠٣٠م.
300
| 07 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
13194
| 20 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1782
| 21 نوفمبر 2025

شخصيا كنت أتمنى أن تلقى شكاوى كثير من...
1383
| 18 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1164
| 20 نوفمبر 2025

القادة العظام يبقون في أذهان شعوبهم عبر الأزمنة...
1134
| 18 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
969
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
912
| 20 نوفمبر 2025

نعيش في عالم متناقض به أناس يعكسونه. وسأحكي...
804
| 18 نوفمبر 2025

يُعد البيتومين (Bitumen) المكون الأساس في صناعة الأسفلت...
705
| 17 نوفمبر 2025
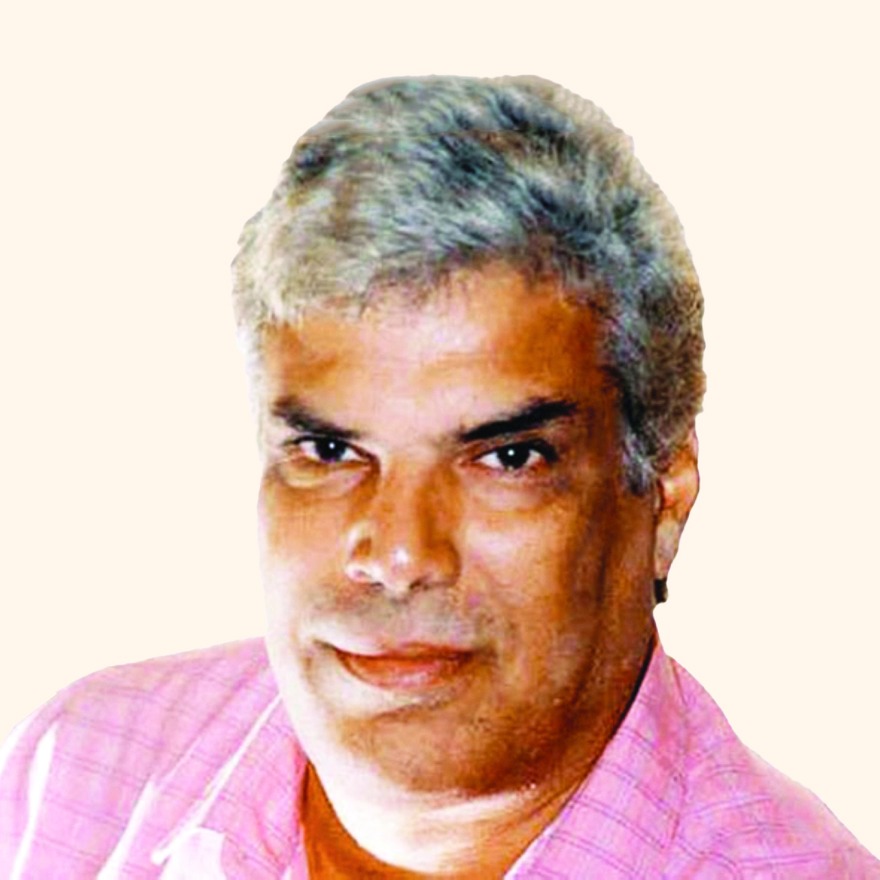
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
645
| 20 نوفمبر 2025

المترجم مسموح له استخدام الكثير من الوسائل المساعدة،...
621
| 17 نوفمبر 2025
مع إعلان شعار اليوم الوطني لدولة قطر لعام...
615
| 19 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







