رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حضرت الأسبوع المنصرم مع العديد من الباحثين والكتاب من الخليج والوطن العربي، المؤتمر السنوي السادس عشر، لمركز الخليج للدارسات، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي رعاه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والذي حمل هذا العام عنوان (العلاقة بين الدولة والمجتمع)، ولاشك أن اختيار هذا الموضوع ذو دلالة مهمة في مسيرة الأمة العربية في ظرفها الراهن، حيث تعاني الكثير من البلاد العربية بعض التوترات والصراعات لأسباب سياسية وفكرية واجتماعية، والتي يفترض أن تتكامل وتتعاون لما فيه الوحدة الوطنية، وإقامتها على أسس صحيحة، بحيث تتأسس على أوجه واضحة من التوازن والتفاهم، والتمييز بين ماهية المصلحة العامة والمصالح الخاصة، والتي تصب في النهاية لمصلحة الدولة وفق المواطنة التي يلتقي حولها الجميع في الحقوق والواجبات، وقد أشار راعي المؤتمر، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته الافتتاحية إلى أهمية هذه العلاقة، فقال "إن العلاقة القوية والناجحة، بين الدولة والمجتمع، هي من وجهة نظري، الأساس المتين، لتحقيق الوحدة الوطنية، والعكس أيضًا هو الصحيح: الوحدة الوطنية، هي الطريق الآمن، إلى علاقة مثمرة، بين الدولة والمجتمع، الوحدة الوطنية، تبدأ بتعريف واضح، للمصالح الوطنية المشتركة، وتنطلق من حرص الجميع، على تحقيق السعادة وجودة الحياة، لكل فرد فــي المجتمع، الوحدة الوطنية، هي السبيل للمواجهة الناجحة، للتغيرات والتطورات الهائلة، في المجتمع والعالم، إنها السبيل، إلى مجتمع مدني قادر وناجح، هي السبيل، إلى إرساء مبادئ التضامن والتكافل، والعمل المشترك، في ربوع الوطن إنها المجال، الذي تنمو فيه، قيادات الدولة والمجتمع، كما أنها الإطار الذي يمكن معه إحداث التوازن المطلوب في العلاقة بين الدولة والمجتمع". والحقيقة أن هذه الرؤية جديرة بالاهتمام، لصياغة علاقة صحيحة وصحية، لإقامة مثل هذه العلاقة التكاملية بين الدولية والمجتمع، فإذا تحققت هذه العلاقة، فإن الكثير من الأفكار المتطرفة والتكفيرية وغيرها من الأفكار، لن تجد لها تلك التبريرات التي تريد إيجاد ثغرة لنشر أفكارها المنحرفة عن جادة الصواب، ومن هذه المنطلقات، فإن التطرف والتكفير والغلو، يقتات على بعض المستنقعات والفواصل غير الصحية، أو عدم الحوار والتقارب بين السلطة والمجتمع، وهذا حصل بالفعل في بعض الدول التي لم تقم علاقة صحية في مجتمعاتها، وتعاني ولا تزال تعاني من مشكلات وتوترات وصراعات كبيرة، أصبح الفكاك منها في غاية الصعوبة، ولهذا فإن قضية العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومنها المجتمع المدني، مهمًا وضروريًا، وفي غيابه، ربما يكثر الهمس والبلبلة، وإثارة قضايا غير صحيحة عبر الوسائل التواصل الاجتماعي، التي تمثل خطرًا فكريًا، ولهذا فإن الأفكار المتطرفة تستفيد من العلاقة المتوترة بين الدولة والمجتمع وتستغلها، لإثارة المجتمع لنشر فكرها المنحرف، واستقطاب الشباب، وهذا حصل في العراق، وفي سوريا أيضًا، عندما لم تقم علاقة صحية جيدة بين الدولة وجزء كبير من المجتمع، فإن التطرف والتكفير والغلو، انتشر انتشار الرياح في الهشيم كما تقول الأمثال، وأصبح القضاء على التطرف والتكفير، كبيرًا ومكلفًا، وربما أصبح صعبًا كما تدل الوقائع والأحداث التي مرت على تنظيم داعش في العراق وفي سوريا، والإشكالية أن النظام في العراق الذي جاء بعد سقوط الرئيس السابق، صدام حسين، الذي كان يتهم بالقمع والاستبداد والإقصاء، عاد النظام الذي خلفه أيضًا إلى نفس ممارسات وأساليب ذلك النظام السابق، وربما أكثر، وأصبح العراق، ما بعد صدام في دوامة لا أول لها ولا آخر، بل إن أنصار النظام الجديد، ثاروا أخيرًا على سياساته التي أصبحت صعبة على الجميع وازدادت المشكلات، والأخطر في ذلك أنه بعد سقوط النظام السابق في العراق، تم صياغة قانون (اجتثاث البعث)، وتم تسريح عشرات الألوف من الضباط والجنود العراقيين من عملهم ـ فكيف يعيش هؤلاء؟ـ وهذه سبّبت الكثير من المشكلات في العراق، ولا تزال قائمة، منها كما يطرحه الكثير من الباحثين العراقيين، الذين ينطلقون من رؤية وطنية خالصة، وغير أيديولوجية، أن 70% من قوات داعش، هي من الجيش العراقي السابق، الذي تم تسريحه بعد احتلال العراق في عام 2003! وهذا ما برز في قوة وصمود داعش منذ عامين تقريبًا من مهاجمته، ولا يزال يقاتل كما هو، وهذا أمر خطير لاشك في ذلك، وبرى المفكر البحريني، على فخرو، "إن عزوف المواطنين عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني، من القضايا الأخرى التي تعد سببًا من أسباب لبس العلاقة، وهذا العزوف له أسبابه، كتهميش أقلية على الإدارة، وبقائها في مراكز القيادة لسنين طويلة، وعدم تجذر المبادئ الديمقراطية في ثقافة المجتمع العربي وفي مؤسساته الأساسية". لذلك فإن قيام علاقة قوية وصحيحة، بين الدولة والمجتمع، يعد مربط الفرس ـ كما تقول الأمثال ـ لصياغة علاقة تكاملية تقوم على التفاهم والتعاون، وإقامة مواطنة تجسّد التلاحم والتقارب بينهما بما يعزز هذه العلاقة وينميها.
2123
| 15 مايو 2016
حظيت القمة الخليجية-الأمريكية التي عقدت منذ عدة أسابيع في العاصمة السعودية الرياض، بأهمية كبيرة من كل الدوائر السياسية في العالم، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بينهما، وكذلك الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في العراق وسوريا، وكذلك الوضع في اليمن. كما أن الولايات المتحدة ترتبط بعلاقات قوية مع دول التعاون منذ أمد طويل، لكنها تخضع لبعض الخلاف حول بعض الأزمات والملفات، ولذلك فإن من أهداف زيارة الرئيس أوباما، وانعقاد القمة كما يقول بعض المحللين، أن الولايات المتحدة تريد أن تطمئن دول مجلس التعاون، أن الاتفاق النووي مع إيران ليس موجهًا لدول المنطقة، ولا يشكل خطرًا عليهم، وأنه لا يعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن علاقاتها القوية مع هذه الدول، كما أن بعض دول التعاون لها بعض العتاب على الولايات المتحدة، تجاه بعض الأوضاع في المنطقة، مثل التراجع عن اتخاذ موقع حاسم في الأزمة السورية، وكذلك المشكلات في العراق، والظروف والانتهاكات التي يقوم به النظام الحالي في بعض المحافظات ذات الأغلبية السنية والتوترات القائمة بين المكونات القائمة، وكيفية مواجهة تطرف داعش والجماعات التكفيرية الأخرى في العراق وسوريا، وكيفية حلحلة الوضع في اليمن. وموقف دول الخليج واحد في كل المواقف التي صدرت في اللقاءات والمؤتمرات الخليجية في الأشهر الماضية، ومن المهم أن تتم المصارحة بين دول التعاون والولايات المتحدة في كل القضايا الساخنة وكانت الفرصة سانحة في تلك القمة التي اتسمت بالمصارحة، بدلًا من التصريحات هنا وهناك في الفترة الماضية، وبعضها لا يعبر عن السياسة الرسمية لكلا الطرفين الخليجي والأمريكي. ويرى بعض المحللين أن التصريحات أو الحديث الذي أدلى به الرئيس أوباما منذ عدة أسابيع في بعض القنوات الأمريكية، حول التطرف في المنطقة، وبعض تلميحاته لبعض الدول الخليجية، ربما كانت سببًا لهذه القمة لإزالة العتاب حول هذه التصريحات، وفرصة مواتية لدول المنطقة أن تقول بعض ملاحظاتها حول السياسة الأمريكية في الملفات المشار إليها آنفًا. ولاشك أن سياسة دول التعاون في القضايا الراهنة، واضحة، تجاه كل القضايا العالقة، أو الخافتة، لكن السياسة تحكمها إستراتيجيات كبيرة، ولها رؤى قد تلتقي أو تتقاطع مع هذه الدول أو تلك، لكن الولايات المتحدة تدرك حجم وأهمية منطقة الخليج الإستراتيجي، والاقتصادي، والأمني، وهذه الأوراق هي التي تجعل منطقة الخليج مهمة للولايات المتحدة، كما أن دول الخليج تدرك قوة ومكانة الولايات المتحدة العسكرية، ولذلك فإن هذا اللقاء كان لقاء مصارحة وعتاب في مواقف، وتوافق في مواقف أخرى. ويرى الباحث السعودي د. عبدالحفيظ عبدالرحيم، إن هذه القمة الخليجية-الأمريكية انتهت "بـ6 مبادرات ترسم شراكة خليجية أمريكية جديدة، تبدأ بتشكيل عمليات خليجية أمريكية خاصة للاستجابة السريعة، إقامة أنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية ونظام إنذار مبكر، تبادل المعلومات الاستخباراتية، إقامة مناورات عسكرية أمريكية خليجية موسعة العام المقبل، مبادرات لتعزيز الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى تعاون عسكري بحري. كما أكد البيان الختامي لقمة الرياض على تأكيدات الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة، وأكدت القمة بشكل خاص على مكافحة الإرهاب ومواجهة أنشطة إيران التخريبية، لذلك يؤكد أوباما بقوله: "رأينا دائما ينسجم مع آراء كثير من دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك سيتجه البيت الأبيض نحو تدريب قوات خاصة من دول الخليج لتقوم بدور حاسم في التعامل مع صراعات المنطقة". بل أكد أوباما أن الأوضاع الحالية في العراق تحتم ضرورة الوجود الأمريكي لإعادة الاستقرار وهو ما يعد اعترافا بالعمليات التخريبية لإيران في العراق ولا يمكن ترك العراق لها تسرح وتمرح فيه وتتخذه كنقطة انطلاق وبوابة نحو دول الخليج وسوريا ولبنان، بل أكد أوباما على التعاون مع دول الخليج لقطع الطريق أمام مساعي طهران لزعزعة الاستقرار في المنطقة. لا شك أن هذه القمة أخذت أبعادًا سياسية كبيرة تجاه الملفات العديدة التي نوقشت بالقمة، وهذا ما برز في البيان الختامي للقمة الأمريكية-الخليجية، وقد أشار إلى أهمية هذه القمة العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين، إذ عبروا أن هذه "القمة وهي الثانية من نوعها بعد قمة كامب ديفيد، سترسخ إطارا استراتيجيًا وأمنيًا وتحالفًا بين الجانبين يستمر في فترة ما بعد انتهاء ولاية أوباما في البيت الأبيض". وهذا يعني أن هذه الزيارة، طمأنت دول المنطقة، أن السياسة الأمريكية تجاه دول المنطقة، ثابتة تجاه حلفائها، ولا يمكن أن تغيرها، الاتفاقات والحلول مع دول أخرى، هذا ما حققته هذه القمة.
405
| 08 مايو 2016
يعد الأمن النووي للدول قضية إستراتيجية مهمة في عالم اليوم لمتطلبات كثيرة، في ظل توجهات العديد من الدول، للسعي لامتلاك المفاعلات النووية، التي قد تدفعها إلى امتلاك السلاح النووي، بهدف السعي إلى ما يسمى بـتوازن الرعب، بهدف إبعاد أي خلل في إستراتيجية القوى العسكرية غير التقليدية بين الدول، ومنها السعي للسلاح النووي، الذي يسبقه الكلام عن الحاجة للأغراض السلمية، ولا شك أن التوازن النووي مهم لحفظ السلام والأمن الدوليين، لأن الاختلال في هذا الجانب، قد يسهم في تهديد بعض الدول لدول أخرى في الصراعات السياسية والإيديولوجية، في ظل عدم وجود توازن قوى في هذه القدرات التكنولوجية المهمة في عصرنا الراهن، وهذا ما دفع بعض الدول منذ عدة عقود إلى السعي حثيثًا لامتلاك هذه القوة التكنولوجية، فالصين عندما امتلكت السلاح النووي، وكان بينها وبين الهند مشاكل حدودية قديمة، سعت لهذا السلاح النووي، واستطاعت امتلاكه، وبعدها سعت باكستان لامتلاك السلاح، بسبب حصول الجارة الهند على هذا السلاح النووي، وتحقق لها هذا السعي، وإيران الشاه سعت للسلاح النووي منذ فترة الستينيات، وللإغراض السلمية كما تقول، لكن هذا السعي كان بسبب امتلاك دول المعسكر السوفيتي آنذاك لهذا السلاح، خاصة أنها لها حدود مع بعض هذه مثل أذربيجان وأرمينيا، ثم استمر هذا المشروع النووي بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، لذلك فإن الدول عندما تسعى للمفاعلات النووي تدعي أنها تريدها للأغراض السلمية، لكن الجانب الأهم في هذا السعي هو من أجل الردع النووي، والحاجة إلى الحاجة العلمية السلمية، وهذا المسعى لا يزال إلى الآن يراود الكثير من دول العالم، لكن الهدف الأكثر سعيًا هو لتوازن القوى في ظل بعض الصراعات والخلافات السياسية حقيقة، وهي الرغبة الأساسية للكثير من دول العالم، بما فيها الدول الكبرى. والحقيقة أن السعي للقدرات النووية، لم يعد هدفه الأساسي للحرب، بل من أجل توازن القوى أو توازن الرعب (أنت عندك وأنا عندي)، وهذه هي الرؤية المطلوبة لامتلاك القدرات النووية في عصرنا الراهن، فالأسلحة التقليدية أصحبت كثيرة وخطيرة في أثرها النفسي والمادي، واستخدام السلاح النووي بهدف الحرب، ليس له وجود فعلي ولم يتم استخدامه بعد العالمية الثانية، ولا هناك رغبة حقيقية في استخدام هذا الأسلحة الخطيرة والمدمرة، لكن هذا الامتلاك المتوازن، يسهم إلى التقليل في التهديد والتخويف من فرض القوة والهيمنة من بعض الدول على بعضها الآخر، ويرى د/ إسماعيل صبري مقلد في كتابه (الإستراتيجية والسياسة الدولية)، أن توازن القوى "يحقق بمفهومه هذا أثرين مهمين يتعلق أولهما بحفظ السلم الدولي، بينما يتعلق ثانية ما بحماية استقلال الدول الأعضاء في تلك المحاور والتكتلات ويستند على ركيزتين أساسيتين: ـ إن الدول الأطراف في تجمعات ومحاور القوى المضادة يجمعها هدف واحد، هو الإبقاء على الاستقرار السائد في علاقات القوى، وردع العدوان. ـ إنه في أي موقف دولي، فإن التوازن يتحقق عن طريق قدرة هذا النظام ـ أي نظام ـ على توليد ضغوط متعادلة ومتعاكسة، وبذلك يمكن تفادي حدوث أي اختلال غير مرغوب فيه في علاقات القوى هذه. ولذلك ـ كما يقول مقلد ـ تنقسم توازنات القوى بهذا المفهوم إلى نوعين: أ ـ توازنات القوى البسيطة ـ ب: وتوازنات القوى المعقدة أو المتعددة الإطراف، وتقييم أثر سياسات توازن القوى في العلاقات الدولية (بالمفهوم التقليدي لهذا التوازن) يكشف عن بعض الجوانب الإيجابية، كما يكشف عن الكثير من الجوانب السلبية التي اقترنت بتطبيق هذا المبدأ، فأما إيجابيات هذا المبدأ، أن تطبيق توازن القوى أبقى على تعدد الدول في المجتمع الدولي، واستطاع أن يحول لفترة تزيد على ثلاثمائة عام ـ وهي أطول فترة على تطبيقه ـ دون انفراد دولة واحدة بالسيطرة العالمية، وهذا يفسر سبب الحروب المستمرة التي وقعت في المجتمع الدولي منذ ظهور نظام الدولة القومية، وحتى مؤتمر فيينا، الحربين العالميتين في القرن العشرين. فكل هذه الحروب وقعت للحيلولة دون إعطاء دولة واحدة إمكانية السيطرة على العالم كله". والحقيقة أن مسألة الأمن النووي مطلوبة للأغراض العلمية والسلمية، وأصبح وجود هذه المفاعلات، تحسب لها الدول حسابات كثيرة، لاسيَّما بهدف توازن القوى، ولذلك فإن الحصول على التكنولوجيا النووية، من أجل التوازن التكنولوجي، والاستفادة من مجالاتها العلمية الأخرى، أصبحت حاجة ملحة للكثير من دول العالم، في الجانب السياسي على وجه الخصوص، لكن الدول الكبرى، تحسب حسابات كثيرة لإقامة مفاعلات نووية في دول كثيرة، وقد أصدر الرئيس أوباما منذ عدة سنوات كما تذكر بعض التقارير "الإستراتيجية الجديدة الخاصة بالأسلحة النووية إلى الاحتفاظ بالأسلحة النووية لردع أي تهديد أساسي بضربة نووية على الوطن الأمريكي، مع تعزيزها كذلك لهدفه النهائي المتمثل في جعلها أسلوبا دفاعيا عفا عليه الزمن. وتتناول الإستراتيجية، الواردة في تقرير يقع في 72 صفحة ـ وهو تقرير مراجعة الوضع النووي ـ الذي تم وضعه بصورة مشتركة من قبل وزارة الدفاع، ووزارتي الخارجية والطاقة ومجلس الأمن القومي، وهو ما يعتقد أنه يشكل التهديد المحتمل الأكبر في العقد القادم ـ وهو أن يتمكن إرهابيون من الحصول على مواد نووية لصنع القنابل "القذرة" وزيادة الانتشار النووي على الصعيد العالمي نتيجة لقيام مزيد من الدول بالتسلح بالأسلحة النووية والقنابل القذرة. الدول التي تحصل على القدرات النووية ستمثل معضلة أكثر إثارة للقلق تتمثل في دورة مفزعة من انتشار لا ينتهي من شأنه زعزعة استقرار مناطق بأكملها في العالم". فالدول الكبرى لا تريد أن يفتح الباب على مصراعيه لأسلحة الدمار الشامل، والخوف أن تمتلكه الجماعات المتطرفة التي يقال إن بعضها حصل على بعض الأسلحة المحرّمة، لكن القضية الأهم والتي يجب أن يحرص عليها المجتمع الدولي، أن يتم السعي لإقامة العدل ومحاربة المظالم، وأن ترعى الحقوق المسلوبة للشعوب المضطهدة، وأن يتم إبعاد المعايير المزدوجة للكثير من القضايا العالقة والخافتة، خاصة قضية فلسطين التي تعتبر أطول القضايا التي بقيت لا حل لها حلا عادلا حتى الآن، هذا الحق العادل تم وفق القرارات الدولية، وأن تتم تسوية النزاعات القائمة، ليس على أساس الإيديولوجيات (وهذا معنا وهذا ضدنا)، بل يجب أن يتم تقييم المشكلات على أساس العدل والمساواة من أجل الاستقرار، بغض النظر عن سياسة المحاور والأحلاف الدولية، وإلا ستبقى المشكلات عالقة، وأن خفتت لفترة زمنية، فإنها تعود مرة أخرى، ربما أكثر مما كانت عليه.
387
| 01 مايو 2016
يعاني اللاجئون العرب إلى أوروبا، خاصة السوريين، من ظروف إنسانية صعبة، بسبب نظم وقوانين بعض الدول الأوروبية التي ترفض المهاجرين وفق قوانينها وإجراءاتها في هذا الجانب، ربما لأسباب سياسية واقتصادية، وأكثر هذه المعاناة لحقت باللاجئين السوريين الهاربين من جحيم القتال بين النظام والمعارضة منذ قيام الثورة السورية منذ خمس سنوات، ولا شك أن ظاهرة الهجرة إلى أوروبا من دول عديدة ظاهرة عامة لأسباب اقتصادية، وهو الجانب الغالب على هذه الهجرة المزايدة في العقدين الماضيين، وقد وضعت الدول الأوروبية العديد من الإجراءات الأمنية والمراقبة الحدودية للحد من الهجرة إليها، مع أن الإجراءات والقوانين التي وضعت تخالف حقوق الإنسان في بعض الإجراءات. ويرى الأكاديمي الفلسطيني د/ بشارة خضر، وهو أستاذ في جامعة لوفان في بلجيكا، بخصوص هذه السياسة لمواجهة الهجرة إلى الغرب إن وراء إجراءات المراقبة والحراسة المقترحة والمتبناة من قبل السلطات الأوروبية، والسياسات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، شاغل أمني مضمر في كامل المقاربة الأوروبية لمسألة الانتقال الحر، وبخاصة بعد 11 سبتمبر 2011. لكن من الواضح أن هناك هموما أخرى، إذ يتم الكلام، عشوائيًا، عن تدهور البيئة التي يتسبب بها التدفق الكثيف للأجانب، والخطر الذي يمثله هذا التدفق على أنظمة الرعاية الاجتماعية وخطر تآكل "الهوية" على الجمعية من خلال امتصاص مجموعات سكانية تحمل سمات اجتماعية وثقافية ودينية مختلفة، والتنافس المحتمل في سوق العمل، والضغط القوي على الأجور باتجاه الأسفل. إنها كما يقول د/ خضر محاججة تخفي الإسهامات الإيجابية لموجات الهجرة على الصعد الاقتصادية والديمجرافية والثقافية، وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بـ"تشريع" ووضع خطط العمل والإجراءات بخصوص حرية الانتقال فلأنه تبيّن صعوبة تحقيق الانتقال الحر داخل "البيت الأوروبي" دون أن يتم التفاهم في الوقت نفسه بخصوص إجراءات دخول هذا البيت المشترك".والذي أثار الخوف والتوجس من بعض دول أوروبا، هو الهجمات والتفجيرات في العديد من الدول الأوروبية منذ سنوات في العديد من الدول الغربية، ولهذا من حقهم أن يشددوا الإجراءات للحد من هذه الهجمات، وهذا موجود حتى بين الدول العربية نفسها، والمسألة تحتاج إلى عدم التعميم على كل الهجرات إلى أوروبا، خاصة في الجوانب الإنسانية المؤقتة، مثل تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين الهاربين من الصراع داخل دولهم، ولا شك أن قضية المهاجرين العرب والمسلمين في الغرب، تشكّل هاجسًا كبيرًا للكثير من المهتمين والباحثين الغربيين. ففي المؤتمر الحوار الإعلامي العربي / الألماني الذي عقد في 2004 بمسقط، لاحظت عندما حضرت هذا المؤتمر، أن العديد من المشاركين يطرحون هذه الهواجس، ومستقبل هؤلاء كمواطنين جدد في البلدان الأوروبية، ومسألة الاندماج والهوية والثقافة...إلخ. وهذا التوجسات ازدادت بعد الحادي عشر من سبتمبر 2011 بشكل أكبر، وجعلت الغرب أكثر توجسًا من المسلمين، أو ما يسمى بـ"الإسلاموفوبيا"، وهذا ما جعل الغرب يضع الكثير من الإجراءات والاحتياطات للهجرة من العرب والمسلمين، وهذه ما سببت للكثير المتاعب والمشكلات للهجرات الإنسانية العربية والمسلمة عمومًا، لكن هناك أصواتًا من الغرب ترى الأمر من زاوية أخرى مختلفة عما يقوله البعض من السياسيين وصناع القرار في الغرب عن الهجرة والخوف من المسلمين، ويرى الكاتب الفرنسي "إيدوي بلينيل" في كتابه "من أجل المسلمين" الصادر العام المنصرم "إن قضية المسلمين يتم توظيفها بكثافة لصناعة عدو داخلي، بالمنهجية نفسها التي شرحها المنظّر النازي كارل شميت، وذلك لخلق حالة من الفزع لدى جزء مهم من الرأي العام الفرنسي الذي أصبح يتبنّى مواقف عنيفة ضد قضايا الهجرة، التي صارت مرادفة في الكثير من وسائل الإعلام للإسلام والإرهاب والغزو الفكري والانحراف، وغيرها من مفردات القاموس الكزينوفوبي (كراهية الأجانب). في سنة 2013، أشارت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان إلى "استفحال العنف". وذلك في تقريرها السنوي حول العنصرية ومعادية السامية والكزينوفوبيا، وإن المعطى الأكثر ثباتًا وتجذرًا في هذا العنف هو التعصب المعادي للمسلمين". من هنا يحذر "بلينيل" من التوظيف المتهافت للإسلاموفوبيا بذريعة حماية اللائكية (العلمانية) وتحصينها، كما يؤكد على استعجالية وراهنية التصدي للتوظيف السياسي لقضايا الهجرة والإرهاب، مؤكدًا على ضرورة الفصل بين القضيتين وأن ليس بينهما علاقة السبب والنتيجة كما يحاول البعض التدليل على ذلك بلّي عنق الحقائق وتزييف الوقائع. ويدعو إلى مقاربة سؤال الإسلام بمفاهيم التلاقح الثقافي والتنوع الحضاري وتعدد الهويات وديناميتها، مجابهًا أي محاولة لاستثمار الموضوع سياسيًا، ومنتصبًا في وجه فئة من المتعصبين.ولا شك أن التعصب من بعض السياسيين والنخب الفكرية في الغرب يسهم في هذا الاحتقان من جانب، والغلو والتطرف من بعض المسلمين أيضًا جعل الغربيين يتوجسون من المسلمين، بسبب بعض الأعمال والممارسات التي تثير التوتر والقيود والمعاناة لدى المقيمين والمهاجرين من المسلمين الذين ليس لهم هدف من الهجرة سوى العمل والعيش الكريم في بعض الدول الغربية. فإذن هناك سلبيات من بعض السياسيين المتطرفين في الغرب.
1024
| 24 أبريل 2016
ينقل المفكر السوري د. برهان غليون عن المستشرق الفرنسي رودنسون في كتابه "سحر الإسلام" كيف أنه في القرن السابع عشر وبعده، كان الإسلام يعتبر في الغرب رمز التسامح والعقل على النقيض من الدين المسيحي ومذاهبه المتعصبة للعقل، فقد أخذهم ما يؤكده من ضرورات التوازن بين حاجات العبادة وحاجات الحياة وبين المتطلبات الأخلاقية أو المعنوية وحاجات الجسد وبين احترام الفرد والتشديد على التضامن الاجتماعي". وكان التركيز كبيرًا لدى المثقفين في مواجهة المسيحية على الدور التحضيري للإسلام وعلى عقلانية الاعتقادات النابعة منه. فقط ـ كما يقول د.غليون ـ منذ المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر بدأ الأوروبيون يعتبرون أن المسيحية هي سبب التقدم والنجاح في أوروبا، وأن الإسلام هو سبب العجز والتأخر في العالم العربي والإسلامي، وبعد أن كان الإسلام يستخدم كنموذج للدين العقلاني والحضاري في مواجهة المسيحية "المتعصبة والبربرية" بدأت الآية تنعكس تمامًا ليصبح الإسلام شيئًا فشيئًا مثالًا للبربرية التي تهدد الغرب.. لقد ترسخت القناعة بأن أوروبا هي قاعدة الحضارة وأن كل ما يقف في وجه أوروبا فهو معادٍ للحضارة، وكأن الإسلام كثقافة ومدنية ومجتمع هو العقبة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة التي تحول دون امتداد التوسع الغربي في اتجاه الجنوب والقارات والحضارات القديمة، وكان لا بد لهم من أيديولوجيا تؤجج العداء له وتبرر العدوان عليه في الوقت نفسه في نظر الأوروبيين أنفسهم ونظر العالم".ومن هذه الرؤية الجامدة نشأت "الأصولية العلمانية" في الغرب التي لا تقبل غير الرؤى المنطلقة منها، صحيح أن الغرب عندما انقلب على الكنيسة جردها من سلطاتها وأزاحها من مكانتها الكبيرة في المجتمع الغربي، لكنه لم يتنازل كلية عن طموحات هذه البابوية وذاكرة المركزية الأوروبية وإنها محور الإنسانية وتاريخها وإقصاء الآخر وتهميشه فكريًا وثقافيًا وتأسيس ذاكرة تاريخية ثقافية محور "الأنا" الغربي وتميزه وتفوقه بصفات وخصائص يفتقدها الآخر عقليًا وحضاريًا وعرقيًا..وهذه العقلية بقيت راسخة حتى بعد سقوط البابوية وتأسيس العلمانية". وسنكون مخطئين -كما يقول د. محمد عابد الجابري- إذا اعتقدنا أن الغرب قد تحرر من تلك الخلفيات الثقافية والدينية وأنه الآن غرب علماني خالص عقلاني براجماتي لا غير، سنكون مخطئين إذا نحن جردنا الغرب من ذاكرته الثقافية الدينية ذلك لأنه إذا كانت هذه الذاكرة تفعل بصورة واعية في الكنسيين والمتطرفين في كل من أوروبا وأمريكا فهي تفعل ذلك بصورة لا واعية في العلمانيين والليبراليين. وإن الذاكرة الثقافية والدينية ما زالت تمارس فعلها في تفكير الصحفيين والمحللين وصناع السياسة من الليبراليين العلمانيين في الغرب".وحاولت العلمانية بعد مزاحمتها للكنيسة في التأثير والمكانة في المجتمع الأوروبي أن تستعيد الذاكرة السلطوية لرجال الدين في التميز والهيمنة من خلال الادعاء "بالكونية" والفرادة للغرب، ومن منظور الفلاسفة أنفسهم وشجعوا حتى الاستعمار، وهذا الموقف المزدوج للعلمانية في الغرب جعل البعض يشك في مصداقية مقولاتها عن الحرية والتسامح والتعددية الديمقراطية تجاه الآخر، لكن ذلك لم يتحقق بصورة مقبولة، فليس من المصادفة البتة بل العكس ومن باب الانسجام الفكري ـ كما يقول روجيه جارودي ـ في أن يكون أعظم حامل لهذه الأيديولوجيا مؤسس المدرسة العلمانية "جول فري" هو نفسه المحرض على الغزو الاستعماري في مدغشقر وفي تونس والفيتنام..هذا المفكر الواضح كان في فرنسا المنظر الأعنف للاستعمار مثلما كان في إنجلترا ستيورات ميل وهو تلميذ آخر من تلامذة وضعية "أوغست كونت" ففي خطابه يوم 27 يوليو 1885 أمام مجلس النواب تقوم على ثلاث قواعد اقتصادية..إنسانية..سياسية ". وفي فقرة أخرى قال: "لا أتردد في القول إن هذا ليس من السياسة ولا هو من التاريخ إنه من الميتافيزيقيا السياسية.. أيها السادة لا بد من القول بصوت أرفع وبحقيقة أكثر يجب القول بصراحة أن للأعراق العليا حقًا عمليًا على الأعراق السفلى". هذه "العلمانية" الانتقائية أوجدت نزعة فلسفية تدعى المركزية "الكونية" واحتكار العلم والحضارة مع الإقصاء للآخر المختلف أو كما يسميها البروفيسور [روبرت سولمون] "ثقافة الهيمنة" وهذا ما حدا بالباحث الإنجليزي "ريتشارد ويبستر" يتساءل "هل هذه عملية ارتدادية لعصاب جماعي تحاول من خلالها ثقافة سلفت أن تحيا مرة أخرى لحظة من طفولتها؟ وهل هو أمر مختلف ربما تكون حال دعت العلمانية إلى إسقاط قناعها العقلاني من أجل أن تكشف في لحظة ما عن هويتها الحقيقية والتي هي في عمقها هوية دينية؟ويضيف ويبستر ـ وإذا ما فهمنا تراثنا على نحو أفضل فإننا سنبدأ بالشك في أن العلمانية بدلًا من أن تكون قد هزمت التراث المسيحي اليهودي فإنها عبرت عن تفوقه الكبير وما أريد افتراضه هو أنه إذا كانت القيم الدينية لا تلعب دورًا مهمًا في المجتمع العلماني، فهذا لا يعني أنها تركت أو همّشت، وإنما دليل على مدى دخولها إلى داخل الفرد وإلى هويتنا العلمانية إلى الدرجة التي لا نحتاج معها إلى إظهارها في أي شكل خارجي"!! إذًا القضية أبعد من كونها نظرة سطحية ساذجة أو عاطفية عابرة لذلك فإن ازدواجية الطرح تجاه الإسلام لها من الخلفيات ما يجعل المحلل أو الباحث يفقد معايير الدقة والمصداقية، ومنها موضوع "الأصولية" ومع الاختلاف البين في المصطلح فإن الغرب لا يزال يصر على تسمية الإسلام وربطه "بالأصولية" وفق مفهوم المسيحي الكنسي في القرون الغابرة. "والأصولية في الإسلام" تعني الالتزام بقواعد السلوك والقيم في عصره الأول. وكما عرفه السلف الصالح في الفقه والاجتهاد ومقاصد التشريع..إلخ لكن الأصولية في الغرب هي النظرة المتزمتة التي تحارب العلم والاختراع والعصرنة وهذا ما ينكره الإسلام.أما موضوع العنف والتطرف والإرهاب الذي يجتاح عصرنا الراهن فإن المؤثرين في صناعة القرار في الغرب يحاولون أن يلصقوا هذه الظاهرة بـ"أصل الإسلام" وطبيعته الكامنة فيه، وهذا غير صحيح. فالإسلام وأصوله التشريعية ترفض مبدأ العنف وتنكر الإرهاب والتطرف مهما كانت أسبابه، وقد لا نتجاوز القول إن جزءا من ظاهرة العنف والإرهاب ترجع إلى ما اقترفه الغرب ومظالمه وازدواجية معاييره إذا ما أردنا الدقة والموضوعية..لذلك فإن الأولوية في القضاء على هذه الظاهرة هي العدل في الحكم على الأشياء والظواهر من دون محاباة أو كراهية، وبغيرها سيكون العلاج كمن يقاتل طواحين الهواء مثلما فعلها دون كيشوت.
536
| 17 أبريل 2016
لا شك أن المعلم في بلادنا العربية، مع بعض الاختلاف بين دولة وأخرى، لم يلتفت إليه بالشكل الذي نتوخاه من الرعاية والاهتمام، بالقياس للجهد الذي يبذله ويؤديه لأجيال المستقبل، من معارف وعلوم ونظم وغيرها من المهام التربوية، وهذا الأمر موجود منذ عقود ولا يزال، فإصلاح التعليم، يقع في أغلبه على ما يقدمه المعلم، وما يملكه من أدوات ووسائل لنجاح العملية التعليمية، وإذا لم يتم إعطاؤه وتزويده وتقديره بالصورة التي تدفعه إلى الإبداع والبذل، فان الكثير من الأفكار والتمنيات في هذا المضمار، لن تتحقق بالصورة التي نتوقعها. ومن ضمن هذا الأمور الغائبة (الرعاية والاهتمام بالموهوبين والمبدعين) من طلابنا وطالباتنا في السنوات الأولى، وتوجهيهم وتحفيزهم بالصورة التي تنمي هذه المواهب وتحفيزهم للانطلاق، والاستفادة من قدراتهم المختلفة، وفق الموهبة الذي يتم اكتشافها منهم، ولا شك أن لدينا الكثير من التلاميذ المبدعين والموهوبين، ولكن لم يعطوا الفرصة الكافية، ولا ذلك الاهتمام والرعاية، وهذه ظاهرة عامة في كثير من الدول العربية للأسف، حتى يمكن تنمية وصقل مواهبهم وابتكاراتهم، وتسخير الجهود والإمكانات لتنمية هذه الإبداعات التي ممكن أن تخّرج لنا كفاءات علمية ومعرفية متعددة، لو أننا أفسحنا لهم ما يملكونه من طاقات كبيرة، ولو وضع الاهتمام للطفل في سنوات الأولى ليكون من العوامل المساعدة على خلق دافعية لديه في السنوات الأولى للدراسة، حتى تمييز الطالب الموهوب ورعايته، بصورة مختلفة عن أقرانه الطلاب في المدارس العادية، وهذه مهمة لاكتشاف قدراته الإبداعية، فالمدرسة العادية، تولي الاهتمام للمواد الدراسية العامة، لكن هناك مواهب موجودة عند بعض الطلاب لا يلتفت إليها كثيرا، ومع الوقت تضيع هذه المواهب في غياب عدم الرعاية والتشجيع والاهتمام، وهذه للأسف طاقات مهمة نهدرها في غياب هذا الاهتمام الذي له استجابة كبيرة في الكثير من الدول المتقدمة. قد يقول بعض من التربويين أن وقت المعلم في الاهتمام بعدد قليل من التلاميذ، فيه ضياع لوقت مئات التلاميذ، ووقت المعلم محدود، وهذه تحتاج إلى وقت وإلى خطوات إدارية ومالية، ومدارس أخرى الخ: وهذا للأسف يجعلنا يهدر وقت طاقات طلابنا الموهوبين وقتل إبداعاتهم، الذي قد يستفيد الوطن من طاقات بعضهم في المستقبل في شتى التخصصات، وقد نكتفي بخبراتهم عن خبرات الآخرين، وهذه فرصة لو تم التخطيط لها من قبل مجلس التعليم، ووضع لهذا من يضع لهذا الأمر المهم الاهتمام الذي نتطلع إليه. وتشير بعض الدراسات التي أجريت على عينات كبيرة من الأطفال الموهوبين والأطفال العاديين في بعض الدول، ومنها دراسة د/ إبراهيم ناصر، إلى أن الموهوبين عمومًا يتمتعون بقدرات عقلية عامة خاصة تفوق غيرهم من العاديين، وأنهم يهتمون باهتمامات علمية وفنية وأدبية وميول تطبيقية للجوانب النظرية، كما يتوافرون على دافعية للتعلم، ويفكرون مليًا في حل المشكلات وقدرة عالية على طرح الحلول والبدائل للمشكلة الواحدة، والأطفال الموهوبون ليسوا جميعًا على وتيرة واحدة في القدرات والاهتمامات، بل يختلفون عن بعضهم البعض شأنهم في ذلك شأن الأطفال العاديين فمنهم من يمتلك خصائص وقدرات عقلية عالية في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية والتقنية. إن الوقت قد حان أن نلتفت للموهوبين من تلاميذنا في السن اليافعة للدارس، وأن نخطط بصورة سريعة لهذا الجانب المهم، ويذكر بعض المعلمين، أن المواهب الطلابية ندركها ونرى تفوقها في بعض المواد بصورة غير عادية ومتميزة عن بعض أقرانهم، لكننا لا نملك القدرة أن نعمل شيئا لهؤلاء، لأننا مكلفون بحصص، قد تكون في بعض الأحيان مثقلة لنا، أو فوق طاقتنا، فكيف نستطيع أن نخصص لهم وقتا لنتابع إبداعاتهم ونراعيها وننميها، وهذا كلام منطقي لا غبار عليه، ويحتاج إلى قرار من الجهات المسؤولة عن رعاية الموهوبين والمبدعين، ولا بد من خطوات يتم إعدادها بصورة علمية مدروسة، حتى يتحقق لهذه الخطوة النجاح المأمول. أيضا مدارسنا تحتاج إلى وسائل التقنية في التعلم، وإلى ربط المعلومة بالصورة، وهذه الآن أصبحت من الضرورات المهمة للطلاب، لترسيخ أي معلومة من خلال عرضها، فتنمية قدرات التفكير الإبداعي لدى الأطفال والطلاب عن طريق البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة باستخدام الأساليب العلمية المحكمة ووضع البرامج الإرشادية والأدلة التي تساعد المعلمين والمربين على تهيئة الظروف الملائمة والمشجعة على الإبداع، وهذه مسألة أصبحت من الضرورات الراهنة، لأن العصر أصبح في تحولات كبيرة، والطرق القديمة في التعليم لم تعد قادرة على الجذب والاهتمام، الآن بعض الطلاب في السن الصغيرة، لديهم، الهواتف النقالة، وبها وسائل المعلومة بين يديه، فلو المعلم أعطاه دروسا على (السبورة) ، دون أن تكون مرتبطة بالتقنية الحديثة والمعلومة بالصورة، قد لا تلقى عند الطالب ذلك القبول المأمول ذهنيا ونفسيا، لأنه ـ الطالب ـ يجد فجوة كبيرة، بين ما يجده بين يديه من وسائل اتصالية ومعلوماتية متعددة، وبين الطريقة القديمة في التعليم، دون أن تكون مرتبطة وحاضرة بالصوت والصورة، لذلك علينا أن نساير عصرنا، ونراعي التحولات العلمية في وسائل التقنية، لربطها بالتعليم والدافعية للمبدعين والموهوبين. لابد أن لذوي الشأن أن يضعوا الجديد والمفيد والضروري من الأفكار والوسائل لطلابنا ومعلمينا، سواء في مسألة رعاية الموهوبين والمبدعين من الطلاب في السنوات الأولى، أو إصلاح التعليم عموما، أو تقدير المعلم وتأهيله، بما يحقق الأهداف والمرئيات التي تسعى الجهات المعنية بالإبداع والمبدعين، ومنها ما ذكرناه من حاجة مدارسنا جميعا، إلى الوسائل العلمية والتقنية أثناء التعلم، ووضع خطة لرعاية الموهوبين والمبدعين، وهذا ما نتمناه بإذن الله.
1381
| 10 أبريل 2016
بعد وصول الحكومة اللبيبة الجديدة إلى طرابلس برئاسة فايز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة وأكثر الأطراف الدولية تأثيرًا، يبدو أن المصالحة الليبية قريبة لو تجاوب البعض مع حكومة الوفاق التي تتحرك بحكمة لإنهاء الخلاف السياسي في كيفية إنهاء التوتر وإقامة حكومة وفاق وطني يشارك فيها الجميع دون إقصاء، وهذا ما أكده مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن إبراهيم الدباشي من أنه لم يعد أمام الليبيين خيار سوى حكومة الوفاق الوطني، للخروج من المأزق الراهن الذي تمر به البلاد، ودعا المجتمع الدولي إلى مد يد العون لهذه الحكومة. كما قال فايز السراج رئيس الحكومة الجديدة "لقد حان الوقت لقلب صفحة جديدة وللمصالحة"، مشددا على أنه يسعى لبناء مؤسسات الدولة وفرض وقف إطلاق نار. ولا شك أن هناك عقبات وتحديات تواجه الحل النهائي في ليبيا، من قوى عديدة، بعضها للأسف لا يدرك الآثار الخطيرة لاستمرار الصراع، والذي قد ينذر بتدخلات دولية، وهذا سوف يجر ليبيا إلى مستنقع الحرب الأهلية وربما دولية لفرض الحل على الليبيين، ولذلك فإن جهود الكثيرين من السياسيين الليبيين المخلصين، يدركون هذه المخاطر الكبيرة للصراع الداخلي بين القوى المختلفة، ويتحركون بدعم عربي ودولي لإيجاد الحل الذي يتوافق عليه القوى السياسية، ومن المهم أن تعرف كل القوى في ليبيا ألا منتصر منهم في هذا الصراع، وأن الاتفاق والتوافق وتقديم مصلحة الوطن الليبي هو الذي يقدم على كل المصالح الذاتية، وأن هذه الدماء التي تسفك على الأرض يوميًا هي التي ستجر الأحقاد وربما الانتقام بعد ذلك، وكما حصل في دول عربية عديدة، ومن الأجدى والأفضل لكل القوى السياسية أن تتنازل عن المصلحة الشخصية، لمصلحة بلد يتجه لمخاطر لو لم يجد الحل الذي يطلبه الشعب الليبي في الفترة المقبلة، بل بالعكس فإن بعض الليبيين الذي كانوا معارضين، أو ضد سياسة العقيد الراحل معمر القذافي، يتمنون أن يكون حكمه قائما، بعدما شاهدوا ورأوا القتال والتوترات والانقسامات، وهذا ما حصل في العراق أيضًا، الذي فيه البعض يتمنى حكم الرئيس الراحل صدام حسين، حيث أصبحت مظاهر الطائفية والمذهبية تطغى على كل التنوع الرائع في بلد متعدد، ولذلك من الضروري أن يسعى الجميع إلى الاتفاق على القضايا الكبيرة لتحقيق الاستقرار. ويقول الكاتب والباحث المغربي حسن السوس: "لعل التساؤل المطروح بقوة في مختلف أوساط المتابعين للأزمة الليبية وتطوراتها يدور حول مدى قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ قرارات صارمة في حق الأطراف المعرقلة للحل السياسي في ليبيا، بعد اللقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتباحث حول تطورات الملف الليبي، وحيث تم التشديد على وجوب توحيد صفوف الفرقاء من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إنهاء الأزمة السياسية وتثبيت مؤسسات الدولة، لاسيَّما أن الفراغ السياسي السائد في ليبيا تسبب في أزمة اللاجئين وخلق ملاذا آمنا لتنظيمات مثل داعش. فهل يشكل هذا مؤشرا على مغادرة مواقع التراخي والتساهل مع الجماعات المتطرفة المسلحة في ليبيا لدخول مواقع الحزم والجدية في مقاربة الأزمة واستخدام كل الوسائل المشروعة في القانون الدولي للدفع بمسألة الحل السياسي في ليبيا إلى رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي؟ وأن تحولا ما قد حصل في الموقف الأمريكي الموسوم بالضبابية والغموض من قبل عدد من المراقبين والخبراء في مجال الأمن إقليميا ودوليا؟".ومن الصعب التكهن بما سيجري في الأشهر المقبلة بعد إنجاز الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لكن ثمة تفاؤل بتوافق بين الجميع، لأن الدستور الجيد، سيجعل من الجميع أكثر إيجابية للحل، ولأن البديل هو الأخطر إذا ما عرقل البعض الحلول المتوازنة، بحجج غير مقبولة، لكن بعض التصريحات من اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي في صلالة متفائلة بما جرى في هذه اللقاءات من الأسبوع الماضي، حيث أكدت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي د. نادية عمران في تصريح حصري لـ"الشبيبة العمانية أن "أعضاء الهيئة التأسيسية أنجزوا خلال وجودهم في صلالة قرابة 80% من المواضيع الخلافية بشكلٍ عام، وبقيت بعض النقاط الخلافية ومنها المكونات، واعتماد عاصمة لليبيا. وقالت مقرر لجنة العمل في الهيئة التأسيسية د. نادية عمران، يوم أمس الجمعة: "لقد توافقنا على حقوق المرأة، كما تم التوافق حول موضوع الغرفة الثانية، والنقاط الخلافية في موضوع الحكم المحلي، وفي آلية انتخاب الرئيس، فقط بقيت بعض الأمور الفنية في التدبير الانتقالي في موضوع انتخاب الرئيس، وقد شكلنا لها لجنة مصغرة". وأضافت أن أكثر الموضوعات إشكالية والتي لا تزال قائمة تتعلق بـ"المكونات، وقد شكلنا لجنة مصغرة لها، حيث إن للمكونات طلبات لا يزالون متمسكين بها، لذا لا تقدم في موضوع المكونات، لكن لم يصدر التقرير النهائي حتى الآن". وتابعت عمران في حديثها أن أعضاء اللجان التي تم فرزها "كلهم يمثلون مناطق ليبيا (الشرق، الغرب، والجنوب) ، كما هو التمثيل في أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي والذين اجتمعوا في مشاورات صلالة". ليبيا الآن في مرحلة دقيقة ومهمة وخطيرة، وفي منعطف يحتاج لتكاتف الجميع، اتفاق على دستور يوحد الجميع ويتناسى الخلافات السياسية، لأن ليبيا تتسع للجميع، ومن المنطق أن يقبلوا بعضهم للخروج من الظرف الراهن الصعب والدقيق.
550
| 03 أبريل 2016
من خلال التحركات الدولية ونشاط المفاوضات الأخيرة في جنيف، فإن المؤشرات تبدو في الظرف الراهن أقرب للحل السلمي، وهذا يعني أن هناك رغبة وجدية للحل السلمي من الجميع، بما فيها الدول الكبرى المؤثرة في الأزمة السورية، لتفادي ما أخطر بعد ذلك، لكن المشكلة تكمن في التفاصيل التي تسهم في الخلافات، والتي يبدو أنها قد تثير، أو تؤخر الحل السريع للأزمة السورية التي أرقّت الشعب السوري، بل والمجتمع الدولي والعربي عمومًا بعد خمس سنوات من الصراع، ولا شك أن المفاوضات التي جرت الأيام الماضية، لا تزال متأرجحة، ولم تسفر عن تقارب وجهات النظر، والسبب أن المفاوضين من الجانب النظام السوري، ليسوا في المستوى الذي يجعلهم قادرين على اتخاذ مواقف وقرارات، تعجل بتقارب وجهات النظر، وهذا ما قاله بعض أركان المعارضة في بعض التصريحات، وقاله أيضًا مبعوث الأمم المتحدة، (دي ميستورا) الجمعة الماضية، بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة في جنيف "إن على الحكومة السورية بذل مزيد من الجهد لتقديم أفكار تتعلق بالانتقال السياسي وعدم الاكتفاء بالحديث عن مبادئ عملية السلام.وأضاف دي ميستورا للصحفيين بعد أيام من اجتماعات مع وفدي الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية (نحن في عجلة من أمرنا) ! وأضاف مبعوث الأمم المتحدة أنه أعطى الطرفين مقترحات لتحقيق طلبه من أجل بداية أسرع للمفاوضات يوم الإثنين، وقال إنه خلال الأسبوع الثاني من المفاوضات سيسعى لبناء قاعدة تمثل "الحد الأدنى من العمل المشترك" الذي يمكن من خلاله تحقيق تفاهم أفضل بشأن الانتقال السياسي". والواقع أن أزمة ثقة بين النظام السوري والمعارضة، لا تزال العقبة الرئيسية خلال المباحثات القائمة الآن والتي سبقت في الأشهر الماضية، مع أن المبعوث الأمم المتحدة يبذل جهودًا كبيرة في تقريب المقترحات، للتغلب على الخلافات التي تحتاج إلى مقاربات مقبولة بينهما، للوصول إلى حلول تسهم في وقف الدماء السورية التي تنزف يوميًا، والذي نراه أن الحل قد يتحقق في الأشهر المقبلة للأسباب التالية: أولًا: الانسحاب الروسي المفاجئ، والذي أربك كل الأطراف، بما فيها النظام السوري، وألقى ارتياحًا لدى المعارضة المعتدلة، وكذلك بعض الدول الغربية. ويرى الكثير من المحللين أن هذا الانسحاب، ربما جاء من خلال الاتصالات مع بعض الدول الغربية وروسيا بأن الحل العسكري، لن يحقق النظام السوري انتصارًا على المعارضة التي ليست بالسهلة في القضاء عليها، ومن الأفضل لروسيا الآن ألا تقع في المستنقع السوري، وهي قد جربت تدخلها في أفغانستان وخسرت كثيرا بشريًا وعسكريًا واقتصاديًا، لكن البعض من المحللين يرى أن الولايات المتحدة، لم تعرف مسبقًا بقرار الانسحاب الروسي من سوريا، وأنها تعاملت بحذر مع هذا القرار المفاجئ، قال جوش إيرنست المتحدث باسم الرئيس الأمريكي في تصريحات له، أنه "لابد لنا من أن نعرف بدقة ما هي النوايا الروسية"، وأضاف في مؤتمره الصحفي "من الصعب علي أن أقيم التداعيات المحتملة لهذا القرار على المفاوضات الجارية، واعتبر أنه من السابق لأوانه التكهن بالتداعيات المحتملة لقرار من هذا النوع على المفاوضات الجارية في جنيف".. وهذا الموقف الأمريكي ـ كما يقول بعض المحللين ـ "يعكس ارتباكًا بعض الشيء من الخطوة الروسية، لكن واشنطن تتعامل مع الأمر بتداعياته وليس بالأخبار المتداولة على صفحات الجرائد"، لذا نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمريكية وروسية فيما بعد عن "وجود اتصال بين الرئيس الأمريكي والروسي للتباحث في القرار الروسي الأخير، وعليه ربما ستبنى الأجندة القادمة في المفاوضات". ووصف الكاتب والباحث السياسي التركي محمد زاهد غل الخطوة الروسية "بالشجاعة" التي ربما قد تكون مدخلا لإعادة تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة بعد التوتر الذي شهدته في المدة الأخيرة، ورجح أن تسهم الخطوة أيضا في خلق توازنات جديدة في المنطقة تسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وأثار غل بدوره تساؤلات حول المتوافقات التي تكون قد حصلت ودفعت بوتين إلى اتخاذ هذا القرار، وقال إن الروس الذين دفعوا دفعا لدخول المستنقع السوري، يريدون تحقيق أهدافهم بالمفاوضات بعد أن فشلوا في تحقيقها على الأرض، حيث إنهم لم يتمكنوا من دحر المعارضة السورية وتقوية حليفهم الأسد.ورأى أن الروس أدركوا أن بقاءهم العسكري في سوريا لم يعد مهما، ولم يستبعد حصول توافق بينهم وبين الأمريكيين بهذا الشأن، وأن الإيرانيين أيضا أدركوا عجزهم عن تحقيق أي نصر على حساب المعارضة والشعب السوري، وحذر الكاتب والباحث السياسي السوريين من محاولات الالتفاف عليهم، وهذه المرة عن طريق المفاوضات".ثانيًا: لا شك أن أوروبا تشعر بقلق بالغ، بعد تدفق مئات الألوف من المهاجرين السوريين إلى أوروبا جراء هذا الصراع بين النظام والمعارضة المسلحة، وهذا ما جعل التحرك الغربي سريعًا لمنع تفاقم الأوضاع في المنطقة عمومًا، وفي سوريا على وجه الخصوص، ومنع زيادة المهاجرين من الأراضي السورية إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، وهو ما تسعى إليه أوروبا وأمريكا، لدفع لتحقيق حل سلمي في أسرع وقت ممكن، وأن الجميع بات يرى أن الوسائل العسكرية بين الطرفين لن تحقق الحل المنشود، لا من طرف النظام السوري، ولا من طرف المعارضة، لكن أوروبا تميل إلى استبعاد بشار الأسد من أي ترتيبات مقبلة لو تمت انتخابات بعد اتفاق الأطراف على الحل السلمي، لذلك تسعى الدول الغربية حثيثًا، مع الأمم المتحدة لتفعيل دور المفاوضات الراهنة، أو لفرض حل إذا استعصت المفاوضات بين هذه الأطراف.المؤشرات والتوقعات أن الحلول السلمية، أصبحت أقرب الحلول في الأزمة السورية، بعد انسحاب روسيا، وبروز الضغوط على حزب وإيران، في عدم الانجرار في مساندة النظام، لأن أوضاع الشعب السوري الآن، أصبحت مؤلمة وخطيرة، ولذلك لابد من الحل السلمي لحفظ الدماء السورية، ويتنازل النظام عن بعض أجندته السياسية للحل وتفادي التقسيم الذي تشجعه إسرائيل لأهدافها الإستراتيجية حتى لو تنازل بشار الأسد عن رئاسة سوريا في المرحلة القادمة لوقف النزيف السوري وصد تهديد التقسيم.
679
| 27 مارس 2016
الواقع أن تصوير الفتنة السياسية في العصر الأول الإسلامي بأنها معيار لعدم التسامح، كما يذهب إلى ذلك د. محمد جابر الأنصاري، نعتقد بخطأ تقديره، لأسباب كثيرة منها أن الأحداث التي وقعت، تداخلت فيها الأهواء، واختلفت الآراء والاتجاهات خاصة أنها فتنة، وجد فيها خصوم الإسلام، من بعض المستشرقين وغيرهم عبر التاريخ الإسلامي، مادة للتشنيع والتهوين من شأن تأثير الإسلام في الصحابة (رضي الله عنهم) وفي إيمانهم وتقواهم وإخلاصهم لهذا الدين القويم.. إلى جانب أن كتابة تاريخ هذه الفتنة أصابها الكثير من التحريف والتهويل حول ما جرى ـ كما يرى د.إبراهيم علي شعوط ـ فـ"المسافة التي مضت بين وقوع هذه الأحداث وبين تدوينها، من شأنها أن تجعل الحقيقة مطمورة بين أنقاض الروايات المتضاربة، والأهواء الضالة، والأغراض السيئة، التي وجدت في المجتمع الإسلامي، إبان فترة التدوين". فلا شك أن تأخر كتابة التاريخ عن هذه الفتنة السياسية إلى هذه الفترة المتأخرة، جعل الرواية عنها متضاربة وناقصة، وتحتاج إلى دقةـ تجلي الحقيقة الغامضة في جوانبها المهولة. حتى أن البعض صور هذه الفتنة بتصوير عجيب لم يخطر على بال أحد، ناهيك عن معقوليتها في ظروف نشأة الدولة الإسلامية وخطوات نموها. إذ يقول الشيخ عبد الله العلايلي عن هذه الفتنة:"إن أبا ذر لمس هذا الاستياء، وحاول أن يضع حدا للتدهور الاجتماعي السريع الذي بدأ يؤذن بالثورة على الرأسمالية الوليدة. وقد استنام إلى أفكار عبد الله بن سبأ التي تؤلف برنامجه، لأنها وافقت أفكاره، لأنه وجد فيها علاجًا لا يبعد عن روح الإسلام في جوهره، خصوصًا وأن برنامجه مرده إلى سياسة عمر "رضي الله عنه" المالية في غايته بدون النظر إلى الصيغة التي أفرغ فيها. ونحن لا ننكر أن أفكاره الاشتراكية متطرفة، ولكن التطرف دائما شأن الشعور الضيق، والمفكر بأفكار ثورية يكون دائما متطرفًا. وكذلك الشعب الثائر يكون متطرفًا على مقدار كبير". والأعجب أن تتساوى عند الشيخ عبد الله العلايلي (الثورة) الفتنة في صدر الإسلام مع الثورة البلشفية في روسيا في المنطلقات ضد الرأسمالية البغيضة!! لكن الفارق أن الثورة البلشفية قامت ضد رأسمالية عتيقة، موغلة في القدم، لكن (الثورة) الفتنة قامت ضد رأسمالية وليدة في صدر الإسلام!. وهناك (رأي ليبرالي) عن هذه الفتنة السياسية يختلف مع هذا التحليل الذي طرحه الشيخ عبد الله العلايلي، يقلل من دور عبد الله بن سبأ وتأثيره وأفكاره المتطرفة الخطيرة في جانبها الاشتراكي التحريضي.. يقول د.طه حسين في كتابه(الفتنة الكبرى) "فلنقف من هذا كله موقف التحفظ والتحرج والاحتياط، ولنكبر المسلمين - في صدر الإسلام - عن أن يعبث بدينهم وسياستهم، وعقولهم، ودولتهم، رجل أقبل من صنعاء، وكان أبوه يهوديًا، وكانت أمه سوداء، وكان يهوديا أسلم: لا رغبا ولا رهبًا، ولكن مكرا وخداعا، ثم أتيح له من النجاح ما كان يبغي. فحرض المسلمين على خليفتهم حتى قتلوه وفرقهم بعد ذلك -أو قبل ذلك- شيعا وأحزابًا. هذه كلها لا تستقيم للعقل ولا تثبت للنقد، ولا ينبغي أن تقوم عليها أمور". إذن التاريخ قد يخضع للميول والاتجاهات، بصورة لافتة تجعل الآراء تتنافر وتتقاطع،بصورة حادة،والنصوص المقتبسة تغني عن المناقشة في هذا الجانب المضطرب في تأويله. والشيء الذي نود التعليق عليه في هذا الأمر، أن الشيخ العلايلي وصف الفتنة (الثورة عنده) بأنها قامت لإجهاض الرأسمالية الوليدة، واحتجاجا على سياسة الخليفة عثمان (رضي الله عنه) المالية! لكنك تجد بين ثنايا كتابه (مقدمات لا محيد عن درسها جيدًا لفهم التاريخ العربي)، أن التاريخ الإسلامي قام على أساس ثبات القبيلة ـ يلتقي العلايلي مع الدكتور الأنصاري هنا مع بعض الآراء في تحليله السوسيولوجي في تجربة العرب السياسية ـ وهي عنده أنها "أقامت المجتمع العربي على العصبية النكراء".ولو صح هذا القول من هؤلاء في تحليلهم لما وجد في المجتمع العربي الإسلامي، بعد الفتوحات الكبيرة في العراق والشام وبلاد فارس، الأعراق والديانات المسيحية، واليهودية، والصابئة، والآشوريون، والفينيقيون، واليزيديون، وغيرها من الأعراق والديانات، منذ العصر الأول حتى الآن. وأيضا كيف تجتمع هذه الصفات النافية لبعضها البعض، الثابت القبلي والنعرة العصبية، مع الأفكار التقدمية الاشتراكية! بمقاييس عصرنا مثل الثورة على الرأسمالية الوليدة، في بدايات الدولة الإسلامية. ويرى الباحث وليد نويهض أن "المفاهيم العامة التي توصل إليها العلايلي لا تخلو من إسقاطات أيديولوجية تتحكم فيها النزعة المعاصرة، في قراءة تحولات تدين بقوة إلى فضاءات ثقافية تخضع بدورها إلى عناصر مركبة من المكان والزمان، فتركيز العلايلي على النزعة القبلية كتفسير وحيد لحركة التاريخ أدى به إلى إهمال عناصر أخرى أسهمت في صنع الحدث وإنتاجه، فهو لا يجيب عن أسئلة معلقة تتعلق بـ: لماذا انتصر الإسلام إذا كان التدين ضعيفًا إلى الحد الذي قاله؟ ولماذا نجحت أقلية صغيرة ومطاردة في فك عزلتها وتحولها إلى قوة نجحت لإنزال الهزيمة بالمعسكر المضاد في مختلف معاركها العسكرية والسلمية". ولا شك أن العامل القبلي كان ضمن العوامل التي اشتركت في التحول الذي طرأ على مسار الدعوة الإسلامية، لكنه ليس العامل الوحيد، بل إن الإسلام استطاع أن يضعف دور القبيلة ويتجاهلها، عندما وضع الرسول (ص) الصحيفة ـ دستور المدينة ـ دمجت كل الطوائف والعشائر في هذه الأمة الواحدة الجديدة. وشملت غير المسلمين أيضًا، وهذا يرجع إلى دور النص (القرآن الكريم، السنة النبوية) في التوحيد والتآخي والنصرة بالحق، وتحقيق العدل وغيرها من الجوانب التي وضعها الشرع الإسلامي، ولذلك (فالقوة الإسلامية الجديدة) لعبت دورًا في لحظة تاريخية محددة، في تفكيك عناصر التحالفات القبلية السابقة، وأعادت دمج العناصر القبلية وتوحيدها في مشروع سياسي ثقافي أرقى من السابق. وهو أمر يفسر انتقال القبائل من مرحلة التحالف التضامني، إلى مرحلة الاتحاد الاندماجي تحت راية الإسلام".
593
| 20 مارس 2016
يرى الباحث وليد نويهض في رد على بعض الآراء الاستشراقية التي حاولت التقليل من التأسيس الإسلامي لكيان الدولة في العصر الأول بكل مقوماتها "إن محاولة إيجاد تقابل أو التفتيش عن تماثل، بين الدولة المعاصرة والدولة العربية الإسلامية" ستقع في مطب فكري لا هدف منه سوى التأكيد على مقولة أيديولوجية لا عناصر واقعية لها في التاريخ الإسلامي. فهناك أولا فجوة تاريخية (15) قرنا بين الدولة المعاصرة في نموذجها الأوروبي والدولة الإسلامية كما ظهرت في عصر النبوة. وهناك ثانيا قراءة جامدة لنظرية تطبق على واقع، ولا تنطبق بالضرورة على واقع آخر ومغاير. وهناك ثالثا اختلاف الحوادث والعوامل وهى تحتم رفض أخذ مقولات جاهزة، وغير نهائية ومحاولة تطبيقها قسراً على نمط مختف وتاريخ مختلف". ومن هؤلاء الذين حاولوا إيجاد هذه الذرائع للاستدلال على نفي قيام الدولة العربية في صدر الإسلام الأول، المستشرق "فرد دونر" أستاذ التاريخ الإسلامي في مركز الشرق الأدنى في جامعة شيكاغو. واستنباط آراء بقياسات لا تمت للواقع الصحيح. وإشكالية بعض الباحثين الغربيين، لديهم أحكام مسبقة تجاه المجتمعات غير الأوروبية، ويضعون معايير غير موضوعية، بحكم الانحياز الفكري والإيديولوجي، " فأغلب المؤلفات ـ كما يقول الباحث سالم يفوت ـ التي تتناول تاريخ الحضارة تعاني خللاً في المفاهيم، واستخدامها على عواهنها، فصفة "المتحضر" توزع هكذا انطلاقاً من مرجعية محددة في إطار من الحتمية التطورية البيولوجية والأخلاقية والسياسية. فقد جاء في أحد تلك المؤلفات أن "الحضارة هي النور في مقابل الظلمة التي لا يزال البدائيون يعمهون فيها" ويذهب إلى ذات الرأي مؤلف آخر يعتبر "المعجزة اليونانية" فريدة من نوعها ومنقطعة النظير على سائر الدهور بل يبحث بعض المؤرخين، أحياناً عن أصل الحضارة، وعن مصدر انبثاقها، في المسيحية ذاتها، معتبرين غيابها في بعض البلاد سبباً لما تتردى فيه من جهالة. وسواء أكان هذا أو ذاك، فثمة ميل إلى اعتبار الحضارة نشأت في أوروبا، وأن ثمة حضارة واحدة جديرة بهذا الاسم يعتبر الغرب وريثها الشرعي إذ معه يبدأ العقل والنظام والمنهج، وهي جميعاً من سمات "المعجزة اليونانية" وما عرف من علوم ومعارف وأفكار في باقي الحضارات الشرقية القديمة، ليس من الممكن بحال وضعه في مصاف ما عرفته الحضارة اليونانية التي هي أصل الحضارة الغربية. بل إن سائر الحضارات الأخرى لم ترق حسب العديد من المؤلفين الغربيين إلى مستوى ما بلغته الحضارة الغربية مع اليونان أو بعدهم". وهذه النظرة معروفة حتى بين المفكرين الأكثر مناصرة للعلمانية والفكر الغربي عموماً، عند مناقشتهم قضية نزعة الأحكام المسبقة، والأهواء المغرضة عند بعض الباحثين الغربيين، فيما يتعلق بالتصور التاريخي للحضارة العربية الإسلامية. فهذا محمد أركون الأكاديمي البارز في جامعة السور بون بفرنسا، يعترف بهذا النمط من الأحكام التاريخية المنطلقة من ذهنية مسرفة في الأيديولوجية الضيقة عند هؤلاء المستشرقين "عند إعادة تكوين نشأة فكرة، أو معتقد، أو مؤسسة أو علم. . الخ أن يتبعوا الخط "المستقيم" مباشرة عن الإغريق ـ الرومان والكتاب المقدس [بعد حصر هذا الأخير بالمجال الثقافي] إلى الغرب الحالي، متجاوزين حقبة تاريخية (القرن السابع والقرن الثامن) ومجالاً ثقافياً (الشرق الأوسط والغرب الإسلامي) رغم أنهما ملازمان لما نسميه بالفضاء الإغريقي السامي. ومن أبسط البديهيات التي يعرفها حتى غير المتخصص في العلوم السياسية. أن مقومات الدولة استكملت في (يثرب) -المدينة بعد ذلك- التي أقامها الرسول (ص). ثم سارت عليها الخلافة الراشدة. ومارست كل مقومات الدولة بمقاييس واقعنا المعاصر. وهي كلها اجتهادات تستمد مرجعيتها من الكتاب والسنة. و"لم تترك شيئاً مما تمارسه الدولة اليوم أو كانت تمارسه الدول في القديم إلا مارسته. حاربت وسالمت. علمت وقوّمت وهذبت. جمعت الضرائب والأموال أو جمعت الزكاة والصدقات ووزعتها على المحتاجين. بنت للمنكوبين. أرسلت البعوث تبشر بما تدين به من عقيدة. واستقبلت البعث من الملوك والأمم المجاورة لها تسمع رأيها. لم تبق شيئاً من وظائف الدولة إلا ومارسته. ومع ذلك فقد امتازت عن كثير من الدول التي عرفت بعدها. إلى أن اكتشف الناس سبب هذا التمييز فاقتبسوه منا وجعلوه شعاراً لذلك الكيان الاجتماعي الذي نسميه الدولة ذلك الامتياز كان مصدره قاعدة عجيبة في ذلك الوقت هي قاعدة تقيد الدولة بالقانون". وهذا ما برز في صحيفة المدينة - دستورها بمفهوم عصرنا حيث قننت مقومات الدولة والأمة في السلب والحرب. والتعاهد والتضامن والتآزر. وشمل أيضاً غير المسلمين من مواطني هذه الدولة ويختلفون مع المسلمين في الدين مثل اليهود وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً. وللحديث بقية..
478
| 13 مارس 2016
لعل اعتراف الرئيس الأسبق لليمن الجنوبي علي ناصر محمد بالأخطاء الفادحة التي وقعت في هذا البلد، نتيجة التطبيقات السلبية، والتجاوزات، وخنق الحريات، تغني عن أي تفسير آخر، وتتجاوز عن الحديث في تأثيرات القبلية في الصراعات الداخلية، ففي حديث صحفي قال علي ناصر:" لقد كانت الدولة تمارس صلاحياتها بشدة مما أدى إلى إيذاء الكثير من المواطنين. ففي بدايات التجربة عومل القطاع الخاص كعدو، وعطل بالكامل، ما انعكس سلباً على الحياة الاقتصادية والتنمية. وكان المهمش الديمقراطي في حياة الناس شحيحاً، بحيث لم يسمح بالعمل السياسي إلا من خلال الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان هو نفسه يعاني من ضيق المهمش الديمقراطي للتحرك في أوساطه، الأمر الذي أدى إلى تصفيات دموية للعديد من قياداته، وأوصله في الأخير إلى الانفجار الذي حصل في يناير 1986". القضية أعمق من اختزالها في مقولات، وتوقعات غير محفورة في جسد الفكرة نفسها، وفوق ذلك من قال إن الماركسية نجحت وحققت صموداً في العالم المعاصر؟ إذا كان واقعنا فقط هو الذي يرزح تحت غول القبلية، ولا يترك فرصة للتطبيق الهادئ المتقن، فالماركسية نفسها حملت معاول هدمها، فماركس، كما يقول د/مصطفى محمود: " لم يقدم علماً.. ولا كانت اشتراكيته علمية.. ولا أفكاره موضوعية لهذا أخطأت جميع تنبؤات كارل ماركس وأخطأت حساباته. فلم تخرج الشيوعية من إنجلترا المتقدمة صناعياً، وإنما خرجت من الصين الزراعية وروسيا المتخلفة.. ولم ينقسم المعسكر الرأسمالي وينهار ويتناقض، وإنما انقسم المعسكر الاشتراكي وتناقض وتصارع..(ثم سقط في سنة 1991م)ولم تتفاقم الهوة بين العمال الكادحين وأصحاب رؤوس الأموال المرفهين بل ضاقت".ثم إن مقولة "الحتمية" لحركة التاريخ مقولة غير علمية، لأنها مجرد احتمال أثبت الواقع انحرافها وسقوطها" لكن النظرة الموضوعية العلمية والأمينة، لا تقول بأكثر من الترجيح والاحتمال في أمثال هذه المسائل.. فالقوانين الإحصائية كلها قوانين احتمالية وكلها ترجيحات لا يرتفع أحدها إلى مرتبة الحتمية أو الإطلاق، ومن هنا تكون كلمة "الحتمية التاريخية" أو "حتمية الصراع الطبقي" كلمات غير علمية. ثم إن الإنسانيات لا تجوز فيها الحتمية.. لأن الناس ليسوا كرات بلياردو تتحرك بحتمية فيزيائية.. لكنها مجموعة إرادات حرة تدخل في علاقات معقدة، يستحيل فيها التنبؤ بناء على قوانين مادية وأصدق مثال على كذب دعوى الحتمية الطبقية ما رأيناه في حالات متكررة. فقد رأينا الإقطاعي ابن الإقطاعي تولستوي يتصرف بعقلية بروليتارية، فيوزع أرضه على الفلاحين.. أين ذهبت الحتمية هنا.. ولماذا لم يتصرف بمقتضى طبقته وبالمثل الفوضوي كروبتكين. بل وكارل ماكس نفسه ابن الطبقة البرجوازية الذي ثار على البرجوازية، نحن هنا نفاجأ بالعقل وقد رفض أن يأخذ شكل ظروفه وبيئته.. بل ثار عليها ونهض لتغييرها" إذن ليس دقيقا، ما قاله الدكتور محمد جابر الأنصاري، حول الأزمات العربية، وردها إلى القاع السوسيولوجي، وتأثير العقلية القبيلة فيما جرى ويجري في واقعنا العربي، وتجاهل قضايا لاصقة ومتأصلة في جسد هذا الواقع وأزماته. ومن ضمن الآراء التي طرحها د/ الأنصاري، أن الدولة العربية الإسلامية "لم تجد لها قاعدة دولة تتأسس عليها في المجتمع العربي القديم، فلم هناك من بنى دولة وهياكلها وتقاليدها وتجاربها، ما يساعد على انطلاق دولة كبيرة وواسعة النطاق كالدولة الإسلامية، بل كان التكوين السياسي المجتمعي ببناه القبلية المتعددة. يمثل النقيض لبنية الدولة وثباتها ونموها المتدرج غير المنقطع". وهنا يتجاهل د/ الأنصاري رأيه السابق الذي طرحه في كتابه (تكوين العرب السياسي) عن الآثار المكتشفة المتعلقة بوجود حضارات ومدن عميقة الجذور في الجزيرة العربية مدنيا وحضاريا. ففي الكتاب يقول د/ محمد جابر الأنصاري" الواقع أن نشوء هذه المستوطنات الحضرية، دليل على مدى الجهد التحضري". مضيفا في فقرة أخرى" فمع الاطلاع على المصادر المدونة بالعربية الجنوبية والمصادر الأجنبية والتنقيبات الأثرية، بدأت نظرية الأصل الصحراوي بالتهاوي. وظهرت إلى الوجود جغرافية سكانية وطبيعية مختلفة عما هو شائع بتراث عربي مجهول، ذي طابع مدني لم يكن معروفا. وظهرت دلائل على وجود تجمعات كتابية وتجارية وصناعية في عهود مغرقة في القدم، على السواحل وعلى امتداد شبكة طرق تجارية أشهرها تجارة العطور". وهذا الذي قاله د/ الأنصاري في مسألة الأصل الصحراوي، في مباحثه السابقة ليس جديدا، بل نجده في أغلب كتبه وأبحاثه ومقالاته، ولم يتزحزح قيد أنملة عن هذا الرأي، ففي ندوة [الغزو العراقي للكويت: الآثار المستخلصة والخروج من الأزمة]، قدم الأنصاري ورقة بعنوان (بنية الثقافة السياسية والسلوك العربي) قال ما نصه: "إن العرب على مدار تاريخهم لم يجربوا الحياة في ظل دولة منظمة ثابتة ودائمة بالمعنى التقليدي المتعارف عليه للدولة. صحيح أنهم عرفوا السلطة والحكومة، لكن السلطة شيء وبناء دولة مؤسسية شاملة شيءآخر". والحقيقة أن القراءة التاريخية لنظرية الدولة في التاريخ العربي الإسلامي من خلال الواقع الراهن، أو تمثل الدولة الأوروبية المعاصرة، والقياس عليها سيكون مبتورا وغير علمي بمقاييس حاضرنا الذي بلا شك يختلف كثيرا عما استلهمته التجارب التاريخية، ومنها نموذج الدولة في أوروبا.. فالدولة الحديثة ـ كما يقول الباحث وليد نويهض ـ التي تطور نموذجها في أوروبا بعد عصر الاكتشافات الجغرافية، والسيطرة على السوق الدولية ليست موجودة في الفكر الأوروبي نفسه. والدولة الحديثة التي نهضت بعد الثورة الصناعية وتوحيد السوق القومية بفضل تراكم الفائض من السوق الدولية، ثم ارتسام معالم الدولة والمعاصرة، للفصل بين مصالح السوق (الدخل القومي) وحاجات السيطرة الدولية (الخارج) في آسيا وإفريقيا، فإن فكرتها أو نظريتها السياسية ثم إنتاجها لاحقا في ضوء التطورات التي شهدتها العلاقات الدولية وتحول أوروبا إلى مركز وآسيا وإفريقيا إلى أطراف". وللحديث بقية..
813
| 06 مارس 2016
في كتابه (العرب والسياسة: أين الخلل؟)، ربط الدكتور/ محمد جابر الأنصاري بين سقوط الأيديولوجية الماركسية في اليمن الجنوبي سابقا، وبين العقلية القبلية، أو كما يسميها "القوى المتأصلة في المجتمع" باعتبار أن الأخيرة نقيض الدولة في المجتمع العربي، وهو في أغلب أبحاثه، يرد كل مشكلات الأمة إلى القبلية، دون أن يشخّص جيدا، التطبيقات التي حصلت في الواقع العربي، من استيراد الأفكار والنظريات من خارج الأمة، فيرى د/ الأنصاري أن الايدولوجيا الماركسية "تجاهلت في تنظيراتها وأدبياتها هذا الواقع القبلي، وقفزت عليه نحو مقولات وتعميمات الصراع الطبقي، والتضامن ألأممي ونحوهما.. إلى أن انفجر الصراع القبلي ـ الطبقي ـ من قاعدة التنظيم الحاكم إلى قمته، وأفاقت عدن واليمن الجنوبي على حرب قبلية، لم تشهد لها نظيرا في أكثر عهودها "قبلية"، وذلك من خلال أحداث عدن الشهيرة في عام 1986، والتي انهار فيها النظام الماركسي في حقيقة الأمر، رغم بقاء أحد أجنحته في السلطة. في أول انهيار لنظام ماركسي في سلسلة الانهيارات العالمية".والحقيقة أنني أختلف مع هذا التحليل للدكتور الأنصاري عما جرى للنظام الماركسي في جنوب اليمن من صراعات داخلية سياسية داخل الحزب الحاكم وأجنحته المتصارعة، فبدلا من أن يقول محمد جابر الأنصاري، إن هذا الانهيار جاء بسبب الإيديولوجية الماركسية نفسها، واختلال تطبيقاتها واقعيا، خاصة أنه ذكر سلسلة الانهيارات التالية، ويقصد بذلك سقوط المعسكر الشيوعي في أوروبا الشرقية، وعلى قمتها الاتحاد السوفيتي، رمى بأسباب هذا الانهيار إلى القبيلة! ويعرف د/ الأنصاري أن القبيلة والعشيرة ليس لها وجود في أوروبا الشرقية، ومع ذلك انهارت النظم الماركسية بدولها وأحزابها بطريقة مذهلة حيرّت الأعداء قبل الأصدقاء، وحتى يدعم د/ الأنصاري فرضيته في لصق الإشكالية بالقبلية ذيولها التقليدية، فإنه استعار نصا من مطاع صفدي تبريري للماركسية فيقول في وصف درامية الحرب بالقبلية" إذا بالصراعات الإيديولوجية تنزاح في لمحة عين لتحل محلها كل بدائية الشعائر القبلية، فتنهار القواميس المار كسوية تحت ضربات التسلط ونزعات الثأر الجماعي والثأر المضاد، أي يبرز إلى الوجود ذلك النموذج التاريخي، وهو أورمة العصبية القرابية والدموية ليحكم ويحطم كل الانتماءات الإيديولوجية المستحدثة والملصقة على جبين الإنسان وجسده من الخارج فقط".ولا أدري كيف استساغ د/ الأنصاري لنفسه أن يضع حكماً قاطعاً هكذا على نظام طبق أيديولوجية فشلت تماماً في أغلب بقاع العالم، حتى مع توافر الشروط الموضوعية والاجتماعية والاقتصادية لها، في تلك البلاد. وبدلاً من أن يرجع هذا الفشل إلى تطبيق هذه الأيدلوجية الماركسية في دولة عربية، أرجعه إلى الأسباب القبلية وعصبياتها المختلفة! أين هي تلك القبلية من التطبيقات الماركسية في اليمن الجنوبي [ السابق ]؟ فالذي يتابع ما جرى في هذه الدولة الفتية بعد الاستقلال مباشرة، يرى أن التطبيق نفسه حمل أسباب فشله في السنوات الأولى للاستقلال. ذلك أن تجاهل الواقع، والدين، والمجتمع المحافظ، وسارت النخبة السياسية تنفذ حرفيات المنهج الماركسي بحذافيره، الاتحاد السوفيتي نفسه، لم يكن بتلك الصرامة في هذا التطبيق! فجاءت الأزمات المتلاحقة تحفر سلباً في هذا النموذج. كانت القبيلة إذا ما أردنا الدقة، مهمشة تماماً في هذه الدولة. بل تكاد تكون محرمة من الوجود الظاهري المؤثر، لأنها حوربت فعلياً من هذا النظام الماركسي واعتبرتها من القوى الرجعية المعادية للماركسية والتقدمية، لكن الصحيح الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن صراعات النخب على المناصب والنفوذ، وعلى كيفية الخروج من الانسداد السياسي والفشل التطبيقي أدى إلى الاقتتال المتتالي. ففي البداية حاول الرئيس سالم ربيع علي أن ينفتح على الدول المجاورة، وأن يقيم علاقات دولية خارج السياج السوفييتي فجاءت النهاية المفجعة لهذا الرئيس المعروف بخلقه وتعامله الطيب. بعد ذلك انحسر الصمود الحزبي الماركسي، وبدأت الانقسامات في داخل القاعدة، وعلى القمة. وبدأ يظهر على السطح الصراع الظاهر. من هنا بدأ اللجوء إلى القبيلة، وقد كانت نائمة! لكن الحزبية الماركسية ومنطق الصراع هي التي استدعتها، لتسند الولاء الحزبي المنقسم على نفسه، ولأن العقلية التآمرية التي أفرزتها عقدة التربص والحذر عند القيادات الحزبية، جعلت الانفجار في يناير 1986 مدمراً وقاسياً. الذي أنهى الوجود الأيدلوجي الماركسي في هذا البلد، كما قال د/ الأنصاري نفسه.إن القبيلة التي احتمت بها النخب الحزبية، بعد تفاقم الصراع واشتداده، وتزايد الانسداد السياسي، كانت نتيجة وليست سبباً حقيقياً في هذا الصراع وهذا الرأي ليس دفاعاً عن القبيلة ومنطقها، لكن يشهد على خفايا هذا الصراع والاقتتال المتكرر.وإذا صدقنا مثلاً أن العقلية القبلية والعشائرية هي التي أشعلت العنف في الجنوب اليمني آنذاك، أفرزت هذا الاقتتال، وأن الأيديولوجية الماركسية بريئة براءة الذئب من دم يوسف، وافترضنا جدلاً عدم وجود القبيلة في هذا البلد العربي العريق.. فهل يمكن أن تصمد الأيديولوجية الماركسية وينجح النظام؟ في الوقت الذي فشلت فيه الأنظمة الاشتراكية وتساقطت بشكل مريع! وللحديث بقية
858
| 28 فبراير 2016
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
12909
| 20 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1773
| 21 نوفمبر 2025

شخصيا كنت أتمنى أن تلقى شكاوى كثير من...
1353
| 18 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1155
| 20 نوفمبر 2025

القادة العظام يبقون في أذهان شعوبهم عبر الأزمنة...
1134
| 18 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
966
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
909
| 20 نوفمبر 2025

نعيش في عالم متناقض به أناس يعكسونه. وسأحكي...
804
| 18 نوفمبر 2025

يُعد البيتومين (Bitumen) المكون الأساس في صناعة الأسفلت...
690
| 17 نوفمبر 2025
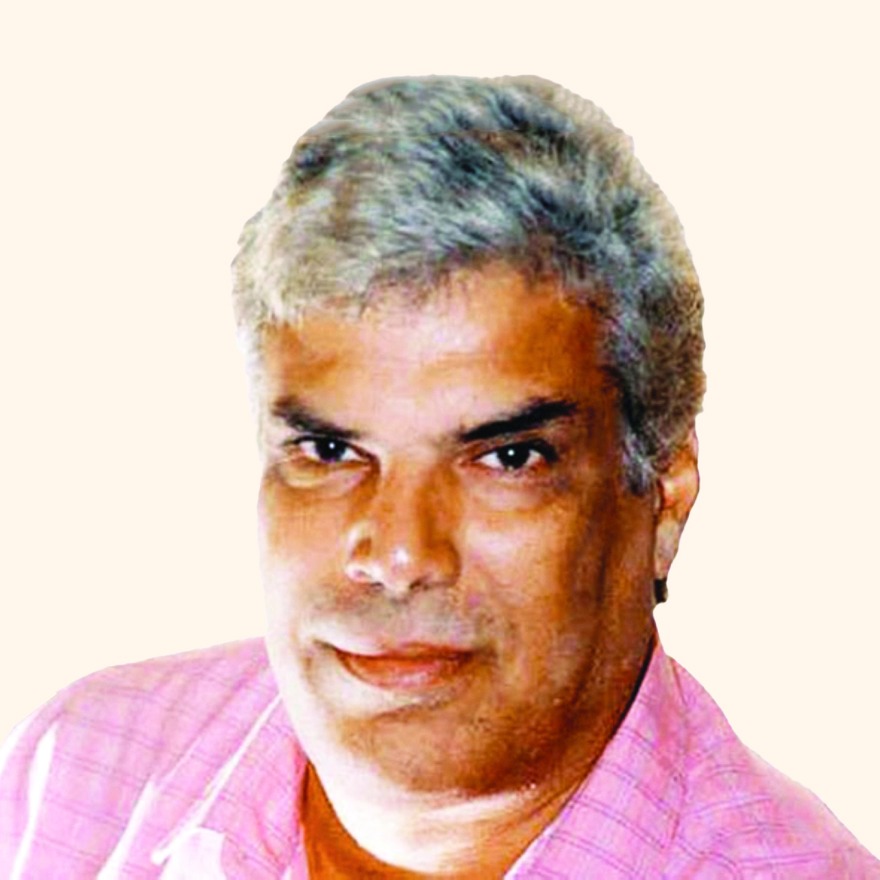
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
645
| 20 نوفمبر 2025

المترجم مسموح له استخدام الكثير من الوسائل المساعدة،...
615
| 17 نوفمبر 2025
مع إعلان شعار اليوم الوطني لدولة قطر لعام...
615
| 19 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







