رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لاشك أن التعصب بدأ يتسرب إلى كيان الأمة في السنوات القليلة الماضية، ويكاد أن يشتت وحدتها وترابطها وتماسكها، نزوعا إلى الحروب والمشكلات الطائفية الضيقة، بسبب الاختلافات المتباينة، والتي هي من القضايا الطبيعية التي تختلف الأمم والكيانات، باعتبارها من السنن الكونية، التي جعلت الناس تختلف في أفكارها ومشاربها، وفي اتجاهاتها في الأمور الحياتية والدينية، والتي تعتبر من الفروع والجزئيات، وليس من القطعيات التي تجمع المسلمين في هذا الدين القويم، مع أن المذاهب مدارس فقهية واجتهادات لعلماء، قد تصيب وقد تخطئ في هذا الاجتهاد، وليس دينا منزليا، نتعصب ونتصارع ونتقاتل لمجرد الاختلاف في الفرعيات التي جعلها الله في هذا الدين سعة ورحمة للأمة وليس العكس، والأخطر أن هذا النهج الأمة، من أسبابه التعصب والتطرف الفكر ومصادرة الحق لنفسه، وغيره على ظلال، وربما يتم تكفيره وخروجه من الملة! وهو الذي يسبق الصراعات والحروب، التي تعيشها الأمة حاليا. ويقدم ابن منظور تعريفاً وهو "أن التعصب هو أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين". وهذا ما تعانيه الأمة الآن، بعد الأزمات الراهنة، والتخندق في الأفكار الضيقة، والإشكالية في هذا الأمر القفز من الخلافات السياسية إلى الخلافات المذهبية، مع الخلاقات في المدارس الفقهية، كما أشرنا آنفا خلافات طبيعية، تمثل الاجتهادات الفكرية للعلماء في تفسيراتهم للقرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والغريب أن التعصب ازداد كثيرا في العقود الأخيرة، ربما بسبب التوترات السياسية، وبعض المؤسسات في بعض الدول الإسلامية تشجع مثل هذه القضايا، وهو سبب من أسباب التعصب لمدرسة فقهية، وهذا زاد من التوتر والخلاف من الجانب الآخر وحصل اقتتال وصراعات في بعض الدول العربية، لذلك لابد للأمة من المراجعة العقلانية إن أرادت أن تكون أمة كما عنها القرآن الكريم(خير أمة أخرجت للناس)، هذه الخلافات والصراعات، وهي نتيجة من نتائج التعصب كما أعتقد، كما أن الاستبداد والإقصاء أسهم في هذا التطرف والتكفير والغلو، ولابد من النظرة الإيجابية لمحاربة التعصب والتطرف معا، إذا ما أردنا أن نبعد مجتمعاتنا عن هذا الوباء الكبير الذي يهدد كيان الأمة واستقرارها ووحدتها وكياناتها المستقرة. والإشكالية في بروز التعصب في بعض المجتمعات الإسلامية في عصرنا الراهن، وتؤرق مجتمعاتنا، ـ كما يرى الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ـ إن الخلافات الجزئية في أمور الدين " واقع لابد منه، وتجاوزها لما هو أهم منها واقع لا بد منه كذلك! ولم أر ناساً حبستهم الجزئيات وغلبتهم على رشدهم مثل صرعى التعصب المذهبي عندنا، وأظن السبب في ذلك أسلوب تعليم العوام. إن المدرس يقول في ثقة: حكم الله كذا في هذه القضية، رأي الدين كذا في ذلك الموضوع.. فيظن المستمع أنّ ما سمع هو حكم الله ورسوله. وما ينبغي أن يذكر بهذا الجزم إلا ما قطع، أما الاجتهادات المذهبية فينبغي أن يقول المفتي أرى كذا أو الحكم عندنا كذا أو صح الدليل لدينا بكذا، ويترك مجالاً للرأي الآخر فلا يحرمه من الانتماء إلى الإسلام". حتى أن الذين يعتقدون أن الاختلافات المذهبية حول بعض القضايا الفرعية أو غيرها المتعلقة بالنص القرآني وتفسيره، فإن الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ـ كما يورده علي أومليل ـ يرى أن "اختلاف الناس حول النص القرآني لا يعني بالضرورة أن الاختلاف كامن في النص نفسه. لو التزم القوم على الأقل، بهذا التمييز لأقرّوا بأن الاختلاف بينهم طبيعي ولاعتبر كل طرف أن اختلاف خصمه إنما هو اختلاف معه هو وليس خلافاً مع النص". فالاختلاف من هذا المنطلق حالة طبيعية لاختلاف الأفهام والعقليات لمشروعية الاجتهاد، ومن هنا نرى ضرورة التركيز على مسألة التعصب الأعمى لقضايا فرعية اجتهادية، لأنها تخلق التوتر، وتقود للغلو والتطرف والتكفير، وأمتنا بحاجة ملحة إلى رؤية جديدة من خلال النخب الفكرية الدينية والسياسية والفكرية، وواجب العلماء والمفكرين والتربويين أن يسهموا في خلق الوعي والفكر لدى الأجيال من مخاطر التعصب والتطرف والغلو،
1889
| 29 نوفمبر 2015
ما جرى في الأسبوع المنصرم في العاصمة الفرنسية باريس، من قيام مجموعة من تنظيم داعش من قتل ما يزيد على مائة وعشرين شخصا من الفرنسيين الآمنين والأبرياء في المطاعم والمقاهي الباريسية، لهو أكبر داعم لنظام بشار الأسد، ومساندة لبقائه في الحكم وليس العكس، وإلا لماذا يذهبون لفرنسا، ويقتلون الأبرياء دون مبررات مقبولة، أو معقولة، ولا سبب قد يفسر. لهذا جاء هذا الاعتداء الآثم لأناس ليس لهم ذنب أو دور في السياسات التي تقررها حكومات هذه الدول الغربية، بل بالعكس فإن الحكومة الفرنسية، من الدول المتشددة في موضوع رحيل بشار الأسد من الحكم، وهذا ليس خافيا، بل هو معروف سياسيا وإعلاميا.. إلى جانب أن هذه الأفعال العدمية والعبثية، لا يقرها دين أو خلق، لأنها تخالف أبسط مبادئ القيم الإسلامية، وحتى في الحروب العدوانية التي تقوم بها دول أو أمم أخرى، في الإسلام لا يجوز الاعتداء على الآمنين، من غير المحاربين، وهذا معروف في الأدبيات الإسلامية، ومن كل المدارس الفقهية. والحقيقة أن الكثيرين في حيرة من هذه التوحش والانتقام من الأبرياء والآمنين، وهذا ما يبرز أن التطرف والإرهاب والغلو، أعمى البصر والبصيرة، وهذا ما سيعجل بنهايته، لأن الفعل نفسه مرعب وخطير على الاستقرار، وقد أصاب المسلمين أنفسهم، في المساجد والأماكن العامة في أكثر من بلد عربي، فالفكر التكفيري، هو ضد الجميع، لمجرد أنهم يختلفون عنه فكريا، لكن هذا الفعل مساند للنظام السوري، ومع أنهم يدعون أنهم يقاتلون لإسقاط النظام السوري، لكن هذا العمل الذي جرى في فرنسا، يدعم هذا النظام الذين يدعون أنهم يريدون إسقاطه! فهذه الأفعال هنا وهناك قتلا وتفجيراً، تجعل الجميع يقف وقفة موحدة لقتالهم، وليس السعي لإسقاط نظام بشار! وهذه للأسف نتاج الفكر التكفيري الذي يؤسس للقتل والتفجير وإشاعة الرعب دون هدف، وهذا ليس من الإسلام قتل الآمنين، وسوف تسبب للمسلمين في الغرب وغير الغرب، الكثير من المتاعب والمشاكل، وربما أشياء أخرى، قد تخلق للمسلمين في دول كثيرة المطاردة والتقليص من أنشطتهم الخيرية للكثير من الأسر التي تحتاج للمساعدة في كثير من دول العالم، وما أخفي ربما سيكون أعظم! إن التكفيريين – في الغالب – ينظرون إلى الآخر بمنظار قاتم، وعدسة سوداء يتحكم بها سوء الظن، ولهذا فإن الآخر عندهم أسود قاتم باستمرار، لا يملك من الحق شيئاً وليس عند نقطة ضوء أو إثارة من هدى، ولو أنهم شاهدوا إنساناً مسلماً على غير مذهبهم يؤدي فعلا عبادياً معيناً له محمل صحيح ومقبول في دين الله، وله أيضاً محمل فاسد فإنهم يسارعون إلى توجيه الاتهام إليه وحمله على المحمل الفاسد، فيكفرونه ويرمونه بالشرك أو الإلحاد، وإذا رأوه يقوم بعمل يحتمل الحلية ويحتمل الحرمة – كمن يتناول الطعام أو الماء في شهر رمضان ويحتمل أن يكون متعمداً للإفطار أو معذوراً في ذلك لمرض أو سفر – فإنهم يحملونه على الأسوأ ويحكمون بعصيانه وفسقه، ولا شك أن هذا التكفير والتطرف والعنف يحتاج إلى تحرك كبير على كل المستويات، لأن الحلول العسكرية والأمنية، لم تستطع القضاء عليه، فهناك ربما أسباب سياسية واجتماعية وفكرية تقود لهذا التطرف، ولذلك لابد أن تكون الحلول والمواجهة لهذا الفكر المتطرف متوازية مع بعض، فالكثير من الأنظمة أسهمت في تمدده بسياساتها القمعية والإقصائية. والتطرف والتكفير يقتات على هذه الأوضاع، ويستفيد من حشد الأنصار والأتباع بسبب بعض الأخطاء، ولهذا نلاحظ أن التطرف والغلو يزداد، ويتوسع، لذلك لابد من المواجهة السياسية والفكرية، والبحث عن الأسباب العميقة لهذه الظاهرة الخطيرة، والحلول العسكرية، تكون مؤقتة كما برز في السنوات الماضية، وليست حاسمة في القضاء عليه.
345
| 22 نوفمبر 2015
لا شك أن المجتمع المدني يعكس إحدى الظواهر الحديثة في التحرك الفاعل تجاه قضايا المجتمع بصورة مستقلة وداعمة لدور الدولة في إحداث تفاعل بين احتياجات المجتمعات المعاصرة، وتبني قضايا تمس حياتهم المهنية والاقتصادية، والدفاع عن مصالحهم في شتى المجالات، بما فيها مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني في العصر الحديث.كما أن المجتمع المدني الفاعل البعيد عن الأغراض والأهداف غير الوطنية، يعد من المؤسسات المهمة في عالم اليوم، لأنها تساهم في الاضطلاع بمهام جيدة من خلال العمل الطوعي في القيام بوظائف اجتماعية ذات الأبعاد، لاسيما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ويدفع بالعمل المؤسسي إلى آفاق متقدمة، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية العمل المدني، وبلورة مضامين تعددية، حتى أن البعض يرى، أنه لا يمكن أن نؤسس ديمقراطية فاعلة دون مجتمع مدني فاعل يدفع بهذه الآلية إلى أفضل خطواتها من خلال الاستمساك بالتوجهات والرؤى، كالشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان، والدفع إلى تطبيقها ولو تدريجياً في المجتمع العربي. والواقع أن مفهوم المجتمع المدني مصطلح حديث مرتبط بالتحولات الفكرية والسياسية في الغرب كمخاض فكري تم حسمه مع الكنيسة، وبظهور ما يسمى بعصر الأنوار الذي أقصى الكنيسة عن سلطة القرار والتأثير في المجتمع الغربي.لكن هذا المفهوم ليس بعيداً عن المفهوم العربي الإسلامي كممارسة تحققت في العصور الإسلامية، وهو مفهوم (المجتمع الأهلي) الذي يقوم بأدوار اجتماعية بعيداً عن دور الدولة والسلطة في المجتمع العربي الإسلامي، إلا أنه كان يختلف عن مخاض المجتمع المدني الذي برز في الغرب نتيجة صراع واضطهاد لانتزاع الحقوق، ووقف القمع والاستبداد الكنسي في القرن السابع عشر، لكن هذا الصراع لم يوجد في الإسلام. وقد لعب المجتمع الأهلي في العصور الإسلامية في القيام بأدوار رائدة سواء في المجال الاجتماعي أو الفكري أو الاقتصادي والشواهد كثيرة، ليس مجال حديثنا في هذا المقال، ولذلك فإن المجتمع المدني ضرورة هامة من ضرورات عصرنا الراهن في تأدية دوره المنوط به في تفعيل مضامين الفكرة النيرة، والطرح الإيجابي في قضايا ومفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يضمن حيوية هذه المضامين، ويدفع إلى تحقيقها على أرض الواقع.وبهذا يمكن القول إن المجتمع المدني الذي يمثل نمطا من النشاط الاجتماعي والثقافي والفكري والسياسي مستقلا نوعا ما عن سلطة الدول، وتمثل هذه الفعاليات في مختلف مستوياتها وسائط تعبير متعددة بالنسبة إلى المجتمع وقضاياه المختلفة، بما يعزز التوجه العام في قيام هذه الجمعيات أو النقابات بدور مساند للدولة وداعم لهموم المجتمع وقضاياه الوطنية.. فهو إذن مجمل البنى والنشاطات والفعاليات ـ كما يشير د/ أحمد شكر الصبيحي ـ «التي تمثل مرتكز الحياة الرمزية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لا تخضع مباشرة لهيمنة السلطة. وفي دول مجلس التعاون فإن المجتمع المدني لا يزال في بداية تأسيسه في العديد من هذه الدول». والمجتمع المدني في دول مجلس التعاون لا يزال محدوداً في نشاطاته وفي تأثيراته نظراً لحداثة نشأته، لكنه بدأ يتحرك وفق ما تسمح به النظم والتشريعات القائمة في هذه الدول، وهذا بلا شك سوف يخلق وعياً قانونياً وفكريا على المدى القريب.يرى د/ سيف الدين عبد الفتاح: أن مفهوم المجتمع المدني باعتباره المفهوم المحوري، يفرض ضرورة البحث في محتواه وطبيعته، كما يلزم الإشارة إلى ما صدقياته وتطبيقاته، خاصة إذا ما أريد ربطـــــه، على نحو أو آخر بالمجال المعرفي الإسلامي. نحن إذن في حاجة ماسة إلى مجتمع مدني فاعل، يسهم في الحراك المجتمعي، والفكري والثقافي، بما يعين الدولة في بسط القضايا والمشكلات من خلال الحوار والنقاش، والنقد البنَّاء الذي يهدف إلى المصلحة العامة في المقام الأول.
1218
| 15 نوفمبر 2015
يعتبر الخلاف السياسي بين حركة فتح، وحركة حماس، من أهم الإعاقات للقضية الفلسطينية الراهنة وتراجعها عن المشهد السياسي العربي والأجنبي، وهذا ما برز في الأشهر الماضية في الأمم المتحدة، وفي غيرها من المناسبات، واستغلال إسرائيل لهذا الظرف القائم،وكذلك الأوضاع العربية الراهنة، لتنفيذ مخططات التهويد في القدس وفي غيرها من الأراضي العربية المحتلة، ولا شك أن الخلافات الفلسطينية الداخلية ساهمت في هذا الوضع الخطير للحق الفلسطيني في المقام الأول، وباتت القضية الفلسطينية تتوارى عن المشهد العالمي في السنوات الأخيرة، وهو نتيجة من نتائج الخلافات بين الفرقاء الفلسطينيين، كما أن الصراعات العربية / العربية أيضا أسهمت في هذا الأمر ،وعززت من عدم الاهتمام بقضية العرب الأولى ، بشكل أو بآخر، لأن القضية الفلسطينية قضية عربية بالأساس ، وليست قضية فلسطينية خالصة، والحقيقة أن الوضع العربي الراهن، والخلافات الفلسطينية/ الفلسطينية، جعلت الكيان الإسرائيلي، يخطط لإعادة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، على ما كانت عليه بعد حرب 1967، وهو ما تفكر فيه الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتطرفة في الفترة الراهنة، ومنها الحزب الحاكم (الليكود)..والإشكالية أن أسباب الخلافات بين فتح وحماس تتمحور في قضايا عدة:أولاً: أن بروز حماس كحركة فلسطينية جديدة، على القضية الفلسطينية، أثرت شعبيا على حركة فتح، وهى التي قادت النضال الفلسطيني منذ منتصف الستينيات كأول حركة منظمة معترف بها من كل الدول العربية، وان كانت قيادات في حركة فتح كانت تنتمي فكريا للمشروع الحمساوي، قبل ولادته فعليا، لكن المتغيرات السياسية، وهزيمة 1967، جعلت المشاريع الأخرى المختلفة مع الفكر القومي العربي، تظهر على الساحة السياسية الفلسطينية، كقوى سياسية لها فكرها المختلف اليساري والإسلامي، كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وما تفرعت عنها من منظمات أخرى، طلعت من رحم هذه المنظمة، تتبنى نفس الفكر الماركسي، وجاء ظهورها، بعد هزيمة 67، على أثر هزيمة المشروع القومي الناصري كما يقول البعض، وقد أخفوا فكرهم الماركسي، تحت مسمى القوميين العرب، ثم ظهرت بعد ذلك حركة حماس التي كانت تنظيما تابعا لحركة الإخوان المسلمين في الأردن،وأن لها المساحة السياسية المختلة وفق الظرف القائم بفلسطين، ،فظهور هذه الحركات جاءت بعد تراجع الحركة الفلسطينية الأم (فتح)، وهذا جاء للحق لأسباب كثيرة ليس مجال مناقشتها في هذه المقالة، وربما أن الظروف التي كانت في ذلك الوقت لم تساعدها على النجاح المأمول في مشروعها التحرري منذ انطلاقتها، ودخولها مع بعض الحركات اليسارية في صراعات مع بعض الأنظمة العربية، وهذا أسهم في التراجع والانقسام في الصف الفلسطيني، وانحياز بعض هذه المنظمات الفلسطينية لبعض الأنظمة العربية، على حساب القضية الفلسطينية المركزية .ثانيا: إن الخلاف السياسي حول كيفية التحرير والنظرة إليه، بين هذه المنظمات، جعلهم يتباعدون عن التعاون والتنسيق فيما بينهم،وهذا ما جعلهم عرضة للصراعات والاقتتال، والانقسام التام حول الحلول المقبولة لمواجهة الاحتلال، وهو ما جعلهم يدخلون في صراعات مع بعضهم البعض في لبنان في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهذا ما ألحق بالقضية الفلسطينية أضرارا كبيرة على المستوى الوطني والعربي والدولي. وقد استفادت منه إسرائيل أيما استفادة في توجيه رسائل للعالم، بأكاذيب كثيرة للنيل من أصحاب القضية العادلة، والحقوق المسلوبة، ولاشك أن هذه الخلافات لا تزال متجذرة وعالقة إلى الآن، وهذا سبب لقيام إسرائيل بعمل اغتيالات كثيرة لقيادات بارزة في حركة فتح وفي المنظمات الأخرى منذ السبعينيات وحتى الآن، بهدف إضعاف الحركات، وبث أسباب الخلاف بينهم. وكان الأولى للمنظمات الفلسطينية جميعا أن تتحد في الهدف الأسمى، وهو تحرير الأرض المحتلة بكل الوسائل المتاحة وأن تتفق على المشروع الأول للتحرير، مع احترام التعدد والتنوع فكريا،لأن الأساس الذي لا خلاف عليه، هو إزالة هذا الاحتلال، وإرجاع الحق السليب.ثالثا: أن بعض المصالح الفئوية، والحزبية، طغت على المصلحة العامة، وأصبحت مصلحة هذه المنظمة وتلك ،أهم من مصلحة فلسطين، وهو ما جعل بعض القيادات في هذه الحركات، تقيم الدنيا وتقعدها من أجل مكانة ومصلحة هذه الحركة وتلك، وهذا للأسف قمة الأنانية والتردي الفكري الذي يجلب الفشل والإخفاق وقد حصل، وهو بدوره تستغله إسرائيل في إثارة الشقاق بوسائلها المختلفة!.وكلنا يعرف ما جرى بعد الانتخابات الفلسطينية في العقد المنصرم، والخلاف الذي جلب الاقتتال، والصراعات بين فتح وحماس، وكان الأولى أن تقبل النتائج، وتتاح لحماس أن تدير العمل السياسي، وليس سهلا لحركة حماس أن تدير الضفة الغربية وغزة، في ظل هيمنة الاحتلال، ولن تحقق الكثير من المكاسب،لكن إلغاء نتائج الانتخابات، وحدوث الانقسام، يأتي بنتائج عكسية على القضية برمتها، فالتفاهم والحوار، أهم من الاختلاف والانقسام، لو قدمت بعض القيادات المصلحة الفلسطينية العليا لكان الأمر أفضل حالا مما يجري الآن.ولذلك فإن تقديم المصلحة الفلسطينية، يجب أن يبرز ويهيمن على كل المصالح الخاصة، الفئوية،أو الحزبية، كما أنه يجب على القيادة الفلسطينية، أن تدرك أن الوعود والتطمينات الغربية بقيام دولة فلسطينية، أثبتت الآن أنه مجرد سراب يحسبه الظمآن ماءً، بعد التخلي الكامل عن جدية إقامة دولة فلسطينية، حتى على أراضي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، فالمراهنة على الحل العادل في ظل الانقسام الفلسطيني مسألة غير واردة للقوى الفلسطينية المنقسمة على نفسها. والآن مضى على اتفاق أوسلو ما يقرب 22 عاما، دون أن يحصل أدنى تقدم في الحكم الذاتي الفلسطيني، الذي بقى كما هو ، في ظل مخططات التهويد، وبناء المستوطنات، والقمع والقتل وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.والحل الأهم والأصلح والأجدر للقضية الفلسطينية عموما، هو أن تتحقق المصالحة الفلسطينية الكاملة، وأن تتوحد الصفوف، سواء في إدارة السلطة والأعمال الإدارية في الضفة وغزة، أو مجال توحيد المواقف تجاه الاحتلال سياسيا، والموقف الفلسطيني الموحد في الظرف الراهن، هو الذي سيعطي القضية وأهلها القوة المعنية، واحترام العالم لموقف ثابت تجاه الحقوق السليبة.
371
| 08 نوفمبر 2015
طرح الدكتور/ فهمي جدعان في كتابه [ الطريق إلى المستقبل] ما قاله بعض الباحثين حول تعليل الإخفاق العربي تاريخياً الذي يمتد كما قالوا إلى «الجذور المجتمعية الضاغطة»، وتأثير القبيلة العميق في التاريخ السياسي العربي فيرد على هذا التفسير:»الحقيقة هي أننا نعقد الأمور على أنفسنا كثيراً، إن نحن توخينا باستمرار العودة إلى الوراء عشرين أو ثلاثين قرناً أو أكثر من أجل أن نفهم واقع الأحداث، التي تجري أمامنا.. والذي نخشاه هو أن يترتب على ذلك التهوين من خطورة الطاقات والإمكانيات والانفعالات والرغبات والمنافع والوقائع المحدثة والإرادات الذاتية ـ الطيبة أو الرديئة ـ لأولئك الذين يفعلون ويوجهون أقدار مجتمعاتهم ودولهم في ضوء هذه المعطيات».ويختلف د/ جدعان مع رؤية هؤلاء في رد أزماتنا إلى الجذور المجتمعية القديمة في خط ممتد بين الماضي والحاضر، في شبه رفض لهذه الرؤية فيقول «يتعذر علي أن أفسر وقائع الإخفاق الكبرى التي أدت إلى أزمة الآفاق المسدودة خلال العقود الحاسمة من هذا القرن، ببؤر متحكمة في طباع عرب الجاهلية سواءً أكانوا قيسية أم يمانية أم غير ذلك من هذه القبائل التي لم تعد تثير نفوسنا، إلا ذكريات هشة غامضة الملامح: ما الذي يأذن لنا بأن نرد «الفعل السياسي» الذي أدى إلى الكارثة المشهودة في السادس من حزيران من العام 1967م إلى عقلية مضر أو قيس أو غيلان أو الفراعنة أنفسهم ؟ وهل ينبغي علينا أن نرجع إلى عقلية «داحس والغبراء» لتفسير الكارثة الكبرى الثانية التي حدثت في الثاني من آب من العام 1990 وما ترتب عليها من مصاعب ورزايا وتطورات، اعترت الكتلة العربية برمتها وجملة الأوضاع الإستراتيجية التي حكمت خلال نصف قرن، العلاقات المركزية والمحورية في الجناح الشرقي من العالم العربي؟».ويعتقد أن هذه الأحكام ـ انطباق سلوكيات العرب الراهنة على العقلية العربية القديمة ـ عقلية القبيلة والعشيرة في أفهامها وطبائعها، وأفكارها، ونهجها، على الرغم من أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين، من الصعب الاقتناع به كسلوك متجذر لدى العرب، وتركيبات مجتمعية ثابتة، لكن «إذا كانت مسالك الناس من حولنا محكومة بالعقلية القبلية مثلاً، فليس ذلك لأن هؤلاء الناس هم بالجوهر والماهية ذوو عقليات قبلية بالطبع، وإنما على وجه التحديد لأن الدولة التي تقوم على شؤونهم تريد لهم لسبب تعرفه الدولة نفسها ـ ويمكن لغيرها أن يعرفه ـ أن يكونوا كذلك، وإلا فليس عليها أقل من أن تلغي بعض القواعد والأحكام والقوانين بضربة واحدة ـ طالما أنها تفعل ذلك في ميادين أخرى وتنجح ـ وذلك ليتسنى تغيير المسار والحراك واستشراف مستقبل آخر. وإذا كانت الغالبية العظمى من الأفراد تنحو في مسلكها الاجتماعي منحىً مضاداً أو مناقضاً للسلوك الديمقراطي المتحضر، فليس ذلك لأن في هؤلاء الأفراد كروموزومات ثقافية أو بيولوجية عمرها عشرون أو ثلاثون قرناً أو ما شاء الله، وإنما لأنهم عادات وأخلاق وأنماط سلوك في المنزل والشارع، وفي السوق وفي المدرسة، وفي الحياة العامة، مناهضة لذلك السلوك، وذلك منذ سنوات العمر الأولى. دليل ذلك أنه يكفينا أن نضع هؤلاء الأفراد، منذ تلك السنين الأولى، في بيئة ثقافية اجتماعية، يسود فيها سلوك متباين حتى يترعرع هؤلاء الأفراد، على نحو آخر بـ «عقليات» مباينة لتلك التي كان يمكن أن تتلبسهم ولو أنهم بقوافي ذلك الكهف القديم». ويرى د/ جدعان أن هذا النمط من السلوك المكتسب، ينطبق على الأطفال في سنوات العمر الأولى، كما ينطبق على الكبار أيضاً، والتجربة تصرخ بأنهم إذا امتدت بهم الإقامة، ولم يعودوا إلى حماهم، فإنهم في الغالب الأعم يتشربون ويتمثلون عادات وأخلاق ومسالك أهل هذه البلدان الجديدة. وفي ختام مناقشته آراء هؤلاء المفكرين والباحثين، يرى د/ فهمي جدعان أن علاج الذي نعانيه في عصرنا الراهن، ووقف هذه التراجع وهذا التأزم الذي أصبح ملازماً لأمتنا لا نحتاج من أجل تبديده وطرده إلى الرجوع إلى علله البعيدة في حياة عرب الجاهلية، أو صدر الإسلام أو الأمويين أو العباسيين أو غيرهم. إن الإجراءات العملية المباشرة، لا أي شيء آخر، هي التي ينبغي أن تكون مناط العمل وهاجس القصد هنا وأية إحالة إلى «الآثار البعيدة» لبعض الوقائع والأحوال الراهنة ينبغي أن تظل في حدود التركيبات المجتمعية الثقافية القابلة للتعديل، لا في حدود البنى الجوهرية الصلبة التي لا تتقبل أي فعل ذي أثر. إذ أفعالنا وسياساتنا، هي ثمرات هذا التخلف، وهذا التراجع النهضوي والتشرذم السياسي، الذي أصبح سمة مميزة يشار إليها بالبنان، وتستغل عالمياً لمصالح وأهداف مغايرة لأهداف هذه الأمة وتصوراتها. وهذا بلا شك نتيجة لسياسة الدولة الحديثة ومن غير المنطقي رد هذه الإخفاقات إلى الجذور والترسبات القديمة، القضية تتعلق بالممارسات السياسية وليس بالجذور المجتمعية.
404
| 01 نوفمبر 2015
منذ القرن الماضي يردد البعض من الكتاب العرب، خاصة العلمانيين منهم، أن الاستبداد بنية كامنة في الفكر العربي الإسلامي منذ العصر الأول، في إشارة إلى المقولة الشائعة "المستبد العادل" التي أطلقت على سيرة الخليفة عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) في الحكم والإدارة، ولكنها ـ كما نعتقد ـ جاءت هذه المقولة محرّفة عن معناها، بحيث لا تعبر عن المفهوم المتعارف عليه في التراث العربي الإسلامي وهو "الحزم" و"عدم التردد في اتخاذ القرار" وإنما بمعنى الاستبداد وفق المفهوم الغربي وهو الانفراد بالرأي والسلطة دون أن تكون هذه السلطة خاضعة للقانون ودون النظر إلى رأي المحكومين.. إلخ. فكيف انتقل هذا المفهوم "الاستبداد" بمضامينه وحمولته الفكرية الغربية إلى المفهوم العربي الإسلامي؟ ومن هو قائل هذه العبارة؟ وهل قصدت عبارة المستبد العادل بمعناها الغربي بتلك المضامين السلبية؟.شاعت مقولة الاستبداد في القرن التاسع عشر والقرن العشرين بين الإصلاحيين الإسلاميين من خلال بعض كتابات ومقالات مختلفة ومن هؤلاء عبد الرحمن الكواكبي في كتابه (طبائع الاستبداد)، وجمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده من خلال مجلتهما مجلة "العروة الوثقى" ويورد د/ إمام عبد الله الفتاح إمام أن مقولة "المستبد العادل" انتقلت من أوروبا إلى الشرق.. فالحل الذي ارتآه جمال الدين الأفغاني لمشكلات الشرق إنما هو "المستبد العادل" الذي يحكم بالشورى.وقال ما نصه: "لن تحيا مصر، ولا الشرق بدوله، وإماراته، إلا إذا أتاح الله لكل منهما رجلاً قوياً عادلاً يحكمه بأهله على غير تفرد بالقوة والسلطان. وهذه المقولة التي قالها الإمام جمال الدين الأفغاني لا تعني أنه أيد الاستبداد بمضامينه المعروفة، إنما تعني الحزم والقوة والعدل في ظل الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي في فترة تكالب الدول الاستعمارية للسيطرة عليه، فهذا القول لا يؤكد أنه يؤيد الاستبداد السلبي بمفهومه الديكتاتوري المتسلط.كما أورد الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه [المشروع النهضوي العربي.. مراجعة نقدية]، أن الشيخ محمد عبده تحدث عن نموذج "المستبد العادل"وقال ما نصه: "إنما ينهض بالشرق مستبد عادل"، مستبد يتمكن به العدل أن يصنع في خمس عشرة سنة ما لا يصنع العقل وحده في خمسة عشر قرناً.الواقع أن مقولة "المستبد العادل" التي قالها الشيخ محمد عبده، أو الحاكم القوي العادل عند جمال الدين الأفغاني في مناسبة واحدة فقط لا تعبر عن موقف ثابت من مسألة الاستبداد من هؤلاء الإصلاحيين المسلمين، حتى وإن كان مفهوم الاستبداد الذي قصداه يتوافق مع مفهومه في الغرب أو ربما جاء الطرح قبل أن يتكشفا الآثار الوخيمة للاستبداد، أما إذا كان مقصدهما الاستبداد بمعناه العربي الإسلامي، كما أشرنا، فإن المسألة واضحة وتتقارب مع كتاباتهما ومقالاتهما الإصلاحية.وهذا أيضاً لا يستقيم ـ إن كانت الإشارة ـ المستبد العادل ـ قصد بها سياسة اتبعها الخليفة عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) وهذا ما يعد مخالفاً لسياساته ومواقفه وأعماله العظيمة في الشورى والعدل والمواقف الإنسانية الأخرى التي تخالف مفاهيم الاستبداد وتطبيقاته العملية. ففي كتابات الإصلاحيين الإمام جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده الكثير من الآراء الناقدة للاستبداد ومخاطره على الأمة والنهضة والتقدم.فقد كتب جمال الدين الأفغاني في مجلة العروة الوثقى العديد من المقالات هاجم فيها الاستبداد هجوماً عنيفاً واعتبر أن الاستبداد أساس بلاء الأمة وشقائها ومما قاله: "إن الأمة التي ليس في شؤونها حل ولا عقد، ولا تستشار في مصالحها، ولا أثر لإرادتها في منافعها العمومية، وإنما هي خاضعة لحكم واحد إرادته قانون، ومشيئته نظام، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد، تلك أمة لا تثبت على حال واحد، ولا ينضبط لها سير". ولم يتوقف إيمان جمال الدين الأفغاني بالحكم الدستوري ـ النيابي، بل واصل دعوته القوية المزلزلة فيقول: "لا تحيا مصر ولا يحيا الشرق، بدوله وإماراته، إلا إذا أتاح الله لكل منهم رجلاً قوياً عادلاً، يحكمه بأهله، على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان، لأن بالقوة المطلقة: الاستبداد، ولا عدل إلا مع القوة المقيدة. وحكم مصر بأهلها إنما أعني به: الاشتراك الأهلي بالحكم الدستوري الصحيح، وإذا صح أن من الأشياء ما ليس يوهب، فأهم هذه الأشياء: (الحرية) و(الاستقلال).وإذا رجعنا إلى التراث الإسلامي وما قيل إن الخليفة عمر ابن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ تنطبق على فترة خلافته فكرة "المستبد العادل"، كما أشار البعض، فإن الآثار عن مواقفه وسياساته التي اختطها هذا الخليفة ـ الملقب بالعادل ـ تخالف وتناقض هذه الفكرة ـ وإن صح أنها قيلت عن خلافته ـ فهذا الخليفة ـ رضي الله عنه ـ عرف عنه الحزم والإقدام والعدل والشورى والديمقراطية بمقاييس عصرنا، لكنه لم يعرف عنه التعسف والاستبداد والظلم وفق المضامين المعاصرة.ونعتقد أن هذه المقولة "المستبد العادل" جاءت في سياقات غير دقيقة وفهمت في غير مرادها، فإذا كان المقصود بعبارة "المستبد العادل" الخليفة عمر ابن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فإن تاريخ هذا الرجل يتنافر مع هذه السياسة ويتناقض معها، كما أن العبارة نفسها "المستبد العادل" تتناقض مع نفسها، إذ نعتقد أنه لا يجتمع العدل مع الاستبداد، كما أن الحزم والشدة وعدم التردد لا يعني الاستبداد والقمع والتعسف. وكنت أتمنى من بعض الكتاب من هذه المسألة الشائكة، ولا يطلقوا أحكاما اختزالية مكرورة رددها البعض دون أن يتحققوا من مجمل آراء الرجل وأفكاره المتناثرة في مقالاته ورسائله ومؤلفاته، وبعد ذلك من قال إن الوضع العربي المتأزم سببه أفكار الأفغاني وأطروحاته، فالذي نعرفه أن آراء الأفغاني كانت غير مطروحة ولا مرغوب فيها في فترة الدولة العربية التقليدية ـ في فترة الاستعمار ـ لأنها تبنت في أغلبها النموذج الليبرالي الغربي، والرجل، كما نعرف، له توجهات إسلامية خالصة من خلال دعوته إلى الوحدة الإسلامية والاسترشاد بالنموذج الإسلامي، وعندما جاءت الدولة العربية القُطرية والحكم الشمولي في أغلبه، فإن أفكار الأفغاني مرفوضة تماما، بل ومطاردة، وغير مرحب بها، فكيف تكون آراء الأفغاني عن المستبد العادل سبب تعاستنا الثقافية والنهضوية؟!.***هذه الآراء التي تختزل مسيرة الفكر السياسي الإسلامي في هذه المصطلحات تحتاج إلى رؤية عادلة ومنطقية، تستجلي حقيقة واقعنا العربي، وكيف يمكن الخروج من المأزق الذي وقعت فيه نخبنا الفكرية والسياسية عند تعاطيها مع الآراء من تراثنا العربي الإسلامي.
3706
| 25 أكتوبر 2015
بعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية التي رتبت من قبل الكيان الإسرائيلي لتنفيذ مراميه في مدينة القدس لتهويدها، إلى جانب قتل الأطفال والنساء لمجرد الشبهة وغيرها من الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والأعراف القانونية منذ الأسابيع الماضية، في ظل الظروف الحالية من عدم الالتزام بالاتفاقات مع السلطة الفلسطينية التي لم تلامس الواقع الحقيقي، وهو الحل العادل الذي يحقق للشعب الفلسطيني طموحه في استعادة حقه السليب وعلى رأسها القدس الشريف، وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تراوغ إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها بالانسحاب منها ضمن ما يسمى بالعملية السلمية، والتهويد والإصرار على إقامة المستوطنات الصهيونية منذ ما يقرب من أربعة عقود.. فهل انتفاضة ثالثة يكون لها الفضل في إنجاز الاستقلال الكامل؟فما هي خلفيات هذه الانتفاضة؟ وكيف تحركت الانتفاضة الأولى التي أجهضتها اتفاقات أوسلو؟ وهل ستلحق انتفاضة أخرى جديدة بنفس الظروف وأسباب الانتفاضة الأولى؟بدأت الشرارة الأولى من مخيم جباليا وبالتحديد في 8 ديسمبر 1987 عندما كان عدد من العمال الفلسطينيين عائدين من عملهم في إسرائيل، ويترجلون من السيارة التي تنقلهم أمام حاجز للتفتيش، فإذا بشاحنة عسكرية تدهسهم ولاذ سائقها بالفرار.. وأسفر هذا الحادث عن سقوط 4 قتلى وسبعة جرحى كلهم مخيم جباليا.وصلت هذه الأنباء إلى المخيم فاشتعل الغضب العارم، وعندما شيعت الأرض المحتلة الشهداء الأربعة تحولت إلى مظاهرات عنيفة شملت كل مخيمات قطاع غزة. وأقام الشباب الحواجز والمتاريس وقذفوا قوات الاحتلال بالحجارة.وكان الظن أن الشرارة التي انطلقت من مخيم جباليا بعد عام آخر ستكون انتفاضة كسابقها لن تتعدى عمرها أيام وتخمد بعد تفريغ شحنة الغضب سواءً من تلقاء نفسها أو بضربة قمع شديدة، مثلما فعل شارون وما تلاه من الإرهابيين الصهاينة، ولكن المظاهرات والاشتباكات مع قوات الاحتلال تجدها لليوم الثالث والرابع وشهر وشهرين وعام... إلخ.. وعمت أنحاء الضفةوالقطاع في قراها ومدنها في أكبر تحد لسلطات الاحتلال وإجراءاتها التعسفية والقمعية. في غزة التي تمنى إسحاق رابين يوماً أن يقوم من نومه ويرى غزة قد غرقت في البحر! تحول الصدام بين جماهير الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال إلى معركة حقيقية حيث أغلقت المدينة تماماً وسدت الطرق وامتلأت الشوارع بالحطام وحرائق الإطارات وانتشار الدخان الأسود. قوة انتفاضة الحجارة ويقول البروفيسور "دون بيريز" أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية نيويورك ومدير برنامج الشرق الأوسط بالجامعة نفسها، إن القليل من السياسيين الإسرائيليين والقادة العسكريين هم الذين توقعوا أن المظاهرات التي اندلعت ضد الاحتلال الإسرائيلي في 8 ، 9 ديسمبر هي شيء مختلف عن تلك التي حدثت في العشرين سنة الماضية. تصورت السلطات الإسرائيلية أن ما حدث في الضفة الغربية وغزة يمكن إخماده في أسابيع قليلة. ولما تخطت الانتفاضة التي قدرت لها بعد التنكيل والقتل والتكسير ومختلف الأساليب القمعية في التاريخ الإنساني أدرك "إسحاق رابين (آنذاك)" وقادة جيشه أن الأسباب الحقيقية وراءها لا تعالج إلا بحل سياسي وليس باستخدام القوة العسكرية. ووصل الأمر إلى أن تبنى بعض ضباط الميدان وأعضاء هيئة الأركان نفس المصطلح العربي "الانتفاضة" الذي يستخدمه الفلسطينيون لوصف مجريات الأمور.قبل الانتفاضة بحوالي شهر تنبأ مسؤول رسمي في الأمم المتحدة بحدوثها، وأدرك أن الانتفاضة أمر حتمي بعد عشرين عاماً من الاحتلال والإحباط وخيبة الأمل، وكانت الاحباطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حاجة فقط إلى شرارة ليحدث الانفجار الكبير لهذا الشعب الذي لاقى من المعاناة والقهر لم يلقه شعب آخر في العصر الحديث.وقد سجلت في تلك الفترة وثيقة قدمت للأمم المتحدة عن الأوضاع التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، فذكرت أن هناك جيلاً ينمو في ظل أحوال معيشية واجتماعية وتعليمية قاسية، ولا شك أنها أحوال صعبة، ورغم أنه يمكن القول بأن المجتمع الدولي قد ركز اهتمامه لفترة تزيد على ثلاثين عاماً على هؤلاء الفلسطينيين بصفة لاجئين، وقد حاولت العديد من المنظمات الدولية تأمين المستوى الأساسي للحياة على الأقل، إلا أن أوضاعهم بقيت متردية وصعبة والاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة تشكل عنصراً جديداً لم تعايشه غالبية أطفال العالم". ورغم أن هذه الاضطرابات تترك بصماتها على جميع أطفال العالم إلا أن أطفال الضفة والقطاع ينؤون بعبء إضافي يتمثل في العيش في ظل احتلال قاس، وعنيف منذ يونيو 1967م.وفي ظل هذا المناخ انطلقت شرارة الانتفاضة وسجلت انتصاراً نفسياً ومعنوياً على الاحتلال من خلال صمودها الطويل لتخلق واقعاً جديداً لابد من إعادة النظر إليه بصورة مختلفة. ويعتقد البعض من المحللين والخبراء الإستراتيجيين أن عملية التسوية التي بدأت بمؤتمر مدريد أكتوبر 1991م كانت اتجاهاً تكتيكياً من إسرائيل لوضع حل لمشكلة الانتفاضة التي أقلقت إسرائيل وشكلت عبئاً أمنياً عليها طوال فترة الانتفاضة ونعتقد أن انتفاضة الأقصى ستكون النهاية للاحتلال.ففي تاريخ فلسطين هناك انتفاضات كثيرة مثل انتفاضة "البراق" عام 1929 وانتفاضة عام 1936، وكان هدفها التذكير بهذا الحق المسلوب.. لكن انتفاضة الشعب الأولى بعد احتلال الضفة والقطاع تعد أروع الانتفاضات في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني المكافح.إن انتفاضة جديدة لو تحققت وسارت وفق الظروف والإمكانيات والتحديات، فإنها لن تتوقف دون أن تحقق أهدافها المبتغاة، مثل ما حدث للانتفاضة الأولى.. فهل يتحقق هذا الهدف على الرغم من القسوة الصهيونية في قمع هذه الانتفاضة وتصفية قادتها؟
1468
| 18 أكتوبر 2015
في ظل الهجمة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وفي ظل الاعتداءات التي تزداد يوما بعد يوم على المقدسات العربية والإسلامية، وقتل الأطفال بصورة همجية، فإن على القيادة الفلسطينية، أن تتخذ موقفا قويا ومعبرا عن الحالة الراهنة ومتغيراتها الخطيرة على القضية الفلسطينية التي بها لاحتلال، والاعتداء على المسجد الأقصى، ومنها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو من أكبر المسائل التي تشغل بال الفلسطينيين منذ عقدين، وسبب الكثير من الضغائن والأحقاد بين الفلسطينيين أنفسهم.. وهي مسألة يعتبرها منتقدو السلطة الفلسطينية جريمة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني، وخيانة عظمى للوطن والمواطنين.. ونعتقد أن تصريحات الرئيس محمود عباس قبل فترة حول ضرورة حل الخلافات مع حماس، خطوة جيدة لحل الخلافات القائمة، فالبديل للتخاصم والاقتتال هو تصفية القضية برمتها مرحلياً، وإقصاء أي فصيل فلسطيني يعني إضاعة ورقة سياسية قوية في يد المفاوض الفلسطيني.. فلا بد لها من أوراق ضاغطة للتفاوض مستقبلا إن كان هناك أفق للتسوية، والمعارضة في اعتقادنا مكسب للمفاوض الفلسطيني وليس العكس. وموقف حماس السياسي الراهن يمكن أن يكون قوة للمفاوض الفلسطيني، إذا أرادت القوى الدولية أن تساند الرئيس محمود عباس وتحقق له الدولة الفلسطينية المستقلة ـ كما يقولون ـ وليس مجرد كلام للاستهلاك أمام المحطات الفضائية والمقابلات والابتسامات والتصريحات كما فعلها الرئيس بوش سابقا، وأخل بوعد في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في عام 2005، ثم ظهر مؤخرا النغمة الجديدة لتبادل الأراضي، وهو خطوة لإطالة وإدامة الاحتلال، والاستمرار في إقامة المستوطنات وغيرها من المشاريع الاستعمارية. والواقع أن المراهنة على الحل العادل في ظل الانقسام الفلسطيني مسألة غير واردة، فلا يمكن أن يحقق المفاوض الفلسطيني نجاحاً مأمولاً في ظل الشرخ القائم بين القوى الفلسطينية المنقسمة على نفسها، فالورقة الأهم أن يحتفظ المفاوض بأوراق معينة حتى يمكن أن يساوم عليها، أما أن يرمي بكل أوراقه في سلة الوعود بدون نتائج على الأرض ويقول أريد حلاً عادلا، فذلك يعد من قبيل الأحلام الوردية غير قابلة للتحقق، لا تعطي شيئاً ملموساً على الأرض، فالمفاوضات عبر التاريخ تحسمها وتقويها الأوراق الضاغطة وموازين القوى وغيرها من الأمور الدافعة في قوة المفاوض. والواقع أن المراهنة على الحل العادل في ظل الانقسام الفلسطيني مسألة غير واردة، فلا يمكن أن يحقق المفاوض الفلسطيني نجاحاً مأمولاً في ظل الشرخ القائم بين القوى الفلسطينية المنقسمة على نفسها وهذا ما برز في المؤتمرات السابقة.فالرئيس محمود عباس مع حنكته السياسية، وقدرته على التحرك السياسي الجيد، إلا أن الانقسام الداخلي يحول دون تحقيق مكاسب في التحرك السياسي، وتلك قضية معروفة في السياسات الدولية، الورقة الأهم أن يحتفظ المفاوض بأوراق معينة حتى يمكن أن يساوم عليها، أما أن يرمي بكل أوراقه في سلة الوعود بدون نتائج على الأرض ويقول أريد حلاً عادلا، فذلك يعد من قبيل الأحلام الوردية، لا تعطي شيئاً ملموساً على الأرض، فالمفاوضات عبر التاريخ تحسمها وتقويها الأوراق الضاغطة وموازين القوى وغيرها من الأمور الدافعة في قوة المفاوض.. صحيح لو أن إسرائيل تريد حلاً صحيحاً وجاداً كان من مصلحتها أن تقبل القرارات الدولية منذ أكثر من خمسين عاماً وما بعدها، لكنها لا تريد هذا الحل لأنها لديها نزعة للتوسع والمساومة والمراهنة على ضعف الفلسطينيين وانقسامهم وتشرذمهم، وهذا يجعلها تمدد أكثر أو على الأقل "تحييد" أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني أو القبول بالأمر الواقع، لكن هذا الافتراض ليس صحيحاً، فلا يوجد في التاريخ شعب نسي أو تناسى حقه مهما اختلت موازين القوى فستظل الحقوق عالقة في الأذهان، وجيل بعد جيل حتى تسترد الحقوق، وكان الأحرى بالشعب الإسرائيلي أن يستقرأ التاريخ ويعرف أن لا فائدة في هذا التباطؤ في عدم الحل العادل مع الشعب الفلسطيني إن أرادوا العيش المشترك مع الشعب العربي الفلسطيني والاستقرار الدائم.ولذلك فإن الوفاق والصالحة بين فتح وحماس هو الأمر الأهم في مسيرة القضية الفلسطينية الآن بعد ظهور التراجع الجانب الصهيوني، والانشغال الأمريكي بقضايا أخرى، وهو الذي سيمكن المفاوض في تمرير استحقاقات السلام المنشودة سواءً على المدى القصير أو المستقبل المنظور لا يمكن أن يتحقق السلام العادل إلا من خلال قوة المفاوض الفلسطيني ما يجري الآن في الضفة الغربية والقدس، وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لهو مؤشر واضح، أن نتنياهو، يريد أن يستغل الموقف العربي المتأزم، والصراعات العربية الداخلية، لينفذ خطط إسرائيل القديمة، في فرض واقع جديد على الشعب الفلسطيني، وإجهاض كل الاتفاقيات الهشة مع القيادة الفلسطينية، ويعتبر هذا الحزب وقياداته المتطرفة، أن الوضع العربي مناسبة لا تعوض، لتنفيذ المخططات الإسرائيلية في تهويد القدس، وإلغاء الاتفاقات السابقة بمبررات واهية، إن الجنود والمستوطنين يتعرضون للهجمات، وهي فرية مكشوفة، وهذا السبب هو نتيجة للاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون، والجنود الإسرائيليون، وهي تخفي على المتابعين والإعلاميين، ناهيك عن الاعتداءات الأخرى على المزارع والممتلكات الفلسطينية، وهذا يستدعي موقفا فلسطينيا موحدا، ومساندة عربية وإسلامية ودولية، لوقف هذا المخطط الذي يقّوض السلام الدولي، الذي للأسف أن المواقف الغربية ليست كما تدعي وتقول عن الحقوق العادلة للشعوب، عدا بعض مؤسسات المجتمع المدني التي لها موقف مشرف تجاه قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال.
436
| 11 أكتوبر 2015
منذ أسابيع قليلة أعاد بعض الكتاب مرة أخرى، رؤية العلامة ابن خلدون في طبائع العرب وصراعاتهم الداخلية المذهبية والإثنية، خاصة ما قاله ابن خلدون بالنص في طبائعهم في كتابه الشهير "المقدمة" عن خروجهم من "ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة.. فهم منافسون في الرئاسة وقل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته، إلا في الأقل وعلى كره من أجل الحياء، فيتعدد الحكام منهم والأمراء، وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية والأحكام فيفسد العمران وينتقص.. فتبقى الرعايا في مملكتهم كأنها فوضى دون حكم". وربط هؤلاء الباحثون بين هذه المقولة، والواقع العربي الراهن، خاصة الصراعات السياسية بين دوله، لكن هذه الرؤية لاقت نقداً شديداً من بعض الأكاديميين والباحثين مثل محمد عمارة في كتابه (الإسلام والتعددية) حيث يرى أن ما كتبه هؤلاء ينطلق من فهم خاطئ وقراءة مبتسرة لمراد ابن خلدون فيقول محمد عمارة: من هم "العرب" الذين حكم ابن خلدون بأن "طباعهم قد بعدت عن سياسة الملك"؟! هل هم العرب كأمة؟! أم العرب الأعراب الموغلون في البداوة والتوحش، قبل أن يتدينوا بالإسلام، فتتهذب طباعهم ويساعدهم الإسلام على حذق إقامة الملك والدولة وسياسة العمران؟!.ويضيف د/محمد عمارة موضحاً مقاصد ابن خلدون في العرب في المقدمة فيقول:"لقد عقد ابن خلدون – في مقدمته – فصلاً جعل عنوانه (فصل في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك) لكنه – قبل هذا الفصل مباشرة – عقد فصلاً آخر جعل عنوانه:(فصل في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين بالجملة).ولو أن قارئا وقف _ عند عنواني هذين الفصلين لأدرك أن هناك عربا يحكم عليهم ابن خلدون بأنهم أبعد الأمم عن سياسة الملك.. وهناك عرب يحسنون الملك والسياسة، لكن إذا كان لهم حظ من الدين. وعندما يقرأ القارئ ما تحت العناوين، سيجد فكر ابن خلدون شديد الوضوح في التمييز بين العرب في طور التوحش والإيغال في البداوة، قبل التدين بالإسلام، أو عند الانسلاخ عن جوهره.. وبينهم عندما جعلهم الإسلام سادة الفتوحات وأساتذة الدول والسياسات.ويقتبس د/ عمارة من هذه المقدمة بعض الآراء لابن خلدون في عرب البداوة المتوحشة الذين قال عنهم إنهم "أبعد الأمم عن سياسة الملك" فيقول إن هؤلاء – كما قال ابن خلدون – هم الذين اختصروا "بالإبل وهي أصعب الحيوان خصالاً ومخاضاً.. فاضطروا إلى النجعة.. فأوغلوا في القفار.. فكانوا لذلك أشد الناس توحشاً (..) – إلى أن يقول – " فيتعدد الحكام منهم والأمراء، وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية والأحكام فيفسد العمران"!.تلك هي صورة العرب – عند ابن خلدون – في طور "البداوة المتوحشة".. الذين يفرون من الاستقرار والعمران، ويهدمون المباني لتحويل أحجارها إلى أثافي للقدور، ويهدمون السقف ليتخذوا من أخشابها أوتاداً للخيام.. هؤلاء الذين قال عنهم ابن خلدون – كما يقول الدكتور محمد عمارة – هم الفئة التي تنطبق عليهم مثل هذه الأوصاف التي ذكرت سابقاً في المقدمة" أما الأمة العربية التي جاءتها رسالة الإسلام، ونبوءة محمد التي حملت الإسلام إلى العالمين، وفتحت الفتوح، وأقامت الدول والمماليك، وبنت الحضارة، وساست العمران.. فلابن خلدون حديث طويل عنها.. لا ندري كيف أغفله هؤلاء؟.ونحن نرى أن هذا التشخيص الخير الذي طرحه د/ عمارة لآراء ابن خلدون لمفهوم البداوة، والتحضر والعمران عند العرب، وإشكالية الممانعة والمدافعة باعتمادهم على الغير، هي الأقرب والأكثر انسجاماً مع أطروحات هذا العالم الجليل، في مجمل ما وضعه من نظريات، في السياسة، والتاريخ، وعلم العمران (الاجتماع) لأنه بالإسلام انتصر العرب، وهم الأقل عدداً وعتاداً على أكبر إمبراطوريتين في ذلك العصر، وهما الإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية الفارسية، والصبغة الدينية عندما تستحكم في النفوس وتقوى في القلوب، فإنها تلعب دوراً أساسياً في صياغة حياة المجتمعات، الفكرية، والسياسية، والاجتماعية ومن هنا يرى الباحث صلاح سالم أن "الاتجاه الخلدوني في صياغة دور الدين في الحياة السياسية، أكثر إنصافاً من كل الفلاسفة الماديين الذين أعلوا سلطان القوة الأعمى، وتناسوا الفكرة الدينية تماماً في القرون الأخيرة بالذات. وذلك رغم ما يشاع عن تأثر ابن خلدون في ذلك بنمط حياته في رحاب السلطة السياسية، وعلى مقربة منها واعتبار ذلك تنظيراً ودفاعاً عن السلطان السياسي والسلطان الروحي الخاضع له في مواجهة السلطان الروحي المستقل والرافض لهذا الخضوع، وفي هذا السياق يقول ابن خلدون في كتاب له "إن السلطان السياسي الذي هو سلطة العصبية والقوة، يمكن أن يضفي على نفسه صفات المعرفة بالإضافة إلى سلطة الروح والدين، فتزداد قوة واستقراراً، لكن المعرفة وحدها لا يمكن أن يتأسس عليها أي سلطان سياسي دون العصبية والقوة. ومفهوم العصبية – عند ابن خلدون – الذي يفهمه البعض بمعناه الضيق في حالة النسب والرحم، إذ لا يكون في كل السياقات هو مراد ابن خلدون، عندما يتحدث عن العصبيات عند العرب، فهناك العصبية العاضدة للدولة والسلطان السياسي، وهناك العصبية الساعية للملك، وهذا ما يظهر من دراسة ابن خلدون للظاهرة الاجتماعية، عندما وضع فصلاً بعنوان (في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك) "فابن خلدون – كما يقول – د/ لؤي صافي – ينطلق من مفهوم العصبية بوصفها ظاهرة سياسية، ومن تصور للطبيعة الإنسانية يرى أن التغلب والتفوق مطلب طبيعي للنفس الإنسانية، ليقرر أن السلطة السياسية، أو القدرة على إمضاء الرأي رغم معارضة المعارض والمخالف، من نصيب العصبية الأقوى، أي من نصيب الجماعة السياسية القادرة على إخضاع الجماعات السياسية الأخرى إما بقهرها والتنكيل بها وتشتيت قواها، أو باسترضائها والدخول معها في تحالفات سياسية ويستمر الحلف السياسي بالتوسع والانتشار وبسط النفوذ بقهر القوى المعارضة أو استرضائها إلى أن يصطدم بحلف سياسي آخر".ولذلك نعتقد أن ما جاءت نظرية ابن خلدون، في علم الاجتماع عن العرب، من التباسات وغموض وتعميمية في بعض الأحيان، كان بسبب معايشته شخصياً فترة أليمة مرت بها الحضارة العربية الإسلامية وتمزق وتناحر أهلي داخلي. ونرى أيضاً أن هؤلاء وقعوا في نفس الظروف عندما كتبوا هذه الآراء بعد الاحتلال الغاشم لدولة الكويت 1990، وما تبعها من انقسامات وتمزقات وجراح أليمة عانتها الأمة العربية كلها، ومازالت مثقلة بآثارها إلى الآن ونرى أن المقارنة غير دقيقة من خلال تنزيل آراء ابن خلدون مع واقعنا الراهن، لاختلاف الظروف والملابسات والوقائع، والقياس هنا من الصعب مقاربته، لأن الفارق الزمني والفكري مختلف عما عاصره العلامة ابن خلدون في عصره وزمنه.
997
| 04 أكتوبر 2015
عندما تنبأ البروفيسور فرانسيس فوكوياما في أطروحته: (نهاية التاريخ) في أواخر القرن الماضي، وقال إن الديمقراطية الرأسمالية هي النموذج النهائي للتطور البشري الإيديولوجي للإنسانية وبالتالي فهي تمثل نهاية التاريخ، فإنه لم يكن يدرك أن هذا الطرح الإيديولوجي أيضا لم ينطلق من رؤى واستقراءات عميقة في التاريخ والصيغ والنماذج البشرية، وأنه ربما سيفاجأ بما حدث للنظام المالي الرأسمالي في الولايات المتحدة الذي أعتبره نهاية النهايات لكل الفلسفات والأفكار الإنسانية، وأصبحت الاقتصاديات العالمية تعيش زوابعه السلبية وأثرها على الأمم في عيشها واستقرارها،آخرها الأزمة المالية التي عصفت بالغرب منذ عدة سنوات وتداعياتها المقبلة.... إلخ.وهذا العام صدر للبروفيسور فوكوياما كتابا بعنوان ( الإسلام والحداثة والربيع العربي)، وهو عبارة عن حوارات أجراها الباحث السوري د/ رضوان زيادة، تحدث فيها صاحب أطروحة نهاية التاريخ عن رأيه في القضايا التي استجدت بعد هذه الأطروحة، وأصبح معتدلا في أفكاره التي قال فيها نهاية التاريخ عن الليبرالية الرأسمالية، وانتقد بعض السياسات الأمريكية في تعاطيها مع القضايا العربية. ويعترف أن هذه الأطروحة جاءت في سياق انهيار المعسكر الاشتراكي والنظم الشمولية في أوروبا الشرقية، ولم تأت نتيجة طرح موضوعي هادئ بعيدا عن الزهو بانهيار الكتلة الشيوعية الذي يقودها الاتحاد السوفييتي آنذاك.ولاشك أن لاندفاع فوكوياما في جعل الرأسمالية الغربية هي أقصى ما تصل إليه البشرية، تخمينات لا ترقى إلى علم المستقبليات التي تتوقع أشياء بناء على استقراءات واقعية ورؤى لما يأتي في المستقبل. لكن ما قاله فوكوياما هو عبارة زهو بما حصل للفكر الاشتراكي من انهيار من خلال النظم الشمولية في المعسكر الشرقي، وهذا الانهيار لا يعبر عن انتصار الليبرالية الرأسمالية بقدر ما يكشف عن سوء الإدارة في النظم الاشتراكية والقمع والقهر والاستبداد الذي صاحب هذه النظم مما جعلها تتراجع وتنهار بالصورة التي تمت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي إلى جانب عيوب هذه النظم الأخرى لا مجال للحديث عنها الآن لكن الذي نود طرحه أن الليبرالية لها مساوئها العديدة وتطبيقاتها السلبية، إنما الجانب الإيجابي الذي أعطى الزخم والتطور للنظام الرأسمالي هو الحرية والديمقراطية والمراجعة الدائمة، وحرية الإعلام، والنقد إلخ... ومن أبرز الكتاب الذين ناقضوا نظرية (نهاية التاريخ) بانتصار الليبرالية الغربية المؤرخ الأمريكي جاك بارزن الذي نشر مقالاً بعنوان (مقولة الديمقراطية) نفى فيها نفياً قاطعاً وجود نظرية موحدة للديمقراطية وأكد وجود العديد من الأفكار الديمقراطية التي لا يربطها نسق فكري واحد، وذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد أن الديمقراطية الأمريكية مثلها في ذلك مثل الديمقراطية الإنجليزية لا يمكن تصديرها للخارج لأن فهم ما في الديمقراطية ليس في مقولاتها التي تقوم عليها أيا كانت، ولكن في طريقة تطبيقها وفي المؤسسات التي تقوم على آلية التطبيق، وهذه مسألة لصيقة بالتاريخ الاجتماعي الفريد لكل مجتمع وهي الحاسمة في موضوع الممارسة الديمقراطية، لكن الأصح أن انتصار الليبرالية الغربية كما صورها بعض الكتاب أن الصراع الذي قام بين القطبين العالميين ( الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي سابقاً) كان صراعا على المصالح والغنائم من خلال التسابق على التسلح والحرب الخفية الباردة بأشكالها المختلفة من أجل إضعاف الآخر وهزيمته، وانتهى طبعاً بسقوط الاتحاد السوفييتي وانهيار نظامه.. هذا السقوط فاجأ الخصم الآخر ـ الولايات المتحدة ـ فسارع إلى استثمار هذا السقوط بالإعلان عن تفرده بقيادة العالم بل و(نهاية التاريخ) في الصراع الفكري والحضاري بهذا الانهيار. هذه التنبؤات والتخمينات موجودة في كل العصور.فقد انتقت الماركسية بعض مراحل التاريخ وصورته بـ (الحتمية التاريخية) فهم لم يأخذوا التاريخ كله كنموذج ليستنبطوا منه فنون حركته، وإنما أخذوا بعض مراحل التاريخ وفقرات هي التي وجدوا فيها مصداقية كلامهم وأغفلوا الباقي.. وما كان لأحد أن يحيط بالتاريخ كله ولو أراد، وما وصلنا من التاريخ ربما بعضه خضع للأهواء والميول، فالمادة التاريخية ـ ما يقول المرحوم د مصطفى محمود ـ مادة خادعة وهي بطبيعتها متعددة المصادر ومتناقضة ومتضاربة ولا يمكن استيفاؤها كلها ولا جمعها كلها بيقين كاف كي يقول فيلسوف التاريخ إلى القول بنظرياته، أو أنه استنبط منها قانونا مطلقاً وقول هذا الكلام هو السذاجة بعينها.ولكن الفكرة الموضوعية العلمية الأمينة ـ كما يقول ـ لا تقول بأكثر من الترجيح والاحتمال، فالقوانين الإحصائية كلها قوانين احتمالية وكلها ترجيحات لا ترتفع للمستوى أو على الأصح إلى مرتبة الحتمية أو الإطلاق، ثم إن الإنسانيات لا تجوز فيها الحتمية لأن الناس ليسوا كرات (بلياردو) تتحرك بقوانين فيزيائية، لكنهم مجموعة إرادات حرة تدخل في علاقات معقدة يستحيل فيها التنبؤ على قوانين مادية.. وهذا ما وقع فيه فوكوياما.منذ فترة وبعد الأزمات الأمريكية بعد الحرب على أفغانستان والعراق بدأ فوكوياما يتراجع عن بعض ما قاله في أواخر القرن الماضي عن انتصار الليبرالية الغربية على كل الصيغ والأفكار والأيدلوجيات الإنسانية، والاعتراف على استحياء بوجود تعدد النماذج الخاصة في الديانات والفلسفات والصيغ الحضارية.. لكن فوكوياما لم يعترف تماما بهزالة أطروحته (نهاية التاريخ) عند الديمقراطية الرأسمالية الغربية في نموذجها الوحيد على كل الصيغ الإنسانية،.. فهل يملك فوكوياما الشجاعة ويعترف بهذا بخطأ أطروحته بعد الأزمة الرأسمالية الأخيرة ؟!العالم الآن يشعر بالإحباط والقلق عندما لم يحسب الحسابات الواقعية الدقيقة بالاعتقاد أن هذا النظام الرأسمالي يمكن أن يتراجع أو ينهار أو يصاب بالأمراض المزمنة تمهيداً إلى الانزواء والتقهقر. وتلك سنة الحضارات والصيغ والنماذج عبر التاريخ. فالرأسمالية أفادتها وجددتها الحرية والديمقراطية من حيث الانفتاح على كل الآراء والتعديل والتحوير في تطبيقاتها مع كل عاصفة من عواصفها منذ قيامها في القرون الماضية، لكن عندما بدأت التلاعبات والغش والأكاذيب والتلفيق في التطبيق في تعاملاتها، لذلك نعتقد أن تجديد الرأسمالية كما حصل في الكساد الكبير أصبح صعباً وربما مستحيلاً، ولا بد من إيجاد النموذج الأجدى بالبقاء والاستمرار في ظل العدل والصدق والشفافية والكف عن مقولات النهايات لنموذج وحيد أوحد وفلسفة نجاحاته، والتسويغ لتفوقه على كل القيم والنماذج الأخرى..والعاقبة لله عز وجل....
2263
| 27 سبتمبر 2015
يعيش الأقصى هذه الأيام محنة كبيرة وخطيرة بعد استباحة الجنود الإسرائيليين المسجد الأقصى، مع الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بشتى أنواع وأساليب القمع والضرب وتكسير بعض الواجهات.. إلخ، تحت شعار مواجهة الأطفال الذين يعتدون على الجنود الإسرائيليين بالحجارة !! وهي حجة واهية، وليست صحيحة، والهدف الحقيقي تهويد مدينة القدس والأماكن المقدسة جميعها، وبين الفينة والأخرى، يتكرر الاقتحام والاعتداء منذ سنوات، مثل واقعة اقتحام المسجد الأقصى وإخراج المعتكفين فيه آنذاك، الذي يتزعمهم الشيخ رائد صلاح وهو من سكان أرض 48، وأحد المناضلين الفلسطينيين في قضية القدس والمسجد الأقصى، ولا تزال إسرائيل تمارس الخطط والممارسات بين الحين والآخر لتهويد القدس بالتدريج، وقد جاء التهديد بفرض السيادة على الأقصى من قبل نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم، في إحدى الوزارات الإسرائيلية السابقة العقد الماضي، والذي قال للإذاعة الإسرائيلية، في تلك الحادثة إن "المعركة بدأت لفرض السيادة على القدس وبشكل خاص على جبل الهيكل". إن الحديث عن تمسكنا بالقدس، ومكانة القدس في العالم الإسلامي، وتاريخنا ناصع البياض في هذه المدينة المقدسة لا يكفي، فهذه الدراسات والبحوث على أهميتها، لا تسهم في إنقاذ هذه المدينة العربية، ولا يحميها من التهويد وطمس معالم، والقضاء على الكثير من آثارها التاريخية الإسلامية العريقة منذ أكثر من أربعة عقود.صحيح أننا يجب أن نؤطر تاريخنا بالوثائق والمستجدات بما يسهم في توضيح الحقائق التاريخية وإبراز حقوقنا القانونية والدينية، لكن بهذه الجهود والتحركات بهذه الطريقة كمن يخاطب نفسه، ويسرد الوقائع على ذاته فقط، لكن الذي يجب أن نعمله للقدس كمدينة عربية إسلامية تحت الاحتلال، وتواجه الكثير من الممارسات الخطيرة أن يكون هناك حراك سياسي وثقافي وقانوني في العالم كله، ونخاطب الرأي العام العالمي بالحقائق التاريخية، ونعرض ما لدينا من وثائق من خلال هذه الندوات والمعارض واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني لفضح ممارسات إسرائيل لطمس معالم هذه المدينة العربية، وإبراز حقوقنا التاريخية من خلال ما نملكه قانونيا وسياديا عليها.لذلك من المهم أن يكون اهتمامنا بالقدس من خلال التحرك الفاعل، لكشف ما تفعله إسرائيل الآن في القدس العربية، والمخاطر المحدقة بهوية هذه المدينة وتاريخها ومعالمها الأثرية.ولا شك أن الندوة أبرزت الكثير من القضايا الهامة والوثائق الجديرة بالطرح تاريخياً، بما يؤكد على عدم أحقية الإسرائيليين في هذه المدينة سوى ما هو متاح لهم من أماكن للعبادة معروف منذ القدم.. إلخ.والأخطر الذي يمكن أن يشكل طمس معالم هذه المدينة المقدسة إقامة المستوطنات الإسرائيلية حول المدينة وحصارها والقضاء على الكثير من هذه المعالم، وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية العسكرية، منها الاستيلاء على بعض الأملاك الخاصة العربية، ومصادرة الكثير من الأراضي الفلسطينية مع أن تنظيمات لاهاي بشأن الأملاك الخاصة واضحة بموجب المادة [46] التي تقول: "يجب أن تحترم الملكية الخاصة"، وأنه "لا تجوز مصادرة الأملاك الخاصة"، لكن إسرائيل كعادتها لا تحترم القوانين والتنظيمات الدولية واعتبرت أن "المادة 46 غير ملزمة لها !! وهناك الكثير من الدلائل والقرائن تؤكد أن إسرائيل هدمت ودمرت مئات المنازل في القدس، وأقامت لها مباني أخرى لأغراض متعددة وبعضها لم تعوض لأصحابها.. ناهيك عن الإجراءات الإسرائيلية التي قامت بها منذ احتلال القدس منذ احتلالها حتى الآن من إقامة مئات المستوطنات وتدمير أملاك لأوقاف إسلامية وتجريدها من طابعها الديني.. وكل هذه الإجراءات تخالف القوانين الدولية وتنتهكها بصورة صارخة، ومع ذلك فإن المجتمع الدولي المتمثل بالدول الغربية لا تزال تعتبر إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وتقف إلى جانبها وتعتبر بعض هذه الدول أنها تدافع عن نفسها، مع أنها دولة محتلة غاصبة لأراضٍ أخرى. وعلينا أن نستشعر الخطر المحدق بهذه المدينة المقدسة، وأنه لابد من التحرك السياسي والقانوني والثقافي لحماية هوية المدينة وآثارها وتاريخها من الطمس والإلغاء وقبل ذلك تخليصها من الاحتلال، وهذا لا يتأتى بالمؤتمرات والندوات داخل بلداننا، فنحن نعرف ماذا يجري في القدس، وما يجري فيها، إنما الذي نوده أن تقوم النخب السياسية والفكرية والثقافية في العالم العربي وخاصة النخب الفلسطينية صاحبة الحق الأصلي هو التحرك الواسع في العالم كله لشرح ما تقوم به إسرائيل، وما تفعله في هذه المدينة ومخالفاتها القانونية لكل القوانين والأنظمة الدولية. إن إسرائيل بدأت معركتها الحقيقية في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة الحالية، لهدم القدس وتغيير معالمها الإسلامية وهذا ليس تخمينا أو تخيلا، بل هذا التوجه بدأ عمليا والتحركات بدأت من سنوات بالحفر في بعض الأماكن في القدس وخاصة باب (المغاربة) الذي طالته الحفريات منذ سنوات، بشكل ممنهج ومن خلال خرائط للوصول إلى هدفهم بتهويد القدس وتغيير المعالم العربية والإسلامية. فهل نستشعر الخطر القادم؟! إننا كأمة عربية إسلامية علينا مسؤولية كبيرة وعظيمة لحماية الأقصى من هذا الخطر الإسرائيلي الداهم على مدينة القدس، والتحرك يجب أن يكون قويا ومخططا من الجانب السياسي والإعلامي والقانوني، ولكي نسهم في وقف هذا التهديد ونحمي القدس وأهل القدس من هذا الخطر الصهيوني الكبير الذي يستغل الأزمات العربية الراهنة، لتحقيق أهدافه في التهويد والسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، وبقية الأماكن العربية الإسلامية، ولم تتوقف الأخبار عن انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى منذ العام 1967 ـ كما يقول الأستاذ/ عبد الستار قاسم ـ والبيانات العربية ضد الانتهاكات مستمرة، وكذلك شكاوى العرب إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، وتمسك العرب بما يسمى بالشرعية الدولية والقانون الدولي ازداد صلابة ومهنية.فعملية تهويد القدس بقيت تسير بوتيرة متصاعدة، وكذلك عملية الزحف على المسجد الأقصى بهدف الاستيلاء عليه، وهذه الاعتداءات الأخيرة هدفها التهويد الرسمي، فهل نشهد تحركا عربيا قويا هذه المرة؟ أم أن ترديد الشكاوى، والبيانات، التي أصبحت ثقافة سلبية معروفة، اعتادت عليها إسرائيل منذ عقود، وهي تراهن على الضعف العربي القائم، والصراعات الداخلية لتنفيذ مشروعها القديم والجديد، لتهويد كل الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بحجة الحق التاريخي لإسرائيل!!.
490
| 20 سبتمبر 2015
لا شك أن التعدد الثقافي عبارة عن تعدد في مسارات مختلفة تسلكها الأمم بمجرد السعي لسبر أغوار الأفكار، هذه الحركة تشبه حركة الماء المراق على الأرض عندما يأخذ بالانتشار بكل الاتجاهات الممكنة ما لم يمنعه مانع؛ فالفكر يتحرك في الفضاءات التي تواجهه ما لم تحد من حركته موانع، كما أنه قابل لأن يتوجه وجهة خاطئة إذا ما تم فرض هذا التوجه عليه، وإذا وضعنا في اعتبارنا علاقة هذا الفكر بحركة الواقع، وكونه القوة التي تجر الحياة البشرية وراءها بأي اتجاه سارت، عرفنا خطورة وأهمية عملية تشكيل الأفكار وخطورة الأغلاط التي يقترفها الوعي وهو يحدد علاقته بموضوعاته، ومن هذا المنطلق فإن الحوار الثقافي يأتي بثمرات عديدة تكتسب من بعدها الانفتاحي على الآخر، ويشكل النواة الصلبة للعمل الثقافي الجاد الذي يتراكم ويتواصل لخلق حالة ثقافية بصفات جديدة وعقلية حضارية تمارس القطيعة المعرفية مع تلك العقلية الضيقة التي لا ترى في الوجود إلا لونين إما أسود أو أبيض.. ولذلك فإن الحوار الثقافي ليس تصدعاً في الذات الثقافية، بل هو إثراء لها وإضافة نوعية إلى بنائها وسياقها المعرفي، وأن أهم ما تمارسه عملية الحوار هذه أنها ترفع الأوابد عن الإبداع وآفاق الثقافة الجديدة.من هنا تبرز ثقافة التفاعل والتنوع كنتيجة للحوار في مقتضياته العديدة وكثمرة للقبول بالآخر ومحاورته، بهدف توطيد جسور التواصل، وفي غياب الحوار الثقافي نفتقد بالتالي إيجابياته وثمراته الكبرى، وتثمر في مقابله ثقافة الاستبداد بحديث يقود المجتمع إلى حالة سلبية من عدم التوازن وعدم الترابط، وبالتالي وضع المجتمع في إطارين؛ إما التصادم بين الأفكار والاتجاهات المتعارضة والوصول للصدام المادي، أو اضمحلال الكل في فكر واحد واتجاه تسلطي منفرد؛ مما يعني انقراض الإبداع، وموت التنوع، وإقصاء الاجتهاد، والتوقف التام عن الحركة الحيوية المستمرة.. أيضاً فإن الاستبداد (يتناقض) مع الحوار، فمع وجوده (يتراجع) الحوار؛ لأنه يمثل اعترافاً بالآخر، وبالتالي إذعاناً للتعددية والتنوع، وهذا أمر ترفضه الدكتاتورية، وفي نفس الوقت فإن قطع الطريق أمام الحوار يقود تدريجياً لتسلط الرأي المنفرد، وإقصاء الرأي الآخر، فالحوار الثقافي يثمر أيضاً ثقافة الانفتاح المحضة ضد الاختراق، ذلك أن الانغلاق ـ كما يقول د/ محمد عابد الجابري ـ "موقف سلبي غير فاعل.. والطريقة الإيجابية للتحصين الذاتي أن يكون الحوار الداخلي قائماً ومترابطاً وبالتالي سيكون متماسكاً حتى في حالة عدم التكافؤ في القدرات والإمكانيات المختلفة بيننا وبين الآخر، مع وجوب إرساء ديمقراطية يتم بها وفي إطارها تحرير الثقافة من السياسة وذلك برفع جميع القيود عن حرية التعبير التي من دونها لا تفكير ولا حوار ولا إبداع، فالاستقلال الثقافي يبدأ من استقلال الفكر، وليس هناك من بديل للفكر المستقل غير التبعية للغير أو الجمود على التقليد.. والحوار الذي توفره الديمقراطية الحقة في إطار تكافؤ الفرص وضمن الإستراتيجية الثقافية..هو وحده القادر على أن يحفز عملية "التجديد من الداخل، عملية تبيئة الحداثة وجميع مكتسبات الفكر الإنساني المعاصر بالصورة التي تجعل من الاتصال والتواصل مع الثقافات الأخرى عصر إغناء وإخصاب، لا عامل استلاب واستسلام".ومن ضمن ما قام به الإسلام عند انطلاقته العظيمة، أنه اتخذ الحوار طريقاً إلى الإنسانية، فأثمر هذه الحضارة العملاقة التي تفاعلت مع كل الحضارات في ذلك العصر "بوتيرة لا سابق لها في تاريخ البشر. فتوسعه في آسيا كما في أفريقيا وأوروبا قد أتاح له أن يكون بوتقة عملاقة انصهرت فيها ثقافات عدة. وهكذا نشأت حضارة أصيلة عالمية الطابع، متخذة العربية لغة مشتركة فدور الحوار أنه يساهم في التعايش مع ثقافة الآخر وفكره ورؤاه من منطلق القبول بالتعدد الثقافي والإقرار بها، وهذا في حد ذاته غنىً للثقافة نفسها، وقوة لعناصرها الذاتية، يضاف إلى ذلك أن نظرتنا للقبول بالآخر والتعايش معه تعتبر جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا وحضارتنا وديننا الحنيف، ومن المهم تعميم ثقافة القبول بالآخر والتعايش معه والدفاع عن حقه في التعبير ما دام يلتزم القوانين والأنظمة المرعية، وهذا ما يدفعه أيضاً للقبول بالحوار الثقافي والتعايش معه، بما ينمي التفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب من خلال هذا التفاعل، ومع أن لكل أمة سلمها الحضاري، وحيزها في هذا السلم ودرجته، إلا أن هذا التفاعل يتنامى مع الحوار الثقافي، ويترك أثره وتأثيره بالتراكم الثقافي، ويكون أقدر على الثبات والتأصيل، والأقدر أيضاً على الحوار الثقافي والحضاري مع الحضارات والثقافات الأخرى بحكم تفاعلها الثقافي معهما.حيث يتفق عليها المجتمع من خلال التشريعات والقوانين واللوائح، لتشكل جزءاً لا يتجزأ من كيانها الشخصي والمجتمعي، وأصبحت أنماط سلوك متعارفا عليها، وقد تكون قيماً مرحلية تنعدم خواصها بمجرد انقضاء المرحلة الزمنية التي تواجدت فيها تلك المفاهيم. من هنا، فإن القيمة تدخل في صميم التكوين الثقافي الجمعي والفردي على حد سواء، لأن الثقافة المميزة لأية مجموعة توضع على شكل مفاهيم وقيم وأنماط سلوك، ومنظومات معرفية تحققت لدى أنساق متتالية من الجماعات البشرية عبر مراحل متعددة.ومن ثمرات الحوار أيضاً في الثقافة أن هذا الحوار يسهم مساهمة إيجابية في الانفتاح السياسي، أو على الأقل الاقتراب من الديمقراطية المختلفة، وهذه الديمقراطية ـ بغض النظر عن المسميات والمصطلحات ـ تقترب كثيراً من مفهوم الشورى في الإسلام من حيث التعدد في الآراء، والاختيار الحر النزيه للأشخاص الذين يتصدون للعمل العام، وكذلك القبول بنتائج الانتخابات... إلخ.. حتى الشيخ أبو الأعلى المودودي، وهو أكثر العلماء المعاصرين انتقاداً لبعض النظريات الغربية بما فيها الديمقراطية، قال في كتابه "مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة": كان الصحابة أكثر حباً للديمقراطية وأشد الناس تمسكاً بالحرية الفكرية ولم يكن الخلفاء يكتفون باحتمال نتائج الحرية الفكرية من قبل الناس، بل كانوا يستثيرون هممهم. ولم يدّع أحد من الصحابة أنه لا يخطئ. وأبو بكر هو القائل: "هذا رأي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وعمر هو القائل: "لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، وفي وجود ثقافة الحوار ومعطياته وتحدياته الاجتماعية والفكرية فإن الإبداع الحقيقي في الثقافة ينمو ويزدهر ويثمر بالتالي نتاجا أصيلا، ذلك أن النواة الحقيقية للإبداع هي التفاعل "الخلاّق بين المثقف وواقعه.. وهذه العلاقة تنتج معالجات وإبداعات تنسج واللحظة التاريخية.فتفاعل المثقف مع الواقع لا يعني الخضوع إلى معوقاته أو الدخول في نفق تلك المقولة السلبية ليس بالإمكان أبدع مما كان. فالتفاعل الذي نعنيه هو التهيئة اللازمة للشروط النفسية والعقلية، لجعل الأديب أو المثقف يستوحيان من الواقع الأعمال الأدبية والثقافية، كما أن الأرض الخصبة التي تؤهل الأديب أو الفنان لعمليات الإنتاج الأدبي أو الثقافي المبدع، هي التي تشكل الرهان الإبداعي المبتغى في عملية البناء الثقافي، ولكي يكون المنجز عملية واعية في أفقها الصحي والانفتاحي للرؤى والقضايا الوطنية والقومية، وفي مسارها المنسجم مع راهنها بظروفها الإيجابية والسلبية بعيداً عن الأطياف الخادعة والمقولات الواهمة.كما أن منطلقات الحوار الثقافي تثمر في مسار الديمقراطية السياسية وتفرعاتها وآلياتها المختلفة، أشخاصاً واعين للمعترك السياسي والقادرين على الفرز والتقييم الواعي بين الغث والسمين، في الإسهام التطوري للديمقراطية ومستلزماتها في الانفتاح على المجتمع سياسياً، عن طريق التدرج الهادئ بعيداً عن حرق المراحل، أو القفز على الواقع حتى يمكن أن تنجح الخطوات الديمقراطية ـ الشوروية ـ في انطلاقها العقلاني الرزين بعيداً عن التقليد أو الاستنساخ المسخ لثقافة الآخر وتطوره الديمقراطي. فلا شك أنه يفتح آفاق الحرية والإيمان بها باعتبارها هبة إلهية من الخالق عز وجل، والحوار الثقافي يجعل من هذه القيمة العظيمة مرتكزاً للتعاطي الإيجابي مع قضايا الحق والحرية والعدل، والحرية على هذه الأسس متوازنة في الإسلام، حيث منح "الحرية الفردية في أجمل صورها، كما يمنح المساواة الإنسانية في أدق معانيها، ولكنه لا يتركها فوضى، فوضع (مبدأ التوازن) في كفتّي ميزان، أي التوازن بين متطلبات الفرد، ومتطلبات المجتمع، حيث لا يطغى أحدهما على الآخر، وأن المجتمع لا يدمج الفرد، ويمحو إرادته، ويطحن اعتباره، ولكنه يجعل إرادته للخير الجماعي بقوة التدّين والضمير.. ولذلك كانت حقوق الأفراد مقيّدة دائماً بحق الجماعة، من أجل الأمة ورعاية مصالحها.
1621
| 13 سبتمبر 2015
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
13626
| 20 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1800
| 21 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1176
| 20 نوفمبر 2025

شهدت الجولات العشر الأولى من الدوري أداءً تحكيميًا...
1149
| 25 نوفمبر 2025

في مدينة نوتنغهام الإنجليزية، يقبع نصب تذكاري لرجل...
1050
| 23 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
996
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
918
| 20 نوفمبر 2025

أصبحت قطر اليوم واحدة من أفضل الوجهات الخليجية...
825
| 25 نوفمبر 2025

في زمن تتسارع فيه المفاهيم وتتباين فيه مصادر...
804
| 25 نوفمبر 2025

عندما أقدم المشرع القطري على خطوة مفصلية بشأن...
723
| 25 نوفمبر 2025

حينما تنطلق من هذا الجسد لتحلّق في عالم...
717
| 21 نوفمبر 2025
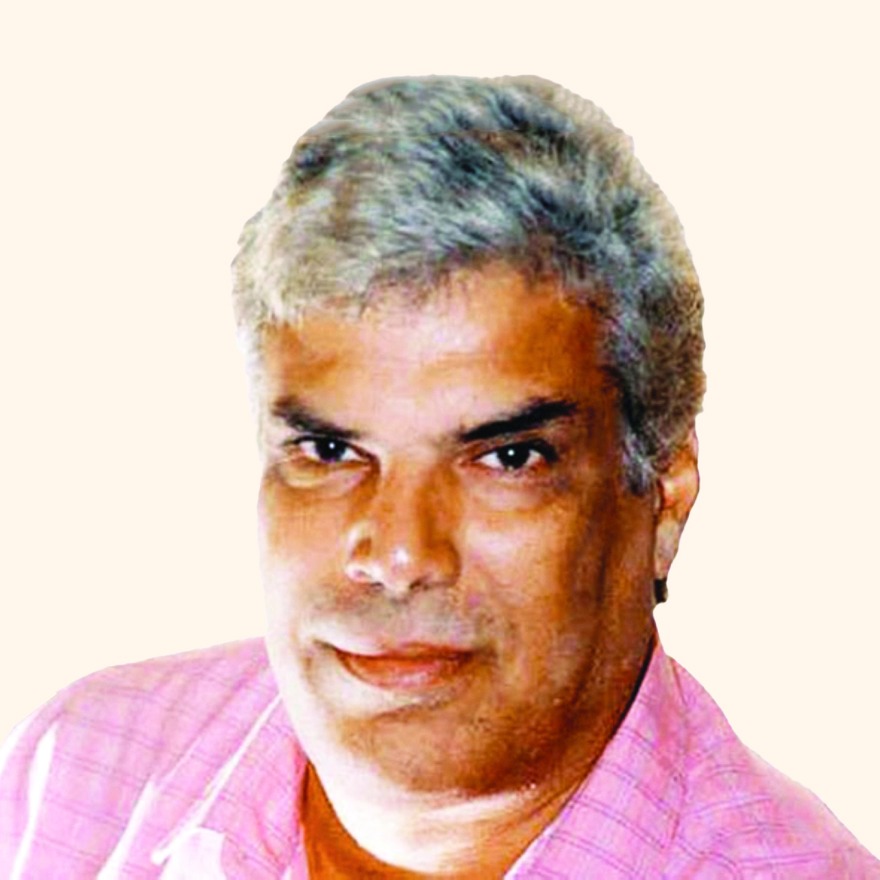
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
657
| 20 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







