رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بدأت المشكلة السورية كنزاع داخلي بين النظام والمعارضة في عام 2011، وما سمي آنذاك بالربيع العربي، وقد كانت المطالبات الشعبية في سوريا محدودة، وتتلخص ببعض الإصلاحات في مجال الحريات السياسية والعامة، لكن النظام رفض هذه المطالب وسخر منها، وقال الرئيس بشار (إن سوريا غير تونس وغير مصر)، واستخدم العنف في مواجهة المسيرات السلمية، فحصلت الانشقاقات في الجيش والشرطة والأمن، بعد بروز القمع الشديد للمواطنين المطالبين بالإصلاحات، ولو استجاب النظام لبعض المطالب لوقفت هذه الانتفاضات، وتجنّبت هذا البلد العربي المهم، التدمير والقتل والتهجير، فبعد التدخل من قوى عديدة في هذا الصراع، أصبحت المسألة السورية قضية دولية، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن روسيا تدخلت عسكرياً مع النظام، بينما الولايات المتحدة والغرب الرأسمالي، كان تدخله محدوداً تركز على دعم المعارضة قبل سنوات، لكنها قامت في تلك الفترة بتسليح وتدريب عناصر من المعارضة السورية التي تصفها الولايات المتحدة بالمعتدلة.. وفي العامين الماضيين تراجع الدعم مؤخراً بصورة ملحوظة، ومنها كما تذكر بعض التقارير الصحفية، قيامها ببعض العمليات السرية العسكرية على الحدود السورية مع تركيا، هدفها الأساسي معرفة أي مجموعات المعارضة التي يمكن للولايات المتحدة إمدادها بالسلاح، وهي مؤيدة للمعارضة المعتدلة، بعدما بدأت الإخبار بالتوارد عن وجود عناصر قريبة من القاعدة، كجبهة النصرة وداعش، التواجد في الأماكن التي تسيطر عليها المعارضة في بعض المدن السورية. كما ساعدت الاستخبارات الأمريكية أيضًا بعض هذه العناصر المعارضة، لفتح طريق لعدمها وإسنادها للوقوف في وجه قوات النظام، كما قامت بتدريبهم على وسائل الاتصالات الحديثة، ومحاولة الابتعاد عن الجماعات القريبة من القاعدة وداعش والجماعات التكفيرية، ضمن المجموعات التي تتواجد في سوريا، بينهما روسيا استخدمت السلاح الجوي، إلى جانب الأسلحة الأخرى، من خلال دعم النظام عبر إرسال الأسلحة والخبراء العسكريين والفنيين، لتدريب قوات على استخدام السلاح الروسي وغيرها من المعدات العسكرية الروسية، ويعتقد البعض أن الولايات المتحدة، لم تكن جادة في دعم المعارضة المعتدلة بالصورة التي تجعلها تخل بميزان القوة مع النظام، والسبب أن إسرائيل لا تريد أن ينتهي الصراع لصالح القوى التي ربما يكون لها السيطرة على الحكم وبالذات القوى الإسلامية، إذا ما سقط النظام السوري، وهذا ما جعل الولايات المتحدة، أقل اهتماماً بالمشكلة السورية، وفي رفضها للنظام الحالي في السنوات الأخيرة، وهذا الموقف الأمريكي ربما شجّع روسيا على التدخل المباشر لدعم النظام، أو التغاضي عنه، لكن الموقف الأمريكي أيضاً لا يريد أن ينجح النظام بصورة تامة، وذلك حتى لا تسيطر إيران في حالة انهيار المعارضة المعتدلة، وربما يدور الحديث منذ فترة، أن الفرصة الأقرب لحكم سوريا، هو نظام علماني، يكون هو الأنسب الذي يتولى الحكم، بعد سقوط النظام حتى لا يحصل انقسام وتفتيت لسوريا وتتحول إلى كنتونات طائفية، لكن روسيا وإيران يتحركان بقوة لبقاء النظام، أو مشاركة المعارضة المعتدلة في الحكم بعد الاتفاق على سلام ثابت بضمان الأطراف الدولية، ويبدو أن الصراع في سوريا أصبح صراعاً دولياُ وليس إقليمياً ولا داخلياً، لكن من يحدد التوازن الداخلي، هي القوة العسكرية الدائرة الآن في مدينة حلب وبعض المدن السورية الأخرى، على الرغم أن الموقف الغربي، ليس موقفه مثل موقف روسيا في تدخله بصورة مباشرة في القتال إلى جانب النظام مع إيران وحزب الله، لكن يبدو أن الحرب البادرة بدأت الآن بصورة جلية، كصراع دولي على النفوذ على مناطق مهمة سياسيا وإستراتيجيا، وربما روسيا ترى أن النفوذ الأمريكي، أصبح أكثر سيطرة على المناطق التي كانت سابقا أكثر ارتباطاً بالاتحاد السوفييتي آنذاك في فترة الحرب الباردة, وضمن محور المعسكر الاشتراكي سابقاً، إذا ما سقطت سوريا، سيصبح النفوذ الأمريكي ماسكا بكل الخيوط الإستراتيجية في المنطقة، وربما أن روسيا تريد أن تستعيد مكانتها السياسية في المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتفكك دوله، وسقوط المعسكر كله في أواخر الثمانينات، وهذا ما يجعل روسيا بحاجة لاستعادة بعض مكانتها وإثبات وجودها السياسي والعسكري، بعد العزلة السياسية التي استمرت ما يزيد على ربع قرن تقريباً، فالصراع الآن بدأ بالبروز في الأزمة السورية، وفي بعض دول الاتحاد السوفييتي سابقاً, وبدلا من تركيز النظام الدولي على تحقيق العدل وإشاعة التعايش السلمي وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان الأكثر اضطراباً ، فإنه بدأ يستعيد "ما يسمى اصطلاحا بالحرب الباردة [ Coldwar ] الذي شاع استخدامه في العلاقات الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة ـ كما يقول د/ إسماعيل مقلد ـ وهذه الحرب الباردة عملت على تأسيس نظرية الصراع الدولي، وأنماط القوة في المجتمع الدولي، وتوازن الرعب النووي، وسياسة الاحتواء، وغيرها من حقائق القوة والصراع في الإستراتيجية الدولية المعاصرة. ولعل أخطر إفرازات الحرب الباردة ما سمّي بنظرية "الصراع الدولي"، ذلك أن الصراع في صميمه هو تنازع أرادت بحكم الاختلاف في التوجهات والسياسات. وهذه النظرية هي التي قسمت العالم إلى معسكرين متصارعين وعملت على استنزاف الاقتصاد للدول الصغيرة وجعلتها أسيرة هذا الصراع لاختيار مدى قوة التوازن الدولي، واختبار الأسلحة التي يتم تصنيعها. مع انفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم كقوة عظمى بلا منافس أوجد وضعا شديد التعقيد، إذ على أثر انتهاء الاتحاد السوفييتي بتفكك دولة، وقيام الحروب الأهلية في البلقان وفي غيرها انكشفت عيوب النظام الدولي. فلو عدنا إلى الوراء قليلا لوجدنا أن كل الأنظمة الدولية التي أقيمت كانت لأسباب حروب ومغامرات دولية.. وكذلك كل الصيغ التي أوردتها ديباجة هذه القوانين هي شروط "فرض" وليس اختيارا مقنعا، وهذا ما يفسر انهيار الكثير من الأنظمة، ففي عام 1815 فرضت الدول الأوروبية المنتصرة نظامها العالمي الذي تمثل بحفظ "الستاشكو" الأوروبي بعد مغامرات نابليون السياسية التي عصفت بأوروبا آنذاك". ولا شك أن الأزمة السورية، أصبحت بيد القوى الدولية، شاء السوريون، أم أبوا، حتى الدول الإقليمية التي لها أثر واهتمام بدأت بالتراجع عن صدارة المشكلة السورية، لذلك فإن الصراع الدولي أصبح أمرا واقعاً بوسائل كثيرة، على اعتبار أن المنطقة العربية مهمة إستراتيجياً، وأمنياً، بحكم موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا.. لذلك فإن الصراع على النفوذ والمناطق المؤثرة والمهمة، هو صراع إرادات بين هذه الدول، وهذا الصراع على حساب الدول الصغيرة وعلى شعوبها، ولذلك فإن على النظام والمعارضة السورية أن يتخذوا قراراً يخلّص هذا البلد من ظروف وحالات تتمزق فيها هذه الدولة إلى دويلات وعصبيات وكانتونات، تتصارع إثنياً ومذهبيا وسياسياً.
635
| 14 أغسطس 2016
طرح بعض الكتاب الغربيين من الفرنسيين وغيرهم قضية ازدياد بعض الأعمال الإرهابية في فرنسا في السنوات الأخيرة منذ العام المنصرم، لكن وتيرتها ازدادت بصورة لافتة، في وقت كانت الأعمال الإرهابية في دول أوروبية أخرى قليلة مقارنة بما حصل في فرنسا من عمليات إرهابية كثيرة حصدت المئات من الأبرياء منذ عدة أشهر، واستهدفت الكثير من المواطنين الفرنسيين، وغيرهم من الجنسيات الأخرى التي تعيش بفرنسا. وطرح بعض المحللين ظاهرة التطرف والإرهاب في فرنسا، إلى جانب قضية التهميش والإقصاء في بعض الضواحي الفرنسية من العاطلين والمهشمين، إلى جانب أن اتهام العنصرية المهاجرين، كانت سببًا من أسباب التوتر والقلق في الضواحي الفرنسية قبل سنوات، وحصلت خلالها مظاهرات واحتجاجات كبيرة بعد مقتل شابين من المهاجرين أكتوبر 2005 في ضاحية "كليشي سو بوا" استمرت عدة أسابيع في كل أنحاء فرنسا، وسببت قلقًا للحكومة الفرنسية والأحزاب السياسية والنخب الفكرية والثقافية، كما جرت مسيرة كبيرة بمشال العاصمة الفرنسية، نددت بالعنصرية والتهميش وسميت بمسيرة "الكرامة ضد العنصرية" وذلك في الذكرى العاشرة لأعمال شغب جرت في ضواحي المدن الفرنسية، وقد سبق وأن خرجت مسيرات قبل 33 عاما تطالب بالحقوق، ووقف التهميش، وقد صرح بعض منضمو المسيرة أنه بعد ثلاثة عقود على هذه التظاهرة "فإن المضايقات التي يتعرض لها سكان الأحياء الشعبية من السود والعرب والروم وحتى البيض، والإهانات التي يعانون منها تشكل جزءا من حياتهم اليومية". وقد وعد رئيس الحكومة الفرنسية السابق" مانويل فالس" في 2015، بأن الحكومة الفرنسية "عازمة على محاربة العنصرية والظلم اللذين يعاني منهما سكان الضواحي الفرنسية. وأضاف: "إن مسلمي فرنسا هم أيضا أبناء الجمهورية". ولا شك أن مسألة العنصرية والتهميش يعتبرها البعض سببًا من أسباب التطرف والإرهاب، وهي التي جعلت فرنسا هدفًا لهذه الأعمال من بعض الجماعات التي تستغل ظروف وإحباطات بعض سكان الضواحي الفرنسية، وطرح الكاتب الفرنسي "فرهاد خافار" هذا الرأي في مقالة بجريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وربط ما سماه بالجهادية الفرنسية والتصلب العلماني، وقال في هذا المقال اللافت: "منذ الثورة الفرنسية، يرجح الوزن الأيديولوجي لصورة الأمة (الفرنسية) عن نفسها: نازع جمهوري إلى الارتياب من الديانات، على أنواعها، بدءًا بالكاثوليكية. وهذا النموذج أُسيء استخدامه في مرحلة العودة عن الاستعمار ثم في أعوام الأزمة الاقتصادية، ووصم الخصوصيات الثقافية بعيوب، وإلزام الأجيال الجديدة بالفردية وتقليص العولمة هامش عمل الحكومات. والحق يقال، تخفق فرنسا في تذليل مشكلة التهميش الاجتماعي والاقتصادي. فنموذجها، وهو يغالي في حماية أصحاب الوظائف ولا يشمل كل العاطلين من العمل، يغذي القلق وينفخ فيه. فشباب الضواحي مهمشون والآفاق أمامهم ضيقة، وهم يشعرون بأنهم ضحية. وتتوجه البروبجاندا الجهادية إليهم وتستميلهم، غالبًا، إثر المكوث في السجن جزاء ارتكاب جنحة ما". وهذا الرأي ما تحدث عنه أيضًا وقاله الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني "يورغن هابر ماس" في محاضرة منذ فترة، حملت عنوان "أوروبا ومهاجروها"، من إن المشكلة التي "تحرق أصابعنا هي تفاقم الثقافة الأصولية الجمعوية داخل مجتمعاتنا. هذا المشكلة تم التعامل معها ولمدة طويلة جدًا من وجهة نظر سياسة الهجرة. ففي أوقات الإرهاب، تم معالجتها فقط على مستوى الأمن الداخلي. لكن حرق السيارات في ضواحي باريس، والإرهاب المحلي من طرف الشباب المهمّش في أحياء الإنجليزية للمهاجرين، والعنف في مدرسة روتلي، قد علمنا أن الحماية الأمنية لم تؤتِ أكلها في تحصين أوروبا. أبناء وأحفاد المهاجرين السابقين هم ومنذ فترة طويلة جزء منا. ولأن الأمر ليس كذلك، فإن ذلك يمثل تحديًا بالنسبة للمجتمع المدني وليس لوزارة الداخلية.الأمر يتعلق هنا باحترام ذوي الثقافات والديانات الأجنبية في اختلافهم وإدماجهم في إطار التضامن الوطني". ولا شك أن قضية المهاجرين المسلمين إلى بلاد الغرب، تحتاج إلى وقفة أخرى تسهم في تأسيس التعايش، وأن تتحقق للمهاجرين العيش الكريم، دون تهميش أو إساءة إلى دينهم أو حياتهم الاجتماعية، فالذي قاله الفيلسوف "هابر ماس" عن التهميش مسألة ينبغي أن تأخذ في الحسبان من قبل النخب السياسية والفكرية في الغرب، وخاصة أن هذا ما تقوله الدساتير والقوانين في الغرب عموما، وفي فرنسا بصورة خاصة، وهذا التهميش يخل بهذا النظرة الديمقراطية التي ينظر لها الكثيرون نظرة تقدير واحترام، كما أن هذا التهميش والإقصاء تستغله الجماعات المتطرفة، لزرع التكفير والغلو لهؤلاء المهاجرين، الذين يعيشون في أماكن ينقصها الكثير من الظروف الحياتية الجيدة، ولذلك لابد من النظرة الجيدة لهم وإبعاد النظرة العنصرية، وإرساء العدل والمواطنة الحقة، كما حددته قوانين الجمهورية الفرنسية، وهذا هو الحل الناجع الذي سيسهم في وقف الكثير التطرف والإرهاب.
381
| 07 أغسطس 2016
تفاجأ الكثيرون من المراقبين والمتابعين للشأن التركي، بالفشل الذريع للانقلاب الذي قاده بعض جنرالات الجيش في الخامس عشر من يوليو الحالي، مع بعض الأنصار من القضاة والاستخبارات الموالين للداعية التركي المعروف فتح الله جولن الذي يعيش منذ فترة في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات، ويعزى البعض هذا الفشل الكبير، إلى معلومات تلقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من بعض القيادات العسكرية والاستخبارية الموالية للنظام الحالي، بينهم رئيس الأركان الحالي، وكذلك قائد الجيش الأول حسب ما تذكر بعض المصادر.. ويعزى البعض الآخر أنصار النظام التركي، أنه هو الذي أجهض هذا الانقلاب بعد ما طلب الرئيس رجب طيب أردوغان منهم الخروج لمواجهة الانقلاب، مع أن الانقلابيين قد سيطروا على أغلب الأماكن الهامة في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وإعلانهم الأحكام العرفية في الساعات الأولى لبيان الانقلاب، لكن بعض المحللين يرون أن حزب العدالة والتنمية، أصبح من القوة والسيطرة في الداخل التركي ما جعل قيادات الانقلاب تنهار بسرعة وتستلم، وهذا ما برز في التصريح الأول لرئيس الوزراء بن علي يلدريم .. فما هي الأسباب القوية لهذا الفشل، وانهياره بهذه السرعة؟ لا شك أن هناك أسباباً جوهرية ساهمت في هذا الفشل الذريع، ويرجعها البعض إلى قوة شخصية رجب الطيب أردوغان، والذي نجح بذكائه في أن يتحرك لوسائل الإعلام، ويطلب من الشعب الخروج للتعبير عن رفضهم للانقلاب على الديمقراطية والشرعية، وهذا ما نجح فيه بصورة لافتة، وكما يبدو أن هناك قناعة من الرئيس وقيادات حزب العدالة والتنمية، بعد ساعات قليلة من أن الانقلاب مصيره الفشل، وهذا ما صرح به بن علي يلدريم رئيس الوزراء، من "أن الانقلابيين سيدفعون ثمناً باهظا بهذا الانقلاب"، وهو ما كرره الرئيس أردوغان بعد ساعتين أيضاً، وقال فيه عبر سكاي بي (تلفزيونياً)، إن قيادات الانقلاب سيدفعون الثمن باهظاً في محاولتهم الانقلاب على الديمقراطية التركية، لكن الأقوى تأثيرا كان خروج الشعب التركي بكل انتماءاته، الذي لم يأبه لسماع الطائرات التي استخدمها الانقلابيون، ولا لدوي المدافع ولا لسماع طلقات الرصاص في بعض الأماكن العامة، فالشعب التركي الذي استجاب لرئيسه، يريد أن يحافظ على ديمقراطية تواجه مصيراً قاتلاً في بلد كبير متعدد الأعراق والقوميات، وما قد تواجه من صراعات وتحولات داخلية خطيرة، ربما ترجعها عشرات السنين إلى الخلف، فالثقة الكبيرة، كما يقول الباحث د/ هشام توفيق،"التي ميزت القيادة التركية هي التي مكنتها من التصدي للانقلاب، وهي ثقة راهنت على السواد الأعظم التركي، وراهنت على تقدير حجم نصرة الشعب ومدى تشبّعه فكرا ووعيا بمفهوم الدولة والديمقراطية وخطورة الانقلاب.من تجليات ذلك ظهور الرئيس أردوغان سريعا على إحدى المحطات التلفزيونية عبر الهاتف في عشر ثوانٍ، يخطب في للجماهير التركية بثقة كبيرة، وبث فيها الأمل وراهن عليها، وطالبها بالنزول على الشارع، وبذلك وضع ثقته في الشعب، وجعله في مواجهة الانقلاب. سواء كنت تؤيد سياساته أو تعارضها، فأنت أمام رئيس دولة مسؤول يعلم أنه منتخب من أبناء وطنه ويؤمن بحق بأن لا مكان للبندقية أمام إرادة الشعب".. ولذلك فإن هذه الثقة فالشعب، جعلت الانقلابيين يتفاجأون من سرعة خروج الشعب التركي، لمقاومة الانقلاب مع حظر الطوارئ والحديث عن الأحكام العربية، وهذا يبرز أن الوعي الشعبي والنخب السياسية بكل أطيافها الحزبية، رفضت الانقلاب، وهذا هو الرصيد القوي الذي جعل القيادات الانقلابية تخسر تأييد الأحزاب المعارضة، فالمعارضة على الرغم من خلافها السياسي الحزبي، مع حزب العدالة والتنمية، إلا أنها تدرك أن الانقلاب، عودة للخلف ونكوص على الحريات والتعددية والديمقراطية التي اكتسبتها تركيا... إلخ.. وهي تجربة مريرة ذاقها الأتراك منذ خمسة عقود من توالي الانقلابات، والحقيقة أن الرئيس أردوغان استفاد من هذا التأييد الشعبي والنخب السياسية، وفي إحباط هذا الانقلاب في ساعاته الأولى، ووجه ضربة كبيرة، ربما لم يسبق لها مثيل في التاريخ التركي المعاصر، وهذا يعني أن وسيلة الانقلاب في تركيا، لن تجد لها بعد الآن قبولاً بعد ما جرى في 15 يوليو الماضي. وقد أدرك الرئيس أردوغان، قوة وتأثير الإعلام ووسائل الاتصال الأخرى وفق نظرية "الإقناع الناعم" لأنطونيو غرامشي، فكان أن تحرك له عبر الإعلام المرئي، بوسيلة صغيرة (سكاي بي)، وهي التي قلبت الموازين بعد حديثه السياسي القصير، مما أفشلت المحاولة الانقلابية سريعاً، كما أن المساجد خالفت نظرية كارل ماركس، من (أن الدين أفيون الشعوب)، فقد انطلقت من المساجد الصيحات المدوية، تخاطب الشعب التركي لمواجهة الانقلاب، بعبارات حديثة وواعية غير تقليدية "أنتم من يمنع التسلط" و"أنتم الوتد الأساسي للحرية والكرامة والمساواة"، فكل هذه الصيحات زعزعت الانقلابيين، وجعلت الشعب التركي بكل توجهاته الفكرية والسياسية ومنهم العلمانيون أيضاً، وقفت مع شرعية الدولة الحكومة المنتخبة، لمواجهة الانقلاب.. لكن لماذا وجهت التهم للمفكر الإسلامي التركي فتح الله جولن؟ وماذا يعني اتهام تياره بالكيان الموازي للدولة ؟ وللحديث بقية...
842
| 24 يوليو 2016
في مقالتي الأسبوع الماضي تحدثت عن سنن التاريخ في صعود وسقوط الفلسفات والدول، أو تراجعها عن مسارها السابق، وهذه من السنن الطبيعية للبشر والحياة، إن لم يتم التجديد والمراجعة، وهناك كما يروى أن حديثا للنبي (صلى الله عليه وسلم) يتحدث عن أهمية التجديد في أمر الدين وقيمه،غير القطعية أو الفكر الإسلامي عمومًا، ونص الحديث كما ورد (إن الله يبعث في كل مائة عام، من يجدد للأمة أمر دينها)، وهذا يبرز أهمية التجديد والمراجعة ما يأتي من أفكار وترسبات مع الزمن، ودخلت في الدين من تفسيرات ومقولات ليست هي في أصل الدين نفسه.. والإشكالية أن بعض الفلاسفة والمفكرين، اعتقدوا أن الفكر البشري يستطيع أن ينجز لنفسه فلسفات تكون (الخلاص النهائي) للبشرية، ولا فكر آخر يحل بعدها! ونتذكر قبل عقد ونصف، أن البروفيسور الياباني/ الأمريكي فرانسيس فوكوياما قال في أطروحته الشهيرة (نهاية التاريخ)، والتي صدرت بعد ذلك في كتاب بهذا الاسم: "إن الديمقراطية الرأسمالية هي النموذج النهائي للتطور البشري الإيديولوجي للإنسانية وبالتالي فهي تمثل نهاية التاريخ"، فإنه لم يكن يدرك أن هذا الطرح الإيديولوجي أيضا لم ينطلق من رؤى واستقراءات عميقة في التاريخ والصيغ والنماذج البشرية، وأنه ربما سيفاجئ بما حدث للنظام المالي الرأسمالي في الولايات المتحدة الذي اعتبره نهاية النهايات لكل الفلسفات والأفكار الإنسانية، وأصبحت الاقتصادات العالمية تعيش زوابعه السلبية وأثرها على الأمم في عيشها واستقرارها، آخرها الأزمة المالية التي عصفت بالغرب منذ عدة سنوات وتداعياتها المقبلة لكنه بعد سنوات تراجع هذا القول الذي كان طرحًا عاطفيا، وزهوًا أو افتخارا بسقوط الاتحاد السوفيتي (آنذاك)، مما جعله يقول إن التاريخ سيتوقف عند الديمقراطية/ الليبرالية، فقال في مقالة له "في الواقع فإن النمو الاقتصادي وحده لن يضمن الاستقرار. ولكن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأننا دأبنا على المغالاة في تقدير المخاطر التي تتهدد الاستقرار منذ الحادي عشر من سبتمبر، وأن ردة فعلنا هذه والمبالغة فيها هي التي أوجدت الكثير من المخاطر الخاصة. وخلال فترة هجمات 11 سبتمبر ربما لم يكن هناك أكثر من بضع عشرات من الناس في العالم لديهم الدوافع والوسائل الممكنة للتسبب في إحداث كارثة تلحق الأذى بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن وبمجرد أن ركز جهاز أمننا القومي القوي على هذه المشكلة، تلاشت إمكانية وقوع مثل هذه الهجمات بصورة دراماتيكية. ولعل قرارنا بغزو العراق قد أوجد مشكلة جديدة تمامًا لأنفسنا حيث أوجدنا أرضًا خصبة للإرهاب وغيرنا من ميزان القوى في المنطقة لصالح إيران". والواقع أن فوكوياما لم يعد ينظر تلك النظرة التفاؤلية تجاه الديمقراطية الليبرالية التي بشر بتفوقها على كل الفلسفات والأيديولوجيات وهيمنتها على كل العالم. لأن الأوضاع التي تلت أطروحته في [ نهاية التاريخ ] أصبحت بلا جدوى، وفكرة وهمية غير واقعية ربما أقرب إلى الأيديولوجيات التي ظهرت في القرنين الماضيين مثلها مثل كل الأيديولوجيات التي سبقتها وأصبحت في متحف التاريخ.قد يكون جانب الحريات والانفتاح السياسي والإعلامي في الغرب هو الذي جعل النظرية الليبرالية تبقى حتى الآن متماسكة بعكس الأيديولوجية الماركسية التي تهاوت بشكل غريب وغير متوقع لأن الاستبداد والقمع والإقصاء عجل بسقوطها سريعًا بتلك الصورة المزرية.. الآن ما يجري في العالم، خاصة في الغرب، أن الكثير من الفلسفات والنظريات، لا يمكن أن تبقى طويلا، أو تكون الخلاص النهائي للإنسانية، فالغرب يعاني من ارتباك في منظومته السياسية والفكرية، وهذا طبيعي، بعد عقدين من الانطلاق والتقدم، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تبرز أن هناك شيئا ما غير مرئي، ليس متماسكًا بالصورة التي نراها في الظاهر، وهذا ما يراه البعض مقدمات للتغيير في الكثير من الرؤى التي استقر عليها الفكر الليبرالي الرأسمالي، لكن من الصعب التنبؤ بما يكون عليه الغرب في العقود الأربعة المقبلة.
340
| 17 يوليو 2016
عندما جاء تصويت الشعب البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، طرح كثير من المحللين كثيرا من التوقعات والتنبؤات، لما يكون عليه الغرب مستقبلا، في ظل التفسيرات الكثيرة، من أن يحصل تفكك للغرب، كما حصل للاتحاد السوفيتي في نهاية القرن الماضي، عندما أقدم ميخائيل جورباتشوف على ما سماه، إعادة البناء (البيروسترويكا) التي طرحها بعد تسلمه الحكم عام 1985، وهي ما ساهمت في انهياره، وسقوط المعسكر الاشتراكي كله، وانتهاء النظام الشمولي برمته في هذا المعسكر بعد ذلك، وانضمام بعض دوله إلى الاتحاد الأوروبي. والواقع فالمقارنة بين ما حصل للاتحاد السوفيتي من تفكك وانهيار النموذج الاشتراكي الشيوعي، وبين ما يحدث في الغرب الليبرالي الرأسمالي، بينهما مساحات كبيرة للاختلاف البيّن، لأن النموذج الرأسمالي جرى تجديده وإلغاء التوحش والاستغلال الذي اتسمت به الرأسمالية في القرن التاسع، بعد قيام الثورات، والمطالبات لوقف التجاوزات غير العادلة، وهو ما جعل النظام الرأسمالي يعدل من شراسته، وأصبح العامل في الغرب أفضل من العامل في المعسكر الاشتراكي، وهذا التجديد والتغيير حصل في ظل الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، بعكس النموذج الشيوعي الذي تجمّد وتحجّر عن تغيير وتعديل نموذجه، ما جعل شعوب هذا المعسكر تفقد الثقة في هذا الفكر، وجاءت البيروسترويكا، لتفتح الباب واسعًا لتغيير لتحولات هائلة، سقطت معها أنظمة عديدة، وتوحدت ألمانيا من جديد بعد اقتسامها بين المعسكرين بعد الحرب الكونية الثانية.. وكانت الفكرة الماركسية حاملة أسباب فشلها، فقد انتقت الماركسية بعض مراحل التاريخ وصورته فيما أسمته بـ(الحتمية التاريخية)، كما يقول المرحوم د. مصطفى محمود: "فهم لم يأخذوا التاريخ كله كنموذج ليستنبطوا منه فنون حركته، وإنما أخذوا بعض مراحل التاريخ وفقرات هي التي وجدوا فيها مصداقية كلامهم وأغفلوا الباقي.. وما كان لأحد أن يحيط بالتاريخ كله ولو أراد، وما وصلنا من التاريخ ربما بعضه خضع للأهواء والميول، فالمادة التاريخية مادة خادعة وهي بطبيعتها متعددة المصادر ومتناقضة ومتضاربة ولا يمكن استيفاؤها كلها ولا جمعها كلها بيقين كاف كي يقول فيلسوف التاريخ إلى القول بنظرياته، أو أنه استنبط منها قانون مطلقًا، وقول هذا الكلام هو السذاجة بعينها. ولكن الفكرة الموضوعية العلمية الأمينة لا تقول بأكثر من الترجيح والاحتمال، فالقوانين الإحصائية كلها قوانين احتمالية وكلها ترجيحات لا ترتفع للمستوى، أو على الأصح إلى مرتبة الحتمية أو الإطلاق، ثم إن الإنسانيات لا تجوز فيها الحتمية لأن الناس ليسوا كرات (بلياردو) تتحرك بقوانين فيزيائية، لكنهم مجموعة إرادات حرة تدخل في علاقات معقدة يستحيل فيها التنبؤ على قوانين مادية". فهل النموذج الرأسمالي الغربي أصابه بعض التصلب والتحجر، كما جرى للنظام الشيوعي؟ لا شك أن سنن الحياة للإنسان والدول من حيث الصعود والسقوط، أو التقدم والتراجع، أو تشيخ مع مرور الزمن، حقيقة واقعة أن يتم التجديد في النموذج، وسد مواطن الخلل والفساد، ما يجعلها تنكمش وربما تتفكك، وهذه معروفة عند الكثير من المؤرخين. ومن أسبق هؤلاء الذين تحدثوا عن هذه التحولات، العلامة ابن خلدون الذي أشار إلى دورة الحضارات في عمرها الافتراضي في الصعود والسقوط، وسماه (طبائع العمران) في التغير الذي يصيب الدول والمجتمعات، ويأذن بتراجعها وانهيارها، والدورة الحضارية من ضمن السيرورة التاريخية، في حياة الأمم والدول، لكن يمكن تلافي هذه السيرورة الطبيعية من خلال التجديد والتغيير في حركة مداواة العطب التاريخي للسيرورة، عند ظهور الأعراض، لكن هل ما جرى في الغرب الليبرالي، تنطبق على مثل هذه الأسباب؟ ابن خلدون قال إن "الظلم مؤذن بخراب العمران"، والغرب تحدث عن المبادئ التي يحملها بعد عصر الأنوار في الحرية والمساواة والحقوق العادلة، لكنه لم يتمسك بتلك المبادئ التي يتحدث عنها، وتجد الكثير من المظالم تعشش في ظلم قوانين ونظم تم تسميتها لكل الإنسانية في هذا العالم، لذلك فإن بغياب تلك المبادئ عن التطبيق تظل الدول في حالة من التوترات والحروب والصراعات التي تعد من المقدمات لفساد العمران وانحلالها.
316
| 10 يوليو 2016
جاءت موافقة الشعب البريطاني على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، صدمة للكثير من دول العالم، وخاصة من القارة الأوروبية، فلم يتوقع أحد الخروج بهذه السهولة من الاتحاد الذي عملت الدول الغربية في تطبيقه بالتدريج لما يصل إلى نحو ستين عامًا، على اعتبار أن هذا الاتحاد نموذج رائع للتكتلات السياسية والاقتصادية في عالم اليوم، كما أنه هو في الظاهر بما يمثله من فوائد اقتصادية للمملكة المتحدة، حيث يملك الاتحاد الأوروبي واحدًا من أكبر المناطق التجارية في العالم، ويقدر المحللون أن ناتجه المحلي الإجمالي يتجاوز 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. كما أن عضوية الاتحاد الأوروبي تستفيد منها الحكومة البريطانية فوائد كبيرة خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إذ تقدر سنويا في الغالب الأعم بما يقارب مليارا ونصف المليار دولار أمريكي نصفها له علاقة بالاتحاد الأوروبي.. فما الأسباب غير المعلنة، أو غير الاقتصادية التي دفعت الشعب البريطاني إلى الموافقة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؟ لم تعلن الحكومة البريطانية عن الأسباب الحقيقية للانسحاب من الاتحاد، إلا أنها قالت إنها استجابت لرغبة الشعب البريطاني، وهذا ليس كافيًا لشرح هذا التوجه من أغلبية الشعب البريطاني للخروج من الاتحاد دون البقاء فيه، لأن الخسارة الاقتصادية كبيرة، وستستمر لفترة طويلة، وكما وصفها البعض بأنها أخطر القرارات لبريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية بعد رفض الزعيم تشرشل الإنذار الألماني للاستسلام بعد القصف الألمان العنيف للعاصمة البريطانية لندن، ونجاح الإنجليز في الصمود والمقاومة.ومن الأسباب القوية التي جعلت البريطانيين يصوتون للخروج من الاتحاد الأوروبي، حسب التوقعات والتحليلات، هي الهجرة المتزايدة من مواطني الاتحاد الأوروبي خاصة من دول أوروبا الشرقية التي انضمت مؤخرًا إلى الاتحاد، وكانت سابقًا ضمن المعسكر الاشتراكي الذي كان يتزعمه الاتحاد السوفييتي السابق قبل تفككه في عام 1991 من القرن الماضي، وهذا ما قاله وزير التوظيف المحافظ والمتشكك بالاتحاد الأوروبي بريتي باتيل أثناء جلسة مناقشة شاركت في استضافتها النسخة البريطانية لـصحيفة (هافينجتون بوست) "إن بريطانيا لا تملك سيطرة كاملة على سياسات هجرتها نظرًا لعضويتها في الاتحاد الأوروبي، وهو الرأي الذي يوافق عليه كثير من مؤيدي المغادرة البريطانية، وحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة التلجراف البريطانية بالتعاون مع ORB على 800 شخص، فإن 52% يؤمنون بأن قرار الخروج من الاتحاد سوف يحسّن من نظام هجرة المملكة المتحدة". وكانت مجلة (الإيكونو ميست) البريطانية قد كتبت في أبريل 2016 "أن العلاقة بين معاداة الهجرة ودعم قرار المغادرة من الاتحاد علاقة قوية ومرتفعة، وبهذا تمكّن أنصار حملة المغادرة من تحويل قضية الاستفتاء إلى قضية استفتاء على الهجرة، فسيفوزون لا ريب -وهو ما تحقق فعلا عبر التصويت الأسبوع الماضي- حيث كان أنصار الخروج مؤخرًا قد صوروا قضية الهجرة على أنها أحد أعمدة منصة خطابهم، وأنها قضية لن تنجح معالجتها إلا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا التصويت كان بمثابة الرغبة في الحد من مخاطر اجتماعية وسياسية وربما اقتصادية بسبب الهجرة، حيث إن حرية التنقل التي هي أهم عناصر عضوية الاتحاد الأوروبي والتي تمكّن مواطني الاتحاد من العمل بحرية كاملة دون أن يتطلب ذلك الترخيص لهؤلاء المهاجرين بحكم عضوية دولهم في الاتحاد، وزادت في السنوات الأخيرة حتى فاقت كل التوقعات حسب ما قاله بعض السياسيين البريطانيين المؤيدين للانسحاب من الاتحاد، ولا شك أن الحكومة البريطانية درست بشكل عميق كل الخيارات الإيجابية والسلبية، ولم تطرح التصويت إلا بعد أن رأت أنها رغبة شعبية للخروج من الاتحاد، ومع أن هذا الخروج ستكون له تداعيات سياسية واقتصادية، فالحفاظ على الهوية والخوف من الانصهار مع تكاثر الهجرات الأوروبية وغير الأوروبية جعلت الحكومة البريطانية تطرح الأمر للتصويت الشعبي للاختيار، حتى لا تكون هي التي اختارت الانسحاب دون رغبة المواطن البريطاني، مع أن الأضرار الاقتصادية كبيرة وربما خطيرة بمقاييس الربح والخسارة، لكنه قرار جاء بإرادة شعبية في النهاية. أما ما يتصل بالنتائج فإنها ستظهر وتتضح تباعا.
790
| 03 يوليو 2016
من البديهيات المعروفة أن التعليم يعد الأساس في عصرنا الراهن لإقامة تنمية مستدامة وحقيقية، تسهم في تحقيق نهضة تعليمية ومهنية في كافة مجالات التنمية التي ننشدها، وتساهم في التقدم والتطور بصورة مضطردة في كافة المستويات، ولذلك فإن الكثير من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا من التقدم التكنولوجيا منذ عقود وأكثر، تحقق لها من خلال الاستثمار في التعليم نجاحات باهرة، عندما تأسس على مقومات علمية ومنهجية قوية، وصرفت على مجالات جودة التعليم في خططها المتعاقبة، وكان التركيز على خطط التعليم والتأهيل، ما تحقق لها نجاحات كبيرة وبصورة مضطردة تدريجيًا، وأصبحت يشار إليها بالبنان في التطور العلمي والتكنولوجيا، ونجحت بالتالي أن تقضي على مشكلات البطالة وقلة الخبرات في أبنائها، وهزمت التخلّف وتوابعه ومشكلاته في فترات قصيرة ولا تزال قضية التعليم وأزماته مقلقة في العديد من دول الوطن العربي، ويعزو البعض تركة هذه المشكلات في القرن العشرين، والتي انتقلت إلى هذا القرن، ومنها أن الجودة كانت ضعيفة في الفترة الماضية لأسباب اقتصادية وتخطيطية، فمع إدخال النظم الحديثة إلى التعليم في القرن الحادي والعشرين، والبعض الآخر يرى المشكلة في التطبيقات الجديدة وظروفها المختلفة، حيث برزت المعوقات العديدة خاصة في نوعية التعليم وأدواته مع اقتصاديات السوق ومتطلباته في ظل العولمة، وترى الباحثة الدكتورة/ محيا زيتون في كتابها (التعليم في الوطن العربي في ظل العولمة وثقافة السوق)، في ظل هذا الوضع، فإن تعليم المستقبل يستمد معالمه وخصائصه من التطور اللاحق في المحيط الاقتصادي وفي المجال المعرفي والتقني، كما أصبح مرتبطًا أيضًا بنظام عالمي جديد تتزايد فيه أهمية المنافسة في الأسواق العالمية كمعيار للتميّز. ويستعد العديد من الدول المتقدمة وتلك الساعية إلى التقدم لمواجهة التحديات لتغُير وتطوّر أنظمة التعليم والبحث العلمي. واتجه بعضها إلى التكتلات الاقتصادية والسياسية لتتيح قدرات مادية وبشرية ضخمة، علاوة على مزايا تنسيق الأهداف والسياسات لمواجهة قوى العولمة الشرسة. وعلى الرغم من هذه الجوانب الإيجابية -كما تقول الدكتورة محيا- فإن ما تحقق في الوطن العربي لا يزال محدود الأهمية ولا تزال هناك آلاف المدارس في أماكن متعددة لا يوجد فيها خط هاتفي يسمح بإمكانية الاتصال بشبكة المعلومات الدولية، حتى في المدارس والجامعات الخاصة حيث يدفع الطلبة رسومًا باهظة، لم يبلغ بعد مستوى إتاحة الحاسوب الشخصي والاتصال بالشبكة معدلًا يتناسب مع عدد التلاميذ واحتياجات تدريبهم، ويبدو الإنجاز على مستوى الوطن العربي متواضعًا أيضًا إذا قيس بما حققته بعض البلدان النامية من تقدم ملحوظ في هذه المجالات. وسادت أنظمة التعليم في الوطن العربي مظاهر سلبية أخرى تتنافى مع تطلعات المجتمع العربي للنهوض بالعلوم والتقنية وتطوير المؤسسات التعليمية، من أجل توافر المتطلبات الأساسية لهذه النهضة. وأهم هذه المظاهر وضوحًا هو التزايد الكبير في أعداد طلبة التعليم العالي المتخصصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مقابل الانخفاض في أعداد الطلبة في اختصاصات العلوم الأساسية والتطبيقية هذا في الوقت الذي تثبت فيه دراسات مختلفة أن نسبة الطلبة المتخصصين في الرياضيات والعلوم الهندسية هي التي ترتبط إيجابيًا بمعدلات النمو الاقتصادي، وهي الأكثر تحقيقًا بالتالي لعائد اجتماعي مرتفع لاستثمارات التعليم العالي. ولا يعني ذلك التقليل من شأن الدراسات الإنسانية والاجتماعية ومن أهميتها العلمية ومساهمتها في تقدم المجتمعات وتطورها، ولكن للأسف فإن توسع فرص التعليم العالي في هذه الاختصاصات تم على نحو مبالغ فيه ربما لتحقيق أغراض مالية محضة وليس لغرض خدمة أهداف ومتطلبات التنمية. إن الكثير من المجتمعات العربية التي حققت نموًا مرتفعًا للطلبة في هذه الاختصاصات فيما عدا دول الخليج الغنية، اقترن توسع نموها ببقاء الإمكانات المتاحة من أعضاء هيئة تدريس ومكتبات وحجرات دراسة وتجهيزات وخلافه، من دون تغير يذكر. وبمعنى آخر، أصبحت الدراسة في هذه المجالات مخزنًا يتكدس فيه طلبة الجامعات، وتتباهى من خلاله بعض الحكومات بتحقيق معدلات مرتفعة للقيد في التعليم العالي.. وللحديث بقية.
550
| 26 يونيو 2016
تعيش الأمة العربية هذه الفترة انقسامات وصراعات كبيرة في بعض المجتمعات، يشعرك بالخطر الذي ربما يجعل وعيها غائبًا عن حاضرها ومستقبلها، لاسيما أنه لا سمح الله قد يسبب انعكاسات على وجودها القائم، ولا شك أن الفارق شاسعًا بين الاختلاف الطبيعي الذي تقتضيه الظروف الطبيعية من الاختلاف في الرؤى والنظر في مسائل يقتضيها التعدد الذي هو من طبائع البشر وجبلّة بشرية، وبين انقسامات فكرية وسياسية، وهذا ما يجعلنا نقبض على قلوبنا من آثار هذا الانقسام الذي يؤثر في الوعي العام للأمة العربية، وهذا الفكر قبل أن يعيش، كما يقول د.برهان غليون في كتابه (الوعي الذاتي): "الثنائية دائمة وأن لا يرى نفسه ولا يعيها إلا من خلال هذه الثنائية المعممة في الوعي والعقل والممارسة: ثنائية الحديث والقديم، والسلفي والمتجدد، والأصولي والمعاصر، والديني والعلماني... إلخ. وفي جميع المحاولات النظرية التي تعرضت لهذه الأزمة، يبدو التأكيد على هذا الجانب أو ذاك أو الدفاع عن ضرورة التوفيق بينهما، التزامًا أساسيًا لدى مختلف الأطراف. ولكن قليلة هي الدراسات التي سعت إلى الذهاب أعمق من ذلك لرؤية الأسباب الكامنة وراء هذه الثنائية، والمنابع التي تستمد منها حياتها واستمرارها. وهكذا لم يقم الفكر النظري العربي في العقود الماضية، وبقدر تبنيه لهذه الثنائية كواقع ثابت وطبيعي، إلا بإعادة إنتاجها وتجديدها. وسبب ذلك أن منهج دراسة الفكر والثقافة بقي في أغلب الأحيان، إن لم يكن في جميعها، منهجًا سجاليًا يقوم على تبرير تأكيدات ومواقف معينة أصالية أو عصرية، والدفاع عنها في وجه خصم مفترض، ولم يسمع إلا لمامًا لتجاوز هذه التأكيدات وأحكام القيمة المستمدة منها إلى الكشف عن قوانين هذه الثنائية أو وضعها موضع الشك والتساؤل. فلا يمكن أن يصدر هذا التجاوز إلا عن منهج التحليل التاريخي والمعالجة العلمية التي لا تنطلق من مناقشة صحة أطروحة الحداثة والأصالة أو خطئهما، وإنما تقوم على البحث عن مصدر هذه الثنائية في الوعي والواقع معًا. هذا لا يعني -كما يرى غليون- أن ليس لهذه التيارات السائدة والمتصارعة تفسيراتها الخاصة وغير المعلنة لأزمة الثنائية الثقافية. إذ في ردودها المتبادلة تحاول كل الأطراف أن تظهر سبب بقاء الأطراف الأخرى، وتلحقه بشكل أو بآخر بعوامل سلبية داخلية أو خارجية. ثم إنها تحتاج لتبرير نفسها وشرعية وجودها إلى أن تعطي تفسيرًا خاصًا وإيجابيًا لوجودها ومزاعمها. ويمكن تلخيص هذه التفسيرات في مذهبين أساسيين يتفق كلاهما في إرجاع عوامل هذه الأزمة إلى أسباب تاريخية قديمة أو خارجية حديثة، مستثنين من ذلك ومستبعدين عوامل الحاضر والواقع العربي الراهن في الوقت نفسه. ولا شك أنه داخل هذين المذهبين، هناك خلافات جزئية ترتبط بنظرة المنتجين لهما ورؤيتهم المثالية والمادية، وحساسيتهم الشخصية والخاصة تجاه عالم الوعي أو عالم المجتمع والتاريخ.."وهذين المذهبين الذين يقصدهما د/ برهان غليون، هما المذهب الأصولي، والمذهب الحداثي". لكن نشوء تيارات ثورية أو معادية للإمبريالية والرأسمالية وللبرجوازية معًا في حجر الإيديولوجيات التقليدية الدينية والقومية، وتصفية البنى الإقطاعية، قد أدخلا عنصرًا جديدًا إلى المعادلة، شكك في صلاحية منطقاتها وأظهر ميكانيكيتها. وهكذا ولد اتجاه ثالث جديد توفيقي يسعى إلى الربط بين الاتجاهين ويصلح أحدهما بالآخر على أرضية تفسير اجتماعي موحد لا ينفي أطروحات التحديثية الأساسية ولكنه يغنيها. وباختصار لا تنبع أزمة الثقافة العربية من استمرار وجود تيارين فكريين متنازعين، فلا يمكن تقليصها إلى وجود كل واحد منهما. فهي ليست ثمرة لبقاء الوعي المفوّت أو المتأخر أو التقليدي. وهى ليست مجسدة أيضاُ في وجود الوعي العصري أو العلماني أو التحديثي. إن جذورها تمتد في عمق التاريخ الحديث، تاريخ الأزمة الواقعية التي تعيشها المدنية العربية ذاتها، بما هو استبعاد الجماعة من ساحة المبادرة والفعل والمشاركة الحضارية العالمية. فهي بنت الحاضر أولًا، وهي بنت الحداثة ثانيًا، وهي ثمرة القطيعة بين الحاضر والماضي أو الذات من جهة، وبين الواقع والواقع العالمي- الحضاري من جهة ثانية. فهي إذن جزء من أزمة الفعل العربي، ولا مخرج منها، كما يشير غليون، إلا بتجاوز هذه القطيعة وتحرير الفعل. إن الصراع على السيطرة الإيديولوجية، الذي يجعل من الثقافة ساحة معركة أساسية. هو الوجه السائد للصراع الاجتماعي في مجتمعات العالم الثالث الراهنة التي تعاني من تقهقر حقيقي في مواقعها الدولية، سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد تقسيم العمل العالمي، وذلك بعد انهيار أوهام التنمية والتصنيع التي تعاظمت بعد الاستقلال". إذن القضية الأهم التي نراها جديرة بالاهتمام أن مراجعة الأمة لذاتها أصبحت ضرورية ولازمة للحفاظ على وجودها من الانهيار والتصدع والانقسام، وهذا يحتاج إلى رؤية واعية وعقلانية لحل الإشكالات القائمة، ورفض ما يراه البعض وسيلة غائية لفرض الفكر بالقوة والإرغام والفرض.
315
| 19 يونيو 2016
بعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية في الأشهر الماضية وما تزال، الذي خططت له إسرائيل في تنفيذ مخططاتها في القدس لتهويدها، وقتل الأطفال والنساء لمجرد الشبهة وغيرها من الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والأعراف القانونية، في ظل الظروف الحالية من عدم الالتزام بالاتفاقات مع السلطة الفلسطينية التي لم تلامس الواقع الحقيقي، وهو الحل العادل الذي يحقق للشعب الفلسطيني طموحه في استعادة حقه السليب وعلى رأسها القدس الشريف، وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تراوغ إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها بالانسحاب منها ضمن ما يسمى بالعملية السلمية، والتهويد والإصرار على وإقامة المستوطنات الصهيونية منذ ما يقرب من أربعة عقود..فهل انتفاضة ثالثة يكون لها الفضل في إنجاز الاستقلال الكامل؟ فما هي خلفيات هذه الانتفاضة؟ وكيف تحركت الانتفاضة الأولى التي أجهضتها اتفاقات أوسلو؟ وهل ستلحق انتفاضة أخرى جديدة بنفس الظروف وأسباب الانتفاضة الأولى؟. بدأت الشرارة للانتفاضة الأولى من مخيم جباليا وبالتحديد في 8 ديسمبر1987 عندما كان عدد من العمال الفلسطينيين عائدين من عملهم في إسرائيل، ويترجلون من السيارة التي تنقلهم أمام حاجز للتفتيش فإذا بشاحنة عسكرية تدهسهم ولاذ سائقها بالفرار. وأسفر هذا الحادث عن سقوط 4 قتلى وسبعة جرحى كلهم من مخيم جباليا. وصلت هذه الأنباء إلى المخيم فاشتعل الغضب العارم. وقبل الانتفاضة بحوالي شهر تنبأ مسؤول رسمي في الأمم المتحدة بحدوثها، وأدرك أن الانتفاضة أمر حتمي بعد عشرين عامًا من الاحتلال والإحباط وخيبة الأمل، وكانت الإحباطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حاجة فقط إلى شرارة ليحدث الانفجار الكبير لهذا الشعب الذي لاقى من المعاناة والقهر ما لم يلقه شعب آخر في العصر الحديث. وقد سجلت في تلك الفترة وثيقة قدمت للأمم المتحدة عن الأوضاع التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، فذكرت أن هناك جيلًا ينمو في ظل أحوال معيشية واجتماعية وتعليمية قاسية، ولا شك أنها أحوال صعبة، ورغم أنه يمكن القول بأن المجتمع الدولي قد ركز اهتمامه لفترة تزيد على ثلاثين عامًا على هؤلاء الفلسطينيين بصفة لاجئين، وقد حاولت العديد من المنظمات الدولية تأمين المستوى الأساسي للحياة على الأقل، إلا أن أوضاعهم بقيت متردية وصعبة والاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة تشكل عنصرًا جديدًا لم تعايشه غالبية أطفال العالم. ورغم أن هذه الاضطرابات تترك بصماتها على جميع أطفال العالم إلا أن أطفال الضفة والقطاع ينوءون بعبء إضافي يتمثل في العيش في ظل احتلال قاس، وعنيف منذ يونيو 1967م.وفي ظل هذا المناخ انطلقت شرارة الانتفاضة وسجلت انتصارًا نفسيًا ومعنويًا على الاحتلال من خلال صمودها الطويل لتخلق واقعًا جديدًا لا بد من إعادة النظر إليه بصورة مختلفة. ويعتقد البعض من المحللين والخبراء الاستراتيجيين أن عملية التسوية التي بدأت بمؤتمر مدريد أكتوبر 1991م كانت اتجاهًا تكتيكيًا من إسرائيل لوضع حل لمشكلة الانتفاضة التي أقلقت إسرائيل وشكلت عبئًا أمنيًا عليها طوال فترة الانتفاضة ونعتقد أن انتفاضة الأقصى ستكون النهاية للاحتلال.
370
| 13 يونيو 2016
في الحديث عن التطرف والإرهاب الذي يجتاح بعض الدول من داعش، ومن الجماعات التي تقتل وتدمر وتفجر دون مبررات، ودون وجه حق، فإننا يجب ألا ننسى الإرهاب الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين في عام 1948، وما تلاها من مجازر وتهجير واعتقال، مع أن القوانين والنظم الدولية اعترفت بهذا الحق، وأصدرت قرارات منذ أكثر 60 عامًا لإعادة الحق لأصحابه، ومع ذلك لم تتوقف كل هذه الممارسات حتى الآن، وهذه الهجمة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني مستمرة حتى وقتنا الراهن، وفي ظل الاعتداءات التي تزداد يوما بعد يوم على المقدسات العربية والإسلامية، فإن هذا يعتبر إرهابًا في حق شعب يطالب بالحرية والعيش الكريم على ترابه الوطني، مثل بقية الشعوب المتحضرة. وقد مارست إسرائيل العنف بأبشع وأعنف ما عرفه التاريخ المعاصر لطرد شعب بأكمله، من أرضه وهو الشعب العربي الفلسطيني.. فلماذا لا نعدل في أحكامنا وفي كتاباتنا ونحدد ما هو عنف أعمى، ونضال تكفله القوانين فإسرائيل منذ احتلالها لأراضي فلسطين مارست الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضد أهل الأرض الأصليين، شتى أصناف الرعب والإرهاب، التي لا يختلف اثنان على أنها كذلك، فقامت بطرد الفلسطينيين من منازلهم ودمرتها على رؤوسهم وطاردتهم ونفذت فيهم عمليات القتل والاغتيال داخل وخارج وطنهم، وصادرت الأراضي وسممت المياه ومارست قواتها كل أعمال القمع والعنف ضد المواطنين العزل، من تكسير للأذرع، وتهشيم للأضلع على مرأى ومسمع من عيون وآذان العالم، ولم يتوقف الإرهاب الإسرائيلي عند هذا الحد، بل تعداه إلى الإضرار بالمقدسات والشروع في حرقها وتدميرها وطمس معالمها، كما حصل للأقصى الشريف أكثر من مرة، ناهيك عن أعمال القتل والتدمير التي طالت أراضي عربية أخرى في لبنان والجولان السورية المحتلة، تلك الأعمال الإرهابية مورست بأمر وتوجيه من أعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة الأمن الإسرائيلي، أليست هذه الأفعال الفظيعة تمثل قمة ثقافة العنف والإرهاب؟والإشكالية أن مصطلح الإرهاب يستخدم أحيانًا بطريقة انتقائية وتلصق أحيانا على أعمال لا تندرج ضمن مفهوم التعريف المشار إليه آنفًا، وهذه مسألة تثير الارتياب في تعريفات بعض الدول للإرهاب، ومنها الولايات المتحدة على وجه التحديد. والذي يدعو إلى الأسف أن مصطلح الإرهاب لا يزال ورقة يتلاعب بها الكثيرون ويتقاذفونها كالكرة فيما بينهم، وكل يصم الآخر بالإرهاب وكل مشكلة داخلية يعانيها بلد ما، ترفع التهمة الجاهزة على البعض الآخر بالإرهاب، وبدلًا من اتخاذ الوسائل السلمية والقوانين المرعية، وحقوق الإنسان لحل هذه المشكلات ـوالتي تختلف من بلد إلى آخرـ فإن شعار الإرهاب بات الآن سيفًا مسلطًا بلا معايير دقيقة لتقييده، وهذه إشكالية ربما تساعد في ازدهار الإرهاب لا في استئصاله. وأيضا عدم التفريق الدقيق بين الإرهاب كظاهرة عالمية، غير محدد بدولة أو بشعب أو بعقيدة، وبين كفاح الشعوب ونضالها لنيل حقوقها المشروعة في التحرير ومحاربة المحتل والمستعمر. وهذه بلا شك قضية محورية يجب أن توضع في مكانها الصحيح، وتنضبط وفق مقاييس دقيقة وثابتة بعيدًا عن الأهواء والميول والاتجاهات الأيديولوجية واختلافها. فمصطلح الإرهاب يستخدم أحيانًا بطريقة انتقائية وتلصق أحيانا على أعمال لا تندرج ضمن مفهوم التعريف المشار إليه آنفًا، وهذه مسألة تثير الارتياب في تعريفات بعض الدول للإرهاب ومنها بعض الدول الكبرى. وليس أقوى داعم للإرهاب وثقافة العنف مثل تجاهل أسبابه الكامنة والموضوعية لقيامه وانتشاره في المجتمعات الحديثة، خاصة في عصر الثورة المعلوماتية والعولمة في جانبها السلبي، فإن التطرف والإرهاب سوف يعشش ويقتات من هذه السلبيات التي تزداد بازدياد أنظمته العالمية الجائزة والمجحفة في تعاملها الاقتصادي وفق النظرية الدارونية البقاء للأقوى "بدل البقاء للأصلح"! أيضًا من السلبيات التي تسهم في انتعاش ثقافة العنف الازدواجية والمعايير في السياسة الدولية، والكيل بمكيالين عند التعاطي معها، والتي أصبحت ظاهرة تؤرق العالم، والشعور بالظلم إزاء بعض القضايا التي باتت تستعصي على الهضم والتقبل، والكوارث الإنسانية التي يلاقيها الشعب الفلسطيني، من جراء الاحتلال وتوابعهما. فالتعاطي بالازدواجية في الكثير من القضايا، أثمر الكثير من الكراهية غير المبررة في بعض الأحيان، ومنها الإرهاب المرفوض الذي تعاني منه الإنسانية، لذلك فإن أفضل الخطوات لوقف هذا الإرهاب واستئصاله، هي مواجهته بنفس الأساليب التي يستخدمها ضد الآخرين، وفي الوقت نفسه من المهم البحث الجاد عن أسبابه وإيجاد المخارج المنطقية والعقلانية لتجفيف منابعه بالحكمة أولًا، ثم بالتعاطي العادل مع مسببات هذا الإرهاب.
292
| 05 يونيو 2016
لا شك أن الفكر التكفيري الذي يقود إلى التطرف والإرهاب، خسارته العسكرية حتمية لا شك في ذلك ولا تحتاج إلى استقصاء، وهذا تحقق في دول عديدة في العقود الماضية، ويعلمنا التاريخ أن التطرف والغلو، لم يكسب شيئًا من أفعاله ومن أفكاره، عند استخدامه العنف لتحقيق أهدافه، لكن الإشكالية في عودته بصورة ملفتة في السنوات الماضية في دول عديدة، وتمدد في أنصاره ومؤيديه إلى أوروبا وآسيا، وهذا مما يجعل أهمية المواجهة الفكرية ضرورية ولازمة لصد الفكر بالفكر، وأتذكر عندما كنت أدرس في المرحلة الجامعية في بداية الثمانينيات من القرن الماضي في مصر الكنانة، وبعد فترة حادث اغتيال المرحوم الرئيس السادات 1981، كنا نتابع في التلفزيون المصري، الحوارات التي يجريها كبار علماء الأزهر، مع الجماعات التي تسمى بجماعة الجهاد، والجماعة الإسلامية، التي اتهمت باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في حادث المنصة الشهير، وقامت بالكثير من الأعمال الإرهابية أثناء وبعد هذا الحادث، واغتالت الكثير من الأبرياء من السياح وغيرهم، بينهم أستاذنا رحمه الله د. رفعت المحجوب، وحققت هذه الحوارات نجاحا باهرًا، وانتهت برجوع العدد الأكبر من قياداتهم وأتباعهم، عن أفكارهم العنيفة والمتطرفة، بل وذهبت بعض هذه القيادات إلى أسرة المرحوم أنور السادات، للاعتذار والندم على ذلك الاغتيال غير المبرر، وجاءت هذا المواقف في مؤلفات عديدة لقيادات هذه الجماعات، سمّيت بـ(بالمراجعات)، فالحوار يكون بتقديم الحجج للمغرر بهم، والذين لا يملكون حقائق الدين الصحيح، فإن مواجهة الفكر بالفكر، مهمة ومؤثرة لتغيير الأفكار الخاطئة، وهذا ما تحقق في النهاية، ولذلك فإن المواجهة الفكرية لابد منها، لأن العنف الفكري هو الذي يقود إلى السلوك المادي، ولهذا فإن الفكر هو المنطلق إلى الأفكار العنيفة المتطرفة. فلا يكفي أن نستخدم المواجهة العسكرية في مقابل التطرف، فقد حصل التراجع للعنف والتطرف في السنوات المنصرمة بفعل المواجهة العسكرية، لكنه عاد أقوى مما كان عليه، فقد يضعف في مكان، لكنه يظهر في أماكن أخرى أكثر شراسة، ويختفي فترة، وسرعان ما يعشش في مدن وقرى قريبة، لكن الفكر العنيف يتغذى ويعشش ويقتات، على بعض الأخطاء والممارسات، ففي العراق، بعد سقوط النظام السابق عام2003، أقدم النظام الجديد، على ما ُسمي قانون بـ(اجتثاث البعث)، ومن خلال هذا القانون، تم تسريح عشرات آلاف من الضباط والجنود العراقيين، ومنهم آلاف من المدنيين أيضًا، بحجة انتمائهم لهذا الحزب، وهذا من أكبر الأخطاء الذي قام بها هذا النظام، ويعاني منه العراق معاناة كبيرة وخطيرة، فتسريح هؤلاء من وظائفهم المدنية والعسكرية، يعني كأنك حكمت عليهم بالإعدام، وهذا خطيئة كبيرة وتطرف في الحكمة والسياسة، وهذا ما ظهر أخيرًا من المتابعين والمحللين، أن آلافا من الجيش العراقي الذي تم تسريحهم، انضموا إلى داعش، ولذلك هذا يؤكد ما تقوله القاعدة الفيزيائية (لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه)، وكما هو معروف، عندما تغلق الباب على القط، وتحاول أن تهاجمه، سوف يهاجمك وبشراسة كبيرة، ولا تستطيع رده، وهذا للأسف ما يعانيه العراق من التوغل الكبير لداعش للعديد من المدن العراقية، بعد السيطرة عليها من قبل داعش، والآن فإن استعادة هذه المدن، سوف تكلّف الكثير من الجيش العراقي، ومن السكان الآمنين في هذه المدن، وهذا من أسباب طرد أو اجتثاث عشرات الألوف من العراقيين من وظائفهم، كما أن الوضع في سوريا أيضًا نفس السياسات الخاطئة، فلو أن النظام قام بتعديل بعض السياسات، وعدّل بعض الأفكار، عندما قامت المظاهرات، فإن الوضع لم يكن سيصل لما وصل إليه، ولما استغل بعض المتطرفين الظروف القائمة في سوريا، وبعضهم كما يقال كانوا في السجون، وأطلقهم النظام لخلط الأوراق السياسية، لتعميم تهمة التطرف والتكفير على الجميع. فأفضل الحلول وأنجعها أن يتم جر البساط من تحت فكر التطرف والغلو، أن يتحقق العدل ورد الحقوق، وتأسيس مواطنة التي لا تقصي أحدًا، ولا تفرق بين المواطنين، لأن هذا الفكر المتطرف يستغل بعض الأخطاء والسلبيات، ويروّج لفكره لبذر التضليل والعنف والتطرف، وهذا ما حصل في بعض الدول العربية، التي تعاني من التطرف والتكفير والإرهاب ولا تزال.
414
| 29 مايو 2016
عاشت أمتنا منذ عقود، وما تزال في صراع مع فكر التطرف والتكفير والغلو، بمؤثراته وتأثراته الخطيرة، لعل أهمها التفجيرات الانتحارية، وتفجير الطائرات والمطارات، وأماكن العبادة وغيرها من الأفعال والممارسات، وأغلب هذه الأفعال والممارسات تصيب الأبرياء، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ـ مع المسلم أكثر المستهدفين من المتطرفين والتكفيريين! والشيء الغريب واللافت أن هذه الأعمال المشينة، تتحدث باسم الدين وباسم الجهاد ومرضاة الله، مع أن كل النصوص القطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، وأقوال المدارس الفقهية الإسلامية، تحّرم قتل الأبرياء، وترفض قتل غير المسلم غير المحارب، والمحارب أيضا له هناك تشريعات لا تجيز القتل إلا ببيّنات وقرائن، إلا حالة الدفاع عن النفس، كما أن غير المسلم الذي يدخل البلاد العربية، يعد في رعاية هذه الدول وحمايتها، لأنه دخل بجواز وإقامة وليس محاربًا، هذه كلها تدحض ما تفعله هذه الجماعات، والحقيقة أن انتشار التطرف بشكل ملفت، مدعاة للنظر والمراجعة، لماذا ينتشر هذا الفكر مع هزائمه وتراجعاته العسكرية منذ عقدين أو يزيد؟ والحقيقة أن الرؤية ضبابية في أسباب الانتشار الكبير لفكر التكفير والتطرف في عصرنا الراهن، بل إن بعضًا من هؤلاء من عاش في الغرب، من العرب والمسلمين، وبعضهم من الأوروبيين أنفسهم، فإن الأمر يزيدك في الحيرة والاستغراب من شباب كل دراسته كانت وفق المناهج الغربية، وهذا يدحض المقولة التي رددها بعض الغربيين في بحوث ودراسات عديدة، ومن بعض العرب والمسلمين أيضًا، أن بعض النصوص الدينية في مناهجنا هي السبب في هذا التطرف والتكفير والغلو، ولابد من تغيير هذه النصوص، حتى يتم سحب هذه الأفكار التي تشجع على التطرف والتكفير، وما حصل من تفجيرات ومن أعمال انتحارية في الغرب، خاصة في فرنسا وبلجيكا في الأشهر الماضية، أن من قاموا بهذه الأفعال شباب تربوا وعاشوا في الغرب، ودراستهم كانت غربية تماما! ومن هذه المنطلق فإن من المهم البحث عن أسباب ومسببات هذا التطرف الذي امتد إلى شباب ثقافتهم غربية، وبعضهم كان في سلوكه كما عرف عنه بعد البحث والاستقصاء، أنه كان في حياته من رواد المراقص، وعاش حياته بعيدًا عن التدين، الذي يقال إنه السبب في هذه الأفعال المتطرفة والإرهابية. والحقيقة أن الإرهاب والتطرف الذي يعتبر الآن قضية القضايا ومحط أنظار العالم واهتمامه وتوجسه وهواجسه، له من الأسباب الكثيرة ما يجعل حصره في مسألة أو قضية واحدة فكرة هلامية وتبسيطية غير صحيحة. فالإرهاب والتطرف يتمايز في منطلقاته، وهذا التمايز يجعل هذه الظاهرة -الإرهاب والتطرف- تختلف من بلد لآخر تبعا لأسباب وعوامل عديدة ومتداخلة في الوقت نفسه. منها العامل السياسي ـوهو الأكثر بروزا ـ إلى جانب العامل الاجتماعي والديني والاقتصادي والثقافي والفكري وهكذا. فظاهرة التكفير والتطرف والغلو، ظاهرة مركبة ومعقدة ومن الإنصاف أن تكون النظرة إليها شاملة ومتوازنة ولا تقف عند عامل واحد فقط ونغض الطرف عن الأسباب الأخرى التي ربما تكون هي العامل الحاسم في هذه المشكلة أو الظاهرة التي تجتاح العالم كله وليس عالمنا العربي والإسلامي فقط. فالبعض يرجع قضية الإرهاب والتطرف إلى الجهل وقلة العلم والفهم بأمور الدين والدنيا. والبعض الآخر أيضا يراها نتيجة من نتائج الفقر والبطالة في العديد من المجتمعات العربية. والبعض الآخر أيضا يراها نتيجة من نتائج القمع السياسي والاستبداد وغياب الحرية والديمقراطية ويراها البعض الآخر مشكلة نفسية واجتماعية وأسرية..إلخ وهذا التحليل أخذ جانبًا من الجوانب، دون النظر إلى جوانب أخرى، ولذلك فإن من المهم والأدق، البحث عن الأسباب، في كل حالة من الحالات، ذلك أن دخول الكثير من الغربيين مع داعش كمقاتلين في العامين الماضيين، يبرز أن الأمر يحتاج إلى استقصاء أوسع وأكبر، حتى يتم البحث في جذور هذا الفكر وأسبابه، دون أن يضع كل الممارسات الإرهابية في سلة واحدة، ويرى الكاتب حسن أبوهنيّة المتخصص في هذه الجماعات"أن صعود هذا التنظيم، محليًا وإقليميًا، ليس طارئًا وهزيمته تتجاوز الجانب العسكري والأمني، إلى مواجهة الشروط الموضوعية السياسية التي تقف وراءه ووراء التنظيمات والنماذج الشبيهة. ولذلك لا بد من المواجهة الفكرية أيضا، لأن هذه التنظيمات تتغذى على مستنقعات التوترات والإحباطات والإقصاء في الكثير المناطق الملتهبة، وهذا ما استفادت منه بعض هذه الجماعات للأسف، وجذبت إليها بعض هؤلاء المغرر بهم، ولذلك من المهم أن تتقاسم المواجهة الفكرية مع المواجهة العسكرية، لتقليص ما تستفيد منه الجماعات التكفيرية والمتطرفة". كما أن البعض يرى أن ظهور داعش والمجموعات المتطرفة معها فجأة، وبقدرات وإمكانات كبيرة، يجعل الكثيرين يشككون في فرضية، أن مساحات وقدرات وإمكانات، وضعت داعش، لتتمكن من فرض نفسها على الواقع الميداني والعسكري في سوريا والعراق، حتى يتم التمهيد لخطوات أخرى لترتيب المنطقة على أسس تراها بعض الدول أنها أكثر حماية واستقرارا للمنطقة. والبعض الآخر يرى أن ظهور التطرف والتكفير، في دول بعينها، كسوريا والعراق، يبرز أن القمع والاستبداد، هما أحد الأسباب الأساسية لظهور التطرف والغلو، وأن هؤلاء ضحايا للظلم والاستبداد في هذه الدول، وإلا لماذا دول بعينها يظهر فيها هذا الفكر المغالي، دون غيرها من الدول ويلقى قبولا كبيرا من الكثير من السكان؟ فالأسباب داخلية بحتة، كما أن هذا الفكر، ليس نبتة جديدة تبرز مع داعش والنصرة، فهو موجود عبر التاريخ، وفي عصرنا الراهن نتذكر، جماعة التكفير والهجرة التي قتلت الشيخ الذهبي وزير الأوقاف المصري في 1977، وهذه الأفكار التكفيرية، التي تحملها التكفير والهجرة، لا تختلف كثيرًا عن فكر داعش وجماعات التطرف والغلو الأخرى، وإذا كان ثمة اختلاف بين تلك الجماعات، فهي اختلافات هامشية وليست جوهرية، ولذلك فإن هذا الفكر يحتاج إلى مواجهة فكرية أيضًا، ربما تكون أقوى من الجانب العسكري، الجانب العسكري لا يكفي وحده للقضاء على الفكري المتطرف، فطالما الأفكار تستنسخ، فإنها ربما تعود بوجه آخر وبمسميات أخرى.. فكيف تتحقق المواجهة الفكرية؟ وللحديث بقية.
1433
| 22 مايو 2016
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
13506
| 20 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1791
| 21 نوفمبر 2025

شخصيا كنت أتمنى أن تلقى شكاوى كثير من...
1413
| 18 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1173
| 20 نوفمبر 2025

القادة العظام يبقون في أذهان شعوبهم عبر الأزمنة...
1143
| 18 نوفمبر 2025

في مدينة نوتنغهام الإنجليزية، يقبع نصب تذكاري لرجل...
1005
| 23 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
990
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
918
| 20 نوفمبر 2025

نعيش في عالم متناقض به أناس يعكسونه. وسأحكي...
810
| 18 نوفمبر 2025

شهدت الجولات العشر الأولى من الدوري أداءً تحكيميًا...
786
| 25 نوفمبر 2025
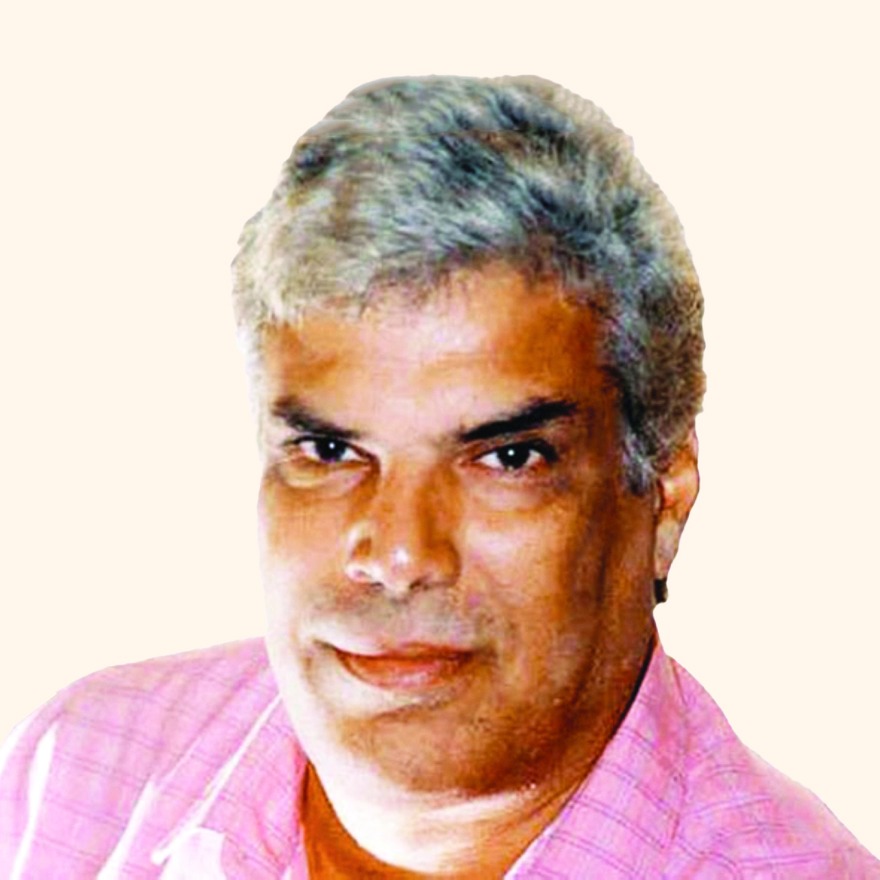
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
654
| 20 نوفمبر 2025

حينما تنطلق من هذا الجسد لتحلّق في عالم...
651
| 21 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية





