رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الحمدُ للذي أنطقَ اللسان، وجعل للكلمةِ سُلطانا وللبيانِ جَنانًا لا يطويهِ الزمانُ ولا المكان. وبعدُ : أيُّها الجمعُ الكريمُ فقد كانت مكتبتُنا منذ أيامٍ معدودات، على موعدٍ مع مجلسٍ ماتعٍ من مجالس «قطر تقرأ» و»مركز القيادات»، حيث دار الحديثُ عن مقامات الحريري، فأحيا الحاضرُ صليلَ الماضي، واستيقظتْ البلاغةُ من سِباتٍ طويلٍ سامي. ويومها صُغتُ «المقامة الكَوّارية الأولى» مجاراةً لفنٍّ عربيٍّ نبيل، وتأكيدًا أنّ هذه الأرض تُنبتُ الفصاحةَ كما تُنبتُ النخيل، وتَسقي البيانَ بماءِ الثقافةِ الأصيل. واليوم… نعودُ للمقاماتِ عودةَ الغيثِ للروابي بعد طولِ ظمأ، ولقاءَ الروحِ بالمعنى بعد طولِ عناء. فأحيّيكم جميعًا تحيّةَ الحرفِ للحرف، والمدادِ للصفحاتِ النضر. وأخصّ بالترحيب الأخ العزيز محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وهأنذا أضعُ بين أيديكم: المقامة الكَوّارية الثانية تيمّنًا بالوصل، وتثبيتًا للفضل، في زمنٍ تعودُ فيه لغتُنا شامخةً بهيّة، تسترجعُ مكانتها السامقة في مدائن المعرفة الإنسانية حُكِيَ - والحديثُ ذو شجونٍ وشؤون - أنَّه في يومٍ من أيّام الدوحةِ الغرّاء، حيث تلتقي العقولُ والكتب بالضياءِ وتظلّلنا مكتبةٌ جعلت من العلمِ منارًا، ومن الذاكرةِ إرثًا يتجدّدُ نهارًا بعد نهار، خطرَ لي أن أكتبَ مقامةً عن الصَّمْدَة، كلمةٍ حيّةٍ في ذاكرةِ قطر، ولفظةٍ خرجت من رحمِ الصحراءِ تحملُ في طيّاتها معاني الكرم، الأمن، والضيافة. فقلتُ مخاطبًا نفسي: يا أبا تميم… إنَّ للمقاماتِ رجالًا، وللبيانِ فرسانًا، وما لهذا المقامِ إلا أبو زيد السروجي سيّد الحيلةِ والبديهةِ واللسان الفصيح الملتهبِ طلاقة. فناديته بصوتٍ سافرٍ عبرَ الزمن، فقامَ من بين طيّاتِ التاريخِ كأنّه حيٌّ لم يمت، عمامةٌ على الرأس، ولسانٌ فيه فصاحةٌ لا تكلّ ولا تَسأم. فقال - وقد رفع حاجبيه دهشةً واستنكارًا - ما شأنُك تدعوني من رقادٍ طويل؟ وما حاجتُك بي في هذا السبيل؟ فقلتُ - مستزيدًا من تأنّقه - أريدُ مقامةً في الصَّمْدَة، محطّةِ العابرين، ومأمنِ الضالّين، ومجلسِ المسافرين حين يضيقُ الطريقُ ويشتدُّ الهجير. قال - وقد تفتّحت ذاكرته - الصَّمْدَة؟ تلك التي كانت ملاذًا من شدائدِ السفر؟ وراحةً من وعثاءِ السَّير؟ قلتُ: هيَ هي… لكنّها اليوم في قطر تحوّلت من خيمةٍ على أطرافِ الرمال إلى رمزٍ حضاريٍّ بين النجومِ والأطلال، تُعانقُ المطاراتِ والجامعاتِ والندوات، وتُشيعُ في العالمِ رسالة الضيافة والثقافات. فقال السروجي: إن كان هذا شأنُها، فلا بُدَّ من مقامةٍ تُخلّدُ أمرَها وتُسطّرُ خبرَها. قلتُ: هاتِ نكتبها سويًّا؛ أنتَ تسعفُني بالعبارة، وأنا أُسعفُك بالدلالة والإشارة. فجلسنا على رُخامِ المكتبة، حيث الكتبُ شهود، والأقلامُ جنود، والصفحاتُ تنتظرُ مولدَ الكلامِ الولود. فقال السروجي: حدّثني عن أصل الكلمةِ في أرضكم يا قومَ الندى والهمم. كانت الصَّمْدَةُ - يا أبا زيد - قلتُ: خيمةَ الراحةِ على قارعةِ الظمأ، ومجلسَ القهوةِ والأنس والبهجة، يأوي إليها المسافرون من جهدِ الطريق، ويستعيدون فيها قوّةَ عزمٍ يواصلون به المسير. فضحك وقال - مفتخرًا بسفرِه القديم -: وما أكثرَ ما طويتُ البيداءَ، ،، ومشيتُ على الرمالِ الصفراء، فالسياحةُ عندنا كانت سفرًا لطلبِ رزقٍ أو علم، أو موعظةٍ تُهذّبُ الروحَ والقيم. فقلتُ: صدقتَ يا بطلَ المقامات، لكنّ للسفرِ في عصرنا وجهًا جديدًا وجَنابًا مجيدًا: سافِرْ ففي الأسفارِ خمسُ فوائدٍ تفريجُ همٍّ واكتسابُ معيشةٍ وعِلمٌ وآدابٌ وصُحبةُ ماجدِ ثم أضفت: أمّا اليوم… فقد تبدّلت الوسيلةُ وتغيّرت الغاية؛ صار الترحالُ في الأجواءِ، بعد أن كان على ظهورِ الإبلِ والخيولِ العَتاق، وصارت السياحةُ رسالةَ سلام، ولقاءً بين الأنام، وجسرًا من القلب إلى القلب قبل أن يكون من الأرض إلى الأرض. فقال السروجي وقد أشرق وجهُه إعجابًا: سبحانَ من بدّل رواحلَ الأمسِ طائراتِ اليوم، وجعل من مشقّةِ الطريقِ متعةَ الاكتشافِ والتفاهم والوئام. قلتُ: وقد اجتمعنا اليومَ في مكتبتِنا الوطنية - مهوى الأفئدة، وموئلُ المعرفة - لنحتفي بكتابٍ عنوانُه: «الصَّمْدَة: مستقبل السياحة في قطر» كتابٌ يوثّقُ الشواهدَ والمَعالِم، وينطقُ بلسانِ النهضةِ والقِيَم، ويُخبرُ العالمَ أنَّ قطرَ جعلت السياحةَ دبلوماسيةً ثقافيةً راقية، تُخاطبُ الضميرَ الإنساني قبل الجَيبِ والمَغنم. ففتح السروجيُّ صفحاتِه، وتأمّلَ أسرارَه، ثم قال: ما أروعَ ما أنجزتم! نقلتم الضيافةَ من زادِ الصحراءِ إلى فخامةِ الحاضرة، ومن صَفحة الرمالِ إلى صفحاتِ التاريخِ المدوَّنة. قلتُ: وهنا جوهرُ الصَّمْدَة يا صاحِ… فالضيفُ عندنا لا يُستقبلُ ببابٍ من حديد، بل ببابِ قلبٍ مفتوحٍ لا يُغلقُ في وجهِ أحد. فقال: صدقتَ، فما السياحةُ إلا ضيافةُ الروح، وما الصَّمْدَةُ إلا عهدُ أمانٍ ووعدُ حنانٍ يُقدَّمُ قبل المكان. فقلتُ وأنا أزيدُ من وصفِ النعمةِ والبُنى: يا أبا زيد… لقد صار المسافرُ في بلادنا يجدُ: فنادقَ تُنافسُ قصورَ الملوك ومتاحفَ تُنطِقُ الآثارَ والفنون وأحياءً ثقافيةً ك كتارا ومشيرب لا تنضبُ فيها الينابيع وجامعاتٍ تُعانقُ السماءَ بعلمٍ وفكرٍ رفيع ومكتبتَنا هذه… تاجًا على رأسِ الثقافة وحدائقَ فيحاءَ كانت حلمًا فأصبحت حاضرًا مدهشًا فقال السروجيُّ - وهو ينظرُ بدهشةِ الطفل وفرحةِ المكتشف - يا لروعةِ الدوحة! ،، جمعتِ المتعةَ والفائدة، والضيافةَ والمعرفة،،، فغدتِ مقصدَ الأسرةِ والعالِمِ والمغامرِ في آن. ثم التفتَ إليّ وقال: أترى أنَّ هذه المقامةَ قد اكتملت؟ فقلتُ: لا يا صاحِ… فكلُّ صَمْدَةٍ بدايةُ مسير، وكلُّ ضيافةٍ بذرةُ تقدير، وما دامت قطرُ تُنيرُ، وتُبدعُ وتُوقّرُ الإنسان، فالمقامةُ مستمرةٌ على مَرِّ الزمان. فخطَّ السروجيُّ خاتمتَه وقال: هذه مقامةٌ كَوّاريةٌ مُشتركة، كتبَها قلمٌ من الماضي، وصوتٌ من الحاضر، ليثبتا للعالمِ أنَّ الصَّمْدَةَ القطرية ليست استراحةً على طريق، بل عهدُ وطنٍ يَمضي… بين الرمالِ والنجومِ بثقةِ الملوك.
621
| 02 نوفمبر 2025
احتفلت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي بمرور عشر سنوات على إنشائها. وأعترفُ لكم في البداية بأنّني أنظرُ إلى هذا الحفل باعتباره لحظة تاريخيّة مؤسّسة، تُشعرني بفخرٍ كبيرٍ حينَ تلتمعُ في ذهني ونحن في فترة حضاريّة جدُّ حساسة من تاريخ ثقافتنا العربيّة بأنّني أشهد على «استئنافٍ حضاريّ» يتولّد من هنا، من الدّوحة كمركز عربي ودوليّ. فما نعيشه في هذا اليوم، وقد مرّت على إحداث جائزة الشيخ حمد للترجمة عشر سنوات، ليُعدُّ حدثًا مُجدّدا لنشاط الفكر العربي وهو يتفاعلُ مع الرصيد الإنساني للمعارف من خلالِ الترجمة. ••• لنكن اليومَ صُرحاء وجديرين بالاعتداد بهذا المكسب، إنّنا نستعيدُ لحظةً مضيئة من تاريخ ثقافتنا العربيّة، وبقدر ما نُدرك مسؤوليّة تلك الاستعادة فإنَّنا نعي جيّدا التحديات التي تعيشها ثقافتنا وحضارتنا بشكلٍ أشمل، فليست «جائزة الشيخ حمد بن خليفة للترجمة والتعاون الدّولي» مجرّد حدثٍ عابرٍ في سماء الثقافة العربيّة بقدر ما هي انتصارٌ آخر للشخصيّة العربيّة التي لا ترى في هويّتها القوميّة انغلاقا على الذّات رغم ما تعانيه من عداءٍ معلنٍ ومُبطّن في الخطاب الثقافي الغربي، فهيَ لم تيأس من الحوار مع الثقافات الأخرى ولم تبخل بمدّ جسور التّواصل أيّا كانت الظروف، لذلك فالاستمرار في هذا المشروع الكبير هو من أبرز تجليات ديناميكيّة الشخصيّة العربيّة المعاصرة، وأحد عواملِ تجدّدها سيما وهيَ تجعلُ من اللّغة العربيّة لغةً مُحاورة للغات العالم. ••• من الشيّق أن نعترفَ بأنَّ اقتران الجائزة باسم الشيخ حمد حفظه اللّه، علامةٌ دالّة على وضع رمزيّ في تاريخ قطر المعاصر وليسَ أمرا متعلّقا بتبجيل شخصيّة قياديّة كما هو شائع في كثيرٍ من الجوائز في العالم. ليسَ اقتران الاسم بالمسمّى لإضفاء سمة رسميّة على الجائزة، فما تستمدّهُ الجائزة من الاسم، يتجاوز ذلك بكثيرٍ. إنّنا نعلمُ رؤية سموّ الشيخ حمد للثقافة ودورها في نهضة دولة قطر، بل نُدرك كيفَ ينظر إلى الثقافة باعتبارها جزءا من عمليّة التنمية، ومحورا لتقدّم المجتمعات، فقبلَ عشر سنواتٍ انطلقت هذه الجائزة لتنبتَ في البيئة القطريّة التي مهّد طريقَ نهضتها سموّ الشيخ حمد الأمير الوالد، وعزّز بُناها صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى حفظهُ اللّه. لقد آمن سموّ الشيخ حمد بدور الثقافة في التنمية، وليست الترجمة غير صمّام أمان للثقافة حيثُ تسمح لها بالانتشار بين الشّعوب وتجاوز حدود البلدان، وتحلّق بالمعارف في المكان والزّمان. لذلك فقد كان إطلاق الجائزة ضمن رؤيته الشاملة للثقافة وقدرتها على أن تروّجَ لقيم المجتمع القطري في انفتاحه على الأمم الأخرى. ••• عندما نتحدّث عن «الاستئناف الحضاري» فإنّنا نقرُّ بوجود مقوّمات لهذا الاستئناف، وهيَ مقوّمات موضوعيّة، وإن كانت متشابكة مع ما هو ذاتي، فلو لم يكن الشيخ حمد مؤمنًا بدور الترجمة في إحداث التغيير الثقافي وبناء علاقات دوليّة متجدّدة وندية مع العالم، لما كانت الترجمة جزءا من هذه المقوّمات. فالعامل الذّاتي مهمّ في أيّ مشروع حضاري. لو لم يكن هارون الرشيد وابنه المأمون مؤمنيْن بمشروع «بيت الحكمة» لـمَا كانَ لهذا البيت أن يضيء أركانَ الحضارة العربيّة في الفترة العبّاسيّة. لذلك لا معنى للمشاريع التي تولدُ دونَ رغبة ذاتية في إنمائها، وكلّما كانَت للمشاريع إرادة ذاتيّة تتحلّى بالإيمان العميق برسالتها فإنّها تثبتُ في تُربة الواقع وتينعُ وتكبرُ مثل شجرة وارفة للمعرفة. ••• ما تُقدّمه الجائزة للثقافة العربيّة وليسَ لمجال الترجمة فحسب، هو القدرة على بناء الجسور وليسَ بناء الجدران. وأمّا الترجمةُ فهي من لبناتِ هذه الجسور التي عرفتها الحضارات القديمة، وتعهّدتها الحضارة العربيّة الإسلاميّة في أزهى فتراتها. فقد عرف اليونانيّون أزهى مراحل عيشهم حين ترجموا كنوز العلوم والفنّ عن حضارات قديمة كالحضارة الفارسيّة والمصريّة القديمة، وعرفت الحضارة العربيّة الإسلاميّة أبدع لحظاتها حين تحوّلت الترجمة إلى رهان مهم من رهانات الدّولة العباسيّة، ولكنّ الكثيرين يُهملون لحظة مضيئة من تاريخ هذه الحركة الترجميّة، وهي اللّحظة الأندلسيّة، فقد اهتمّ المسلمون في الأندلس بترجمة الكتب والمؤلّفات العربيّة إلى اللّغة اللاّتينيّة والقشتاليّة حتّى عُدّت الأندلس مركزا من مراكز الترجمة وبلغت حركة التعريب أوجهها في القرن العاشر للميلاد بمشاركة الأساقفة الذين أسّسوا معاهد للترجمة في مدينة طليلطلة حيثُ تمّت ترجمة العشرات من المؤلّفات العربيّة التراثيّة في مختلف العلوم كالفلسفة والطب والتنجيم. ومن المهمّ التأكيد أنّ الترجمة في حضارتنا لا تقلّ شأنا عن أيّ نشاط علميّ آخر. ••• وفي هذه السياقات الحضاريّة المختلفة ظلّت «بيتُ الحكمة» مثلَ المرجعيّة في الذاكرة الجماعيّة للمثقفين العرب، حتّى أنّني أتذكر أننا في 2010 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة اخترنا رمز «بيت الحكمة» في بغداد في أوج الخلافة العباسية، ليكون موضوع حفل «الدوحة عاصمة للثقافة العربية»، منذ ذلك الوقت كان الحلم المشروع لاستئناف حركة الترجمة العربيّة في صميم فكر ووجدان الشيخ حمد، لهذا لا نستطيع، ونحن نستذكرُ المحطّات المضيئة للترجمة في تاريخنا أن لا نصنّف «جائزة الترجمة» ضمن حلقات هذا التاريخ. من الإنصاف دائمًا أن نضعَ هذه الجائزة في صدارة المشروع الثقافي العربي، بعيدًا عن حالة التأزّم التي يعشها جزء من النخب الثقافيّة العربيّة التي انجرّ بعضها إلى تبخيس الذّات وإشاعة اليأس من إحداث التحولات بدل زرع الأمل. هكذا تعطينا الجائزة باستمرار وتيرتها ونجاحها من نسخة إلى أخرى أمل إحداث نقلة نوعيّة في تفكيرنا الثقافي ورؤيتنا المتجدّدة للثقافات الأخرى كلّما قامت الجائزة بتوسيع دائرة اللغات التي يترجم منها وإليها. ••• في كلّ دورة تُضاف لغات جديدة إلى قائمة اللغات المعتمدة للترجمة حتّى غطت الجائزة خلال عشر سنوات 37 لغة حول العالم، ممّا يوسّع نطاق التفاعل الثقافي لأنّ التّواصل بين الثقافات يتجاوز المعرفة اللغويّة، فاللغة ليست غير جزء من قمّة جبل الجليد المغمور، وكثيرا ما نذهب إلى الاعتقاد بأنّ الترجمة مجرّد امتلاك للغة أخرى ونقل ما تعبّر عنه من معارف الآخرين، قد يكونُ ذلك بُعداً من أبعادها لكنّه ليسَ رسالتها العريقة. ومثلما تتطلّب الترجمة إلماما بثقافة اللغة المترجم منها وإليها فإنّ ما هو جوهري في الترجمة هو تحقيق التقارب بين الشّعوب وتبادل الثقافات بين الأمم. ومن مزايا الترجمة إنقاذ الثقافة الإنسانيّة من الضّياع والتّلاشي والحرق والإتلاف والتّهميش والإقصاء، فهي حافظة مستمرّة، بل أشبه بذاكرة صامدة في وجه الزّمن ودُعاة الانغلاق الفكري. وإنّنا لنذكر ما حدث لكتب ابن رشد وغيره من المفكّرين من حرق، ولولا الترجمة لضاعت الفلسفة الرّشديّة، ولما استطاعت الإنسانيّة أن تتطوّر على هذا النّحو السّريع، لأنّ الترجمة حافظت على ما ساهمت به الشّعوب من إبداعات في الفكر والفن والعلم. ••• لا مبالغة إذا قلنا إن المترجمين من الأبطال المجهولين، ولا تقل بطولتهم عن بطولة الجنود في الميدان، لذلك تسعى الجائزة لتكريمهم وتقدير دورهم في التعارف بين الشعوب ونقل المعرفة بين الحضارات، ومد قنوات التواصل بين الأمم، إذ أعادت الجائزة المكانة الاعتباريّة للمترجم بل وفّرت له البيئة الإبداعيّة التي تدفعه نحو المساهمة في هذا المشروع الحضاري. لقد أصبحت الجائزة حاضنة للمترجمين وداعمة لهم وأصبحوا لها سفراء في كلّ مكان في العالم، فكلّ المترجمين الذين شاركوا في الجائزة إنّما خاضوا تجربة المشاركة وبعضهم خاض تجربة التتويج وفي جميع الحالات مثّلت الجائزة سياقًا ثقافيا عربيا جديدا للمترجمين المتمسّكين بالتزامهم التاريخي لأجل نقل المعارف للأجيال بأمانة ومسؤولية. ••• تؤكد الجائزة مكانة اللغة العربية وتأثيرها كلغة حية متطورة، قادرة على التفاعل مع تحديات العصر والمساهمة في التطور الفكري والعلمي في القرن الحادي والعشرين، وتترجم التوجّهات الوطنيّة في تعزيز اللغة العربية هذا المسار، حيثُ لا يُمكن الحديث عن استئناف حضاري دونَ تأكيد حضور اللغة العربيّة وتجديدها، ونعتقد أنّ الجائزة تُساهم في هذا التجدّد الذي تعيشه اللغة العربيّة وهيَ تنقلُ آداب وعلوم الأمم الأخرى، بذلك تكون لغتنا معاصرة لأحوال معاشنا، ومعبّرة عن ذلك التفاعل الدّائم مع منتجات الحضارة الإنسانيّة. ذلك ما تهبهُ لنا الترجمة من إيمانٍ بأنّ العربية ليست لغة الماضي المجيد فحسب، بل هي لغة الحاضر والمستقبل وتحمل في طياتها قدرةً لا متناهية على الإبداع والتجديد. ••• من مزايا جائزة الترجمة تفاعلها مع مبادرة الأعوام الثقافية ودبلوماسيتنا الناعمة بصورة عامة من أجل تعزيز التفاهم الثقافي والتقارب بين الشعوب، وفي هذا التفاعل ما يؤكّد قدرة الجائزة على أن تكونَ قوّة ناعمة لدولة قطر، وشعاع ضوءٍ في درب الثقافة العربيّة التي باتت في أمسّ الحاجة إلى الوعي بشروط نهضتها، وما الترجمة غير ذلك القنديل المنير لمستقبل حضارتنا، بما تضخّه من معارف معاصرة في عروق ثقافتنا فتتجدّد وتتقدّم. إنّني في غاية السّعادة وأنا أحلم مثل غيري من المثقفين العرب باستعادتنا لمجد حضارتنا، ونحن نقفُ متفائلين بثمار جائزة الترجمة واثقين من دورها الحضاري. ••• في هذا اليوم تعود بي الذاكرة إلى موقف تاريخي سنة 2010 عندما التقيت بصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد وأمير البلاد آنذاك حفظه الله ورعاه أعجبه شعار الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010 (الثقافة العربيّة وطنا والدوحة عاصمة) وقال لي سموّه: « نحن واثقون من أنّ الدوحة ستنجح هذا العام، ولكن طموحنا أن تكون الدوحة عاصمة دائمة للثقافة» وها هي الدّوحة الآن عاصمة من عواصم الثقافة بكلّ ما تعني الكلمة من معنى. وها هي عاصمتنا بمؤسساتها وصروحها الثقافية ودبلوماسيتها الناعمة تشعّ ثقافة وفنّا وتلعب دورا مميّزا في عالم العرب وفي كلّ مكان بقيادة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، حفظه اللّه ورعاه. ••• وإنّني في غمرة هذه السّعادة والتفاؤل أود أن أتقدم بالشكر لفريق جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، وأعبر عن تقديري العميق لجميع المترجمين والباحثين والأدباء الذين يساهمون بجهودهم القيمة في إثراء الثقافة العربية وثقافات العالم، فهم في ذروة العطاء الفكري والقلب النابض للتواصل الإنساني، ويجسدون القيم التي نسعى إلى ترسيخها في مجتمعاتنا. وأود أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الجائزة على مدى السنوات العشر الماضية، هذه الجائزة التي تعزّز فيه التواصل بين الثقافات والشعوب والدول، وتمنحنا أمل الاستئناف الحضاري.
357
| 08 ديسمبر 2024
إنّ من لا يستوعب حركة التاريخ في تجددها ومتغيراتها لا يستطيع إدراك حجم تحديات أيّة مرحلة ولا يقدر على استخلاص العبر، لذلك فالنظر إلى أي تجربة سياسية يخضع بالضرورة إلى فهم مقتضيات التاريخ التي ترى في الممارسة السياسية عملا إنسانيا يستجيب لطبيعة المجتمع وليس فعلا يتغذّى من النظريات التي لم تتولّد طبيعيا من تراكمات التجربة السياسية للمجتمع، فلا معنى لإسقاط نظريات سياسية «مستوردة» على مجتمع له خصوصياته المحلية وتجربته الذاتية. ليس في كيفية إدارة الشأن العام وإحكام العلاقة بين السلطة والشعب بل في سائر مجالات معاش هذا المجتمع، حيث يختص بمدوّنته القيمية وأعرافه النبيلة المتوارثة عبر الأجيال. وهذا ما تشي به التعديلات الدستورية التي مرت بها بلادنا منذ صدور الدستور حتى الآن من مراكمة للخبرات وتأمّل في فاعلية الممارسة على أرض الواقع. فالأمم الحية هي التي تتسم بمراجعة تجاربها، على ضوء مسيرتها، فتعدل وتضيف وتحذف ما تقتضيه مصلحتها. إذ لا يمكن أن تستمرّ في وجودها إلاّ بفضل هذه المراجعة. * واذا كان هذا الأمر بالمطلق، فهو الأجدر في المرحلة التي نعيشها، والتي تتسم بسرعة المتغيرات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبتزايد التحديات، فالعالم يتغير بوتيرة متسارعة، ويضع كل مجتمع أمام تحديات جديدة، ومن حق كلّ مجتمع أن يُقدّر طبيعة وشكل الاستجابة لهذه التحديات، وما دام المجتمع حرا وصاحب سيادة فلن يستعير تجارب مجتمعات أخرى ليطبّقها في معاشه، بل هو ينطلق لا محالة من أصالة تجربته التاريخية والحضارية ليكون له منواله المخصوص. فبلادنا العزيزة منذ صدور الدستور حتى الآن اتسمت مسيرتها بإنجازات جمة وبتغييرات في كل المجالات، وأصبحنا جيلا متعلما وقادرا على تحمّل المسؤوليات وله كفاءة المشاركة في بناء البلاد. *كما أن لدينا قيادة مدركة لمتطلبات التنمية المستدامة والاستقرار، ومدركة لحجم بلدنا الاقتصادي وتقدّر دورها في استقرار المنطقة والعالم ككل، وقد استطاعت بتناغمها مع متطلبات شعبها وسرعة التطورات في العالم أن تقود الدفة، وأن تقوم بدور بارز ومقدر في تسوية الأزمات والنزاعات بفضل الوساطة بين الأطراف المتنازعة، مما جعل دولة قطر تحتل مكانا على خريطة العمل من أجل إحلال الأمن والسلام في العالم بدور بارز ومعترف به في العديد من القضايا الشائكة، وجعل بلادنا محط أنظار العالم بنجاحها في حلحلة قضايا عديدة في منطقتنا وفي العالم ككل، وقوبل هذا الدور باعتراف العالم وتقديره لدبلوماسيتنا، كما كان لدبلوماسيتنا الناعمة دور كبير في تعزيز مكانة بلادنا، وتقديم ثقافتنا وخدمة قضايانا، والتعريف بقيمنا في نصرة المظلومين والوقوف مع الشعوب التي تتطلع لتحقيق كرامتها وحريتها. *كما أن ذلك التناغم بين الحاكم والمحكوم القائم على الثقة على امتداد أجيال الحكم من زمن تأسيس الدولة إلى الان، والحرص على تحقيق العدل بين المواطنين كان له أيضا دوره في الاستقرار وتعزيز مسيرة البناء الناجحة على كل الأصعدة. وما استضافة بلادنا للفعاليات الدولية بنجاح أبهر العالم مثل استضافة كأس العالم لكرة القدم بشكل لم يسبق، إلا دليل أثبتنا فيه قدراتنا على مجاراة نسق التطور الحضاري في العالم وأبرزنا فيه تلاحم الشعب مع القيادة وتقديم العرب وثقافتهم والثبات في وجه التحديات، وكان ذلك بمثابة الأنموذج المبهر للنجاح الذي تحققه دولتنا الفتية. * والآن تأتي التعديلات الدستورية لتؤكد استعداد بلادنا بقيادتها الشابة والنشطة على الاستعداد للمرونة والتغيير المطلوبين للاستقرار والازدهار والسلم الاجتماعي. وكلنا نعلم الأزمات الكبرى التي يمرّ بها العالم وتمرّ بها منطقتنا العربية على وجه الخصوص والتي تستلزم منا الحذر والحرص على التلاحم وتقييم تجربتنا في الشورى، واتخاذ ما يلزم من تغييرات ولذلك كانت التعديلات الدستورية التي تقدم بها قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مجلس الشورى منذ عدة أيام، وقد أقرها مجلس الشورى الموقر في جلسته أمس الاول بالاجتماع وستطرح للاستفتاء للشعب ليقول كلمته النهائية. * والناظر في التعديلات يرى موضوعيتها وضرورة الأخذ بها والتصويت بنعم عليها، فالمواطنة ماعادت تفرق بين مواطن وآخر، وهذا إنجاز يجب أن نصوت عليه ونوثقه وهو يعكس روح التآلف والتعاون والتضامن بين المواطنين فيما بينهم وبين قيادتهم، وهو ديدن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في دولتنا عبر المراحل منذ ولادة الدولة حتى يومنا هذا. كذلك فإننا مجتمع متجانس ونعرف بعضنا بعضا، كما نثق في قيادتنا التي تمثلنا خير تمثيل في اختيار مجلس الشورى، بما يجعل منه مجلسا فعالا، ولدينا جيل متعلم وواع ومدرك لواقعه ولمحيطه الخليجي والعربي والدولي، ونحن على ثقة أن قيادتنا ستختار أفضل القيادات لعضوية الشورى، بما يعكس طبيعة بلادنا وثقافتنا وعقيدتنا ومتطلبات التنمية المستدامة، ليقوم بمهمته على خير وجه، وليضع يده في يد القيادة لبناء البلاد، ومواجهة التحديات والسير إلى شاطئ الأمان بنجاح وبسلام اجتماعي وبتضامن للمحافظة على هذا البلد المعطاء. * وأضيف أن مبدأ الشورى متأصل في مجتمعنا، حيث أهل المشورة والخبرة يجدون قنوات مفتوحة عبر مجتمعنا وعلاقاتنا الاجتماعية ومجالسنا التي هي جزء من حياتنا اليومية، ولقاء مفتوح ومتاح بين القيادة والناس. لذلك سنقول وبصوت عال للاستفتاء بنعم كبيرة تعكس وحدة القيادة والشعب كما تترجم الإرادة في وحدة بلادنا واستقرارها وسيادة قرارها ونجاح دورها في العالم كقوة خير وسلام وعطاء. إن حرص القيادة بطرح التعديلات على الاستفتاء،، لدليل على ثقتها في شعبها وحرصها على سماع صوته، والاستفتاء سيد القوانين. كما أنّ هذه الخطوة علامة على شجاعة وجرأة القيادة في تعديل ما ينبغي تعديله وفق فهمها العميق لطبيعة المرحلة التاريخية. ولنعلم أنّ الشعوب الحية والجديرة بالحياة هي التي تقف من وقت لآخر لتقوّم تجربتها، ولتنطلق من جديد في مسيرة النجاح والاستقرار بينما الشعوب والأمم التي تتراخى عن أداء دورها التاريخي سرعان ما تفقد قدرتها على التجدّد والاستمرار.
759
| 30 أكتوبر 2024
ماذا يمكن للكلمات أن تبوح وهي في لوعة الوداع، فأنا في غاية الحزن والتأثر لوفاة زميلي وأحد أصدقاء عمري موسى زينل موسى. في مثل هذه المناسبة لا أجد الحروف، فأجمعها بصعوبة وهي ممزقة تستحضر الذكريات المشتركة. ليس أمرّ من الفقدان، وخاصة فقدان شخص نحت اسمه في التاريخ الثقافي لوطننا وامتدت تجربته في العالم العربي، فكان رائدا من رواد المسرح القطري، والثقافة العربية ولم يبخل على امتداد عقود في بذل الجهد من أجل تطوير وتعزيز حضور بلده وتمثيلها في الداخل والخارج. بدأت العلاقة بيننا مبكرة جدا وبعد السنة النهائية للمرحلة الابتدائية وكنت حينئذ شابا قرويا، قد انتقلت من قرية الغارية إلى العاصمة الدوحة، ومعارفي محدودة للغاية، وصادف أن كان معي على مقعد الدراسة الشاب موسى زينل موسى. ومنذ ذلك التاريخ نشأت علاقة ود وزمالة لم تزدها الأيام إلا رسوخا، ولم ينهها إلا الموت، شعرت منذ البداية بأنني وجدت رفيق درب عالي الهمة وصادقا صدق المخلصين. وكان قرارا اتخذناه معا مع مجموعة من الطلاب الأصدقاء التحاقنا بالمعهد الديني الثانوي في الدوحة وعلى نفس كرسي الدراسة لمدة ست سنوات، جمعت بيننا مقاعد الدراسة، ولكن أيضا الصداقة بعد الدراسة، كنا نلهو معا ونلتقي في بيوتنا ونتشارك الهوايات ونتقاسم السراء والضراء، مازلت أذكر نقاشاتنا في قضايا الأدب والمسرح والفكر، فقد كان موسى مهتما بالثقافة وصاحب أفكار وخفة دم لا تمل، وتمر ست سنوات في المعهد الديني من أجمل سنوات عمر الشباب عشناها على المستوى الشخصي والأسري مع مجموعة الأخوة والأصدقاء رحم الله من مات منهم وأطال الله عمر الحي. ثم انتقلنا طلبة إلى القاهرة، وما كان لنا أن نفترق فقد جمعتنا شقة واحدة في الأربع سنوات التي قضيناها في القاهرة، وازددنا اقترابا من بعض وحملنا معا هواجس إقامتنا في القاهرة ورغم أني التحقت بجامعة الأزهر كلية الشريعة وهو بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، فإن دراستي في الأزهر لم تطل إذ انتقلت لأدرس مع صديقي في كلية دار العلوم. وكانت القاهرة قلعة الفكر والفن والأدب بما انعكس على ثقافتنا ومسيرة حياتنا. وقد كانت تلك الفترة من أجمل السنوات وكنا مشهورين في الجامعة وارتبطنا بعلاقات رائعة مع الأساتذة والطلبة من كل مكان من ديار العرب، وعشنا حياة ثقافية ثرية بما كانت الحياة القاهرية تجود به فشكلت تلك السنوات قاعدة ومنطلقا لثقافتنا ومسيرة حياتنا. ثم انتقلت إلى وزارة الخارجية وعاد المرحوم لدراسة الماجستير بدار العلوم وافترقنا ولكن بقيت الصداقة الصادقة تربط بيننا، وبقي موسى في القاهرة ساطعا بمعارفه في عالم الثقافة والفن والمسرح ليكون من كبار المثقفين القطريين في الخارج كما الداخل. والمرحوم شخصية تتمتع بمواصفات استثنائية، تجعل من يعرفه، لا يمله ولا ينساه ولا ينسى نقاء روحه ولطف معشره، وخفة دمه وثراء معرفته، في قطر كما في عالم العرب. عدت وزيرا للإعلام والثقافة عام 1992، واخترت المرحوم وكيل الوزارة للشؤون الثقافية، فكان نعم المعين بعلمه وعلاقاته وثقافته وتفانيه في العمل، ولم تخلُ لي مهمة في الخارج دون أن يكون موسى معي، فقد كنت أأنس بصحبته واستنير برأيه. ثم عاد للعمل معي عام 2018 حين أصبحت مرة أخرى وزيرا للثقافة، مستشارا، وكان نعم المستشار ونعم المعين. واليوم بوفاة المرحوم انطفأت شمعة مضيئة من شموع الثقافة والمسرح القطري والعربي، وأسدل الستار على حياة كانت مليئة بالإبداع. وها أنا اليوم في لوعة لفقدانه فالقلب حزين بغيابه، وسيبقى خالدا بسيرته وبأعماله النبيلة وبسمعته الناصعة وبروحه المرحة. كل من عرفه لا ينساه، ففي هذا اليوم يحزن المسرح القطري لفراقه ويحزن المثقفون القطريون والعرب على خسارة قامة ثقافية بارزة. رحم الله موسى زينل وأسكنه فسيح جناته وجزاه بقدر بما قدم لوطنه وأمته. تعازي لأسرته الكريمة ولإخوانه الأعزاء (إسماعيل وإبراهيم ومحمد ويوسف وعلي) ولزملائه الأعزاء وأصدقائه في كل مكان.
1671
| 08 سبتمبر 2024
يذكر كلّ واحد منّا كيفَ عشنا أيّام «جائحة كورونا»، عندما استيقظ العالم فجأة على خبر انتشار واسع لفيروس تسبّب في تغيير نمط الحياة في كلّ المجتمعات الإنسانية، قبيلَ ذلك بفترة قصيرة كنتُ قد حضرتُ افتتاح مكتبة (الأمة) في أنقرة - تركيا - وفي كلمة الافتتاح ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة فلفَت نظري سرده لحكاية ذات مغزى، حيثُ إنَّ أحد الخلفاء العباسيين بعث لاستقدام أحد العلماء الكبار ليحاوره فذهب إليه الرسول ليطلب منه الحضور إلى الخليفة حالًا فوجد العالم في مكتبته وعندما أبلغه برغبة الخليفة قال العالم إني في جلسة حوار لا أستطيع قطعها وسآتيه غدا، وفي الغد ذهب العالم إلى الخليفة، فسأله الخليفة مع من كنت بالأمس قال: كنت مع الكتب.. تلك القصّة الرمزيّة تسرّبت إلى حياتنا تحت وطأة الجائحة، وقد قدّرتُ وقتها أنّ العالم سيتغيّر دون أن يطيح بمكانة الكتاب. وفعلاً ازدادت وتيرة انتقالنا إلى العصر الرقمي دونَ أن نتخلّى عن المعرفة، ومرّت تجربة الحياة تحت وطأة «التباعد الاجتماعي» بإحلال تقارب من نوع جديد وبوسائط جديدة، فقد هيمن البعد التكنولوجي وارتفع نسق الاتّصال والتواصل وبدا السّؤال عن منزلة الكتاب والمكتبات ملحّا لدى المثقفين والكتّاب والقرّاء، ولدى الجهات المعنيّة بمصير الكتاب والمكتبات. كنتُ أسأل نفسي: ما مصيرُ المكتبات في العصر الرقمي؟ وكان لسؤالي وقع مضاعف لأنني لم أكن كاتبا وقارئا فحسب وإنّما رئيسًا لمكتبة قطر الوطنيّة، ممّا حمّلني مسؤوليّة أكبر في تناول هذا السّؤال وتقليبه والتفكير في أهمية تطوير المكتبات حتّى لا يلعب هذا العصر الرقمي بوسائله المتعدّدة دور القضاء على المكتبات، وحتّى لا نعيش زمن هدم المكتبات بطريقة حديثةٍ. استمرار مجتمع المعرفة صمدت المكتبات في تاريخ الإنسانيّة رغم الهدم والحرق. ولا يُعقل أن تنحني لعاصفة العصر الرقمي. فقد عرف تاريخ الكتاب مراحل تاريخيّة مختلفة في وسائل التواصل، ولكننا نشهد اليوم حلول أشكال جديدة لتواصلنا مع الكتاب. لنُدقّق الأمر أكثر، فقد كانت المرحلة الأولى التي عاشتها الإنسانيّة تشهد على امتداد أربعة آلاف سنة قبل الميلاد كيفَ تعلّم الإنسان الكتابة، وكيفَ بدأ مع اختراع الكتابة في استخدام لفافات الورق ومخطوطات البردي لحفظ المعلومات والمعاملات والفنون وتعبيره عن رؤيته للحياة والمعتقدات. وبعدها أصبح المخطوط شائعًا فسهّل عمليات التواصل، وعدّ اهتداء الإنسان لفنّ المخطوط ثورة ثقافيّة في تلك العهود سمحت له بتملّك «الوثيقة» وتصفّحها والتعليق عليها في هوامشها، لكنّ مرحلة اختراع الطباعة نحو عام 1450م مكّن الإنسان من الدّخول في عالم التواصل الواسع النطاق، فبعد أن كان استنساخ النّصوص من اختصاص النّساخ صار من مهام المطبعة التي وسّعت مجالات تداول المعرفة ونقلت الكتاب من زمن المخطوط إلى زمن المطبوع. ولا شكّ فإنّ المكتبات التي كانت في السابق تعتمد على المخطوطات وتستعين بصناعة الورّاقين تطوّرت خدماتها بتطوّر صناعة الكتاب. وها نحن اليوم نعيش زمن «النصّ الإلكتروني»، وهي ثورة أخرى في تاريخ الكتاب والتواصل، والمتأمّل في وتيرة تطوّر هذا التاريخ، سيندهش لتلك النقلات المتسارعة التي وفّرتها التكنولوجيا للإنسانيّة، فبينما استغرقت مدّة استخدام الإنسان للكتابة على اللفافة قرابة 4300 سنة، فإنّ استخدام المخطوط بحروف متنقلة دام قرابة 524 سنة، وتطلب الانتقال من الكتاب المطبوع إلى الإنترنت بمحرّكات البحث قرابة 17 سنة لتستغرق مدّة إنجاز محرّكات البحث مع الترتيب عبر غوغل حوالي 7 سنوات. ومن الصّائب الاعتراف أنّنا نعيش على وقع تغيير في تعاملنا مع الكتاب والقراءة على السّواء، إذ يُعدّ دخول الكتاب الورقي إلى عالمنا ميلادًا لفترة جديدة في تاريخ الإنسان. لم تعد القراءة مقتصرة على الكتاب المطبوع، بل إنّ جيلاً كاملاً نشأ بين الصّفحات الافتراضيّة لمحرّكات البحث، وهو لم يعد يستخدم نفس الطرق التي كنا نقرأ بها ونتعامل بها مع الكتاب. إنّه جيل تنوّع طرق القراءة، فالشاشة غير الورقة، وهو قادر في وقت وجيز على تصفح كتب مختلفة في وقت واحد والاكتفاء بنبذات من هنا وهناك. ولا يعني ذلك أنّنا نتحسّر على زمن ما قبل الرقمي فلم يتحسّر أبناء زمن المطبعة على زمن المخطوط، ولم تلغ المطبعة تاريخ الكتاب بل طورته، وكذلك موقفنا من العصر الرقمي. وما الحديث عن أزمة القراءة والكتاب بدعوى هيمنة الرقمي على حياتنا إلاّ حكم يحتاج إلى تروٍّ، فقد عصفت أزمة القراءة أوروبا مثلا قبل أن يحلّ العصر الرقمي، وقد سبق تراجع قراءة الكتب في فرنسا زمن هيمنة الرقمي على عمليات النشر وتداول الكتاب. إنّنا مجبرون لفهم طبيعة العصر الرقمي ومتطلّباته لكي نستثمر وسائله. لقد حلّ الرقمي في مختلف المجالات، ومن المهمّ التّصريح بذلك حتّى لا يُعتقد أنّ مجال الكتاب والمكتبات مهدّد بشكل متعمّد من هذه الوسائل الجديدة. انتقلت الإدارة في أغلب بلدان العالم من الإدارة الورقيّة إلى الإدارة الرقميّة، وأصبح لزاما على كلّ بلد تطوير خدماته باستخدام التكنولوجيا، لذلك فإنّ الدول التي تعيش ما اصطلح على تسميته بـ»الفجوة الرقميّة» تظلّ متأخرّة قياسا بدول أخرى تمتلك وسائل الرقمنة. لا يعني الانخراط في العصر الرقمي إعلانا عن «نهاية المكتبات»، فالمكتبات مثل الإنسان تماما فهي على سبيل المجاز «مدنيّة بطبعها» وهي تتأقلم مع المتغيرات التي تحيط بها، وإذا كان «العصر الرقمي» في ظاهره عصر الوسائل والتقانات فإنّه في جوهره عصر معرفي، وما المجتمع الذي يدعو إليه سوى «مجتمع المعرفة». ولكنّ هذا الموقف يتطلّب في الآن نفسه مجهودات كبيرة لأجل «الإبقاء» على المكتبات بل وجعلها تنمو وتعمل بوظائفها المعلومة، وإذا كنا اليوم قادرين على الدخول إلى أيّة مكتبة في العالم للاطلاع على محتوياتها والاستفادة من خدماتها فذلك من فضائل العصر الرقمي ولا يعني أنّ فضاء شاشات الحواسيب سيعتقل القرّاء ليمنعهم من الذّهاب إلى المكتبات واستعارة الكتب منها والمكوث بين أروقتها. تقوم المكتبات بالتكيّف مع متطلبات العصر، وما يطلبه جمهور القرّاء أيضا، لذلك سارع المهنيّون في المجال إلى دمج وسائل جديدة في المكتبات مثل الشّاشات والألواح الرقميّة في القاعات، ويعني ذلك أنّ إدارة المكتبات ستختلف عمّا كانت عليه، وقد برهن العرب في تاريخنا الثقافي على قدرتهم على اصطناع وسائل جديدة في إدارة المكتبات منذ القديم، فلم يكن لديهم إنشاء المكتبات وليد هاجس حفظ المعارف بقدر ما اهتمّ العرب بـ»إدارة» رصيد مكتباتهم فتوصّلوا قبل غيرهم من الأمم إلى علم إدارة المكتبات، وتصنيف المؤلفات تصنيفاً موسوعياً، ونذكر من أشهر «خزاني المكتبات» سهل بن هارون وابن مسكويه وأبو سيف الأسفرايني. ولذلك فإنّ تطوير المكتبات في هذا العصر ليس مجرّد حاجة وإنّما هو استمرار لمجتمع المعرفة الذي تحافظ فيه المكتبة على مكانتها. الرقمنة خيار إستراتيجي لشدّ ما أعجبني قول جيمس برايدل «لا تعني التقانة مجرّد صناعة أو استخدام أداة ما، بل هي صياغة الاستعارات»، فقد اهتدى إلى أنّ الغاية الرئيسيّة في هذا العصر الرقمي لا ترتكز على تملّك أدوات التقنية، بل ترتكز على تلك المفاهيم الجديدة التي نمتلكها لتطويع تلك الأدوات وليس لتوثينها، فيصبح الأمر نوعا من الانقياد الطوعي لـ»الوسيط»، فنغترب فيه وننسى أنّه من صنعنا ولسنا من صُنعه. وعندما حللت رئيسا على مكتبة قطر الوطنيّة فكّرتُ طويلاً في كيفيّة استثمار هذه الوسائل الجديدة لخدمة مضامين الهويّة الوطنيّة وقيم التعارف الإنساني، وعملتُ على أن توظّف هذه الوسائل في المحافظة على التراث الثقافي لدولة قطر والخليج العربي والتراث الإنساني. ولعلَّ من أبرز أدوار المكتبات الوطنية في العالم بشكل عام القيام بهذا العمل الجليل منْ حفظ للتراث الفكري الإنساني، وذلك هو دور من الأدوار الأساسيّة التي تقوم بها مكتبة قطر الوطنيّة. لقد تعلَّمنا بأنّ التَّجارب والخبرات التي عرفتها الحضارات استطاعت أن تُراكم معارف ومهارات لا غنى للإنسان عنها في أيّ زمان ومكانٍ لأنّها نواة هذا التطوّر الذي نعيشهُ، وإننا نرى هذا التراكم فيما تركته الأجيال من وسائط مدوّنة أو شفاهيّة، وتناقلتها الأمم، وسارعت إلى حفظها من الزوال حتّى تظلَّ محفورة في ذاكرة الأجيالِ وفاعلة في حاضرها متى دعت الحاجة إليها. وقد تحوّلت هذه الوسائط إلى مصادر للمعرفة يستفيد منها الجميع، ولكنّ هذه الوسائط تحتاج على مرّ السنوات إلى حفظ وصون، وقد أتاحت الوسائط الرقميّة فرصة لهذا الحلم. تُعدُّ مكتبة قطر الوطنيّة قلعة من قلاع التراث الثقافي بفضل ما تزخر به المكتبة التراثية بها من مخطوطات وخرائط نادرة توفّر للمستفيدين معرفة تراثيّة واسعة بالتاريخ القطري خاصّة، وإن كان معمار مكتبة قطر الوطنيّة حديثًا في طابعه الهندسي فإنّها تولي التراث الثقافي مكانته المتميّزة واللائقة به. وقد تجاوزت المكتبة الدور التقليدي في المحافظة على التراث من خلال تبنيها للأساليب التكنولوجيّة المتقدّمة، ولم تعد تكتفي في أعمالها بتنمية مجموعاتها الوثائقية بحسب حاجيات المستفيدين فقط، بل سارعت إلى حصر الإنتاج الفكري الوطني وتجميعه وتنظيمه والاهتمام بالتراث الثقافي القطري حتّى تكون المكتبة عنصرا فاعلا في بناء الهوية الوطنيّة. ومن أثر انفتاح هويتنا على التقدم التكنولوجي توظيفنا لكلّ الوسائط الرقميّة، فالمخطوطات تحتاج إلى عناية مخصوصة للمحافظة عليها نظرا لقِدمها ونُدرتها وصعوبة تحقيقها، ومن هنا تأتي أولويّة رقمنتها في جميع مكتبات العالم الإسلامي حتّى تبقى شاهدة على تاريخنا المشترك، وتظلّ مصدرا أساسيا من مصادر معرفتنا بكنوز التراث الفكري والمهاري الذي عرفه المسلمون على امتداد قرون. إنّ المجتمع الرقمي هو الصّورة الجديدة لمجتمع المعرفة، حيثُ أصبحت المعرفة معتمدة على تقنيات ومنهجيات وأساليب عمل حديثة متطوّرة، وتُترجم مكتبة قطر الرقميّة هذا الانخراط في المجتمع الرّقمي الذي يوسّع من القدرة على استيعاب أكبر قدر ممكن من المعارف وتحصيلها على محامل جديدة كما يوسّع قاعدة المستخدمين من قرّاء وباحثين، فتصبح المعلومات والمعارف متاحة بسهولة ويسر وبلا قيود، ليكون المجتمع الإنساني بشكل عام أكثر معرفة من أيّ وقتٍ مضى. فقد تمّت رقمنة أكثر من مليون ونصف المليون صفحة، وقريبا سترقمن تسعمائة ألف صفحة من المواد الجديدة حول منطقة الخليج، وتعكس هذه الأرقام التدفّق الكبير للمعارف ووفرة المادّة العلميّة المتاحة للأكاديميين والمؤرّخين، والطلاب والباحثين على السّواء. لنعترف جميعًا بأنّ استخدام التكنولوجيا اليوم لم يعد ترفا يمكن تجاوزه أو الاستغناء عنه، مثلما أصبحت المكتبة الرقميّة جزءا من حياة المجتمع المعاصر، وجزءا من تطلّع كلّ مجتمع يريد الخروج من الفجوة الرقميّة ليبلغ التقدّم. ولعلّ من بين ما أنجزته مكتبة قطر الرقميّة، قدرتها على تأكيد عبور دولة قطر إلى مصاف الدول التي تراهن على المعرفة بأدوات في غاية التطوّر، فلم تعد المكتبة مجرد مخزن للكتب ولأوعية المعلومات في صروح شاهقة وبعيدة أحيانا بل أصبحت أقرب إلى القارئ والباحث فتسمح له باستثمارها الاستثمار الأمثل، ويمثّل تيسير تلقي المعرفة نقلة في الزمان والمكان حيثُ تصبح المعلومة والمادة البحثيّة قريبة من طالبها، وتلك هي القيمة المُضافة للمكتبة الرقميّة. وتساهم رقمنة الموادّ التاريخيّة في اكتساب عامل الوقت، حيث تصبح الاستفادة من المعرفة سريعة، وهو ما يحقّق التواصل مع المواد العلميّة التي كان من المتعذّر الحصول عليها، وهي فائدة تغني الطلاب والباحثين وسائر القرّاء عن التنقّل إلى مواقع هذه المصادر التي كانت مشتتة في المكتبات أو مبثوثة على أرفف الخزائن. وإذا كان النفاذ إلى المعلومة التاريخيّة قد أصبح أمرا متيسّرا فإنّ سعي مكتبة قطر الرقميّة إلى أرشفة مواد من المكتبة التراثيّة بالإضافة إلى مواد من شركاء المكتبة الدوليين من المراكز الأرشيفيّة مثل الأرشيف العثماني والأرشيف الدبلوماسي الفرنسي في باريس والأرشيف الوطني الهولندي، سيسمح بتوسيع دائرة المعرفة، وسيعطي للباحثين فرصا لم تكن متوفّرة لتحصيل الحقائق التاريخيّة، ولفهم التجارب الإنسانيّة المختلفة. نحن اليوم في حاجة إلى الحوار والتفاعل الإيجابي بين الثقافات والحضارات وليست مكتبة قطر الرقميّة غير أداة متقدّمة للاستجابة إلى هذه الحاجة، فالرهان الحضاري كبير، وهو معقود على تحقيق مستقبل أفضل للإنسانيّة حيثُ يستفيد القارئ من المعرفة لا ليكنزها في عقله ووجدانه بل ليعمل بها، وينتج من خلالها ويساهم بمادّتها في تطوير المعرفة البشريّة، فتنمية المعارف بواسطة التقنيات الجديدة جزء من تنمية مستقبل الإنسانيّة الذي لا يقوم إلا على المعرفة باعتبارها خلاصة احترام الإنسان لأخيه الإنسان لأجل حاضرٍ تسوده القيم المشتركة ومستقبل يعمّه السّلام.
1470
| 05 أبريل 2023
اقترنت حياتي بالكتاب، ذلك ما كنتُ أردّده لكلّ شخصٍ مقرّب إليّ، فعلى امتداد مسيرتي الدبلوماسيّة والثقافيّة، تعرّفت على مدنٍ كبرى وثقافات ولغات وشخصيّات، وفي كلّ أسفاري وجولاتي وتنقّلاتي من مكان إلى آخر ومن مسؤوليّة إلى أخرى، ظلّ الكتاب هو الرفيق الذي لا يُفارقني. وكلّما زرتُ بلدًا إلاّ وفكّرتُ في الاطلاع على أهمّ كتبه، وزيارة مكتباته. تحوّل الكتاب منذ صباي إلى هاجسٍ، حتّى أنّي لم أدخل باب الكتابة إلاّ من باب القراءة. تدرّبتُ طويلاً على القراءة، ومع هذا التدرّب كان عليّ أن أحيا مع الكتب، فأجمع ما راق لي منها، وأبحث فيها عن حكمة العابرين من أجداد الإنسانيّة الذين تركوا لنا إرثًا في جميع الآداب والفنون، بعد أن تنبّهتُ في بداية شبابي إلى أنّ حفظ الملوك والسلاطين في الحضارات القديمة للكتب في الخزائن هو علامة على أنّ الكتاب يفوق المعادن النفيسة في القيمة والأثر. المكتبة ليست خزانة كتب كانت مصادر الحكمة تُخفى في الخزائن ولا تُعرض في المكتبات. تذكّرتُ كيفَ أخفى ملك الهند دبشليم كتاب «كليلة ودمنة» الذي صنّفه الفيلسوف بيدبا في آداب الحُكم وأجراه على لسان الحيوانات، وكيف سارع ملك الفرس كسرى أنوشروان في طلبه من خلال تكليف الطبيب برزويه للسفر إلى الهند وإخراج الكتاب المخفيّ وترجمته لتكون حكمته بيد الفرس، وكيفَ نجح برزويه في مهمته وانتهت إلى إخفاء الكتاب في خزانة ملك الفرس، كأنّما قُدّر للحكمة أن يُزجّ بها في عتمة الخزائن. فكّرت طويلا في رمزيّة ذلك. واستزدت من الاطلاع على تجارب الأمم في التعامل مع الكتاب، ونظرتُ بعين الفخر إلى ما سلكه العرب في هذا الطّريق. كانت مكتبة «بيتُ الحكمة» علامةً مضيئة في تاريخنا، أكاد أجزمُ أنّها «ملحمة» أبطالٍ آمنوا بأنّ المعرفة صراعٌ دائمٌ ضدّ ظلمات الجهل. كنتُ أتساءلُ: ما الذي كان سيحدثُ للعرب لو لم يقم العباسيّون بإنشاء هذا الصّرح الذي لم يكن مجرّد مكتبة أو خزانة كتب ومركز للترجمة؟ كانت مكتبة «بيت الحكمة» مركز إشعاع ثقافي، وجسر حوار بين الثقافة العربيّة الإسلاميّة والثقافات الأخرى، ولولاها لما استطاع العربُ التقدّم في نيل المعارف والعلوم، فقد ضربوا آنذاك أسمى معاني تبادل الثقافات وقبول الآخر الفكري، قبل مئات السنين من رفع شعارات «الحداثة» اليوم، والتوجّهات الأمميّة. في ذلك العصر العباسي تجسّمت مُثل الحوار الحضاري، وصارت بغداد أشبه بوردة تنشر رائحتها الزكيّة على كامل أنحاء المعمورة، مثلما غدا للأوروبيين لاحقًا مدينة فلورنسا التي وهبت أوروبا رائحة النّهضة. لقد بلغ إشعاع بيت الحكمة الأندلس، وأطنب الكتاب والإخباريّون العرب في وصف ما كانت تزخر به، فقد قال عنها القلقشندي في كتابه صبح الأعشى في صناعة الإنشاء:» كان فيها من الكتب ما لا يُحصى كثرة، ولا يقوم عليه نفاسة، ولم تزل على ذلك إلى أن دهمت التتار بغداد، وقتل ملكهم هولاكو المستعصم آخر خلفائهم ببغداد، فذهبت خزانة الكتب فيما ذهبَ وذهبت معالمها، وأعفيت آثارها». وبيّن القلقشندي أنّ «بيت الحكمة» هي أوّل دار كتب حكوميّة في الحضارة الإسلاميّة، وهي واحدة من ثلاث دور أثّرت في مسار الثقافة العربيّة الإسلاميّة، إلى جانب خزانة الخلفاء الفاطميين بمصر وخزانة خلفاء بني أميّة بالأندلس. لقد أشرتُ في كتابي» على قدر أهل العزم» إلى مزيّة المأمون الكبرى حين حوّل «خزانة الكتب» التي أنشأها المنصور إلى «بيت الحكمة»، فالخزانة ليست غير مستودع للكتب بينما البيت يفترض وجود سكّان به، أي تتدفّق فيه الحيويّة والنشاط ومن ذلك ما عُرف به «بيت الحكمة» من نشاط للعلماء من مختلف الأجناس واللغات في علامة لاحتضان حوار الحضارات بين الحضارة العربيّة الإسلاميّة والحضارات الهنديّة واللاتينيّة واليونانيّة والسنسكريتيّة وغيرها. وقد حرصتُ حين كانت الدّوحة عاصمة للثقافة العربيّة عام 2010 أن يكون العرض الافتتاحي عن «بيت الحكمة» لما أؤمن به وأتوقّعه من أنّ الدّوحة عاصمة للمعرفة ولما يحمله بيت الحكمة من دلالة، وهذا نراه اليوم جليّا في عاصمتنا من اهتمام بالثقافة وما تنتهجه قطر في تسليط الأضواء على هذا البعد. وفي العهد الفاطمي شهد العرب إنشاء مكتبة الفاطميين، فكانوا يرون فيها عجيبةً من عجائب الدّنيا، فاحتوت على آلاف الكتب من جميع العلوم، ومن الوقائع التي ظلت مقترنة بها، في علامةٍ على نفائس ما احتوته، أنّ العالم أبي الصّلت أميّة بن عبد العزيز الإشبيلي (1067-1134م) الذي أتى مصر فعاش فيها عشرين سنة، مقرّبا من الوزير الفاضل شاهنشاه بن بدر الدين الجمّالي، في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر باللّه، وبسبب افتراء واحد من حاشية الفاضل حُبس لثلاث سنوات في المكتبة، فأخذ ينهل من معارفها ودرس مخطوطاتها، فخرج منها وقد أضحى من العلماء وبعد أن ألّف كتابه «الحديقة» على أسلوب «يتيمة الدّهر» للثعالبي. وتواصل الاهتمام بالمكتبات في الأندلس، خاصّة في عهد بني أميّة، فجمع الحكم المستنصر (915-976م) ثاني خلفاء الأندلس أربعمائة ألف مجلّد، وجمع بداره الحرفيّين من أهل صنعة النسخ والوراقة والتجليد، وأرسل رجاله بحثا عن نفائس المخطوطات في مراكز الثقافة الإسلاميّة فكانوا يشترون المؤلّفات من الكُتاب وينشرونها في الأندلس قبل أن تظهر في العراق أو الشام أو مصر. وسار الأندلسيّون عامّة على نحو ما سار عليه حكّامهم من تقدير لمنزلة الكتاب والمكتبات في الحياة العامّة. كان إنشاء المكتبات وليد الحركة العلميّة والأدبيّة والفكريّة التي عاشتها البيئة الأندلسيّة، فنشاط المكتبات هو انعكاسٌ لما في الحياة الثقافيّة الأندلسيّة من حراك، وهي تُسهم في ترويج مضامين تلك الحياة مثلما ساهمت في تطوير حركة تأليف الكتاب وكلّ الصّنائع المجاورة لها. وتنوّعت المكتبات في الأندلس في مجتمع شاعت فيه القراءة بين جميع طبقاته، فكانت المكتبات الملحقة بالمساجد، والمكتبات العامة، ومكتبات القصور، ومكتبات الوجهاء والأعيان. إنّنا حين تنفحّص الرقيّ الحضاري للأندلسيين لا يُمكننا عزله عن واقع المكتبات آنذاك، فلم تكن المكتبة عنصرا ثانويّا في حياة الأندلسيين، بل جزءا من حياتهم اليوميّة، حتّى إنّ سوق الكتاب في قرطبة تعتمد على «المزاودة»، فالكتاب بضاعةٌ قيّمةٌ مبثوثة في اقتصاد المجتمع الأندلسي، وهو ما لمسه ياقوت الحموي ( 1178-1229) بقوله «إنّ الكتب كان يُنادى عليها بالمُزاودة». ولكنّ تاريخ المكتبات العربيّة لم يسلم من المآسي، مثلما لم يسلم الفكر الحضاري العربي الإسلامي من محاولات إقصائه عن دوره الطلائعي في الثقافة الإنسانيّة، فقد شهد ذلك التاريخ في فترات مختلفة وبأيدٍ داخليّة وخارجيّة حرقًا وهدما للمكتبات، فهدمت مكتبة بيت الحكمة من طرف المغول عام 1258م، الذين ألقوا الكتب في نهر دجلة، وطالت النّار كتب ابن رشد في الأندلس مثلما هُدمت فيها المكتبات ممّا جعل بولسترون يعترف بأمانة في كتابه الشيّق «كتب تحترق، تاريخ هدم المكتبات»:» لقد عاشت قرطبة في القرن العاشر أكبر تجربة مرعبة لحرق المكتبات في القرون الوسطى كلّها». وتعكس لنا وقائع هدم المكتبات وحرقها عبر التاريخ تلك الأهمية التي تمثّلها المكتبات في صناعة المجتمعات وفي حفظ ماضيها والتعبير عن حاضرها، وهو ما دفع بأعداء الحياة والمعرفة على أعمال الهدم والحرق، لأنّ المكتبة تشكّل الكيان الاعتباري لثروة أمّة ما من الأمم. ذلك أنّا لمكتبات ارتبطت منذ القديم بهذه الفكرة الجوهريّة: لا تقدّم للإنسانيّة إلاّ بمدى تقدّم معارفها. المكتبة رحلة معرفة تُعدّ المكتبة منبعا للمعرفة، بل حصنها الحصين، فهي تمنح القارئ والباحث عامّة القدرة على الدّخول إلى مصادر المعرفة الورقيّة أو الرقميّة، وكثيرا ما يشعر فيها بالأمان، لأنّها تعبير ملموس عن الكلمة المفتاحيّة «اقرأ» التي وهبت حضارتنا دافعيّة الوجود، فجعلت حياة المجتمعات متّصلة بالمعرفة، وعبّرت أيضا عن الشّرط الأساسي للتقدّم والبناء الحضاري. كنتُ أفكّر دائما بشأن تلك الصّلة المُشوّقة بين المكتبة والاكتشاف، فالعيش في مكتبة أشبه بقبول المغامرة بلقاء من لا تعرف، وقبول باستضافة المختلف. لذلك صمّمت على أن تكون مكتبتي جزءا من مجلسي الشّخصي، فتكون جلسات النقاش والتفكير بين روّاد المجلس في بيئة الكتاب، ويكون التعارف بين الجميع نوعا من استحضار الهدف من القراءة وجمع الكتب وهو اكتشاف المعرفة التي دفع الإنسان ثمنها باهظا على امتداد تاريخه. طالما استعدتُ رواية «اسم الوردة» للكاتب الإيطالي إمبرتو إيكو حين اعتبر أنّ « الكتب أحلام» وهو يستدعي جرائم تسميم الرّهبان في دير أثناء تصفّحهم لكتاب أرسطو، حيثُ تُعاقب الكنيسة في القرون الوسطى بشكل رمزي كلّ من تُسوّل له نفسه بالاطلاع على معرفة تعارض آراءها وتفتح العقول آنذاك. ففي أحد الأديرة يتولّى الرهبان نسخ الكتب اللاهوتيّة، وإذا ما فكّر أحد منهم قراءة كتاب الفلسفة في مكتبة الدّير سرّا يُواجه مصير الموت مسموما، بعد أن عمد كبيرُ الرهبان على نسخ الكتاب بالحبر المسموم. وقد وجدتُ في الحيلة التي استخدمها إيكو لبناء أحداث روايته وبلوغ مقصده شيئا مقاربًا لذلك في الليلة الخامسة من كتاب «ألف ليلة وليلة» حين شفى حكيمٌ الملك بعد سقمه فقرّبه الملك منه ممّا أثار حقد وزيره فأوغر قلبه على الحكيم الأمر الذي دفع الملك إلى إعلان رغبته في التخلّص من الحكيم فأعلمه بأنّه سيعدمه، وإذا بالحكيم يطلب الذهاب إلى بيته قبل الإعدام ليجلب كتابا يهديه له، وما إن عاد بالكتاب حتّى أخذ الملك يتصفّحه فكان يبلّ إصبعه بريقه ويوّرق الصّفحات إلى أن ماتَ مسموما. وقد أدركت على امتداد مسيرتي الفكريّة أنّ عالم الكتاب والمكتبة من العوالم التي تبني إنسانيّة الإنسان، لذلك يخشاها أعداء التفاعل الحضاري بين الأمم. وفي استقراء لتاريخ مكتبات الغرب وأثر المكتبة في بناء نهضتهم، عدت لتذكّر ما أقبل عليه الكاتب الإيطالي بترارك (1304-1374) الذي أسّس جماعة الإنسانيين في عصر النهضة، فقد عاد إلى الآداب الكلاسيكيّة رغم موقف معاصريه منها، وقام برحلات واتصالات للحصول على المخطوطات فصار صائدا لها، واعتمد على نفسه في تحقيقها ودراستها، إذ كان يؤمن بأنّه لا معنى لتجميع الكتب دون أن ينتفع بها الجامع. كانَ شغوفا بالكتب فأنشأ مكتبة خاصّة عظيمة، وجعلَ عليها حرّاسًا، حتّى أنّه وُجد لشدّة ولعه بالكتاب ميّتا على الأرض وبجانبه كتاب مفتوح كان يُطالعهُ. وواصل «الإنسانيّون» من بعده عملية جمع المخطوطات الكلاسيكيّة اللاتينيّة واكتشاف ذخائر ما تُرك إثر سقوط الامبراطوريّة البيزنطيّة يدفعهم العطش إلى المعرفة. كنتُ أستعيدُ ذلك العصر بما فيه من حماسةٍ لتلقّف المخطوطات بمخيال من يُتابع مغامرة الإنسان في تحصيل المعرفة. إنّ هاجس بترارك ومن قبله العرب المسلمين، لم يكن مُجرّد تحصيل الكتب وجمعها، فقد كانت المكتبات صروحا للمُثل والقيم الإنسانيّة المشتركة أيضا. فالمكتبات حاضنة لكلّ القيم الإنسانيّة التي تدعو إلى التعايش وتقارب الثقافات والحضارات واحترام الهويّات والآخر عموما، وهي قيم تحقّق تنمية حقيقيّة للمجتمع لأنّها تجعله متوازنا مع نفسه مثلما تجعله منفتحا على العالم. وبقدر ما تُشجّع على المعرفة والانفتاح على الآخر، فإنّها تدعو إلى الإبداع بما تحمله من معارف لا يؤخذ لمجرّد استظهار المعلومات. وكلّما استعدت هذه المعاني السامية لما تهبه المكتبات للإنسان ظللت أتساءلُ عن مصير المكتبات في العصر الشبكي، فهل تستمرّ المكتبات في أدوارها السابقة أم تسير اليوم في اتّجاه مجهول؟. المقال القادم: المكتبات في العصر الرقمي
1449
| 29 مارس 2023
إنّ البحث عن الوفاق العالمي والتقارب بين الشّعوب ليس أمرا جديدا في عالم الدبلوماسيّة والعلاقات الدوليّة، بل هو هدفٌ ناضلت من أجله أجيال من المفكرين والسياسيين ودُعاة الحوار الثقافي، وسارت على منواله المنظمات الدوليّة بنشر خطابات مختلفة ومنها «التنوّع الثقافي». وعمادُ البحث عن الوفاق بين جميع شعوب الأمم، يجعلنا ننظر إلى علاقتنا بالآخر المختلف باعتباره شرطا من شروط وجودنا لأنّ أيّ مجتمع لا يستطيع العيش دون علاقات مع المجتمعات الأخرى حتّى وإن كانت تختلف عنه في العرق واللغة والمعتقد والثقافة. فما من إنسان في هذا الوجود يستطيع العيش منفردًا، وبتعبير الشّاعر الألماني غوته:»ليس ثمّة عقاب أقسى على المرء من العيش في الجنّة بمفرده، فالمؤكّد أنّ الوجود من دون الآخرين يبدو ضربا من المستحيل». لذلك شكّلت الصّراعات بين الأمم خلال الألف سنة الماضية صورة معاكسة للطبيعة البشريّة التي وصّفها ابن خلدون بـ»الطابع المدني»، فمثلما يكون الإنسان مدنيّا بطبعه بمعنى أهليّته للتواصل مع غيره من البشر تكون المجتمعات مدنيّة في احتكامها إلى ضرورة التواصل الدّولي. وإذا كانت الثقافة مثلما أشرنا هي القوّة الفاعلة في هذا التواصل فإنّ اعتبارها قوّة ناعمة منذ عقود يسّر لقوى عظمى امتلاك أدوات الجذب والإقناع بأنماط تفكيرها وعيشها أكثر ممّا وفّرته لها القوّة الصلبة التي اعتمدت على الآلة العسكريّة. ذلك ما ترجمه الواقع الدولي منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية وإبّان دخول العالم في تجاذب قطبي بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، حيثُ اكتشف السياسيّون في تلك المرحلة أنّهم بحاجة إلى وسيلة أكثر فاعلية من طاولات المفاوضات، وأدركوا ما للثقافة من دور في التأثير على الشّعوب وقدرة على تشكيل العلاقات الدوليّة. الثقافة وزن دبلوماسي جديد: لقد فكّرت القوى العظمى كثيرًا من خلال مراكز أبحاثها ومفكّريها في كيفيّة استعادة مكانتها أو مواجهة التّحديات الجديدة دون اللّجوء إلى استخدام القوّة الصّلبة، وهو ما أفرز منذ بداية التسعينيّات نمطا جديدا من أنماط الدّبلوماسيّة الدوليّة وهو «الدبلوماسيّة الثقافيّة»، ولم يتمّ الاهتداء إلى هذا النّمط بفضل تراجع المواجهة العسكريّة بين القوى العظمى فقط، وإنّما لظهور معطيات جديدة قلبت منطق «العلاقات» و»طبيعة الصّراع». ففي عالم تشهد فيه وسائل الاتّصال ثورات عقب ثورات لم يعد من السّهل قبول منطق استقواء دولة على أخرى، فقد تقلّصت الفوارق الفكريّة والنفسيّة والاعتقاديّة بين البشر، بسبب انفتاح الشّعوب على بعضها البعض، وانتقال العالم من تاريخ الإعلام التقليدي إلى «الإعلام الرقمي» فصار العالم أشبه بقرية صغيرة. وقد ساعد هذا الامتدادُ الاتصالي في التقارب بين الشّعوب، والأهم من ذلك أنّه أعطى قوّة جديدة للثقافة. إنّنا حين نؤكّد على دور الثقافة في العلاقات الدوليّة فذلك لنشير بأنّ الدول المتقدّمة بالخصوص أدركت أهمية الصناعات الثقافيّة في مبادلاتها التجاريّة مما سمح لها بتوظيفها في دبلوماسيّتها الناعمة، ألم يقل ستيف جوبز بأنّ التزاوج بين التكنولوجيا والفنون والإنسانيّات هو ما جعل قلب آبل يُغنّي؟ ذلك أنّه اعتقد بأنّ التكنولوجيا لا تتقدّم ولا تنمو بواسطة علوم الحاسوب وإنّما من خلال تواصل تلك العلوم بالعلوم الإنسانيّة والفنون. غالبا ما تكون الثقافة مؤثّرة في صناعة الصّورة التي تحتفظ بها الدول عن بعضها البعض، وتساهم أيضا في تصحيح الانطباعات ونبذ الأفكار المسبقة والمغلوطة، لأنّ تحقيق التفاهم يتطلّب التعرّف على الحقيقة. ويزداد أثر الثقافة كلّما تمكّنت الدول من أدوات الجاذبيّة والإقناع، فتتحوّل المثل التي تنادي بها عبر دبلوماسيّتها الثقافيّة إلى أفق خلاص لبعض الشّعوب أو طموحا لبعضها الآخر. لننظر في تلك المرحلة التي عاشتها أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية حينما تمّ جذب الشباب الأوروبي الذي كان يشرئبّ إلى الموسيقى خلف جدار برلين، وكيفَ أصبحت المثل الأمريكيّة في الحرية أملاً للشباب في الصين عند حادثة تيانانمين حين بنوا نسخة من تمثال الحرية، وغيرهم من شباب العالم الذين رأوا في النمط الفكري الأمريكي خلاصًا لأوضاعهم فتبنّوا الموسيقى الأمريكيّة ونمط اللباس الأمريكي والأكلات الأمريكيّة، وفي المقابل لننظر في الأثر الذي تركته أمريكا في نفوس الشباب إثر حرب الأسابيع الأربعة في العراق عام 2003 حين كسبت الولايات المتحدة الأمريكيّة الحرب بإسقاط نظام صدّام، ولكنّ طغيان الآلة العسكريّة أثّر في تراجع صورتها وشعبيّتها في العالم، وحتّى في البلدان التي شاركت حكوماتها في الحرب. ذلك أنّ شنّ حربٍ على العراق بائتلاف صغير من الدّول، ودون غطاء واسع للشرعيّة الدوليّة، ساهم في زعزعة صورة أمريكا في العالم، فقد انتصرت الآلة العسكريّة وهزمت «المثل» الأمريكيّة، ولم يكن من اليسير على الولايات المتّحدة الأمريكيّة أن تستعيد قوّتها التأثيريّة ثقافيّا في العالم، إذ كما يقول جوزيف ناي سيكون»كسب السّلام أصعب من كسب الحرب». إنّ تبادل الأفكار والمعلومات وكافّة السلع الرمزيّة دون إكراه هو وسيلة الدبلوماسيّة الثقافيّة، وهذا التبادل يضمن بقاء تأثير أيّ دولة على دول أخرى أكثر من الهيمنة العسكريّة أو الاقتصاديّة، فلو قارنّا بين أثر غزو روما لليونان عسكريّا وغزو اليونان لروما ثقافيّا لوجدنا أنّ الحضور الروماني سريعا ما اندثر ولم يُخلّف أثرا في الشّعب اليوناني بينما دام التأثير اليوناني في المجتمع الروماني. لذلك تسعى الدّول إلى تفقّد موارد قوّتها الناعمة من فترة إلى أخرى، ونقصد بذلك أن تهتمّ أكثر بوسائل الإعلام وبالأدوات الثقافيّة والمساعدات في مجالات التعليم بالخصوص في شكل تقديم منح للراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي أو في مساعدة دول العالم على تنفيذ مشاريع تعليم الأطفال في الدول الفقيرة، فتكون للقوّة الناعمة قدرة على الجاذبيّة والتأثير في وقتٍ واحدٍ، وهو ما لا تستطيعُ القوّة الصلبة تحقيقه. وقد يذهب بعض الباحثين إلى القول بأنّ القوّة الصلبة قادرة أيضا على التأثير في الشّعوب من خلال استخدام وسائل التهديد والرشاوى وشراء الذّمم، إلاّ أنّ هذه الوسائل السيّئة لا تنجز ما ينجزه التفاعل الطوعي للشعوب مع الثقافات والأفكار وأنماط السلوك التي تبثّها الدبلوماسية الناعمة لأنّها أكثر إغراء. أين نحن من الدبلوماسيّة الثقافيّة؟: أدركت على امتداد مسيرتي الدبلوماسيّة والثقافيّة أنّ النوايا الحسنة غير كافية لتفعيل دور التبادل الثقافي إن لم تتبعها سياسة ثقافيّة لأيّ دولة من أجل إحكام قوّتها الناعمة، وكثيرًا ما عبّرت عن انشغالي بوضع صرح ثقافي عربي، ألا وهو معهد العالم العربي بباريس باعتباره أداة من أدوات الدبلوماسيّة الثقافيّة، وحزنت لما آل إليه من تراجع وضعفٍ في تحقيق الأهداف التي بُعث من أجلها. وكم أسهبتُ في تناولِ النتائج الوخيمة لمحدوديّة إيمان بعض الدول العربيّة بجدوى الثقافة في نهضة الشّعوب بالداخل وفي أثرها على تغيير صورة العرب في الخارج، ولكنّ الوضع العربي اليوم لا يساعد البتّة على خياطة قوّة ناعمة بقماشة مهترئة! إنّ السياسة الدولية سريعة التغيير، ونحن لا نعرف إلى حدّ الآن كيف سيتشكّل العالم بعد هذه الأزمات المتتالية التي مرّ بها وآخرها استمرار الحرب الروسيّة-الأوكرانيّة، ولكنّنا ندرك أنّنا مطالبون كعرب باستلهام التجارب الناجحة للقوّة الناعمة، والمضيّ في تفعيلها. ثمّة تحوّلات كبرى تستدعي النظر، فأثر الدبلوماسيّة الثقافيّة الغربيّة يتراجع قياسا بنموّ دبلوماسيّة الصين التي تعمل على إعادة صياغة «قوانين اللعبة»، ويبدو أنّ التوسّع الصيني في العالم وخاصّة أمام انحسار دور الولايات المتّحدة الأمريكيّة، يعكس بداية الاستعداد إلى انتقال قيادة النظام العالمي إلى الضفة الشرقيّة، وقد منحت السياسة الخارجيّة الصينيّة للموارد الثقافيّة والاقصاديّة دورا مركزيّا في تحقيق هذه الغاية، ومن معالم الذكاء الصيني في إدارة الخطوة الحضاريّة القادمة أنّ الصين لا تقدّم نفسها بديلاً عن الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فهي لا تدّعي إعلان التحدي مع القوّة العظمى التي تهيمن على العالم، بقدر ما تتقدّم بنعومة نحو هدفها، وقد انعكس ذلك على خطابها الذي جذب نخبا وشعوبا كثيرة في العالم، حيثُ تبنّى خطابها السياسي القول بوجود عالم متعدّد الأقطاب لا تُحتكر فيه القيادة ولا الأنماط الثقافيّة ولا تُحقّر فيه ثقافات الآخر مقابل مركزيّة الثقافة الغربيّة. لذلك تقدّم الصين نفسها باعتبارها قوّة مضافة للتطوّر في العالم وليست خطرا يهدّد السلم العالمي. إنّ هذا الدّور الصيني يُذكّرني بما لعبته الحضارة العربية الإسلاميّة في أزهى مراحلها، حين كان العرب يهبون الإنسانيّة علومهم وآدابهم، فانتعشت حركة الترجمة بين العرب وغيرهم من الشّعوب، لما تفطّن إليه العرب من أثر للتبادل الثقافي في تطوير الحضارة الإنسانيّة. وسارع الغرب في أكثر من مرحلة تاريخيّة إلى الاستفادة من التراث الفكري العربي، ذلك ما شهدته طليطلة على سبيل المثال في القرن الحادي عشر للميلاد، حين أصبحت مركزا للترجمة يقدّم للعالم الغربي ثمرات التأليف العربيّة فتأسّس فيها «معهد المترجمين الطليطليين»، فالترجمة تلعب دورا مهمّا في نماء الفنون والتقنيات وأنماط الحياة، لأنّها أشبه بجسر تعبر منه السلع الثقافيّة بشتّى أنواعها وتزيد في تمتين الصّلات بين الشّعوب حتّى يتبيّن لها أنّ الغاية من الوجود واحدة وأنّ مصيرنا مشترك. فتبادل السّلع الثقافيّة من شأنه توطيد العلاقات بين المجتمعات الإنسانيّة، وهو ما يكون سدّا منيعا أمام اهتزاز قيم المحبّة والحوار والتفاعل الحضاري. ولكنّ واقع الترجمة في العالم العربي مازال متردّيا، فمن المحتمل أنّ ترجمتنا لآداب الشّعوب الأخرى تشهد إقبالا ونسبًا مرتفعة إلاّ أنّ ترجمة آدابنا العربيّة إلى اللغات الأجنبيّة هزيلٌ جدّا، وما يزال أمامنا طريقٌ طويلٌ لإحداث تطوير لهذا المجال الذي يعدّ من أبرز أدوات صناعة صورة الثقافة العربيّة. وإذا ما أردنا تطوير آفاق هذه الدّبلوماسيّة الثقافية فإنّه لا خيار أمامنا غير فسح المجال أمام النخب الثقافيّة لتقدِّم تصورات وخططا من أجل تفعيل التبادل الثقافي وتزويد الدبلوماسية العربيّة بمنتجات التبادل الثقافي، ومن ضرورات ذلك تشريك الأكاديميين، والمؤسسات الأكاديميّة، فالعلوم التي تدرّس في الجامعات ليس غايتها الأساسيّة توفير كفاءات للمجتمع فحسب، بل تأهيل مواطنين يُمارسون قيم الحوار وتبادل الثقافات من أجل نشر التّفاهم مثلما تقوم الجامعات بتوفير منتجات علميّة لها أثرها في العالم. ولا يعني ذلك أنّ الدبلوماسيّة الثقافيّة شأن تختصّ به الأجهزة الحكوميّة فقط، بل للمثقفين والنخب والأدباء والفنانين دور مهمٌّ في تطوير أثرها وجاذبيّتها، ورغم ذلك يظلّ دور الدولة أساسيّا. لذلك كنّا في قطر واعين تمام الوعي بهذا الأمر ومارسنا الدبلوماسيّة الثقافيّة بتميّز ممّا عزّز مكانة بلدنا وتفاعله مع العالم، فكانت تجربة السّنوات الثقافيّة بين قطر وبعض دول العالم علامةً فريدة على نجاح الثقافة في بناء جسر بين الشّعوب، وتعزيز التفاهم من خلال تبادل التجارب الإبداعيّة واستكشاف التنوّع الثقافي والتفاعل الحضاري. وشاركت مختلف المؤسسات الثقافيّة في هذا الاتّجاه، لتمنح الدبلوماسيّة الثقافيّة محتوى متجدّدا في البرامج الثقافية. كما ساهمتْ مبادرات «التّعليم فوق الجميع» و»علّم طفلاً» في تعزيز الروابط الدّبلوماسيّة لما تحمله رسالة التّعليم من تنمية لثقافة السّلم، وعزّز نجاح قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من تقديم الحجّة على دور الرياضة في بثّ الرسائل الثقافيّة التي تدعم القوّة الناعمة. إنّ العالم يتغيّر من حولنا بنسقٍ سريعٍ، وإذا أردنا أن نتبوّأ المكانة التي تسمح لنا بالمساهمة الفاعلة في الحضارة البشريّة فما علينا إلاّ أن نعيد الاهتمام بدبلوماسيّتنا الثقافيّة ونتعهّد مكاسبها بالتطوير حتّى لا نقف عند نجاحات بعض ما نقوم به، دون أن نستفيد حقّا من ثمار تلك النّجاحات.
2499
| 01 مارس 2023
إنّ ما تمرّ به الإنسانيّة اليوم من تقلّبات وفترات صعبة منها ما اتّصل بالكوارث الطبيعيّة ومنها ما اتّصل بالنزاعات ولّد لدى الشّعوب رغبة في البحث عن التقارب أكثر من البحث عن الاختلاف الذي من شأنه تعميق مسافات التباعد فيما بينها، فقد شعرتُ أثناء جولتي الأوروبية الأخيرة بمدى عطش الناس لمرحلة حضاريّة يسودها الوفاق، وفي الوقت نفسه وجدتُ في الانطباعات الإيجابيّة حول نجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022 لكلّ من التقيت بهم وصادفتهم ما حرّك فيّ حماسة الكتابة من جديد حول الدور المهمّ الذي يُمكن أن تلعبه الدبلوماسيّة الثقافيّة في هذه المرحلة التاريخيّة من حياة الأمم، وتيقّنت من جديد بأنّ السياسة الدوليّة ما تزال قاصرة على تحقيق السّلم العالمي. فممّا لاشكّ فيه أنّ جميع الثقافات البشريّة مختلفة بمعنى التنوّع، باعتبار الاختلاف ظاهرة اجتماعيّة وتاريخيّة، ولكنّ تحويل هذا الاختلاف إلى ذريعةٍ لنشر خطاب الصّدام بين الثقافات، يحوّل العلاقات بين البشر إلى معاداة قائمة على أطروحات عدم التكافؤ والمساواة. لطالما ناديتُ في أغلب ما كتبتُ بضرورة الانتباه إلى ما يحدث في الثقافة العالميّة اليوم من انحسار وعجز على لعب أدوار طليعيّة تمنع ما نراه أحيانا من انغلاق بين الثقافات وتغليب لما هو سياسي ومنافع ضيقة على حساب انفتاح الثقافات البشرية على بعضها، وازددتُ قناعة بأنّ إحياء أدوار الثقافة من شأنه رأب صدوع كثيرة في العلاقات الدوليّة، ولكن هل من مجيبٍ في وقت تعجز فيه منظمات دوليّة على توفير النجاعة الكافية لخطاب «التنوّع الثقافي» والتقارب بين الشّعوب؟ وقفت من خلال تجربتي الدبلوماسيّة ومسيرتي الحياتيّة على تلك الطريق الذّهبيّة لتحقيق الوفاق العالمي، وقد وجدتُ في بيئتي الثقافيّة والسياسيّة ما يعزّز السير في الطريق. كنتُ مؤمنا وما أزالُ بأنّ الاختلافات الثقافيّة بين البشر هي نتاج طبيعي لتنوّع العوامل والظروف الموضوعيّة التي تعيشها المجتمعات، فالثقافة بما هي ظاهرة مركّبة تشمل المعارف والمعتقدات والفنون والآداب والأخلاق والقوانين والأعراف والقدرات وجميع الاستعدادات التي يكتسبها الإنسان كما عرّفها إدوارد تايلور في كتابه «الثقافة البدائيّة»، ليست مجالا للمفاضلة بين الشعوب، فخصائص ثقافة كلّ مجتمع ليست غير تنويعات لقيم مشتركة، لذلك فإنّ الوحدة الثقافيّة العميقة أمرٌ شبه يقينيّ، حيثُ يتطلّع جميع البشر إلى العيش المشترك أكثر من التطلّع إلى النزاع، ويميلون إلى البناء الحضاري أكثر من الصّدام الحضاري. الثقافة أوّلا: لماذا نصرّ في خطابنا الفكري دائمًا على الدعوة إلى الاهتمام بمكانة الثقافة؟ أليس من الأجدى الاكتفاء بدعوة السياسيين للقيام بدور الوفاق العالمي، وترك الثقافة جانبًا لتكون في معزل عن العلاقات الدوليّة؟ ينبغي أن أبيّن منذ البداية أنّ تعريفات الثقافة ليست نهائيّة، وهي تتغذّى من التجارب الاجتماعيّة للبشر في كلّ مكان، ولكلّ الشّعوب انتماء لثقافات مميّزة، لها خصوصيّتها وتأثيرها في جميع الممارسات الاجتماعية التي تسم كلّ شعب، باعتبار أنّ الثقافة تهب المجتمع هويّته الاجتماعية التي لا يقدر على الاستغناء عنها، فتكون الثقافة أشبه بالتربة التي تتوغّل فيها الجذور فتنمو وتحيا. وبما أنّ الثقافة شرط أساسي للوجود الإنساني لما توفّره من إمكانات لإبداعه في جميع المجالات، فإنّها حجر أساس العلاقات التي يقيمها الإنسان مع أبناء مجتمعه ومع المجتمعات الأخرى. ذلك يعني أنّ الثقافة تحمل في داخلها عناصر الحوار والتبادل والتواصل، وهي ليست دائرة مغلقة على نفسها، فلو كانت تتّسم بالانغلاق لما اغتنت الحضارة الإنسانيّة بروافد الإبداع الثقافي من كلّ المجتمعات أيّا كانت درجة المساهمة كمّا ونوعًا. وعندما أدعو إلى تمكين الثقافة من مكانتها الطبيعيّة في العلاقات الدوليّة، فإنّني لا أقدّمها بديلاً عن السياسة. لقد تفحّصتُ طويلاُ الجملة الأثيرة لتيري إيغلتون التي يقول فيها «إنّ الثقافة نتاج للسياسة، أكثر بكثيرٍ من كون السياسة تلك الخادمة المُطيعة للثقافة»، ومع ذلك فإنّني ما زلتُ أردّد بأنّ الثقافة لا يُمكن أن تكون بديلا عن السياسة ولكنّ السياسة لا تستطيع التخلي عن الثقافة في إدارة الأزمات وفي معالجة العلاقات الدوليّة، إنّنا نحتاج إلى معاضدة دائمة من الثقافة لأنّها تشكّل البنى العميقة للمجتمع، وحين نبحث عن توثيق العلاقات الدوليّة فإنّنا لا محالة منساقون إلى فهم خصوصيات المجتمعات، ولا يكون ذلك إلاّ بالثقافة باعتبارها جسرا وليست سورًا. إنّنا إزاء خريطة متنوّعة من الثقافات، ومنذ الحضارات القديمة، كانت الإنسانيّة منشغلة بقيمة التبادل والتعلّم والاستفادة المتبادلة، لذلك لم يكن ممكنا الحديث عن إقصاء دور ثقافة من الثقافات في بناء أيّة حضارة، فما بالك بالحضارة الجامعة التي رفدت إليها كلّ الإسهامات الإنسانيّة؟ لا مجال لأحد الادّعاء بأنّ ثقافة واحدة لها حظوة على أخرى أو تمتلك الشّرط الأساسي لبناء الحضارة الإنسانيّة، بل ينبغي لكلّ إنسان على الأرض أيّا كان جنسه أو معتقده أو لغته أن يفخر بأنّ أجداده قد ساهموا جميعا في إغناء شجرة الإنسانيّة، وهنا أستحضر مثلاً صينيّا بديعًا « إنّ تفتّح زهرة واحدة لا يعني مجيء الربيع، وتفتّح مائة زهرة يجعل الحديقة مليئة بأجواء الربيع». فلا توجد ثقافة في العالم ليس لها قيمة، ولا سبيل إلى القبول بخطاب المفاضلة، فكلّ ثقافة تسعى للمساهمة في هذه الحضارة الكونيّة، لأنّه ما من ثقافة كاملة ونهائيّة، وقد زرت بلدانا كثيرة، واطلعت على اختلاف الثقافات فيها وحرصت أن أتلقّى الثقافات المتنوعة دون تكبّر حتّى أفهم سرّ تلك الثقافات، فأستفيد منها بما يتناسب مع ثقافتي وهويّتي، وأدركت ما في جوهر هذه الثقافات من تسامح، وكلّما حافظت على ذلك الجوهر استطاعت أن تمتدّ في التاريخ وأن تفيض بالعمران. المبادلات الثقافية ليست نبتة بلا جذور: إنّ التواصل بين الثقافات أمر قديم وغير طارئ على الحضارة الإنسانيّة، وقد بيّنت في كتابي «على قدر أهل العزم» كيف تجلت المبادلات الثقافيّة على أعلى مستوى سياسي في صيغة «الهدايا»، إذ تُعدُّ الهديّة من بين هذه الأشكال التي ترجمت منذ قرون إرادة التّواصل بين الشّعوب حتّى أصبحت رمزا للتّقارب، وضربتُ مثلاً على ذلك من الفترات المضيئة في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة، فقد عدّ تبادل هارون الرّشيد الهدايا مع الملك شارلمان خير مثالٍ على درجة المبادلات الثقافيّة التي كانت تعبّر عن تقدير الدّول لثقافات بعضها البعض، وعن احترامها للمعارف الثقافيّة التي شكّلت ما يسمّى بـ«ثقافة الأشياء المشتركة»، واهتمّ العرب بدور الهدايا، فألّف القاضي الرّشيد بن الزبير في القرن الخامس الهجري كتاب «الذّخائر والتّحف» وفيه استعرض أخبار الهدايا والتّحف بين الملوك والرُّؤساء وغرائب المقتنيات، ممّا يدلّ على اتّساع الصّلات بين الشّعوب، واعتبار الهديّة أداة للتقارب. وكم ساعد «اقتصاد الهدايا» على تقارب الشّرق بالغرب، وأشاع التّسامح بين الشّعوب على اختلاف عقائدها وثقافاتها. لذلك فنحن بصدد موضوع متأصّل في حضارتنا الإنسانيّة. لقد بيّنت الدبلوماسيّة الثقافيّة في تجلياتها الأولى عبر التاريخ كيف كانت الهديّة ذاتها نوعا من أنواع التّواصل بين الأمم، ولذلك نعتبر أنّ اقتصاد الهدايا هو مجال دقيق لعب في التاريخ العربي كما في التاريخ الغربي دورا بارزا في توثيق عُرى العلاقات بين الدّول والشّعوب، ولم تكن الهديّة نوعا من التقارب بين السّلاطين والحكّام بل كانت أيضا مرآة عاكسة لذائقة الشّعوب ومدى تقدّم الأمم، وهو ما أدّى إلى التعايش بين الذّات والآخر. ولم تكن الهدايا بالضّرورة أغراضا مادية تعكس التطوّر التقني لشعب من الشّعوب وإنّما كانت كتبا نفيسة أيضا تعكس تطوّر التجربة الفكريّة والرّوحيّة لأمّة من الأمم ممّا زاد في توسيع دائرة التّعارف ونقل المعارف وأدّى إلى الإيمان بأنّ الحضارة البشريّة هي جماع مساهمات جميع الأمم. ولا أنكر أنّ ثقافات أخرى عرفت جذور الدبلوماسيّة الثقافيّة دون أن تتواضع على هذا المصطلح الذي سيكون له شأنه لاحقًا. ورغم أنّ الباحثين يربطون بين نشأة المصطلح وما حدث من تطوّر في الأوضاع السياسيّة في أوروبا في القرن التاسع عشر ، فإنّني أميلُ إلى إنصاف الحضارات السابقة بمعرفة هذا النوع من التواصل فيما بينها، والذي عكس نوعا من السياسة الثقافيّة الخارجيّة لها، ولا أستبعد أن يكون الرحالة والمستكشفون والتجار والفنانون الذين ساروا في الأرض شرقا وغربا، قد مهّدوا السبيل لتمتين العلاقات الثقافيّة بين الأمم، وكانوا أشبه بدبلوماسيين ثقافيين في العالم. لذلك فإنّ النظرة إلى الدبلوماسيّة الثقافيّة من زاوية موضوعيّة ومحايدة من شأنها أن ترفع الضّيم عن تاريخ طويل للمجتمعات الإنسانيّة غير الغربيّة في العمل على التقارب بواسطة المحتويات الثقافيّة والخيرات الرمزيّة لشعوبها. ولاشكّ فإنّ «التاريخ الدبلوماسي» للحضارات لم يكتبه التاريخ الرسمي، بل لولا كتابات الرحالة لما وقفنا على ذلك الثراء الثقافي الذي تبادلته الشّعوب فيما بينها فكان محتوى أساسيّا لما نسمّيه اليوم بالدبلوماسيّة الثقافيّة، حتّى أنّ بعضا من الكتّاب تفطّنوا إلى ظاهرة «الدبلوماسيّة غير الرسمية» وأثرها في التقارب بين الشّعوب، من ذلك ما عبّر عنه الكاتب الصيني لي تشي شونغ بوجود «السفارة الشّعبيّة من التجار والرحالة العرب»، وكانت الرحلات بين العرب والصينيين ترتكز على المبادلات التجاريّة إلاّ أنّها لم تخلُ من المبادلات الثقافيّة، ويمكن أن نقيس هذه «الحالة» الثقافيّة على سائر المجتمعات والثقافات حيثُ لم تقتصر المبادلات على «التمثيل الرسمي» فالتفاعل الثقافي بين الشّعوب يتدفّق بشكل طبيعي. إنّ ما أسعى إلى بيانه دائما هو تجنّب كلّ منظور مركزي في مقاربة التاريخ الثقافي للعالم، لذلك فإنّ ولادة «الدبلوماسيّة الثقافيّة» ليست حديثة بالمعنى الغربي، فجذور هذه الظاهرة ممتدّة في تربة الحضارات القديمة أيضا، وهو ما يؤكّد حتميّة الاعتماد على الثقافة كقوّد دافعة لأيّ علاقات بين الدّول في لحظتنا المعاصرة، وبالتالي لا يُمكن النظر إلى «الدبلوماسيّة الثقافيّة» كأداة جديدة في ساحة العلاقات الدوليّة، وإنّما هي أداة حاضرة في مختلف الأزمنة التي شهدت رغبة طبيعيّة لدى الشّعوب في التعارف فيما بينها وفي توطيد علاقاتها واللجوء إليها كسند للتفاوض في فترات الأزمات والخلافات. المقال القادم: القوة الناعمة، كيفَ يُمكن أن تغيّر العالم؟.
2280
| 22 فبراير 2023
لم يمرّ كأس العالم قطر 2022 دونَ أن يُذكّرنا بوجود اختلافات كثيرة بين اعتزازنا بقيمنا وبانتمائنا العربي الإسلامي وبين انتصار آخرين، على قلّتهم، إلى أفكار لا تقبلها ثقافات شتّى في العالم. وبدت مواقف بعض الجهات من قضايا زائفة تجعلنا نفكّر منذ المونديال وإلى الآن في ضرورة أن نقدّم للعالم هويّتنا وثقافتنا من منظورنا وليس من منظور أولئك الذين ظلّت فيهم آفات الفكر الاستعماري معمّرة في عقولهم إلى أيّامنا. لذلك كنتُ حريصا في فترة المونديال وبعده على الدّعوة إلى توثيق كلّ شيء، لأنّنا حين نوثّق فإنّما نفعل ذلك بمنظورنا للحياة وبثقافتنا الأصيلة وبرؤيتنا لعلاقتنا مع الثقافات الأخرى، بينما لو وثّق الآخرون حاضرنا فإنّهم لاشكّ سيسبغون عليه الكثير من نظرتهم وأفكارهم. وما أحوجنا إلى أن ندرك أنّ التوثيق ليس مجرّد حصر كتابي أو بصري لما حدث، وإنّما جمع كلّ الوثائق وتقديمها من زاويتنا، إذ علينا أن نعتبر من تاريخنا العربي حين كانت الوقائع تُقدَّم من زاوية الآخرين، فيُظلم أجدادنا فضلا عن ثقافتنا وحضارتنا وتُشوّه صورتنا. لننظر في ذلك التناول الذكي للروائي أمين معلوف في كتابه "الحروب الصليبيّة كما رآها العرب" حين عاد إلى وثائق الإخباريين العرب ليواجه بها ما راج من "الحقائق" عن تفاصيل مائتي سنة من الصراع بين الفرنجة والعرب المسلمين، والمدهش في السرديّة التاريخيّة التي أنشأها معلوف إشارته الأولى والمربكة إلى أنّ الإخباريين العرب لم يستخدموا مصطلح "الحروب الصليبيّة"، بل استخدموا عبارات مثل" حروب الفرنجة" أو "غزوات" ولكنّ الغرب اصطنع هذا المصطلح ليحوّل مجرى العلاقة بين العرب وبينه إلى صدام "ديني"! لذلك يبيّن معلوف غايته من الكتاب قائلاً: " الحقّ أنّ ما أردنا أن نقدّمه ليس كتاب تاريخ آخر بقدر ما هو، انطلاقا من وجهة نظر أهملت حتّى الآن، "رواية حقيقيّة" عن الحروب الصليبيّة وعن هذين القرنين المضطربين اللذين صنعا الغرب والعالم العربي ولا يزالان يحدّدان حتّى اليوم علاقاتهما." ولئن عاد معلوف إلى استخراج وثائق القُدامى لـ"تصحيح" التاريخ، فإننا اليوم لن ننتظر مرور سنوات وقرون لتتبنّى أجيالنا القادمة "تاريخنا الحاضر" برواية الآخرين، ألسنا أولى بتوثيق "روايتنا" لتاريخنا. ذلك هو الهدف الأساسي من رهان التوثيق، إنّه مطلبُ أجيال عربيّة عاشت لعقود تواجه صورة حضارتنا من زاوية الغرب. ولا أعتقد أنّ توثيق حدث تاريخي هام مثل المونديال هو شأنٌ غربيّ، ولكنّه شأنٌ يَخصّنا قبل غيرنا. إنّنا نوثّق الوقائع انطلاقا ممّا عشناهُ، وهذا المبدأ الأساسي في التوثيق هو منطلق علمي أيضا لما يسمّى في الدراسات التاريخيّة بـ"تاريخ الزمن الراهن"، حيثُ عاد المؤرّخون إلى تناول التجربة المعاصرة، بما فيها من مادّة متحرّكة وذاكرة حيّة، تقوم على مراقبة "الشّهود" لما جرى في فترة يكون فيها الماضي قريبا من الحاضر، وهو بتعبير موجز "تاريخ الماضي القريب" الذي كنّا نحن جزءا من الشهود عليه، قبل انقضائه. نقف أمام تاريخنا الراهن موقف الشّهود، حتّى لا نتلقّف الوعي به عن طريق الآخرين، لقد تأذّت حضارتنا العربيّة طويلاً من حركة الاستشراق التي وثّقت تراثنا و"حقَّقته"، فالاستشراق له استراتيجيّة معلومة، أسهب إدوارد سعيد في فضحها، حين اعتبر أنّ الغرب لا يرى نفسه غير "اليد العليا" التي لها فضل على العرب، وأنّ الحركة الاستشراقيّة مرتبطة بالنزعة الاستعمارية من ناحية وبالعنصريّة من ناحية أخرى. ورغم ذلك فإنّنا لا نستطيع أن نتجاهل الأثر الإيجابي للمستشرقين، فقد نفضوا الغبار عن مئات المخطوطات وقاموا بالضبط البيبلوغرافي للمخطوطات العربيّة وأصدروا فهارس لأبرز المخطوطات العربيّة الموجودة في خزائن المكتبات الأوروبية، ودرسوا مصادر التراث العربي فصنّفوه وحصروه ووثّقوه، ولكنّ هذه الإسهامات التي وجدنا أثرها منذ أواخر القرن الثاني عشر الميلادي جديرة بأن تراجع من منظورنا العربي، كما أنّه لا يفوتنا أنّ تلك "الجهود الاستشراقيّة" أفادت كثيرا الأهداف الدينيّة والعسكريّة والتوسّعيّة للدّول الغربيّة، لذلك نجدّد القول بخطورة التوثيق وأهدافه وفي المسالك التي تتحكّم فيه أحيانًا. وبالنظر إلى ذلك الإرث الهائل من تراث المخطوطات الذي حققه المستشرقون، علينا أن ننتبه إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي متعلّقة بمناهج التحقيق، حيثُ تأثّرت مناهجهم بما رافق نقدهم للنصوص الكلاسيكيّة اللاتينيّة القديمة، حيثُ ساد التشكيك فيها، فتمّ التعامل مع التراث العربي من نفس الزاوية، ولذلك كثرت المقاربات النقديّة له دون مراعاة لأصول التدوين لدى العرب، وقد أريق حبر كثير حول عمليات النقد والشك والتحريف لمصادر تراثيّة، وانتقل ذلك الهاجس إلى عدد من الباحثين والكتاب العرب بفعل أثر الحركة الاستشراقيّة، وبات من الضّروري التخلّص من النظرة الاستشراقيّة إلى تراثنا، بوضع منهج أصيل يُستمدُّ من معايير التدوين والتوثيق العربي. ولاشكّ فإنّ الاهتمام بالمخطوطات وحفظها هو جزء من الوعي التوثيقي، وفي هذا السياق سعت مكتبة قطر الوطنيّة إلى القيام بهذه المسؤولية التاريخيّة والمجتمعيّة، ذلك أنّها منذ تأسيسها وهي تعمل على الحفاظ على التراث العربي الإسلامي باعتباره من أهم ركائز رسالتها، وقد ساهمت مجهودات المؤمنين بهذه الرسالة في تزويد المكتبة بمخطوطات ومصادر نادرة كانت نواة أساسيّة للمجموعة التراثيّة التي اشتملت على آلاف المخطوطات العربيّة الإسلامية وانخرط ذلك المسعى في تقليد عُرف به القطريون منذ عقود حين كان حكّام قطر والميسورون يهتمون بالمخطوطات ويقتنونها، فكان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس الدولة يعتني بالمخطوطات وينفق في طباعتها لتوفيرها لطلاّب العلم في مختلف الدول العربيّة، وعلى نهجه سار ابنه الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني عندما أوقف بعض المخطوطات وكذلك الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الذي عرف بشغفه بالعلم والكتاب وأوقف كتبه في دار الكتب القطريّة وفي مكتبة قطر بالأحساء، وخلق هذا التوجّه الثقافي بيئة مناسبة للاهتمام بالمخطوطات لدى المثقفين القطريين، فتجد أغلب المكتبات الخاصّة ثريّة بالمخطوطات، وكانوا يسعون في اقتنائها والاستفادة منها، فتكون حديث مجالسهم ونواة لكثير من معارفهم. وليس من الغريب على مكتبة قطر الوطنيّة أن تحمل هذه المسؤوليّة وأن تقوم بدورها في صيانة المخطوطات بشكل حديث، فالمكتبة التراثيّة تزخرُ بأنفس المخطوطات، والوثائق والخرائط والصّور النادرة. ومن أجل توفير رصيد أكبر من المخطوطات لفائدة القراء والباحثين على السّواء أرست مكتبة قطر الوطنيّة جسرا للتواصل مع المكتبات والأرشيفات والمؤسسات العالميّة للحصول على نسخ رقميّة من الوثائق والمخطوطات، وعرضها في البوّابة الرقميّة التي تعدّ ثمرة شراكات ممتدّة ومتينة في الزّمن مع المكتبة البريطانيّة ومؤسسة قطر، وقد تضمّن مشروع الرقمنة قرابة مليون وثيقة تاريخيّة من الأرشيف البريطاني حول تاريخ المنطقة، وكم يسّرت هذه الوثائق فهمنا لمنطقة الشرق الأوسط، وهي مادّة هامّة للدراسة قد تنقل إلينا منظور الآخر، ولكن إذا كنا على وعي بثقافتنا وتاريخنا فإنّنا ندرسها من زاويتنا وبالمناهج التي تغذّي رؤيتنا ولا تجعلنا غافلين عن إدراك الحقائق فيها. وإذا علمنا أنّ الأرشيف الضّخم المعروف باسم سجلات مكتب الهند يمسح قرابة تسعة أميال من مساحة أرفف المكتبة البريطانيّة، فإنّنا ندرك ما توليه الأمم من أهمية للوثائق. إنّنا نحتاج إلى التوثيق حاجتنا إلى بناء أرشيف واسع أيضا، لأنّ الذاكرة التاريخيّة تتطلّب وجود هذا الأرشيف، فمن خلاله يستطيع الفرد كما المؤسسات تحويل الذّاكرة إلى قوّة فاعلة في الحاضر، لقد كنت ألاحظ في كلّ أسفاري مدى انتشار ثقافة التوثيق في دول العالم وخاصّة منها الدّول الغربيّة، هناك حيثُ يدرّبون الأطفال منذ صغرهم على توثيق تواريخهم الشّخصيّة من خلال ألبومات الصّور وكتابة المذكرات عن رحلاتهم، وتسجيل أبسط الأشياء اليوميّة، وقس على ذلك ما تفعله المؤسسات من أرشفة تاريخها. فعمليّة التوثيق تُسعفنا أفرادا ومجتمعات من فقدان الذاكرة، وتجعل ماضينا القريب بعد أن يُصنّف في "التراث" مادّة تنتمي إلينا بشتّى المعايير، ويصبح الأرشيف التاريخي بما يغتني به من وثائق شاهدا على كلّ الجوانب الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة وحتى السياسيّة والإداريّة، فيساهم في حفظ الذاكرة وبناء الوعي التاريخي لكلّ فئات المجتمع بما يعزّز ذاكرتهم الوطنيّة، لذلك فإنّ التوثيق هو جزء من عمل وطني لا تقلّ قيمته عن بناء وسائل التقدّم في المجتمع، فلا يُمكن للشّعوب أن تعيش دون ذاكرة. وقد حرصت خلال مسيرتي العمليّة أن تكون مؤلفاتي نوعا من التوثيق لمسيرة حياتي، إذ أنّ كلّ كتاب هو نوع من التوثيق لفترة من حياتي. فكثيرًا ما عُنيت بأدب الرّحلات لما له من قيمة توثيقيّة، واعتبرتُ حياة الإنسان أشبه برحلة، وما عليه إلاّ أن يترك أثرًا فيها فيسجّل ما يراه صالحا للتوثيق لفائدته على نفسه وعلى النّاس، واعتبرتُ أنّ سعي العرب إلى توثيق رحلاتهم أسعفنا كثيرًا من انفراد الروايات الغربيّة عن بلداننا وعن الشعوب الأخرى، فمنذ نهاية القرن التاسع الميلادي بدأت الرحلات العربيّة مع المسعودي في نقل الحقائق الجغرافيّة والتاريخيّة وأنماط عيش الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم، من خلال التجارب والمشاهدات، ومن أجلّ ما وصلنا كتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر" الذي جمع بين التاريخ والجغرافيا والسياسة، وكان القرن الثاني عشر الميلادي من أكثر القرون تسجيلاً للرحلات، فعرفنا فيه رحلة ابن جبير الأندلسي ورحلة ابن بطوطة التي سمّاها بـ"تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" وقدّم فيها صورة شاملة عن العالم الإسلامي في القرن الثامن الهجري، واستمرّت الرحلات إلى عصرنا الراهن مرورا بعصر "النهضة العربيّة"، فمن يقدر أن يتجاهل رحلة رفاعة رافع الطهطاوي التي سجّل تفاصيلها في كتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" فبيّنت ما بلغه الغرب من تقدّم في نهايات القرن التاسع عشر، وأثر ما سجّله على حركة الفكر والأدب في أجيال العرب. إنّنا لا نستطيع أن ننفي الدور الكبير الذي ساهم فيه أدب الرحلات لنقل منظورنا العربي الإسلامي للآخر ولطبيعة تفكيرنا وتلقينا للحضارة الإنسانية في فترات تاريخيّة مختلفة، ولذلك فإنّ تلك الرحلات إنّما هي وثائق صاغها العرب من زاوية تفكيرهم وانطلاقا من ثقافتهم ورؤيتهم للعالم. وقد كنتُ على وعي مبكّر بكلّ هذه الأبعاد العميقة لأدب الترحال ولأهمية التوثيق حيثما حللتُ، فقد سمحت لي مسؤوليّاتي الدبلوماسيّة حين عملت سفيرًا لبلدي في أكثر من دولة على أن أطّلع على ثقافات الشّعوب وأن أوثّق فيما كتبتُ للقضايا الكبرى التي شغلتني وشغلت الثقافة العربيّة، فكتابي "جدل المعارك والتسويات: الحرب الخليجيّة الأولى ومجلس الأمن"، هو إلى حدّ ما توثيق للموضوع الذي شغلني مع زملائي سفراء دول الخليج العربي أثناء عملي مندوبا لبلادي في الأمم المتّحدة بنيويورك حول تعامل مجلس الأمن مع الحرب الإيرانيّة العراقيّة. وفي كتابي "على قدر أهل العزم" وثّقتُ لعملي كوزير للإعلام وبعدها للثقافة والتراث والفنون، وليس أدلّ على ذلك ما عمدتُ إلى توثيقه عن فعالية "الدوحة عاصمة للثقافة العربيّة عام 2010"، ذلك الحدث الذي حوّل الدوحة إلى مركز إشعاع ثقافي عربي. كما وثّقت للحواضر الثقافيّة في العالم العربي، التي عشت فيها ومن بينها القاهرة، وبيروت، وسجلتُ ملاحظاتي عن المتاحف التي عرفتها ومنها "متحف اللوفر" و"متحف الميتروبوليتان"، و"متحف الفن الإسلامي"، و"متحف قطر الوطني"، وهي أعمال توثيقيّة رافقتها آرائي ومواقفي الفكريّة. أمّا كتابيَّ ""وظلم ذوي القُربى"، و"جسور لا أسوار" فهما توثيق دقيق لترشحي ومسيرتي نحو رئاسة اليونسكو وما واجهته من تحديات خلال هذه المسيرة، ولا شكّ فإنّ ما فيهما من معطيات توثيقيّة ستسهم في تقديم تلك التجربة من زاوية العرب وليس من زاوية "الإعلام الغربي"، فقد سارعتُ إلى توثيقها حتّى لا يمرّ الزمن عن تفاصيلها فيغمر النسيان بعضًا منها، فالحاجة إلى الذّاكرة أمر لا محيد عنهُ، وكم نحن في حاجةٍ إلى تسجيل تجاربنا الخاصّة التي لها علاقة مباشرة بالوطن وبالقضايا التي تعيشها المجتمعات العربيّة، فقد كنت أيّامها صوتا للمثقفين العرب الذين عانوا طويلا من إقصاء المتشدّقين بحقوق الإنسان وبالتنوع الثقافي وبالتساوي بين الشّعوب. واستمرّ عملي التوثيقي في كتابي"مسافر زاده الجمالُ" فسجّلت فيه ما جادت به القريحة في لحظات ملهمة وثّقتها التكنولوجيا، فاستوعب الأنستغرام النصوص القصيرة، بالإضافة إلى الصور بشأن موضوعات كثيرة منها الشخصيات التي عرفتها وصنعت جزءا من تاريخ أوطانها، وزياراتي للبلدان ولقاءاتي بمثقفيها وقادتها وكبار المسؤولين فيها، كلّ شيء موثّق بالنص والصّورة ليبقى أثرا للأجيال، وإننّي لأحثّ صانعي الأحداث على التوثيق الشّخصي لمساهماتهم لما في ذلك من نفع لمجتمعاتهم.
1002
| 31 يناير 2023
التقيتُ عقب كأس العالم 2022 بعدد كبيرٍ من الأصدقاء من دولٍ مختلفة ومن اتّجاهات فكريّة شتّى، وكلّهم يُجمعون على أنّ ما عاشوه أثناء المونديال هو نوع من الحلم، الذي لا يقبلُ التصديق لولا أنّهم كانوا متابعين لمجريات هذا الحدث التاريخي الذي نجحت في تنظيمه دولة قطر باقتدار وباعتراف عالمي. وبقدر ما كنتُ أُسَرُّ بهذا الانطباع العام الذي يترجمُ الدهشة المتواصلة والإعجاب اللامتناهي، فإنّني كنتُ أقلقُ من ربط هذا الحدث الواقعي بهالة ما هو خيالي من شدّة الرّوعة والرفعة التي سارت عليها تفاصيل المونديال، لأنّ هذه الصّورة التي ظلت في الأذهان ينبغي أن لا تستقرّ فقط في الجانبِ العجائبي من الذاكرة وإنّما ينبغي لها أن تستقرّ في العقل وأن يشملها التوثيق كي لا تتحوّل مع الزمن إلى حكاية حالمة أو أسطورةٍ تتناقلها الأجيال فحسب. إنّ ما حدث في المونديال هو أمرٌ جليلٌ، فقد نحج البلد الصّغير العربي المسلم في كسب التحدي العالمي، وإنّنا ما نزال إلى اليوم مأخوذين بهذا الإعجاز، ورغم حلاوة التذكر واستعادة كلّ اللحظات والمشاهدات والمباريات والأحداث الرائعة عن الحوار الإنساني المتجاوز للرياضة إلى أبعاد قيميّة واسعة يسودها الاحترام وتبادل الثقافات، فإنّ ما نحتاجه اليوم، ولأجل استثمار كلّ تلك المكتسبات، هو توثيق كلّ مجريات كأس العالم بجوانبها الرياضيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، حتّى تكون "مدوّنة كأس العالم" منبعا للاعتبار للأجيال وتجربة وطنيّة وعربيّة وعالميّة يمكن الاستفادة منها في مستقبل العلاقات الدوليّة. الأمم تفكّر في ذاكرتها لا يُمكن للأمم أن تحفظ ذاكرتها دون أن تفكّر في تاريخها، ولا يصنع هذا التاريخ خارج عمليات التوثيق المختلفة، فمنذ القديم سارعت الحضارات إلى الاهتمام بتسجيل حياتها ووقائع مسيرتها في السّلم والحرب، في البناء والمحن. بل إنّ المجموعات البشريّة قبل بداية التاريخ فكّرت في توثيق حياتها، فلم يكن للإنسانيّة أن تعرف شيئا عن حياة الشّعوب البدائيّة لو لم ينتبه الإنسان البدائي إلى ضرورة توثيق ممارساته الدينية والاجتماعيّة، ماذا لو لم يرسم إنسان الكهوف تلك الرسوم الكهفيّة البديعة لمظاهر الحياة في مرحلة ما قبل التاريخ؟ إنّنا نرى في كهف لاسكو الواقع في محافظة دوردونيه الرسوم والنقوش الأقدم في العالم، رسوم في "قاعة الثيران الكبيرة" ونقوش للحيوانات وخريطة لـ "سماء الليل" تترجم اهتمام إنسان ما قبل التاريخ بعلم الفلك والكواكب والنّجوم، واستطاع المصريّون القدامى بعد اكتشافهم لورق البردي تبادل الوثائق فيما بينهم والأمم الأخرى، كما سمح اكتشاف الكتابة المسماريّة لدى السومريين من تدشين التاريخ وتيسير التوثيق، وبدأت الإنسانيّة تقطع مرحلة جديدة من حياتها عند الشّروع في التوثيق المكتوب بعد أن استغرقت زمنا طويلاً في التوثيق البصري من خلال الجداريات والرسوم في الكهوف والمعابد والقصور، ولم يكن ذلك التاريخ المكتوب في أوّل بدايات غير ترجمة لـ "الوثائق الشّفاهيّة"، فالناظر في تواريخ هيرودوت يجد أنّه استقى معلوماته ممّا جمعه من الألسن، فقد قضى حياته مسافرا عبر آسيا الصّغرى ومناطق الشّام وفلسطين ومصر وهو يلتقي بالناس فيجمع من أفواههم الأخبار والقصص وينظر في الأطلال والخرائب فيستقي من مشاهداته بعضا من الاستنتاجات، وفي روايته للوقائع التي حدثت قبله بقرون دليل على أنّه تلقّف الأخبار ممّا يتناقله الناس من معاصريه، فتداخلت الحقائق بالترهات فيما روى، واستطاع المؤرّخون الإغريق والرّومان من بعده أن يقلّصوا من سطوة المشافهة فيسجّلوا ما عاشوه من أحداث، من ذلك ما قام به المؤرّخ ثيوديد عند توثيقه لحرب البلوبونيز، فغطّى أحداثها على امتداد سبع وعشرين سنة، وكان يتنقل من قرية إلى أخرى لجمع المعلومات عن الحرب ومقارعتها حتّى يدقّقها في كتابته. كان الأوروبيون على وعي بأهمية الوثيقة، وقد اشتقّت كلمة Document من الأصل اللاتيني Docere وتعني "يعلم"، وظلّت في معناها الضيق تفيد أوراق الدّولة الرسميّة من قوانين وتشريعات ومعاهدات مع الدّول ومعاملات فيما بين الدّوائر الرسميّة. ولئن دلّ المصطلح العربي على معنى إحكام الأمر وتثبيته، فإنّه يتماهى مع الاصطلاح الغربي في القولِ إنّ التوثيق هو تسجيلٌ للمعلومات والوقائع، ولا يُمكن لأمّة أن تُمرّر ثروتها الرمزية إلى الأجيال من غير استخدامه، فالتوثيق أداة التعامل في الحاضر وضمان التواصل في المستقبل، لذلك انتبه المؤرّخون الغربيّون إلى أهميته في العصور الوسطى، وبقدر ما اعتمدوا على الوثائق الشفاهيّة وما هو متواتر على الألسن، فإنّهم فكّروا في أداة أكثر تطورا توثّق كل ما يكتبون ويتبادلون من معلومات، فكان اختراع يوحنا غوتنبرغ للمطبعة في القرن الخامس عشر للميلاد حدثا مهما في تاريخ البشريّة لتساعد المطبعة في أعمال التوثيق. ولم يكن الفكر اليوناني الروماني وحده هو الذي اهتدى إلى أهمية التوثيق، فمنذ القديم عرف العرب ذلك البحث عن توثيق معاشهم فغلب على الحياة العربيّة في فترة طويلة التوثيق الشفهي بفعل التناقل، فكان التعويل على الحفظ، وكان الشّعر قبل الإسلام يُحفظ عن طريق الرواة، فسجّل العرب أيّامهم في ديوان أشعارهم، وتناقلوا أخبارهم عبر المشافهة، فعرف العرب القصّاص وهم فئة اضطلعت برواية أخبار القبائل وغزواتها ومآثرها الاجتماعيّة ومعتقداتها، وإثر ظهور الإسلام ازدادت العناية بالتوثيق، ومن ذلك التوثيق الشفوي والكتابي للقرآن الكريم، فظهر "كتّاب الوحي"، وبعد تناقُص عدد حفّاظ القرآن الكريم بدت الحاجة ماسّة إلى عمليّة الجمع، فكان جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه لحظة مؤسسة لتدشين التّدوين، وظهرت علوم تتّصل بضبط التوثيق للسنة النبويّة، ومنها علم الرّجال، وعلم الأسانيد، وعلوم مصطلح الحديث، وكان عصر التدوين العربي إيذانَا بمرحلة جديدة في الثقافة العربيّة، فالتدوين بما هو توثيق ليس مجرّد تسجيل لحركة الفكر، إنّه انتقال إلى مرحلة جديدة في الإبداع العربي. وزخر تراثنا العربي الإسلامي بمبادرات الكتّاب الذين أدركوا بحسّهم الفكري قيمة التوثيق، وكلّما عدتُ إلى كتاب "الفهرست" لابن النّديم، إلاّ وشعرتُ بذلك الوعي التوثيقي الذي لازم صاحبه، فابن النّديم وراق وتاجر كتب عاش في بغداد في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، لهُ فضل كبيرٌ على الثقافة العربيّة من خلال ما وثّقه في كتابه من الكنوز الأدبيّة التي لم يسلم أغلبها من تصاريف الدّهر، ولما تضمّنه من معلومات عن نشأة العلوم بتقديم تراجم علماء كلّ فنّ، فعُدّ الكتاب موسوعةً علميّة لا يمكن لأيّ باحث في التراث العربي تجاهله. وقد عمل الكتّاب العرب على توثيق نتائج أبحاثهم في شتّى العلوم، فازدهرت صناعة المخطوطات طيلة قرون، ولولاها لما استطاع الغرب أن يخرج من ظلمات قرونه الوسطى، إذ شكّلت المخطوطات العربيّة التي ترجمت إلى اللغات الغربيّة أساسا لنهضة علميّة وفكريّة واسعة النطاق في أوروبا. وفي تاريخنا العربي شواهد كثيرَةٌ على أثر الأعمال التوثيقيّة التي حرص المثقفون العرب القدامى على القيام بها خاصّة في فترات جزر الثقافة العربيّة ومحاولة طمس كنوزها وآثار رموزها، ونستذكر عمليات حرق كتب ابن رشد في زمن الخليفة المنصور في القرن الثاني عشر الميلادي، فلو لم يسع تلاميذه إلى نسخها قبل حرقها لما وصلنا شيء من علم ابن رشد ولما انتفع الغرب بأفكاره الفلسفيّة، فالوعي بالتوثيق أنقذ التراث العربي في أكثر من مناسبة من التلاشي وحفظ ذاكرة الحضارة العربيّة في أكثر من مجالٍ. الوعي التوثيقي في ملحمة المونديال لا شكّ أنّ التوثيق لا يقتصر على عمل المؤسسات، فهو يبدأ بعمل الأفراد وحرصهم على توثيق وتثبيت اللّحظات والفترات والوقائع التي يعيشونها في حياتهم الخاصّة أو يشهدونها في حياة مجتمعهم، ويتّخذ وسائل مختلفة منها المكتوب ومنها البصري، وقد ساعدت الوسائط الرقميّة في الإحاطة بكلّ ظواهر المعاش الإنساني، حتّى صار كلّ فرد يمتلك هاتفا خلويّا بمثابة موثّق. وقد رأينا كثيرًا من عمليّات التّوثيق الفرديّة التي دأب أصحابها على تسجيل الأحداث في فترة كأس العالم قطر2022، وهو أمر مفيدٌ ولكنّه يحتاج إلى مجهودات المؤسسات ليكون التوثيق أشمل وأبقى. وما لفت انتباهي وسررت به تلك الخطوات الذّكيّة التي قامت بها بعض المؤسسات القطريّة في سياق الإعداد لمونديال قطر بهدف توثيق هذا الحدث الجليل، فكما هو متعارفٌ عليه فإنّ الوثائق المعاصرة ليست مجرّد مادة مكتوبة، فمثلما كان التوثيق في العصور السابقة متعدّد الوسائط، فإنّ مجتمعنا الحديث عرف أيضا قيمة أنواع من التوثيق سريعة التداول بين الناس ومنها العملات والطّوابع البريديّة. لذلك قام المصرف المركزي القطري بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار العملات التذكاريّة بمناسبة استضافة قطر لكأس العالم2022، ومنها ورقة نقديّة تذكاريّة مضمونة القيمة، تمّ فيها استخدام مادّة "البوليمر" لحفظها لمئات السنين، وأصدر المصرف أيضا عملات معدنيّة تتضمّن صور أهم ملاعب بطولة كأس العالم، ومنها ملعب البيت، وملعب لوسيل، وملعب الثمامة وملعب خليفة الدّولي، وساهمت هذه العملات التذكاريّة في توثيق وتخليد الحدث التاريخي لا في قطر فحسب وإنما في الوطن العربي. إنّ ما توفّره هذه العملات من مادة تاريخيّة للأجيال القادمة لأمر في غاية الأهمية، فقد مثّلت العملات منذ القديم مادّة تاريخيّة قيّمة في المشرق والمغرب، فلو لم تكن العملة اليونانيّة لما كنّا نعرف الكثير عن تاريخ الكيانات السياسيّة في ذلك العصر، وقس على ذلك على بدايات سكّ العملة في التاريخ الإسلامي، فقد عكست تلاقح المسلمين بثقافات غيرهم من الأمم، فيُذكر أنّ أوّل نقد إسلامي ضُرب في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة 18 هـ، وإن تمّ أخذ نقش الكسرويّة عن الدراهم فإنّ المسلمين زادوا عليها كلمات "الحمد للّه" وفي بعضها "محمّد رسول اللّه" وفي بعضها "لا إله إلاّ اللّه"، وإن كانت المسكوكات من ضرب الأعاجم قبل المسلمين، فقد استفاد المسلمون منهم، ووثّقوا بدايات حضارتهم على تلك العملات واستمرّ ضرب المسكوكات في عصور متقدّمة من التاريخ الإسلامي، لتصبح المسكوكات من المصادر الوثائقيّة التاريخيّة الموثوقة، لما تتضمّنه من معلومات وأحداث توثّق المراحل السّياسية والمنعرجات الاقتصاديّة وتعكس المهارة الفنّية لدى المجتمعات. ولا محالة فإنّ ما تعكسه المسكوكات متشبّع بالتاريخ الرسمي للمجتمعات، ولكنّ ما يتضمّنه من معلومات لا غنى عنه لبناء فهم واضح لمنعطفات التاريخ الإسلامي، وقد عُدْتُ أكثر من مرّة للاطلاع على كتابٍ قيّم عني بهذا الموضوع ويعود إلى الأب "إنستاس الكرملي" وعنوانه "النقود العربيّة وعلم النميات"، حيثُ يتعرّض فيه إلى ما دوّنه الأدباء والمؤرّخون العرب المسلمون عن النقود، إلاّ أنّي كنتُ أبحثُ دائما عن تعميق تلك البحوث بدراسة الجوانب الحضاريّة للنقود أكثر من الاكتفاء بالعرض ووضع فهارس تشمل مسميات النقود ومصطلحاتها. استطاعت النقود أن تكون وسيلة لتيسير المعاملات الاقتصاديّة، وأن تحمل رموز السيادة في كلّ حقب التاريخ وأن تعلن عن تدشين عصر ونهاية عصر آخر، وأفول حضارة وصعود أخرى، وهذا يدلّ على أنّ المسكوكات من الوثائق التي لا يستغني باحث في التاريخ عن دراستها، وإذا ما سارع المصرف المركزي بدولة قطر إلى تخصيص عملات لحدث المونديال فلمعرفته العميقة بالخدمة الجليلة التي يقدّمها للباحثين في المستقبل، وبقدر ما يبتهج الناس بالحصول على هذه العملات التذكاريّة فيجمعها الأفراد كما المؤسسات فإنّ الوعي التوثيقيّ بقيمة تسجيل الحدث على العملات يجعلنا نخلّدُ الإنجازات البطوليّة لجيل المونديال. ولم يتوقّف هذا الوعي التوثيقي لدى المؤسسات القطريّة عند هذا الحدّ بل انتشر في العديد منها، ولعلّ ما أقدم عليه بريد قطر، يعدّ نموذجا آخر من ترجمة هذا الوعي، فقد تمّ في سياق بطولة كأس العالم 2022 تدشين إصدارات لطوابع بريديّة، ومنها طابع سلّط الضّوء على إرث دولة قطر في مجال رياضة كرة القدم، وإطلاق طابع البريد الرسمي للبطولة الذي جاء في شكل خارطة لدولة قطر ويحمل الشعار الرسمي للبطولة، إضافة إلى طوابع تعرّف بملاعب كأس العالم، ومجموعة طوابع التعويذة الرسميّة لكأس العالم، ولم يسعد بهذه الإصدارات هواة جمع الطوابع البريديّة فحسب بل سُرّ بها كلّ باحث يُدرك أهمية التوثيق لمثل هذه الأحداث الكبرى، فكلّما تمّ تداول هذه الطوابع انتشرت في أنحاء العالم "الوثيقة" المعبّرة عن استمرار خلود الحدث رغم انقضائه، ولذلك تكون مزية هذا النوع من التوثيق اتّساع المدى الزمني للحفر في الذاكرة الإنسانيّة مما يُجنّبه المحو على مرّ الأزمان.
1011
| 24 يناير 2023
ماذا بعد المونديال؟ لم يكن هذا السؤال البديهي حاضرا بقوة قبل سنوات وحتى أيام قليلة من إطلاق صافرة نهاية المباراة الأخيرة. لم نفكّر كثيرًا فيما بعد نجاح قطر في تنظيم نسخة استثنائية لكأس العالم 2022، كنا نعلم مثلاً مصير تلك الملاعب الأيقونات التي شدت أنظار المليارات وعشقها المشجعون واللاعبون الخاسرون والرابحون، فملعب 974 صمّم منذ البداية ليفكَّك بالكامل، وسيقدَّم للدول التي تحتاج ملاعبها للمقاعد في إطار تنميتها، وأمَّا الملاعب الأخرى فستُفكَّك الآلاف من مقاعدها لتُخفَّض طاقتها الاستيعابية بما يكفي احتياجات الرياضة في قطر، ولتوفير جزء من البنية التحتية الرياضية للدول النامية، بالإضافة إلى أن بعض الملاعب ستشهد تغييرات إضافية، فملعب لوسيل سيُحوَّل إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر ومقاهي وعيادات طبية، بينما سيضم ملعب الثمامة فرعا آخر لمستشفى «سبيتار» وفي مكان المدرجات العليا سيبنى فندق صغير، وبعد أن تُخفَّض الطاقة الاستيعابية لملعب المدينة التعليمية سيكون وجهة رياضية وترفيهية، هكذا يكون مصيرُ الملاعب التي شهدت أروع المباريات وصولات نجوم كرة القدم وأهازيج المشجعين وآمالهم، وإذا كنا نعلمُ ما ستؤول إليه هذه المعالم التي تحوَّلت إلى جزء من الذاكرة الرياضية العالمية، فإننا نُمعن النظر في مكاسب المونديال الأخرى. إنني لا أنكر ذلك الشعور الغريب الذي أحسست به كلَّما كنَّا نقترب من نهاية المونديال، فرقٌ تخسر فتغادر قطر ويُغادر عقبها أغلب مشجّعيها وفرقٌ تنتصر لتظلّ إلى آخر مباراةٍ، ومع كلّ موجة مغادرين تنتابني قشعريرة وداعٍ. حقّا، لقد ألِفت مثلما ألِف القطريون والمقيمون على أرض قطر ذلك الوئام بيننا وبين مرتادي كأس العالم، خلال شهر كامل نمَت بين الجميع صلات نفسية وثقافية راقية، لم تكن الأعلام المميزة لمنتخبات الدول المشاركة تمنعُ ذلك التواصل الخلاَّق بين الجميع، ولم تمنع الاختلافات الثقافية من تواجد الجميع على أرضية الاحترام والتقارب. لقد أفقنا جميعا بُعيْد ساعات من نهاية كأس العالم بشعور من يودِّع أحبابهُ من الأسرة الإنسانية الواسعة، بعد أن نلنا تجربة مُثلى في العيش المشترك، فقد مرَّ كأس العالم دون ذلك الشَّغَب الذي اعتدنا مشاهدته في نسخ أخرى منه في بلدان أخرى، لا عراك في الشوارع ولا مضايقات للنساء في المدرجات أو في أي مكان، ولا كلام فاحش أو سباب بين المشجعين المتنافسين، مرّ كلّ شيء بسلاسة وسلامٍ، كأنّه حلمٌ. وليس المهمّ أنّ تنظيم كأس العالم في قطر سفَّه أقوال المناوئين لهُ، ولكنَّ المهم هو ذلك الرصيد الرمزي من التجربة الاجتماعية التي استفاد منها المجتمع القطريّ أولا وقدّمت للعالم صورةً مختلفة عن الرياضة لجميع أبناء المعمورة. لقد كان الشعور بالأمان لدى كلّ مشجّع دافعا للتعرّف على ثراء المجتمع القطري وثقافته العربية الإسلامية، فقد رأى العالم كيفَ تفاعلت جماهير المشجّعين مع العلامات الثقافية القطرية من لباس وأكل ولهجة وعادات وتقاليد، بل إنني أكاد أجزم بأن هذه التجربة النفسية والفكرية التي عاشها المشجعون ستقلب الكثير من الأفكار في المستقبل عن الشّرق الأوسط وعن العرب المسلمين تخصيصًا، وسيستيقظ العديدون على خداع الأباطيل الإعلاميّة التي حاولت التشويش على سير المونديال، بذلك تسقط أقنعة الإعلام أمام انكشاف الحقائق، فلا يُمكن استبلاه العالم وشهود العيان من كلّ مكان أقروا بمتعة نجاح التجربة القطرية في تنظيم الكأس. لا أخفي على أحد أنني كنتُ أتابع خلال فترة كأس العالم، المباريات في الملاعب، ومباريات أخرى تقع خارجها بين المشجعين والقطريين والمقيمين هدفها الأساسي هو التنافس في إبداء المودَّة الإنسانية وتحقيق التقارب الثقافي وكأنه خيار الشعوب منذ القديم، أو هو قدرٌ في الجينات البشرية، ولأقل إنه من فطرة الله التي فطر عليها عباده ليتعارفوا. هكذا كسبنا التجربة المجتمعية التي سيكون لها تبعات إيجابية على المجتمع الآن وغدا، وستسم تكوين الأجيال القطرية والعربية على السواء وتهبها الأمل والتفاؤل في مستقبل أفضل، إنّني أذكر قول نيلسون مانديلا: «يمكن للرياضة أن تُحقّق الأمل حيثُ كان هناك يأس فقط»، ولا أحد ينكرُ أن اليأس كاد يلتهم الشّعوب العربيّة في إمكانية استئناف «اللعب» الحضاري والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانيّة، فقد أعادت هذه النسخة من كأس العالم الأمل من جديد في قدرة العرب على مجاراة نسق الحضارة، ولأكن أكثر جرأة في القول بأنّ هذا النجاح المستفزّ لكلّ العنصريين في العالم، مكَّن العرب والمسلمين من التخلي عن تلك الصورة التي كست تفكيرهم بشأن دورهم في العالم، وهي صورة استشراقية تعمَّد الغرب الاستعماري تصويرها لنا وإرغامنا على الاقتناع بأنها «حقيقتنا»، ولكن بئس ما كانوا يفعلون! دبلوماسية رياضية مُبهرة أكدنا في أكثر من مناسبة على عناية دولة قطر بالدبلوماسيّة الرياضيّة منذ سنوات، وأبرزنا أهمية ذلك في نطاق الدبلوماسيّة التقليديّة ومكانتها في الدبلوماسيّة الثقافيّة عموما، لإيماننا بأنّ هذه الوسائل لها نجاعة خاصّة في تأهيل الدول للعب أدوار كبرى في العالم، وإذا كان كأس العالم لكرة القدم هو المرآة الأكثر انعكاسًا لتجربة الدّول في الدبلوماسيّة الرياضيّة، فإنّ قطر سجّلت بنجاحها في التنظيم هدفًا في مرمى التقدّم. ليست الرياضة قطاعا هامشيّا أو رهينة مناسبات، بل هي في رؤية دولة قطر مجالٌ أساسيّ في نمط العيش قبل أن تكون مجالَ تأثير في العلاقات الدوليّة، فالمجتمع الآمن الذي أُعجب به العالم هو وليد تلك النظرة للرياضة المجتمعيّة، حيثُ أصبحت الرياضة في قطر شعارا للتعاون وليس شعارا للتنافس. لقد ظلّ العرب بعيدين عن لعب الأدوار الكبرى في الرياضة، لذلك لم تكن لديهم دبلوماسيّة رياضيّة مؤثّرة، علاوة على ضعف الدبلوماسيّة الثقافيّة، ولعلّ الدرس القطري يفتح باب التفكير من جديد في هذه الوسيلة، خاصّة بعدما أيقنت الشّعوب قبل الدّول بأنّ مكاسبها لا تُعدُّ، فقد اعتدنا أن نُرجع قوّة الدول العظمى إلى ما هو عسكري أو اقتصادي متناسين ما توليه من أهمية للقوّة الناعمة، إنّني ما زلت أذكر أحداثًا لعبت فيها الدبلوماسيّة الرياضيّة ما لم تقم به الدبلوماسيّة السياسيّة من دور في إحلال السّلام أو التقارب بين الشّعوب أو الخروج من الأزمات السياسيّة الدوليّة، ففي عام 2002 غرقت ساحل العاج في حرب أهليّة، وحين تأهّل منتخبها إلى كأس العالم لكرة القدم عام 2006 استغلّ الحدث لإطلاق نداء للسّلام، وناشد قائد الفريق ديدييه دروغبا، وكان لاعبا محترفا في صفوف نادي تشيلسي اللندني، أن يسود السّلام أبناء شعبه، قائلا: «يا رجال ونساء ساحل العاج، في الشمال والجنوب والوسط والغرب، أثبتنا اليوم أن بإمكان العاجيين أن يتعايشوا في سبيل هدف مشترك ألا وهو التأهل لكأس العالم، لقد تعاهدنا أن الاحتفال سيوحّد الناس. اليوم، نتوسّل إليكم ونحن جاثون على ركابنا، مقابل السّماح والعفو والصّفح»، ولا شكّ أنّ كلمات «دروغبا» ليست عصا سحريّة لتغيير الأوضاع في بلد نهشته الصّراعات الدمويّة، ولكنها عبّرت عن الضّمير الحيّ في الشّعب الإيفواري، ولا أحد يُنكر ما لذلك النّداء من أثرٍ في تحقيق ما فشل في تحقيقه السياسيّون الأفارقة آنذاك. لنتمعَّن في المكسب الكبير الذي حققته القضيّة الفلسطينية من جديد بفضل كأس العالم، لقد نجحت الرياضة في تذكير الرأي العالمي بعدالة القضيّة الفلسطينيّة كقضيّة إنسانيّة بشكل مبهر، فالرياضة كلّما أخلصت للمبادئ التي نهضت عليها فإنّها تكون وفيّة لكلّ قضيّة إنسانيّة، فكان رفع الراية الفلسطينيّة من قبل المشجّعين بمختلف جنسياتهم دليلاً على حضور فلسطين في الضّمائر الحية في العالم، فرفرف العلم الفلسطيني جنب الأعلام الأخرى في علامة رمزيّة لتوافق إنساني على أنّ الرياضة ليست «أفيونًا» يُلهي الشعوب عن قضايا البشر، وهذه رسالةٌ عميقة من رسائل كأس العالم قطر 2022. كأس العالم ليس التحدي الأخير نظر القطريون إلى كأس العالم باعتباره تحديا عندما أعلن الفوز بملفّ الترشّح منذ 2010، إذ تندرج استضافة المونديال في «وسم» الدولة وصورتها في العالم، فقد أخذت السياسة الخارجية القطرية الحكيمة في لعب دورٍ كبير خلال السنوات الأخيرة في جهود الوساطة المتعددة في ملفات سياسية ساخنة وشائكة من قبيل اتفاق السودان ولبنان 2008، وأفغانستان 2022، والتشاد 2022، وقد منح نجاحها كوسيط دولي في إظهار صورتها كدولة تؤمن بالسلام الدولي وتحث الأمم على تحقيقه، وليست الرياضة غير جزء من هذا الاتجاه الإستراتيجي العام لدولة قطر. ومما زاد في توسيع انتشار صورة قطر دون شك في نسخة هذه الكأس هو التطور التكنولوجي الكبير لوسائل الاتصال، حيثُ نجحت قطر في توظيف هذه الوسائل لتقديم أفضل صورة عن المونديال أوَّلا ولتقديم ثقافتها ثانيًا، فقد تناقلت جميع الوسائط الإعلامية التقليدية والجديدة وبكلّ لغات العالم ما يحدث من حلقات «المعجزة القطرية» التي سطرها القطريون فأعادت الثقة للعرب في إمكانياتهم وقدراتهم، وعاشها المتطوعون الذين قُدِّر عددهم بعشرين ألف متطوع، عن قرب وهم سيكونون سفراء للثقافة العربية. لقد استطاعت قطر أن تقدِّم الثقافة العربية خير تقديم بإنقاذها من النمطية المجحفة التي كرَّسها الغرب في إعلامه وأفلامه السينمائية، ويبدو أنّ ما حدث سيعطِّل لوقت طويل الآلة الجهنمية لفبركة الصورة الزائفة عن العرب، ولكن ينبغي استثمار هذه المكتسبات، فهي بذرة طيبة لوجهة جديدة، تحتاج إلى رعاية حتى تنمو وتتطور، فقد صار بالإمكان إيقاف تلك الآلة عن إفراز الأباطيل حول صورتنا، ليكون كأس العالم هو المرآة الحقيقية التي نرى من خلالها صورتنا، إذ نحتاج إلى نجاحات وطعم للانتصارات بعد قرون من التراخي الحضاري، وكل هذه النتائج المبهرة يمكن أن تتلاشى أو أن تدخل «متحف التاريخ» إن لم تتبعها جهود تبني على الإنجازات، فالنجاح الكبير الذي يشهد به القاصي والداني بقدر ما هو مصدر سرور وفرح فإنه يعني مزيدا من تحمُّل المسؤولية على الناجح لاستمرار النجاح واستثماره. لقد توفَّرت لبلدنا الرؤية والشجاعة لتحدي طلب استضافة المونديال، ثم تطلَّب ذلك العمل ليل نهار لبلوغ قمة النجاح المبهر، فمررنا جميعًا بتجربة ثرية بالتحديات، وقد أصبح لدولة قطر التي تميَّزت قيادتها الحكيمة بالوضوح والصبر، خبرة كبيرة لتدرك ثمن النجاح وتعرف أعداء النجاح أيضا، لذلك فإن المسيرة مستمرة للمحافظة على النجاح والانتقال إلى مراحل أخرى لمزيد كسب النجاحات، وهذا يتطلَّب خطة متكاملة واضحة المعالم للتعامل مع النجاح واستمرار تحصيله في المراحل القادمة، وشعار اليوم الوطني هذا العام منطلق وقاعدة ذهبية لاستمرار هذا النجاح (وحدتنا مصدر قوتنا). ماذا بعد المونديال؟ مسيرة النجاح والتحديات مستمرة
1653
| 25 ديسمبر 2022
فرض كأس العالم علينا جميعًا إيقاعا خاصّا في حياتنا اليوميّة، نستيقظ لننام على وقع المباريات وما يحدثُ في محيط الملاعب وفي الشّوارع والأسواق من حركيّة ونشاط للمشجّعين، حقّا غيّر مونديال قطر عاداتي الشّخصيّة، لم يكن صائبا القول بأنّ كأس العالم مجرّد فُرجة أو منافسات رياضيّة ترفع حميّة المشجّعين أو مجرّد محرّك لاقتصاديّات مختلفة، لأنّ في هذه اللعبة ما يُغيّر حقّا الأفراد والمجتمعات. ربّما لم نكن ندرك ذلك طيلة عقود من متابعتنا لهذا الحدث ونحن أمام جهاز التلفزيون، لا نتعامل معه إلاّ كصورة مرئيّة تحرّك مخيالنا ومتعتنا، بينما اختلف الأمر ونحن نعيش في داخل الحدث وعلى مقربة ممّا يثيره من تفاصيل وكواليس وظواهر. بدا الأمر مختلفًا، بل هو إدراك آخر شبيه بنوع من التورّط وجدانيا وذهنيّا فيما يحدث لا في الملاعب وإنّما وحتّى خارجها في الشّوارع والأماكن العامة والمراكز التجاريّة والأسواق ووسائل النقل، وحتّى في الفضاءات الافتراضيّة التي يتيحها عصرنا الرقمي من جدران الفايسبوك وتغريدات تويتر وعوالم إنستغرام وغيرها من تطبيقات. هل يستطيع أحد اليوم في قطر أن يقول بأنّ المونديال مرَّ من هنا دونَ أن يثير فيه شيئا ما أو يحرّك فيه فكرة أو يدفعه لفعل شيء نبيل والعالم في ضيافته؟ لقد اتّسعت دائرة المبادرات الثقافيّة والمجتمعيّة لتكون هذه النسخة من المونديال استثنائيّة حقّا. سارعت المؤسسات الثقافيّة إلى تأثيث برامج وفعاليّات متنوّعة لفائدة المشجّعين، صارت الدوحة خليّة نحل حقيقيّة لا تهدأ، وفي كلّ يوم أتابعُ فيه المستجدّات، ينتابني الشّعور بأنّ كأس العالم تحوّل إلى حدث ثقافي، ومن بينِ ما استحسنته إقدام بعض المؤسسات الإعلاميّة على توثيق الفعاليات، وتقديم مقاربات عميقة لها، ذلك ما وقفت عليه في كتاب مهمّ للغاية أصدرته مؤسسة "العربي الجديد" تحت عنوان "سحر كرة القدم، أدباء من الشرق والغرب يحكون عن الشّغف باللعبة الأكثر بهجة"، وقد أعدّه وحرّره الأستاذ معن البياري، وضمّ الكتاب حقّا تجارب الكتّاب في علاقتهم بكرة القدم، ووجدتُ فيه بوحًا واعترافات مهمة لمبدعين من كلّ القارات حول منزلة كرة القدم في حياتهم، بعضهم تورّط في اللعبة، وبعضهم ظلّ متابعا لها ومشجّعا، والطريفُ في كلّ تلك الشّهادات اشتراكها في الإقرار بـ "السحر" الذي تمارسه الرياضة الأكثر شعبيّة في العالم، من ذلك ما ذكره الشاعر اليوناني ديمتريس أنجيلس "تكون كرة القدم تعبيرا عن شغف مازال يُوحّدنا أو يفرّقنا. بمعنى آخر، إنّها تثيرنا، تسحرنا، وتجعلنا نحسّ أنّنا أحياء، حتّى لو كانت مشاركتنا الجسديّة قليلة، وبتنا عاجزين عن فعل أيّ شيء ما عدا القفز والصياح بسبب القلق، فيما نحن نشاهد مباراة كرة قدم من الأريكة أو مدرّجات الاستاد"، حتمًا تورّطنا في هذه اللعبة بتفاوت وشعرنا بأنّا صرنا جزءا من الحدث، وفجأة تحوّل "المستهلكون للفرجة" إلى "منتجين للفرجة"، ما يتغيّر فقط هو موضوع الفرجة، وقوانين اللعب! وإذا كان الكتاب معبّرا عن تحوّل "كرة القدم" إلى جزء من حكاية كاتب، وجزءا من مسيرة حياته، بتأثيرات متفاوتة، فإنّ كرة القدم لم تستأثر بتشكيل هويّة ما للاعبين، بل استطاعت أن تساهم في كلّ دورة في إثارة موضوع "الهويات" واختلاف الثقافات، وفي هذا المونديال نجحت قطر في فرض" نمط ثقافي" يسمو بالمبادئ التي طالما رفعتها مؤسسات أمميّة، ولا نشكّ في أنّ الفعاليات الثقافيّة التي كانت تنظَّم في فضاءات عديدة عكست التنوع الثقافي بقدر ما عبّر العديد منها عن "الهويّة الثقافيّة" للبلد المستضيف، فلم تُدر قطر ظهرها لمسألة الهويّة ومقوّماتها، فقد كان من رهانات المونديال أن يقدّم القطريّون ثقافتهم وأن يُقنعوا العالم بقدرتهم على التفاعل مع من يحترمهم. سعت المؤسسات الثقافيّة إلى نشر الوعي بالثقافة الوطنية والتعبير عن التفاعل مع الثقافات الأخرى، من ذلك ما قامت به المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، حيث نظّمت مئات الفعاليّات، وفي مختلف الأنواع الإبداعيّة، كما نظمت النسخة الثانية عشرة من مهرجان /كتارا/ الدولي للمحامل التقليدية، بالإضافة إلى مهرجان /فنون الشارع/ الذي يقام في جميع أروقتها، ويجمع الفنانين والممثلين والموسيقيين من كلّ أنحاء العالم ليقدّموا بحريّة مسؤولة إبداعهم بشكل فردي أو جماعي. ونظّمت متاحف قطر مبادرة /قطر تبدع/ بإقامة المعارض الفنية، ووضعت أكثر من ثمانين مجسّما في أنحاء قطر، وقامت مكتبة قطر الوطنيّة بإنجاز فعاليّة "تحدي المعلومات الرياضية" الذي يتطلب من الأطفال قراءة مقالات قصيرة عن الرياضة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها، بالإضافة إلى المعرض التوثيقي "جووول! ضربة البداية لكرة القدم في قطر" الذي يسلّط الضوء على رحلة كرة القدم وتاريخها وازدهارها في دولة قطر منذ بداياتها حتى وقتنا الحاضر. وافتتحت وزارة الثقافة المقرّ الجديد والدائم لـ"درب الساعي" في أمّ صلال محمّد، وهي منطقة تراثيّة، فأنشأت تصوّرا جديدا لتقديم الثقافة القطريّة، ولتعزيز المشاعر الوطنيّة، واستقبل "درب الساعي" ضيوف المونديال للاطلاع عن كثب على ثراء ثقافتنا الوطنيّة، ولم يقتصر هاجس التعريف بثقافتنا الوطنية على المؤسسات الرسميّة بل سارعت جميع الفئات الاجتماعيّة للتعبير عن ذلك، فتحوّل كلّ فردٍ إلى سفير لبلاده، وتُرجمان لثقافة الأجداد والآباء، فقد أبدى القطريّون ترحابا بضيوف بلدهم، رغم ما كان يروج في الإعلام الغربي من أباطيل، كان المواطنون جنب ملعب الثّمامة يستقبلون المشجّعين فيحملون الماء والفواكه والحلوى لتقديمها لهم في علامة على حسن الضيافة، وكان الأطفال في عديد الأمكنة يهدون المشجعين الورد، وأمّا المجالس فقد استقبل عددٌ كبيرٌ منها زوّار المونديال، فكانت لهم فرصة سانحة للتعرف على الثقافة القطريّة ومجالسة القطريين وتبادل الآراء، فوقفوا على تلك الوظيفة التي لعبها وما يزال المجلس في تفاعل الثقافات، واقتربوا أكثر من الآداب القطريّة فشهدوا مضامين العادات والتقاليد، بحماسة من يريد التعرف على المختلف، في سياق الكرم الذي لم يبخل القطريّون بتقديمه كلّ يوم من أيّام المونديال. كثيرًا ما كنتُ أتحدّث وأحاضر وأكتب مقالات وكتبا عن أهمية "بناء الجسور" بين الثقافات، وفي هذا المونديال العظيم وجدت حروفي وقد تحوّلت إلى حقائق، وآمنتُ أكثر بأنّ قضيّتي لم تكن مجرّد محاولات يائسة في تحقيق بعضٍ من أحلام الإنسانيّة في التقارب بين الشّعوب، فقد استطاع القطريّون بتمسّكهم بهويّتهم الوطنيّة وثقافتهم أن يبنوا ذلك الجسر الذي لم يكن يشترط كما توهّم الغربيّون تخلّي أهل الثقافات المحلية عن ثقافتهم وهويّتهم، أو أن يتبّنوا تلك المبادئ الكبرى لاحترام الآخر وحقوق الإنسان بشرط التنازل عن الهويّة الوطنيّة وقبول كلّ شيء باسم "الانبطاح والتبعيّة " للغرب ثقافيّا. هذا درسٌ جديد يقدّمه القطريّون والعرب والمشجعون من كلّ أقطار العالم الذين عاشوا التجربة الموندياليّة ليعلنوا بأنّ التعايش أمر ممكن دون شروط تفرضها رؤية منحرفة للمبادئ وتغلّب قضايا هامشيّة وفئويّة ضيقة من أجل التشويش على الحدث، ولذلك عادت من جديد أسئلة الهويّة والعلاقة الثقافيّة بين العرب والغرب، وحرّك المونديال "الذاكرة الجماعيّة " للشّعوب، لقد وجد العرب والمسلمون تخصيصا في النجاح التنظيمي المبهر لكأس العالم نوعا من استعادة الأمجاد العربيّة الإسلاميّة حين كنّا نقود ركب الحضارة، ومزيّة هذا الحدث أنّه لا يولّد ذلك الشّعور بالنخوة والاعتزاز بالانتماء لهذه الحضارة فقط وإنّما يحرّك دوافع الإبداع من جديد ويرسم أفق الأمل في استئناف ما كانت عليه حضارتنا. ولم يكن كأس العالم فرصة لترويج ثقافتنا العربيّة الإسلاميّة فحسب، بل ساهم في إيجاد أرضيّة شعبيّة للتذكير بالقضيّة الفلسطينيّة باعتبارها قضيّة إنسانيّة قبل أن تكون قضيّة سياسيّة، وحين ارتفع العلم الفلسطيني في ملاعب الدوحة وشوارعها فإنّ السّواعد التي رفعته وحملته لم تكن سواعد العرب والمسلمين فقط بل كانت سواعد المشجعين من كلّ أنحاء العالم وهذا دليل على شرعيّة هذه القضيّة، وأنّ الرياضة لا تحجب العمق الإنساني للقضايا، باعتبار أنّها تنطوي على مثل إنسانيّة قبل كلّ شيء. إنّ ما قام به كأس العالم هو أعمق ممّا يتصوّره البعض من إحصائيات ومنجزات في المباني لأنّه يتعلّق بما أسميه بـ" تحريك الدافعيّة" للذاكرة التاريخيّة، لأنّ هذه الذاكرة هي أحد المحركات لتقدّم الشّعوب، وقد عمِلت قوى غربيّة في السابق على تقويضها ولكنّ مرآة كأس العالم أثبتت أنّه لا يُمكن التلاعب بهذه الذّاكرة لذلك تُعدّ الجوانب الثقافيّة لكأس العالم هي الركائز لهذه الذّاكرة، ولئن سقطت بعض أجزاء الذّاكرة في النسيان لأسباب عديدة، فإنّ كأس العالم أعاد تنشيط ما هو قابع في النسيان أيضا ليَخرج إلى الحياة من جديد، هكذا نرى كأس العالم جسرا جديدا نحو العالم والتقدّم، وجسرا جديدا نحو ذاكرتنا الحضاريّة حتّى لا تظلّ "آفة حارتنا النسيان" كما قال نجيب محفوظ يومًا. * المقالة القادمة: وماذا ما بعد المونديال؟ مسيرة النجاح والتحديات مستمرة.
996
| 18 ديسمبر 2022
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
11598
| 20 نوفمبر 2025

وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام...
2454
| 16 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1752
| 21 نوفمبر 2025

شخصيا كنت أتمنى أن تلقى شكاوى كثير من...
1347
| 18 نوفمبر 2025

القادة العظام يبقون في أذهان شعوبهم عبر الأزمنة...
1128
| 18 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1119
| 20 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
930
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
906
| 20 نوفمبر 2025

الاهتمام باللغة العربية والتربية الإسلامية مطلب تعليمي مجتمعي...
888
| 16 نوفمبر 2025

نعيش في عالم متناقض به أناس يعكسونه. وسأحكي...
804
| 18 نوفمبر 2025

يُعد البيتومين (Bitumen) المكون الأساس في صناعة الأسفلت...
681
| 17 نوفمبر 2025
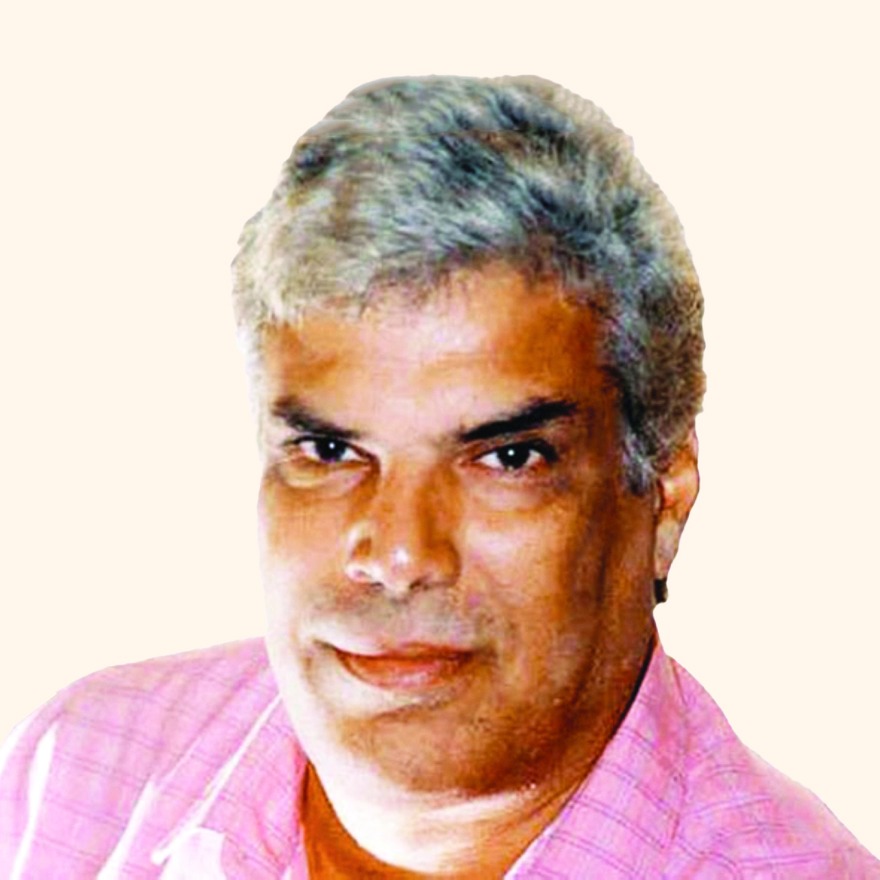
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
639
| 20 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







