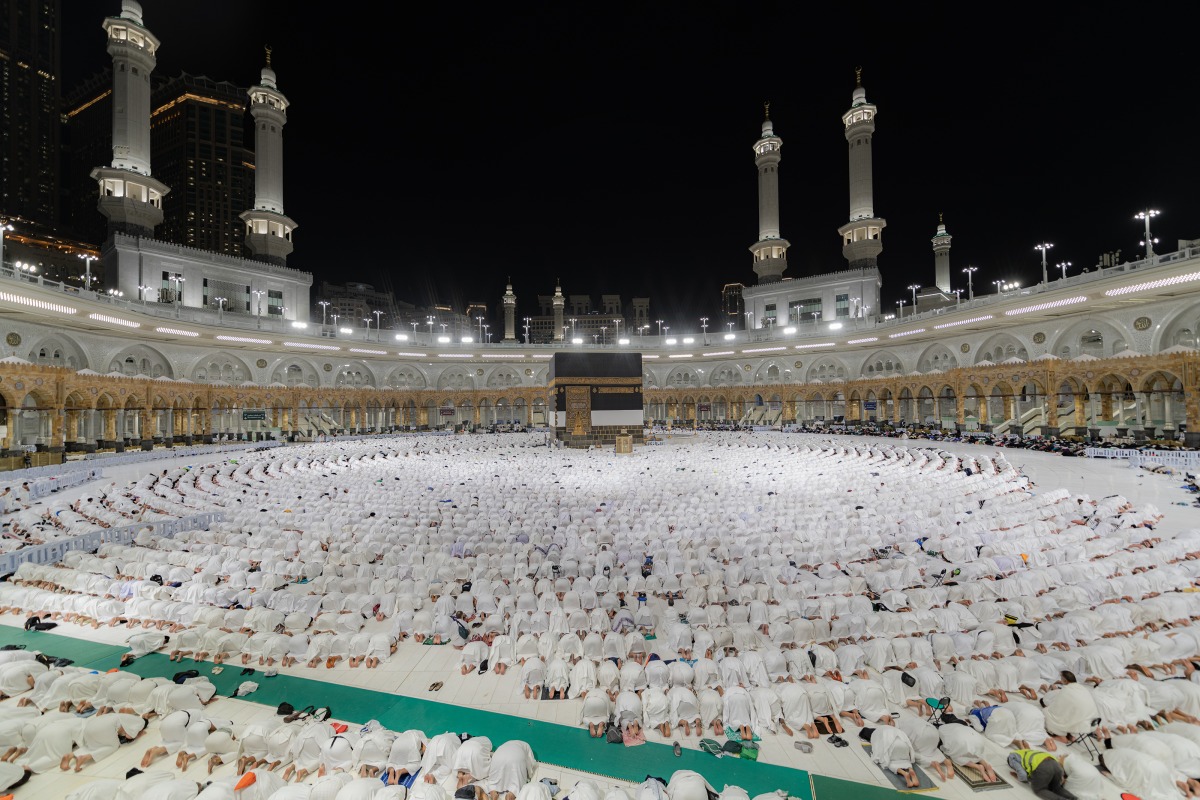رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هناك هوس. ربما لا غنى عنه. بإطلاق تعبير "جديد" على أي تطورات وتحولات تحدث في سياق من السياقات السياسية والثقافية والاجتماعية. لكن لفظة وتعبير "الجديد" تنطوي على مدلول مُضلل من ناحية معرفية. لأن "الجدة" المفترضة هنا مؤقتة وظرفية. وسرعان ما يتجاوزها الزمن ويأتي بـ"جديد" آخر. فجديد الأمس صار قديم اليوم. كما أن "جديد" اليوم سيعفو عليه الزمن ويصبح قديم الغد. سياسيا. وفيما يتعلق بتوصيف المنطقة التي نعيش فيها. تكرر تعبير "الشرق الأوسط الجديد" بشكل مدهش منذ انحسار النفوذ البريطاني وعهد الاستقلالات العربية. وصعود النفوذ الأمريكي. عندها كان "الجديد" هو هذا الاستبدال في النفوذ الأجنبي والسيطرة. بين ذلك "الجديد" و"الشرق الأوسط الجديد" الذي يتحدث عنه البعض الآن في حقبة ما بعد الثورات العربية وبداية انحسار النفوذ الأمريكي. مرت المنطقة بمراحل عديدة من "أشرقة أوسطية جديدة". أحدها بشر به شمعون بيريز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانعقاد مؤتمر مدريد. وأشهرها مؤخرا ما بشر به جورج بوش الابن إبان غزو العراق. كل تلك "الأشرقة الأوسطية" صارت قديمة، بما يعني أن جدتها كانت ظرفية بحتة.ذات الجدل ينطبق على مفهوم "الإعلام الجديد" بل وبمفارقات أكثر، مرة أخرى. هناك "إعلام جديد" كل عقد من السنين على الأكثر. منذ ثورة التلفزيون الذي كان "الإعلام الجديد" الثوري مقارنة بالراديو. وهناك سلسلة متواصلة من "الإعلامات الجديدة". اليوم يُستخدم التعبير للدلالة على وسائل التواصل الاجتماعي وكثافة الاستخدام الفردية للإعلام الإنترنتي. بعيدا عن سيطرة المؤسسات الإعلامية التقليدية الكبرى. لكن هنا يتداخل التقليدي والجديد. ذلك إن اعتبرنا أن التلفزيون والصحف والمجلات هي ما يندرج تحت صفة الإعلام التقليدي فإن الغالبية الكاسحة من هذه الوسائل قامت بتجديد نفسها وأصبحت "أونلاين" وتفاعلية وتقريبا انمحت الفروقات الواضحة بينها وبين "الإعلام الجديد". يُضاف إلى ذلك سؤال له علاقة بأجيال المستخدمين. ذلك إن اعتبرنا أن الشريحة الأوسع من مستخدمي "الإعلام الجديد" هم الشباب والمراهقون وطلبة المدارس بل وحتى الأطفال (وهواتفهم النقالة والألواح الإلكترونية التي يلعبون عليها-ـ الآي باد وسواه). فإن هذه الشريحة لم تعرف من الإعلام إلا هذه الوسائل وبالتالي ليس هناك إعلام تقليدي أو قديم بالنسبة له كي تعتبر أن ما بين أيديها هو "إعلام جديد" ـ إنه إعلام جديد للجيل الأكبر سنا الذي خبر ورافق الإعلام "القديم".الواقع يشير إلى أن الحدود بين الإعلام "التقليدي" و"الجديد" تتداخل والوظائف تتكامل بحيث يصعب رسم خطوط صارمة تفرق بين الفضاءين. ويمكن رصد بعض جوانب التداخل والتكامل هنا. الجانب الأول. التكاملية الوظيفية (functional complementarity): وهذه الخصيصة ربما كانت الأهم والمقصود بها أن كلا من الإعلامين اشتغل على وظيفة معينة تكمل الوظيفة التي يقوم بها الإعلام الآخر. فالإعلام الجديد. وتعبيره الأهم وسائل التواصل الاجتماعي. يعتمد على الهواتف النقالة المحملة بالكاميرات الشخصية. ويسجل الأحداث على الأرض مباشرة (zoom-in) ثم يبثها "أونلاين" سواء للآخرين أو لمواقع إلكترونية. وربما تنتهي لقنوات تلفزيونية. كما شهدنا خلال الانتفاضات العربية. حيث كانت محطات التلفزة الكبرى مثل الجزيرة والعربية وغيرهما تقوم بعرض ما يصلها على الشاشة الكبيرة وتنقلها لمئات الملايين من المشاهدين في العالم (zoom-out). في العدد الأكبر من الحالات لم تستطع التلفزيونات الكبرى الوصول إلى أماكن الأحداث. إما بسبب التضييق الأمني. أو بسبب سرعة إيقاع الحدث. عندها كان الإعلام الاجتماعي هو الذي يقوم بالمهمة. الجانب الثاني يتعلق بالحراك والتعبئة (mobilization and mobility) ويعكس مرونة الحركة والقدرة الفائقة على النشر والاستدعاء وسوى ذلك. وهنا هنا يتحرك الإعلام الاجتماعي. الموجود في جيب كل فرد من الأفراد (أو الناشطين السياسيين والاجتماعيين) على شكل هاتف النقال من مكان إلى مكان بسهولة وسرعة تسابق حتى أجهزة الأمن. بخلاف ثقل حركة الإعلام التلفزيوني بكاميراته ومعداته الثقيلة. وفي الوقت نفسه يعمل مديرو الصفحات والمواقع الخاصة بالإعلام التقليدي على استلام الرسائل وإعادة توجيهها. وبالتالي إدارة عملية الحشد والحركة بشكل فعال. التي هي خليط بين التعبئة والإعلام ونشر المعلومة. جانب التكامل الثالث هو الشمولية (inclusivity) والمقصود هنا أن الإعلام الاجتماعي بسبب توفره في أيدي الجميع. عن طريق الهواتف النقالة. أو الكاميرات الصغيرة. قد تمكن من القيام بتغطية إعلامية شاملة لكل الأحداث التي تقع ضمن الانتفاضة الشعبية وفي كل المدن والقرى. هذا في حين تركزت تغطية الإعلام التلفزيوني في الميادين الرئيسية والمدن الكبرى. ولم يكن باستطاعة هذا الإعلام نشر تغطية تشمل كل المناطق بسبب الموارد البشرية والمادية وإدارة العملية الإعلامية نفسها. القدرة على التملك (affordability). وهنا تمتاز أدوات الإعلام الاجتماعي برخصها النسبي وإمكانية امتلاكها من قبل معظم شرائح المجتمع. وعمادها ببساطة الهاتف النقال. إضافة إلى ذلك فإن غالبية الشرائح الشبابية في الوطن العربي متواصلة الآن بواسطة الإنترنت وعندها حسابات على الفيسبوك أو تويتر. وهذا كله لا يحتاج إلى موارد مالية غير عادية. القدرة على تجاوز الرقابة (un-controllability) والمقصود هنا أن الإعلام الاجتماعي على الأرض off-line على شكل هواتف نقالة. وفي الواقع الافتراضي on-line. تصعب السيطرة الأمنية عليه. بخلاف الإعلام التقليدي والتلفزيوني. ويمكن القول إن المهارة الشبابية في استخدام الإعلام الاجتماعي فاجأت كثيرا من أجهزة الأمن في الدول التي حصل فيها الربيع العربي. ولم تستطع تلك الأجهزة مجاراة السيطرة الشبابية على تلك الوسائل. مما وفر فجوة آمنة خدمت الثورات العربية – وهي بالمناسبة فجوة تحاول أجهزة الأمن في الدول التي يحدث في ثورات ردمها بسرعة وبكل ما أوتيت من موارد.
5655
| 19 مايو 2014
بوكو حرام حركة دينية نيجيرية مهووسة وبالغة التطرف تأسست منذ أكثر من عقد من السنوات بهدف تحريم التعليم الغربي وملاحقة الطلبة والطالبات وحرق المدارس على رؤوس الدارسين فيها. بوكو حرام تعني "التعليم الغربي حرام" ولحظر هذا التعليم تقوم الحركة بالذبح شمالا ويمينا. وبالحرق طولا وعرضا. واليوم توسع وتنوع من قائمة جرائمها لتمتد إلى خطف البنات وبيعهن. ربما كانت هذه الحركة أكثر حركة في تاريخ الإسلام والمسلمين انحطاطا وإجراما. وتنافس في إجرامها وسخف أفكارها كل من سبقه وكل من عاصرها من جماعات متطرفة أخرى. لأنها تجمع سخف الأفكار إلى دموية الإجرام في منظومة واحدة. المعلم الأشهر في "جهاد" هذه الحركة هو الهجوم على المدارس والكليات خاصة الداخلية وقتل الطلبة وهم نيام ورميا بالرصاص. لكن التطور الأخير والانتقال إلى الخطف نقل النشاط الدموي للحكرة إلى مستوى جديد. فزعيم العصابة أعلن منذ عدة أيام أن الفتيات المخطوفات سوف يعاملن كسبايا ويتم بيعهن أو تزويجهن بالقوة. مطلوب أكثر بكثير من مجرد الإدانة وإصدار البيانات والفتاوى التي تقول إن الجماعة المجرمة التي تسمى بوكو حرام وأفعالها لا تمت لدين أو لخلق أو لإنسانية بصلة. خطف مئات الصغيرات بأسلوب غادر وجبان ثم الاحتفاظ بهن والتبجح بالتخطيط لبيعهن هو سلوك يشل اللغة عن الوصف. مطلوب تضامن أوسع وأعمق في العالم الإسلامي مع المخطوفات البريئات وأهاليهن. ومطلوب التعبير المكثف عن هذا التضامن. إعلاميا وشعبيا وسياسيا. وعلى الأقل في البلدان العربية. ليس هناك سوى التغطية الإعلامية والإدانات الرسمية الجافة والتصريحات الدينية التي تدين الجريمة وتبتعد عنها. وكل ذلك وبرغم أهميته. يحدث خارج الحدث ولا ينخرط فيه بعمق وقوة. لكن كيف يمكن الانخراط في الحدث وما هو التعبير المطلوب؟ الإجابة على هذا السؤال يمكن استنباطها عبر قلب الفاعل والمفعول به وافتراض أن هناك جماعة أصولية مسيحية في نيجيريا اختطفت عدة مئات من بنات المسلمين وتهدد ببيعهن والاتجار بهن. عند ذلك ماذا سيكون الموقف وكيف سيكون رد الفعل في البلدان العربية والإسلامية. رسميا وشعبيا ومنظماتياً؟ ستخرج بطبيعة الحال مظاهرات كبيرة تندد بالفعل الإجرامي وتطالب بتحرير الفتيات. وتحمل الحكومة المعنية مسؤولية سلامة المخطوفات. وسوف تندلع الاحتجاجات أمام السفارات النيجيرية في العالم الإسلامي وبعضها سوف يتعرض للاعتداء بل وربما الحرق. وبطبيعة الحال سوف تقفز وسائل الإعلام المتلفز منها والاجتماعي لنقل كل ما له علاقة بالحدث من قريب أو بعيد. وتخصص له لقاءات إعلامية على مدار الساعة. واستيعابا للحالة الشعبية الغاضبة والإعلام الملتهب سوف تضطر الحكومات الإسلامية والعربية لاتخاذ خطوات أو على الأقل بيانات تضامنية تقترب من الحس الشعبي الجارف. على صعيد المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإسلامية وغيرها سوف تنظم حملات تبدأ من التبرع للمال دعما لعوائل المخطوفات ثم تمتد لتشمل كل شيء. في ضوء هذه الإجابة المتوقعة على الحدث الافتراضي الذي يقلب شكل الحدث الحقيقي الواقع اليوم نستطيع أن نرى قصور رد الفعل العربي والإسلامي. وضرورة أن يتطور ويأخذ أشكالاً فعالة. أو على الأقل منخرطة ومتفاعلة معه. وعلينا أن نقول إنه في ضوء السجل الأسود الذي أبدعت في تسطيره جماعات الإرهاب والإجرام التي تقوم بما تقوم به وتنسبه للدين والجهاد فإن الحاجة تزداد إلى رد فعل متفاعل ومتضامن مع المخطوفات وأهلهن ومع نيجيريا بشكل عام ضد العصابة المتوحشة التي تروع الآمنين في شمالها. فهنا وخلال العقدين الماضيين أو أكثر تم ترسيم صورة شائهة عناصرها هي التالية: أقلية صغيرة جدا في العالم الإسلامي تنفذ إجراما وإرهابا في طول وعرض العالم باسم الإسلام والمسلمين. بينما الغالبية الكاسحة من المسلمين بريئة ولا علاقة لها بما يتم من إجرام ينُفذ باسمها. لكن هذه الغالبية تكتفي بالصمت أو الإدانة الخافتة لما يحدث. ليس لأنها موافقة عليه. بل بكل بساطة لأنها كسلى ولا أبالية وتعتقد أن بإمكانها أن تواصل العيش في نفس السفينة التي تعمل تلك الأقلية المجرمة على خرقها وتوسيع الثقوب في قعرها. بالتالي فإن نواتج ومنعكسات الإجرام الاقلوي تعود على الأغلبية ودينها وصورتها. ولذلك صار "العربي والمسلم" وليس فقط متطرفو الجماعات المسلحة إرهابي في كل مكان يذهب إليه. صوت التفجيرات المرعبة هو الذي يرتفع في العالم تحت رايات تحمل شعارات إسلامية. بينما صوت الغالبية الكاسحة مبحوح أو غير موجود أصلا. مطلوب أن يتحرك الناس بفعالياتهم المدنية وغيرها ويعلنوا تضامنهم مع المخطوفات وأن تتوجه وفود منهم مع الإعلام إلى السفارات النيجيرية لتقدم التضامن مع أهالي البنات. وأن تتوجه وفود من الجمعيات الخيرية وغيرها إلى نيجيريا لذات الغرض. أن يعلن المسلمون حيث كانوا وبالفم المليان أن ما تقوم به بوكو حرام من خطف وقتل ضد الأبرياء هو جرائم دموية لا عنوان لها سوى الغدر بالآمنين مما لا يقره مبدأ أو دين. وليس من المروءة هنا المماحكة والقول ولكن ماذا عن الضحايا من المسلمين الذين يقعون في إفريقيا الوسطى أو مينمار وهنا وهناك. هؤلاء الضحايا هم أيضاً يستحقون كل التضامن وكل التأييد وكل العمل الممكن لوقف الإبادات التي تنفذ ضدهم. لكن يجب عدم خلط الأمور. فسقوط ضحايا هنا لا يبرر ولا بأي شكل من الأشكال قبول سقوط ضحايا هناك أو التقليل من مأساتهم. والموقف الإنساني والحقيقي والوجودي هو في أصله الانتصار للضحايا والوقوف إلى جانبهم بغض النظر عن خلفياتهم القومية وانتماءاتهم الدينية أو الإثنية.
475
| 12 مايو 2014
شبكة الإذاعة الإيرانية الناطقة بالانجليزية أسهبت في تغطية خبر الأزمة الخليجية التي نشبت إثر القرار المفاجئ للسعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر. ركزت تلك التغطية على أن هذه الأزمة ستقود إلى تفكك مجلس التعاون الخليجي وانهياره. وهو المجلس. بحسب تلك التغطية. الذي عانى دوما من خلافات وضعف في أسلوب صوغ الخبر هناك غبطة يسهل التقاطها بين السطور. مُضاف إليها قدر غير قليل من التفكير الرغائبي بأن تسير الأمور من سيء إلى أسوأ في البيت الخليجي. يكرر الخبر كذلك استخدام وصف "الخليج الفارسي" بشكل ملفت. وكأنه يحمل رسالة تقول إن أي تجمع إقليمي في الخليج لا تكون إيران على رأسه وتدمغه بالختم الفارسي لن ينجح ويجب ألا يقوم أساسا. بل إن اسم مجلس التعاون الخليجي باللغة الانجليزية Gulf Cooperation Council وهو الاسم الرسمي والدولي المعترف به والمستخدم عالميا يتم تعديله إلى Persian Gulf Cooperation Council. ربما لم نكن بحاجة إلى إشارة الإذاعة الإيرانية حتى ندرك أن إيران هي المستفيد الأول والمباشر من خطوة سحب السفراء التي فجرت الخلاف على السطح داخل البيت الخليجي العربي. وأن التمدد والنفوذ الإيراني المتواصل في المنطقة العربية. من العراق. إلى سوريا. إلى لبنان. إلى اليمن. ومعطوفا عليه جيوب التأييد هنا وهناك سواء في الخليج أو وراءه. هو المستفيد الأول والمباشر من إضعاف الجبهة الخليجية بل والعربية في وقت هي في أمس الحاجة إلى الاستقواء الداخلي. تداعيات هذه الخطورة قد تكون خطيرة وكبيرة وكارثية إن لم تتحرك رئاسة مجلس التعاون وتشتغل بكل جهد لاحتوائها. فالمجلس يواجه الآن أخطر تحد له. ربما منذ تاريخ تأسيسه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وهو تحد يطال الأمن القومي لكل بلد من بلدان الخليج العربية بشكل منفرد. كما يطال أمنها الجماعي. ويضع دول المجلس أمام خيارين: إما الاحتواء الفوري للأزمة وتداعياتها، وإما فسح المجال عريضا أمام إيران لتخترق الخليج في منطقة القلب منه هذه المرة. وليس على هوامشه كما هي حال الاختراقات الإيرانية في العقود الماضية. ومما لا شك فيه أن صناع القرار ومنظري الإستراتيجية الإيرانية في طهران يفركون الآن أيديهم أملاً بأن تتفاقم الأزمة وتزداد توتراً. وينقسم مجلس التعاون الخليجي على نفسه. وتسير الأمور باتجاه السيناريو الثاني ليسهل الاختراق الذي لطالما حلمت به طهران. التحدي الكبير الذي يوجهه مجلس التعاون الخليجي يستلزم مقاربة دقيقة وعقلانية وهادئة بعيدة كل البعد عن ردود الفعل الغاضبة والعاطفية. وتعتمد على تقليب المسألة والنظر في اعتبارات كثيرة منها الآتية: الاعتبار الأول هو ضرورة إدراك وتعقل الدرس الإيراني في السياسة الإقليمية. وهنا يدفع العرب. خاصة عرب الخليج. ثمنا باهظا أن فات عليهم الدرس المتكرر في السياسة الإيرانية الإقليمية بكونها لا تضيع وقتا ولا تتردد في القفص واقتناص الفرص بشكل فوري. والمباشرة في تبني خيارات هجومية واستثمارية سياسية كلما لاحت لها فجوة محتملة في الجوار الإقليمي. وربما لن ننتظر طويلا حتى نرى توظيفا إيرانيا سريعا للأزمة الخليجي من قبل طهران. وستحوم ملامح هذا التوظيف حول تكريس الانقسام الراهن وتعزيزه عبر مد جسور "التعاون" و"الدبلوماسية" لتتموضع هذه الجسور في المساحة الفاصلة بين محوري الأزمة السعودية. الإمارات والبحرين من جهة. وقطر وإلى حد ما وعُمان والكويت من جهة ثانية. تشجيع بلورة هذين المحورين هو ما سيقع في قلب التوظيف الإيراني المُتوقع. لأن هذا معناه الإبقاء على فجورة الانقسام الفجوة التي ظهرت فجأة. ثم السهر على رعايتها وتوسيعها. الاعتبار الثاني هو ضرورة إيقاف الأزمة فورا وعند حدها الذي وصلت إليه. وعدم السماح لها بالتفاقم عن طريق القيام بأي إجراءات أخرى من قبل أي طرف. فتجميد الأزمة على ما هي عليه والحيلولة دون تدهورها هو الخطوة الأولى لبداية حلها وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وهنا علينا أن نقول إن رد فعل قطر على الخطورة كان حكيما وناضجا. إذ لم تتسرع بالقيام بسحب سفرائها من الدول الثلاث كرد ومعاملة بالمثل. وعدم الرد هذا يمثل إبقاءً الباب مفتوحا لأي جهود وساطة يجب أن تبدأ الآن وفوراً. وهنا فإن القناعة التي يجب تتملك الجميع تكمن في لا حل عملياً إلا بالحوار وإعادة ترسيم العلاقات والمواقف على أسس تعاونية وتكاملية وسيادية. سياسة إدارة الظهر والقطع لا تحل المشكلات. فهذه السياسة في عالم اليوم المتسم بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والإعلامية المفتوحة والمركبة والمعولمة ليس لها من الناحية العملية تأثير كبير. الاعتبار الثالث هو إعادة تذكر إحدى القواعد الصعبة في مشروعات التكامل الإقليمي وهي صعوبة توحيد السياسة الخارجية والسياسات الأمنية. وتجربة الاتحاد الأوروبي تقدم الدرس الأكثر غنى في هذا الصدد. فهذه التجربة التي تعتبر رائدة تجارب التكامل الإقليمي في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية تقول لنا إن هناك جوانب في هذا التكامل يمكن تحقيقها والتقدم في إنجاز مستويات عالية في تنفيذها مثل الجانب الاقتصادي. والجمركي. وجانب تنقل الأفراد والبضائع. وجوانب أخرى متعلقة بالفن والتشريعات وحقوق الإنسان وغيرها. وفي المقابل هناك جوانب بالغة الصعوبة حيث يتسم التقدم في إنجازها وتحقيق مستويات ولو متواضعة فيها بالبطء والتدريج وأحيانا الجمود. وعلى رأس هذه الجوانب السياسة الخارجية المشتركة. وكذلك السياسات الأمنية الداخلية ـ وهذه تختلف عن الاستراتيجيات الكبرى التي تكون أحيانا هي الدافع الأساسي للتكامل الإقليمي. كالانخراط في حلف الناتو مثلا كإطار عسكري حام للمنظومة برمتها. لكن المقصود بالسياسات الأمنية هنا ما يتعلق بالداخل والمجتمعات والتهديدات "غير الوجودية". الاعتبار الرابع. وبالتأكيد ليس الأخير إذ هناك اعتبارات أخرى يمكن إضافتها. متعلق بمستقبل التعاون بين دول الخليج والأطروحات الأخيرة التي نوقشت في القمم الخليجية بشأن الانتقال من مرحلة "مجلس التعاون الخليجي" إلى "الاتحاد الخليجي". مستقبل تلك الأفكار الطموحة يجب أن يتم التمهيد له عبر مراحل وسيطة تعزز من التعاون والتسيس الخليجي الداخلي على أسس براغماتية ومصالح متبادلة. والأزمة الحالية تطرح بقوة ضرورة إيجاد آلية خليجية لفض النزاعات تكون فعالة وقوية وتقف إلى جانب التقدم للإمام عند الرغبة في الانتقال إلى أي مرحلة جديدة من التعاون. في السياسة والعلاقات الدولية والإقليمية لا تعتبر الخلافات شيئا نادرا أو مُستغربا. بل ربما كانت هي النمط الأكثر تسيداً. والسياسة أصلا هي حسن إدارة تلك الخلافات وتقليلها إلى الحد الأدنى وتفادي منعكساتها السلبية. الأزمة الحالية من هذا المنظور يمكن تحويلها إلى مناسبة لاجتراح مقاربات إيجابية وآليات مستقبلية تقوم على قاعدة احتواء الخلافات والسيطرة عليها وحلها. وعدم تركها للسيطرة على الحكومات والدول وبالتالي قيادة الجميع إلى المجهول.
1299
| 11 مارس 2014
طالب في الاعدادية يعرف بنفسه في حسابه على الـ "الفيس بوك" بأنه "مسلم سني" في بلد مشرقي يشكل السنة فيه أكثر من 99%. بنت عمرها ٥ سنوات في بلد خليجي تعود إلى أمها من روضة الأطفال تبكي وتشتكي بأن زملاءها في الروضة يقاطعونها ولا يلعبون معها لأنهم يقولون إنها "شيعية" وتسأل أمها عن معنى ذلك! على مستوى أعلى يتنافس تكفيريون شوهوا الثورة السورية وحرفوها عن مسارها مع حزب الله في قتل آلاف من السوريين الأحياء دفاعا عن مرقد للأموات لا ترقد أساسا فيه السيدة زينب. وخلفية المشهد المأساوي للتعبيرات التي لا يمكن حصرها هو التخندق في الهوية الطائفية إذ تصبح المميز الأهم في فرز تكتلات المجتمعات مذرية التعايش العفوي الذي ساد قرونا وعقودا طويلة. في البلدان الخليطة طائفيا مثل العراق ولبنان وبعض دول الخليج يتحدث كبار السن بألم ممض عن سنوات وعقود عاشوها ولم يكونوا يعرفون من هو سني ومن هو شيعي. حيث يتزاوج الناس ويتعاملون فيما بينهم عفويا وطبيعيا من دون الفرز الهوياتي. قبل أن يضرب المنطقة هوج التيارات الإسلامية (السنية والشيعية) وخطاباتها التي تزعم التعايش والتسامح وكل الكلام الفارغ. كان الناس يعيشون في تعايش وتسامح عاديين. وكان الدين بوجهه الأليف وتفسيراته المعتدلة يُمارس في المجتمعات من منطلق العلاقة الفردية مع الخالق والحب مع المخلوق. في الحقبة "الإسلاموية" المظلمة صار الدين عنفاً ودما وسياسة قاتلة وجماعية. وانتشرت التفسيرات الإقصائية والتكفيرية المُستنبطة في المناخ العام وسممته. بل تسربت إلى التعليم المدرسي والمساقات التي تُدرس للأجيال الجديدة. صار مسيحيو الوطن "نصارى صليبيون" وصار شيعته "صفويين كفرة". وانخرط الجميع في حفلة انتحار جماعي يكاد لا يُستثنى منها وطن أو مجتمع. في تحليل جذور ما وصلنا إليه نعرف أنها تعود إلى التنافس والاقتتال المدمر بين السلفية المتطرفة والخمينية المتطرفة الذي استعر منذ قيام الثورة الإيرانية في نهاية السبعينات وردود الفعل السلفية التي استفزتها. انخرط الطرفان في حرب خطابات مدوية حول من يمثل الإسلام والمسلمين. ووظفت في تلك الحرب كل أساليب الدعاية والهجوم والإعلام. واستنفر كل الماضي البائس وثاراته ودمويته. تم ترحيل المجتمعات إلى قرون سحيقة وعوض أن نعيش في القرن الحادي والعشرين والعالم يصل إلى المريخ وصلنا بسرعة الضوء إلى معاوية وعلي وصفين وكربلاء. وأقمنا هناك. ونبشنا كل الدماء التي جفت وأعدنا إليها بعبقرية بالغة ومحطمة لونها الأحمر وحرارتها فصارت كأنها سالت اليوم. وبعثنا فيها حياة دائمة. صارت دماء حارة لا تجف أبدا. وكل يوم تلطخ وجهنا. وتملأ أفواهنا وتخنقنا. وحيث لا يوجد هذا الانقسام السني ـ الشيعي تتحول الطاقة التدميرية إلى المسيحيين كما في مصر حيث في حقبة ما بعد سقوط مرسي وحدها تعرضت أكثر من أربعين كنيسة للحرق والتدمير إضافة إلى عشرات المحلات والصيدليات التي يملكها مسيحيون. سيقول قائل إن هناك شبهات كبيرة حول تلك الاعتداءات وحول تورط بعض أجهزة الأمن فيها للتحريض على التيار الإسلامي وسوى ذلك. وبفرض وجود ذلك فإنه لا ينطبق على كل الحالات ولا ينفي كارثية التحريض الطائفي الكريه والتسمم الجماعي به. والذي لولا وجوده لما استطاعت اية اجهزة أو أطراف "مشبوهة" القيام بتلك الاعتداءات ونسبها إلى غيرها. نحن اليوم نقف على حافة هاوية إن تركنا أنفسنا نهوي فيها فإننا سنحتاج عقود طويلة كي نخرج منها. كما يقول لنا درس التاريخ المرير. إنها هاوية الطائفية حيث يرقد في قاعها العفن والموت الجماعي وحيث لا أحد ينتصر. غول الطائفية انفلت في بلادنا بشكل لم يسبق له مثيل يأكل الأخضر واليابس. ويطارد الجميع ويدفعهم إلى تلك الهاوية. يحشدهم جماعات ومجتمعات ويقودهم منقادين ومنومين إلى حتفهم الكلي. يجب أن ينتابنا رعب جماعي من هذا الغول ونصده بكل الجهد والعزيمة لأن المعركة معه معركة حياة أو موت. في الطائفية وحروبها ليس هناك منتصر. بل الكل يخسر والكل يُدمى بالهزيمة. الطوائف والأديان كما القوميات منزرعة في تكوينات البشر وفي الأرض والمجتمعات ولا يمكن خلعها. لن تكون هناك طائفة أو قومية غالبة ظافرة بالمطلق حتى لو ظنت أنها هزمت الآخرين. نار الطائفية تظل تغلي تحت الرماد. والحل الوحيد لإطفائها هو الإقرار الجماعي بالتعايش والاحترام المتبادل. وليس مواصلة الحرب والاتهام والرغبة البدائية بالإبادة والتطهير. إطار التعايش الذي يمكن أن تتصالح فيه الطوائف والأديان والعصبيات المختلفة من دون اصطراع تبادلي التدمير هو إعلاء الأولوية للانتماء إلى الوطن على الانتماءات الأخرى وعلى قاعدة المواطنة والمساواة التامة. الأفراد في كل وطن من الأوطان هم مواطنون أتباع للوطن أولا. ثم لأية انتماءات ثانوية ثانياً. هم مصريون أولا. ثم يأتي بعد ذلك أي ولاء آخر. إسلامي أو قبطي. وهم عراقيون ولبنانيون وبحرينيون قبل أن يكونوا سنة أو شيعة. وهكذا. هذا ما يجب أن يتوافق عليه الجميع كفكرة مؤسسة للجماعة الوطنية التي ينتمون إليها. وتكون حجر الزاوية في الدستور والقوانين. وهي ما يجب أن يؤسس لكل ما يتعلمه طلاب المدارس وتمارسه المؤسسات الرسمية أولا ويتبناه المجتمع المدني والديني ثانيا. عندما تترسخ فكرة المواطنة وفكرة المجتمع والدولة المدنية لا الدينية نواجه جماعيا غول الطائفية ونبدأ في الهجوم المعاكس. من دون ذلك فإننا سننخرط في دوامات الصراعات الطائفية ونستدعي أحقاد الماضي لتكون هي العتاد المسموم في حياتنا السياسة والاجتماعية والثقافية. ومن دون ذلك نظل ضحايا طوعيين للغرائز البدائية وبكائيات القرون الخالية وتمتص الثارات التافهة لأموات قدامى كل ما هو اخضر وحي في حاضرنا. من دون ذلك سوف نغلق بوابات المستقبل في وجه الأجيال القادمة. وندفعهم للعيش في الماضي. شباب في عمر الورد لكن كل الذي يفكرون فيه هو الرحيل بعيدا في ماض سحيق للالتحاق بجيش خيالي لعلي أو جيش خيالي لمعاوية. وإعلان الحرب الأبدية التي لا تموت ضد الآخر. حيث نتيجة الحرب وللطرفين معا هي الموت المحقق والهزيمة المحققة.
612
| 25 نوفمبر 2013
"في وجهها يستوطن بهاء قديم لم تحرمه الأيام نضارته الأولى. ومن وجهها ينضح عطر سماوي يشبه ما يمنحه المطر لتراب الأرض. وعند وجهها تتزاحم حكايات الحسن. وقد تخلت عن نهاياتها الحزينة". هذا ما يظل يدندن به بطل رواية "مرسى فاطمة" لحجي جابر حول حبيبته المفقودة. واصفا إياها لكل من يراه ويظن بأن لديه طرفا من خبر عنها. بعد قصة حب قصيرة تغيب سلمى ويغيب بطلنا وراءها بحثا عنها، أو عن سرابها، أو هيامه أو وهمه بها، إنها السردية المتألقة الأخرى لجابر بعد روايته الأولى "سمراويت" التي فازت بجائزة الشارقة للرواية من سنتين."مرسى فاطمة" هو الشارع الذي التقى فيه سلمى أول مرة ووقع على رصيفه بدء تاريخ حبه لها. من ذلك الشارع تركب سلمى الحافلة التي تقلها إلى المدرسة الثانوية، ويجري قلبه مع عجلاتها، لكن لهذا المكان رمزية أبعد بكثير، إنه إريتريا الناس العاديين والمفعمين بالجمال العفوي والتعايش غير المُدعى، بعيدا عن جبروت السياسة، وبعيدا عن عفن التطرف القادم من وراء الحدود. يخبرنا حجي جابر أن: "مرسى فاطمة اسم أطلقه الجبرته على هذا الشارع تيمنا باسم جزيرة مباركة قرب مصوع سكنتها امرأة صالحة من نسل الصحابة، ليحل محل اسم الإمبراطورة "منن" زوجة "هيلاسيلاسي"، والتي اختارته دون سواه ليحمل اسمها.. هنا يسكن مسلمون ومسيحيون ولا دينيين.. الشارع يبدأ بكنيسة إندا ماريام وتنتهي تفرعاته عند جامع الخلفاء الراشدين، وقد بناه الإيطاليون بأموال تاجر يمني استوطن اسمرا. هنا تتجاور بيوت الأغنياء والفقراء، وكذلك قلوبهم. هنا أيضاً لا تجد أسرة لم تفقد حبيبا في حرب الاستقلال. مرسى فاطمة يمثل وطنا رحبا لكل سكانه". يتناهى إلى علمه أن سلماه تم تجنيدها وإرسالها إلى معسكر الخدمة العسكرية الإجبارية "ساوا" الرابض بين الجبال البعيدة عن العاصمة اسمرا. هناك الحياة تنتمي إلى من نوع آخر من الحياة. يلحقها ويتطوع لأداء الخدمة الوطنية (القلوقلوت)، ويستسخفه كثيرون لأنه معفى منها أساسا بكونه وحيد والديه. هناك يتفنن المدربون في إذلال الشباب تحت عنوان تربيتهم على حياة الجندية ومواجهة الصعاب. المعسكر هو صورة النظام الحاكم: السلطة الفوقية وعدم الشفافية، والفساد المتسربل في خريطة القيادة العليا له. يتجبر الضباط في المجندين في فرض أقسى أنواع التدريبات بدءا من فجر كل يوم وحتى مغيب شمسه، يركضون، يلهثون، تنقطع أنفاسهم. ثم يُطعمون كسرة خبز وماء شاي، ثم يصفعون محاضرة في الوطنية والبطولة من قبل ضابط ثمل جاء لتوه من معسكر الإناث بعد أن جال بفحولته على عدد منهن، إمعانا في الوطنية. بطلنا الشاب يتحمل طوعا ما يتحمله زملاؤه قسرا وهو يأمل أن يعثر على خيط أمل يقوده إلى سلمى التي يفترض أنها في المعسكر المجاور. لا سبيل إلى الوصول إليها، حيث يمنع ذلك على المجندين، ولا يتمتع بتلك الحظوة إلا الضباط. ينفلق الحظ السعيد لبطلنا، إذ يختاره أحد الضباط سائقا له، بما يعني سهولة دخوله إلى معسكر الإناث يقود سيارة الضابط. هناك وفي لحظات توهان الضابط في سكراته المختلفة يستغل العاشق كل دقيقة ليسأل عن حبيبته سلمى. يترك صفاتها واسمها وعشقها له مع كل فتاة يتمكن من الحديث إليها، لكن لا أثر لها. يفعل المستحيل للهرب من "ساوا" بعد أن اكتشف أن سلمى ليست هناك، ويلحق سرابا لها باتجاه السودان، إذ وصلته أطراف أخبار بأنها عبرت الحدود إلى هناك. رحلة الهرب من الوطن الإرتيري أوديسة أخرى تُضاف إلى رحلات الهروب من أوطان الجنوب. على الحدود الإرتيرية السودانية يقع أسيرا وضحية لـ"دولة الشفتا"، والشفتا هم القبائل المسيطرة على المنطقة الحدودية بالسلاح والقوة وفرض الخاوات. تتهيب السلطات على طرفي الحدود من سطوة تلك القبائل وعصاباتها وتشتري ولاءها، ويمتد نفوذها إلى وزراء ومسؤولين كبار. على الفارين من جحيم الوطن أن يمروا بجحيم الشفتا ويدفعون ألوف الدولارات كي يصلوا إلى الجحيم الثالث، إلى مخيم "الشجراب" الضخم في الأراضي السودانية، والذي يعتبر من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم. في "الشجراب" دويلات أخرى، من المنظمة العالمية للاجئين، لعصابات المهربين، للسلطات السودانية، ولكل ما يمكن أن يتصور من عوالم سفلية. يبحث في أزقته وخيامه وتجمعاته عن سلمى التي لا أثر لها. يسأل كل الناس، لكن ليس ثمة طرف خبر مؤكد. يعزم في نهاية المطاف مغادرة المخيم البائس ركضا وراء خبر ما بأن سلمى أصبحت في السودان. ينخرط في عملية تهريب ثانية، وبعيدا عن الوطن، أو بحثا عنه. قبل مغادرة المخيم يتعرف على خريطة "الأمل" لكثير من اللاجئين الشبان وهي أن جل همهم هو تأمين هروب سري عن طريق بعض العصابات إلى إسرائيل. هل هربت سلمى معهم وأصبحت هناك أيضا؟تضيع سلمى وسط تفاهات الحرب، والفساد، والفقر، والتطرف، والسياسة، والتهريب، والحدود الملتهبة، والبؤس المودي للهجرة اليائسة إلى إسرائيل. تضيع سلمى بطل جابر حجي الذي ينذر نفسه للبحث عنها ولقياها. إنها تحمل جنينهما في أحشائها. إنه المستقبل الذي يريد بيأس وعناد أن يأخذ "مرسى فاطمة" إلى غد مشمس.. إلى ماضيه الجميل. لا تضيع سلمى وحسب، بل إريتريا "مرسى فاطمة" هي التي تضيع. وحجي يبحث عنها. يبحث عن وطن بسيط تترتب فيه الأشياء بفوضى الناس العاديين، بعيدا عن أيديولوجيا الحزب الحاكم، وتشدق الساسة، وقوافل الموتى الملتحقين بأتون نار تلتهم ألوف الشباب، وقوافل الهاربين في كل الجهات. يلحق حجي بإريتريا الضائعة التي ما عاد فيها مرسى لفاطمة، وتشتت شبابها بين "ساوا" وجبهات المعارك، ومخيمات اللجوء والهرب على الحدود السودانية، ثم تبعثرت طوابير الهاربين في صحارى الشمال وسيناء أملا بالوصول إلى "مرسى" بديل واعد، في إسرائيل. ومن هناك، من "أرض الوعد والميعاد"، تأتي قصص تقشعر لها الأبدان لتصل إلى المنهكين وسط الصحراء المتوجهين إلى أرض الأعداء، لأنها أصبحت أخف وطأة من الوطن. من المدن اللامعة والحديثة في إسرائيل إلى قلب صحراء سيناء يكتشف المتعبون بأنهم ليسوا سوى قطع من الأعضاء البشرية تتداولها عصابات الإتجار بالكلى والأعضاء. ويكتشفون أن ضريبة عبور الصحراء إلى "الجنة الموعودة" هي كلية لا حاجة لهؤلاء بها. أما الإناث من الهاربين فإن مرارتهن مضاعفة، عليهن إشباع حقارات سلسلة المهربين من الحدود الإريترية والسودانية والمصرية، وصولا إلى سيناء ثم إسرائيل. كل جزء من أجزاء الرواية يستحق أن يكون رواية منفصلة: معسكر ساوا، دولة الشفتا، الشجراب. حجي ظلم نفسه وأبطال روايته وحرمنا من ثلاث روايات واستعجلها في رواية واحدة. لكن تبقى "مرسى فاطمة" رواية بطعم المرارة عن وطن إريتري مفقود. عن ذلك الشيء المُبهم الذي يقول عنه في الصفحة الأولى من روايته: "الوطن كذبة بيضاء.. يروج لها البعض دون شعور بالذنب، ويتلقفها آخرون دون شعور بالخديعة".
1510
| 18 نوفمبر 2013
وقعت المجتمعات الحديثة في أسر أنماط الحياة والسلوك والاقتصاد والسياسة والتنظيم الصارم الذي جاءت به الحداثة، وجاءت به أصلا للتمرد على فوضى وخوف ولاعقلانية المجتمعات ما قبل الحديثة. وهكذا فقد حررت المجتمعات من قيود الخرافات حيث كان الأفراد يخضعون لإملاءات غيبية ميتافيزيقية غير مباشرة وسلطوية مباشرة، لكنها أخضعتهم لقيود الحياة الحديثة وبرنامجها المنضبط الذي يحدد حياة الأفراد ويرسم لهم التوقعات والمسارات التي من المفترض أن يسيرون فيها. وعلى هذا الضبط الصارم والتنميط الجماعي للأفراد ثارت مدرسة نقد الحداثة، واشتغلت أولا على خلق هوامش للحرية والانعتاق والتمرد على جوانب الحداثة وتمثلاتها المختلفة في الحياة، ثم لاحقا وهو الأهم على نقل تلك الهوامش لتصبح في «المجال العام» للحداثة ذاتها، وتمييع ما هو تنميطي فيها أو إضعافه. وتجلت انعكاسات تلك الإزاحة بالغة الأهمية في ازدياد التمرد ما بعد الحداثي على التنميط الحداثي نفسه، في مجالات الفن والأدب والإعلام والعمارة، ثم توسعت لتشمل مقاربات عديدة في العلوم الاجتماعية وصولا إلى السياسة والاقتصاد في «سياسة ما بعد الحداثة». وهكذا خلقت الحداثة ذاتها وعبر آلية النقد التي استبطنتها جوهريا «ما بعدها» الخاص بها... «ما بعد الحداثة». لكن هذه «الما بعدية» لم تنقض العملية الأم، الحداثة، لكنها قامت بدور بالغ الأهمية وشبه فريد في تاريخ الأفكار وهو طرح الأسئلة الصعبة والمتفجرة وإلقاؤها في حضن الحداثة التي تنشغل في إيجاد الرد عليها عن طريق تصويب مساراتها المتعرجة والمتعددة دائما. لكن ما الجديد في هذه السيرورة، أي أن تنتج فكرة ما وليدها الناقد الذي يصحح بعض جوانبها؟ فهذه السيرورة موجودة في كل الأفكار وحتى في الأديان، حيث شهدت كبرياتها حركات قامت على النقد والإصلاح الديني. الفرق الكبير في حالة الحداثة وما بعد الحداثة هو أن النقد لم يكن مقيدا بحدود الفكرة الأم ولم يحترمها ولم يقدسها، ما بعد الحداثة لم تحاول نقد الحداثة وحسب بل ونقضها. من هنا فإن التميز وربما الانفراد التاريخي الذي جاءت به الحداثة ووليدتها يكمن في هذه النقطة بالضبط، وهي انعتاق النقد وآليته من دون حدود، وإلى درجة النقض الكلاني للفكرة المؤسسة. وبسبب لا محدودية هذا النقد وشراسته في كثير من الأحيان فإن الفكرة الأم صارت دائمة الاستنفار للانخراط في عملية تصويب مستديمة لذاتها وتجسيداتها في الواقع. وبكلمة أخرى، أنتجت الحداثة آلية داخلية شبه نادرة وتميزها عن أي فكرة أخرى تتمثل في التصويب الذاتي المستديم والذي يسير يدا بيد مع الفكرة وتطبيقاتها، ولا يقف على الهامش أو يستخدم ظرفيا أو تظاهريا. النقد الذاتي الحداثي وما بعد الحداثي للحداثة صار جوهرها ومحركها الأساسي، ولهذا ظلت تتجدد وظلت محافظة على بريقها. ويأتي بريقها الأهم من عدم ادعائها بأنها تمثل الحل الخلاصي لأي مجتمع من المجتمعات، وبكونها قطعت من زمن طويل مع بداياتها الأيديولوجية، والنظريات الخطية التي سيطرت على عقول كثيرين في الحقبة الكولونيالية، حيث أرادوا جلب العالم المتخلف إلى أنوار الحداثة التي هي وحدها هي الحل وهي وحدها التي سوف تخلصهم من تخلفهم حتى رغما عنهم. تنجح أي فكرة أو سيرورة أو سياسة وتستديم بالقدر الذي تتبنى فيه النقد الذاتي، لأن هذا النقد هو الآلية الوحيدة التي تضمن التصويب المستمر للأخطاء وتعيد مقاربة الأشياء بالشكل الأكثر قربا لما هو مفترض ومتوقع من فاعلية للوصول إلى ما هو مرغوب من أهداف.
493
| 06 نوفمبر 2013
تفترق فكرة الحداثة عن جميع الأفكار الأخرى بأنها ولّدت آلية النقد الذاتي الذي أصبح جوهرها الموجه لها. في بداياتها الأولى وثورتها على السلطة والمجتمع التقليديين القائمين على خليط السيطرة والاستغلال الذي أنتجته قرون التحالف بين الإقطاع والدين، قدمت الحداثة طرحاً ثوريا تحرريا لكنه كان مؤدلجاً وخلاصيا، أي أنها اعتقدت أنها "الحل" الخلاصي للإنسانية الذي يحررها من قيود التقليد والميتافيزيقيا والدين والاستغلال. وبذلك فإنها طرحت نفسها، بوعي أو من دونه، بديلا أيديولوجيا في ميدان الأيديولوجيات الخلاصية، والتي كان كل منها يضع نهاية سعيدة للكون والبشر، ويريد حشر مسيرة التاريخ والمستقبل لتسير وفق تلك النهاية. وكما كان الدين يرسم مسارا خاصا للإنسانية ونهاية محددة، جاءت الحداثة لتقوم بالشيء ذاته وتتورط في المنهج الخلاصي نفسه، لكن مع تغيير في الطريق وفي شكل النهاية المفترضة. بمعنى ما، أصبحت الحداثة "الصارمة والتقليدية" القائمة على جبروت العقل والعلم والانعتاق دينا جديدا وأيديولوجيا تنافس الأديان والأيديولوجيات القائمة.لكن الفصل المثير في قصة الحداثة يكمن في توليد طاقة النقد الذاتي، ذلك أنها وباعتمادها على العقل اكتشفت خطل تموضعها على مسار الأيديولوجيات التي تعتقد في ذاتها معرفة المسار الخفي للبشرية وقانون الطبيعة وترسم تبعا لذلك "خطة" لأيلولة الإنسانية والكون. نقدت الحداثة نفسها وتحررت من شكلها الأيديولوجيا، ذلك أن الأيديولوجيا وكما وصفها ماكس هوركهيمر أحد رواد مدرسة فرانكفورت النقدية هي العقبة الأساسية في طريق الانعتاق الإنساني. التحرر الذي حدث للحداثة من التورط في أدلجة لا انفكاك منها تم بفضيلة النقد والمنطق والعقل وهي القيم الجوهرية للتنوير والثورة على التقليد، في قلب الحداثة تأسست تدريجيا مدرسة نقد الحداثة، والتي كان هوركهيمر أحد أهم فلاسفتها، انتبه هوركهيمر إلى الديالكتيك الخطير الذي انزلقت إليه المجتمعات الحديثة التي من المفترض أن تكون نتاج عملية التحرير الكبير الذي قادته الحداثة وأخرجت به هذه المجتمعات (خاصة الغربية) من غيبوبة التقليد وتحالف سلطات الدين والمجهول والإقطاع عليها. لقد تحررت هذه المجتمعات من قيود تقليدية ما قبل حداثية، لكنها سرعان ما ورطت نفسها طائعة في قيود جديدة وعبوديات حداثية، وقد التقط هوركهيمر هذه السيرورة مبكرا جدا في أربعينيات القرن العشرين، في كتابه "تجاوز العقل"، واصفا إياها بما يلي: "... بعد أن ساعدنا العلم على تخليص أنفسنا من الرهبة من المجهول في الطبيعة، ها نحن الآن نصبح عبيدا للضغوط الاجتماعية التي صنعناها نحن، فإزاء الدعوة كي نكون فاعلين مستقلين، نتوق عوض ذلك للالتحاق بالنظم، والأنماط والسلطات. وإذا كانت الاستنارة والتقدم العقلي تعني تحرير الإنسان من المعتقدات الخرافية في القوى الشريرة والأساطير والقدر الأعمى، أو باختصار تحريره من الخوف، فإن نقد ما يسمى اليوم بالمنطق هو أكبر خدمة يمكن للمنطق أن يقدمها".وقعت المجتمعات الحديثة في أسر أنماط الحياة والسلوك والاقتصاد والسياسة والتنظيم الصارم الذي جاءت به الحداثة، وجاءت به أصلا للتمرد على فوضى وخوف ولاعقلانية المجتمعات ما قبل الحديثة. وهكذا فقد حررت المجتمعات من قيود الخرافات حيث كان الأفراد يخضعون لإملاءات غيبية ميتافيزيقية غير مباشرة وسلطوية مباشرة، لكنها أخضعتهم لقيود الحياة الحديثة وبرنامجها المنضبط الذي يحدد حياة الأفراد ويرسم لهم التوقعات والمسارات التي من المفترض أن يسيرون فيها. وعلى هذا الضبط الصارم والتنميط الجماعي للأفراد ثارت مدرسة نقد الحداثة، واشتغلت أولا على خلق هوامش للحرية والانعتاق والتمرد على جوانب الحداثة وتمثلاتها المختلفة في الحياة، ثم لاحقا وهو الأهم على نقل تلك الهوامش لتصبح في "المجال العام" للحداثة ذاتها، وتمييع ما هو تنميطي فيها أو إضعافه. وتجلت انعكاسات تلك الإزاحة بالغة الأهمية في ازدياد التمرد ما بعد الحداثي على التنميط الحداثي نفسه، في مجالات الفن والأدب والإعلام والعمارة، ثم توسعت لتشمل مقاربات عديدة في العلوم الاجتماعية وصولا إلى السياسة والاقتصاد في "سياسة ما بعد الحداثة".وهكذا خلقت الحداثة ذاتها وعبر آلية النقد التي استبطنتها جوهريا "ما بعدها" الخاص بها... "ما بعد الحداثة". لكن هذه "الما بعدية" لم تنقض العملية الأم، الحداثة، لكنها قامت بدور بالغ الأهمية وشبه فريد في تاريخ الأفكار وهو طرح الأسئلة الصعبة والمتفجرة وإلقاؤها في حضن الحداثة التي تنشغل في إيجاد الرد عليها عن طريق تصويب مساراتها المتعرجة والمتعددة دائما. لكن ما الجديد في هذه السيرورة، أي أن تنتج فكرة ما وليدها الناقد الذي يصحح بعض جوانبها؟ فهذه السيرورة موجودة في كل الأفكار وحتى في الأديان، حيث شهدت كبرياتها حركات قامت على النقد والإصلاح الديني. الفرق الكبير في حالة الحداثة وما بعد الحداثة هو أن النقد لم يكن مقيدا بحدود الفكرة الأم ولم يحترمها ولم يقدسها، ما بعد الحداثة لم تحاول نقد الحداثة وحسب بل ونقضها. من هنا فإن التميز وربما الانفراد التاريخي الذي جاءت به الحداثة ووليدتها يكمن في هذه النقطة بالضبط، وهي انعتاق النقد وآليته من دون حدود، وإلى درجة النقض الكلاني للفكرة المؤسسة. وبسبب لا محدودية هذا النقد وشراسته في كثير من الأحيان فإن الفكرة الأم صارت دائمة الاستنفار للانخراط في عملية تصويب مستديمة لذاتها وتجسيداتها في الواقع. وبكلمة أخرى، أنتجت الحداثة آلية داخلية شبه نادرة وتميزها عن أي فكرة أخرى تتمثل في التصويب الذاتي المستديم والذي يسير يدا بيد مع الفكرة وتطبيقاتها، ولا يقف على الهامش أو يستخدم ظرفيا أو تظاهريا. النقد الذاتي الحداثي وما بعد الحداثي للحداثة صار جوهرها ومحركها الأساسي، ولهذا ظلت تتجدد وظلت محافظة على بريقها. ويأتي بريقها الأهم من عدم ادعائها بأنها تمثل الحل الخلاصي لأي مجتمع من المجتمعات، وبكونها قطعت من زمن طويل مع بداياتها الأيديولوجية، والنظريات الخطية التي سيطرت على عقول كثيرين في الحقبة الكولونيالية، حيث أرادوا جلب العالم المتخلف إلى أنوار الحداثة التي هي وحدها هي الحل وهي وحدها التي سوف تخلصهم من تخلفهم حتى رغما عنهم.تنجح أي فكرة أو سيرورة أو سياسة وتستديم بالقدر الذي تتبنى فيه النقد الذاتي، لأن هذا النقد هو الآلية الوحيدة التي تضمن التصويب المستمر للأخطاء وتعيد مقاربة الأشياء بالشكل الأكثر قربا لما هو مفترض ومتوقع من فاعلية للوصول إلى ما هو مرغوب من أهداف.
918
| 04 نوفمبر 2013
"الكراهية لا تواجه بمزيد من الكراهية"، هذا ما يقوله محمد أنصار الناشط الإسلامي الآسيوي في بريطانيا والذي لمع اسمه في السنوات الأخيرة كأحد أهم الأصوات المسلمة المعتدلة. وأكثرها تأثيرا في تصويب الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين في المملكة المتحدة والغرب. أنصار هو المعادل الموضوعي لكثير من الأسماء المسلمة المتطرفة التي استغلت حرية التعبير في الغرب ولم تعمل سوى على جلب مزيد من الكراهية والحقد على المسلمين ودينهم. وفي بريطانيا على وجه التحديد هناك قائمة طويلة تبدأ ولا تنتهي بتلك الأسماء. من أبو حمزة المصري إلى أبو قتادة الأردني إلى محمد بكري اللبناني وليس انتهاء بأنجم شودري الباكستاني. مُضافا إلى هؤلاء جميعا "نضالات" حزب التحرير الإسلامي في سبيل إقامة خلافة إسلامية في لندن. وضد "الديمقراطية" البريطانية التي يعتبرها كفرا. وهي الديمقراطية التي تسمح له بالعمل السياسي والتعبير عن آرائه! تزداد المفارقة والإثارة في قصة محمد أنصار عند مقارنة تأثير خطابه بتأثير خطابات الكراهية التي بثها أولئك بغباء وحماقة. في أبريل من العام الماضي ظهر محمد أنصار في برنامج حواري على شاشة الـ"بي بي سي" في مواجهة مع تومي روبنسون زعيم رابطة الدفاع الإنجليزية. وهي جماعة عنصرية على أقصى اليمين وتعبر عن آراء فاشية ومتطرفة ضد المسلمين والمهاجرين وكل ما هو غير إنجليزي. وتظهر بعض الاستطلاعات أن نسب التأييد لمواقفها في تزايد مستمر وسط الرأي العام البريطاني (في تناغم مع نسب تأييد متماثلة في بلدان أوروبية أخرى للأحزاب اليمينية. مثل "الجبهة القومية" في فرنسا. و"من أجل الحرية" في هولندا. و"الفجر الذهبي" في اليونان). وتصاعد شعبية هذه الأحزاب ذات المواقف التي كانت على أقصى الهامش لها أسباب عديدة منها ما هو داخلي متعلق بالأزمات الاقتصادية وانتهازية السياسيين وشعبيتهم. ومنها ما هو خارجي وله علاقة بالتطرف والإرهاب المعولم الذي ينفذ باسم الإسلام. بكلمة أخرى يمكن اعتبار أسامة بن لادن وبقية عصابته أعضاء مؤسسين ليس للقاعدة فحسب بل ولكل الأحزاب الفاشية المتطرفة في الغرب وغيره والتي تعادي الإسلام والمسلمين. في ذلك البرنامج الحواري الشهير بين محمد أنصار وتومي روبنسون لم يُستدرج أنصار لخطاب الكراهية. ولم يفقد أعصابه وينزع نحو الغضب والشتائم وبالتالي فقدان تأييد المشاهدين. تمكن بمنطقه وخطابه العقلاني والهادئ من بداية زعزعة قناعات روبنسون التي يعتبرها مسلمات يقوم عليها عداؤه الشديد للمسلمين ومطالباته بتخليص بريطانيا منهم. بل وأكثر من ذلك انتهى الحوار بدعوة عشاء قدمها أنصار لروبنسون كي يواصلا الحوار. والمثير في القصة أن روبنسون قبلها حيث التقى الاثنان تحت عيون الكاميرات وبعيدا عنها مرات عديدة. في هذه اللقاءات تعرف روبنسون على مسلمين آخرين وإسلام آخر. وكتب على تويتر يقول لأنصار: "لو كان كل المسلمين مثلك لما كان هناك أي مشكلة". لم تنته القصة هنا. بل كانت نهايتها المفاجئة في تخلي روبنسون تماما عن رابطة الدفاع الإنجليزية وتعديل آرائه. وسوف تبث الـ"بي بي سي" برنامجا وثائقيا عن القصة كلها يوم الإثنين القادم 28 أكتوبر بعنوان "عندما التقى تومي مع مو". محمد أنصار متحدث لبق ومنطقي ومطلع على الأصول الشرعية وينظر للآخرين نظرة هداية واستيعاب وليس نظرة عداء وكراهية. وهو مكروه كما هو متوقع من عتاة السلفيين والمتطرفين الذي يهاجمونه بسبب اعتداله و"مهادنته للكفار". خلفيته الحقوقية وارتكازه على الحقوق المدنية والتعددية الثقافية والحرية وتمتعه بمنطق تصالحي تعددي يُضعف منطق خصومه. سواء من الفاشيين الغربيين أو الفاشيين المسلمين. مقابل محمد أنصار هناك أنجم شودري زعيم ما كان يُسمى "مسلمون ضد الصليبيين" قبل أن يحظرها القانون بسبب أعمال الحرق وممارسات أخرى ضد مخالفيها الرأي. وكان أنصار وشودري قد ظهرا في برنامج حواري منذ أكثر من سنتين ولم يستطع شودري الرد على آراء أنصار الاستيعابية المعتدلة. وكان ينحرف بسرعة إلى خطابات الاتهام والغضب والتشويه. من دون الاعتماد على المنطق. أهمية نموذج محمد أنصار. رغم قلة صوته وسط بحر الصراخ المتطرف والخطابات التهديدية التي تصدر كل يوم من أبوات التطرف الإسلامي. أنه يقدم الفعل والفاعلية والنشاط في مواجهة خطابات وممارسات التطرف والإرهاب. ولا يتوقف عند الإدانات اللفظية الخجولة. فالصورة التي يجب الإقرار بها ومواجهتها عن الإسلام والمسلمين في الغرب سيئة وتربط الدين ومنتسبيه بالإرهاب بشكل آلي. وتساهم في تزايد وتائر الإسلاموفوبيا. وتعامل المسلمين والعرب مع هذه الحقيقة يأخذ المنحى السهل والهروبي عن طريق اتهام الإعلام الغربي والأحزاب والجماعات المتطرفة بتشويه تلك الصورة. وتبرئه الذات بشكل مباشر أم غير مباشر. واتهام الآخرين وإلقاء المسؤولية على الغير يُعفي من القيام بأي عمل إيجابي وفاعل. ويبرر الكسل والقعود. بيد أن التعامل الفاعل والمبادراتي لمواجهة الإسلاموفوبيا يتخطى التشاكي والتباكي المستمرين. والانخراط في جهد حقيقي يبدأ بمواجهة "العدو الداخلي". وهو الجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية. وتفنيد كل إدعاءاته بتمثيل الإسلام والمسلمين. وإعلاء الصوت بمعارضته. فالمشكلة هنا تكمن في أن صوت الإرهاب ورغم أنه يمثل أقلية، الأقلية الأعلى والأكثر تأثيرا بسبب الضحايا التي يُسقطها والدم الذي يسيله. في المقابل فإن صوت العقل والمنطق والاعتدال ورغم أنه يمثل الغالبية الكاسحة أقل وصولا وتأثيرا لأنه يعتمد على الحوار وليس الدم والقتل. لأجل هذا يتوجب على الغالبية أن تعلي من صوتها أكثر. وتستعيد تمثيلها لذاتها ودينها وترفض أن يظل ذلك محصورا بإدعاءات الأصوات المتطرفة. قبل فترة وجيزة انتشرت صورة على الإنترنت لمجموعة من النساء المنتقبات في بريطانيا يحملن لافتات تندد بقرارات بعض المؤسسات التي تحظر النقاب. لكن تلك اللافتات حملت شعارات أخرى مثل "لا للحرية". "الإسلام سوف يحكم بريطانيا". وغير ذلك مما يثير الحنق ويستفز الرأي العام ضدهن ولا يثير أي تعاطف. ربما تكون الصورة كلها مفبركة وتشويهية. لكن تلك الشعارات وقريبا منها كثير رفع في التجمعات والاحتجاجات التي كانت تقوم بها الجماعات المتطرفة في لندن. وأمام مقر الحكومة. وفي غيرها من المدن. تلك التجمعات و"المظاهرات" لا تجذب إلا عدد محدود لا يتجاوز العشرات في كل مرة. لكن في المقابل لا نرى مظاهرات تقوم بها الغالبية المسلمة ترفع شعارات تؤيد الحرية. وتندد بالمتطرفين. وترفض أن يتحدثوا باسمها وباسم الدين. والإعلام بطبيعته التي تركض وراء الإثارة وما يحدث في الشارع يغطي "الحدث" الذي تقوم به التجمعات المتطرفة ويصور شعاراتها المُستفزة. ولن يغطي "الأحداث" الذي تقوم به الأغلبية الصامتة عبر القعود في بيوتها.
518
| 21 أكتوبر 2013
يغترب النص عن الواقع إن تعالى عليه. ثم ما يلبث أن يصبح عالة على الواقع إن يخضع لاشتراطاته وينخرط في تلك الدينامية الإنسانية التاريخية التي تخلط النص بالواقع وتعيد تشكيل الاثنين وفق توافقات وتنازلات دائمة الحدوث. يحدث هذا مع أي نص يتوجه إلى تغيير الواقع. وينهمك في رصد اعتلالات الاجتماع البشري ويأخذ على عاتقه مهمة إصلاحها. أو بتواضع أكثر محاولة إصلاحها. نصوص الأيديولوجيات البشرية التي حاولت مناطحة الواقع وتغييره تقدم تاريخا غنيا وبديعا. متابعته تتيح استنطاق تجارب لا تعد ولا تحصى على طول قرون. واحد دروسه تشير إلى انحناء الأيديولوجيات المتكرر لعواصف الواقع التي لا تقف أو تخف. تولد الأيديولوجيات تفسيرات تنحرف بها عن "المبدأ" الأصلي. وتعيد إنتاج تفسير ذاتها لتخرج بثوب "تصحيحي" أو "ثوري" جديد. جوهره تقديم تنازل آخر للواقع. ذات الصيرورة تحدث أيضاً في قلب النص الديني ذلك أنه مع مرور الزمن واستطالة التجربة التاريخية وتعقدها وتشابك مصالح الطبقات الحاكمة. والمتنفذين. مع مصالح رجال الدين (الذين يحتكرون تفسير النص الديني على وجه التحديد) فإن النص ينخرط عمليا في سيرورة دائمة التغير لناحية التفسير والتطبيق. وفق الإمكانية والسياق. في هذه الحالة يتصدى المفسرون والمفتون للعب دور الوسطاء وتقديم الحلول الوسط بين النص الأصلي والواقع المتغير. حتى لا ينفصل النص عن سيرورة التاريخ. في كلا الحالتين. وفي كل حالات النصوص التي تُقارب الواقع مُقاربة تغييرية. تواجه السمة الاستقلالية للنص عن الواقع. بحسب ادعائها الأولي. واستعلائها عليه ظروف التعرية والضعف التدريجي. كأنما ذاك ضرروة تاريخية لا محيص عنها. تنبع هذه الضرورة من عبقرية الإرادة البشرية في تطويع وتطوير النص ومواءمته مع الواقع الذي يبقى هو المادة الصلبة في التاريخ الإنساني. في مواجهة ذلك يواصل رجال الدين والنخب السياسية الحاكمة اتكاءهم على النص وتوظيفه واستخدامه بما يعني عمليا "وواقعيا" إعادة إنتاجه. وبذلك فإن الجانب الاجتماعي-السياسي-الجمعوي من النص. الديني في هذه الحالة. يظل في عملية مستمرة لا تتوقف عن الإنتاج وإعادة الإنتاج. وهو ما تقوم به التفسيرات المختلفة للنص. والفتوى التي تحاول مصالحته مع الواقع. ما يبقى ثابتا من النص. الديني مرة ثانية هنا. هو ما يتعلق بالجانب الطقوسي-العقدي-التعبدي الذي ينظم علاقة الفرد بخالقه. في مستوى آخر يتبلور النص ويتفاعل وينفعل في قلب الأيديولوجيا مقدما سيرروة مثيرة أخرى. وهو يفعل ذلك في نوعي الأيديولوجيا. الأول وهو ما هو قائم منها على جوهر إنساني والثاني وهو ما هو قائم على جوهر غير إنساني (تسلطي). الأيديولوجيا الإنسانية هي تلك المرتكزة على الحرية وتحرير الإنسان والفرد من كل القيود وتمكينه بالنقد والنقد الشامل الذي يشمل أيضاً نقد الأيديولوجيا ذاتها التي حررته. اما الأيديولوجيا غير الإنسانية فهي تلك التي قد تنطلق لأجل تحرير الإنسان وتقاتل من أجل ذلك لكنها تخضعه لنظام ثقافي. تسلطي. فوقي. بديلا عن النظام الذي حررته منه. وبكونها ذات برنامج فوقي-خلاصي فإنها لا تسمح لهذا الفرد المحرر والمتحرر بأن يتحرر منها أيضاً أو ينقدها. هي تشجعه على نقد النظام الثقافي والسياسي والأيديولوجي المُنقضي. بيد أنها ترفع ذاتها إلى مرتبة عليا. فوق النقد والناقدين. وتتحول إلى منظومة مُستبدة للأفراد الذين حررتهم (النازية. والستالينية كمثاليين ناجزين). من هذا المنطلق يرصد التاريخ تمثلات متعددة للدين. أي دين. أولها. في الغالب الأعم تمثله لأيديولوجيا تحررية انعتاقية تزيح القيود السلطوية والفوقية المفروضة على الفرد والتي تعودت على استغلاله وتعود هو على الخضوع إليها. هنا يعمل الدين على تحرير الفرد من الإكراهات السياقية والأفقية. رابطا مصير المحررين بعلاقة عمودية وطوعية وحسب مع خالقهم. في هذه المرحلة يكون الدين أيديولوجيا إنسانية وثورية. لكن إثر تغلب الدين على بقية السلطويات وإخضاعه لها سرعان ما تتبلور قوى سياسية واجتماعية ونفعية وحتى دينية تعمل على توظيف الأيديولوجيا الجديدة لإخضاع الفرد مرة أخرى. وهذه المرة باستخدام ذات الأيديولوجيا التي حررته. هنا يتحول الدين. وتفسيراته وتوظيفاته. إلى مجرد نظم قوننة جامد ومغلق وتطبيقاته تؤول إلى السلطات التي تسيطر على الفرد والمجموع. ويكون قد تخلى عن مرحلة التحرر والانعتاق ودخل معه الأفراد إلى مرحلة الأيديولوجيا غير الإنسانية. ومن ناحية تاريخية أيضاً لا يسقط الدين كليا في قبضة الفكر المنغلق أو في حفنة من المفسرين الجامدين أو المهووسين بالتضييق والتحريم من ناحية. والتحكم والإخضاع من ناحية ثانية. فالذي يحدث عادة حتى في قمة ظافرية الانغلاق وسدنته هو تواصل سلسلة المقاومة وتجديد التحرر والانعتاق. وطالما ظلت الحرية والنداء إليها شكل أحد الاندفاعات الكبرى وراء الطاقة الثورية للدين. إذ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فإن ما يتمكن منه الانغلاق والاستبداد في حقبة ما يخسره في حقبة لاحقة. في بداية عمره يقترب النص من الواقع بتواضع. يجادل الناس الذين يرون فيه قادما جديدا وغريبا على ثقافتهم وما ألفوه بتؤده ومنطق. هنا يطرح النص بديلا طوعيا واختياريا. يضعه إلى جانب البدائل الأخرى. وفي سياق جدله المُتحول تدريجيا إلى نوع من المعركة الفكرية. يبدأ النص بالتحول إلى شيء آخر – إلى "خطاب". و "الخطاب" يختلف عن النص جوهريا وبشكل شبه تام. النص يصف ويطرح ما يحمل من دون اندفاعة في التشخيص الحاسم وطرح الحل الحاسم. "الخطاب" يطرح المشكلة ويطرح لها الحل التام والمُطبق. و "الخطاب" وبطبيعة حوامله الأيديولوجية والتبشيرية وبرامجه التي تستهدف تغيير الواقع ذاته قليل المهادنة مع "الخطابات" الأخرى. ويضيق ذرعا بما تطرحه. ذاك أنها تنافسه عمليا على ما يقوم به – تغيير الواقع إلى الوجهة التي يريد. وهنا نرصد آلية أخرى من آليات تحول أيديولوجيا ما من طور نزعتها الإنسانية إلى طور الجبر والإكراه والانغلاق. يتحول النص إلى خطاب. وتتحول الأيديولوجيا من العتق إلى الاستعباد.
2086
| 14 أكتوبر 2013
الحديث عن الانتخابات والديمقراطية الكردية تستدعيه حاجتان. الأولى الإشادة بها وبما تكرسه من مأسسة للديمقراطية. والثانية إعادة طرح السؤال لماذا تنجح كل الديمقراطيات المجاورة للعرب (كما في تركيا. في إيران. في إسرائيل. في كردستان. ثم بعيدا في بلدان إسلامية مثل ماليزيا. وإندونيسيا) فيما تفشل ديمقراطيتهم؟ الانتخابات التي نظمت في كردستان العراق آخر الشهر الماضي ونجاحها ونتائجها وما رافقها من ممارسة سياسية وديمقراطية تنتزع الاحترام. لم تكن العملية خالية من العيوب. ذاك أنه وكما في معظم الانتخابات في مناطق العالم. وتبعا لما أوردته تقارير صحفية وتصريحات لأحزاب معارضة. سجلت بعض التجاوزات والانتهاكات هنا وهناك. لكن في المجمل العام رسخت هذه الانتخابات العملية السياسية وعملت على تعميق الممارسة الديمقراطية. وأكدت على التمرين القاسي بتبادل مواقع الفوز والخسارة في المعارك الانتخابية. في هذا الإقليم. وسواه من الأقاليم الكردية سواء في تركيا أم إيران أم سوريا. عانى الأكراد من ظلم تاريخي امتد لعقود طويلة واصطبغ تاريخهم مع جيرانهم بالصراع والدم. وكذا اصطبغت صراعاتهم الداخلية وانشقاقاتهم. بيد أنهم يخرجون الآن. وفي جزئهم العراقي. من تاريخ الصراع إلى تاريخ البناء المؤسسي. ويقدمون لنا. نحن جيرانهم العرب الكثر. درسا في الديمقراطية وفي البناء! ينتقل الصراع من ميادين الرصاص والعنف إلى ميادين السياسة وصناديق الاقتراع.في الانتخابات الأخيرة والتي تجاوزت نسبة المقترعين فيها 74% تنافس الحزبان الرئيسان. الاتحاد الوطني الكردستاني (بقيادة جلال طالباني). والحزب الديمقراطي الكردستاني (بقيادة مسعود برازاني). مع أحزاب المعارضة. وأهمها حركة تغيير (كوران). والحزب الإسلامي الكردستاني وأحزاب أخرى أقل تأثيرا. أحد الحزبين اللذين هيمنا على السياسة الكردية لعقود طويلة. وهو الاتحاد الوطني الكردستاني. مُني بخسارة ثقيلة. وفقد موقعه كثاني أكبر الأحزاب الكردية في السياسة وفي التمثيل البرلماني. وتقدم عليه أهم حزب معارض. حركة تغيير. ليحتل الموقع الثاني بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حافظ على تصدر المشهد والأغلبية البرلمانية. هذا ما تقوم به عبقرية الديمقراطية من تعديل للمواقع ومكافأة الأحزاب العاملة بجد ومعاقبة المتكاسلين أو المسترخين على أوهام إنجازات الماضي أو إرث التاريخ.بيد أن الدرس الأهم والأكثر إيقاعا تمثل في الكيفية التي تلقى فيها الاتحاد الكردستاني خسارته الانتخابية القاسية. وهنا يستحق الحزب وقادته الذين أقروا بالخسارة. التقدير والاحترام. فعلى إثر الخسارة أصدر الحزب بيانا قال فيه: "إن نتائج الانتخابات مقلقة وليست مفرحة.. وأن الحزب يتحمل المسؤولية الكاملة عنها. وسيعيد النظر في آليات عمله. مثلما يحترم إرادة الشعب ويتلزم بها". لم يخرج الحزب إلى الإعلام ليلفق اتهامات بأن الانتخابات مزورة. ويطعن في العملية برمتها. بل توجه إلى نفسه بالنقد الذاتي. مقرا بأن الخسارة سببها سوء الأداء. وفي الوقت ذاته احترم إرادة الشعب التي اختارت غيره.لا يتوقف الأمر عند ذلك. بل أبعد منه ما صدر عن برهم صالح نائب رئيس الاتحاد الكردستاني من إقرار بالهزيمة واحترام لإرادة الشعب. واتهام حزبه ذاته بمحاولة التزوير في بعض المناطق وإدانته لتلك الممارسة بكونها ضد إرادة الناخب الكردي وتصادر قراره الحر. وفي تصريحات نقلها الإعلام يقول صالح: "إن النتائج الأولية لأعضاء الاتحاد الوطني في انتخابات الإقليم تظهر بأن الجماهير غير راضية عن أداء وسياسة الاتحاد الوطني وأسلوبه في إدارة مهامه للمرحلة الراهنة.. وأن الخسارة مُرّة ولكن التهرب من قرار الشعب مخجل وأن أي شخص أو جهة تحت أي ذريعة كانت إذا ما سعت للتلاعب في قرار الشعب فإنها تخالف قرار المكتب السياسي وقيادة الاتحاد الوطني فضلا عن أنها تخالف إرادة أعضاء الاتحاد وأي مسعى بهذا الخصوص يُعد أمرا مخجلا.. (مشددا) على ضرورة التزام المكتب السياسي للاتحاد بإرادة شعب كردستان والتمعن في رسالة العتب والنقد التي بعثها ومراجعة سياسات الاتحاد وقيادته. وأسلوب عمله على أمل الحصول على دعم وثقة الشعب".أيا ما كانت خلفية تلك التصريحات والتي يقلل البعض من شأنها ويحشرها في نطاق الصراع داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. إلا أنها والعملية برمتها يجب أن تدفعنا للتأمل. عربيا. في وضعنا نحن وفي معظم الدول العربية برؤية نقدية والتساؤل لماذا تستعصي الديمقراطية العربية وتتقدم غيرها. كل الأطروحات التي وقفت في وجه الديمقراطية في دول ما بعد الحقبة الكولونيالية تفككت أطروحة إثر الأخرى. ولم تعد هناك أي منها تمتلك الطاقة على الاستمرار. وتبعا لذلك فقد قصرت إعمار النظم الاستبدادية في العالم والمنطقة. وبدا تيار الديمقراطية وموجتها زاحفاً كقدر تاريخي. تآكلت أطروحة تأخير الديمقراطية حتى تنتهي الدول الناشئة والمستقلة حديثا من طور البناء الاقتصادي والاجتماعي. وتأمين الطبقة الوسطى التي تشكل البنية التحتية التي تقف عليها الديمقراطية بصلابة. وبرزت تجارب ديمقراطية ناجحة في دول فقيرة. وفي دول تعدادها السكاني مهول مثل الهند. وتآكلت أطروحة إثارة العداء للديمقراطية والحداثة بمسوغ أنهما منتجات غربية وامبريالية يفرضها المتروبول الاستعماري على الهوامش العالمثالثية. وثبت أن كل تلك المقولات لم يكن لها هدف سوى تسويغ الاستبداد "النضالي" الذي استظل بمظلة الأخ المُستبد الأكبر في موسكو خلال الحرب الباردة. كما تآكلت أيضا مقولتان أخريان استخدمتا "لدرء" الديمقراطية عربيا بسخاء وتكرار. وهما الانشغال في الحرب مع إسرائيل. والخصوصية الثقافية. وُظفت الأولى من قبل أنظمة على اليسار وعلى اليمين. وتحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" قُمع صوت الشعب نفسه وأخرس وتم الحجر على إرادته وكأنه مجموعة من المعوقين الذين لا حق لهم في شيء سوى السمع والطاعة والتبعية. مرت عقود طويلة على صوت المعركة ودفن الديمقراطية فلم ينتج عن تلك المعركة الصورية سوى سلسلة من الهزائم. أما الخصوصية الثقافية فقد اشتغلت بفاعلية أيضاً لكن هاهي تستنزف طاقتها وفاعليتها. فهنا تكررت مقولات عدم موائمة الديمقراطية مع "الثقافة" العربية والتقاليد ومع الدين أيضا. وأن ما يسود في البلدان العربية هو أنماط حكم تقوم تقليديا وعرفيا على الاستئثار بالحكم من قبل القبيلة والعائلة. وكأن الاستبداد مكتوب كقدر ثابت على العرب ويسري في دمائهم. لم يعد لأي من تلك الطروحات مكان مُعتبر في ثقافة اليوم. ومع ذلك لا تزال الديمقراطية العربية عرجاء. ويدفعنا عرجها للتطلع إلى الجوار مرة هنا. ومرة هناك. وهذه المرة إلى إخوتنا الأكراد ونجاحهم الديمقراطي الذي نرفع له القبعات.
508
| 08 أكتوبر 2013
تتغير الحكومات في إيران لكن ما لا يتغير هو استمرار صعود إيران في المنطقة وتزايد نفوذها. سواء أكان الحكم في طهران متطرفا بقيادة أحمدي نجاد. أم معتدلا بقيادة حسن روحاني فإن مسار السياسة الإيرانية يبدو متجها في ذات الخط التصاعدي. ليس ثمة عبقرية خاصة تميز تلك السياسة تقودها إلى إنجازات من نوع مختلف. بل هو الفراغ الإقليمي العربي وضعف الدول العربية هو الذي يغري دولا إقليمية مثل إيران وتركيا كي تحتلان موقعا متميزاً في قلب النفوذ الإقليمي. مُضافا إلى ذلك غباء السياسة الأمريكية في العراق التي انتهت إلى تقديمه على طبق من فضة لطهران ونفوذها. خلال فترة حكم نجاد اختلطت السياسة الإيرانية وتوسعها الإقليمي بنبرة أيديولوجية دينية وشعارات وتهويمات الرئيس نفسه الذي كان يعيش عالمه الغيبي الخاص به. في السياسة ليس اخطر من رجل يعتلي هرمها وتقوده أحلام أو أوهام الأيديولوجيا ويظن أن الغيب أوكل إليه مهمة إصلاح الكون. كان نجاد يعتقد أنه قائد جيش المهدي المنتظر وأن ظهور هذا الأخير بات وشيكاً وكل ما كان يقوم به نجاد هو التمهيد الضروري لعودة ظهور الإمام. وكان يرى في الغزو الأمريكي للعراق محاولة أمريكية يائسة لتأخير ظهور الإمام لأن وسائل الاستخبارات الأمريكية علمت قبل غيرها بموعد الظهور! بكل الأحوال صار ذلك خلف ظهورنا. ونأمل إلى الأبد. مع انتخاب وتولي حسن روحاني الحكم الذي يتأمل كثيرون أن يفتح صفحة جديدة في السياسة الإيرانية خاصة لجهة علاقات إيران مع جيرانها العرب. لكن المواقف والتوجهات التي يمكن رصدها حتى الآن من سياسات الحكم الجديد تشير إلى الشيء ونقيضه وما زالت لم تترسخ. ومن الموضوعي منحها فترة أطول حتى تتبين بشكل أوضح ومن ثم يتم الحكم عليها. لكن الشيء المقلق هو أن تتغير السياسة الإيرانية دوليا وتتصالح مع الغرب في الوقت الذي تبقى على حالها من تشدد وبسط نفوذ وتدخل على المستوى الإقليمي. بل وأزيد من ذلك أن يوفر لها انفتاحها على الغرب وتقديمها تنازلات في الملف الأهم بالنسبة للدول الكبرى. وهو سقف امتلاكها التكنولوجيا النووية وقدرتها على تحويل تلك التكنولوجيا إلى المجال العسكري. فرصا جديدا للاستقواء الإقليمي وتكريس سياسة التدخل في الجوار وبسط النفوذ. والشيء الأكيد هنا هو أن طهران تقرأ وتستوعب الدرس السوري جيدا ومدى الهوس الغربي بسلاح سوريا الكيماوي الذي أدهش وفاجأ حكام دمشق أنفسهم. حيث اكتشفوا أن هذا السلاح هو رافعة النجاة للنظام. ليس عبر استخدامه بل عبر التفاوض مع الغرب على تسليمه. ومن شبه الأكيد هنا أن تكون طهران قد قدمت نصيحة غالية لدمشق لقبول فكرة تسليم السلاح الكيماوي. بهدف كسر الانسداد السياسي الذي كان يواجه الحكم في سوريا. وفتح الطريق واسعا إلى "المفاوضات مع الغرب" حول كيفية وآلية تسلميه. والجدول الزمني. وترتيبات السلامة. والبروتوكول السياسي والدبلوماسي والأمني. وقائمة طويلة لا تنتهي من الإجراءات. طهران التي تمتلك خبرة عريقة في "المفاوضات مع الغرب" حول الملف النووي سوف تكون إلى جانب دمشق تمدها بتلك الخبرة. وسوف تطول مفاوضات الملف الكيماوي السوري مع الغرب كما طالت شقيقتها الإيرانية. وخلال ذلك يستقوي النظام ويستمر في طحن الشعب السوري دفاعاً عن حكم الإقطاع الأسدي. كانت طهران تدرك أن الملف النووي هو الورقة الأهم إن لم تكن الوحيدة التي تمتلكها على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة والغرب من أجل اكتساب اعتراف بموقع ومصالح إيران في المنطقة والكف. حسب ما تقول طهران. عن التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية. والآن جاء الدرس السوري ليس ليؤكد ما كانت تعرفه إيران وحسب. بل ولتدهش حكامها بمدى هوس الغرب واستعداده لتقديم تنازلات كبيرة في سبيل تحييد هذا السلاح في سوريا. ثم في إيران. لم يهم الغرب أن أكثر من مائة ألف سوري قتلوا بالسلاح التقليدي غير الكيماوي. ذلك أن هذا السلاح فعال فقط ضد الشعب ولا فاعلية له خارج حدود سوريا. وتحديدا مع إسرائيل. وكذا الأمر بالنسبة للملف النووي الإيراني. فطالما تم تحييده فإن خطر إيران على إسرائيل (سواء أكان حقيقيا. أم متوهماً) سوف يتم إبطاله. في المقابل تُترك إيران حرة وطليقة في سياساتها الإقليمية وإزاء جيرانها. على ذلك فإن المرحلة المُقبلة سوف تشهد تحديات كبيرة للنظم الإقليمي العربي المتداعي أصلا إزاء ما قد تصل إليه المفاوضات الإيرانية الغربية. فطهران روحاني سوف تكون في الغالب أكثر اعتدالا وبراغماتية مع الغرب إزاء الملف النووي. وليس من المُستبعد أن تصل معادلة شبيهة بالمعادلة الروسية وأساسها هو: التنازل للغرب من أجل السيادة في الإقليم. ولأن بوصلة الاهتمام الأمريكي والغربي عامة هو أمن إسرائيل فحال أن يتم تأمين ذلك بشكل مطبق. فإن إطلاق يد طهران إقليميا لن يقض مضاجع الرئيس الأمريكي أو حلفائه. وهذا يُبقي التحدي الحقيقي والكرة الملتهبة في الملعب العربي ويطرح الأسئلة الصعبة التي يجب التصدي لها وهي كيفية التعامل مع إيران. وما هي الرهانات على طهران الجديدة وحاكمها الجديد. وما هي نسبة الجديد والمتغير إزاء القديم والمستمر في سياستها. المعضلة الكبيرة في السياسات العربية. في كل القضايا تقريبا. هو التردد والبطء وعدم الإقدام. على العكس تماما من السياسة الإيرانية التي تتصف بالهجومية وعدم التردد. خلال سنوات الثورة السورية الثلاث دخلت إيران في قلب النار من دون تردد. ووقفت إلى جانب نظام الحكم الدموي ولم تأبه لأي شيء آخر. كانت تدرك أن سقوط النظام يعني إنحسار نفوذها الإقليمي وانكسار الهلال الإيراني في الحلقة الأهم منه. في المقابل لم يكن هناك موقف عربي يتسم بنفس السمات في سوريا مؤيدا لثورتها. وإذا نظرنا إلى سياسة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في السنتين الماضيتين فإننا نرى بوضوح التردد والتراخي في الملف السوري. وعندما صار هناك موقف خليجي مبادر وفعال وهجومي فقد اتجه للمعركة الخطأ. أي في مصر. واستنزف الجهد والموارد والتخطيط للحرب على نظام الإخوان في القاهرة وهو النظام الذي كان سقوطه محتما بالانتخابات وبالإرادة الشعبية ومن دون تدخل خارجي. وفي غمره الانهماك في مصر. كانت إيران تتجذر في سوريا واليمن والمنطقة كلها.
524
| 23 سبتمبر 2013
أخطر القادة هم أولئك الذين تصيبهم لوثة الشوفينية القومية، وتستبد بهم شهوة إعادة بناء الأمجاد الغابرة واستحضار الماضي باعثين في شعوبهم مشاعر الضحية والفقدان ومستفزين فيهم غرائز الانتقام من الآخرين. هناك في تاريخ البشر والسياسة قومية حميدة وهناك قومية مدمرة. الأولى تعكس الانتماء الطبيعي والعفوي للوطن والثقافة والهوية. من دون مبالغة وانجرار باتجاه الإدعاء بالتفوق الإثني والثقافي على الآخرين ومن دون احتقار القوميات الأخرى، القومية الحميدة تُطلق طاقات الناس الإيجابية لخدمة جماعتهم ووطنهم والاعتزاز به والتنافس مع "الأوطان" الأخرى عن طريق الإنجازات. وليس عن طريق التباهي بـ "نقاء الدم" أو أمجاد الماضي أو عظمة التاريخ الذي أغلب مراحله تكون متخيلة أو مركبة والخيال الجامح فيها أكثر من الحقائق. النوع الثاني من القومية" القومية المدمرة" هي تلك الشوفينية التي تختلط مع العنصرية وتنظر للذات القومية بكونها الأعلى والأفضل تراتبية. وترى الآخرين وقومياتهم وأوطانهم يحتلون دوما مراتب أدنى على السلم القومي وسلم "الأجناس والإثنيات". كثير من الحروب الدموية التي دفعت فيها البشرية ملايين الضحايا نشبت عن جنون القوميات الإثنية أو الدينية. حيث يأتي قائد ما مهووس بجنون الأفضلية وسيكولوجيا الضحية، ويريد أن يصوب التاريخ ويضع المستقبل "على الطريق الصحيح" رغما عن كل الحقائق الموضوعية الأخرى. كل ما يقف في وجه مشروع إعادة المجد الغابر وفي وجه تصويب التاريخ وتثبيت بوصلة المستقبل يجب أن يُحارب، ويُزاح، ويُستأصل. من قلب الشرق الصيني والياباني. إلى قلب الغرب الأوروبي مرورا بكل جهات الأرض. هناك نماذج وسيرورات قومية من المفترض أن تكون قد وفرت أمثلة وتجارب تردع عالمنا من التورط في مساراتها. في أوروبا مازالت تجربة القومية النازية والرعب والموت الذي جلبته على القارة طازجا. لأن تلك القومية رأت في الجنس الآري العنصر النقي الأعلى والذي يجب بالبداهة أن يحكم أوروبا والعالم كله من ورائها. كل من يعتبر عائقا وحملا ثقيلا يحول دون المضي في طريق ذلك "المشروع الطبيعي". أو حتى يبطئ من انطلاقه فإن مصيره الاستئصال والموت. القوميات الشرسة لا تدجن بسهولة فضلا عن أن تموت، رأى العالم كيف انبعثت القومية الصربية من تحت ركام عقود طويلة من القيد اليوغسلافي، وانقضت على من جاورها والحلم الذي يقودها بكل عماء هو صربيا الكبرى. صربيا العظيمة والمتسيدة. كما كانت مُتصورة في عقول قادة مهووسيين مثل سلوبودان ميلوسيفتش ورادوفان كارديتش. كانت النتيجة مجازر وإبادة عرقية في قلب أوروبا مرة أخرى. في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو. الليبرالية والديمقراطية هي الآليات التي اقتحمت فضاء القوميات الشرسة وعملت على تدجينها. الليبرالية الديمقراطية تتجاوز التراتبيات الإثنية والقومية الحادة. وتعلي من قيمة الإنجاز كمعيار تفاضل. وتكرس مبادئ المساواة بين البشر على أساس إنسانيتهم. هناك بالطبع اختلالات كبيرة في التطبيق. خاصة عندما نلاحظ خفوت أو عدم انعكاس تلك المبادئ في السياسات الخارجية. لكن الشيء المهم والأساس في الليبرالية الديمقراطية أنها توفر معايير إنسانية وعالمية للاحتكام إليها. غير مرتكزة على أي أسس قومية. روسيا بوتن اليوم هي روسيا المهجوسة بإعادة بعث القومية الروسية وأمجادها الغابرة. خطاب بوتن وسياساته الداخلية وبرامجه الانتخابية التي طرحها أثناء ترشحه للرئاسة تنبعث منها روائح الشوفينية. ولتحقيق أحلام "روسيا فوق الجميع" فإن ذلك يعني تبني سلسلة من السياسات الداخلية والخارجية التي تقوم القسر والقوة والإزاحة الإجبارية. داخلياً تبنى بوتن مفهوم "الديمقراطية السيادية" وهو مفهوم فضفاض وغامض، المقصود المُعلن منه هو عدم السماح لأي أطراف أجنبية في التدخل في "سيادة" روسيا من خلال التدخل في ديمقراطيتها وأحزابها وجمعيات المجتمع المدني فيها. التطبيق المباشر لـ "الديمقراطية السيادية" كان تشديد القبضة البوليسية على الحريات العامة، والجمعيات، والإعلام. وقولبة كل ما هو موجود في المجتمع والسياسة والثقافة وفق رؤية بوتن. وكأحد الأمثلة المُدهشة الآن ليحاول القارئ أن يتذكر إن سمع رأياً حول الشأن السوري من أي سياسي أو صحفي أو مثقف أو ناشط أو أكاديمي روسي يخالف الرأي الرسمي؟ في أي بلد آخر على الجهة الأخرى من "الديمقراطية السيادية". وبدءا من الولايات المتحدة وحتى تركيا ومرورا بكل البلدان الأوروبية هناك طيف واسع من الآراء يشمل السياسيين والإعلاميين والكتاب والأكاديميين. في السياسة الخارجية ينطلق بوتن من شوفينية روسية إزاء الجوار الإقليمي تذكر بسياسة هتلر. فبوتن يرى في الجمهوريات الآسيوية "الحيز الحيوي" لروسيا. والذي يفرض على موسكو أن يبقي تلك الجمهوريات تحت النفوذ الروسي وتابعة له. سواء أكان ذلك تحت ظل الاتحاد السوفيتي وعبر الشيوعية الأممية. أو عن طريق مباشر ومن دون التخفي وراء أي مشروعات أيديولوجية. ولم يترك بوتن أي مجال لأي متشكك في سياسته إزاء الجوار الإقليمي. وهي السياسة التي قامت على القسر والبطش والتركيع. من الشيشان وتسوية عاصمتها غروزني بالأرض. إلى جورجيا وتركيعها وتنصيب نظام موال لموسكو فيها. بوتن الذي يتشدق بضرورة التزام الدول الكبرى بالقانون الدولي عند طرح أفكار التدخل الخارجي في سوريا. داس على ذلك القانون وتبختر عليه جيئة وذهابا في الجوار الإقليمي. ثم لفظه بعيداً. قيصر موسكو الذي يريد أن يدخل التاريخ بكونه من أعاد بعث المجد الروسي بعد الإذلال الذي تعرضت له روسيا إثر انهيار الإمبراطورية السوفيتية. وبكونه من أعاد توحيد الأراضي السلافية. ولأنه مهجووس بشوفينية روسية عابرة للحدود وخطيرة فإنه لا يخجل من رعاية ما يُعرف بـ "نادي ثعالب الليل" وهم مجموعات من راكبي الدراجات النارية. والمعروفون بشعور رؤوسهم ولحاهم الكثة. والأوشام والسلاسل التي تملأ سواعدهم وصدورهم. ويعتبرون من أشد مؤيدي بوتن ونظرته القومية الشوفينية. وهم يطوفون في رحلات طويلة سواء في روسيا أو البلدان المجاورة لها. وأحيانا تستهوي بوتن أن يرافقهم في بعض جولاتهم. وفي حادثة مشهودة تناقلتها وسائل الإعلام العام الماضي توقف بوتن مع "ثعالب الليل" في إحدى جولاتهم في أوكرانيا خلال زيارة رسمية له للبلاد وتجول معهم وأبقى الرئيس الأوكراني منتظرا له أكثر من أربع ساعات. وفي نفس تلك الزيارة نقلت أقوال وعهود أخذها "ثعالب الليل" على أنفسهم أمام بوتن بأنهم سيبقون إلى جانبه كي يساعدوه في توحيد الأراضي السلافية التي قسمها الأعداء! الذين يصفقون لبوتن وروسيا على "القوة" و"العظمة" التي يبديها في السياسة الدولية عليهم أن يراجعوا أنفسهم. روسيا بلد عظيم وتاريخها غني ولا تحتاج إلى سياسة شوفينية كي تثبت نفسها. القومية الشوفينية تقضي على الذات قبل أن تقضي على الآخرين. هذا هو درس التاريخ الذي لا يمل من تعليمنا.
966
| 16 سبتمبر 2013
مساحة إعلانية

يطلّ عليك فجأة، لا يستأذن ولا يعلن عن...
4332
| 26 سبتمبر 2025

في قاعة الأمم المتحدة كان خطاب صاحب السمو...
4059
| 25 سبتمبر 2025

هناك لحظات تفاجئ المرء في منتصف الطريق، لحظات...
3942
| 29 سبتمبر 2025

تواجه المجتمعات الخارجة من النزاعات المسلحة تحديات متعددة،...
1533
| 26 سبتمبر 2025

في ظهوره الأخير على منصة الأمم المتحدة، ملامحه،...
1251
| 29 سبتمبر 2025

بعض الجراح تُنسي غيرها، ليس بالضرورة أن تكون...
1242
| 28 سبتمبر 2025

أُنّشِئت الأمم المتحدة في العام ١٩٤٥م بعد الحرب...
1173
| 28 سبتمبر 2025

يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودا ويخططون لاغتيال...
1047
| 24 سبتمبر 2025

من أخطر ما يُبتلى به التفكير البشري أن...
1038
| 29 سبتمبر 2025

في قلب الدمار، حيث تختلط أصوات الأطفال بصفير...
942
| 23 سبتمبر 2025

صاحب السمو أمام الأمم المتحدةخطـــــاب الثبـــــات علــى الحــــــق.....
915
| 24 سبتمبر 2025

تعكس الأجندة الحافلة بالنشاط المكثف لوفد دولة قطر...
831
| 25 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية