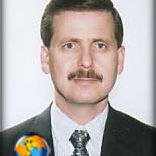رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أسوأ أنواع الحصار أن تُحاصرَ نفسك. هذا ما تفعله شرائحُ من السوريين بنفسها اليوم. وهي إذ تفعل ذلك لا تكتفي بأن تحشر نفسها في زاوية، وإنما تُدخِلُ حاضرَ سوريا ومستقبلها في مأزقٍ كبير، لا داعي له أساسًا. منذ أسبوع، خرج علينا الروس والأمريكان بما أسموه مشروع "اتفاق هدنة". وفي هذا الإطار، أرسل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، مايكل راتني، رسالةً إلى هيئات وفصائل المعارضة السورية تخاطبهم بعبارات مثل "نحتاج من المعارضة" و"ينبغي على المعارضة"، فيما يتعلق بقرارهم تجاه الاتفاق المذكور.الرسالة، باختصار، مُهينة. ومن الغريب ألا ينتبه لهذا دبلوماسيٌ مثل راتني، يُفترض أن يكون مُحنكًا، وأنه صار خبيرًا بالشأن السوري وحساسياته. يكفي حجم الاستغباء للسوريين الموجود، مثلًا، في هذه العبارة منها، حيث يقول راتني: "لقد كان التعامل مع روسيا صعبًا للغاية، إذ من الصعب جدًا إجراء هذه المباحثات مع الروس حتى وهم يقتلون السوريين بشكل يومي. تسألنا المعارضة باستمرار: (كيف يمكن لروسيا أن تظل راعية للعملية السياسية بينما تتصرف في الوقت نفسه كطرف أساسي في الصراع). ونحن نسأل أنفسنا هذا السؤال كل يوم"! .أما الاتفاق المذكور، فلا تكفي كلمة "الإهانة" لوصفه. فهو، فوقَ ما فيه من تجاهلٍ لحقائق الواقع وازدواجية المعايير، لا يحمل الحد الأدنى من الانسجام مع مقتضيات القانون الدولي، بل ومع مقتضيات المنطق الإنساني الأخلاقي السليم، أيضًا في حدِّهِ الأدنى.أوجه المشكلة في الاتفاق كثيرةٌ، وباتت معروفة. وصدقَ الزميل عبدالوهاب بدرخان حين وصفه بأنه (اتفاق هدنة بشروط روسيا ولمصلحة الأسد وإيران).رغم كل هذا، لم يكن ثمة تناقضٌ أبدًا بين صدور موقفٍ سلبي من الاتفاق من ناحية، وبين كون صدورهِ، من ناحيةٍ أخرى، فُرصةً للقيام بخطوةٍ لا مفر منها، سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا، تتمثل في إلغاء أي وجودٍ لتنظيم القاعدة في سوريا، بات يتمثل الآن في جبهة "فتح الشام".في هذا الإطار، حصل حِراكٌ كبير في أوساط الفصائل المسلحة بعد إعلان الاتفاق والرسالة كليهما، بحثًا عن قرارٍ صائب، كونَهما يحملان تهديدًا باستهداف الجبهة، ويُطالبان الفصائل بـ"المفاصلة" معها. وكتب الدكتور مازن شيخاني، الذي كان مستشارًا سياسيًا لكبرى الفصائل في أيام نشأتها، رأيًا أرسَلهُ إلى الفصائل التي طلبت منه الرأي، يقول فيه: "نعم نحن في مأزقٍ حقيقي وخطير، ويحتاج جرأة أخلاقية كبيرة، وموقفًا إسلاميًا أصيلًا... لو أن سوريا والشعب السوري هم المُقدَّمونَ على مصلحة الفصائل مهما قَدَّمَت، وأيًا كان نصيبُها من العمل، فهناك مخرجٌ وأي مخرج. على القاعدة أو فتح الشام، لا فرق، وأيضًا أشباهها من الفصائل أن تحلَّ نفسها نهائيًا، وتترك الشباب ليلتحقوا بباقي الفصائل، وتختفي من المشهد السوري نهائيًا، بخطابها وكل رموزها. وتتخلى الفصائل الإسلامية عن مشاريعها الوهمية، وتعلن أن كل جهدها مُنصبٌ فقط على الجانب العسكري، الذي يهدف إلى إسقاط النظام، وحماية الشعب السوري، كل الشعب السوري، وحماية قراره وحريته في شكل الدولة بعد الثورة، وأن مستقبل سوريا السياسي يحدده الشعب... وإن أصرَّت فتح الشام على تعنُّتها مع من يشبهها من الفصائل، وظلت أسيرةً لثقافةِ أزمتها، متذرعةً بما قَدَّمَت وضَحَّت، فهي رسالةٌ واضحةٌ منها أنها ومشاريعها أهمُّ من كل الشعب السوري، حتى لو استمر نزيف الدم، وقَضى على ملايين الناس، ودمَّر البلاد والعباد. وعندها ستكون هي مع النظام مسؤولةً عن استمرار المأساة، وستلقى الله بدماء الأبرياء الذين ضحت بهم من أجل أجنداتها الفصائلية. ولتنتظر حتى تُدمرَ آلة الأعداء أركانها في سوريا، ليذهب من نجا منها لبلدٍ آخر ثائر، ويُعلنوا مشروعهم متفاخرين بالنصر الذي حققوه في بلاد الشام، كنصرهم العظيم الذي حققوه في العراق على لسان الجولاني، إذ لم يستطع أعداء الأمة القضاء عليهم، فنقلوا التجربة لبلدٍ جديد. أما ما لحق تلك البلاد من دَمارٍ فهو ثمن نصرهم المزعوم. المخرج الوحيد والله أعلم أن يقف علماء الأمة وشيوخها ومؤسساتها الشرعية والفصائل موقفًا موحدًا يطالب بخروج القاعدة من المشهد السوري، وأن يكون الأمر مشروعًا وليس مجرد بيانات ومطالبات"...لم تستمع سوى قلةٌ من أصحاب الرأي والقرار لهذا الرأي الحكيم، والإستراتيجي. وأصرَّ كثيرون على أن يحاصروا أنفسهم وثورتهم وأهلهم وبلادهم، وأن يعتبروا رفضَ الاتفاق والرسالة يؤديان بالضرورة لرفض "استهداف جبهة فتح الشام". هذا تفكيرٌ بطريقة ثنائيات "إما، أو" المتناقضة. وهو منهجٌ لا يوفر فُسحةً لتفكيرٍ خلاق يستفيد من كل الأوراق المتوافرة. أين المشكلة في رفض الاتفاق المجحف من جانب، والتفكير بشكلٍ واقعيٍ وإستراتيجي من جانبٍ آخر، ومطالبة الجبهة بأن تحلَّ نفسها كليًا؟ وإذا غاب التفكير السياسي الإستراتيجي، ألا يقضي الواجب الديني وضعَ مصلحة الجماعة الكبرى، متمثلةً بالشعب السوري، فوق مصلحة أو سمعة أو اسم أي فصيل، كما أوضح الدكتور شيخاني في رأيه بشكلٍ لا يحتاجُ لمزيدِ بيان؟يقول البعض إن استهداف الجبهة سيكون مقدمةً لاستهداف فصائل أخرى تُعتبر الآن "معتدلة". هذا احتمالٌ قائم، لكن التعامل معه يتطلب حسابات دقيقة لترجيحَ مصالح كبرى وعامة ومستقبلية على مصالح صغرى خاصة وعاجلة. وهذا ترجيحٌ يحتاجه السوريون بشدة، لأنه وحده الذي يُحررُ من الإصرار على مثالياتٍ موهومة، ليس لها نتيجةٌ سوى الهلاك أو الانتحار الجماعي.
468
| 18 سبتمبر 2016
في "التضحية" بقيم العبادات الإسلامية: أحكام "الأضحية" مثالًا "ثمانون مسألةً في أحكام الأضحية"، هذا عنوان أحد الأبحاث المتعلقة بأضحية العيد. وبشيءٍ من التأمل، لا يجدُ المرء، عقلًا ومنطقًا، طريقةً أخرى لتفريغ العبادات الإسلامية من القيم الكبرى، الواضحة والفِطرية، الكامنة فيها، أكثرَ فعاليةً من هذه الطريقة.لم يكد يوجد مسجدٌ على هذه الأرض لم يتناول موضوع الأضحية في الجمعتين السابقتين، وإذا تابعتَ الموضوع بقصد الاستقصاء والدراسة، تسمع بشكلٍ عام شكوى مريرة ممن حضرَ الخطب المتعلقة بهذه القضية. ويبدو أن عملية (التسابق) على التفصيل والتوسيع في الحديث عن أحكام الأضحية انتقل من بطون الكتب إلى منابر المساجد.بدءًا من التعريف، قال خطيبٌ مشهور: "سُميت أضحية من وقت ذبحها اشتقاقًا من وقت الضحى الذي تذبح فيه، إنها من بهيمة الأنعام فلا تجزئ من غيرها، والذين يريدون تطيير الشريعة تحت عنوان تطوير الشريعة، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يخرجون اليوم بالفتاوى المعوجة لتغيير الدين وتبديله".. ويكتب آخر قائلًا: "من ذبح أضحيته ليلة العيد نظرًا للزحام على الجزارين فإنها لا تقع أضحية وإنما شاته شاة لحم، وعليه أن يذبح مكانها أخرى".هكذا، من اللحظة الأولى، يجري التأكيد على مسائل وقضايا استنبطها الفقهاء تاريخيًا من بعض النصوص، ويتم تحويلها، ولو من دون قصد، إلى قواعد تَحكمُ الشريعة، ثم تُحاصرُ بها قيم الإسلام الكبرى والأصيلة الكامنة في عباداته، ويُتهمُ كل من يدعو لمراجعتها بأن هدفهم الحقيقي هو "تطييرُ الشريعة".يتحدثُ النص القرآني عن نوع الأضحية بكونها من "بهيمة الأنعام". وفي المعاجم، تدل كلمة "بهيمة" على "كل ذات قوائم من دواب البر والبحر، ماعدا السِّباع" وقال بعضها: "البهيمة، الحيوان مُطلقًا". وكذلك، وردت كلمة "الأنعام" في مقامٍ آخر في القرآن: {أحلت لكم بهيمة الأنعام}، وثمة غالبيةٌ من الفقهاء تقول بأن المقصود هو "الأنعامُ كلُّها". قال أبو جعفر: "الأنعام كلها: أجنتها وسخالها وكبارها. لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك "بهيمة وبهائم"، ولم يخصص الله منها شيئا دون شيء. فذلك على عمومه وظاهره، حتى تأتي حجة بخصوصه يجب التسليم لها".رغم ذلك، تُصرُّ الغالبية العظمى من الفقهاء، تاريخيًا وفي الحاضر، على حصر تعريف "بهيمة الأنعام" في الإبل والبقر والغنم عندما يتعلق الأمر بأضحية العيد. كيف يُقبل هذا التناقض مع التعريفات المُعجمية أولًا، ثم مع تفسير نفس الكلمتين في آيتين من القرآن الواحد؟ على تناقضها مع التيسير للناس في كل مكانٍ في هذا العصر توجد فيه أنعامٌ من كل نوعٍ ولون.أكثرُ من هذا، نجد فقهاء عاشوا بعيدًا عن بلاد العرب على امتداد مئات السنين، ومن المعاصرين، يذكرون عبارة "وهذا هو المعروف عند العرب" بعد حديثهم عن تعريف بهيمة الأنعام. ولا يخطر في بال هؤلاء أن تفسير آية قرآنٍ جاء يخاطب الإنسانية في كل زمان ومكان بهذا الشكل (القومي) هو تعسفٌ خطيرٌ من جانب، وعودةٌ لشرائع الإصر والأغلال والتعسير على الناس من جانبٍ آخر. والغريب أكثرَ وأكثر أن يتجاهل غالبية الخطباء والفقهاء رواية النووي لما "حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش"، ولو على سبيل الإشارة إلى وجود من فَكَّرَ بشكلٍ منطقي يُحقق المقاصد في تاريخنا الفقهي.ومن الأحكام المذكورة بإلحاح، التشديدُ على ضرورة الالتزام بعمر الأضحية، إلى درجة أنه لا يجوز التضحية، مثلًا، ببقرةٍ عمرها سنتان إلا بضعة أيام، ولو كان وزنُها، ولحمها الذي سيُعطى للناس، ضعفَ بقرةٍ أخرى أتمت سنتين، في حين (تجوز) التضحية بالثانية! ما من شكٍ أن ثمة أحكام للأضحية تَظهر الحكمة في الالتزام بها، لأنها تحقق مقصد العبادة، ومنها مثلًا أن تكون الأضحية خاليةً من العيوب. لكن كثيرًا من العاملين في الفقه، تاريخيًا وفي زمننا الراهن، يعودون لمسألة التعسير على الناس حتى في مثل هذه المواضع. وحين تجد مثلًا أكثر من ثلاثين عيبًا يتحدث الفقهاء عن (الكراهة) في التضحية بوجود أيٍ منها، ومنها ضعفُ البصر وصِغرُ الأذنين ورائحة الفم! فإن هذا يناقض كل معاني التيسير الذي يهدف إلى مساعدة الإنسان على تحقيق مقصد العبادة في مُجمل ظروفه وأحواله.تطول قائمة أحكام الأضحية، وفيها مثلًا تفضيلٌ لِلَونها، بحيث تكون أقرب للون الأملح، على أساس الاقتداء بلون أضحية الرسول الكريم؛ وحصرُ توقيت الذبح لكل المسلمين في العالم، وليس للحجاج فقط، بشكلٍ تتوافر معه ملايين أرطال اللحم فقط في هذه الفترة المحددة، ولا يعلم إلا الله كم يفسدُ منها، في حين يبقى ملايين الناس محرومين حتى من رائحة اللحم بقية العام. ثم إن الأضحية تكفي عن أهل البيت الواحد، لأخَوين وعائلتيهما، مهما كان عددهم (لنفرض 10 أشخاص)، أما إن كانا يعيشان في بيتين منفصلين فيجب التضحية لكل واحدٍ منهما (ولو كان عدد الأفراد فيهما 6 أشخاص مثلًا). إلى غير ذلك من أحكام.ثمة خيرٌ كبير يمكن أن ينتج عن أداء المسلمين لشعيرة الأضحية بفهمٍ مقاصدي أصيل. رغم هذا، من الواجب التخفيف على الناس فيما يتعلق بمشاعر من لا يستطيع منهم أداءها. لهذا، يكون غريبًا تهميش قضايا من مثل ماقاله ابن العربي المالكي في كتابه "عارضة الأحوذي": "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح". وكذلك ما رواه البيهقي قائلًا: "رأيت أبا بكر وعمر كانا لا يُضحّيان كراهية أن يُقتدى بهما". وروايته الأخرى، بإسناد صحيح، عن أبي مسعود البدري الذي قال: "إنّي لأدع الأضحى وإنّي لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنّه حتم عليّ".وأخيرًا، فإن من عجائب الأحكام المذكورة "إجماع" الفقهاء على أن ذبح الأضحية أفضلُ من التصدق بثمنها، بل إن اسمًا كبيرًا يكتب في الموضوع قائلًا: "ولذلك كان الذبح أفضل من التصدق بأضعاف ثمن الأضحية، قال سعيد بن المسيب رحمه الله: "لئن أضحي بشاة أحب إلى من أن أتصدق بمائة درهم"، فلعلها تشهد يوم القيامة لصاحبها بقرونها، وأشعارها، وأظلافها، وحتى المكان الذي يقع عليه دمها".يرحم الله ابن المسيب على قدر نيته، لكن السؤال يبقى كبيرًا: أين مَن يجلد الناس للالتزام بهذه الطريقة في التفكير من حال مئات الملايين من فقراء المسلمين وغيرهم في هذا العصر؟ بل أين هو، قبل ذلك وبعده، من قرآنٍ خاطب الرسول، الذي حمله للناس، واصفًا إياه بأنه "رحمةٌ للعالمين"؟
1504
| 11 سبتمبر 2016
هل يفكر العرب بشكلٍ إستراتيجي حين يتعلق الأمر بحاضرهم ومستقبلهم؟ ثمة تناقضٌ، يُظهره الاستقراء العلمي الرصين، بين الشعارات والواقع في هذا المجال. هناك لغطٌ كثير عن الموضوع، بشكلٍ مباشر وغير مباشر، في صالونات السياسة والإعلام، وحتى أروقة صناعة القرار. أكثرَ من هذا، توجد محاولاتٌ، حثيثةٌ أحيانًا، لتحويل الشعارات إلى واقع.لكن السؤال لا ينفك يفرض نفسه من منطلقات عملية بحتة: هل يتحرك العرب، أو من لا يزال يستطيع الحركة منهم، وفق رؤيةٍ إستراتيجيةٍ متقدمة وحقيقية، حين يتعلق الأمر بعلاقتهم مع النظامين الإقليمي والدولي، وفي ضوء التهديدات الكبرى التي لا جدال بأنهم الأكثر استهدافًا بها في قادم الأيام؟مرةً أخرى، لا مفر من صراحةٍ ووضوحٍ وشفافية عند الحديث عن هذه القضية."الوقائع كائنات مقدسة، تُمارس انتقامًا بشعًا من الباحث الذي يتظاهر أنها غير موجودة". لا تنطبق هذه المقولة التي تُنسب لأحد مؤرخي اليونان القديمة على الباحثين فقط، وإنما يصدقُ مضمونها، بدرجةٍ أكبر، على صانع القرار السياسي العربي المعاصر.فمرةً تلو أخرى، على امتداد الأشهر الماضية، يُفاجأ العرب بقرارات وممارسات سياسية لم يُحسب لها حساب، تَصدرُ عن أطراف النظامين الإقليمي والدولي، وتَخلق، على أرض الواقع، وفي مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، تطورات جديدة، المُشكلُ أنها تكون، في نهاية المطاف، من ذلك النوع الوجودي المتعلق بهم، شعوبًا ودول، حاضرًا ومُستقبلًا وخرائط.لم يعد سرًا إذًا أن العرب يعيشون زمن (الانكشاف) الكبير. ولم يعد خافيًا على عربي أن دول المنطقة تشهد عملية (استفراد) لم تشهد لها مثيلًا من قبل. فأين تكمن المشكلة بالتحديد؟ثمة عناصر للموضوع يبدو ضروريًا التفكيرُ بها في معرض تحليل معنى الفكر الإستراتيجي وعناصره ومداخله ومُقتضياته قبل أي شيءٍ آخر.ما هو التفكير الإستراتيجي أصلًا؟ ثمة من يراه في القدرة على المناورة بين التوجهات السياسية للحكومات بين وقتٍ وآخر. وهناك من يحصره في "تأمين" العلاقة مع القوى العالمية، وأحيانًا بأي ثمن. أسوأ من هذا الوهمُ بأنه يعني "ترسيخ" علاقات شخصية ومباشرة مع أفراد بعينهم في تلك القوى، بحيث يضمن بهذا "ولاءهم" ويأمن "شرهم". إلى غير ذلك من الأفهام المُجتزأة والسطحية السائدة في ثقافتنا السياسية عربيًا.بالمقابل، يُغطي التفكير الإستراتيجي حشدًا من المكونات والعناصر لا يمكن القولُ بتحقيقه دون الإحاطة بها. والتفصيل بشأنه يحتاج إلى مقامٍ آخر.التاريخ وتجاربه الكبرى، العلوم الاجتماعية ومدارسها ونظرياتها؛ الأنظمة التي انبثقت عن تلك النظريات وأصبحت بمجموعها "نظامًا" يحكم العالم؛ التطورات الحساسة للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي لمجتمعات العالم ودوله؛ كيف تتفاعل هذه التطورات مع مكونات ذلك النظام وتؤثر عليه مُظهرةً ثغراته المتزايدة وعدم قدرته، باطراد، على حل أزمات البشرية المتصاعدة؛ كيف يتعامل أهل القرار العالمي مع هذا الواقع في معرض البحث عن تبريرات لعدم قدرتهم على حل تلك الأزمات داخليًا وعالميًا؛ هيمنة الاقتصاد، بكل فوضويته وممارسات مراكز قواه، على مجريات الأمور عالميًا؛ ثورة تقنية الاتصالات والمعلومات بآفاقها الأقرب للخيال ومستتبعاتها على كل عناصر الاجتماع البشري؛ التطورات الكونية للظاهرة الدينية وتحديدًا جانبها الصاخب والشعبوي؛ الاهتراء الكامل لمنظومة الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة وعجزها العملي النهائي؛ سقوط الحد الأدنى من قواعد السياسة في العلاقات الدولية وطغيان ممارسات الخديعة والنفاق والكذب وازدواجية المعايير بوقاحة ووضوح؛ (موت السياسة) والهوس الأعمى بجدوى العمل عبر الوسائل الاستخباراتية والسرية والتآمرية بين الدول؛ المستتبعات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الظواهر أعلاه على الواقع العربي، وحجم الضغط القادم على المجتمعات العربية شعوبًا وحكومات. فضلًا عن غياب رؤى حضارية / ثقافية مُحكمة البنيان، تتعلق بقيمة الإنسان والمجتمعات، وضوابط العلاقة بين الشعوب والأنظمة، لا يمكن بناء أي إستراتيجيات سياسية من دون وجودها.هذه، وغيرها كثير، عناصر أساسية يستحيلُ وجود تفكيرٍ سياسي إستراتيجي بمعزلٍ عنها. ليس غريبًا، في ظل غياب التفكير السياسي الإستراتيجي، أن نتذكر كيف واجهَ العرب، أكثر من مرة، واقعًا مفاجئًا حمل معه تغييرات جذرية لم يعد ممكنًا، معها، العودةُ إلى الوراء. وكان آخرها، وأكبرها، انطلاق شرارة الثورات العربية وسط ذهول البعض ودهشتهم، في حين كانت كل قوانين الاجتماع البشري تؤكد على قدومها.وسيكون مهمًا جدًا، في هذا السياق، الانتباه إلى أسئلةٍ تتعلق بمن هو مكلفٌ، ابتداءً، بهذه المهمة الخطيرة والحساسة: التفكير الإستراتيجي سياسيًا. ففي حين يتجاوز البعض هذه الأسئلة أصلًا، أو يتعاملون معها بحسابات تقليدية، يبقى التعامل معها مفرق طريق أساسي يضع الممارسة، من بدايتها، بين طريقي "السلامة" أو "الندامة". من هو المؤهل حقًا لمثل هذه المهمة الاستثنائية؟ ما هي طبيعة "الولاء" الذي يجب أن يتوافر في أصحابه؟ للدولة والشعب وحاضرهما ومستقبلهما، أم لمديرٍ هنا ومسؤولٍ هناك؟.نقول هذا لأن استقراءً استراتيجيًا حقيقيًا للمستقبل، القريب قبل البعيد، يُفرز رؤية خطيرةً لما هو قادم على المنطقة من تغييرات، سيبدو الحديث في تفاصيلها غريبًا لدى البعض، وتهويلًا لدى آخرين. لكن هذا، بحد ذاته، تعبيرٌ صادق عن الأزمة المُشار إليها أعلاه، بشكلٍ يذكرنا بمقولة للعرب تاريخية: "وَلاتَ حين مَندم".
1492
| 04 سبتمبر 2016
ليس من قبيل المبالغة القول إن عنصر المفاجأة كان كبيرًا فيما يتعلق بالتدخل التركي العسكري في شمال سوريا. يصحُّ هذا في حق "محللين" و"خبراء" وكُتاب كما يصحُّ في حق دول وحكومات. والأرجحُ أن هذا كان آخر ما يُفكر به هؤلاء جميعًا بعدما شاع تفسيرٌ لسياسات أنقرة الأخيرة يربط هذه السياسات بنوعٍ من الاستسلام الكامل لرؤية روسيا وإيران في سوريا تحديدًا. في مقالٍ لكاتب هذه الكلمات هنا، قبل أسبوعين من الانقلاب الفاشل، بعنوان "تركيا وإعادة الترتيب بين الأيديولوجي والسياسي"، وبعد الحديث عن أسباب عدم تدخل تركيا في سوريا سابقًا ثم العلاقات السياسية المستجدة لها مع روسيا وإيران وإسرائيل، وَردَ ما يلي: "ومع تطور الأحداث، وجدت تركيا نفسها تنزلق تدريجيًا باتجاه مآزق داخلية وخارجية إستراتيجية. وبحساباتٍ منطقية، بات واضحًا أن توازنات عناصر معادلة الأيديولوجيا والسياسة لديها، والمتعلقة بالشأن السوري، لم تصل بها إلى النتيجة المرجوة. فلا هي استطاعت الاستمرار، بشكلٍ لا نهاية له، في تحمل تبعات الموقف الأخلاقي/الأيديولوجي، أمنيًا واقتصاديًا. أما معادلة السياسة التي تتمحور حول اعتمادها على الناتو وأمريكا فقد أظهرت فشلها الذريع... ثمة تحليلٌ بأن هذه المحاولة تهدف إلى تأكيد موقف تركيا من تغيير نظام الأسد، بمعادلات ومداخل وأوراق أخرى، لكن هذا التحدي كبير، ولا يعرف أحدٌ ثمن تحقيقه سياسيًا واقتصاديًا. إضافةً إلى هذا، يطرح التحول التركي أسئلة جديدة وصعبة على أردوغان وحزبه تتعلق بالتوازنات التي كانوا يحاولون الحفاظ عليها بين مقتضيات "الأخلاقية" وتَبِعات "السياسة" بمفهومها الواقعي السائد عالميًا". الواضحُ أن تركيا سارت قُدمًا في عملية إعادة الترتيب، ورغم أمل السوريين بأن يكون هذا فعلًا تأكيدًا لموقف سوريا من الأسد ونظامه، بمعادلات وأوراق أخرى، إلا أن النتيجة حتى الآن تتمثل في مشهدٍ راهن يُعيد التذكير بطبيعة السياسة في ثوبها المعاصر، بكل ما فيها من تقلبات وتناقض وحسابات وجَدٍ كثيرًا ما يمتزج بالهزل. قد يكون من قبيل المبالغة القول بعدم إدراك تركيا لهذه الحقيقة، لكن ما حصل، بعد ذلك، يتمثل في قناعتها الجديدة بأن ممارسة السياسة عمليًا يجب أن تأخذ الحقيقة المذكورة بعين الاعتبار أكثر من ذي قبل، بكثير. فمن توقيت التدخل العسكري التركي في شمال سوريا يوم وصول نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي الذكرى الـ500 لمعركة "مرج دابق" التي انتصر فيها السلطان سليم الأول على المماليك ودخل سوريا بعدها، وبعد يوم من زيارة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، ويومين من زيارة قائد قوات الناتو في أوروبا لأنقرة، وبعد عدة أيام من زيارة وزير الخارجية الإيراني للعاصمة التركية، والحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي أردوغان إلى طهران، يبدو التدخل المذكور مُحاطًا، عن قصدٍ في أكثر الأحيان، بجملةٍ من المعاني الرمزية على مستوى الجغرافيا/السياسية والتاريخ. تتعدد الإشارات الكامنة في تلك الرموز نفسها أيضًا. فمن جهة، لا تجد تركيا مسؤولًا يَستقبل نائب الرئيس الأمريكي أعلى مرتبةً من نائب والي العاصمة أنقرة. وفي حين يُبدي بايدن حرارةً منقطعة النظير في إدانة الانقلاب والتغني بعلاقة بلاده مع تركيا، يقول في معرض تفسير الموقف الأمريكي صبيحة ذلك اليوم الفارقِ في تاريخ تركيا: ".. ولكننا في البدء لم نفهم فيما إذا كانت المحاولة حقيقية أم لا، أم إنها خدعةُ إنترنت أو غير ذلك. لم نفهم إن كانت محاولةً جدية أم لا". هذا من اختلاط الجدّ بالهزل، وقد يتناسب مع شخصية بايدن بشكلٍ عام، ومع "اعتذاريته" الشديدة الواضحة في تصريحاته وفي لغة الجسد خلال زيارته لأنقرة. لأكثر من خمس سنوات، التزمت تركيا بكل ما يُفترض أنه خطوط الغرب وأمريكا والناتو الحمراء، فيما يتعلق بالتدخل في سوريا، مع التزامها بالتعاون مع هؤلاء "الحلفاء"، والتزامها المقابل بما هو أقرب للعداء مع روسيا وإيران. ماذا كانت نتيجة ذلك؟ الاقتراب من الكارثة داخليًا وخارجيًا، وفي جميع المجالات. وما إن قررت تركيا قلبَ المعادلة، حتى شَهِدنا التدخل في سوريا وكأنه أمرٌ عادي، أو "شربة ماء" كما يقولون في الشام. لم نسمع مجرد استنكار من إيران، في حين كان أقصى ما فعلته روسيا هو "التعبير عن القلق"! ما يثير الدهشة أكثر هو سرعة صدور تصريحات بايدن بالدعم الأمريكي للعملية! لنا أن نتخيل الوضع لو جاء التدخل التركي قبل ثلاثة أشهر فقط. قلناها ونعيد التأكيد عليها: في عالمٍ لا يفهم إلا لغة المصالح، يمكن لكل سياسةٍ أن تتغير، ويمكن لكل قرارٍ أن يتبدل إذا كانت المصلحة تقتضي حصول ذلك. وأكبر وهمٍ سياسي عربي يتمثل اليوم في وجود تضارب بين الحفاظ على علاقة جيدة مع أمريكا وبين العمل بحزمٍ وجدية لتحقيق مصالح العرب. ثمة حاجةٌ، بطبيعة الحال، للإبداع والابتكار في الفعل السياسي إلى جانب الحزم والجدية. وبوجود العنصرين، يتحقق أيضًا استمرارُ التقارب التركي الخليجي، في وقتٍ أصبح فيه هذا الأمر عاملًا أساسيًا لتحقيق مصالح الطرفين.
505
| 28 أغسطس 2016
ثمة إحصاءات، نجهل بعضها ونتجاهل بعضها الآخر، تحمل إشارات حساسة لضرورة فتح ملف الإصلاح الديني، على الأقل بالنسبة لمن يهمهم فعلًا شأن الدين. فمِن توجهِ شباب العرب والمسلمين إلى (الإلحاد)، مرورًا بازدياد ملحوظ لظاهرة خلع الحجاب، وصولًا إلى تصاعد الغلو والتطرف، نجد أزمة هوية تُعبر عن نفسها عبر استقطاب في اتجاهين متضادين، خاصةً بين شرائح الشباب المذكورة. ففي ظل ما يمكن أن نسميه الضغط (الحضاري) العالمي، بتجلياته السياسية والاقتصادية، ومع الفقر المدقع في جهود الإصلاح من قبل علماء ورجال دين وخبراء ومثقفين يُفترض فيهم الاهتمام بهذه المسألة، وباعتبارنا نعيش في عصر ثورة الإعلام والمعلومات والمعرفة والاتصالات، لا تجد تلك الشرائح إجابات في الإسلام، بفهمه التقليدي السائد، على الأسئلة الكبرى التي يقذفها العالم المعاصر في وجههم بشكلٍ سريعٍ ومتكررٍ ومُلحّ. قد يقبل البعض نظريًا بضرورة العمل على الإصلاح وسط الضغوط، لكن المأزق يكمن دائمًا في طبيعة وجدوى أساليب الإصلاح حين ننتقل من النظرية إلى الواقع. لن ينفع في شأن الإصلاح الديني، مثلًا، استبدال طاقمٍ بطاقمٍ آخر ينتشر أفراده هنا وهناك في مجالات الرأي والثقافة والإعلام. لا ينفع أن نلغي بعض المصطلحات لنستحضر في خطابنا مصطلحاتٍ بديلة عنها. لا يكفي أن نعلن ليل نهار وقوفنا ضد الغلو والتطرف. ولا يكفي أن يصبح التغني بقيم الإسلام الحضارية معزوفةً مكرورةً نطرحها في كل محفل. إن الوقوف عند هذه الممارسات مأساةٌ مزدوجة. لأن من يقوم بها يخدع نفسه ويقع في الوهم بأنه قام بالواجب وأدى المطلوب. الأمر الذي يمثل دعوة للعودة إلى مواقع الكسل والاسترخاء والطمأنينة الكاذبة. فكل ما تفعله تلك الممارسات هو وضع غطاءٍ شفاف وملوّن على المشكلة الحقيقية التي تتعلق بطريقة فهم الدين وطريقة تنزيله على الواقع المعاصر. وهي مشكلةٌ تحتاج إلى ثورةٍ فكريةٍ حقيقيةٍ بكل المقاييس. وهذه الثورة التي نتحدث عنها لا تحتاج فقط إلى طرحٍ جديد، وإلى رؤىً مختلفة في كل المجالات. وإنما تحتاج أيضًا إلى رجال، ونساء، جُدد أحيانًا. لسنا بصدد التعميم الكامل. لكن قراءة ما يصدر عن الغالبية العظمى ممن يتصدرون للحديث عن الإسلام، وحضور فعالياتهم، والحوار معهم، والاستماع إلى طروحاتهم، وتحليل مقولاتهم، ومحاولة إعادة تركيب خطابهم بشكلٍ متكامل، بناءً على ما سبق، يُظهر الحاجة لإعادة النظر في أهليتهم لقيادة عملية تغيير حقيقية، فضلًا عن قيادة ثورةٍ فكرية. إن الثورة التي نتحدث عنها تتجاوز خطابين يقدمان طروحات تدّعي حمل لواء التغيير لطريقة فهم الإسلام ولطريقة تنزيله على الواقع الإنساني في هذا الزمان. الطرح الأول مليء بالتناقضات، حيث ترى من البعض موقفًا يوحي بالأصالة الثورية في مقام، ثم ترى جملة مواقف تنبع من عمق الفكر التقليدي الحَرفي الجامد. والطرح الثاني مهووسٌ بالتردد، حيث تسمع، على انفراد، رأيًا ينبثق من صُلب الفكر التجديدي، ثم تجد في العلن موقفًا بعيدًا عن مقتضيات ذلك الرأي. هذان طرحان يجب أن تتجاوزهما الثورة المطلوبة. وتتجاوز معهما جملة قضايا أخرى، منها ذلك الخطاب الماهر في طرح الآراء والمواقف القابلة لأكثر من تأويل، والخطاب الذي يتقن الحديث في كل موقع بما يناسب الموقع ومَن يوجد فيه، وخطابٌ ثالث ذلك يجمع بين قناعةٍ داخليةٍ راسخةٍ، عند أصحابه، بفهم تقليدي للإسلام هو من أسباب المشكلة، وبين كلامٍ معلنٍ يستصحب ضرورات الواقع، ببراغماتية وأحيانًا تُقية، باستخدام بعض الكلمات والألفاظ (الرائجة). ولكي نكون واضحين، لا يمكن في هذا المقام اتهام أحدٍ بعينه بالنفاق والاحتيال، أو الخداع والمناورة. لكننا نعلم بوجود جملةٍ من القواعد والمقولات الشائعة ثقافيًا، يمكن أن تكون سببًا للوقوع في الإشكالات التي تحدثنا عنها قبل قليل. فالبعض يقول (خاطبوا الناس على قدر عقولهم)، لكن هؤلاء ينسون أحيانًا أن العقول بحاجةٍ إلى من يرفع سوية تفكيرها، خاصةً في أجواء الاهتراء الثقافي والعقلي الطاغية، وهذا يتطلب خطابًا مختلفًا عن السائد لا يداري الواقع أو يداهنه بدعوى الالتزام بتلك القاعدة. والبعض يخاف على فتنة الناس من الآراء الجديدة والمختلفة، حتى لو كانت صحيحة. لكن هؤلاء يتجاهلون الفتنة الكبرى التي تغرق فيها المجتمعات مع سيادة الفكر التقليدي ومقتضياته. والبعض يتحدث عن التدرّج والأولويات، لكنه لا يترك مجالًا لإمكانية خطئه في الحسابات فيما يتعلق بصواب معرفته المتعلقة بالأولويات والتدرج المتعلق بها. كأن يكون تدرّجُه أقرب إلى البُطء القاتل، أو تكون أولوياته في غير مكانها، أو أن ينطلق في تعامله مع هذه القضايا من الخلط بين الحاجات والمصالح العامة والحاجات والمصالح الخاصة. إلى غير ذلك من الاحتمالات. ومن غير المنطقي هنا إغفال جوانب الضعف الإنساني المتعلقة بالموضوع. فمشكلة (تبعية العلماء للعامة) موجودةٌ في تاريخنا وحاضرنا. وهناك من يربط بين موقعه ومصير الإسلام، فيحرص على بقائه في الموقع حرصًا على الدين. والاجتهاد الدقيق يحتاج إلى بحثٍ مُضنٍ وعملٍ وجهد، في حين أن قبول الرأي السائد لا يحتاج إلا لمراجعة المحفوظ وترديده، وهذا أقرب للراحة النفسية والجسدية. لا مفر من القول أيضًا إن رفض الإصلاح الديني، في خضم الضغوط الدولية الراهنة، كثيرًا ما ينبع من التماهي مع الإسلام، بمعنى (أنا الإسلامُ والإسلامُ أنا)، حتى لو لم يُنطق ذلك بلسان المقال. فالتحديات كبيرةٌ والمهمة صعبةٌ وشاقة. وفي مقابل هذا، يبدو واضحًا أن رافضي الإصلاح في وسط الضغوط ينطلقون من ذلك التماهي، فيجعلون الإسلام الكبير صغيرًا، حين يُضفُون عليه، دون أن يدروا، كل ما فيهم هُم من ضعفٍ ومَحدودية وقصور. قد تبدو كلمة "الثورة" التي ذكرنا أنها مطلوبة لتحقيق الإصلاح كبيرةً لدى البعض، ورومانسيةً عند آخرين. لكن معرفةً حقيقية بسنن وقوانين الاجتماع البشري، وقراءة واقع العرب في السنوات الأخيرة، تؤكدان أنها قادمة.
353
| 21 أغسطس 2016
يبدو واضحاً للجميع أن الشأن الديني في واقعنا العربي، بكل قضاياه الشائكة، أصبح عنصراً مؤثراً قوياً، ليس فقط في صناعة الحاضر، وإنما في مآلات ذلك الواقع ومُستقبله. ومع طبيعة الاستقطاب الذي تخلقه الأوضاع في المنطقة والضغوط الكبرى عليها، يصبح الحديث في ذلك الشأن واقعاً في ذلك الاستقطاب نفسه. فإما التركيزُ، من قِبل شرائح، على إدانته بكل تعميم، واختزاله فقط في العبارة المُختزلة أصلاً: "الحرب على الإرهاب".. أو استدعائهُ، من شرائح أخرى، بكل ملامحه الحماسية والشعاراتية للتعامل مع الضغوط المذكورة. تُغفلُ المقولة الأولى كل التعقيد الكامن وراء اختزالها وتبسيطها المُخل نظرياً وعملياً للمسألة، ولا تنتبه أنها، بهذا، تُبقي الشأن الديني جزءاً من المشكلة. بالمقابل، تقفز المقولة الثانية على حقيقة الحاجة إلى استمرار الحاجة للحديث في الإصلاح الديني، والعمل الجدي عليه، في مثل هذه الظروف تحديداً، وأكثر من أي وقتٍ آخر. وفي مثل هذه الظروف، تشيع مقولة ضرورة تأجيل الحديث عن الإصلاح والعمل عليه بسبب الضغوط الراهنة، وأن هذه الممارسة، في هذه الأحوال، ترفٌ لاحاجة له ولامكان. تُحيلُ الظاهرة أعلاهُ إلى مدخلٍ آخر لتفسير ظاهرة التَشنُّج من عملية الإصلاح تتعلق بمقولة (الخوف على الإسلام). إذ يبدو هذا الخوف، إلى درجة الهوس أحياناً، مُحرِّكاً لكثيرٍ من المواقف، خاصةً في ظروف الأزمات. وفي حين يبدو واضحاً، من ممارسات البعض، أن المقولة إنما (تُوظف) في نهاية المطاف للحفاظ على مكتسبات شخصية أو حزبية، تَصدﱡراً للمشهد الاجتماعي و/ أو السياسي، وبحثاً عن الأتباع والمريدين، وحفاظاً على مصادر النفوذ والقوة، إلا أن شرائح أخرى تبدو صادقةً مع نفسها في (خوفها) المذكور. المشكلة في الموضوع أن خوف هؤلاء من الإصلاح الجدي، بسبب صدقهم في الخوف على الإسلام، يبدو، بنظرةٍ عميقة، أكثر خطورةً على الإسلام نفسه من خوف الشريحة الأولى. ففي حين تكشف الوقائع والأحداث حقيقة دوافع أصحاب المصالح، كما يحصل دائماً في نهاية المطاف، يتضارب هذا النوع (الصادق) من (الخوف)، وبهذه الطريقة، مع منهج القرآن نفسه بأكثر من طريقة. فهذا الخوف يتناقض مع قضايا أساسية وجوهرية، يؤمن بها المسلمون جميعاً، ومنهم (الخائفون) المذكورون. فهم إذ يؤمنون بأن الإسلام مصدرهُ إلهٌ خالقٌ وقادر، وبأنه تَكفَّل بحفظ (الذكر)، ويؤمنون بخلود الإسلام، وكل ما يتعلق بهذه المواضيع فلسفياً ومعرفياً وعملياً، فإن خوفهم عليه برفض الإصلاح، يُزعزع، منطقياً، التصديق بقوة إيمانهم. نقولها بصراحةٍ وشفافية، للتفكير فيها بقوةٍ وتجرد. أكثر من هذا، يتناقضُ الخوف على الإسلام مع دعوة الإسلام نفسه إلى المراجعة الدائمة. يتجلى هذا في منهج الأنبياء المذكورة قصصهم فيه، لا على وجه الحكاية والتسلية، وإنما على سبيل طرح إشاراتٍ منهجية كبرى تتعلق بكيفية الحفاظ على الدين وقيمه من خلال العودة المباشرة إلى مقولة {ربﱢ إني ظلمتُ نفسي}، وهذا يحدث دائماً في مقام مواجهتهم للأزمات والمشكلات، ويحدث مدخلاً للنظر إلى الخطأ في الفهم أو التنزيل، أو في كليهما. ومدخلاً، بالتالي، إلى التصحيح المستمر. بالمقابل، تُظهر ممارساتُ (الخوف على الإسلام)، الرافض للإصلاح، إنساناً يعيش في هذه الدنيا بنفسية المذعور فيها ومنها، بدلاً من أن تُظهر إنساناً كبيراً قوياً واثقاً بنفسه ورؤيته الحضارية، يجابهُ الواقع بممارساته ومواقفه، من خلال إيمانه الحقيقي بعزة دينه، بعيداً عن الشعارات الكلامية من جهة، وبعيداً، من جهةٍ أخرى، عن بعض مظاهر العنف والقوة الاستعراضية الفارغة نهايةَ المطاف. هكذا، يَظلمُ العرب عامةً، والإسلاميون منهم تحديداً، والسوريون خاصةً، الإسلام كثيراً، ويظلمون معه المسلمين والعالم بأسره. يظلمونه أكثر من أي جهةٍ أخرى يعتقدون أنها تُعادي الإسلام وتُشكلُ خطراً عليه. فهم يُقزﱢمونه بدعوى الخوفِ عليه، وخاصةً حين يرفضون الإصلاح ويُصرُّون بشكلٍ غريب على تجنب أسبابه.. فالواقع الراهن الماثل أمام أعينهم، أو ما يُسمى ضغوطاً عالمية سياسية وعسكرية وثقافية، مليءٌ بالتحديات والأسئلة الصعبة التي تحتاج إلى مواجهتها بشكلٍ واضحٍ وشجاع، وبكل شفافيةٍ وجرأة، اليوم والآن، بدون تأجيل، وبعيداً عن خوفٍ كاذبٍ على الدين يخنق في نهاية المطاف قدرته على التعامل مع الضغوط، وتقديم الإجابات على تلك الأسئلة. وإذا كانوا يخافون من الفوضى، فإن رفض النقد وغياب المراجعات هو الذي يؤدي إلى الفوضى وسيؤدي إلى المزيد منها على جميع المستويات. لأن هذا يترك المجال مفتوحاً أمام عمليات اختطاف الإسلام الكثيرة التي تهدف إما لتوظيفه بحيث يُصبح خادماً للواقع ومبرراً لسلبياته، أو لتجميده بحيث يُضحي منظومةً بائسةً من المظاهر والطقوس والرموز والأشكال، أو لتحويله (وحشاً) لا يتجاوز دوره في هذا العالم القتل والتخريب.
356
| 14 أغسطس 2016
بغض النظر عن الشعارات والتصريحات، توحي أحداث الواقع أن غالبيةً كبرى من العرب يحاولون ممارسة هوايتهم التاريخية في تأجيل الاستحقاقات، والهروب من الحقائق، والالتفاف على الوقائع والأحداث، وانتظار تغييرٍ ما، يحدث من الخارج، أو يهبط من السماء. لكن هذا كله لن ينفع في مثل هذه المرحلة من تاريخهم وتاريخ الإنسانية. ربما أمكن للعرب اختيارُ الحياة على هامش التاريخ سابقًا، بعيدًا عن استحقاقاته، لكن ما يجري في هذا العالم لم يقتصر فقط على إدخالهم في هذا التاريخ قسرًا. بل إنه جعلَ واقعهم وثقافتهم وممارساتهم وسياساتهم من محاوره الكبيرة. من هنا، سيبقى ذلك الواقع وتلك الثقافة، ومعها الممارسات والسياسات، في بؤرة الحياة البشرية زمنًا لا يعلمه إلا الله. يعتقد البعض بأن هذا العالم بات مهووسًا فقط بكل ما له علاقة بـ(الإسلام) و(المسلمين). وفي هذا بعضُ صواب، لكنه صوابٌ يجب أن يوضع في إطاره الأكبر. فأبسطُ قراءةٍ للواقع الجيوسياسي في العالم تُظهر حجم الفرق في اهتمام القوى الدولية حين يتعلق الأمر بما يجري في جاكرتا وأبوجا، مقابل اهتمامهم بما يجري في بغداد وحلب والقاهرة. نحن، كعرب، إذًا في بؤرة أحداث التاريخ المعاصر. ومع أننا نساهم في صناعته، بكل ما في واقعنا وثقافتنا من عشوائيةٍ وإشكالات، فإن هذا يرتدُ علينا بسياسات تستهدف حاضرنا ومُستقبلنا في جميع المجالات وعلى كل المستويات. لا فرق هنا بين أغنياء وفقراء، ولا بين (معتدلين) و(متطرفين)، ولا بين شعوب وحكومات. لا فرق بالتأكيد بين (مسلمين) و(غير مسلمين)، بغض النظر عن كل اللافتات المزيفة المرفوعة في العالم بخصوص حماية (الأقليات). ورغم أن الحديث عن (استهداف) العرب صار مُملًا في صيغته التقليدية، وهو عند البعض لجوءٌ يائس لمنطق المؤامرة وتفسيراتها الممجوجة، إلا أن واقعنا الراهن يفرضُ الحديث عنه كحقيقةٍ تؤكدها الشواهد. وقد يكمن الفرقُ في تحليل أسباب الاستهداف التي لم تعد تنحصرُ في المقولات القديمة المتعلقة بالثروة والموقع الإستراتيجي فقط. فقد كان استيعاب تلك العناصر والتعامل معها، من قبل القوى الدولية، ممكنًا دائمًا في الماضي، دون الشعور بالحاجة لاستهداف العرب بالمعنى القاسي والشامل للاستهداف. فمن ناحية، أصبحت المنطقة مصدرًا لإشكالات عالمية معروفة، يرى مَنطقُ النظام الدولي أن حَلَّها يكمنُ في تجريب درجات متصاعدة من (الاستئصال)، بعيدًا عن أي شعور بالحاجة لمعرفة الأسباب الحقيقية لتلك الإشكالات. ومن ناحية ثانية، باتت المنطقة الموقع المثالي لصراعٍ عالميٍ على النفوذ والمصالح، في مرحلة صار فيها ذلك النظام الدولي نفسه مُخلخلًا، فاقدًا للأساسات، وقابلًا للتغيير، بحيث يمكن لمراكز القوى الفاعلة فيه خرقُ ما كان سابقًا قواعد جيوسياسية مُتفقًا عليها، بمثابة المُحرّمات. وأخيرًا، ثمة انطباعٌ يجري تعميمه، إعلاميًا وسياسيًا، في الغرب تحديدًا، يقضي بأن الهياكل السياسية العربية التي كان يُعتقد دائمًا أنها جزءٌ من الحل، لم تُصبح فقط جزءًا من المشكلات، وإنما كانت من أسباب ظهورها ابتداءً. وثمة جهود كبيرة لطرح هذا على أنه اكتشافٌ خطير ينبغي التعامل معه بجدية ووضوح بدلًا من إخفائه والتعامل معه بشكلٍ دبلوماسي. من هنا تنبعُ جدية الخطر الراهن الذي يواجهُ العرب. وهو يواجههم، كما ذكرنا، دون تمييزٍ بين عناصر ومكونات للواقع العربي يحسبُ بعضُنا أن قِيَمها متفاوتة، وأن منها ما لا يجب أن يُمس، وأن هذه الحسابات مأخوذةٌ حقًا بعين الاعتبار لدى القوى الدولية.. في حين أن أكبر ما يُميز المرحلة الانتقالية الإستراتيجية الدولية الكبيرة التي يمر بها العالم اليوم هو سقوط المحرمات التقليدية السابقة. لهذا، يجدر الانتباه إلى الفوارق الحساسة بين حسابات العرب وحسابات المعادلات الجديدة في المرحلة المذكورة، وحسابات لاعبيها الكبار، داخل الإقليم وخارجه. إذ يمكن أن يَظهرَ، بعد فوات الأوان، أن العرب يعيشون ماضيًا تغيرت قوانينه وقواعده وتحالفاته، وهم يحسبون أنهم يعيشون في الحاضر. هذا يعني، فيما يعنيه، أن الهروب بكل أشكاله لم يعد ممكنًا. لكنه يعني أيضًا أن الهروب من الإصلاح الشامل باتَ أقرب للمستحيل. وأن هذا الإصلاح يتطلب جرأةً وإقدامًا غير مسبوقين، بقدر ما يتطلب من إبداعٍ وتفكيرٍ (من خارج الصندوق). تغيرت المعادلات التي اعتاد العرب أن يجمعوا من خلالها بين بقائهم الفيزيائي في الدنيا، وغيابهم الفعلي المؤثر عنها. لذلك، لن تنفع في شيءٍ تلك المحاولات التي تجري هنا وهناك في العالم العربي لاستدعاء المعادلات القديمة، وإلباسها ثوبًا آخر يوحي بأنه يليق بالعصر. بمعنى أن إثارة الضجيج الإعلامي نظريًا حول التغيير والإصلاح، مع الإصرار عمليًا على تغييرات جزئيةٍ وهامشيةٍ ومظهريةٍ ومؤقتةٍ، لن يكون حلًا، وإنما سيكون مدعاةً فقط إلى مزيدٍ من الفوضى ومزيدٍ من الاهتراء. لم تعد ثمة جدوى لعمليات التجميل المصحوبة بالوعود والأماني والأرقام والكلام الكبير، فهذا يزيد الاحتقان والغليان ومشاعر اليأس والقنوط. وإذا يبدو طبيعيًا أن يحاول النظام الدولي خداعنا بكل طريقةٍ ممكنةٍ، إلا أن خداع الذات يبقى وحده رصاصة الانتحار.
430
| 07 أغسطس 2016
جغرافيًا كانت تركيا، ولا تزال وستبقى دائمًا، نقطة اللقاء والعبور والتواصل بين الشرق والغرب. لكنها أعطت العالم أيضًا تجربة على صعيد حوار الحضارات ولقائها، خلال العقدين الماضيين على الأقل، بات صعبًا التكهنُ بمصيرها اليوم. من ملامح تلك التجربة معهد العلوم والفنون في إسطنبول، الذي أسسه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، بمنهجٍ للبحث قائمٍ على ثلاثة مبادئ رئيسية، تحكم بشكل صارم أي عملٍ وإنتاج ونشاطٍ فيه، وهي: 1- امتلاك رؤية عالمية والانطلاق منها. 2- اعتماد المدرسة التكاملية البَينية في العلوم وطرق البحث Interdisciplinary لفهم الظواهر الاجتماعية ودراسة طرق التعامل معها. 3- الحياد وعدم الدخول أبدًا في عالمي السياسة والاقتصاد، وإنما العمل على إثراء المجالين من جانب، وإثراء إنتاج المعهد من خلال دراستهما المستمرة من جانب آخر.أسسَ المعهدُ بعد ذلك جامعةً اسمها Istanbul Ṣehir University، وعندما تنظر إلى فقرة (رؤية الجامعة) تقرأ ما يلي: "من الممكن إنشاء نظام عالمي حيث تكون العلاقة بين الفرد والمجتمع والعلاقة بين المجتمع والطبيعة في غاية التناغم والانسجام المتبادل. يهدف معهد العلوم والفنون (من إنشاء الجامعة) إلى توفير أجواء أكاديمية وثقافية حيث يمكن للمرتكزات المعرفية والروحية والفنية لمثل هذا النظام أن تُبحث بحرية".هل يبقى ممكنًا استمرارُ التجربة التركية خلال الأشهر والسنوات القادمة وفق الروح والمعاني الكامنة في المبادئ والرؤية المذكورة أعلاه؟ تبدو الإجابة على هذا السؤال في غاية الصعوبة بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب العسكري فيها، رغم أن الإجابة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات، ليس فيما يتعلق بمستقبل تركيا فقط، بل بإمكانية وجود حوارٍ حقيقي للحضارات في عالمنا المعاصر، أو استحالة تحقيق ذلك الحوار، بكل ما يترتب على هذا الفشل من آثار كارثية على الإنسانية بأكملها.ثمة ضغط هائل على أهل التجربة التركية يُؤخذ بعين الاعتبار عند التفكير في القضية. ورغم أهمية الجوانب السياسية والأمنية لذلك الضغط، فإن الضغط النفسي المُصاحب لمجريات الأمور يبدو عنصرًا مهما لا يمكن إغفاله على طريق أي محاولةٍ للبحث عن إجابات. وفي مثل هذه الأوضاع يُصبح الحفاظ على التوازنات بين المثالية والواقعية بدورهِ مهمةً صعبة.فمن ناحية، لا يمكن تجاهل المشاعر التي تخلُقُها في أي جماعةٍ بشرية أحداثٌ يراها هؤلاء بمثابة "تصفية حسابات" كبرى على المستوى الحضاري العالمي. وهذا ما يجعل المطالبة بتجاوز الضغط النفسي، والإصرار على المبادئ والرؤية أعلاه، حتى في هذه الظروف، نوعًا من الترف والمثالية بالنسبة للكثيرين.لكن قوانين الاجتماع البشري، من ناحيةٍ أخرى، تفرض على من تصدى لمسؤولية المساهمة الفعالة في حوار الحضارات أن يستحضر مُقتضيات تلك المسؤولية. وهذا أمرٌ لن يفهم المُستقيلُ من مثل تلك المساهمة سببًا للحديث عنه أصلًا.سيكون مفيدًا هنا التذكير ببعض ملامح التجربة المختلفة التي نتحدث عنها.فقبل كل شيء، كانت التجربة تحاول إلغاء كل ما يمكن إلغاؤهُ منطقيًا من الثنائيات التي تسيطر على عقل الإنسان في الغرب والشرق على حدٍ سواء. فالعلم لا يتناقض مع الإيمان، والسياسة لا تتضارب مع الدين بفهمه الحضاري. وهذان مبدآن شائعان في العالم المعاصر ليس من السهل تحديهما نظريًا وعمليًا.وفي الإطار نفسه، لم يشعر أهل التجربة أن الانفتاح على جميع شرائح المجتمع يعني تمييعًا للانتماء الديني والعقدي. بمعنى، أن الانتماء الوطني لا يتضارب بالضرورة مع أي انتماءٍ آخر. لهذا، لم يكن غريبًا أن يكون في أعضاء حزب العدالة ومسؤوليه من يقول إنه مسلم ملتزم ومن يقول إنه علماني ومن يقول إنه قومي، بشرط أن يكونوا جميعًا ملتزمين بمبادئ وبرنامج الحزب الذي يتمحور حول تنمية الإنسان والمجتمع، وتحقيق مبادئ العدل والحرية، وصيانة الوحدة الوطنية، وحفظ المصلحة العليا للبلاد. وكان يمكن لأي إنسان أن يرى مصداق هذا حتى في مقرات الحزب في أنقرة وإسطنبول مثلًا، حيث يمكن رؤية من يمثلون جميع تلك التوجهات. فترى المحجبة وغير المحجبة، والحليق والملتحي، والمرأة والرجل، وأشخاصًا تعود أصولهم لجميع المناطق التركية، ولمختلف المذاهب والانتماءات، وغير هذا من التنويعات.كانت التجربة تُدرك أيضًا أن الرموز لا تُخيف سوى القاعدين الكسالى، كما هو الحال مع الكثيرين في الشرق، أو المصابين بالذعر الحضاري، كما هو الحال مثلًا مع المشرعين الفرنسيين الذين خافوا يومًا من قطعة قماش تضعها المرأة على رأسها. بينما تنتشر، بالمقابل، صور أتاتورك، مؤسس العلمانية التركية في كل مكانٍ في البلاد، وتوجد حتى في مقرات حزب العدالة والتنمية بنفسه، دون أن يُوتّر الأمر الحزبَ الحاكم الذي يوصف بأنه "إسلامي". وحين طالبت المحكمة، منذ سنوات، بهدم مدرسة تحفيظ القرآن التي درس فيها أردوغان في طفولته قامت قائمة بعض التقليديين الذين يربطون استمرار الهوية باستمرار الرموز، وليس باستمرار عملية تحقيق القيم والمبادئ الأصيلة للهوية. في حين أمر أردوغان نفسُهُ بهدم المبنى لأن الطلب ينسجم مع قانونٍ عام يقضي بهدم المباني المتداعية في المناطق العشوائية.هل ثمة مجال لاستمرار التجربة بمثل هذا المنهج بعد الآن؟ هذا، مرة أخرى، سؤال له تداعيات على مستقبل تركيا، ومستقبل العرب والمسلمين، ومستقبل علاقتهم بالعالم، ومستقبل هذا العالم بأسره في نهاية المطاف.
567
| 31 يوليو 2016
منذ ثمانية عشر عامًا حُكِمَ على رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول يومها، بالسجن أربعة أشهر بعدما قال أبياتًا من الشعر رأت فيها محكمة "ديار بكر" تحريضًا على قلب النظام العلماني وإثارة مشاعر الحقد الديني بين أفراد الشعب. وفي طريقه إلى السجن خاطب الرجل أنصارهُ بقوله:"وداعًا أيها الأحباب، وداعًا لوقت قصير، تهانيَّ القلبية لأهالي إسطنبول بعيد الأضحى، تهانيَّ القلبية للشعب التركي بعيد الأضحى، تهانيَّ القلبية للعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم كل الخير، كما أهنئ أهالي هذه البلدة التي سأبقى ضيفًا فيها لمدة 120 يومًا". ثم أضاف قائلًا:"إنني لست ممتعضًا، ولا حاقدًا ضد دولتي، ولم يكن كفاحي إلا من أجل سعادة أمتي، وسأقضي وقتي خلال هذه الأشهر الأربعة في دراسة المشاريع التي توصل بلدي إلى أعوام الألفية الثالثة، والتي ستكون إن شاء الله أعوامًا جميلة، ولكن ذلك يحتاج منا جهدًا كبيرًا وعملًا شاقًا، وسأعمل بجدٍ داخل السجن، وأنتم اعملوا خارج السجن كل ما تستطيعونه، ابذلوا جهودكم لتكونوا معماريين جيدين وأطباء جيدين، وحقوقيين متميزين، أنا ذاهب لتأدية واجبي، واذهبوا أنتم أيضًا لتؤدوا واجبكم، إن الشعب يستطيع بتجربته التاريخية الواسعة أن يرى كل شيء ويقيم كل شيء بشكل صحيح، وما يجب عمله الآن ليس إعطاء إشارة أو رسالة إلى الشعب، وإنما الفهم الصحيح لما يريده الشعب".بعد كل هذه السنوات، جاء وقت "إعطاء إشارة أو رسالة إلى الشعب" في تركيا، ومن قِبَلِ أردوغان نفسه، فلم يخيب الشعب ظن رئيسه، وكان له دورٌ أساسي في إحباط الانقلاب العسكري على الرجل وحكومته.لكن هذا لم يكن ليحصل لولا أن أردوغان، وحزبه، وحكوماته، فَهِمت في الفترة الماضية "ما يريده الشعب"، وعملت على تحقيقه، لم يكن الشعب التركي يبحث عن شعارات يسمعها من نمط "الإسلام هو الحل"، فهذه شعارات لا تُطعمُ من جوع ولا توفر الأمن من خوف.لم يكن ينتظر أن يرى تركيزًا على مظاهر الدين والتدين الخارجية ورموزه وإشاراته، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعة البشرية.لم يكن يترقب من يحمل أحلامه المتعلقة بالحاضر والمستقبل، فيتلاعب بها بحيث يعيش، عمليًا، في الماضي، بلغته ومفرداته وأسئلته وإجاباته، وكل خصوصياته الزمانية والمكانية.لم يكن الشعب التركي يبحث عن مزيدٍ من رجال الدين والمشايخ وحاملي الشهادات الشرعية، وإنما كان بحاجة إلى من تحدث عنهم أردوغان في كلمته قبل السجن "معماريين جيدين وأطباء جيدين، وحقوقيين متميزين".كان الشعب ينتظر من يحل له مشكلات البطالة والسكن والمواصلات والتلوث وانقطاع الماء والكهرباء، والفساد والإهمال الحكومي للمواطن، وتفشي مشاعر الكسل وخيانة الأمانة واللامسؤولية وفقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم.وهذا ما ركز عليه أردوغان وحزبه وحكوماته بشكلٍ كبير لأكثر من عشر سنوات، فتشكلَ الرصيد الذي يمكن الاعتماد عليه عند الحاجة.لكن وقائع الأيام العشرة الماضية أظهرت أن ما جرى في تركيا منذ عقدين على الأقل، هو في حقيقته، مشهدٌ آخر من مشاهد التجربة البشرية التي تُصيبُ وتُخطئ، وتُحاولُ وتجتهد، وتَقوى وتضعف، وتتنازعها المشاعر الإنسانية التي تُصاحِبُ مراحل الخطأ والصواب والضعف والقوة.ففي حين بقي أردوغان وبعض المسؤولين الأتراك يرددون أن الانقلاب انتهى بشكلٍ تام بعد اثنتي عشرة ساعة، ثم بعد يوم، ثم بعد يومين.. تأكد من مجريات الأحداث أن ما جرى خلال الأيام الماضية، وما يجري حاليًا، وسيجري في الأسابيع والأشهر القادمة، يدل على أن ثمة "مشكلةً" كبرى لا تزال تخترق تركيا مجتمعًا ودولة أفقيًا بشكلٍ كبير، قد يكون إطلاق تلك الإعلانات صائبًا من وجهة نظرٍ سياسية تكتيكية، لكن من الأرجح أن أصحابها يعلمون الآن حجم المشكلة، وثمة تاريخٌ ينتظر منهم أن يتعاملوا معها بشكلٍ صحيح.لا يصحﱡ هنا، منهجيًا وسياسيًا وحضاريًا، اختزالُ المشكلة التي نتحدث عنها في جماعة فتح الله غولن، ولا في مقولة تآمر قوى خارجية على تركيا ورئيسها، مهما كان نصيب هذه العناصر مما جرى. هذا جزءٌ من الحسابات فقط. وثمة جزءٌ آخر أكبر يتعلق بالعودة إلى الذات، الفردية والجماعية، لأصحاب التجربة التركية، والقيام بمراجعات تتعلق بتلك الذات دون غيرها، بكل ما في الوسع من قوةٍ وشجاعة وصراحةٍ مع النفس والشعب والتاريخ.هل اختلت التوازنات الدقيقة في التركيز، مثلًا، خلال السنوات القليلة الماضية بين الشعارات والإنجاز؟ وبين مظاهر الدين ومقاصده الكبرى؟ وبين الحياة في الماضي في مقابل الحياة في الحاضر؟ وبين الأهلية والولاء؟ هل حصل خللٌ في حسابات الأدوار والمواقع بين الفرد والمؤسسة؟ وبين الحزب والدولة؟ وبين من يمثل "الأنا" ومن يمثل "الآخر"؟هذه الأسئلة، ومثلها كثير، هي مما يُدرك الباحثون الحقيقيون عن الكمال في التجربة الإنسانية ضرورةَ طرحها على أنفسهم قبل غيرهم، ذلك أنهم يعلمون دقة التوازنات المتعلقة بها وأثرَها في التجربة من ناحية، وحقيقة كونهم بشرًا يُخطئون ويُصيبون من ناحية ثانية، وأخيرًا، واقعَ أن الإجابة عليها هو منطلق تصويب التجربة واستمرارها، قبل الإشارة بأصابع الاتهام إلى كل ما هو خارجي. ولا تكتمل المعادلة إلا حين تحصل هذه الممارسة الصعبة في مواجهة أكثريةٍ صاخبة ترى في مضمون تلك الأسئلة ترفًا، أو غفلةً عن إدراك كيف يعمل هذا العالم في نهاية المطاف.
663
| 24 يوليو 2016
"حاجةُ أوروبا وأمريكا للمراجعات تزداد إلحاحًا مع تتابع الأحداث والوقائع لحمايتها هي نفسها، قبل أي شيءٍ أو أحدٍ آخر، من الفوضى التي تنزلق إليها بأسباب تمتُ إلى الديمقراطية بأكثر من نسب". وَردَت العبارة أعلاه الأسبوع الماضي في معرض التحليل لعنوان هذا المقال. حصل هذا قبل أن يُقتل مواطنان من السود في أمريكا برصاص شرطةٍ من البيض في ولايتين مختلفتين لمجرد الاشتباه بهما، وقبل أن يُقتل بعدها بيومين خمسة رجال شرطة بيض، انتقامًا للرجلين، برصاص مواطنٍ أمريكي أسود. وبالتأكيد قبل أن يجتاح إرهابيٌ مسيرة مزدحمة لاحتفال الفرنسيين بسقوط الباستيل فجر الجمعة بشاحنةٍ كبيرة، على مسافة أكثر من ميل، مطلقًا النار عليهم في الوقت نفسه، في أكبر وأغرب عملية إرهاب، على الأقل في التاريخ المعاصر.مهما قيل عن أهداف وجود النظام الديمقراطي، وهي كثيرة، لكن قدرتها على تأمين سلامة المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرار بلادهم تمثل، دائمًا وأبدًا، الهدف الأهم والأكبر.وهذا هدفٌ لم يعد يتحقق على الإطلاق بكل المعايير، لا على المستوى الدولي بشكلٍ عام، ولا في البلاد التي ابتكرت الديمقراطية كنظام مازالت تعمل وفقه حتى الآن.يمكن أن يقول الغرب، أوروبا وأمريكا تحديدًا، ما تشاء عن الإرهاب نفسه، وأن تُلقي كل أنواع اللوم على الإرهابيين. بل يمكن، كما يحدث عمليًا، أن تتلاعب بالأمور وتخلط الأوراق فتهرب القيادات والنُخب من إخفاقاتها السياسية والاقتصادية في مجتمعاتها، وأن تتجاهل السقوط المدوي الأخلاقي والسياسي لها في قضايا دولية كثيرة، أوضحها وأقساها وضعُ سوريا اليوم. ويمكن، لتغطية هذا الهروب، أن تُلقي باللوم على شعوب وثقافات وأديان مغايرة لها، بدعوى أنها شريرةٌ في جوهرها، وأن هذا هو السبب الوحيد في كل ما يجري، بعيدًا عن كل خطاياها وأخطائها المذكورة أعلاه.يمكن أن يحصل كل هذا. وهو يحصل، وسيحصل كثيرًا في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة. بل إننا كبشر سندخل، كما أكدنا مرارًا في هذا المقام، مرحلةً سوداويةً تنفلتُ فيها مقتضيات العقل أكثر فأكثر لدى الغرب وأهله، ويكتسحُ فيها التفكير الشعبوي أوساطهُ الأهلية والسياسية، بكل ما يمكن أن ينتج عن هذا من ممارسات سيتبين افتقاد الديمقراطية، كنظام، عن استيعابها، بشكلٍ متزايد.من هنا، ورغم كل ممارسات اللوم والاتهام والهجوم والعنف التي ستصبح سيدة الموقف تجاه الإسلام والمسلمين والعرب تحديدًا، فإن كل هذا لن يغير من الحقيقة التي نحاول التأكيد عليها: إن ما جرى ويجري، وسيجري، من فوضى يؤكد فشل الديمقراطية في تحقيق الهدف الأكبر من وجودها المذكور أعلاه "قدرتها على تأمين سلامة المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرار بلادهم".إذ المفروض فيها هي، كنظامٍ سياسي يملك أهله إمكانات هائلة على جميع المستويات، تُمثلُ الدولة التي يُفترض فيها أن تكون أقوى مؤسسة في المجتمع بما لا يُقاس، أن تكون القادرة على استيعاب تجليات الفعل البشري والتعامل معه، أيًا كان هذا الفعل، حتى لو كان ظاهرة الإرهاب. ومن التفكير الطفولي، سياسيًا وحضاريًا وثقافيًا، الاعتذارُ بأنها غير قادرة على التعامل مع هذه الظاهرة تحديدًا لأنها غريبةٌ وجديدة.. وغير ذلك من الأعذار.ما تتجاهلهُ أنظمة الغرب الديمقراطية في هذا المقام هو أننا وصلنا إلى هذه الظاهرة لأن نظامها الديمقراطي نفسه، كما يجري تطبيقه، وبعيدًا عن المبادئ النظرية، لا يهرب فقط من معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية لهذه الظاهرة، وإنما يمارس ازدواجية المعايير، والتلاعب بمصائر الشعوب في العالم، ويعقد الصفقات السرية والعلنية على حسابهم لتحقيق مصالحه. وهو بهذا يخلق فيها واقعًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا لا يمكن إلا أن يؤدي إلى انفجارات داخلية وخارجية.لا يريد الساسة "المعتدلون" في أوروبا وأمريكا الاعتراف بهذه الحقائق، لأنها، ببساطة، تتنافى مع مقتضيات الديمقراطية الحقيقية. هذا إن كانت شعوب العالم خارج القارتين تستحقها في نظرهم بطبيعة الحال. وبما أنهم يفشلون، بشكلٍ متزايد، في حل مشكلات بلادهم الاقتصادية، وبالتالي الاجتماعية، فإنهم لا يمانعون في إعطاء الفرصة، بشكلٍ غير مباشر حتى الآن، في فتح المجال لشعارات القوى العنصرية والفاشية التي تلقي اللوم على المهاجرين تحديدًا، وعلى الثقافات والشعوب والأديان الأخرى "الهمجية في تكوينها الذاتي"، لتبرير تلك المشكلات.لكن مفرق الطريق يقترب سريعًا، لهم وللبشرية بأسرها. فبعد اليوم، ثمة طوفانٌ قادم لقادة العنصرية والفاشية وقواها، بكل شعاراتها وسياساتها، لن يرضى إلا بمواقع القيادة الأساسية، وديمقراطيًا، بموافقة الشعوب المذعورة. يبدأ الطوفان، طبعًا، بسياسات خرقاء وخطيرة تستهدف العرب والمسلمين، شعوبًا ودولًا. وسيحصل هذا بقوانين وتشريعات "استثنائية" غير ديمقراطية، بمبرر أن التشريعات الديمقراطية لم تعد تتمكن من التعامل مع مثل هذا الوضع. لكن أحداث الطوفان ستعود لترتد على أوروبا وأمريكا، من داخلها ومن خارجها، بحيث يُمسي كل ما حصل فيها من فوضى حتى الآن مثل لَعبِ الأطفال.
442
| 17 يوليو 2016
قد تُظهر الأحداث في بريطانيا نفسِها أن مقولة رئيس وزرائها السابق، ونستون تشرشل، بخصوص الديمقراطية، تحتاج إلى إعادة نظر. لم يكن السياسي الداهية مفتونًا بالنظام الديمقراطي على الإطلاق، فهو يقول إنه "أسوأ نظام للحكم باستثناء الأنظمة الأخرى التي جرﱠبتها البشرية"، بمعنى أنه يُدرك وجود إشكالات عديدة في الديمقراطية، لكنه يحكم عليها قياسًا على ما سبقها من تجارب إنسانية للحكم لم تُحقق، بإجمال، ما حققتهُ هي من نجاح، ولو نسبي، على الأقل في مجال إشراك أكبر عدد ممكن من الناس العاديين في صناعة قرارات تتعلق بحياتهم، من خلال آليات الانتخاب والتمثيل النيابي.لكن تطورات الأحداث في بريطانيا، ومعها أمريكا وأوروبا بأسرها، بدأت تُظهر من الثغرات والمشاكل ما يوحي بضرورة مراجعة النظام الديمقراطي، كتجربةٍ أخرى من تجارب البشرية، وأن الأوان ربما حان للبحث في نظامٍ قد يكون أفضلَ منها، أو في ضرورة تطويرها بشكلٍ جذري في أقل الأحوال.لا علاقة لهذا التحليل بأوهام تتحدث عن "انهيار الغرب" غدًا أو بعد غد، أو بشماتةٍ يتمثل زادُها في تغذية الحلم بسقوطه مع كل خبرٍ أو واقعة. فنحن، عربًا ومسلمين، على هامش صناعة الواقع العالمي الراهن، وإذا كان لواقعنا من "إسهامٍ" في الموضوع، فإنه يتمثل في إظهار عورات النظام الديمقراطي، عالميًا، بشكلٍ غير مباشر، ومن خلال معادلات حضارية مُعقدة ليس هذا مقام التفصيل فيها.فأوروبا وأمريكا بحاجةٍ لإعادة النظر في ديمقراطيةٍ شاخت، فيما يبدو، ولم يعد بمقدورها استيعاب حيويةِ الإنسان التي تبقى فتيةً على الدوام. وهي حيويةٌ تحمل ما هو سلبي وما هو إيجابي بنفس القَدرِ والقُدرة. وحاجة أوروبا وأمريكا للمراجعات تزداد إلحاحًا مع تتابع الأحداث والوقائع لحمايتها هي نفسها، قبل أي شيءٍ أو أحدٍ آخر، من الفوضى التي تنزلق إليها بأسباب تمتُ إلى الديمقراطية بأكثر من نسب.من رحمة الله، بطبيعة الحال، أن أي إصلاح حقيقي للنظام الديمقراطي في العالم سيكون للعرب والمسلمين منه نصيب، لكن هذا لا علاقة له بجهدهم وعملهم، كما هي العادة فيما يُصيبهم من خير، منذ زمنٍ بعيد.عودة للأسئلة التي يثيرها الواقع اليوم: ماذا يعني، مثلًا، أن تُصوت غالبية البريطانيين في استفتاء شعبي للخروج من الاتحاد الأوروبي؟ في حين أن كل الدراسات والإحصاءات تؤكد أن غالبية "ممثلي" البريطانيين أنفسهم في البرلمان هم ضد الخروج منه! بماذا تنفع إذًا آلية التمثيل الشعبي في هذا الموضوع؟ ولو لم يكن ثمة استفتاء، وبقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، هل يعني هذا أن ممثلي الشعب كانوا ضد إرادة مواطنيهم في مثل هذا الموضوع الخطير؟المفارقة المُعبِّرة جدًا هنا أن موضوع الاستفتاء بأسره حصل نتيجة قرار شخص، هو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وبسبب مناكفات انتخابية منذ ثلاث سنوات، وجاء على شكل نزوة تحدٍ لمنافسيه عبر المقامرة فيما يتعلق بهذا الموضوع. هكذا، في الديمقراطية المعاصرة، تتحدد مصائر قارةٍ كاملة، اخترعت الديمقراطية للمناسبة، من خلال مشاعر وردود أفعال شخصية لفردٍ واحد في لحظةٍ معينة. ولا تثريب في ذلك، ببساطة، لأنه "مُنتَخب" من الشعب.صدق لورنس بيتر، خبير التعليم والمفكر الكندي، حين التقط بذكاء أحد جوانب النظام الديمقراطي قائلًا: "الديمقراطية عمليةٌ يمكن من خلالها للناس اختيار الشخص الذي سيوجهون له اللوم".إضافةً لما سبق، ماذا نفعل بحقوق الناس في تقرير مصيرهم، وهذا من أغلى أهداف وجود النظام الديمقراطي، حين يُحرم أهل مدينةٍ مثل لندن، ومعها سكان بلدين، هما اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، من رغبتهم في البقاء في الاتحاد الأوروبي؟ وحين تُحرم شرائح الشباب في بريطانيا من ذلك، وهي التي ستعيش خمسين عامًا مع القرار، بسبب غلبة قرار من سيعيشون معه خمسة أعوام أو عشرة؟المضحك المبكي أن وسمًا أو (هاشتاج) يقول: "#ماذا_فعلنا؟" كان من الأكثر انتشارًا في بريطانيا بعد نجاح الراغبين في الانفصال عن أوروبا في معركتهم، حيث انتشر عبر التحليلات أن غالبية هؤلاء لم يكونوا يتوقعون نجاحهم في التصويت في حقيقة الأمر. هل نقول هنا أيضًا عن الديمقراطية ما قاله الكاتب الأمريكي آرت سباندر:"الشيء الرائع فيما يتعلق بالديمقراطية يتمثل في أنها تعطي كل ناخب الحق في القيام بشيءٍ أحمق".
503
| 10 يوليو 2016
ثمة إغراءٌ كبير في النظر إلى المواقف التركية الأخيرة بخصوص روسيا وإسرائيل انطلاقاً من موقفين متناقضين لاثالث لهما. واحدٌ يمثلُ الإسلاميون أكثريته، ويكمن في منظومةٍ متكاملة من المقولات تندرج في النهاية تحت وصف "الاعتذاريات"، والاستغراق، لدرجة التعسف، في إيجاد مايعتقدون أنه أعذار ومبررات لتلك المواقف. يأتي هذا بمضمونٍ مهلهل سياسياً ومنطقياً، وأدوات خطابية وشعاراتية، لايمكن إدراجها جميعاً إلا في سياق الولاء الأيديولوجي المُطلق للتجربة التركية وأهلها، فضلاً عن الشعور بالحرج من مواقف التأييد الصارخ السابقة، وافتقاد الشجاعة لمواجهة هذا التحول بمقتضيات العقل والمنطق. في مقابل هذا، يبدو وكأن شريحةً من السوريين، وغيرهم، وجدت في الحدث الراهن فرصةً ذهبية، كانت تتعطش إليها بشوقٍ غامر، للتهجم على تركيا وحكومتها. ليس فقط لاتهامها بكل أنواع الغدر والانتهازية والافتقار إلى المبادىء، ولتأكيد المواقف السلبية السابقة لهذه الشريحة من تركيا. وهي مواقف كانت تتجاهل كل إيجابية تجاه السوريين أياً كانت كبيرة ومعروفة، وتعمل على تضخيم الأخطاء مهما كانت صغيرة. هذان نمطان في التفكير يعبران سوياً عن جزءٍ آخر، خطير، من الأزمة البنيوية في فهم الجماهير، وشرائح ممن يعتبرون أنفسهم نُخباً، لظاهرة العلاقة بين تركيا والثورة السورية تحديداً. لكن تأثير الأزمة يمتد أيضاً ليشمل الأسئلة الكبرى التي طرحتها الثورة السورية بمتغيراتها، ليس فقط على تركيا، بل وعلى الإقليم والعالم بأسره. لانحصر الأسئلة المذكورة هنا في الحقل السياسي، سواء منه الداخلي أو ذلك المتعلق بمنظومة العلاقات الدولية، رغم الحساسية البالغة في هذا المجال كونها تمثل التعبير المباشر عن المآزق الكبرى التي تُفرزها تلك الأسئلة. فمن جهة، بلغ تأثير الوضع السوري في الداخل التركي درجةً من التعقيد يكاد يصعب على حكومةٍ في العالم تفكيكها إلى عناصر واضحة قابلة للفرز، بغرض التعامل معها بشكلٍ يحقق الحد الأدنى من الأمن والاستقرار للمجتمع التركي، وبدرجةٍ من الانسجام مع المبادىء الأخلاقية التي حاولت تركيا أن تحافظ عليها في معرض تعاملها مع الواقع السوري. ومن جهةٍ أخرى، شهدت "منظومة" العلاقات الدولية في كل ماله علاقة بالوضع السوري درجةً من التداخل وخلط الأوراق فَقدت معها كل منطق سياسي. وتجاوزت التحالفات والتحالفات المضادة، السرية منها والعلنية، والتناقضات بين الممارسات العملية من جانب، والتصريحات والوعود من جانبٍ آخر، أي قواعد يمكن الاعتماد عليها في فهم واقع العلاقات بين الدول، بحيث لم يعد بالإمكان نهائياً إطلاقُ وصف "منظومة علاقات دولية" عليها أصلاً. لو عدنا إلى البدايات. سيكون سخيفاً ألا نُقوﱢمَ إيجابياً الجهود التركية لاستيعاب قرابة 3 ملايين سوري لاجىء في تركيا، في أوضاع أفضل بكثير من نظرائهم في البلدان الأخرى. ومن غير الممكن القول بأن هذه الظاهرة لاتدخل في خانة التعامل الأخلاقي، النابع من رؤية إيديولجية بمعنىً من المعاني. وبشواهد أخرى مماثلة لايصعب التفكير بها، يمكن القول أن هذا المنهج كان جانباً من الموقف التركي الرسمي للتعامل مع المسألة السورية. على صعيد آخر، ومن البدايات أيضاً، كانت "السياسة"، بمعنى الحسابات المتعلقة بالتوازنات العسكرية والسياسية في القرارات الخاصة بسوريا جزءاً من ملفها في تركيا. من هنا، تجنبت الحكومة التركية بإصرار التدخل العسكري المباشر، وخاصةً لإنشاء منطقةٍ آمنة كانت مُقتنعةً تماماً بضرورتها. أدرك الجميع لاحقاً خطأ تركيا في هذا الموضوع تحديداً، بمن فيهم تركيا نفسها. لكن هذا كان، بحسابات منطقية وقتَها، يحمل مظنة توريطٍ لتركيا وحدها في الداخل السوري، في زمنٍ لم يكن يتخيل فيه أحدٌ، بما فيه الأتراك، أن هذا الداخل سيُصبح ساحة تدخل مباشر لقوىً إقليمية وعالمية أصبح تعدادها صعباً. وكان الاعتقاد بأن التصريحات والمواقف الصارخة المؤيدة لثورة الشعب السوري، ومايتعلق بها من أحاديث عن خطوط حمراء، ستكون حافزاً لتعاون عملي حاسم مع أمريكا وحلف الناتو وغيرها على الأرض السورية. ومع تطور الأحداث، وجدت تركيا نفسها تنزلق تدريجياً باتجاه مآزق داخلية وخارجية استراتيجية. وبحساباتٍ منطقية، بات واضحاً أن توازنات عناصر معادلة الأيديولوجيا والسياسة لديها، والمتعلقة بالشأن السوري، لم تصل بها إلى النتيجة المرجوة. فلا هي استطاعت الاستمرار، بشكلٍ لانهاية له، في تحمل تبعات الموقف الأخلاقي / الأيديولوجي، أمنياً واقتصادياً. أما معادلة السياسة التي تتمحور حول اعتمادها على الناتو وأمريكا فقد أظهرت فشلها الذريع. من هنا، أعادت تركيا ترتيب حساباتها السياسية، فقررت أن تحاول اختراق اللاعبين المؤثرين على الأرض مباشرةً سياسياً وميدانياً، مثل روسيا وإسرائيل، خاصةً في ظل الجوار الجغرافي المؤثر لهما. ثمة تحليلٌ بأن هذه المحاولة تهدف إلى تأكيد موقف تركيا من تغيير نظام الأسد، بمعادلات ومداخل وأوراق أخرى، لكن هذا التحدي كبير، ولايعرف أحدٌ ثمن تحقيقه سياسياً واقتصادياً. إضافةً إلى هذا، يطرح التحول التركي أسئلة جديدة وصعبة على أردوغان وحزبه تتعلق بالتوازنات التي كانوا يحاولون الحفاظ عليها بين مقتضيات "الأخلاقية" وتَبِعات "السياسة" بمفهومها الواقعي السائد عالمياً. من المؤكد، في نهاية المطاف، أن المشهد التركي الراهن بات دليلاً آخر على حجم الفوضى العالمية التي تجتاح المنطقة والعالم في كل مجال، والحاجة لأن تبحث كل دولة فيه عن بدائل مبتكرة لصناعة السياسات. وعلى كون تلك الفوضى، بالتأكيد، مخاضاً لنظامٍ عالمي جديد لابد من ظهوره، وهو ماتوحي المؤشرات باستحالته إلا بعد تصاعد احتقانٍ راهن يؤدي لانفجارٍ كبير وشامل.
930
| 03 يوليو 2016
مساحة إعلانية

تهاوي هياكل الظلم والظلام واللاإنسانية أرثت عوالق ما...
7950
| 23 فبراير 2026

رمضان في الوعي الإسلامي ليس مجرد شهر عبادة...
1284
| 25 فبراير 2026

تُعد قضايا الأسرة من القضايا المهمة التي تحتل...
720
| 20 فبراير 2026

جوهر رمضان هو العبادة، وتخليص النفس للطاعة، والتقرب...
690
| 25 فبراير 2026

كلنا يعلم الرابط القوي والعلاقة المميزة بين القرآن...
681
| 20 فبراير 2026

استكمالا لما ورد في (مقالنا) الذي نُشر تحت...
597
| 24 فبراير 2026

يشهد قطاع التعليم تطورًا مستمرًا في أدواته وأنظمته،...
594
| 24 فبراير 2026

كشف التقرير السنوي لقطر للسياحة أن عدد الزوار...
591
| 22 فبراير 2026

لم أفهم معنى أن يكون للطفولة ظلٌّ يحرسها...
552
| 23 فبراير 2026

لئن كان صيام رمضان فريضة دينية، إلا أن...
507
| 22 فبراير 2026

الكلمة في ميزان الإسلام ليست صوتًا يذوب في...
483
| 24 فبراير 2026

تُعد دولة قطر شريكاً محورياً في الجهود الدولية...
471
| 20 فبراير 2026
مساحة إعلانية