رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يكاد القلق أن يكون الشكوى المشتركة بين غالبية الناس وهو بالمعنى الواقعي والعملي يعني تهويل المواقف وتفسيرها بأسلوب مزعج ومثير للخوف والارتباك. وهو كاستجابة سلوكية يعتبر سلوكا متعلما قد ينتقل للأبناء من خلال عمليتي الملاحظة والتقليد، ثم يستمر ليصبح عادة سلوكية، وقد يتطور ليصبح سمة في الشخصية. إن تدريب الأبناء ومساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة وضغوطها يقتضي توافر نماذج والدية تتميز بالعقلانية في التفكير والتجرد والتحرر من مشاعر التوتر والقلق، والقدرة على ضبط الانفعالات والتعامل مع المستجدات والمتغيرات بطريقة فكرية وانفعالية منضبطة، والقدرة كذلك على إدارة الحياة مع التحلي بالمرونة ومهارة التفاوض والنقاش والحوار. وتختلف أشكال القلق ودرجاته عند الأبناء ولعل أكثرها شيوعاً ما يعرف عيادياً بــ (القلق الاجتماعي) والذي ينشأ في ذواتهم من البيئة التي تعظم في نفسية النشء معنى الخوف والخجل وتمنع الابن من الحوار وتقلل من شأنه باستصغاره وتهويل أخطائه. وقد يظهر القلق لدى الأبناء بصورة قلق الانفصال والذي يصيبهم عندما يبتعدون عن ذويهم، خاصة الأم أو الأب مما يجعلهم في ارتباك وتوتر وخوف يعيق تفاعلهم مع العالم الخارجي، كما قد يظهر قلق الأبناء في صورة شعور عام بعدم الراحة نتيجة كثرة المشاحنات والانفعالات داخل البيئة المنزلية. إن مرور الطفل بخبرات وصدمات مؤلمة أمر لا يستهان به في نموه النفسي، والآباء القلقون عادة ما تحمل رسائلهم معاني الحذر والحيطة مما يحرم الأبناء من النضج النفسي والانفعالي. إن سلوكيات الآباء هي الرسائل الأكثر تأثيراً في ذهن الأبناء ويصعب عليهم تناسيها أو تجاهلها وتظل خبرة وتجربة ممتدة لحياتهم ومستقبلهم. إن بعض الآباء يظنون أن تجنيب أبنائهم للمواقف التي تثير لديهم القلق يحميهم من مخاطره، لكن ذلك في الحقيقة يؤدي بهم إلى ضعف الثقة بالنفس وتعزيز القلق وسوء تكيفهم على الصعيد الشخصي والاجتماعي وضعف مهارات التواصل والتراخي عن الدور الاجتماعي في الحياة. إن مساندة الأبناء لا تعني الحماية المفرطة التي تحفز في دواخلهم مفهوم التبعية، وفي حالة الضغوط نجد بعض الآباء يتجنبون مواقف التفاعل بالهروب وعدم المواجهة مما يستدعي مشاعر الخوف والقلق عند الأبناء من خلال فقدان الأمان الذي هو الوظيفة الأولى للوالدين. إن التنصل من الدور الوالدي تجاه الأبناء يفقدهم النموذج القدوة وبالتالي يخل بأساسيات النمو النفسي المتوازن، كما أن ردود الأفعال الغاضبة من قبل الوالدين تحمل رسائل سلبية عن مفهوم الحياة وعن الآخرين مما يعزز في نفسية الأبناء القلق من المواقف عامة، ويدفع الابن دون استبصار إلى توقع المخاطر قبل وقوعها. ويتجسد القلق في أحد أشكاله عندما يظهر في صورة خوف دائم أو نقد مستمر لتصرفات الابن، أو في صورة الحماية الزائدة له مما قد يؤدي إلى تعزيز سمات الشخصية القلقة (الوسواسية) لديه. إن القلق ليس مجرد سلوك متعلم أو مكتسب أو مشاهد ولكنه أيضا ردود أفعال وأسلوب في التربية يعيشه الأبناء بتقلباته ومتغيراته ويصاحب ذلك مشاعر متذبذبة ومعارف سلبية يتشكل من خلالها قلق جديد في صور جديدة. إن أزمة القلق الأخرى أن بعض الآباء يعتقدون أنه حماية مرغوبة وواجبة تتماشى مع مسؤولية الأبناء والحفاظ عليهم والاهتمام بهم، فيندفع الآباء لاعتماد القلق كأسلوب تربوي. وتؤكد الكثير من الدراسات أن مقارنة الابن بغيره من أهم مسببات القلق لديه. وذلك لأن مجرد شعوره أن هناك من هو أميز وأفضل منه سيجعله ينشغل بغيره عن تطوير ذاته، إذا تختلف أسباب القلق وأشكاله وبواعثه ومعززاته وتظل الحقيقة العلمية تؤكد أن أساليب التربية التي تعتمد الخوف والحماية المفرطة وعدم مواجهة المواقف هي بيئة خصبة لنشأة القلق وتعزيزه.
4459
| 29 مايو 2013
عزيزي القارئ.. لا تتعجب أن يكون هناك طلاق ناجح.. فالطلاق مثل الزواج له اعتبارات وضوابط شرعية واجتماعية وإن تم الأخذ بها كان ناجحا في طريقته وآثاره. الطلاق هو في الغالب نهاية حتمية لعلاقة زوجية اتسمت خلال مسيرتها بكثرة الخلافات والهزات التي استحال معها استمرار العيش المشترك في بيت الزوجية. ورغم كراهية الطلاق على جميع المستويات إلا أنه في بعض الحالات يكون مخرجا مهما ووحيدا لحياة ارتسمت في ملامحها معاني اليأس والإحباط. فحين يصعب الحوار والالتقاء والتقدير والمودة والاحترام تكون الحياة بمثابة رحلة من المتاعب لكل أفرادها بما في ذلك الأبناء. وبما أن الواقع يؤكد علمياً أن نسبة الطلاق تجاوزت في بعض المجتمعات الــ 40% كان لزاماً على المختصين والمهتمين وضع استراتيجيات لإدارة الحياة لما بعد الانفصال وذلك لتقليص حجم المعاناة خاصة على الأبناء. إن الطلاق مثله مثل الزواج من حيث ضرورة التمهيد له وحسن التخطيط وهو قرار في بعض الأحيان قائم على الاتفاق والتراضي ولكنه في أحيان كثيرة قائم على الفرض و الإلزام، وذلك في حالة إصرار طرف ورغبته دون الطرف الآخر. إن وقوع الطلاق بحد ذاته قد لا يكون ضررا ولكن يحدث الضرر النفسي والاجتماعي البالغ عندما يتم الطلاق بصورة عنيفة مندفعة وانفعالية متشنجة، ويشتد الضرر عندما يصر الطرفان أو أحدهما على ملاحقة الآخر بالشتم والتشهير والانتقاص والتحقير والتقليل من شأنه. إن الطلاق مرحلة يصل إليه شخصان ينقصهما الاستعداد للعيش سويا. وقد يكون عدم الاستعداد هو نتيجة لخلل في المشاعر أو تنافر في الطباع أو شدة المشاكل وتكراراها وتصاعد الخلاف لدرجات يصعب معها الحوار والاتفاق، إذا في النهاية.. الطلاق هو قرار حتمي لبعض العلاقات. وتلك حقيقة يجب على أطراف العلاقة استيعابها. إن الطلاق الناجح يعتمد على التخطيط الناضج لمستقبل الأبناء الذين سيتحملون جزءا كبيرا من تبعات القرار. الطلاق الناجح هو نتيجة مفترضة لعدد من المقدمات والعوامل، منها الاقتناع المشترك بقرار الطلاق و التفاهم المسبق على آليات التعامل مع الأبناء وعدم الاسترسال في الحديث عن عيوب الطرف الآخر والتركيز عليها و التكيف مع أسرة الطرف الآخر لتحقيق الجو الأسري للأطفال والحرص على جو من الأمان لتسهيل عملية التواصل والاتصال. ويصبح الطلاق ناجحاً إن تم استدراك إيجابياته والعمل على تغيير نمطية الحياة. وعدم الاسترسال في الألم أو الاستسلام لمشاعر الندم ولوم الذات والشعور بخيبة الأمل، إن التغيير في أي مجال من الحياة وأياً كان شكله وهدفه قد يكون مقلقاً لحد ما. وعندما يكون هذا التغيير مرتبطا بشكل اجتماعي وأدوار حياتية قد تكون غير محببة للذات في بدايته فلا شك أن القلق سيكون بدرجة أعلى وبصورة أعمق وأكثر تأثيراً. إن دور الأم والأب هو دور مكثف. فإضافة إلى تحمل القرار وتبعاته والآثار النفسية الذاتية لكل طرف والتي تعكس شخصيته فإن على الوالدين ضرورة الظهور أمام الأبناء بالتوازن وتجهيز البيئة الجديدة بما يتناسب مع شخصية الأطفال ومراعاة المرحلة الانتقالية للأبناء وترتيب أمورهم المدرسية. وتنشيط حياتهم الاجتماعية بما يحقق لهم التكيف الإيجابي. الطلاق مسؤولية عظيمة يترتب عليها حياة مختلفة وجديدة. لذلك الناضج من يخرج من دائرة ألمها إلى فضاء حسن إدارتها والتعامل معها وذلك عن طريق تقبل الحياة الجديدة و تفهم متطلبات التغيير و تقبل الألم الناتج في بدايته مع عدم الاسترسال به والتعايش مع الدور الجديد و الالتزام بالواجبات و احترام حقوق الطرف الآخر والحديث عن الطرف الآخر في حدود الاحترام خاصة أمام الأبناء والأهل. إن إنهاء الحياة الزوجية بهدوء وتراضي يعكس شخصيات ناضجة عاقلة. استوعبت مشكلة الطلاق واعتبرتها جزء من حياتها وليس كل حياتها. وبالتالي فإن التعامل معها يقتضي القدرة على ضبط النفس وإدارة الانفعالات من خلال استخلاص المزايا والنواحي الإيجابية في عملية الطلاق. ومن خلال إدراك الدور المؤثر للآباء على الأبناء في هذه المرحلة تتجلى أهمية التهيئة المتزنة والآمنة للأبناء ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وإيجابي. ويتم ذلك من خلال إعداد الأبناء لخوض الحياة الجديدة ليس على أنها أزمة وكارثة علينا البكاء عليها. وإنما على أنها شكل جديد للحياة واختلافات علينا التعايش معها وتقبلها.
18943
| 22 مايو 2013
النوم حاجة تختزل في صورتها المبدئية حاجات الإنسان الأساسية في الراحة والسكينة والاستقرار والأمان، ويمكننا القول أن النوم الجيد هو دلالة على حسن التنظيم الجيد للحياة عموماً كما أنه دلالة واضحة على التنسيق المتزن بين الوظائف الحياتية المتنوعة والمختلفة والتي تفرضها متطلبات الحياة. وقد أشارت بعض الدراسات العلمية أن 40 % من المصابين بالأرق لديهم اضطرابات أو أعراض نفسية، ويعتبر الأرق انعكاسا طبيعيا لتلك النفوس التي تعاني من الإخفاق الشخصي في التعامل مع النوم كحاجة وحالة يعيشها الفرد لتحقيق درجة من التكيف الحيوي والبدني والفكري والنفسي. وباستثناء الحديث عن اضطراب النوم كحالة عضوية تتعلق باضطرابات صحية أخرى واختلال الغدد أو الهرمونات. فإن الأرق يمثل أهم أعراض المزاج الذي يتسم بالتوتر الدائم والكآبة التي تتولد نتيجة التعامل السلبي مع مواقف الحياة. إن ارتباط النوم أو المرحلة التي تسبقه بعادات فكرية أو سلوكية سلبية هو المنتج الأساس للأرق المزمن، والأرق هو: عدم القدرة على النوم، أو النوم ولكن مع عدم الشعور بالراحة. وقد يكون في بداية النوم ـ أي صعوبة الدخول في النوم ـ أو كثرة القيام أثناء النوم أو قلة عدد ساعات النوم ويصاحب ذلك شعور دائم بالتوتر الداخلي والذي ينعكس سلبا على الأداء والسلوك بل وحتى التفاعل الاجتماعي والقيام بالأدوار الحياتية المختلفة. الأرق مشكلة يصعب تحجيم آثارها لأنها في حقيقتها خطر يهدد الحاجات النفسية التي تعتبر محفزات للعطاء والإنتاج والإنجاز، إن مرحلة قبل النوم هو الوقت الذي عادة ما يختلي به الإنسان بنفسه. والبعض يدركه كلحظات استرخاء وتأمل. وعند البعض يعتبر كتصفية حسابات لبعض الضغوط اليومية التي لم تعالج ولم تنته. ولعل من أهم مسببات الأرق هو الاعتياد على استرجاع المواقف السلبية في الحياة وعدم القدرة على مواجهتها وحلها بشكل إيجابي فتتحول في ذات بعض الأشخاص إلى كوابيس ليلية ترتبط بوقت النوم. إن البعض قد يعانون مما يسميه الطب النفسي ـ اضطراب الفزع ـ أو نوبات الفزع وهي حالة تأتي في كثير من الأحيان عندما يكون الشخص بمفرده، وتكون مصحوبة بأعراض مختلطة من القلق والخوف مع توترات جسدية مهيمنة في تلك اللحظة تؤثر على راحة الجسم وصفاء الذهن مما يغير في شكل النوم وكيفته وساعاته. إن كثرة الانفعالات والشد والمشاحنات اليومية تؤثر سلباً على مزاج الشخص وهدوئه الداخلي مما ينعكس على قابليته واستعداده الجيد والصحي للنوم فيتسبب بشكل مباشر في حدوث الأرق، ويؤثر صخب الحياة اليومية وفوضى الأفكار والمشاعر وتراكم الأعمال على راحة الفرد بمستويات وأشكال مختلفة تؤثر على استمتاعه بالنوم كذلك. ويؤجل الكثير أفكاره السلبية المتراكمة لتحليلها والاستغراق فيها إلى الليل دون تعمد أو قصد حيث يجد نفسه تلقائياً في لقاء ليلي يومي مع الشك والحيرة والإحباط الأمر الذي قد يرهقه جسدياً وذهنياً مما يجعله يجد صعوبة في البدء بالنوم أو يعاني من النوم المضطرب أو من تكرار الأحلام المزعجة والتي تعكس ضجيج الحياة الداخلية للفرد. إن إهمال الصحة والعشوائية في إتباع العادات السليمة للغذاء والنشاط تتسبب في تهديد الأمن الصحي الذي يؤثر على راحة الجسد وزيادة مستوى توتره مما يجعله يعاني صعوبة بشكل أو بأخر في تحقيق استرخاء يسمح بالدخول في النوم بطريقة عفوية وانسيابية. ويتجاهل البعض التجهيز الخارجي المناسب لمكان النوم. فلا يلتفت للضوضاء أو أريحية الفراش مما يؤثر على وضعية الجسم التي تنزعج من فوضى المكان وتقاوم الرفض بسلوك خارجي يظهر بصورة نوم غير صحي وغير مستقر، إن حاجات الإنسان قائمة على التكامل والشمولية لذلك فإن إهمال جانب يؤثر على باقي الجوانب حتى في حالة اكتمالها ووجودها. فوجود المكان المهيأ لا يكفي للنوم المستقر إن كان الذهن يعج بالأفكار السلبية المتضاربة والمتكررة والملحة. إن مجرد اعتقاد البعض أنه مصاب حتماً بالأرق وقناعته بعدم القدرة على التغيير يعزز في ذاته الشعور بالخوف والقلق مما يعزز ويثبت من حالة الأرق، لذلك فإن أي خطوة لمعاجلة حالة الأرق هو التفكير العملي في تعديل أسلوب الحياة وبالتالي تعديل السلوكيات الخاطئة المرتبطة بحالة التعود التي جبل الإنسان نفسه عليها، ومع كل هذه الاحتمالات فإن معالجة الأرق تتمركز في فك الاشتراط بين النوم والمخاوف المرتبطة به. وجعل أجواء الليل لديك مرتبطة بمحبوبات النفس كمهاتفة صديق أو كتابة خواطر أو قرأه في كتب أو مقالات أو مواضيع شيقة وجذابة،مع ضرورة معالجة ومواجهة الضغوط اليومية بعقلانية ونضج وعدم تأجيلها وكبتها لتتحول لمآسي تتسبب في الحزن والخوف وبالتالي الأرق.. إن التدريب على تمارين التأمل والاسترخاء من الفنيات العلاجية المناسبة جداً لمعالجة الأرق وما يصاحبه من أفكار ذهنية سلبية ملحة وتوترات جسدية تتصل مباشرة بتشتت الانتباه والتركيز.
2496
| 15 مايو 2013
لنتفق أولاً على أن سلوك الأبناء هو انعكاس للممارسة الوالدية المتأرجحة أو الثابتة. المتزنة أو المنفعلة، إن التربية ليست عملية عشوائية ترتقي بالاجتهادات الشخصية. إنها منهج منظم قائم على إدراك طبيعة الطفل وإدراك خصوصيته الفكرية والنفسية وكذلك الروحية. التربية هي علاقة تعتمد على التقديم والقيام بالواجبات المادية والمعنوية مقابل الظفر بمخرجات بشرية تحمل أفكارا وسلوكيات متناغمة مع الأدوار المتوقعة من كل شخص حسبما تقتضيه المرحلة العمرية التي يعيشها، و لا يمكن لهذه العلاقة أن تثمر مالم تخضع للمنهج العلمي المقنن وليس المعمم. فإن كنت تبحث عن سلامة النشء فعليك الإحسان للنبتة. وإن كان هدفك الخروج للمجتمع بجيل معتدل نفسياً فعليك بحسن الاستثمار لتلك الطاقات والمواهب والمعطيات البشرية التي تعتبر في مرحلة ما ضمن أسوار حياتك وتمتلك القدرة على توجيهها وضبطها. إن عالم الطفل هو عالم محير في حس الكثيرين. وقد يشعر البعض أنه العالم الغامض أو الصعب. كما قد يتجاهل البعض أهمية ذلك للحد الذي قد يجعله متنحيا عن تعلم أدبيات وفنون التعامل مع هذا العالم المركب والمتنوع. والحقيقة أن الكيان الطفولي يمكن النظر له من عدة زوايا وبأشكال مختلفة. بمعنى أن الطفل هو في أساسه وتكوينه الجسماني والعقلي والنفسي مخلوق ضعيف لا يمارس الاستقلالية في حياته إن لم يتدرب عليها ويتعلمها بل ويتقمصها من خلال المحيط الذي يتعامل معه بشكل مباشر. وفى المقابل فإن الطفل يعتبر مخلوقاً قوياً في متطلباته وحاجاته ورغباته وكذلك في الدفاع عن نفسه وفى التعبير عما يريد. وهذه التركيبة المتناقضة هي من خصائص مرحلة الطفولة التي من خلالها يتم التكامل في عملية التربية. فالطفل يعيش مرحلة إلحاح للحاجات النفسية والجسدية ومرحلة الحاجة الدائمة للمعرفة والتوضيح ومرحلة الحاجة المستمرة لإثبات وجوده، وقد يخفق البعض عندما يتجاهل هذه الحاجات الأساسية ويتفانى في إشباع الحاجات المادية للحد الذي قد يُفقد الطفل مساحة كبيرة من نموه ونضجه النفسي والانفعالي. إن الطفل لا يقدر أن يتقبل الفصل أو التمييز بين إشباع حاجاته بل هو يرى ضرورة إشباع كل ما ينقصه وبصورة ترضي تطلعاته وآماله. وبالرغم أن الإشباع هدف في حد ذاته إلا أن الهدف الجوهري الحقيقي هو وسيلة هذا الإشباع والكيفية التي يتم من خلالها تحقيق الرغبة. إن المتعة الحقيقة يمكن تحقيقها إن فهم الطفل الأبعاد الواسعة والممتدة من إشباع حاجاته. فمثلاً : لماذا ينام الطفل (ينام كي يصحو مبكراً)، إن هذا الاقتصاد والاختصار في الشرح يجعل النوم حاجة ملحة ولكن غير مكتملة عند إشباعها. ذلك لأن الاستيقاظ مبكراً قد لا يكون هدفا بالنسبة للطفل وبذلك قد ينشأ شكل من أشكال الصراع الداخلي للطفل سببه عدم ارتقاء التفسير لمستوى احتياجه. وحتى يوازي الطرح مستوى الطموح الذي يرسمه الطفل ويتوقعه لابد أن يتم احتواء احتياج الطفل معرفياً ونفسياً وليس فقط جسدياً ومنحه قائمة التبريرات والتفسيرات من دائرة اهتمامه. فمثلاً : (النوم. . مهم لصحة الإنسان.. لأنه يجعلك قويا.. يجعل وجهك أجمل.. يجعل لعبك أفضل) وهكذا. إن ربط إشباع الحاجة بمحبوبات الطفل وغمره بمفاهيم متنوعة وواسعة يساعده على تكوين مفهوم القيم لديه قبل تشكيل السلوك، إن ممارسة السلوك قد تكون مجرد ظاهرة طبيعية تتشابه بها جميع الكائنات الحية ولكن أن ينطلق السلوك من قيمة معنوية ومعرفية ثرية بالتوضيحات فإن ذلك مايميز الكائن البشري ويميز تكوينه الإنساني الخاص. إن التركيز على بناء السلوك هو خطوة ستنتهي بحصيلة مكثفة من السلوكيات والممارسات غير المترابطة أو المضبوطة في الكثير من الأحيان إلا أن تشكيل السلوك بمزيج من المعرفة والتوضيح والتطبيق هو الأسلوب التربوي الأكثر نفعاً وسلامة لصحة الطفل ونموه النفسي. إن الطفل الذي ينطلق من قيم راقية تشكلت في تربيته سيكون أكثر توازناً وثباتاً من ذلك الطفل الذي يمارس السلوك وهو في الحقيقة لا يعي المعنى من هذا السلوك ولا الهدف منه. إنه في الغالب يبحث عن تحقيق حاجاته ورغباته وسعادته دون أن يتبلور في حسه وإدراكه قيمة ومعنى الهدف من ممارسة أي سلوك. إن تشكيل القيم يعتمد على نوع التربية التي يستظل الطفل بها. فربط حاجات الطفل وحياته ببنية معرفية متوافقة مع عمر الطفل ومستوى فهمه وقدراته. أفضل من ربط الحاجة بالإشباع المادي فحسب. كما أن تنمية مفهوم الحس الاجتماعي واستشعار الطفل لتقدير الآخرين وقبول سلوكه ووصفه بالواعي والمتزن يشكل قيمة الشعور بالمسئولية عند الطفل تجاه سلوكياته وتجاه نفسه عموماً، ويعتبر تقدير الآخرين من محفزات و معززات السلوك الإيجابي لدى الطفل بل ومن دواعي ثباته ذلك لأنه يعمل بشعور الجماعة متناغما مع أفكارها وأعرافها. إن القيم تتشكل من خلال : تنمية المفاهيم التي تهتم بالقبول والاستحسان والتقدير والحب والحاجة للأمان وبذلك تنشأ في ذهن الطفل وتصوره صورة متكاملة عن أي سلوك ليرتقي بذلك السلوك من كونه أداء عمليا مجردا إلى قيمة إنسانية واقعية وعملية.
3238
| 08 مايو 2013
يمثل جسم الإنسان انعكاسا للصورة الواقعية والفعلية لمقدار ما تحويه نفسه من اعتلال نفسي أو ذهني، فالجسد المسترخي المتألق بصحته وعطائه يعكس حالة نفسية صحيحة نسبياً، وفي المقابل فإن الجسد المتهالك المنهك قد يعكس حالة نفسية غير صحيحة وغير معتدلة نسبياً. وتتعدد وتختلف الشكاوى الجسدية التي تصل في كثير من الأحيان لدرجة المرض العضوي مع تغيب الأسباب الطبية لها، وهنا يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم سؤال مباشر: ما الأسباب المجهولة وراء ذلك؟ إن مواقف الحياة التي تمر على الإنسان تحمل في طياتها قائمة من الصدمات المتفاوتة بين أسرية وعاطفية وشخصية ولكل موقف حالة مزاجية تتزامن معه ولكل شخص أسلوب يستخدمه للتعبير عن تأثره بتلك المواقف والأحداث. فالبعض يتمثل الإيجابية والبعض يستسلم والبعض يخفق في إدارة انفعالاته وردود أفعاله للحد الذي يخلق في ذاته مقاومة مرضية للتعامل مع تلك الصدمات والمواقف وليس مواجهتها أو ضبطها. ويأتي الجسد ليقوم بمهمة مشاركة النفس والذهن في الألم والمعاناة كوسيلة مساعدة للتخفيف من حدة معاناة الألم النفسي، وتكمن الخطورة في عدم تفهم المريض لطبيعة هذه الأعراض الجسدية والتنقل بين الأطباء والعيادات الطبية مما قد يعرضه لخطأ التشخيص والعلاج، إنه يبحث عن سبب عضوي غير موجود إلا في صورة أعراض جسدية لا حقيقة طبية لوجودها. إن ظهور الأمراض (النفس جسمية) هو نتيجة طبيعية للتفاعل المحتمل بين النفس والعقل والجسد، وتعتبر منطقة (الهيبوثلاموس) جهاز استقبال وإرسال يستقبل الشحنات الانفعالية من النفس ثم يرسلها إلى أجهزة الجسم المختلفة ليعبر عنها كل شخص بطريقته التي تحاكي شخصيته وعملية الإرسال هذه تتم من خلال أساس الجهاز العصبي اللاإرادي بفرعيه: السيمبثاوي والباراسيمبثاوي. إن الانفعال هو شعور داخلي مثل الحزن أو التوتر أو الغضب ولكن يتم التعبير عنه بصورة خارجية كالبكاء والصراخ وأحياناً الألم وتلك هي آلية ظهور الأمراض (النفس جسمية) أو ما تعرف عياديا بــ الاضطـرابات السيكوسوماتية، ومع ذلك لا يجب المبالغة في النظر لكل الأعراض الجسدية والأمراض العضوية على أنها نفسية المنشأ. فهناك تشخيصات عيادية فارقة تحدد دقة التقييم. إن أسلوب الحياة الذي يتبعه كل شخص يكشف عن مستوى نضجه أو إخفاقه في التعامل مع الأزمات والصدمات، ويعتبر سوء التكيف والتجاوب مع الصراعات الانفعالية سبب قوي لظهور الأعراض المرضية الجسدية ذات المنشأ النفسي. وقد تظهر الأمراض النفسية الجسمية ((Somatoform Disorders)) بصورة أمراض تتمثل في اعتلال الجهاز الهضمي أو ارتفاع ضغط الدم أو الذبحة الصدرية أو تقرّح القولون والتهاب المفاصل أو آلم متفرقة في الظهر، كما يعتبر الصداع أحد الأعراض الجسدية التي تأتي كتعبير عن القلق أو التوتر النفسي كنوع من التعبير البدني عن شدة الصراع. ويستخدم البعض الأعراض الجسدية كحيلة دفاعية للهروب من موقف يسبب له الانزعاج كمن يشعر بالصداع الشديد ليجد حجة الاعتذار من لقاء أو اجتماع يسبب له الخجل أو الإحراج، وكذلك عندما يشتكي البعض من ألم الظهر المتكرر للهروب من عبء عمل يجد فيه المشقة والجهد، ولا يعني ذلك الإدعاء أو الكذب بل هو نوع من التوهم الذي يشعره الفرد حقيقة ليتخلص من موقف يفوق قدرته على التكيف أو المواجهة. وقد كشفت بعض الدراسات إضافة للملاحظات الإكلينيكية (العيادية) عن ظهور الأعراض الجسمية ذات المنشأ النفسي لدى شخصيات أكثر من غيرها. ومنها الشخصية القلقة، حيث تتسم تلك الشخصية بدرجة عالية ومستمرة من القلق الذي يمتد ليشمل النواحي الجسدية فيبدأ الشخص في هذه الحالة بتضخيم الأعراض البدنية وتهويل الشعور بها للحد الذي يزيد من حدة المشاكل الصحية والتي تحتد بالخوف المبالغ به وغير المنطقي على الصحة. كذلك الشخصية ذات الطابع الهستيري، وفي الغالب تعبر مثل هذه الشخصيات عن أعراضها النفسية بأشكال من التحول الهستيري. مما يعرضها للإغماء الهستيري أو القيء أو الآلام المتفرقة في الجسد. وقد تظهر الأعراض الجسدية كأعراض مصاحبة لبعض الاضطرابات النفسية مثل الخوف الاجتماعي حيث يصاب الإنسان بالتعرق والرجفة والصداع، وكذلك اضطراب الوسواس القهري حيث تظهر في بعض الحالات تقلصات وأمراض في الجهاز الهضمي للإنسان، وهذه على سبيل المثال لا الحصر. فقد تمتد التوترات الجسدية لأكثر من ذلك في بعض الحالات. إن استمرارية الاضطراب النفسي يؤدي إلى تغيرات في وظائف الأعضاء. وقد يكون ذلك أمراً عارضا في البداية إلا أنه مع الوقت قد يتحول إلى عرض مزمن ومتكرر ومزعج ومسيطر. وتختلف أساليب علاج الأمراض (النفس جسمية) باختلاف السبب والاضطراب النفسي الكامن خلف ظهورها، ولكن يعتمد العلاج في العموم على منح المريض مساحة للتفريغ والتنفيس الانفعالي عن صراعاته ومكبوتاته. حيث تلعب سرعة الاستثارة دورا في ظهور الأعراض النفس جسمية. لذلك يعتبر التفريغ والتنفيس الانفعالي بمثابة تحويل إيجابي لمسار الاستثارة، كما تفيد تمارين الاسترخاء مع الحالات التي لديها قابلية للاستجابة في تحسين الأعراض الجسدية النفسية عن طريق إرخاء العضلات وإزالة التوتر بشكل تدريجي، إن عملية التحكم في الانفعالات هو الأساس الجوهري للعلاج ولا يتم ذلك إلا من خلال التحكم في درجات التوتر والقلق للسيطرة على الأعراض سواء كانت نفسية أو جسدية.
19162
| 01 مايو 2013
إن إصابة الإنسان بالمرض النفسي لا تعني بالضرورة قيامه بالسلوك الإجرامي أو العدواني وبالتالي لا تعني تنصله من المسؤولية القضائية أو الجنائية، إذ إن المرض ـ الاضطراب النفسي ـ أشكال وأنواع ودرجات وحالات كذلك، وأعني بحالات أن الشخص قد يكون مصاباً بعلة نفسية ولكنه عند ارتكاب السلوك الإجرامي ـ إن جاز التعبير ـ لا يكون تحت تأثير الاضطراب النفسي أو أعراضه، ولعل من المناسب في هذا المقال أن آتي على تقسيمات الأمراض النفسية ـ الأساسية ـ وحدود تأثيرها على سلوك المريض النفسي. أول هذه الأنواع هو الأمراض النفسية العصابية، وفي الغالب يظل المصابون بهذه الاضطرابات على درجة عالية من التماسك في سمات الشخصية وهم على دراية بأفعالهم وسلوكهم. ويكون الاضطراب في جزئية محددة لا تصل لحد ارتكاب الجرائم خارج دائرة الوعي والإدراك. ولابد عند إتيان المصاب بهذا النوع من المرض النفسي بأي سلوك منافٍ للعرف والشرع والتقاليد العامة أن يخضع للتقييم العيادي من قبل المختصين في الطب النفسي الشرعي وعلم النفس لتحديد مدى تأثير اضطرابه على سلوكه. أما النوع الثاني فهو الأمراض النفسية الذهانية ويعاني المصاب بها في الغالب من اختلال في البصيرة وفي الإدراك وقد تتغير الشخصية هنا بشكل جذري، ويتميز سلوك المريض بالاندفاع والتجاوب مع ما يسمى (الهلاوس والضلالات) مما يدفع المصاب للإتيان بسلوك ـ أحياناًـ في ظاهره يبدو إجرامياً لكنه في حقيقته مرضي يستوجب العلاج، وما يحدد ذلك السلوك وأبعاده وآثاره هو التقييم والتشخيص العيادي من قبل المختصين. وثالث هذه الأنواع هو اضطرابات الشخصية، وهي عبارة عن خلل في أحد سمات الفرد أو بعضها مما يؤثر على سلوكه وأفكاره وانفعالاته وأسلوب تعامله مع الآخرين، وتختلف الأعراض في شكلها وحدتها وأثرها على حسب نوع الاضطراب، وليس بالضرورة أن يرتبط اضطراب الشخصية بالسلوكيات الإجرامية. لأن المصاب باضطراب الشخصية في داخلة معاناة نفسية حقيقة وألم مترسب. إلا أن الأمر ليس كذلك في بعض أشكال هذه الاضطرابات مثل اضطراب ما يعرف بالشخصية السيكوباتية ـ الشخصية المضادة للمجتمع ـ والتي تقترف الجرائم باندفاعية وإصرار دون أدنى شعور بالمسؤولية أو الذنب. ويتراوح اضطراب السمات مابين الانطواء وعدم ثبات المزاج والاندفاعية والتشكيك في الآخرين والخروج على التقاليد الاجتماعية، كما تتأرجح الآثار السلبية لسمات الشخصية المضطربة بين إيذاء الذات وبين إيذاء الآخرين وارتكاب الجرائم بكل أشكالها بما فيها الجرائم الأخلاقية. ويعتبر المصاب بأحد أشكال اضطرابات الشخصية على درجة مقبولة من الوعي والإدراك التي تجعله مسؤولاً عن سلوكياته بشكل عام، ومع ذلك يفضل الحكم على أي سلوك غير متكيف وخارج عن ضوابط المجتمع بعد إجراء الفحوصات النفسية اللازمة من قبل المختصين في الطب النفسي الشرعي وعلم النفس لتحديد دور المرض النفسي في السلوك غير التوافقي الذي أقدم عليه هذا الإنسان. إن مشكلة المريض النفسي لا تقتصر على أعراض مرضه النفسي فقط وإنما هي قضية مجتمعية، فليس كل مريض نفسي يتلقى ما يحتاجه أو يستحقه من رعاية أسرية واجتماعية تحميه من نفسه وتحمي المجتمع منه. إن مشكلة ادعاء المرض النفسي وجعله مفسراً ومبرراً لبعض الجرائم للتنصل من القضاء مشكلة لها أبعاد متشعبة أهمها الخلط بين المريض النفسي ومدمني المخدرات وأصحاب السلوكيات المنحرفة، وكذلك محدودية الوعي بمعنى المرض النفسي وأشكاله وأنواعه من قبل المسؤولين عن البت في أمور القضاء بالإضافة إلى الجهل بالآثار السلبية والممتدة لارتكاب الجريمة وتكرارها والتهاون بها. وتبقى دوافع الجريمة لدى مرتكبيها مختلفة وتفسر ضمن نطاق السلوك الإجرامي غير المرضي بالضرورة، ولكن الإتيان بسلوك إجرامي بوعي تام والتخفي وراء أعراض المرض النفسي جريمة مركبة أخرى تستوجب سرعة التعامل معها وفق الضوابط والقوانين الشرعية. إن السلوك الإجرامي التخريبي يهتك بأعراف المجتمع ويسهم في تسيد الانحرافات والتجاوزات الأخلاقية والدينية. ومهما كانت دوافعه الشخصية فلا يعقل تجاهله أو التهاون في التعامل مع مرتكبيه لذلك كان الإدراك الواعي من قبل المسؤولين بالتمييز بين الإجرام والمرض مطلب مجتمعي وإنساني لتحجيم الجريمة والحد من آثارها السلبية المدمرة للناس والمجتمعات.
5491
| 24 أبريل 2013
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
13005
| 20 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1773
| 21 نوفمبر 2025

شخصيا كنت أتمنى أن تلقى شكاوى كثير من...
1353
| 18 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1161
| 20 نوفمبر 2025

القادة العظام يبقون في أذهان شعوبهم عبر الأزمنة...
1134
| 18 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
966
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
909
| 20 نوفمبر 2025

نعيش في عالم متناقض به أناس يعكسونه. وسأحكي...
804
| 18 نوفمبر 2025

يُعد البيتومين (Bitumen) المكون الأساس في صناعة الأسفلت...
693
| 17 نوفمبر 2025
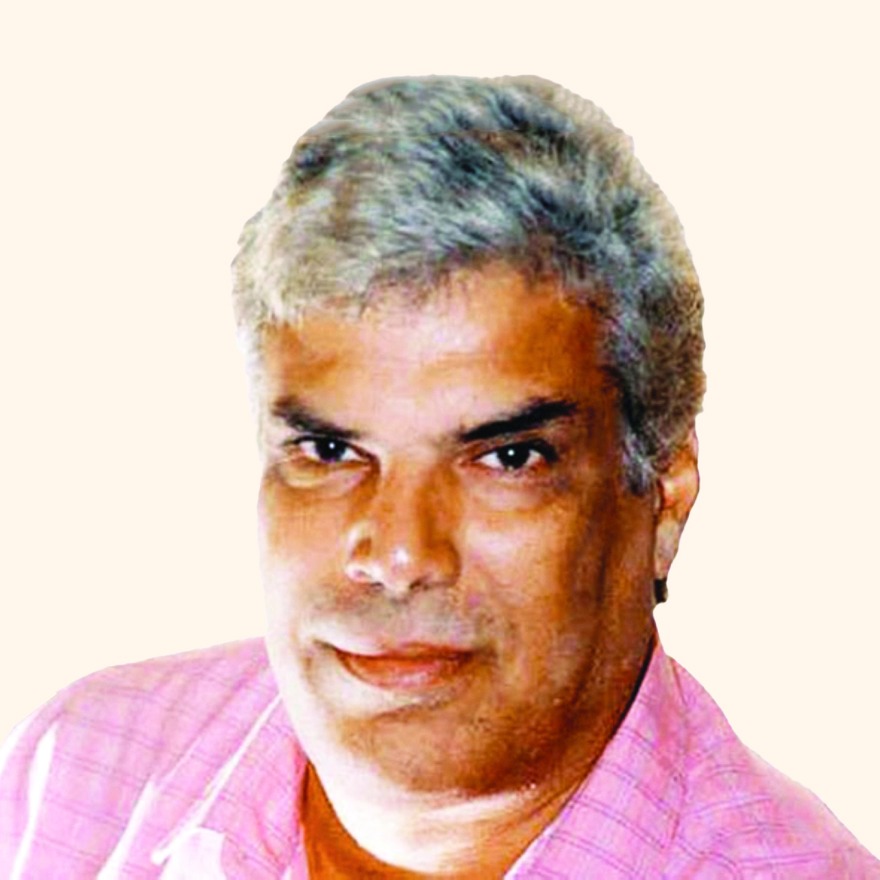
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
645
| 20 نوفمبر 2025

المترجم مسموح له استخدام الكثير من الوسائل المساعدة،...
618
| 17 نوفمبر 2025
مع إعلان شعار اليوم الوطني لدولة قطر لعام...
615
| 19 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







