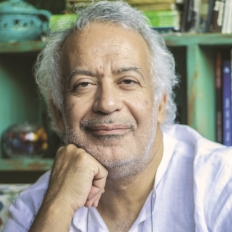رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
(1) كان ملكًا شابًّا، تولَّى الحكم لتوِّه، يحمل أفكارًا عصرية، يريد أن يسير في شوارع بلده وبين أهله دون مواكب الملوك، وأن يتصرَّف كإنسان طبيعي، ثم انتهى به المطاف إلى ملك صورة، مفعول به وليس فاعلاً، مسيَّر وليس مخيَّرًا، في قفص ذهبي معزول عمَّن أحبَّ أن يكون بينهم، وذلك ليس إلا بسبب حرسه القديم. (2) تصفَّح كتب التاريخ، هؤلاء الزعماء الذين ملأوا الدنيا صياحًا وأخبارًا، أتظن أنهم فعلوا ذلك وحدهم، ألم يكن حول كل رجل منهم ألف رجل، يسهمون في صناعة مجده، أو في ظلمه وجبروته. لا يفعل الرجل وحده فعله، وإنما صحبه، فإما أن يرفعوه ويرتفعوا معه، وإما أن يُسقطوه ويسقطوا معه. أشعر أني مؤمن صالح، أو أني أشبه بزنديق، ينبني الأمر على من بصحبتي؛ عندما أجلس مع صالحين أشعر معهم بالحالة الأخيرة، أقارن نفسي بهم، أتساءل: لماذا هم كذلك؟ ولماذا أنا كذلك؟ على عكس الحالة الأولى؛ فإني أشعر أني بقليل عباداتي إنما أنا أشبه بـشيخ الإسلام. أصدقاؤك، هؤلاء الذين يلتفُّون حولك ويحيطون بك ليسوا عناصر للترفيه، تستمتع معهم بوقتك وينتهي الأمر، أصدقاؤك ليسوا سوى قواتك الخاصة، التي سترفعك إلى القمة، أو تهوي بك إلى الحضيض. يقول أحمد أمين في سيرته «حياتي»: «صحِبته فكان مكمِّلاً لنقصي، موسِّعًا لنفسي، مفتِّحًا لأفقي، كنت أجهل الدنيا حولي فعرَّفنيها، وكنت لا أعرف إلا الكتاب، فعلَّمني الدنيا التي ليست في كتاب، ملأ فراغي وآنس وحدتي». هل أصحابك على هذا الشكل؟ (3) متى تكتشف معدن أصدقائك؟ ليس عند الحاجة فحسب، ليس إذا ما مرت بك أزمة طاحنة، ولكن أيضا إذا ما قرَّرت أن تتغير! وأخطر الأصدقاء هم الذين على شاكلة «الحرس القديم»، أولئك الذين يحملون أفكارهم الرجعية، يريدونك ألا تخالف العادات والتقاليد حتى ولو كانت فاسدة، يرغبون أن تكون نسخة منهم، أو نسخة ممن كان قبلك، يحاربون أي تغيير، مقياسهم وميزانهم: ﴿مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا﴾ وفي اللحظة التي تقرِّر فيها تغيير نفسك، ستجد هذا الصنف في مواجهتك، يكسر عزيمتك، ويقلِّل من أهمية أفكارك، ويشكِّك فيها. في اللحظة التي تريد أن تمضي في حياتك على النسق الذي تريد، حينها سينقلبون عليك، لن يخبروك أنهم ضدك، على العكس تمامًا سيخبرونك أنما يفعلون ما يفعلون من أجل مصلحتك، وأن التغيير الذي تريده، والحياة التي تتمناها إنما تؤذيك، وهم هنا حولك لينقذوك، والعكس صحيح تمامًا. ليس بالضرورة أنهم يفعلون ذلك عن سوء نية وسوء قصد، وإنما ربما لسوء فهم، أو لأنك بفعلك ما تريد ستؤنب ضميرهم، سيسألون أنفسهم ألف سؤال، عن خمولهم وقبولهم الاستسلام في الحياة، لا أن يعيشوا ما يرغبون في عيشه، كما تحاول أنت. (4) في دائرة أصدقائك تحتاج إلى ألوان مختلفة من الشخصيات، بالتأكيد هذا أمر صعب، ففي العادة نحن نختار من تميل إليه قلوبنا، وربما من يوافقنا دائمًا الرأي، غير أن وجود النماذج المختلفة ضروري. كنتُ محظوظًا إذ كان من بين أصدقائي من لا يؤمن بكل ما أومن به، إلى الحد الذي كان يدعو الآخرين للتساؤل عن الرابط بيني وبين هؤلاء الأصدقاء كشخصيات متناقضة، ونسوا نظرية المغناطيس الذي يتجاذب قطباه المتعاكسان، أو مبدأ المرآة التي تريك نفسك على حقيقتها، دون حذف أو إضافة. حرمتني الغربة والسفر من التواصل مع الأصدقاء، الذين عرفتهم في شبابي، ثم كان لي في كل بلد أصدقاء، وفي كل حال من أحوالي المتغيرة أصدقاء، ليسوا كثيري العدد، إنما نماذج أحسبني بهم محظوظًا، إلى حدٍّ أعتبر وجودهم في حياتي نعمة، تستحق شكر الإله. باختصار، حتى تنهض انظر من حولك، فلهم دور عظيم في نهضتك، أو في انتكاستك لا قدَّر الله. (5) في كتابه «السيرة الطائرة» يقول إبراهيم نصر الله: الصديق: آخَرٌ هو أنت.
429
| 04 مارس 2024
(1) كانت الحرب على أشدِّها، والطرق مقطوعة، وليس أمامي إلا أن أقضي يومًا في مسارات التفافية، أمر خلالها بنقاط تفتيش عديدة، وبموانع متعددة، حتى أصل إلى منطقة محدَّدة، حيث المواجهة العسكرية محتدَّة عندها؛ لأتمكن من إعداد تقريري التلفزيوني. غير أن ما رأيته في الطريق حسبته أكثر أهمية مما تضمنه تقريري عن الوضع في المنطقة التي استهدفناها. (2) كانت تجربتي الأولى كمراسل حربي، ولا أعرف هل كان ذلك من سوء حظي أم من حُسنه أن يكون ذلك في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995. في رحلتنا الطويلة، أتوقَّف وفريقي في مناطق عدة؛ طلبًا للراحة، أو للتأكُّد من صحَّة مسارنا، ولأن صديقي المترجم لديه قدرة غير عادية على فتح الحوارات مع الناس، فإنه كان ينقل لي حكاياتهم. أناس بسطاء، لكن حكاياتهم ليست أبدا بسيطة. نصل إلى هدفنا، نعدُّ تقريرنا الإخباري الكلاسيكي، عن القتلى والجرحى، نستشهد بتصريحات الضباط والجنود، ثم نعود أدراجنا. في طريق العودة أسأل نفسي: أيهما أجدر بالسرد، الموقف العسكري، وتصريحات الساسة، أم حكايات الناس؟ ولأنني لم أرغب وقتها في المشاغبة، والتمرد على قرارات إدارة التحرير، فإني تجاهلت الحكايات، وغرقت في الأخبار، ومن حين لآخر أقتنص حكاية هنا وحكاية هناك، والمفاجأة أن من كنت ألقاهم كان يحكون تفاصيل حكاياتي، وليس تفاصيل تقاريري الإخبارية. (3) هل الحكايات قادرة على شرح الموقف السياسي والعسكري؟ نعم، إذا سُردت بذكاء شديد. كل عناصر الحرب حاضرة في حكايات البسطاء. إذا أردت أن تفهم التاريخ والجغرافيا وما كان وما يجري، فإن في حكايات الناس إجابات واضحة. أسألك: أيهما أكثر تأثيرًا على الناس، أن تقول: إن غزَّة فقدت 15 ألف طفل، أم تحكي حكاية هند، الطفلة التي استغاثت بالعالم كله، وعاشت بين جثث القتلى حتى قُتلت؟ بالتأكيد الأمران مطلوبان. ليس لمراسل الحرب أن يتجاهل الأخبار؛ فهذه وظيفته الرئيسية، هذه حقيقة، ولكن الحقيقة الغائبة أن حكايات الناس أكثر أهمية على الأقل في نظري. الطرفان في حاجة لهذه الحكايات. الناس أبطال الحكاية، والناس الذين يشاهدون الأخبار! هؤلاء يرغبون في أن يصرخوا بحكاياتهم ليسمعهم العالم كله لعله ينقذهم. والآخرون يرغبون في معرفة تفاصيل الحياة اليومية للذين يعيشون الحرب، يتوقون لحكايات ناس تشبههم، تصف لهم الواقع، بعيدًا عن هؤلاء القادة وأرباب الحكم بتصريحاتهم الجوفاء. أمسِك أي مراسل حرب بعد أن تنتهي مهمته واسأله: ماذا رأى؟ سيحكي لك حكايات لا تصدَّق. لا تستهن بالحكاية. تخيل أن الذي خلق السماوات والأرض بأعاجيبها أنزل كتابًا خاتمًا إلى البشر، شاء عز وجل أن يُضمِّن ثلثه حكايات، سبحانه وتعالى. الحكايات أشبه بالسحْر، تزوِّدك بالمعلومة، وتثير حماسك، وقد تدفعك إلى فعلٍ ما. أحداث الحرب المتوالية لا تسمح لك برفاهية سرد القصص. نعم أعرف، ولكني هنا أسجل رأيي. امنحوا حكايات الناس مساحة تستحقها. (4) في الحرب - أي حرب- الحكايات على قارعة الطريق، تبحث عمن يلتقطها، ويُحسن سردها، ويُخبر بها العالم. أولاد العم غسلوا أدمغة العالم بحكايات المحرقة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو غير ذلك، ومنها ما تمت المبالغة فيها. أسألك كم شخصًا قرأ كتبًا عن المحرقة؟ وكم من شخص شاهد أفلامها الوثائقية والدرامية، وتأثَّر بها، وتفاعل معها؟ لو الأمر بيدي، لجمعت كل المراسلين والمراسلات الأبطال، بعد أن تنتهي الحرب في غزة،، هؤلاء الذين يعملون ليل نهار، ولقلت لهم: لن تخرجوا من هنا حتى تُفرغوا كل ما لديكم من حكايات. لو الأمر بيدي لطلبت من الروائيين وصناع السينما أن يتفرغوا لتوثيق ما جرى، في أعمالٍ وثائقية ودرامية؛ فالأخبار تُنسى، وتلك الأعمال يَحتفظ الناس بها في مكتباتهم، تأريخًا لجرائم حربٍ كانت تُبث على الهواء مباشرة، وكان الساسة الغربيون يُنكرونها. (5) المشكلة ليست أن عدونا أكثر منا قوة، بل هو أكثر ذكاء، يستحدث أدواته التي يُغِير بها علينا، بينما نحن مستمسكون بوسائلنا التقليدية. أرجوك، لا تنظر للأمر على أنه لا يَعنيك؛ لأنك لا تمتهن هذه المهن. الراغب في العمل سيجد مدخلاً له بلا شك. احفظ القصص التي تُروى، احفظها لنفسك، واحفظها لأولادك. لا يعدِم المخلص طريقة لأن يدافع بها عن الحق وينصر المظلومين. صدقني «الحكاية» واحدة من أقوى الأسلحة.
624
| 26 فبراير 2024
(1) ننتقد النشطاء الغربيين الذين يدافعون عن فلسطين، نرى أنهم لا يتبنُّون روايتنا بالكامل، نطلب منهم أن يكونوا عربًا مسلمين، أكثر منَّا، فإذا عالجوا الأمر من وجهة نظر إنسانية، قلنا: إن المسألة أكبر من ذلك. وإذا دافعوا عن غزَّة، قلنا: ولماذا لا تتحدَّثون عن كامل فلسطين؟ وإذا أقدمت جنوب إفريقيا بطلبها المعروف للمحكمة الدولية، قلنا: ولكن هذا البلد يحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع الكيان! كل شيء مرفوض، عملاً بمبدأ: كل شيء أو لا شيء. لماذا نكفر بخطوط التماس بيننا وبين الآخرين، فنتعاون فيما نتَّفق عليه، ونجتهد في تبيان الحقيقة للآخرين؛ حتى تكبر الدائرة التي نتَّفق عليها؟ شكرًا لكل من يشارك في الدفاع عن المظلومين، وفق ما يستطيع، بحبَّات البرتقال التي رماها التاجر الصعيدي على الشاحنة التي علم أنها تحمل مساعدات إلى غزَّة، إلى الرياضي الذي رفع علم فلسطين في المحفل الدولي، إلى الأحرار في الغرب الذين يُزعجون الساسة الداعمين للإبادة فيطاردونهم في ندواتهم، ومطاعمهم، وفي حركاتهم اليومية. أي شيء أفضل من لا شيء. ولا ننسى أننا جميعًا مدانون -وبحقٍّ- من أهل غزَّة. (2) حادثة مشهورة وتتناقلها الألسنة. الرئيس البوسني علي عزت بيغوفيتش يدخل متأخرًا إلى المسجد في صلاة الجمعة، فيوسع له الحاضرون طريقًا إلى الصف الأول، فيقول لهم: هكذا تصنعون طواغيتكم. نحسب أن بيغوفيتش من الصالحين، رمز وطني وإسلامي وفكري عظيم، لكنه لا يريد تعظيمًا. نفتخر بالأبطال، نضعهم في منازلهم المستحقَّة، ونقدر قدرهم، نحكي لأطفالنا عنهم، لكن في النهاية ندرك أنهم بشر، وإذا كان عطاؤهم يفوق عطاءنا، وإذا كان لا مقارنة بين ما يبذلون، وما نبذل، إلا إنهم يحتاجون نصائحنا، ولا أفهم حساسية البعض من أن توجه نصيحة لأحدهم! فلسطين هي القضية، كل الأبطال الذين مضوا وكل الأبطال المعاصرين إنما كانت عيونهم صوب الهدف، فلنفعل فعلهم. تحت القائد هناك ألف ألف بطل. وخلف الكاميرات ألف ألف بطل. وحكايات المجهولين ربما تكون أكثر دهشة من حكايات المعروفين. لا نريد أن ننتقل من تأليه الحكَّام إلى تأليه الأبطال. الأبطال أنفسهم لا يرغبون في ذلك. ولذلك قال علي عزت بيغوفيتش قولته. (3) هل اشتد تبادل السباب على المنصات أم يُهيأ لي؟ من الطبيعي أن يعبِّر المرء منَّا عن رأيه، ومن الطبيعي أن يختلف معه آخرون، لكن من غير الطبيعي كمية وألفاظ السباب التي يردُّ بها بعضهم عليه! إن الأمر لا يحدث تدريجيًّا، بل يقع الخلاف، فتبدأ الخشونة في الردود، ثم تتطور إلى ألفاظ بذيئة، بل ومن أول ردٍّ تُستخدم أقذع الألفاظ. منذ متى أصبحنا هكذا؟! ثم لماذا نحاكم الآخرين على نواياهم؟ مَن نحن لنحاكم الآخرين ما لم يعلن الآخرون صراحة عن ولائهم لعدونا؟ هل نُفرغ غضبنا المكبوت من عجزنا في سبِّ بعضنا؟ كل ما نفعله الآن ربما هو مؤشر لما سيصبح عليه حالنا في الغد. تخيَّل أن هناك حوارًا ناضجًا بين الجميع، لا يُقصي فيه أحد أحدًا بأي سبب، ما لم يدعُ إلى التعامل مع الآخر بعنف، ما لم يهِنه. تخيَّل حوارًا مع المقربين في دوائر خاصة، وحوارًا على المنصات، حوارًا بين الأفراد والمؤسسات، حول كل شيء، بعيدًا عن المؤسسات الرسمية، يُشارك فيه الجميع، نبحث فيه عمَّا بوسعنا أن نفعل، عن شكل الغد، عن مستقبل أبنائنا. هل هذه أمنية مستحيلة؟! ألا تعكس صدقنا، أو غير ذلك؟! لقد علَّمنا الربيع العربي، أن سقوط الحاكم ليس مقياسًا على النصر؛ فقد أعد الأعداء ألف حاكم خلف الستار، فمتى وكيف نستعد للنصر؟ الوعي وصدقنا وجديتنا وحجارتنا يجب أن تظلَّ موجَّهة إلى الهدف الأكبر. (4) كنت أشعر أنني أعرف كنزًا لا يعرفه بنو قومي العرب. صحيح أنهم كانوا يسمعون ويتابعون الحرب في البوسنة بكل حواسهم ودعمهم، لكنهم لا يعرفون الجانب الآخر من هذا البلد، هذا الجمال الساحر في المشهد، وهذه السكينة التي يشعر بها الزائر له، وما يصيب أرواحهم من راحة. ثم بعد سنوات من الحرب، بدأ العرب يتدفَّقون على البوسنة للسياحة، فانتابتني الغيرة، وفي تناقض عجيب، فمن ناحية أريد أن تظلَّ هذه البلاد هي كنزي وهي مخبئي، ومن جهة أخرى أريد وصالاً بيننا وبين أهل البوسنة. هذا التناقض في المشاعر وقعتُ فيه مرَّة مع حرب غزَّة. فرح لدخول غير العرب في الإسلام. وغيرة منهم لما يكتشفونه من كنز، لم نكتشفه نحن، بل غرقنا في الخلافات المذهبية، وفي الأمور الشكلية، وفي تجريم بعضنا البعض، بينما هم يصلون إلى لبِّ الأمر، وحقيقة الدين، ومعانٍ خفية علينا، بل ويعلن بعضهم أن الإسلام ليس دين العرب، وبالتأكيد محقُّون، العربية لغة القرآن، غير أن الدين لله على اختلاف ألوانهم وأشكالهم. أفرح لدخولهم ديننا. وأغير لوصولهم إلى ما لم نصل إليه.
720
| 19 فبراير 2024
(1) يهمل المرء منا في تدوين يومياته، وتوثيق ما يمر به، يشعر أنه ليس بشخصية عامة أو مشهورة يجب أن تفعل ذلك، لكن الحمد لله أن إحسان الترجمان لم يكن من أنصار هذا المنطق. صحيح أنه مجرد جندي فلسطيني في عمر الواحد والعشرين، يشارك في الحرب العالمية الأولى مع قوات الجيش الرابع العثماني في القدس، ويعمل في أعمال إدارية في الجيش، لكنه سيترك لنا مذكرات زاخرة، تحكي لنا ما لم تحكه كتب التاريخ وبلغة الشارع لا باللغة الأكاديمية. (2) في ليالي خدمته العسكرية وعلى ضوء شمعة يسجِّل يومياته في كراس، ابتداء من الشهر الثالث لعام 1915 إلى الشهر الثامن من العام الذي يليه، ثم تمر السنون، وتستولي عصابات الهاغانا على القدس الشرقية عام 1948، وفي عام 1967 تتم احتلالها لكامل القدس، لتظهر مذكراته ضمن 12 ألفا من المجلدات والمخطوطات العربية التي تم الاستيلاء عليها، ونقلت إلى الجامعة العبرية، ومعها لائحة بأسماء البيوت المنهوبة، ومنها منزل: «عادل بك الترجمان» الكائن بشارع المصرارة. (3) في أوراقه يحكي لنا أمورًا مختلفة مرَّ بها، من عام الجراد، الذي انتشر في أرجاء فلسطين مهددا المحاصيل، إلى زملائه الثلاثة المشنوقين على أبواب الخليل، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، إلى ثريا جارة القلب التي لا تفارقه. يكتب عن طموحاته، وعن معاناة البسطاء والفقراء في بلدته؛ عن مظالم النساء في مجتمعه، وعن سوء الحال وتدهوره. يكتب عن قرار قائد فيلقه الذي يبغضه، بأن يُحتفى بعيد جلوس السلطان محمد الخامس، ومن ثَم «يجب إطعام العساكر في ذلك النهار خروفًا وحلوًا، وأن تضاء المدينة وتتزين، وأن يُطعم الفقراء أيضًا، لكن لا يجب توزيع الأرز على العساكر؛ لأنه قليل». يعبِّر عن تذمره من هذا الإنفاق، في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يكتب: «لقد جاع أهل فلسطين، لكن ثمة سفينةً محملةً بالمؤونة قادمة من الولايات المتحدة إلى ميناء يافا؛ أرز وسكر وما شابه، لكن مهلًا، إنها من يهود أمريكا إلى يهود فلسطين». مِن هنا يحكي لنا عن «الصهيونية الناشئة». (4) في كراسه يكتب عن حفلات القادة بين الفينة والأخرى، ويشتكي من سُكْر بعضهم، ويتساءل عن ظهورهم بمظهر ديني، وهم في حياتهم الخاصة غير متدينين! يكتب عن استمرار الغلاء والضيق، وتوالي هزائم العثمانيين. يتساءل: هل ستسقط فلسطين في يد الحلفاء؟ ثم يحدثنا بعدها عن تفشِّي الجُدَري في المدينة القديمة، وموت شابة مقدسية في عقدها الثالث. يكتب معربًا عن خوفه من عبور الإنجليز مضيق الدردنيل، وسقوط إسطنبول، وانهيار الدولة العثمانية. يكتب أنه لا يريد الموت؛ «أرى الحياة لذيذة وحلوة، نعم أنا لست مرتاحًا من حالتي الحاضرة، ولكن المستقبل يبشِّرني». (5) يسجِّل دهشته «مَن كان يتصور أن ينفد الطحين في بيتٍ بفلسطين وهي مصدِّرة له؟، حتى القمح قد شحَّ، لقد انهار كل شيء، حتى جيش جمال باشا الذي تقهقر إلى حلب». لقد ضاقت الأرض بهذا الشاب الصغير، حتى بلغ به الضغط النفسي حافة الانتحار «كم فكَّرت في هذه الفترة أن أنتحر؛ لأتخلص من هذه الورطة، ولكنَّ شيئًا واحدًا كان يردعني عن هذا العمل، وهو لأني لا أحب أن أنكِّد عيشة مَن يحبني، فيعود لي صوابي وأقول: لا بد أن تنتهي هذه الحرب، ويرجع كل منَّا إلى حيث يريد، ولكن متى يكون ذلك؟!» يسمع بالثورة العربية بقيادة الشريف حسين، فيتعاطف معها كثيرًا، مع كونه جنديًّا عثمانيًّا. ولكنها رغبته النافذة في الخلاص، وكل شيء يحمل له هذا الأمل فهو معه؛ فلقد كان ساخطًا على الإدارة العثمانية بسبب قسوتها في الحرب، لينهي الكراسة بعبارة مليئة بالدراما: «لقد تحقَّقت أمنيتي القلبية بهزيمة الأتراك، ليست سوى أيام قلائل حتى يغادروا القدس دون رجعة، ستعود حياتي كما كانت قبل الحرب، سوف أعود إلى كتبي، وأتزوج من حبيبتي ثريا التي فرَّقتني عنها طلقات المدافع» (6) لكن شيئًا من هذا لم يحدث، فلم تعد فلسطين، ولم يعد إحسان، بل قُتِل في القدس قبل دخول قوات اللنبي إليها، ليرثيه أستاذه خليل السكاكيني في مذكراته الخاصة: «أترحَّم على المرحوم المأسوف عليه إحسان، الذي لا يبرح من مخيلتي». لم يُحقَّق في قتله؛ لأن الزمن زمن حرب، والإنجليز على أعتاب القدس. لقد قُتِل بعد معاناة نفسية، حتى اضطربت هويته، فتارة يحب العثمانيين، وتارة يكرههم، وتارة يرثي شعبه الفلسطيني، وتارة ينقم عليهم قبولهم بالهوان. رحم الله إحسان، ورحم تعالى كل من يعيش التاريخ ويسجله، مهما كان موقعه في الحياة.
1266
| 12 فبراير 2024
(1) يقف رجل ياباني منذ حوالي شهر طوال النهار رافعاً لافتته ضد الإبادة الجماعية في غزة. ذكَّرتني حكايته بحكاية المرأة اليابانية التي عشقت فلسطين، وورَّثت حبها لابنتها. (2) وُلدت «فوسوكو شيغينوبو» في طوكيو، في الثامنِ والعشرينَ من الشهر التاسع لعام 1945م، وما أن تُنهي دراستها الثانوية، حتى تبحث عن عمل يسمح لها بمواصلة تعليمها الجامعي. تنجح في ذلك، وتنشط في ذات الوقت في جامعتها، وتنضم إلى رابطة الجمعيات الطلابية، التي تميل إلى اليسار المناهض للحرب الدائرة حينذاك في فيتنام، والمعادي للرأسمالية والإمبريالية، وتتحصل وتحصل أخيرا على شهادة جامعية مزدوجة في الاقتصاد السياسي والتاريخ. تنضم إلى الجيش الأحمر، وهو تنظيم يساري ثوري يؤمن بثورة اشتراكية عالمية، فتشعر صاحبتنا أن العالم أصبح أكثر اتساعًا، ولأن الرفاق يتعرَّضون للقمع فإن الثورة من داخل اليابان تراها مستحيلة، ويحدث أنها تشارك في أحد اللقاءات التي تناولت القضية الفلسطينية، فتتحمس لها، يشاركها الهمَّ نفسه شاب آخر، فيقرران أن يقتربا من القضية أكثر. (3) يصلان إلى بيروت التي تحتضن حركات المقاومة الفلسطينية، ويتواصلان مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي ترحِّب بهما، وخصوصًا صاحبتنا التي أطلقوا عليها اسم: مريم، وألحقوها بمكتب العلاقات العامة، وتحديدًا بـ: (مجلة الهدف) التي يرأس تحريرها غسَّان كنفاني. مريم اليابانية تناشد النشطاء في بلدها، الذين يستجيبون لها، فتشهد بيروت حراكًا يابانيًّا، من: أطباء، وفنانين، وكتَّاب. غير أن علاقتها بالجيش الأحمر تهتز فتستقيل منه، لتمضي أكثر في تسخير جلِّ اهتمامها للقضية الفلسطينية، خصوصًا وأن الضربات تتصاعد بين الفلسطينيين، وبين العدو. (4) في الثلاثين من الشهر الخامس لعام 1972م، يصل ثلاثة شبان يابانيين إلى مطار اللد في تل أبيب، ليخرجوا من حقائبهم أسلحة رشاشة وقنابل، ويبدأون في إطلاق النار، ليسقط ما يزيد على عشرين قتيلاً، وعشرات الجرحى، وفي ذاكرتهم الكثير من الجرائم التي ارتكبها الموساد، بل يتذكرون العدوان على مطار بيروت الذي دمر الاحتلال فيه 13 طائرة لبنانية. تنتهي العملية بقتل اثنين منهم، وسقوط الثالث أسيرًا. فتلفت العملية الأنظار لكل من هو ياباني، وتوجَّه تهمة التخطيط إلى الجبهة الشعبية، وإلى صاحبتنا. يرد الاحتلال بعملية يُغتال فيها غسَّان الكنفاني، فيعتصر الحزن قلب مريم على أستاذها، ورئيس تحريرها، وتضطر إلى أن تبدأ حياة جديدة تتحرك فيها بسرية شديدة توقعًا لانتقام إسرائيلي، خصوصا وقد أنجبت: «مي». (5) في الشهر السادس من عام 1973م، يَختطف عضو بالجيش الأحمر وأربعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، طائرة يابانية منطلقة من أمستردام في طريقها إلى طوكيو، ويجبرونها على الهبوط في دبي، مطالبين بالإفراج عن زميلهم الأسير، لكن الكيان يرفض، فتقلع الطائرة إلى دمشق ثم إلى بنغازي، حيث يتم إطلاق سراح الركاب، ويفجر الخاطفون الطائرة. في الثالث عشر من الشهر التاسع لعام 1974م، تُقتحم السفارة الفرنسية في هولندا، ويُحتجز السفير الفرنسي ويُقتل ضابط الحراسة، ويُوضع عشرة أشخاص رهائن. وبعد مفاوضات تُدفع الفدية المطلوبة، ويُفرج عن بعض أفراد الجيش الأحمر الموقوفين في السجون الفرنسية، مقابل الإفراج عن الرهائن. يتزايد ضغط الرأي العام، ويُصدِر الإنتربول مذكرة باعتقال مريم، بناء على شهادة زور من أحد الرهائن، الذي سحب شهادته لاحقًا، غير أن مذكرة الإنتربول لم تتغير. (6) تمضي الأيام، ومريم اليابانية مختفية عن الأنظار، تنتقل من منطقة إلى أخرى في بيروت، وابنتها مي تكبر وتصبح فتاة يشهد لها بالذكاء والنشاط، لكن مع تزايد محاولات البحث عنها، قرَّرت الأم ألا يعيشا معًا؛ لإنقاذ ابنتها من أي محاولة اغتيال قد تتعرَّض لها من قِبل المحتل. تعطي ابنتها صورة لهما الاثنين لا تُظهر إلا ظهريهما، تقول لها: عندك نسخة وعندي نسخة، فإذا أبلغك أحدهم رسالة مني دون أن يريك الصورة فاحذريه. تمضي السنون إلى أن يحل الثامن من الشهر الحادي عشر لعام ألفين، ليرن هاتف الفتاة، ليسألها سائل: «هل عائلتك بخير؟». تُدرك أن السائل يقصد أمها، تقلِّب المحطات التلفزيونية لتجد الخبر: القبض على مؤسسة الجيش الأحمر فوسوكو شيغينوبو. لقد نجحت أمها في التخفي قرابة ثلاثة عقود، بل نجحت في الدخول إلى بلدها، لكنها الآن في قبضة الشرطة. تُقدَّم للمحاكمة، وتُعلِن حل الجيش الأحمر الياباني بلبنان. وفي عام ألفين وواحد تنتهي من كتابة تقرير من مائتي صفحة، تصف فيه حياتهما السرية كأم وابنتها. تحصل مي على الجنسية اليابانية بعد 27 عامًا من الحياة دون وثائق، تأتي من بيروت لدعم والدتها. تُتهم فوسوكو بعدة تهم لم يتم إثباتها، لكنها أُدينت بحيازة جواز سفر مزور ومحاولة القتل العمد، ويُحكم عليها بعشرين عامًا. وفي الزنزانة تكتب صاحبتنا كتابًا تهديه لابنتها سمته: (قررت أن ألدك تحت شجرة التفاح). وفي 28 من الشهر الخامس لعام 2022م، يُطلق سراحها بعد قضاء محكوميتها. تستقبلها ابنتها مي، تُلبسها الكوفية الفلسطينية، ويهتف متجمهرون: «نحبك يا فوسوكو».
1041
| 05 فبراير 2024
(1) مقالات حول الكاتب العظيم، ولقاءات تلفزيونية معه، وحفلات توقيع لكتبه، وجوائز وأوسمة يتقلَّدها، واحتفاء ما بعده احتفاء. هذا ما يناله المسكين الذي يقضي أيامه بين القراءة والكتابة ليكتب لنا ما يكتب. غير أنه -لسوء حظه- قد حلَّ بالبلاد ديكتاتور، وقراؤه الآن في فوضى فكرية، ينتظرون أن يخرج عليهم؛ ليجلي الحقيقة، ويزيل الغبار عن المشهد، ويسمي الأشياء بأسمائها، ويصف الواقع على حقيقته، فهل يفعل؟ (2) قد يحقُّ للبعض -إذا ما حلَّت الديكتاتورية في بلده- أن يصمت؛ قد لا يقوى على دفع الثمن، فيلجأ إلى الصمت، واعيًا أو غير واعٍ بأنه سيدفع ثمن صمته يومًا ما، وسنجد له عذرًا، إلا ذلك الكاتب المسكين، فلا عذر له أبدًا. لقد أفسحنا لكلماته -في وقت الرخاء- عقولنا، أمضينا ساعات نقرأ ما كتب، نتأثَّر به سلبًا أو إيجابًا، نغيِّر من أفكارنا، ننمِّيها، نكبِّرها، في ظل عشرات الصفحات مما كتب، لذا فلا يجب عليه -أبدًا الآن- أن يهرب، لا يجب أن يفرَّ أبدًا من دوره، ومن مهمته التي ننتظر أن يؤديها خير أداء، فعليه أن يشرح لنا، ويفسِّر، ويقول، ويصرخ. نحتاج جرأته التي أبداها وهو ينتقد مجتمعنا وأمراضه ومعه -في كثير من الأحيان- الحقُّ، نحتاج جرأته التي أبداها وهو يصف اللحظات الحميمية بين عاشقين، نحتاج جرأته التي أبداها وهو ينتقد ما نؤمن به، ويعلن تمردَّه على معتقدنا ويقول: إنه خرافات الأجداد. نحن في حاجة إلى جرأة الكاتب الذي ادَّعى أنه يحمل شمعة بيديه، ويطالبنا بأن نسير وراءه. قُدنا -إذن- أيها الكاتب العظيم إلى برِّ النجاة، أنقِذ عقولنا مما يجري، اشرح لنا الأمر، أعطنا مثالاً عمليًّا على «التنوير». (3) لكن الكاتب -كإنسان طبيعي- قد يضعف، فيصمت خوفًا من عقاب الحاكم، وقد يبالغ في محاولة طمأنة الحاكم فيمنح الحاكم دعمه، ويبالغ فتخرج الكتب والروايات التي تمجِّد الحاكم. ولأن فترة الديكتاتور تطول حتى يسقط، فإن أجيالاً تولد وتكبر وتتأثَّر بهذا الكذب الذي اُضطر إليه الكاتب أو ادَّعى ذلك. ولك أن تتخيَّل عذابات جيل كامل خُدع بشعارات برَّاقة وحروب وهمية رفعها وقادها الديكتاتور، وزكَّاها الكاتب، وامتدحها. لذلك فإن هناك في المقابل الكاتب الذي يؤمن بشرف دوره في المجتمع، وبقدسية الكلمة وأثرها البالغ في العقول والنفوس، فقرَّر المقاومة بعد أن أدرك أنه لا طريق أمامه إلا المساهمة في إنارة العقول وسط الظلام الحالك الذي فرضه الحاكم الديكتاتور. (4) فقرأنا (السيد الرئيس) للروائي ميجيل أنخل أوسترياس من جواتيمالا الحاصل على نوبل عام 1967م، وبسببها واجه متاعب جمة. وقد استوحى أحداثها من الظروف التي جاءت بالرئيس الديكتاتور خورخه أوبيكو بمساندة من الولايات المتحدة الأمريكية، وحدَّثنا فيها عن الديكتاتور وبطانته من المنتفعين، الذين يُسهمون بحجب الرؤية عمَّا يدور حوله. وقرأنا (منزل العسكر) للروائي الشيلي خوسيه دونوسوا، التي يصوِّر في روايته جوًّا فانتازيًّا لطاغية يُدعى «فنتورا» يعيش في قصر ضخم، مملوء بالسلاحف، وآكلة لحوم البشر، التي تنهش في أجساد سكان المنطقة، ويكون أبناء «فنتورا» هم أول من تنهشهم هذه المخلوقات المتوحشة. وقرأنا للإيطالية (أوريانا فالاتشي) روايتها (إنسان) التي تسرد فيها قصة موت حبيبها المناضل اليوناني اليكو باتاجوليس، الذي وقف ضد ديكتاتوره الذي قام بانقلاب عسكري في بلاده. ولا ننسى (خريف البطريرك) لغابريال غارسيا ماركيز، الذي كان مباشرًا ولاذعًا في نقده للديكتاتوريات، وصوَّر عوالمها الموازية من فساد وانحرافات، في مجتمعات يسودها التخلف، وبالتأكيد الأمثلة كثيرة. (5) والكاتب المقاوم، قد لا يكون بوسعه أن يقوم بعمل انتحاري بحديث مباشر، لذلك نسمح له بأن يسلك طرقًا ملتوية للوصول إلى ما يريد، وقد يخرج لنا برواية رمزية نفهم من ضمنها رسائله. قد نسمح للضعيف منهم بذلك، لكننا أبدًا لن نعفيه من دوره المفترض في تشكيل الوعي الجماهيري وتحريك الرأي العام، مؤمنون بأنه يجب أن يكون للكاتب الشجاعة للوقوف في وجه القمع والظلم، والكتابة بصدق وإخلاص، وتحريك النضال ضد الديكتاتور. المهم لا عذر للكاتب أبدًا أن يصمت.
696
| 29 يناير 2024
(1) سؤال: ما هي الكتب التي ساهمت في تكوينك الفكري؟ جواب: لا أعتقد أن هناك كتبًا بعينها تفعل ذلك. دعني أسألك أنا: هل يمكن أن تذكر لي أسماء الأطعمة التي ساهمت في تكوينك الجسماني؟ لا أظن أن بوسعك الإجابة؛ تكوينك الجسماني هو خلاصة أغذية مختلفة ومنوَّعة. تسري القاعدة -أيضًا- على تكوينك الفكري. بالتأكيد إنَّ من اعتنى بما يأكل وأحْسنَ اختيار أطعمته، سينال تكوينًا جسمانيًّا أفضل. نفس القاعدة تنطبق على التكوين الفكري؛ مَن أحسنَ اختيار ما يقرأ ويدخل إلى عقله، سينال تكوينًا فكريًّا مختلفًا، وأفضل ممن لم يفعل. (2) تقرأ مائة كتاب، ألف كتاب، لا تتذكَّر أسماءها، ولا ما ورد فيها، تعتقد أنَّ كل شيء قد تبخَّر، وأنك أضعت الوقت والمال. لكن، في الحقيقة لم يحدث؛ إنَّ آثارها كامنة بداخلك، تؤثِّر على نظرتك للحياة، وعلى أفكارك، بشكل أو بآخر، حتى لو لم تُدرك ذلك بشكل صريح ومباشر. التراكم هو الذي يُحدث الفرق، غير أننا نميل إلى الفوز بالضربة القاضية، لم يعد لدينا الصبر لإحداث هذا التراكم، نريد كتابًا أو أكثر نقرؤها فتُحدِث التغيير المطلوب، هكذا بضربة حظ، كتاب واحد يُحدث كل التغيير، إنه لأمر مستحيل! نعم، قد يؤثِّر فيك كتاب بعينه؛ تتفاعل معه؛ يغيِّر قليلاً أو كثيرًا من وجهة نظرك؛ يدفعك إلى فعلٍ ما، لكن في النهاية فإنَّ أثره محدود، ويظل التراكم هو العامل الأساسي والفعَّال. (3) لقد اندفع الإنسان إلى فكرة الوجبات السريعة للأطعمة، ثم لاحقًا اكتشف أضرارها وراح يحذِّر منها، وأظن كذلك أنه يجب علينا أن نحترس كثيرًا من فكرة الوجبات السريعة للقراءة. نحن نخدع أنفسنا عندما نقضي ساعات في متابعة المنصات، بين ما يُقرأ سريعًا، أو يُشاهد، إلى أن نشعر بالتخمة، ونظن أننا قد تناولنا بما فيه الكفاية. والحقيقة إنَّ ما التهمناه إنما هو غثاء، يجعل عقولنا تنتفخ، دون فائدة تُذكر، بل ربما بأضرار عديدة. نحن بحاجة لأن نختار ما نقرأ بعناية، ثم نقرأ ببطء، ثم ندع عقولنا تفكِّر على مهل فيما قرأته. العبرة ليست بعدد الكتب التي نقرؤها، ولا بالسرعة التي حدثت فيها ذلك، لكن العبرة بما استقرَّ في وجداننا من أفكار، وأحدثته من تغيير، وفتح منابع الحكمة. نحتاج إلى أن نقرأ كتبًا متنوعة، تمنحنا أفكارًا متعددة، الجسد يؤذَى لو تناول أطعمة من نوع واحد على الدوام، وهكذا أفكارنا. الكتب غير الملابس، فلا تلجأ إلى الأسماء المشهورة، فربما كاتب مغمور يحمل كتابه فكرة رائعة، لذا سيكون من الضروري أن تستعلم عن الكتاب قبل أن تبدأ في قراءته. ولا تنزعج إذا بدأت القراءة ولم تقوَ على أن تُكمل الكتاب الذي اخترته. كن مرنًا؛ ففي كل مرحلة من حياتك سوف تحتاج نوعًا ما من الكتب مختلفًا عن الكتب التي اعتدت قراءتها. لاحظتُ ذلك على نفسي، كنت أنزعج -أحيانًا- من أنه لا طاقة لي وصبر لقراءة هذا الكتاب أو ذاك، لكن وجدت أن ذلك طبيعي؛ فكما أن احتياجاتك الجسدية من الفيتامينات تختلف من مرحلة عمرية لأخرى، فاحتياجاتك الفكرية من الكتب كذلك، لتجد أن ما كنت تحبه بالأمس ما عدت تحبه اليوم، والعكس صحيح. (4) يصاب القارئ بما يصاب به الكاتب أحيانًا ويسمى بـ: (القفلة)، فلا يستطيع أن يكتب سطرًا وهو صاحب المؤلفات العديدة، يصيب المرض ذاته القارئ -أيضًا- فلا يستطيع قراءة صفحة واحدة من كتاب جديد. ربما عليه في هذه الحالة أن يبتعد قليلاً عن القراءة، أن يمارس شيئًا مختلفًا، أن يدع نفسه لأن تعيش هذه الحالة لفترة مؤقتة، ثم يسحبها لاحقًا وبهدوء وذكاء لتعود إلى حالة ذهنها المتقد. تسألني: ما الكتب التي أخرجتك يومًا من قفلتك؟ أجيبك: موت صغير، خسوف بدر الدين، بلدي، اسمي زيزفون، دلشاد، الرجل الذي يحب الكلاب، فتيان الزنك، مَرسى فاطمة. لكن لو سألتني: لماذا هذه الكتب بالذات؟ فلن أعرف الإجابة. ثمة كتب تتسلل إلى عقلك من حيث لم تحتسب، أو تطرقه طرقًا وأنت لا تعرف لماذا، لكنها تفعل! ربما يكون الأمر مرتبطًا بالمزاج، بالحالة النفسية التي عليها القارئ، لذلك قد يؤثِّر به هذا الكتاب الآن، أما قبل شهور أو بعد شهور فلا يفعل. ولا ترتبط المسألة بجودة الكتاب، أقرأ ما يكتبه البعض عن كتابٍ أبهره، يمتدحه مدحًا، أقتنيه سريعًا، لكن لا أستطيع أن أكمل بضع صفحات منه، أتهم نفسي وأدعه. (5) ذات مرَّة أخذني والدي -يرحمه الله- إلى مكتبة صغيرة وأنا لست في سن القراءة، استمتعت بالرسومات التي شاهدتها في الكتاب الذي اختاره لي، ومن حينها -وحتى الآن- لم أغادر المكتبة، ولم تغادرني رائحة الكتب، وملمس الصفحات، وشكل الرفوف وهي تحمل كنوزها، المكتبة أعظم قصر لنا في هذه الدنيا، وربما أعظم مخبأ.
654
| 22 يناير 2024
(1) يسألني الشباب عن أمرٍ ما؛ يعتقدون أن في جعبتي إجابة جاهزة، علَّمتني إياها سنون العمر الطويلة. في حين أن الدرس الذي تعلَّمته -فعلاً- هو أن لا حلول جاهزة، وإنك حتى تعرف الإجابة يجب أن تخوض في الأمر، يجب أن تختبره، وبحسب النتيجة يمكنك اتخاذ القرار، إما أن تمضي في طريقك، أو تتوقَّف عنه وتعود إلى نقطة الصفر؛ لتبدأ من جديد في اتجاه آخر، وهو ما يسمى بـ: (التجربة). بالتأكيد تكلِّفك التجربة وقتًا، ومالاً، وأمورًا معنوية أخرى؛ خصوصا إذا باءت التجربة بنتائج سلبية، مما يصيبك بالإحباط، لاستنزاف التجربة منك جهدًا كبيرًا، لكن للأسف ما من حلٍّ آخر. (2) كنتُ أعتقد أن بصمات اليد هي التي تختلف من شخص لآخر، لذلك اُعتمدت في الأبحاث الجنائية طريقة يمكن التعرف بها على صاحبها، لكن ما تعلَّمته هو أن بصمات اليد ليست وحدها التي تختلف، وإنما كل إنسان منَّا له هويته الخاصة، وحالته المميزة، وكينونته التي لا تتشابه مع الآخرين. أنت في حد ذاتك حالة مختلفة مهما بدا أنها تُشبه حالة أخرى، وما يصلح معك قد لا يصلح معي، والعكس صحيح، رغم أننا متشابهان في واقعنا، وفي عمرنا، وفي بلدينا، بل وربما متشابهان في نوع التجربة التي نخوضها، وفي النقطة التي سننطلق منها، والنقطة التي نريد الوصول إليها. لذلك لا إجابات جاهزة في الحياة، وإنما عليك خوض التجربة بنفسك. تعلَّمتُ هذا الدرس في عمر متأخر، عندما كنت -ذات مرة- في زيارة مريض عزيز، وفُتح نقاش طويل، أخبرنا الطبيب يومها أن المرضى بهذا النوع من المرض يتناولون دواءً ما، لكن نتائجه تختلف من شخص لآخر، هذا يتأثَّر به ويُشفى، وهذا لا يفعل فعله معه، نفس المرض، نفس العلاج، نفس العمر، لكن النتائج مختلفة. تقضي عدة أيام تدرس موادَّ بعينها، وتخلص إلى أنك أحببتها، وتريد أن تلتحق بالكلية التي تدرِّسها، لكن بعد الخوض فيها قد تغيِّر رأيك! بل قد تحسم أمورك في اختيار الإعلام -مثلاً- تخصصًا دراسيًّا، لكن من الصعب أن تحدِّد -من البداية- أي فرع منه ستدرس، وسيكون عليك أن تقرأ كثيرًا، وتفكِّر كثيرًا، ثم تختار، ثم تخوض التجربة، فإما أن تستمر في تخصصك، وإما أن تهرع إلى تخصص آخر. (3) نعم يبدو الأمر مكلِّفًا، لكن لا يجب أن تحسب خسائره فقط، وإنما احسب أيضًا فوائده؛ فأنت بعد التجربة شخص مختلف، وعندما تعود إلى نقطة الصفر لتبدأ من جديد لن تكون نفس الشخص الذي بدأ من الصفر مِن قبل. لا تعود أبدا من أي تجربة وأنت خالي الوفاض؛ فكل خطوة تخطوها في حياتك سوف تستفيد منها بصورةٍ ما، التجربة هي المعلِّم، وأنت التلميذ، لذلك يجب عليك أن تصغي جيدًا إلى تجربتك. وهذا هو الذي يختلف فيه الناس، بين تلميذ مُجدٍّ استفاد من دروسه، وبين تلميذ غير ذلك، خرج من التجربة كما دخل فيها، ثم هو يلعن الحظ والنصيب والدنيا والظروف، ولا يلوم نفسه أبدًا. المهم في التجربة إدارتها، واستيعاب الرسائل التي تصلك وأنت تخوض فيها، وتحليلها، والاستفادة منها، بغض النظر أن تمضي في الأمر لاحقًا، أو أن تُنهي التجربة، وتعود من جديد. (4) لا تقارن نفسك بآخر أبدًا مهما تشابهت الظروف، أنت تُدرك التشابه الظاهري، لكنك لا تعلم الاختلافات الداخلية بينكما، وبالتالي من الغباء أن تتوقع نفس النتائج التي حصل عليها آخرون. أسأل أحدًا مرَّ بالتجربة التي تنوي الخوض فيها، قد يمنحك عصارة تجربته، لكن لا تتوقع أبدًا أن تحصل على ذات النتائج أنت كذلك؛ هناك خصوصية في حالتك تختلف عن خصوصيته، ما يُخبرك به هو أشبه بعلامات على الطريق، قد تساعدك، وقد لا تجدها عندما تخوض بنفسك في الطريق، فثمة عواصف تطيح بالعلامات. (5) اقرأ ألف كتاب ، وتعلَّم ألف حكمة، لكن عندما تدس قدميك في التراب، وتخوض في الوحل، وتشق طريقك، فإنك ستجد الأمر مختلفًا، تجربتك لها المذاق الخاص بها. نحن نكبر وننضج بالتجربة، عمرك الحقيقي ليس مقترنًا بسنوات عمرك، وإنما بعدد تجاربك، بل الأحرى أن نقول: بنوعية تجاربك واختلافها، لذلك لا تبخل على نفسك بخوض تجربة تلو تجربة في حياتك. ستلحظ ذلك بوضوح عندما تعود إلى دارك بعد تجربةٍ ما، فتجد أن رفيقك الذي لم يبارح داره لم يتغير قيد أنملة، ستراه وكأن الغبار يعلوه، فقد لزم السكون، وأنت تحركت، وتحمَّلت عناء الطريق، وتعلَّمت الكثير، ونضجت حتى بتَّ بتجاربك أكبر من سنوات عمرك الحقيقية. في الحقيقة عندما تهرم ستنظر إلى الوراء وتدرك أن الحياة نفسها بكل ما مرَّ بك من قسوة إنما هي تجربة لن تتكرر أبدًا، ستنظر إليها من عل، وتضحك كثيرًا على أوقات ضعفت فيها، وأصابك اليأس، وتمنيت الراحة، ولم تكن تدرك أن الراحة ليست في الدنيا أبدًا.
594
| 15 يناير 2024
(1) قبل أن تُغمض عينيك، أو وأنت عالق في المواصلات، أو ربما وأنت في خضم اجتماع، تلوح لك فكرة، تقول لنفسك: حسنًا، سأكتبها عندما أستيقظ، أو عندما أصل البيت، أو حين أُنهي اجتماعي، إياك وأن تفعل ذلك، ألقِ القبض عليها ما إن تلوح لك، يسمون ذلك: صيد الخاطر، احبسها حتى وإن لم تكتمل، لا تدعها تهرب أبدًا، إذا انتظرت لن تجد شيئًا، ستهرب من ذاكرتك، تدوينها يحبسها، يمكِّنك من استرجاع التفاصيل، لتقرِّر بشأنها ما شئت، تحتفظ بها وتكبِّرها، أم تتخلص منها. أوَتعرف البخيل؟ إنه ينسى أحيانًا المخبأ الذي وضع فيه نقوده فيخسرها. أنت كذلك لا تخبئ أفكارك؛ فربما تنساها، وتنسى أين وضعتها. (2) لا تتسرع بالإعلان عن فكرتك، لا تطلقها إلى الهواء، احتفظ بها كما تحتفظ الأم بحملها، مدها بأنابيب الحياة، وغذِّها، واعتن بها، حتى إذا حان الموعد ونضجت وُلدت وخرجت إلى العلن. نعم سيكون المخاض مؤلمًا، تفكّر وتفكّر وتفكّر، تتردَّد، تقلِّبها على كل الأوجه، ثم عليك لاحقًا ألا تنزعج، ولا تأبه أنها وُلدت ضعيفة، هزيلة، غير مكتملة النمو؛ فهذه طبائع الأشياء، فإذا ما تعهدتها بالرعاية، نمَت وكبرت واكتملت، وباتت قادرة على مواجهة التحديات. أفكارنا مثل أطفالنا، يكبرون، وتتغير ملامحهم، لكن جوهرهم باق كما هو، تستهين بها وهي صغيرة، فإذا ما كبرت وانتشرت اندهشتَ لمَا صارت إليه، وكيف صارت إليه! (3) يحق للمرء أن يفخر بالصناعة المحلية مهما كانت جودتها، فلا تحمل أفكار الآخرين وتنسبها لنفسك، فالممتطي جواد غيره سينزل عنه طال الوقت أو قصر، اصنع فكرتك بنفسك، لا تأبه أنها لا تحمل علامات تجارية مشهورة، اصنع عالمك بنفسك، بالمواد الأولية التي بحوزتك، بالحجارة التي في بيئتك، لا تبحث عن «الانبهار»، أفكارنا تكون في البداية مغطاة بغلافها، لا يستطيع أحد اكتشاف هويتها وجمالها وإبداعها، إلا بعد أن تُطلقها أنت للعلن، وتنزع عنها غلافها. (4) لا تشعر بالحرج إن ظننت أن الفكرة التي تملأ دماغك هي فكرة بسيطة، هذه ليست تفاهة، الإنسان العادي ربما لا يستطيع أن يرى إلا الأشياء الكبيرة والضخمة، بينما الأكثر ذكاء، يستطيع أن يلتقط من أشياء بسيطة جدًّا أفكارًا عظيمة، أشياء بسيطة قد يمر بها الآخرون ولا ينتبهون لها، لكنها أثارتك أنت، أضاءت شيئًا في عقلك، فلا تستهن بها. ولا تقلق إن شعرت أن بعض أفكارك نتاج عاطفتك الجياشة؛ فالعبقرية أن تتغذى الأفكار بالعاطفة، «منَ الْحبِّ والكُرْهِ، كالنارِ التي تتغذَّى بالحطبِ اليابِسِ، بِعِ الحقلَ والبيتَ وَافْقِدْ كلَّ ما تَملِكُ لكنْ لا تَبِعِ الإنسانَ فيكَ ولا تَفْقِدْهُ». كل ما في الأمر هو أن تعمل بهذه النصيحة: «لا تُمسِكْ حجرًا لا تستطيعُ رَفْعَهُ، ولا تَبلُغْ في سباحَتِكَ مكانًا لا تستطيعُ العودةَ منهُ، ولا تفتَحْ بابًا لا تستطيعُ بعدَ ذلكَ أنْ تَسُدَّهُ». وتذكَّر أنه «كلما اتسع الممكن عسُر الاختيار». (5) لا تسألني: كيف تواجه التردد، فهذا عار، يجب عليك التخلص منه في الحال، أسمعت ما قاله الإمام شامل: «من فكر قبل المعركة في نتائجها فليس شجاعا» لن تخسر الكثير إذا أقدمت على فكرتك واكتشفت عدم صلاحيتها، ضع في ذهنك أنك ستخسر أكثر إن لم تُقدم عليها، وراء كل فكرة ناجحة ألف محاولة فاشلة، جرَّبها صاحبها دون تردد، خاضَ المعارك من أجلها، تحمَّل كل العثرات التي وقع فيها، إلى أن خرج بفكرته الناجحة، وكل محاولة فاشلة يخرج منها بفائدة ما، فلا تردد، ثمة خسارة محقَّقة في تردُّدك، وفي تراجعك، لكن كل النجاح في المحاولة. ولا تنس أن «الحياة لها حدودٌ، إنها قصيرة، أما الأحلام فلا تنتهي، تستطيع بمفتاح صغير أن تفتح صندوقا كبيرا، اسمع: النار في صدرك يجب أن تحافظ عليها تماما كما تحافظ على نفسك من النار الخارجية» لكن لا تتكلَّم كثيرًا فقوة الثور لا تُعرف بخواره، بل بعمله. (6) شكرًا رسول حمزاتوف، الشاعر والأديب الداغستاني؛ فقد استقيت كلامي من كتابك الجميل «بلدي»، قرأته ذات مرة، واكتشفت إنه لا يتحدث عن داغستان فحسب، بل يتحدث عن الحياة، إنه يؤثِّر بك، ولا يدعك تنتهي منه وأنت على حالك الذي بدأت به؛ فالأفكار خطيرة، وإذا تعوَّدت عليها ستدمنها، بل وسوف تستمتع بها مهما أصابك من أذيتها.
900
| 08 يناير 2024
(1) ما جدوى مهاجمة الأنظمة؟ الهدف من معارضة نظامٍ ما، هو فضح انحرافه، أو خيانته، أو فساده، أو ظلمه، لعامة الناس، فإذا تحقَّق الهدف؛ وأصبح الجميع على علمٍ بحقيقة هذا النظام، وبات واضحًا، مثل الشمس في وضح النهار، فما جدوى الاستمرار في مهاجمته؟ ما الفائدة المرجوة من استنفاد الطاقات والجهود في ماكينة الإدانة على مدار الساعة؟ هل نفعل ذلك لأن ليس بأيدينا من يمكن فعله؟ هل يُشعرنا ذلك بأننا نؤدي واجبنا، فنُرضي ضمائرنا، وننصرف إلى حياتنا اليومية. وما هو البديل؟، هل نتوقَّف؟، وماذا يمكن أن يتحقق من صمتنا إلا المزيد من انحراف هذا النظام. السؤال الجاد هو لماذا لا نطوِّر موقفنا، لماذا توقفنا عند هذه النقطة من الهجاء، لماذا لا نفكِّر في خطوة أخرى، في شكل آخر، لماذا لا نَعْبُر هذه المرحلة إلى مرحلة ذات جدوى؟ أي فائدة مرجوة في أن تظل تخاطب المواطن البسيط وتشرح له بالأدلة أنَّ حاكمه يسرقه؟، هو بفطرته، بمعاناته اليومية يدرك ذلك، بل هو على يقين من ذلك، قد يسمعك لأنَّك تُنفِّس عن غضبه، لكن لم تُخبره ماذا عليه أن يفعل، ما هي الخطوة العملية لما بعد الإدانة؟ (2) متى يمكن أن تتحرَّك الشعوب حركة جماعية؟ عندما يصل غضبها إلى حدٍّ لا يُحتمل. وهل الغضب لم يصل بعدُ حدَّه الذي لا يُحتمل بعدَ غزَّة؟ لا أظن أنَّ هناك مرحلة تضامن فيها العرب -على اختلافاتهم- مع فلسطين، كما هو الحال الآن؛ الكل غاضب وحزين، ويشعر بالعجز والقهر، بينما الأنظمة لم تأخذ خطوة تضامنية واحدة، ولا حتى طرد سفراء الكيان، بل ما زالت ترسل بضاعتها إلى العدو، وأغلقت معابرها ليموت الناس في غزَّة جوعًا وعطشًا إن لم يموتوا بالقصف، بل وتمنع في أغلبها التظاهر، والناس حزينة وغاضبة إلى أقصى حد، لكنها لم تتحرَّك بعدُ، لم تنفجر. تخيلتُ أنَّ غزَّة أقوى من صفعة بو عزيزي، وأنَّ تخاذل الأنظمة في دعمها -بل ومناصرة عدوها- سببًا كافيًا لثورة عارمة لا تُبقي ولا تذر. لكن هذا لم يحدث، وليس لديَّ أي تفسير أو إجابة على هذا السؤال! (3) أريد أن أُحقِّق حُلمي لكن كلَّما هممت واجهت مشاكل فماذا أفعل؟ ذات مرَّة وصلني سؤال على هذه الشاكلة، أحيانًا لبداهة الإجابة أحتار في الرد، وهل هناك حُلم أو عمل يمكن أن يقوم به المرء في الحياة كلِّها دون أن يواجه مشاكل وعقبات؟! وبالأساس لا يفرِّق بين الناس إلا همّهم، ذاك يتعثر في أول خطوة فيعلن فشله، وذاك يتعثر فيقف من جديد، فيتعثر مرة أخرى فيعاود النهوض، وهكذا حتى يصل. في الحياة الدنيا ليست هناك طرق ممهَّدة. كل الطرق غير معبَّدة، أنت السائر تعبِّدها بالخوض فيها. كلنا نقول: نحن مع غزَّة لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ تخيَّل لو أن رجال المقاومة قالوا نفس الأمر، نريد تحرير غزَّة، لكن ماذا نفعل؟ ثمة مخرجٌ ما على كل واحد منا أن يجده، قد يكون مخرجًا فرديًّا أو جماعيًّا، المهم أن هناك مخرجًا، هناك وسيلة، هناك طريقة. ليس المطلوب أن تقود طائرة حربية أو دبابة لنُصرة غزَّة، لو صدق الواحد منَّا لوجد طريقه. عندما نجد طريقًا إلى نجدة غزَّة سنجد طريقًا لننجد أنفسنا. (4) هل رأيت غزَّة وهي ساجدة؟ الذي يعاني من آلام الظهر، يُدرك جيدًا معنى ألم الانحناء، فما بالك بألم السجود؟ فما بالك بألم الإصابة القاتلة في الظهر والدم ينزف وأنت وحدك وعدوك يراقبك بطائرته؟ وفي هذه اللحظة -التي يصعب وصفها- تقرر أن تحاول بكل الطرق أن تسجد؛ حتى تلقى خالقك ساجدًا! أعدتُ المشهد مرات، كما فعل أغلبنا. الأدهى أن رجال المقاومة ليسوا هم الذين صوروه، ولكن عدوه، ونشرها رغبة في التشفِّي، فإذا هو يمنحنا هدية غالية. أتعرف.. هذا هو الأمل الأخير في نظري. لن يهلكنا الله لأن بيننا مثل هؤلاء. لكنه -عز وجل- قد يعذبنا على أيدي أعدائنا، فنحن نعلم -أو ليتنا نعلم- إنه إذا التهم الغزاة غزَّة -لا قدَّر الله- فسوف يستديرون علينا بلدًا بلدًا. ليس هذا تحليلاً، وإنما قولهم بألسنتهم. وأعتقد أنه لو قَدِرت عليهم غزَّة -بإذن الله- فسوف يستدير المنتصرون على الخائنين واحدًا واحدًا. المهم.. ليس ماذا فعل هذا المجاهد في هذه اللحظة. لكن الأهم.. ماذا فعل قبل هذه اللحظة -وعلى مدى سنوات قبلها- ليصبح هذه النسخة المذهلة؟
1260
| 01 يناير 2024
(1) الحرب مثل العاصفة؛ تقع فتطيح بنا وبكل ما حولنا، لا تهز ممتلكاتنا المادية فحسب، وإنما حتى مفاهيمنا وأفكارنا ومواقفنا في الحياة، فيعيد الأذكياء منا التفكير فيها، وتهذيبها، والاستغناء عن بعضها، واستبدال أخرى بأفكار مختلفة، لم يتصوروا يومًا أنهم يمكن أن يعتنقوها. ربما ليست كل حرب تفعل ذلك، إنما غزة فعلت، ليس بنا وحدنا في العالم العربي، وإنما في العالم أجمع، يدخل الناس في الإسلام، أو يقرأون عنه، يؤمن الناس بفلسطين التاريخية، أو يقرأون عنها. (2) إذا رمى عدو لك صواريخه على عدوك «الكيان» هل تبقى على الحياد، فتضيف قوة إلى الكيان، أم تؤيد عدوك، وهو الذي قتل من عائلتك وأصدقائك من قتل؟! فريق يعتقد أن تأييده واجب في هذا الموقف بالذات، وفي هذا المكان بالذات، وأن التأييد هنا لا يعني -أبدًا وبأي حال من الأحوال- أن تمنحه شرف البطولة، ولا أن تمتدح كيانه وأفكاره، أنت تؤيده في غزة، ترفضه في اليمن، تدينه في سوريا. وفريق يرى أن تأييده يمنحه فرصة غسل عاره هناك، ثم كيف لمن حاصر المدن وجوَّع أهلها هناك أن يدافع عن المدن المحاصرة هنا، كيف للذي قتل الأطفال هناك أن يدافع عن الأطفال هنا؟! ذات مرة أقمت في رواندا مخيمًا للتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية، وكانت فرصة للمتدربين أن يصنعوا بأنفسهم أفلامهم التي تمحورت حول تجربة هذا البلد، كيف عانى من مذابح بشعة، وكيف أنقذته المصالحات ليصبح دولة إفريقية نموذجية بعد ما فقد مليونًا من أبنائه ذبحًا. قال لي الشباب المشاركون: ربما تكون تجربة رائعة، لكن من المستحيل تكرارها في بلادنا، فمن الذي يستطيع أن يغفر لمن اغتصب وقتل وشرَّد أهله؟!وجهة نظر جديرة بالاحترام، ولأني لم أذق ما ذاقوه ليس بوسعي معارضتهم، لكن في المقابل ما هو الحل؟ يضطر المصاب أحيانًا أن يبتر عضوًا منه حتى يعيش، أنت مضطر لتقديم تضحية ما إذا لم يكن بوسعك تسديد ضربة قاصمة لعدوك. (3) تعوَّدنا على الشمولية، أي أن نحب ونوالي على طول الخط شخصًا ما، أو تنظيمًا أو جماعة، نعتقد أنه مثال كامل شامل، فيه كل خير، وفي خصومه كل شر. فإذا وقع أمر ما واصلنا دعمنا لمن نؤمن به، حتى لو حدثتنا نفوسنا أنه هذه المرة على خطأ، وواصلنا رفضنا لمن نخاصمهم، حتى لو حدثتنا نفوسنا أنهم هذه المرة على حق.في حرب غزة وجدت أناسًا على خلاف رئيسي مع الحركات الإسلامية، يؤيدون المقاومة في غزة، لقد تغلبوا على الفكرة الحمقاء القائلة: «تؤمن به كله، أو تكفر به كله». ليس خصومنا على باطل دائمًا، ولسنا على حق دائمًا، وفي كل موقف علينا أن نتجاوز انتماءاتنا ونحسم موقفنا بناء على قناعتنا ومبادئنا، وليس بناء على الولاءات.لا يمكن أن تتعامل مع الأفكار كما تتعامل مع كرة القدم، تشجع فريقك مهما فاز أو انهزم، ثمة خطوط تماس كثيرة بيننا وبين خصومنا، يحتم علينا إخلاصنا أن نتعاون معهم بخصوصها. (4) أيام زمان، كان البسطاء من أبناء بلدي يقتطعون كل شهر مبلغًا صغيرًا جدًّا من أقواتهم، ويستمرون على هذا الحال وبصبر شديد لسنوات طويلة، فإذا حان الموعد السنوي وقد اكتمل المبلغ المطلوب، قصدوا الحج. ما علاقة هذا بالحرب؟ أنا أخبرك. لو زرت غزة قبل هذه المعركة، ومشيت في شوارعها، والتقيت أهلها، ما كنت تظن أبدًا -على كل حسن ظنك- أن لديهم كل هذا السلوك الإيماني الذي رأيناه في الحرب، هذا التسليم بقضاء الله، الرضا بما قسم، اليقين بعدله -عزَّ وجل. لم يكن هذا ليمنع الألم الشديد باعتباره طبيعة إنسانية، لكن المرء -أيضًا- يختبر عند وقوع الكارثة، رد فعله الأول، ماذا يقول، وماذا يفعل؟ هذا المخزون من الإيمان، لم تكن لتلاحظه، وربما هم أنفسهم ما كان بوسعهم أن يتخيلوا أن يخزنوا بداخلهم هذا الإيمان العميق.التعبيرات التي صدرت منهم في لحظات الفجيعة لم تكن خارجة من فلاسفة، بل كانت بسيطة للغاية، لكنها عميقة للغاية، هزتنا هزًّا، بل هزت الغرباء الذين لا يؤمنون بما نؤمن به.لم يولد أهل غزة اليوم، وما نشاهده منهم إنما هو حصيلة سنين طويلة من تراكم الإيمان والتجارب، ما تعلموه من دينهم، وما مارسوه من نضال بأشكال مختلفة. لماذا يستخف المرء بالأفعال الصغيرة؟ أليست مخازنهم هي حصيلة أفعالهم الصغيرة، راكموها لسنوات، وعند الحاجة لجأوا إليها، أليست هي التي تنقذهم اليوم؟ السر كله في المخزن، تخيل أهل غزة ومخازنهم الإيمانية فارغة، ماذا كنا سنسمع منهم، أو نرى منهم؟ أنظر بحسرة إلى مخزني وأدعو لهم.
1005
| 25 ديسمبر 2023
(1) أفهم أن بعض الأمور في حياتنا ذات جدوى حتى وإن بدت غير ذلك، أو قُل: لها سلبيات وإيجابيات. لكن هذا الألم الذي يكرهه الجميع هل يمكن أن يكون له جدوى، أن تكون له ثمة فائدة ما في حياتنا؟ هل نعزِّي أنفسنا حين نقول: إنه لا بأس ببعض الألم، فإنه السبيل إلى النجاة، هل نكذب؟ أم نقول الحقيقة، أم نبالغ فيها؟ (2) يلمس شيئًا ساخنًا جدًّا، لا يشعر بشيء، يحترق جلده، يُدرك قيمة الألم، ونعرف أن هذا مرض خطير يصيب قلَّة، لكنه موجود ويعاني أصحابه بشدة، فهذا الشعور الخاطف بالألم الذي يجعلك تصرخ إذا لامست شيئًا ساخنا، له الفضل في أنك تُبعد يدك سريعًا، ولا تدع جلدك يحترق، سواء لامست شيئًا شديد السخونة، أو حتى شيئًا شديد البرودة، نجاتك مرتبطة بهذه اللحظات من الألم التي هي بمثابة جرس إنذار، يدفعك لردِّ فعل يُنجيك مما هو أسوأ. الألم هو الذي يقوم بتنبيهنا إلى أن هناك شيئًا غير طبيعي يحدث في جسدك، وأن عليك أن تفعل شيئًا. وقد قرأت مرَّة: أن آلام الظهر يشعر بها المرء بصورة مخففة، ثم تزول، ثم تعود إليه بعد شهور بصورة أقوى، كأنها عقاب على أنه لم يُنصت لرسالة التحذير في المرة الأولى. الألم الجسدي دليل على وجود مشكلة صحية تحتاج اهتمامك. غير أن الألم النفسي يكون -أحيانًا- هو الأشد: الفقدان، والفراق، والخذلان، والخيانة، كلها تُحدث في النفس آثارًا قد لا تزول طيلة حياتنا، تترك ندبات لا تُشفى. ثم إن الألم علامة على أن قلوبنا حية، أقوى دليل على أنك إنسان، ليس هناك دليل أقوى على ذلك من الألم. انظر إلى الذين يشاهدون ما يحدث في غزة ولا تتحرك قلوبهم، ولا أحاسيسهم، هل تتمنى أن تكون مثلهم؟ عليك إذن أن تختار بين أن تكون بليد الإحساس، وستدفع ثمن ذلك، وبين أن يكون قلبك حيًّا؛ يتألم لكل مشهد، وستدفع -أيضًا- ثمن ذلك. للأسف ليس هناك اختيار ثالث، قارن أنت بين الخيارين، وقرِّر بنفسك. ثم إن الألم هو الضامن ألا ننسى، ألا نكرر الفعل الذي أدَّى بنا إلى فشلٍ ما، أو سقوطٍ ما، بل المطلوب ألا تعتاد الألم؛ فإنك إن اعتدته نسيت، وإن نسيت أُصبت بألم أعظم؛ عقوبة لك على نسيانك. (3) قرأتُ لابن قيم الجوزية أن رجلاً سأل الشافعي -رحمه الله- فقال: يا أبا عبد الله، أيُّما أفضل للرجل: أن يُمكَّن أو أن يُبتلى؟ فقال الشافعي: لا يُمكَّن حتى يبتلى؛ فإن الله ابتلى نوحًا، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمدًا -صلوات الله وسلامه عليهم، فلما صبروا مكَّنهم. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم ألبتة. إن الله -عز وجل- يمنحنا نعمًا مادية كثيرة نكتشفها سريعًا ونعمل على استغلالها، مثل: الذهب، والنفط، والغاز، وغيرها، غير أننا لا نكتشف بسهولة النعم غير المرئية الأخرى. نعم إن الخالق -عز وجل- يُنعم علينا بأدوات كثيرة جدًّا في الدنيا، وينظر إلينا كيف سنتعامل معها، فينجح بعضنا، ويفشل بعضنا، بل إن بعضنا لا يُدرك بالأساس سر وجودها، لذلك فإن الألم إن فهمنا مغزاه فهو نعمة. الألم جزء لا يتجزأ من تجربة الإنسان، بل هو المعلم لأن تكتشف نفسك، وقدراتك، وقدرتك على الصمود والتحدي، ويشجعك على أن تنظر إلى الحياة من منظور جديد، وهو فرصة لتقدير لحظات السعادة والصحة عندما نعيشها. (4) في إحدى الروايات المعنية بأدب السجون ذكر الكاتب أن البطل كان يحدِّث نفسه وهو في انتظار وجبة تعذيب: أن الألم فكرة في الرأس، فإن غلبتها فكرة أخرى أقوى تراجعت. قد لا يكون ذلك صحيحًا مائة في المائة، لكنه -على كل حال- محاولة لمواجهة الألم والتعامل معه. كلنا يصيبنا الألم، لكن لسنا جميعًا جاهزين للتعامل معه، والتكيف مع ما يفرضه من حال، لسنا جميعًا نُحسن إدارة الألم. حسن إدارة الألم يعني أن نتجنب انهيار حصوننا، أن نكتشف مصادر قوتنا، أن نعالج مواطن ضعفنا. غزة هذه الأيام هي المثال الناجح لفكرة إدارة الألم. قبول قضاء الله، والرضا به، مع الحزن كطبيعة إنسانية، شرط ألا تتوقف حياتنا.
531
| 18 ديسمبر 2023
مساحة إعلانية

انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت...
7011
| 14 أكتوبر 2025

المعرفة التي لا تدعم بالتدريب العملي تصبح عرجاء....
2853
| 16 أكتوبر 2025

ليس الفراغ في الأماكن، بل في الأشخاص الذين...
2433
| 20 أكتوبر 2025

في ليلةٍ انحنت فيها الأضواء احترامًا لعزيمة الرجال،...
2127
| 16 أكتوبر 2025

قمة شرم الشيختطوي صفحة حرب الإبادة في غزة.....
1605
| 14 أكتوبر 2025

يمثل صدور القانون رقم (24) لسنة 2025 في...
1575
| 21 أكتوبر 2025

في زحمة الحياة وتضخم الأسعار وضيق الموارد، تبقى...
1395
| 16 أكتوبر 2025

الوقت الآن ليس للكلام ولا للأعذار، بل للفعل...
1251
| 14 أكتوبر 2025

لا يخفى على أحد الجهود الكبيرة التي تبذلها...
1122
| 14 أكتوبر 2025

لم تعد مراكز الحمية، أو ما يعرف بالـ«دايت...
798
| 20 أكتوبر 2025

في قلب كل معلم مبدع، شعلة لا تهدأ،...
780
| 17 أكتوبر 2025

القيمة المضافة المحلية (ICV) أداة إستراتيجية لتطوير وتمكين...
777
| 20 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل