رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لم تكن الهزائم التي أربكت خطواتها ناتجة عن قسوة الحياة أو تقلبات الأقدار، ولا حتى عن أعداء وقفوا في وجهها ذات حرب. لم تخذلها الحياة كما يفترض أن تخذلنا، بل أولئك الذين صنعتهم من دمها، وأطعمتهم مضغة من قلبها، ووهبتهم الكثير من شهقاتها، وظنتهم ضلعها المستقيم، فكانوا الخنجر الذي لا يُرى.. حتى يغوص في الشغاف. كانوا الوجوه الأقرب، الأسماء التي كانت تهمس بها في صلواتها، الأيادي التي تشبثت بها في العتمة، الذين أودعتهم أسرارها وعرت أمامهم ضعفها وهي تثق بأنهم لن يخذلوها أبدًا. صنعتهم حبًا، لا مصلحة. دعمتهم حين ترنحوا، وحملت عنهم أثقالهم وهم لا يعلمون. ظنت أنها تقيم معهم وطنًا صغيرًا من دفء وأمان، فإذا بهم أول من يشعل النيران فيه. ليتهم خذلوها جهارًا، بصراحة الجفاء. ليتهم قالوا: “لا نحبك”، أو حتى “لقد انتهى الأمر”. لكنها لم تتلقّ شيئًا من هذا الوضوح الجارح. تلقّت ما هو أشد، خناجر مغموسة في العسل، كلمات محبة تخبئ وراءها نية غادرة، أفعال ملبّسة بالحنان لكنها مشروطة، وظهورهم في وقت حاجتها كان دومًا مؤجلًا حتى إشعارٍ آخر. لم تكن غبية، لكنها أحبّت بعمى. لم تكن ساذجة، لكنها آمنت أن النقاء لا يُقابل بالخداع. كانت تظن أن الحب يحمي، أن العطاء يربّي الوفاء، أن القلوب التي تزرع فيها ضوءها لا تثمر ظلامًا. لكن الواقع كسرها بطريقة هادئة ومدروسة؛ لم تصرخ، لم تنكسر دفعة واحدة، بل تهشّمت على مهل، كل مرة كان أحدهم يتسلل من قلبها ليطعنه ويختفي، تخلّفت فيها شظية لا تشفى. ولأنها لم تتعلم الحذر مبكرًا، تكرر الطعن. وكل مرة كانت تبني الجدار من جديد، أكثر صلابة، أكثر عزلة، لكنها تعود وتفتح نافذة صغيرة على أملٍ جديد، فتُخذل مجددًا. لم تكن لعنتها في الحب، بل في الظن الحسن. في أنها تُحب أكثر مما يجب، وتصفح قبل أن يُطلب منها الصفح، وتُعطي حتى لا يبقى فيها ما يُعطى. كانت مثل الشجرة التي لا تملّ من حمل أثقال الطيور وأعشاشها، حتى حين تُكسر أغصانها، لا تسقط، بل تُنبت غيرها. لكن ماذا يحدث حين تأتي الفأس من داخلها؟ من الشريان الذي كانت تظنه جذرها؟ تنهار بصمت، لا لأن الريح قوية، بل لأن الخيانة جاءت من داخل الحصن. ويا للمفارقة… ما كان يؤلمها لم يكن فعل الخيانة ذاته، بل اكتشاف أن الحب وحده لا يكفي. أنها مهما أحبّت، لن تضمن الوفاء. وأن من يُطعَم من القلب قد يُصبح أول من يدوس عليه. الألم الحقيقي لم يكن في ما فعله الآخرون، بل في ما فعلته هي: في سذاجة التوقع، في ثقتها التي منحتها من دون قيد أو شرط، في الأحلام التي شاركتها معهم وكأنها حق مشترك. ولكنها تعلمت. لم تُصب بالقسوة، لكنها صارت أكثر وعيًا. لم تُغلق قلبها، لكنها فتحت عينيها. لم تعد تبحث عن المدى في عيون الناس، بل صارت تقرأ ما بين السطور. أدركت أن بعض الأسماء لا تستحق أن تُكتب بالحبر الذي سُكب من مشاعرها، وأن بعض القلوب لا يصلح أن يكون لها مفتاح. الخذلان، مهما تكرر، لا يُميت القلب، لكنه يُعيد تشكيله. يُنضجه. يجعل نبضاته أكثر حذرًا، وعطاءه أكثر انتقاء. وقد أدركت الآن، بعد كل هذا الوجع النبيل، أن خسارة من لا يقدّر نعمة. وأن الحب لا يُقاس بما تمنحه، بل بمن يبادلك الصدق فيه. وأن الضلع المستقيم… لا يُطعنك. وهكذا، في لحظة صدق مريرة، لم تعد تنتظر من أحد أن يُنقذها. عرفت أنها وحدها خلاصها، وأن من لا يُشعل النور في حياتك، لا يستحق أن يعيش في دفئك. كتبت نهاية القصة، ثم بدأت من جديد، لا تحمل سكينًا في ظهرها، بل درعًا على صدرها، وقلبًا ينبض… لكن بحكمة.
483
| 02 يونيو 2025
في غزة، لا توجد استثناءات من الموت. لا مهنة تحميك، ولا أمومة تعفيك، ولا وجود للخطأ في توجيه الصواريخ. الحكايات في هذه المدينة ليست مشاهد درامية ولا سرديات خيالية، بل وقائع دامغة تسير على الأرض، وتُسجل في ذاكرة من تبقى. واحدة من هذه القصص هي قصة الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار. آلاء لم تكن في البيت حين سقط عليه صاروخ إسرائيلي. كانت في المستشفى، في عملها اليومي كطبيبة أطفال. تؤدي واجبها الإنساني في رعاية من نجا من الموت، تعالج المصابين وتواسي المفجوعين، وتقاتل بيديها وضميرها من أجل إنقاذ أرواح صغيرة. وبينما كانت تقوم بذلك، لم تكن تعلم أن تسعة من أطفالها كانوا يُقتلون في اللحظة ذاتها، في بيتها، الذي تحول في دقيقة إلى ركام. حين عادت، لم تجد بيتًا. لم تجد أصواتًا مألوفة، لم تجد حتى فرصة للوداع. لم تجد سوى أنقاض، وجثث ممزقة، وأشلاء صغيرة متناثرة، كل منها يحمل اسمًا من أسماء أبنائها. تسعة أطفال، لم يكن فيهم مقاتل، ولا مستهدف عسكريا، ولا من يشكل تهديدًا لأي طائرة أو صاروخ أو جندي. كانوا أطفالا فقط! هذه ليست حادثة معزولة، وليست “أضرارًا جانبية”. هذا قصف مباشر لمنزل مدني، في حي سكني، أثناء وجود الأطفال فيه، في لحظة غياب للأم. الصاروخ لم يخطئ. كان دقيقًا في إصابته. هذه هي طبيعة العدوان الذي يتعرض له سكان غزة؛ لا أحد في مأمن، ولا منزل يُستثنى، ولا طفل يُعفى. الطبيبة آلاء لم تُقتل. نجت، فقط لتظل شاهدة حيّة على جريمة مكتملة الأركان. وهذا بحد ذاته عقاب آخر. أن تُترك أم بلا أطفالها، أن ترى البيت بلا أصوات، بلا لعب، بلا فوضى الحياة اليومية، أن تُجبر على حمل صورهم بدلًا من أيديهم، وعلى تذكّرهم بدلًا من تربيتهم. نجت، لتروي الحكاية، لتكون شاهدًا حيًا على المجزرة. هذه القصة، على قسوتها، ليست الأشد غرابة في غزة. في كل يوم، هناك أم فقدت أبناءها، هناك أب حمل أشلاء طفله بيديه، هناك منزل تحول إلى قبر جماعي. لكن في قصة آلاء تتجلى المفارقة البالغة: طبيبة أطفال تفني يومها في محاولة إنقاذ أطفال الناس، وتفقد في المقابل أطفالها جميعًا بصاروخ واحد. من واجبنا ألا نقرأ هذه القصة كخبر، بل كوثيقة إدانة. هذه الحكاية شهادة دامغة على نوع الحرب التي تُشن على غزة، وعلى الاستهداف المباشر للمدنيين، وعلى انهيار كل ما يمكن أن يُسمى قانونًا دوليًا أو معايير إنسانية. ما يحدث في غزة ليس مجرد “ردود فعل”، ولا مجرد “نزاع معقّد”، بل هو عدوان منظم ضد شعب كامل، يُعاقب جماعيًا في كل تفاصيل حياته. آلاء لم تكن تحمل سلاحًا، ولم يكن بيتها مخزنًا للذخيرة، وأطفالها لم يكونوا مقاتلين. كانوا تسعة أرواح تنام في البيت، مثل أي أطفال في العالم. لكن في غزة، لا يُمنح الأطفال حق النوم الآمن، ولا الأمهات حق الحياة العادية، ولا البيوت صفة الحماية. حين نكتب عن هذه القصة، لا نحتاج إلى زخارف لغوية أو استعارات أدبية. يكفي أن نقول الحقيقة كما هي؛ قصف بيت فيه تسعة أطفال، فقتلوا جميعًا، وبقيت أمهم شاهدة. هذه جريمة لا تحتاج تفسيرًا، ولا تحليلًا، ولا تبريرًا. هذه مأساة لا ينبغي أن تمر بصمت. صوت آلاء اليوم ليس مجرد صوت أم مكلومة، بل هو صوت غزة كله. هو الصوت الذي يصرخ في وجه العالم: انظروا جيدًا. هذا ما يحدث هنا. ليس في الخيال، بل في الواقع، كل يوم.
777
| 26 مايو 2025
في اللحظة التي يصدح فيها الأذان للفجر، لا يستيقظ الجسد فقط، بل تصحو معه ذاكرة غائرة في الأعماق، أصوات من رحلوا، ملامحهم، ضحكاتهم، وحتى حكاياهم التي كنا نعتقد أنّها ذابت مع الزمن، تتسلّل فجأة من حيث لا أدري. هم لا يطرقون الباب، لا يستأذنون، بل يأتون في صمت، في خفة، كأنّ الفجر موعدهم، وكأنّ صلاة الفجر فسحتهم المخبأة للعودة إليّ، ولو قليلاً. أجلس على سجادتي بعد الصلاة، أبقى حتى أشعر بيدٍ خفية توضع على كتفي. لا ألتفت. أعرف هذا الشعور لكنني لا أتحرك لأنني لا أريد أن أربك تلك الطمأنينة التي يصنعها الفجر في روحي. حين نصلي الفجر، لا نصلي وحدنا. هناك مَن يطمئن علينا، من حيث لا نراهم. لا صوت لهم، فقط أرواحهم تحيط بنا كوشاح من دفء، تهمس في القلب: “نحن هنا.. نراكم، نحبكم، لم نغادركم حقًا.” والمفارقة الجميلة أن تلك الأرواح تعرف الوقت جيدًا. تأتي قبل الصلاة بقليل، وتختفي قبل أن نرفع أيدينا إلى السماء. لا تمنحنا وقتًا كافيًا لنبكي أمامها، كأنها تأبى أن ترى الدموع، أو كأنها تقول إن اللقاء لا يجب أن يُثقل بالحزن. صلاة الفجر هي الموعد الذي لا يكذب، هي اللحظة التي تخلع فيها الحياة أقنعتها، وتتجلى كما هي. لا شيء يُخفي الروح عن حقيقتها وقت الفجر. حتى الدعاء يكون نقيًا، فوريًا، بلا زخارف. تقول ما تريد دون ترتيب: “يا رب، خذ قلبي إليك، وخفف عني فَقْد من أحب.” تقولها وأنت تعلم أن من تحب قد غاب، لكنه يعود، في هذا الموعد تحديدًا، ليأخذ من حزنك ما يستطيع، ويترك لك من الطمأنينة ما يكفي ليوم آخر. كل الذين فقدناهم، مهما كانت طريقة الرحيل، يعودون فجراً. لا يتكلّمون، لا يبتسمون، حضورهم يكفي. تفتح عينيك في الضوء الخافت فتشعر بهم، كأن الهواء صار أثقل قليلاً، كأنك لست وحدك. ولأن الفجر زمن النقاء، فإن حضورهم لا يخيفك، بل يربّت على قلبك، لأن أرواحهم تعرف أن الوقت محدود، وأن الطمأنينة التي يزرعونها فيك لا بد أن تكون سريعة وخفيفة. ما أغرب هذه العلاقة بين الموت والفجر. الفقد والضوء الأول. في لحظة طلوع النهار نافذة صغيرة نطل بها على من تركونا. لا لنسألهم عن شيء، بل لنخبرهم أننا ما زلنا هنا، نحاول، نتذكّر، نصلي وندعو لأجلهم. في كل ركعة وعد خفي أن لا ننسى، ونظل نذكرهم من دون ضجيج ولا وجع فاضح. إنها لحظة الصدق النادر، لحظة يكون فيها الحنين طاهراً لا يشوبه غضب ولا احتجاج. مجرّد أمنية أن يكونوا بخير، وأن يكون الله قد لطف بهم كما نرجوه كل يوم. وكل فجر نمرّ به هو رسالة غير مكتوبة، نبعث بها إليهم: “أنتم في القلب، في الدعاء، في تفاصيل الحياة.” وربما كانت الصلاة نفسها هي لغتنا المشتركة معهم الآن، حيث لا رسائل ولا مكالمات، فقط هذا الصمت المقدس الذي نمارسه أمام الله، ويصل صداه إليهم، حيث هم. ثم، ما أن تنتهي الصلاة، ويبدأ الضوء يتسلل من خلف النوافذ، حتى يبهت كل شيء. كأن الراحلين لا يريدون أن يراهم النهار. يعودون إلى غيابهم الأكيد، بهدوء، كما جاؤوا. يتركون وراءهم قلبًا أكثر اتزانًا، وعينًا رطبة دون أن تفيض. وتبقى الرائحة، رائحة الفجر الذي مرّ عليهم وعليك، وصوت الأذان الذي جمعكم للحظة، ثم مضى. في كل فجر، لا نصلي فقط، بل يعاد ترميمنا من الداخل. في كل ركعة شيء يشبه اللقاء، وشيء يشبه الفقد، وشيء يشبه الرضا. الفجر موعد الأرواح الخفيفة، الوجوه التي لم تنسها قلوبنا، ولم تغب عن ذاكرة الدعاء. هؤلاء الراحلون لا يغيبون فعلًا، بل يختارون أجمل الأوقات ليعودوا. وها هو الفجر مرة أخرى، يفتح لنا بابه، لنلتقيهم في صمت، ونكمل الصلاة، وقد صار القلب أخف.
453
| 19 مايو 2025
تخيّل أن كلماتك ستُقرأ بعد مائة عام. أن يُقلّب أحدهم صفحاتك كما يُقلّب الذكريات، ليبحث بين السطور عنك، لا عن زمانك، وعن صوتك لا صدى الآخرين فيك. تخيّل أن الكتابة لم تكن لحظتك أنت، بل اللحظة التي تسبق ميلاد قارئٍ لن تراه، فماذا ستكتب؟ وكيف ستُكتب؟ الكتابة ليست تمرينًا لغويًّا ولا استعراضًا لأدواتك البلاغية، إنها رسالة تُرمى في بحر الزمن، لا تدري على أيّ شاطئ ستُلفظ، ولا من سيمسك بها بعدك. لهذا. لا تكتب ليُقال: «يا له من أسلوب»، بل ليُقال: «يا لها من روح»، أو «من هذا؟ أشعر أنني أعرفه، رغم أن بيننا قرنًا من النسيان». وفي زمن يتهافت فيه كثيرون على نسخ الآخرين، وعلى تكرار النغمة نفسها بحروف مختلفة، والانبهار بما يُرضي السوق لا النفس، تصبح الكتابة التي تشبه صاحبها عملة نادرة. لكن الكاتب الحقيقي لا يختبئ خلف الظلال، بل يصنع ضوءه الخاص، حتى لو كان باهتًا أول الأمر، لأنه مع الوقت، يُصبح الضوء صوتًا، ويُصبح الصوت أثرًا، ويُصبح الأثر حياةً ثانية. حين تكتب، اسأل نفسك؛ هل ما أقوله الآن نابع من صدري، أم من تراث محفوظ؟ هل هذه الكلمات تشبهني، أم تشبه الكتب التي قرأتها؟ لا عيب أن تتأثر، ولكن العيب أن تُصبح نسخة بلا ملامح. اجعل لحروفك ملامحك، حتى لو لم تكن الأجمل، حتى لو كانت مليئةً بالشوائب. فالنقاء لا يصنع دائمًا الصدق، وأحيانًا العيوب هي ما يُحبّبنا في الأشياء. نحن لا نحبّ اللوحات المتقنة دائمًا، بل تلك التي تُحدث فينا رعشة، التي تجعلنا نتوقف، نتأمّل، نقول: «هناك شيء هنا… شيء لا يُرى، لكن يُحَسّ». والكتابة التي تُشبه صاحبها، لا تُهرَم. لأنها لا تنتمي فقط إلى سياقها الزمني، بل تنتمي إلى تجربة إنسانية أوسع، وإلى الصدق، وهذا ما يبقى. فقد تتغير الأذواق، وقد تتبدل المدارس، لكن شيئًا واحدًا لا يُغيّره الزمن؛ الشعور بالصدق. فحين تقرأ رسالة كتبها عاشقٌ قبل مائة عام، وتشعر أن قلبك يخفق معها، فاعلم أن ما كتبه كان يشبهه حقًّا. لم يُحاول أن يُقنعك، بل فقط قال ما يشعر به، وها أنت تشعر به أيضًا. وهنا يكمن السرّ؛ اكتب لتُشبه نفسك، لا لتُرضي غيرك. لا تُشبه كاتبًا تحبّه، ولا مدرسةً تُعجبك، ولا زمنًا تتمنى أن تنتمي إليه. اكتب لأنك لا تعرف طريقة أخرى للنجاة. لأنك تريد أن تترك أثرًا، لا أثر أحدهم، ولا تحتمل فكرة أن تمرّ في هذا العالم، وتغيب من دون أن تترك وراءك شيئًا يقول: “كنت هنا، هذا أنا، وهذا حُبّي، وهذا حزني، وهذا ضحكي، وهذه أسئلتي التي لم أجد لها إجابة». إن الكتابة الحقيقية لا تخاف من الفقد، بل تُراهن عليه. تعرف أن الزمن سيمحو كثيرًا، لكنها تؤمن أن ما كُتب بصدق لا يُمحى بسهولة. تُراهن على أن الحروف حين تنبض بالروح، تصير أكثر بقاءً من الجسد. لذا، لا تكتب كمن يخشى النسيان، بل كمن يعرف أنه لن يُنسى طالما أن أثره صادق. اجعل من حبرك امتدادًا لنبضك، لا لبصمتك فقط. لا توقّع باسمك، بل بروحك. اكتب كما لو أن الكتابة طوق نجاةٍ من الزيف، وكأنها الطريقة الوحيدة لتقول لمن سيأتي بعدك؛ «أنا لم أكن شبحًا، كنت إنسانًا… وهذا دليلي». ربما لن تقرأك الملايين، وربما لن تُدرَس نصوصك في الجامعات، لكنك ستكون قد كتبت ما يُشبهك، وهذا وحده يكفي، لأنك عندها لن تكون مجرد صوت مرّ في الزحام، بل نفسًا، روحًا، شعورًا يُحسّه من سيأتي بعدك، حتى لو لم يعرف اسمك. اكتب، لا لتعيش في الكتب، بل لتعيش في من سيقرؤك.
429
| 12 مايو 2025
ليس الحقُّ لغزًا يحتاج إلى تفكيك، ولا سرًّا خفيًا لا يُدركه إلا القلّة، بل هو واضحٌ كالشمس، جليٌّ لمن أراد أن يراه. لكنه، في كثيرٍ من الأحيان، ليس كافيًا وحده. فالمشكلة ليست في غموض الحق، بل في الذين يتجاهلونه عمدًا، في الذين يُعيدون تشكيله بحيث يُناسب رواياتهم، في الذين يُرهقون المظلوم بأسئلةٍ لا تُطرحُ على الظالم، وكأنَّ عليه أن يُثبت مرارًا وتكرارًا أنه ضحية، بينما يُمنح الجلاد حقَّ الشك والتمهل في الحكم. لذلك، لا ينبغي أن تُضاعفوا على المظلوم عبء التبرير، ولا أن تُحملوه فوق آلامه اختبارًا قاسيًا يُثبتُ من خلاله أنه يستحقُّ التعاطف. المظلوم لا يحتاج إلى إحسانكم، بل إلى إنصافكم، لا يحتاج إلى دموعكم، بل إلى أن تقفوا حيث يجب أن تقفوا، بلا تردد، بلا تحذلقٍ يُحاول أن يجعل كل شيءٍ رماديًا، بلا خطبٍ باردة تُحاول أن تُخفف وقع الجريمة بحجة الموضوعية. لكن هناك من يظن أن التعاطف مع المظلوم يُجيز له الانتقاص من كرامته، كأنما هو يتفضّل عليه بمواساته، فيُشعره بأنَّه ضعيف، بأنَّه مدين لهذا التعاطف، بأنَّه محظوظٌ لأنَّ هناك من التفت إليه أصلًا. هذا النوعُ من التعاطف ليس إلا وجهًا آخر للخذلان، لأنَّه لا يرى في المظلوم إنسانًا له حق، بل مجرد حالةٍ تستدعي العطف لا العدالة، يستدرُّ دموع الآخرين لكنه لا يستفزُّ وقوفهم معه. ليس هناك ما هو أشدّ قسوةً على المظلوم من أن يُصبح مجرّد قصةٍ يتداولها الناس بعبارات الأسف العابر، ثم يمضون في حياتهم كما لو أن شيئًا لم يكن. أن يُعامَل كأنه مُكسَرٌ إلى الأبد، كأنَّ مأساته هي كلُّ ما يُعرّفه، كأنَّ الحياة قد حُسمت له في خانة الألم، فلا يُنتظر منه إلا أن يبقى هناك، في دائرة الضحية التي لا تخرج منها. لكنه ليس ضحيةً ليُعزى، بل إنسانٌ له كامل الحقِّ في أن يكون أكثر من قصته الحزينة، له الحقُّ في أن يُعامل بكرامته، لا بشفقةٍ تُلقي عليه نظرةً من علٍ، وكأنه أقل شأنًا ممن لم يُصبه ما أصابه. المشكلة في هذا العالم ليست في قلة العدل فحسب، بل في أولئك الذين يظنون أنَّهم يُمارسون التعاطف، بينما هم، دون أن يشعروا، يُمارسون لونًا آخر من الظلم. في الذين يمدّون يدهم للمظلوم لا ليُعينوه على النهوض، بل ليبقوه في موضع الاستجداء. في الذين يُحدّقون في جراحه بدهشةٍ زائفة، لا لأنهم يريدون مداواتها، بل لأنهم يجدون في تأمل الألم نوعًا من التسلية، من الفضول، من الإحساس المُريح بأنَّهم في موقع المتفرّج لا في موقع المتألم. الحقُّ واضحٌ لمن أراد اتباعه، لكن المشكلة دائمًا في الذين لا يُريدون ذلك، في الذين يُجيدون الالتفاف حول الحقيقة، في الذين يُنفقون جهدهم في تبرير القسوة بدلاً من مواجهتها، في الذين يُمارسون حيادًا خادعًا يُساوي بين الظالم والمظلوم، ثم يُنادون بتسامحٍ لا يُطلب إلا ممن فُرض عليه الألمُ فرضًا. أما العدالةُ ليست فعلًا انتقائيًا، تُمارَس حين تكون مُريحة، وتُتجاهل حين تُصبح مكلفة، لأن المظلوم ليس بحاجةٍ إلى نصفِ موقف، أو كلماتٍ جميلة لا تُغيّر من واقعه شيئًا، أو تعاطفٍ مشروطٍ بقبوله لدور الضحية الصامتة التي لا يُسمح لها بالغضب، ولا بالمطالبة بحقها كاملًا. ما يحتاجه هو أن يُؤخذ حقه بجدية، لا أن يُعامل كحالةٍ إنسانيةٍ تُثير التعاطف، ثم تُطوى صفحتها مع أول خبرٍ جديدٍ يسرق انتباه العالم. ومن أراد أن يقف مع المظلوم، فليقف معه بكرامته، لا بشفقته. ومن أراد أن يكون عادلًا، فليكن ذلك بوضوح، بلا مواربة، بلا عباراتٍ مُلتوية تُجمّل الوقوف في المنتصف، بلا خطبٍ فارغة تُحاول أن تُخفي الحقيقة وراء ستارٍ من الكلمات المنمقة. الحقُّ واضحٌ، لا يحتاجُ إلى زخرفةٍ لغويةٍ تُخفي حدَّته، ولا إلى تبريراتٍ تُخفف من وطأته على من لا يُريد أن يراه كما هو.
498
| 05 مايو 2025
حين يكتب أحدنا يومياته، فإنه يمارس أبسط أشكال الاعتراف مع النفس. لا يكتب ليصنع نصًا أدبيًا ولا ليبهر أحدًا، بل لأنه يشعر أن هناك أشياء لا يمكنه مشاركتها مع الآخرين. الكتابة اليومية أشبه بعملية جرد داخلي: ماذا حدث اليوم؟ كيف شعرت به؟ ماذا تعني لي هذه التفاصيل الصغيرة التي قد تبدو عابرة لكنها، مع الزمن، تصنع حياتي الحقيقية؟ الكتابة هنا وظيفة عملية أكثر منها عاطفية. إنها طريقة لتنظيم الأفكار، لتفريغ المشاعر السلبية قبل أن تتراكم وتتحول إلى مشاكل أكبر. الإنسان الذي يكتب مشاكله وانفعالاته اليومية غالبًا ما يكون أكثر قدرة على إدارتها بعقلانية لاحقًا، لأنه راقبها بوضوح بعيدًا عن لحظة الانفعال. كما أن اليوميات تؤدي دورًا مهمًا في بناء الوعي الذاتي. حين يراجع الشخص ما كتبه قبل أشهر أو سنوات، يلاحظ أنماطًا معينة تتكرر؛ طريقة تعامله مع الغضب، مصادر قلقه، أخطاؤه المتكررة، أو حتى تطور نظرته إلى نفسه والآخرين. بهذه الطريقة تصبح المذكرات أداة لفهم السلوك الشخصي بشكل أكثر علمية وموضوعية. ولا يمكن تجاهل أن الكتابة اليومية أيضًا وسيلة لحفظ الذاكرة الشخصية. التفاصيل التي تبدو تافهة اليوم قد تحمل لاحقًا قيمة لا تعوض. الشخص الذي كتب عن حوار قصير مع والده أو عن صباح شتوي عادي قد يكتشف بعد سنوات أن هذه الذكرى البسيطة تساوي كنزًا شعوريًا يصعب تعويضه. الذين يواظبون على كتابة مذكراتهم لا يفعلون ذلك بدافع الحنين فقط، بل لأنهم يدركون أن الإنسان كائن ينسى. والكتابة، ببساطتها وصدقها، تصنع نسخة موازية للحياة، نسخة يمكن الرجوع إليها حين تغيب التفاصيل أو تختلط الذكريات. كذلك، الكتابة تتيح نوعًا من الانفصال المؤقت عن ضغوط الواقع. عندما يكتب الإنسان عن مشكلة ما، فإنه ينقلها من ذهنه إلى الورق. هذه الحركة البسيطة تخلق مسافة عقلية بين الشخص والمشكلة، تجعله ينظر إليها ببرود نسبي يسمح له بتحليلها بهدوء بدل أن يبقى عالقًا في دائرة التفكير السلبي. وليس كل من يكتب يومياته يعاني من مشكلة أو أزمة. كثيرون يكتبون ببساطة لأنهم يجدون في الكتابة طريقة لتوثيق حياتهم كما هي، بحلوها ومرها. الكتابة هنا تصبح سجلًا موضوعيًا لرحلة إنسانية مليئة بالتناقضات؛ الفرح والحزن، النجاح والفشل، البداية والنهاية. وهذا السجل الشخصي لا يُكتب من أجل الآخرين، بل من أجل احترام التجربة الذاتية نفسها. وهذا يعني أن كتابة المذكرات واليوميات ليست رفاهية ولا سلوكًا غريبًا. إنها فعل طبيعي لإنسان يسعى لفهم نفسه، وللحفاظ على صوته الخاص في عالم كثير الضجيج. إن الشخص الذي يكتب يومياته لا يبحث عن شهرة، ولا يحاول أن يبدو مثاليًا. إنه ببساطة يمارس حقه في أن يكون صادقًا مع نفسه، أن يواجه مشاعره وأفكاره دون تزييف أو تبرير. الجميل في كتابة المذكرات أنها لا تتطلب قارئًا آخر. الكاتب والقارئ في هذه الحالة شخص واحد. لا أحد يفرض عليك قواعد اللغة ولا منطق الأحداث. يمكنك أن تبدأ من النهاية، أو أن تكرر نفسك مئة مرة، أن تكتب بأخطائك، بدموعك، بأحلامك المحطمة. كل شيء مسموح لأنك تكتب لنفسك، ولنفسك فقط. وفي هذا الفعل البسيط تكمن قيمة كبيرة: القدرة على رؤية الذات بوضوح، القدرة على تنظيم الفوضى الداخلية، القدرة على الاحتفاظ بما هو مهم وسط سيل النسيان. لذلك نكتب. نكتب كي نفهم. نكتب كي لا نضيع. والمهم أن نكتب، لأن الكتابة تضيء العتمة التي نخشى النظر إليها، وتبني لنا جسرًا بين ما نحن عليه وما نرجو أن نكونه. المهم أن نكتب لأننا، ببساطة، لا نستطيع أن نصمت أكثر!
495
| 28 أبريل 2025
ليست الكارثة في أن يظهر فنان على المسرح ليقدم وصلة فنية لا تعجبنا، نحن «جيل الطيبين»، كما يسمى كل من غادر الأربعينيات من عمره وحسب، بل في أن يتحول المسرح إلى منصة لاغتيال الذوق، وأن يُستبدل الفن بالاستعراض، والرسالة بالمهزلة، والجمال بالإثارة الرخيصة. في ليلة أمريكية صاخبة، وقف «ممثل» مصري على خشبة المسرح مؤخراً، ليعرض جسده في بدلة رقص نسائية لامعة ومبتذلة! لم يكن ما فعله مجرد “عرض فني”، كما يحاول أن يبرر، بل كان فعلاً مقصوداً بعناية، وموجهاً، ومشحوناً برسائل خفية وظاهرة في آن. لم يكن يبحث عن صدمة جمالية، ولا عن كسر لحدود فنية قديمة، بل عن ضجيج. ضجيج يداري خواء التجربة، وغياب الموهبة، وارتباك البوصلة. ضجيج يجذب الكاميرات، ويفتح أبواب الجدل على مصراعيها، ويعيد اسمه إلى “الترند”، ولو على حساب أجيال تبحث عن قدوة، وعن ملامح رجل شرقي لا ينهار تحت بريق الشهرة الغربية الزائف. ما فعله «الممثل» ليس حدثاً معزولاً، بل هو حلقة في سلسلة طويلة من محاولات تجريف الوعي، وتفكيك الثوابت، وضرب ما تبقى من قيم في عالم عربي بات يتلقى صدماته الأخلاقية واحدة تلو الأخرى، دون أن يملك الوقت ليلتقط أنفاسه. فالفن الذي كان من قبل يُهذِّب الذوق، ويُنير العقول، ويُسائل الواقع، تحوّل على يد بعض المغامرين إلى لعبة تجارية قائمة على الانحدار، وعلى تصدير التفاهة باعتبارها “تحرراً”، والانحطاط باعتباره “فنّاً”، والخروج عن المألوف كأنه شجاعة، لا قلة حياء. في بدلة الرقص النسائية التي ارتداها «الممثل»، لم يكن الجسد وحده عارياً، بل كانت الرسالة أيضاً عارية من المعنى، عارية من أي إحساس بالمسؤولية تجاه مجتمع يتفكك، نحو أطفال ومراهقين يتخذون من نجوم الشاشات والمسرح مرآة لهويتهم. فما الذي يمكن لطفل في العاشرة أن يفهمه حين يرى “نجم الأكشن” و”الأسطورة” يرقص كراقصة مبتذلة على المسرح؟ وأي نوع من الرجولة يُعاد تصديره هنا؟ وأي مفاهيم تُزرع في اللاوعي الجمعي؟ * إن المشكلة ليست في حرية الفنان، فالفن الحقيقي لا يُربى في أقفاص، بل في غياب البوصلة القيمية. الفنان حين يعتلي المسرح، يعتلي قلوب الناس، ويتسلل إلى عقولهم، ويشغل وجدانهم. فإذا خان هذه المساحة، خان جمهوره. وإذا قرر أن يطل على الناس بلا مسؤولية، فليتحمل نتائج قراره، لا أن يتذرع بـ”حرية التعبير” ليخرب الذوق العام. لقد دخل كثيرون مثل هذا المغني الممثل، في سباق نحو قاع لا قاع له. سباق لا يحترم الفن، ولا الجمهور، خاصة أن ما يُبث عبر المسرح، أو التلفاز، أو وسائل التواصل، ليس ترفاً، بل هو تشكيل للوعي، وصناعة للقيم، وخلق لنماذج إنسانية يتبعها الملايين. * نحن لا نهاجم الأشخاص، بل نُحاكم الأفعال. لا نريد أن نصادر حرية أحد، لكننا نرفض أن تُغتال الحرية باسمها. نرفض أن يُصدر لنا نموذج مشوَّه عن الفن، عن الرجولة، عن الإنسان. نريد فناً يحمل همومنا، لا يسخر منها. نريد وجوهاً ترفعنا، لا تسحبنا إلى الأسفل. نريد فناناً يشعر أن على كتفيه عبء رسالة، لا مجرد عباءة لامعة وبذلة غريبة. ولن يخلد التاريخ من رقص على المسرح في ثياب الآخرين، بل من مشى على الجمر بقلبه. ولن يبقى في الذاكرة من صرخ بالألوان والابتذال، بل من همس بكلمة صدق في وجه الانهيار. ونحن، في زمن اختلط فيه كل شيء، ما أحوجنا لأولئك الذين يحمون نار الجمال من الريح، لا لأولئك الذين يرقصون حول رمادها.
1203
| 21 أبريل 2025
في لحظة صمت، وبين يديك كتاب مفتوح، يحدث أمر لا تراه، لكنه يمسّك بعمق. الكلمات التي سُكبت ذات يوم من عقل كاتب إلى حبرٍ على ورق، تبدأ فجأة بالحركة. لا تصدر صوتًا، لكنها تهمس. لا تمتدّ إليك بيد، لكنها تمسك بك. هناك، في ذلك الحبر اليابس، شيء حيّ، شيء قادر على أن يوقظك، أن يأخذك من مكانك إلى حيث لم تكن. الكتب ليست أشياء ميتة تُصفّ على الرفوف. ليست فقط أوراقًا مربوطة بين غلافين. الكتب أشياء تصنعنا، تعيد ترتيبنا من الداخل، تمنحنا عيونًا إضافية نرى بها العالم، وصوتًا داخليًا نُراجع به أنفسنا. من يظن أن القراءة مجرّد عادة ثقافية، لم يقرأ كتابًا غيّره. لم يشعر بتلك الرعشة التي تأتي فجأة عندما تصادف جملة كأنها كُتبت لك وحدك. جملة تضع إصبعها على ندبة في روحك لم تكن تعرف أنها موجودة، ثم تخبرك بهدوء أنها تراها. والكتب هي الشيء الذي نلجأ إليه لا لننسى العالم، بل لنفهمه. نقرأ لنعرف كيف يحبّ الآخرون، كيف يخسرون، كيف يصمدون، كيف يعيشون. نقرأ لنجد تشابهات غريبة بيننا وبين من لم نرهم، ولنشعر أن هذا الاتّساع البشري فيه شيء منا، وأننا لسنا وحدنا في هذا الركض المتعب نحو المعنى. منذ أول قصة سمعناها في الطفولة، بدأ شيء فينا يتشكّل. الطفل الذي يُنصت لحكاية قبل النوم لا ينتظر نهاية سعيدة فقط، بل ينتظر أن يرى نفسه في البطل، أن يتعلم شيئًا عن الشجاعة أو الحيلة أو الحزن. تلك البذور الصغيرة من القصص تنمو معنا، وتتحوّل إلى أشجار ضخمة من الخيال والفهم. وحين نكبر، تصير الكتب مرآة نراجع بها ملامحنا الداخلية، ونحاول بها فهم ما لا يُفهم بسهولة؛ لماذا نشعر كما نشعر؟ لماذا نفعل ما نفعل؟ من نحن أصلًا؟ كل كتاب جيّد هو رحلة. ليس لأنك تنتقل من فصل إلى فصل، بل لأنك تُسافر داخل نفسك. تقرأ شيئًا عن الحب، فتتذكّر من أحببت. تقرأ عن الفقد، فيرتجف قلبك لأحدٍ لم يعد موجودًا. تقرأ عن حلمٍ صغير لأحدهم، فيُوقظ هذا الحلم شيئًا نائمًا فيك. الكلمات تصبح خيوطًا تمتدّ إلى داخلك، وتربطك بأجزاء من نفسك نسيتها أو خفت أن تراها. وهناك سحر خفيّ في الكتب لا يمكن تزييفه؛ أن تقرأ فكرة عميقة عبّر عنها شخصٌ مات قبل مائة عام، وتجد أنها تعبّر عنك الآن. هذا العبور الزمني هو المعجزة الحقيقية. أن نصبح أكثر فهمًا لزمننا من خلال كلمات كُتبت في زمن آخر. أن ننجو من لحظات الوحشة بفضل من كتبوا قبل أن نُولد، وكأنهم تركوا لنا كلماتهم في زجاجة تطفو على بحار الزمن، تنتظر أن نلتقطها. * أنا لا أؤمن بأن الكتب تغيّر العالم بشكل مباشر. لكنها تغيّر القارئ، وهذا يكفي. لأن القارئ المختلف يذهب إلى العالم بطريقة مختلفة. يفكر، ويشعر، ويحلم بطريقة أخرى. ومن هنا تبدأ التغييرات الحقيقية من داخل الفرد، ومن عمق التجربة التي يعيشها حين يقرأ شيئًا يهزّه. بعض الكتب لا تُقرأ مرة واحدة. نعود إليها كما نعود لأماكننا المفضلة. نُعيد اكتشافها، أو نكتشف أننا نحن من تغيّرنا. وما كان يبدو عاديًا صار يمسّ القلب، وما كان عميقًا أصبح أوضح. هذه العلاقة المتحركة مع الكتاب تجعله أكثر من مجرد مادة للقراءة. تجعله صديقًا، شاهدًا على مراحلنا، مرافقًا في صعودنا وهبوطنا. لكن الكتب لا تمنحنا أجوبة نهائية، بقدر ما تمنحنا طريقة أذكى لطرح الأسئلة. تعلمنا أن الحياة ليست وصفة جاهزة، وأن كل إنسان يكتب قصته بنفسه. تعلمنا أن نكون أكثر رحمة بأنفسنا، وبالآخرين. أن نرى الجمال وسط الفوضى، وأن نبحث عن الحقيقة، لا لنمتلكها، بل لنفهمها ونعيش بقربها. من الحبر خرج الحلم. ومن بين السطور خرجنا نحن. أكثر وعيًا، أكثر صدقًا، وأكثر قدرة على احتمال هذا العالم الغريب. فالكتب لا تصنعنا من جديد، بل تُعيدنا إلينا.
735
| 14 أبريل 2025
الكتابة ليست مجرد حروفٍ تُسَطَّر على الورق أو على الشاشة، بل هي معركةٌ يخوضها الكاتب مع نفسه، مع أفكاره، مع العالم. إنها النور الذي ينبعث من قلب الظلام، والجرح الذي ينزف ليمنح صاحبه نوعًا من الراحة. الكاتب الأوروغوياني إدواردو غاليانو اختصر هذه الرحلة العجيبة في عبارة واحدة: “الكتابة تُتعب، ولكنها تواسي”، وكأنه يصف ذلك الشعور المتناقض الذي يعرفه كل من جرب أن يسكب روحه على الورق. إنها عملية استنزاف، لكنها أيضًا شفاء؛ ألمٌ، لكنه يحمل في طياته عزاءً لا يمنحه شيءٌ آخر. أن تكتب يعني أن تنظر إلى العالم بعينٍ ثالثة، عينٍ لا تكتفي برؤية الأشياء، بل تلامس جوهرها، تلتقط التفاصيل التي يغفل عنها الآخرون، وتعيد تشكيلها بلغةٍ قادرة على اختراق القلوب. لكن هذا الامتياز ليس بلا ثمن. الكتابة فعلٌ مرهق، ليس فقط لأنها تستنزف الفكر والمشاعر، بل لأنها تتطلب الغوص عميقًا في الذات، مواجهة المخاوف والشكوك، الحفر في الذاكرة، واستدعاء اللحظات التي ربما حاول الكاتب نسيانها. كل كاتب يعرف ذلك الشعور المزعج حين تتزاحم الأفكار في رأسه لكنه يعجز عن ترجمتها إلى كلمات، حين يكون المعنى واضحًا في داخله لكنه يتعثر في التعبير عنه، حين يشعر أن اللغة خانته وأن الكلمات لا تليق بما يريد قوله. تلك المعاناة لا يفهمها إلا من اختبرها. ومع ذلك، لا يتوقف الكاتب عن الكتابة، وكأن شيئًا ما في داخله يدفعه إلى الاستمرار، رغم التعب، رغم الإرهاق، رغم الإحباطات المتكررة. لكن لماذا نكتب إذن، إذا كانت الكتابة بهذا القدر من المشقة؟ ربما لأننا لا نستطيع التوقف. ربما لأن الكتابة ليست مجرد فعل، بل هي حاجة، غريزة، طريق وحيد للخلاص. الكاتب الحقيقي لا يكتب لأنه يريد ذلك فحسب، بل لأنه مضطر، لأنه لو لم يكتب، لاختنق بما يحمل في داخله. الكتابة تمنحنا القدرة على إعادة تشكيل العالم وفق رؤيتنا، على ترتيب الفوضى، على خلق معنى من العبث، على تحويل الألم إلى شيءٍ أجمل، أكثر قابلية للتحمل. لكنّ الكتابة ليست مجرد منفذ للألم، هي أيضًا عزاء. ثمة راحة غريبة في القدرة على تحويل المشاعر إلى كلمات، في تحرير ما يعتمل في الداخل وإلقائه على الورق، في الشعور بأن ما نكتبه قد يلمس شخصًا آخر، قد يواسيه، قد يخبره أنه ليس وحده في هذا العالم القاسي. الكلمة المكتوبة أشبه بيدٍ تمتد في الظلام، تربت على كتف القارئ وتخبره أن ثمة من يشعر مثله، من يفهمه، من مرّ بنفس ما مرّ به. ولذلك، رغم التعب، رغم الألم، يواصل الكاتب الكتابة. يواصل حتى عندما يبدو الأمر بلا جدوى، حتى عندما يشعر أن كلماته لا تساوي شيئًا، حتى عندما يتسلل الشك إلى قلبه ويقنعه أن كل ما يكتبه تافه. لأنه يعلم، في أعماقه، أن الكتابة ليست مجرد كلمات تُكتب، بل هي حياة تُعاد صياغتها، جراح تُشفى، وأرواح تتلاقى عبر الحروف. ولعل أعظم ما في الكتابة أنها تمنح الكاتب نوعًا من الخلود، فهي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الإنسان أن يتحدى الزمن، أن يترك أثرًا يستمر بعد رحيله. الكلمات المكتوبة تظل قائمة، تتنقل بين الأجيال، تقرأها أعين لم تولد بعد، وتتردد أصداؤها في قلوب لم تخفق بعد. قد يرحل الكاتب، لكن كلماته تبقى، تواسي آخرين لم يعرفهم يومًا، وتمنحهم القوة والدفء في أوقاتٍ لم يكن يتخيلها. إنها هدية غير مشروطة، شهادة على أن الإنسان، رغم هشاشته، قادر على أن يترك بصمة لا تمحى، مجرد جملة واحدة قد تنير ظلام شخص ما، وقد تكون الكلمة الأخيرة التي كتبها الكاتب هي البداية لشخص آخر. غاليانو كان محقًا؛ الكتابة تُتعب، لكنها تواسي. ولعلها التعب الوحيد الذي لا نستطيع، ولا نريد، أن نتوقف عنه.
402
| 07 أبريل 2025
ليس مجرد مناسبة تتكرر، بل هو شعور متجدد ينبض بالحياة في كل عام، ليلةٌ تسبق صباحًا مغمورًا بالنور والبهجة، لكنها أيضًا ليلة تستحضر كل ما مضى، ليلةٌ تلامس القلب كما لم تفعل أي ليلة أخرى. حين يتسلل المساء ببطء، ويبدأ الناس في تجهيز ملابسهم الجديدة وتحضير أطباق العيد، هناك شعور دفين ينمو في زوايا الروح، إحساس يشبه المزيج الغريب بين الفرح والحنين، وكأن القلب يحتفل بيد، ويمسح دمعة بيد أخرى. ليلة العيد ليست مجرد لحظة انتظار، بل هي فصل كامل يمر سريعًا في الظاهر، لكنه يحمل في طياته أعمق المشاعر الإنسانية. إنها ليلة تنبعث منها روائح الطفولة، حيث نسمع في دواخلنا أصوات الضحكات القديمة. في هذه الليلة، يضجّ المنزل بالحركة، الأطفال ينامون بصعوبة، والبالغون ينهمكون في الترتيبات، لكن في خضم هذه الضوضاء، هناك صمت داخلي لا يحس به أحد، إلا أولئك الذين عرفوا كيف يكون العيد حين ينقص منه أحباب كانوا بالأمس معنا. نستيقظ فجرًا، نفرح بالملابس الجديدة، نتبادل التهاني، لكن هناك لحظة صامتة تمرّ بين كل هذا، حين نلتفت إلى المكان الذي كان يشغله شخص عزيز لم يعد هنا. في العيد، لا تغيب الأرواح التي فارقتنا، بل تحضر بقوة أكبر. ربما نشعر بأطيافهم في زوايا البيت، أو نسمع أصواتهم في أغانينا المعتادة، أو نشتم عطرهم في ثنايا الهواء. العيد يعيد تشكيل الذكريات، يبعثرها أمامنا، لنلتقط منها ما نستطيع، ونخفي الباقي في زوايا القلب التي لا يصلها أحد. ومع ذلك، فإن العيد يظل بهجة لا يمكن إنكارها، بهجة تمتزج بالدموع لكنها لا تختفي، كأنها ترقص على إيقاع الذكريات، لا تفقد بريقها رغم كل شيء. حين نجلس حول «سفرة» الإفطار الأولى، حين نخرج إلى صلاة العيد، حين نستقبل التهاني، نشعر أن للحياة إيقاعًا لا يتوقف، وأن الغائبين يعيشون في تفاصيلنا الصغيرة، في ضحكة طفل، في يد حانية تمتد لمصافحتنا، في دعوة صادقة تُرفع للسماء. العيد يعلمنا أن الحنين لا يعني الحزن، وأن الغياب لا يعني النهاية. يعلمنا كيف يكون الفرح رغم الدموع، وكيف نبتسم حتى حين تختنق أرواحنا بالشوق. فكل عيد هو وعد جديد بأن الحب لا يموت، وأن الذين تركونا تركوا جزءًا منهم فينا، يظهر في ليلة العيد، ليبتسم لنا مرة أخرى، ولو عبر دمعة هاربة. وفي ليلة العيد، حين يخفت ضجيج الاستعدادات ويهدأ كل شيء للحظات، نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع ذاك الشعور الغريب الذي لا اسم له. ذلك الإحساس الذي يجعلنا نطيل النظر إلى صور قديمة، أو نعيد الاستماع إلى أصوات محفوظة في ذاكرة القلب، أو نسرق لحظة صمت وسط الزحام لنخاطب الغائبين بصوت لا يسمعه أحد. نخبرهم أننا افتقدناهم هذا العام كما في كل عام، وأن العيد بدونهم يظل ناقصًا مهما ازدانت الأجواء بالفرح. لكننا في الوقت نفسه نوقن أنهم لم يرحلوا تمامًا، فهم يسكنون في دعوات الأمهات عند الفجر، وفي لمعة العيون حين نذكر أسماءهم، وفي ذلك الحنين الذي يمنح العيد طعمه المختلف، طعم الفرح الممتزج بشيء من الشوق، بشيء من الدمع، وبكثير من الحب الذي لا يموت. ويبقى العيد مناسبة تحمل في طياتها الأمل رغم كل شيء. نرجو أن يكون عيدًا مليئًا بالفرح والسكينة لكل القلوب المتعبة، وخصوصًا لأهلنا في غزة، الذين يقاومون الألم بقلوب تنبض بالحياة. لعل العيد يحمل لهم نورًا يمسح شيئًا من جراحهم، ويفتح لهم أبوابًا جديدة من الرحمة والفرج. كل عام والجميع بخير، وأملنا أن يأتي العيد القادم وقد تبدلت الأحوال إلى ما هو أجمل وأعدل.
513
| 31 مارس 2025
"الحياة حلوة، بس نفهمها".. كما تقول كلمات الأغنية القديمة. عبارة تختصر فلسفة بسيطة لكنها عميقة: الحياة مليئة بالجمال، ولكننا أحيانًا نعجز عن إدراكه، نفقد لحظات من السعادة والسلام لمجرد أننا لم نفهم المعنى الحقيقي للحياة. إن فهم الحياة لا يعني بالضرورة الوصول إلى إجابات لكل الأسئلة الكبرى، أو العثور على تفسير واحد لأسرار الوجود. بل هو ببساطة أن نفتح أعيننا على جمال التفاصيل الصغيرة، أن نقدر قيمة الأشياء التي تحيط بنا كل يوم، وأن ننظر إلى تحدياتنا بطريقة مختلفة. في كثير من الأحيان، نرى الحياة من زاوية ضيقة تجعلنا نركز على المشكلات والمعوقات، ونغفل عن لحظات الفرح التي يمكن أن نجدها حتى في أبسط الأشياء. فالحياة ليست مجرد سلسلة من الأيام والليالي التي تمر علينا، بل هي رحلة ذات طابع خاص، مليئة بالتجارب والدروس. أن نفهم الحياة يعني أن نعيش بتوازن، أن ندرك أن للحزن نصيبه، وللفرح نصيبه أيضًا، وأن هذه الثنائية هي التي تجعلنا نقدر قيمة كل لحظة. حين نتقبل أن هناك أوقاتاً صعبة وأخرى سعيدة، نصبح أكثر انسجامًا مع إيقاع الحياة. نتعلم ألا نحارب الزمن، بل أن نستمتع بما يقدمه لنا، حتى وإن بدا في بعض الأحيان قاسيًا أو مليئًا بالتحديات. وإذا تأملنا أكثر، نجد أن الحياة تقدم لنا دروسًا كثيرة. قد تكون هذه الدروس في صورة أشخاص نلتقي بهم، تجارب نمر بها، أو لحظات خاصة نستشعر فيها معنى أعمق للأشياء. نحن نعيش في عصر يتسم بالسرعة والتوتر، حيث يلهث الكثيرون خلف أهداف مادية أو أمان بعيدة. لكن أحياناً، كل ما نحتاجه هو لحظة تأمل، لحظة نستمع فيها إلى أنفسنا، ننصت لصوتنا الداخلي، ونسأل؛ ماذا نريد حقًا؟ ما الذي يجعلنا نشعر بالسلام الداخلي؟ حين نبدأ في فهم أنفسنا، نصبح قادرين على فهم الحياة بشكل أعمق. الحياة حلوة فعلاً، لأنها تمنحنا فرصًا لا تُحصى، وتجدد أمامنا الأمل، وتفتح لنا أبوابًا جديدة حتى بعد الأزمات والانكسارات. فكل تجربة نخوضها، مهما كانت مؤلمة، تضيف إلى نضوجنا وتجعلنا أقوى. وإذا نظرنا إلى الحياة بهذه النظرة المتفائلة، سنجد أننا نتذوق طعم الحلاوة في كل يوم، ليس لأن الحياة خالية من الصعوبات، بل لأننا أصبحنا نفهمها، ونفهم أنفسنا معها. الحياة تصبح أكثر حلاوة عندما نبدأ في تقدير الأشياء البسيطة؛ فنجان قهوة في الصباح، ضحكة صديق قديم، لقاء عائلي دافئ، أو حتى لحظة صمت نتأمل فيها غروب الشمس. إن فهم الحياة لا يتطلب منا سوى أن نتخلى عن ضغوطنا للحظات، أن ندع مخاوفنا جانبًا، ونعيش الحاضر بكل ما فيه من جمال. الحياة حلوة، حين نسمح لأنفسنا بأن نتذوقها، أن نعيشها بعيدًا عن التوقعات المثالية، بعيدًا عن الركض المستمر لتحقيق النجاح المادي. نحن من نصنع طعم الحياة. فحين نفهم أن السعادة لا تكمن في امتلاك كل شيء، بل في الاكتفاء بما لدينا، نصبح أكثر امتنانًا وأقل قلقًا. الحياة لا تنتظر أحداً، وكل لحظة تمر هي فرصة جديدة لنكتشف فيها شيئًا جميلاً. ربما يكمن سر الحياة في البساطة، في عيش اللحظة، وتقدير النعم الصغيرة التي نملكها. فالحياة حلوة، نعم، لكن بشرط أن نفهمها، وأن نتعلم من تجاربها، وأن نُدرك أن قيمتها ليست في طولها، بل في عمقها، ليست في كمية الأيام، بل في نوعية اللحظات التي نعيشها. وحين نصل إلى هذا الفهم، نكون قد بدأنا نكتشف الجمال الحقيقي في الحياة، ونبدأ في تذوق حلاوتها، بكل ما فيها من تناقضات وألوان.
603
| 24 مارس 2025
ثمة صوت داخلي ينادي بلا لغة، يرتفع نحو اللاحدود، ويتلمس في الغيب رحمةً لا تُرى ولكنها تُحس. الدعاء، ذلك السر الخفي الذي يربط الأرض بالسماء، ويمنح الإنسان طمأنينةً لا يفهمها إلا من ذاقها. الدعاء ليس مجرد كلمات تتناثر في الهواء، ولا طقوساً تُمارَس حين تعجز الحيلة. إنه يقين يتجلى في هيئة رجاء، ونداء محمّل بالأمل، وتسليم يشبه ارتخاء الأعضاء بعد عناء طويل. لحظة الدعاء هي اللحظة التي يكشف فيها الإنسان ضعفه، لا ليُهان، بل ليُحتضن، ليُقَال له: لست وحدك. في فلسفة الدعاء، لا يكون السؤال بقدر ما يكون الاعتراف. الدعاء في جوهره إقرارٌ بأن للكون ربًّا يُدبّر أمره، وأن الحكاية مهما التوت فصولها، فإنها تسير وفق حكمة أعظم من أن يُدركها عقل محدود. حين يرفع الإنسان يديه، فهو في الحقيقة يرفع عن قلبه عبء التفسير، ويُسلم أمره لمن وسِعت رحمته كل شيء. لهذا كان الدعاء طمأنينةً قبل أن يكون رجاء، وكان عبادةً قبل أن يكون طلباً. كم مرة نادى القلب في لحظة ضيق، فوجد الراحة قبل أن يأتي الفرج؟ كم مرة سالت دمعةٌ في سجدة، فغسل الله بها كدراً عالقاً في الصدر؟ ليس لأن المشكلة قد حُلَّت حينها، بل لأن الطمأنينة سبقت الحل، واليقين سبق العطاء. إن سر الدعاء ليس في استجابة سريعة تلغي المحنة، بل في ذلك الشعور العميق بأن هناك من يسمعك، من يفهمك، من يرى انكسارك ولا يتركك وحيداً فيه. واليقين بالله هو الروح التي تمنح الدعاء معناه. لا يدعو الإنسان وهو يشك في الإجابة، ولا يناجي وهو في قلبه تردد. الدعاء ليس اختباراً، وليس مقامرةً مع الأقدار. إنه إيمان مطلق بأن الخير قادم، حتى لو لم يكن كما تخيلناه. ولهذا كان أعظم الدعاء ذلك الذي يقترن بالتسليم: «إن لم يكن بك غضبٌ عليَّ فلا أبالي»، «افعل بي ما أنت أهله، لا ما أنا أهله»، «إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين». هذه الكلمات ليست مجرد توسّلات، إنها انغماسٌ في الحكمة الإلهية، واستغراقٌ في الطمأنينة التي تجعل الإنسان يرى حتى في المنع عطاءً، وحتى في الألم رحمةً. ليست كل دعوة تُستجاب كما نريد، ولكن كل دعوة تُسمع. وما من يدٍ رُفعت إلا وأمسكتها رحمة الله بطريقةٍ ما. ربما يمنحك الله ما طلبت، وربما يمنحك أفضل منه، وربما يصرف عنك شراً لم تكن لتراه، وربما يدّخر لك الإجابة لساعةٍ تكون فيها أشد حاجة. في كل الأحوال، الدعاء لا يضيع، ولا يذهب هباءً، ولا يعود صاحبه خائباً. كيف يخيب من قرع باب الكريم؟ والدعاء ليس مجرد وسيلةٍ لطلب المفقود، بل هو صلةٌ يومية، حديثٌ ممتد، علاقة دائمة بين العبد وربه. ليس شرطاً أن يكون في لحظة يأس، وليس من العدل أن نطرق بابه فقط حين تضيق بنا الحياة. الدعاء هو الامتنان حين تُعطى، والثناء حين تُوفّق، والتسليم حين لا تفهم، والحب الذي لا يتغير مهما تبدلت الظروف. حين يدعو المرء، فهو لا يغيّر القدر، لكنه يتغير معه. يصبح أكثر اتساعاً، أكثر هدوءاً، أكثر قدرةً على مواجهة الأيام بقلب مطمئن. يعرف أن في السماء رباً لا يخذل من رجاه، ولا يرد من دعاه، ولو بعد حين. ولهذا، يبقى الدعاء هو الوعد الدائم بأن الحياة، مهما اشتدت، تظل في يد الرحيم، وأن كل همّ، مهما ثقل، يذوب حين يلامس رحمة الله.
606
| 17 مارس 2025
مساحة إعلانية

عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب...
15105
| 08 فبراير 2026

يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة،...
1449
| 10 فبراير 2026
لم يكن الطوفان حدثًا عابرًا يمكن تجاوزه مع...
813
| 10 فبراير 2026

تعكس الزيارات المتبادلة بين دولة قطر والمملكة العربية...
624
| 05 فبراير 2026

لقد طال الحديث عن التأمين الصحي للمواطنين، ومضت...
615
| 11 فبراير 2026

يشهد الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة حالة مزمنة...
552
| 09 فبراير 2026

منذ إسدال الستار على كأس العالم FIFA قطر...
513
| 11 فبراير 2026

راقب المشهد في أي مجمع تجاري في عطلة...
498
| 12 فبراير 2026

لم يعد هذا الجهاز الذي نحمله، والمسمى سابقاً...
498
| 09 فبراير 2026

لم يكن البناء الحضاري في الإسلام مشروعا سياسيا...
483
| 08 فبراير 2026
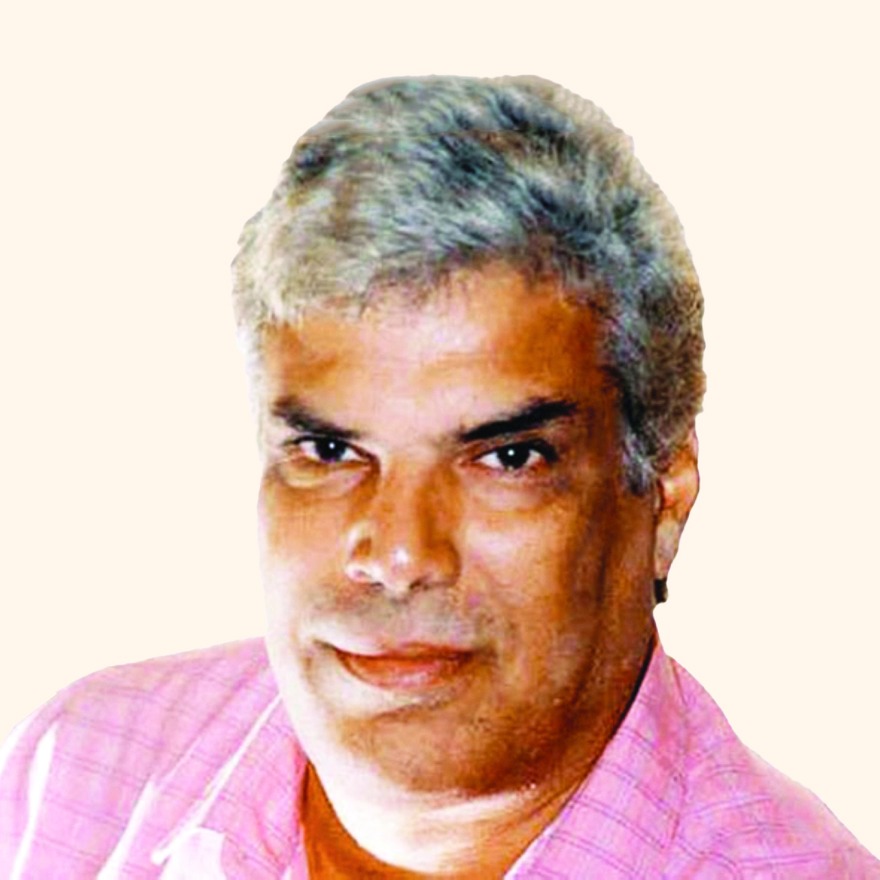
«الآخرة التي يخشاها الجميع ستكون بين يديّ الله،...
447
| 05 فبراير 2026

يستيقظ الجسد في العصر الرقمي داخل شبكة دائمة...
438
| 10 فبراير 2026
مساحة إعلانية







