رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تقول العربُ: "التعلُّم في الصِّغر، كالنقش على الحجر. والتعلّم في الكِبَر كالحرث على الماء" الأول ثابتٌ دامغٌ، والثاني زائلٌ كما يُمحى ما تخطه بعصا على صفحة الماء. وأختلف مع الحكمة الشهيرة. فليس من سنّ محددة ليتعلّم الإنسانُ معارفَ جديدةً. إن الوقت المناسب للتعلّم هو كاملُ المدة التي يقضيها الإنسان فوق الأرض، يعني كامل عمره. لهذا يقولُ الإنجليز: Never too late to lear، لم يَفُتِ الوقتُ أبدًا للتعلُّم. والحقُّ أن الغرب يُطبّق هذه القاعدة بإتقان. فلا نندهش حين نطالعُ في صحف الغرب أخبارًا عن عجائزَ ذهبوا ليتعلَّموا فنونًا ومعارف جديدة. مثل التي ذهبت لتتعلم التطريز وفنَّ تنسيق الزهور وهي في الثمانين، أو ذلك الذي راح، في السبعين، يتدرَّب على رياضة تسلّق الجبال، أو تلك التي قررت العزْفَ على البيانو في التسعين، أو الزوجين المُسنّين اللذين قررا أن يجوبا العالم على دراجتيهما، وغيرهم الكثير! أخبارٌ لم تعد تدهشنا، من فرط تكرارها. أما نحن العرب، فلدينا ميراث مضادّ ضخمٌ، يُقصِر التعلُّمَ على المراحل العمرية الأولى، ويسخرُ من طلب العلم في الكِبَر! كأن المعرفة كمٌّ محدود من المعلومات في حقيبة، يفتحها الصغيرُ في سنواته الأولى ليرى ما بها، ثم يغلقها ويرميها في النهر! ومثل ذلك المَثَل المصري (المحبط): "بعد ما شاب، وَدّوه الكُتّاب!" يعني: أبعدما وَخَطَ الشَّيبُ رأسَه، يذهب إلى الكُتّاب؟! والكُتّابُ مكانٌ يدرس فيه الصغارُ أصولَ اللغة والقرآن في القرى المصرية، قبل سنّ التعليم الإلزاميّ. لهذا ابتهجتُ كثيرًا حين قرأتُ عن الأردنية "فضّة" ابنة عام 1921، بيسان فلسطين، حين قرّرتْ أن تمحو أميّتَها وقد تخطّت التسعين عامًا! لتغدو، ليست وحسب أكبرَ طالبة على مقاعد الدرس في الأردن، ولا في العالم العربي، بل في العالم بأسره! ذكرت صحيفةُ "الدستور" الأردنية أن انحناء ظهرها تحت وطأة السنين، لم يمنعها من طلب العلم الذي حُرمت منه صغيرةً، في بداية القرن الماضي. تقول الجدّة فضة، إن حُلمَ القراءة والكتابة لم يبرحها مدى عمرها الطويل، إلا أن ظرفها المعيشيّ العسر، حالَ دون حلمها. ثم صحتْ ذات فجر وقد قررت أن تتعلّم، بعدما زارها حُلم ليلٍ رأت نفسها فيه تقرأ القرآن. ومع شعاع الشمس، توكأت على عصاها، ومشيت إلى مركز محو الأمية وسجّلت اسمها. كلَّ صباح، تذهب للدرس، ثم تعود البيت عصرًا، فتراجع دروسها مع أبناء أحفادها الصغار، وتُحضّر في المساء دروس الغد. والآن، وقد أتقنت القراءةَ والكتابة، تنوي الاستمرار في التعلّم مادام في العمر متسعٌ. ذاك إن نور العلم قد دخلها وتذوقت بهاءه، ولم يعد ممكنًا أن يحجبه عنها شيء. الأجمل من كل هذا، أنها تقوم كذلك بدور تنويريّ بتشجيع جاراتها المسنّات على التعلم، مثلها. تحية احترام لتلك المرأة التي خَطَتْ بحذائها فوق ثقافة بالية تدحضُ العزيمة، وتركن إلى الكسل والرضا بالمقسوم مادام العمرُ يركض نحو محطّته الأخيرة، وأعلَتْ، بدلَ ذلك، المثلَ الغربيَّ الذي يحثّ على العمل والعلم، مادام في العمر لحظة. لا تصدقوا أن للعمر خريفًا.
3488
| 17 أبريل 2013
هو الشِّعرُ إذن الذي يُلاشي الجغرافيات، ويحطّ رحالَنا هنا وهناك بين أرجاء الأرض، لنشاهدَ المدنَ، ونأتنسَ بالبشر والأمكنة والعادات والتقاليد. الشعرُ جاء بي من القاهرة لأزور "الدوحة" لأول مرة، وأشاهد هذه المدينة الوادعة في حضن الخليج، وتلك التجربة الحضارية التي تقول: إذا الحواضرُ يومًا أرادت أن تكون، كانت، مادام وراءها شعبٌ يتوق للبناء ورفع اسم الأوطان عاليًا. زيارةٌ خاطفة في معية الشعراء، وعلى شرف الشعر، في احتفالية وزارة الثقافة والفنون والثراث، والصالون الثقافي باليوم العالمي للشعر، وفي حضرة الربيع، بما أن الشعرَ ربيعُ الكلمة. ثلاثُ ليالٍ، زادت ليلةً، إذ فاتتني طائرةُ العودة إلى القاهرة. كانت الأبراج الشاهقة الأنيقة بمنطقة "الدفنة"، أول ما لفتني في طريقي من المطار إلى الفندق. ذكّرتني بأبراج منهاتن ونيويورك سيتي، فتوقفت أتأملها، وأسترجع ما درسته من قوانين البناء في قسم العمارة بكلية الهندسة، فاندهشتُ، إذ عرفتُ أنها مبنية على أرض كانت جزءًا من الخليج، تم ردمها، ومن هنا جاء اسمُ "الدفنة". منحتني الأيام الثلاثة التجوالَ في سوق "واقف" ومعرفة الأطباق القطرية الشعبية مثل "المرقوقة"، "الهريس"، "العصيد"، "الثريد"، البرياني"، وتأمل الفنار الكلاسيكي الجميل، وكذلك رحلة بحرية بالخليج الهادئ نظّمتها لي مجموعة من قرائي المصريين بقطر. أما الطائرة التي تركتني، فوفّرت لي فرصة التجول في الحي الثقافي لمشاهدة مركز الفنون البصرية، والمتحف، والمسرح المكشوف على نهج الأجورا الإغريقية، والمكتبة، والمسجد الأنيق، وبرج الحمام الساحر الذي ذكّرني بأبراج الحمام التي تملأ أرجاء الريف المصري. فاتني أن أزور أرض المعارض، كما فاتني التجوال داخل أروقة المتحف الإسلامي، وكذلك المدينة القديمة، أكثر ما يجتذبني في أي دولة أزورها. لهذا رحبتُ بهذه الزاوية بجريدة "الشرق"، التي اخترتُ لها عنوان "ريشة مصرية"، لتكون مصافحتي الأسبوعية للمواطن القطري، والوافد المصري والعربي المقيمين بقطر، نتبادل خلالها فكرة وجودية ما، أطروحة ثقافية أو اجتماعية أو أدبية، بعيدًا عن الشأن السياسي الذي أرهقنا جميعًا، لتكون مثل واحة نستريح فيها من هموم أوطاننا. "ريشةٌ مصرية"، العنوان الثابث الذي اخترته لزاويتي، لأي سبب اخترته؟ ربما هي "ريشةُ ماعت" ربّة العدل في الميثولوجيا الفرعونية. وربما هي "ريشة" يغمسها كاتبٌ في قارورة الحبر، فتخرجُ مُحمّلةً بالأفكار والروئ والحلم بإصلاح العالم. ربما هي "ريشة" طائر يجوب الأفقَ بحثًا عن الحقيقة البعيدة. وقد تكون "الريشةُ" فكرةً نائمةً في كتاب. تفتحه بنتٌ صغيرةٌ تحاول أن تعرف سرَّ الوجود؛ فتتلصص على أفكار الفلاسفة والمفكرين والعلماء الذين مرّوا فوق هذا الكوكب عبر ملايين السنين. تفتحُ أولَ كتاب وهي بعدُ صبيّةٌ نحيلة. وتمرُّ السنوات بها، لنطوي معها آلافَ الصفحات والكتب. وفي الأخير، تغلق آخرَ كتابٍ، وقد غدتِ الصَّبيةُ عجوزًا في الثمانين تعلن، مع طي الصفحة الأخيرة: "سرُّ الكون عَصِيٌّ، سِحرُه أنه لُغزٌ لا يُفضُّ أبدًا." كلَّ أسبوع، سألتقي بكم هنا لأضعَ ريشتي فوق طاولاتكم. مرّةً، ستكون الريشةُ كتابًا جميلا قرأتُه وأودُّ أن أشارك قرائي متعتَه. ومرّةً ستكون الريشةُ قصيدةً من الأدب الغربي، أترجمُها للعربية. ومرّةً ستكون الريشةُ فكرةً احتلّت رأسي، لأشاغبَ بها رؤوسكم، كنوع من "العصف الذهنيّ". "ريشتي المصريةُ" وردةٌ أصافحُ بها وجوهَكم، ونصافحُ بها الحياةَ العذبةَ المُعذِّبة. تعذبنا وتتعذبُ بنا، لكنها لا تبخلُ علينا، بشيء من الفرح، بين الحين والآخر.
810
| 13 أبريل 2013
لماذا نختلف عن بعضنا البعض كلَّ هذا الاختلاف؟ لماذا بعضنا ناجحٌ في حياته، وبعضنا يمشي في ركب الإخفاق والفلَس؟ لماذا بعضُنا محبوبٌ وبعضنا يفرّ منه الناس؟ هل هي أحكامٌ قَدريةٌ، مكتوبةٌ على جباهنا، حيث لا مهرب، أم أننا المسؤولون عن هذا، لأننا ببساطة نقف وراء الأسباب، ونحن صانعوها؟ الإجابة ببساطة: نعم! نحن مَن اخترنا أن نكون ناجحين أو فاشلين، محبوبين أو مُنفّرين، روّادًا في مقدمة الصفوف، أو مغمورين في ثنايا الظلّ. الأمر يعتمد على "لون" القُبّعة التي نضعها فوق رؤوسنا. يحدّثنا "إدوارد دي بونو"، الطبيب وعالم النفس المالطي في كتابه: "ستّ قبعات للتفكير"، حول أننا لا نتمايز في تركيب عقولنا، بل في آلية عمل هذه العقول. وحدد ستة أساليب مختلفة للتفكير البشريّ، ينهج كلٌّ منها نهجًا مغايرًا يؤدي، بالضرورة، إلى نتائج مختلفة. وأعطى "دي بونو" لكل طريقة سمات محددة، تجمع، تقريبًا، كلَّ طرائق تفكير العقل الإنساني. اعتبر دي بونو أن كلّ أسلوب من الأساليب الستة، هو بمثابة "قُبّعة" يرتديها المرء حينما يفكر في أمر ما. وإذن يكون لدينا قبّعات ست، ذات ألوان مختلفة. القبعة الحمراء، تمثّل التفكير العاطفيّ. فصاحب هذه القبعة يُسقط مشاعره، الإيجابية أو السلبية، الحب والكراهية، على الأمر، فلا ينظر للأمور نظرةً محايدة أو موضوعية. القبعة البيضاء هي نقيضُ ما سبق. فصاحبها ينظر إلى الأمور من خلال الأرقام والحسابات والتحليل فيخرج بنتيجة محايدة لا محلّ للعاطفة فيها، ولا مكان فيها للنظرة الشخصية. يشبه الحاسوب الذي لا يعطي نتائج إلا من خلال المعطيات والأرقام التي أدخلتها في برنامجه. القبعة الصفراء، يتميز صاحبها بالتفاؤل والإيجابية، حيث لا يرى إلا مزايا الأمر، غير مُنتبه، أو غير عابئ، إلى سلبياته. أما صاحب القبّعة السوداء، فهو نقيضُ ما سبق. سوداوي متشائم لا يرى في الشيء إلا عيوبه ونواقصه وعوائقه التي تُحول دون إتمامه. القبعة الخضراء تقفز بصاحبها إلى خانة الإبداع والتحليق. من يرتديها لا يعرف التفكير النمطيّ التقليدي، بل يكسر الصندوق وينطلق منه إلى رحب الابتكار والخيال، فيقترح زوايا جديدة للنظر ومن ثم طرائق جديدة للتأمل تؤدي بالضرورة إلى نتائج مبتكرة لا تخطر على بال سواه ممن يسيرون على قضبان المنطق والمحاكاة. أما القبعة الزرقاء فهي المظلّة الواسعة التي توجّه وترسم مسار كل القبعات السابقة. من يرتديها يمتلك نظرة شمولية تجعله يرى الأمور من منظور كُلّي واسع، ومنظم كذلك. يرسم خطّة العمل واضعًا الإستراتيجية العامة، والتكتيك التفصيلي لخطوات الأداء. يضع البرامج الزمنية وينصت إلى جميع الآراء ليفيد منها. ولكن دي بورنو لا يجعلنا نركن لليأس من إمكانية تغيير أساليب تفكيرنا. فمن يظن أنه مجبولٌ على قبعة واحدة يرتديها مدى العمر، قد أخطأ مقصد الكتاب. فبوسع كل منا أن يحوز القبعات الست، فيرتدي منها ما يشاء ويطرح ما يشاء. المهم ترتيب وضع القبعات. فمن الأفضل استخدام القبعة البيضاء في بداية تحليل الأمر، ثم الصفراء والسوداء لتأمل المزايا والعيوب، ثم الانطلاق للخضراء للقبض على جوهرة الابتكار، ثم الختام بالزرقاء، التي تعيد ترتيب الأوراق. شكرًا لله على معجزة: العقل.
2382
| 11 أبريل 2013
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
12801
| 20 نوفمبر 2025

وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام...
2463
| 16 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1770
| 21 نوفمبر 2025

شخصيا كنت أتمنى أن تلقى شكاوى كثير من...
1350
| 18 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1152
| 20 نوفمبر 2025

القادة العظام يبقون في أذهان شعوبهم عبر الأزمنة...
1134
| 18 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
960
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
909
| 20 نوفمبر 2025

الاهتمام باللغة العربية والتربية الإسلامية مطلب تعليمي مجتمعي...
894
| 16 نوفمبر 2025

نعيش في عالم متناقض به أناس يعكسونه. وسأحكي...
804
| 18 نوفمبر 2025

يُعد البيتومين (Bitumen) المكون الأساس في صناعة الأسفلت...
690
| 17 نوفمبر 2025
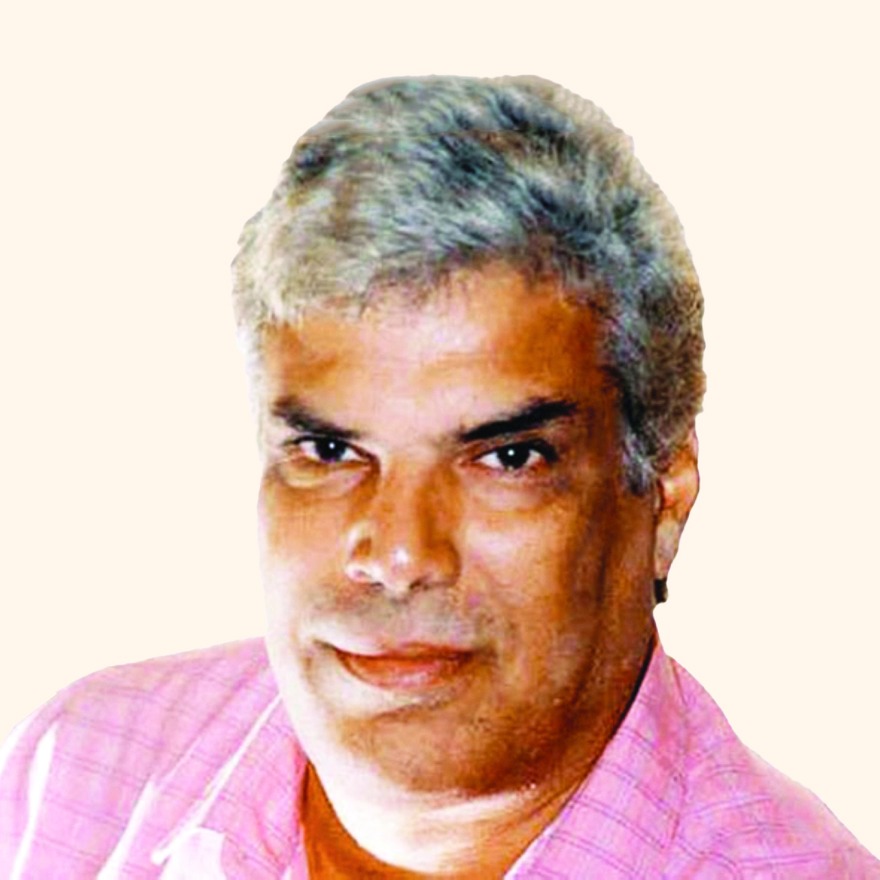
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
645
| 20 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية






