رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محددات مسار الحرب وخيارات جبهة المقاومة: كما كانت جبهة محاربة الفرنسيين في مصر مكونة من ثلاثة عناصر (المصريين، الأتراك، المماليك)، فإن جبهة محاربة الجنجويد ومن ورائهم الخارج في السودان الآن مكونة من عموم السودانيين والإسلاميين والجيش. مسار الحرب في السودان سيحدده اتفاق هذه المكونات على خيارها، فما هي خيارات هذه الجبهة؟ ذكرت في مقال حريق الخرطوم (13 و19 يوليو، الجزيرة نت) أن الجيش ظل يعاني لسنوات من مشكلة المشاة وهي مشكلة لا تنحصر على الجيش السوداني وقد عالجتها بعض الدول بتطوير قدراتها التقنية وبعضها بنظام جيوش الاحتياط وبعضها بغير ذلك. نحن في السودان استعنّا بالدفاع الشعبي واستنهاض عقيدة الجهاد في حرب الجنوب عندما جاء الإسلاميون إلى الحكم، ثم كونت الإنقاذ مليشيا الدعم السريع لمواجهة تمرد دارفور. الواقع الآن هو أن الجيش لا يستطيع مكافأة عدد الجنجويد ولا حماسهم للقتال كمرتزقة يقاتلون للغنيمة بينما جنود الجيش موظفو دولة لا تكفي رواتبهم الكفاف. ما الذي يدفع هذا للاستبسال في القتال؟ خيار الجيش هو في الاستنفار والتعبئة العامة. هذا يضع عقيدة السودانيين في الدفاع عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في مواجهة عقيدة اللصوص، والأولى تغلب. ولكن الحماس وحده لا يحل الإشكال، فالجيش سيحتاج لمن يقاتل مهاجماً الجنجويد حيث استقروا ولن ينفع أن يكتفي بالدفاع عما تبقى في أيديهم من السودان. هذا يجعل من عقيدة الجهاد والخبرة القتالية عند الإسلاميين ميزة كبيرة في كسب الحرب. وهنا تأتي مشكلة الجيش الثانية. فالبرهان (وآخرون)، وكما كان حال مراد بك مع الأتراك، يخشى أن يستعيد الإسلاميون القوة في البلاد للحد الذي دفعه لفتح البلاد بكاملها للجنجويد طمعاً أن يسحقوا الإسلاميين دون نظر إلى حال السودانيين في هذا الصراع. والذي حصل هو أن الجنجويد سعوا لسحق الجميع دون فرز بما فيهم البرهان نفسه، ولكنه رغم ذلك لم ييأس من عقد الصفقة. هنا يجد الجيش أنه تحت قيادة تضع في يديه الأغلال قبل أن تدفع به إلى المعركة ولعل البرهان يرسل الحطب إلى الجنجويد ليحرقوا الخرطوم حتى يستقر عرشه على رمادها! إن التزم العسكريون بطاعة البرهان قادهم إلى الهزيمة، وأغلبهم يعلم ذلك، فلم أبقوا عليه حتى الآن؟ كل الحجج التي سيقت في الصبر على البرهان لا ترجح الثمن الذي ندفعه كسودانيين من هذا الصبر، أيعقل أن يكون الإخلال بتراتبية الجيش أو التهمة بموالاة الإسلاميين أو ادعاء أن عزل البرهان فيه تحقيق هدف المليشيا أو ما سواها من حجج أفدح ثمناً من الانصياع لقائد متخاذل في معركة وجود! لا شيء ينبغي أن يعدل بقاء الوطن، ولكن يبدو أن العسكريين أساؤوا تقدير أمر البرهان كما أساؤوا تقدير مشكلة الدعم السريع من قبل حتى دخل عليهم الجنجويد من كل حدب ينسلون. وإن لم يعزموا أمرهم ويعزلوه فوراً، ولو من باب الحيطة إن تمسكوا بحسن الظن فيه، فسينتهي بنا وبهم الأمر كما انتهى بالمصريين الذين نقض كليبر عهده معهم بعد أن وعدهم بالعفو فنكَّل بهم. قدرة الإسلاميين على تغيير قيادة الجيش محل شك وهم بلا شك عاجزون عن محاربة الجنجويد وحدهم، ولكن إن كان في إمكانهم الضغط من أجل تغيير القيادة في الجيش أو قيادة المقاومة الشعبية وأحجموا خشية أن يقول الناس إنهم يطمعون في استعادة السلطة أو أن يعود الحصار الدولي على السودان فقد أساؤوا التقدير كالعسكريين. أخصب سنين الإنقاذ كانت تحت هذا الحصار المزعوم، ولو ظنّ الإسلاميون أن السودانيين يفضلون حكم الجنجويد على حكمهم فقد بلغ بهم الانهزام حداً بعيدا. الميزان الذي يقيس عليه العسكريون والإسلاميون الأمور الآن هو ذات الميزان الذي قاسوا به بينما البرهان وحميدتي يتعهدان المليشيا بالرعاية والانتشار كالسرطان في جسد السودان ظنّاً أن مقاليد الأمور ما زالت بأيديهم (العسكر والإسلاميون) وأن الصبر خير من التغيير، حتى استفحل أمر المليشيا ودفع السودانيون ثمن التردد وسوء التقدير. والوزن الصحيح للأمور الآن هو أن كل من بيده أن يسهم في النصر فعليه أن يبذل كل وسعه إلا إن كان في ذلك خطر أكبر من زوال السودان، وهيهات! عزل البرهان وأركان حربه من قبل قادة الوحدات والحاميات خير من انقلاب يشق الجيش. وشق الجيش خير من هزيمة مؤكدة تأتي بالجنجويد. بل إن تجاوز الجيش بالكلية والنهوض إلى مقاومة شعبية شاملة خير من حكم الجنجويد، وهذا خيار السودانيين إن تخاذل الجيش. أما الإسلاميون، فهم بعض قومهم غير أنهم أكثر خبرة ودربة على القتال، وإن حلفاً به جموع السودانيين الناهضين للدفاع عن أنفسهم وبلادهم وكتائب الإسلاميين وكل أو بعض الجيش لهو حلف جدير بالنصر! إن اتفقت مكونات جبهة المقاومة على طريق المقاومة حتى النصر، يبقى عليهم الاتفاق على أن كل حدود الصبر قد تجاوزها الحال، وهذا بيّن في النفرة الشعبية التي انتظمت صفوف السودانيين بعد سقوط مدني التي كانت حد صبرهم في إيكال الأمر إلى الجيش، وما صبر العسكريين على البرهان إلا تأخرٌ عن واجب الساعة. فإذا انتظمت هذه الجبهة في صف واحد بات ممكناً ترتيب أحلاف خارجية تتفق مع السودانيين على ضرورة هزيمة الجنجويد وإعادة السودان إلى الجادة، ولن يعوز السودانيون حليفاً ساءه تمدد الإمارات في أرضهم. ختاماً، فإن كتب التاريخ قد سجَّلت أعمال مراد بك المملوكي إبان الغزو الفرنسي في مصر كمثال للخيانات المخزية كما كان شأن يهوذا الاسخريوطي الذي خان المسيح وغيرهم ممن خان قومه أو وطنه. والتاريخ الآن يُكتب عن السودان في ساعة من أقسى ساعات العسرة على أهله، فلينظر أحدنا موطن قدمه!
1230
| 15 يناير 2024
يروي لنا الرافعي في كتابه (تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر) استهانة والي مصر المملوكي مراد بك خطر الحملة الفرنسية التي حذره منها القنصل النمساوي مسيو روسيتي إذ قال مراد بك بعد أن أغرق في الضحك «ماذا تريد من اخافتنا من الفرنسيين، ألم يكونوا أشباه الخواجات الذين كانوا بيننا؟ إنه ليكفيني إذا نزلوا إلى سواحل مصر في مائة ألف من رجالهم أن أبعث للقائهم بعض صغار المماليك ليقطعوا رؤوسهم بحد الركاب». وعزز الرافعي وصف هذا الحال بنقله تنديد الجبرتي ما كان من اهمال المماليك الاستعداد للقتال إذ قال «وليس لأحد من أمراء العساكر همة أن يبعث جاسوساً أو طليعة تناوشهم القتال قبل دخولهم وقربهم ووصولهم إلى فناء مصر، بل جمع كل من إبراهيم بك ومراد بك عسكره ومكث مكانه لا ينتقل عنه ينتظر ما يفعل بهم». هزم الفرنسيون المماليك الذين فرّ قادتهم إلى الصعيد وحل الفزع بسكان القاهرة عندما دخلها الفرنسيون. يقول الجبرتي إنه في تلك الليلة خرج معظم أهل مصر لبلاد الصعيد أو الشرق بينما أقام فيها المخاطرون والذين لا يقدرون على الحركة. ثم، وبعدما عاث الفرنسيون فساداً بقتل المصريين وانتهاك حرماتهم وسلب أموالهم وإخراجهم من بيوتهم، ثار المصريون ثورة قمعها نابليون بنيران المدافع. غير أن ثائرة المصريين لم تهدأ طويلاً إذ ثاروا مرة ثانية في القاهرة عندما كان الفرنسيون بقيادة الجنرال كليبر يقاتلون الجيش العثماني في عين شمس في مارس 1800. أبلى المصريون بلاءً حسناً في إقامة المتاريس والحصون في المدينة ما حدا بكليبر إلى التفكير في تجنب العنف المباشر لإخماد الثورة وفضل أن يستفيد من تعارض المصالح بين عناصر الثورة الأساسية: المصريون والأتراك والمماليك. وجد كليبر في مراد بك ضالته لأنه، كما يقول الرافعي، «كانت تتوق نفسه بعد ما حل به من الهزائم إلى مصانعتهم، ووقف وقفة الخائف الوجل عندما جردت تركيا حملتها الأخيرة على مصر لإخراج الفرنسيين. لأن مراد بك كان يشعر بأن تركيا إذا فتحت مصر بحد السيف وتمكنت من إخراج الفرنسيين منها، طمحت إلى التخلص من نفوذ المماليك». وقد ذكر الجبرتي أن مراد بك بدأ يمد حبال الود تجاه الفرنسيين منذ أن بدأ الأتراك تجهيز الجيوش لمقاتلتهم. أحجم مراد بك عن القتال مع الأتراك في عين شمس حتى قبل أن يوقع الصلح مع كليبر. وقد ذكر كليبر في مذكراته، بحسب الرافعي، أن مراد بك فضل أن يكتم أمر اتفاقه مع الفرنسيين الذي انعقد في أبريل 1800 ولكنه رغم ذلك أرسل أحد أتباعه إلى القاهرة «ليصرف المماليك عن الثورة ويدعوهم إلى النكوص على أعقابهم». خلص الاتفاق بين كليبر ومراد بك إلى أن يحكم مراد الصعيد تحت حماية الفرنسيين مقابل خراج يدفعه لهم. وقد بالغ مراد بك في الولاء للفرنسيين إذ أرسل إليهم فور توقيع الاتفاق الهدايا والغلال والمؤن، وسلمهم بعض العثمانيين اللاجئين إليه. بل إنه مضى شوطاً بعيداً في تلك الموالاة المخزية حيث إنه سعى حثيثاً في أن يضم المماليك في القاهرة إلى صفوف الفرنسيين، ولما أعيته الحيلة، يقول الرافعي، «أشار على كليبر بإضرام النار في القاهرة إخماداً للثورة!» وقد روي عن أحد الفرنسيين الذين شهدوا تلك الحوادث قوله «بعد أن تم التوقيع على معاهدة (كليبر – مراد) أرسل لنا مراد بك المؤن وسلم لنا العثمانيين اللاجئين إلى معسكره. وسعى لدى أعوانه في القاهرة لتسليم المدينة. لكنه رأى أن مسعاه لم يؤد إلى نتيجة سريعة فعرض علينا إحراق المدينة وأرسل لنا لهذا الغرض المراكب محملة أحطاباً». لعله كان بين المصريين الذين داستهم حوافر الخيل الفرنسية من ظلّ ينافح عن مراد بك حتى الساعة الأخيرة، لأنه يعسر عليه تصور أن يكون والي البلاد وقائد الفرسان خائناً. ولكن شهوة السلطان، التي وصفها الغزالي بأنها آخر ما يخرج من صدور الرجال، كفيلة بتفسير أخزى أفعال الرجال وأحقرها. والغفلة عن هذا في حال كحالنا في السودان اليوم هي عين الهلكة! وكما كانت جبهة محاربة الفرنسيين في مصر مكونة من ثلاث عناصر (المصريين، الأتراك، المماليك)، فإن جبهة محاربة الجنجويد ومن ورائهم الخارج مكونة من عموم السودانيين والإسلاميين والجيش. مسار الحرب في السودان سيحدده اتفاق هذه المكونات على خيارها، فما هي خيارات هذه الجبهة؟. «يتبع»
1239
| 13 يناير 2024
كان يوليوس قيصر، جنرال الجيش الروماني وقائد روما الأشهر، يمضي بثبات الى تحويل جمهورية روما الديموقراطية الى امبراطورية ديكتاتورية تحت سلطته المطلقة. رفض قيصر أمر مجلس الشيوخ الروماني(السينيت) له بالنزول عن موقعه العسكري والعودة الى روما فدخل روما بالسلاح وما لبث بعد حرب أهلية قصيرة أن سيطر عليها. لم يواجه قيصر سخطا شعبيا كونه نقض بناء الديموقراطية فقد كان عموم الرومان ساخطين على الطبقة السياسية باعتبارها طبقة من الارستقراطيين الفَسَدة بينما قيصر وهو صانع امجاد روما استهل عهده ب‘اصلاحات‘ نالت رضى الطبقات الدنيا. كذلك فقد تمكن قيصر من تدجين معظم مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يكون صاحب السلطة في روما. كان ‘الشيوخ‘ يتزلفون الى قيصر بالالقاب المجيدة فسموا عليه شهر يوليو و حاولوا أن يمنحوه لقب ‘الملك‘ الذي أباه مفضلا ‘قيصر‘. غير أن اصرارهم لم ينثنِ فمنحوه لقب ‘الديكتاتور الأبدي‘ (الديكتاتور تنطق في اللاتينية كما ننطقها في العربية اليوم ولذات الدلالة!) ليحكم روما الى الأبد. ولكن ليس كل السياسيين فسدة ولا كلهم دواجن في حضرة المستبد وروما لم تخل من أولئك. قام جماعة من الشيوخ أسموا أنفسهم ‘المحرّرون‘ بالتآمر لاسقاط القيصر وتحرير روما من طغيانه فدخلوا عليه في خلوة بعد أن دخل مبنى مجلس الشيوخ الذي لا يدخله حرسه وأنهالوا عليه طعنا حتى فارق الحياة. لم يكن ‘المحررون‘ بالضرورة خصوما لقيصر بل إن بعضهم كان من أصدقائه ومقربيه وأشهرهم بروتوس. والعجيب أن التاريخ ربط اسم بروتوس بالخيانة لكونه تآمر على قيصر الذي كان يأمنه ويثق به. لكن الواقع أن بروتوس كان منازَعا بين مبادئه التي يؤمن بها وهي الحرية والديموقراطية وبين حبه لقيصر وصلته به. حتى إنه يقال أن قيصر كان يقاوم بشراسة النصال التي تهوي على جسده ولكنه عندما رأى بروتوس بينهم انهار وأسلم نفسه بعد أن قال – حسب بعض الروايات التاريخية – ‘حتى أنت يا بني!‘ والتي حوّرها شكسبير الى المقولة الخالدة ‘حتى أنت يا بروتوس!‘. شكسبير نفسه في روايته ‘يوليوس قيصر‘ كان عاذرا لبروتوس حيث ألقى على فمه خطبة عصماء في مجلس الشيوخ بعد الاغتيال كان في آخرها ‘تعلمون أني كنت أحبه لكني أحب روما أكثر!‘ هذه القصة تحكي معضلة التنازع بين الولاء للصحبة وإعلاء أبوية القائد أو تقديم المبدأ على أي فرد مهما كان. هذه المعضلة التي جاهدها بروتوس وبعض رفاقه تصلح مدخلا للنظر في العلاقة المرتبكة الآن بين الرئيس البشير وتيار الاسلاميين في السودان. الاسلاميون، أين هم الآن؟ معلوم أن هذه المعضلة الاخلاقية لا يجاهدها أولئك ‘الاسلاميون‘ الذين أسلموا قيادَهم للبشير فلا يعارضونه ولو ضرب ظهرهم وأخذ مالهم، وإنما يجاهدها منهم من يرى أن الانقاذ هي مشروعهم الذي سُرق. وربما لا يرى حتى بعض هؤلاء خطلا في شخص البشير ولكنهم يرون خطلا في تقديره واختياراته لمن يوليهم الأمور بينما هم عاجزون عن تقويمه الى جادّتهم حيث لم يزل استبداده بالأمر في ازدياد. هذه الفئة من الاسلاميين بعضهم لم يزل في نظام الحكم حيث يرى أن الخروج لا يعدو أن يكون تسليما وأن الأجدى هو مجاهدة الأمر من داخله. البعض الآخر خرج عن النظام براءة منه واعتذارا عن أفعاله ثم عارضوه ونازعوه الأمر ولم يزالوا في ذلك بدرجات متفاوتة. ثم فئة هي سواد الاسلاميين الأعظم تركوا الحكم ومعارضته وفضلوا أن ينتظروا قضاء من السماء بينما هم يسلّون أنفسهم بالأنس في المجالس أو أولوا طاقاتهم مناحي أخرى في الحياة بعيدا عن السياسة. هذه الفئة لا تجمعها راية واحدة، ف ‘الحركة الاسلامية‘ صارت حركات وأظهرها الآن هي أضعفها على مَرّ تاريخها. الاسلاميون الآن لا تجمعهم الا فكرة عامة وغير واضحة عن أشواق لتحقيق رفعة أو نهضة للمسلمين وقد تناولنا اشكالات هذه الافكار في مكان آخر، ولكن الذي أود التأكيد عليه هو أن الاسلاميين في السودان الآن جماعة مبعثرة في انحاء الحياة بعد أن صدمتهم تجربة الحكم البائسة وشوّهت حتى تلك الاشواق الحالمة فلم تعد لها ملامح واضحة (لا زلت أتكلم هنا عن أولئك العاملين لتغيير النظام أو أحواله لا الذين توسَّدوا على عطاياه وركنوا اليه، هؤلاء يعملون لبقاءه لا زواله!). هذه الفئة موجودة في كل مكان في البلد كناتج طبيعي لسياسة التمكين التي اتخذها النظام منذ سنينه الأولى. فهم في بعض دهاليز النظام نفسه وفي مرافق الدولة المختلفة، ثم هم، بعد أن تركوا الأمر أو تُركوا، في المهن والمهاجر، بل هم حتى في السجون والصالح العام وفي القبور ظلما وعدوانا، شأنهم في ذلك هو شأن كثير من السودانيين السابقين لهم في المعاناة. هل بقي للاسلاميين بعد هذا التفرق من جامع؟ هل يجتمعون لاصلاح ما فسد باسمهم؟ الاسلاميون وإشكال الموضع السياسي هشاشة الحلف مع المعارضة: عندما قامت تظاهرات سبتمبر 2013 و أحس بعض الناس أن تغييرا ربما يقع في تلك المرة، بدأ بعض شباب التيارات المعارضة بتوعد الاسلاميين المعارضين بأنهم سيلاقوا ذات مصير الاسلاميين في السلطة وأنهم كلهم سواء للثائر المغبون. كثير من شباب الاسلاميين أحجم عن العمل في تلك الاحداث بعد هذا الوعيد حسب ما سمعت. صحيح أن العقلاء من المعارضة لا يشاركون في هذه الروح الانتقامية ولكن العقلاء ساعة التغيير صوتهم خافت. حيرة الاسلامي الذي سخط على الاستبداد وخرج ليغيره بما استطاع أنه محسوب عند الكثيرين كبعضٍ من النظام وإن بذل حياته ثمنا لتغييره، فما عساه أن يفعل؟ كثير من الاسلاميين المعارضين الذين دخلوا في أحلاف مع تيارات معارضة أخرى شعروا أن هذا الحلف شديد الهشاشة ولا يقيمه الا العدو المشترك، وأحيانا حتى قبل زوال هذا العدو تظهر الصدوع في هذه الاحلاف وربما تنهار تماما. ليس من المستغرب أن تجتمع تيارات مختلفة لتحقيق هدف مشترك ثم تعود هذه التيارات بعد تحقيق الهدف الى التنافس فيما بينها كما كانت من قبل. ولكن بعد سنوات من الاستبداد الطويل فان الغبن المتراكم سيغيب عن البعض القدرة على التمييز بين الخصم الذي تختلف معه وقد تحالفه أحيانا، والعدو الذي تحاربه. هذا يدفع الاسلاميين الى الابتعاد عن العمل مع المعارضة دون أن يعودوا الى النظام الحاكم (الا قليلا منهم!). ربما كان ما زهَّد الاسلاميين في العمل من أجل التغيير هو إحساسهم بأنهم سيخسرون في كل الاحوال وربما خسارتهم عند التغيير وحال انفلتت الأمور تكون أكبر. فشل المشروع الايديولوجي: بعض الاسلاميين لا يجد في نفسه اندفاعا لتغيير النظام كونه يشكل اعلانا بفشل المشروع الايديولوجي لهم. مشروع الدولة الاسلامية بالنسبة لهؤلاء هو الأساس الفكري الذي قامت عليه جماعتهم والانقاذ هي تجربتهم الأولى و ستكون، بعد ما ذاق السودانيون مرارتها، الأخيرة لوقت طويل اذا ذهبت هذه القائمة الآن (وأنا لا أعتبرها دولة اسلامية البتة!). لذلك فهؤلاء يرون أنه من الأفضل العمل على اصلاح هذه بأي وسيلة لأن ذهابها هو بمثابة وفاة للفكرة نفسها. هؤلاء يتمسكون بالسراب! فكلما زادت الدولة طغيانا واثما، كلما زادت في جراح فكرة الاسلاميين، فيزدادون تمسكا بها. تماما كالميت سريريا ويعيش على الالات فأهله لا يستطيعون أن يقيموه بعافية ولا تقوى قلوبهم على ايقاف الالات فيموت يقينا! سيكون من أعسر الأمور اقناع من أفنى عمره في سبيل فكرة ما أن الفكرة نفسها معتَلَّة. وقد يخشى بعضهم شماتة خصمه الفكري أكثر من أي شيء آخر! فكيف لمثل هذا أن يعدِل عن اسناد نظام ظالم بدعوى اصلاحه أو أن ينهى نفسه عن العزة بالإثم؟ ولو قبِل كل ذلك وبقى في بيته سيكون إخراجه لفعل ايجابي تجاه التغيير أعسر. صحوة الخلية النائمة: كم من الاسلاميين الآن ينافح عن الحق عن قناعة (بعضهم مسلوب القناعة، حتى اذا أحسن الفعل ففعله اتّباع)، لا يزعجه سابقةُ خطأه ولا شماتة خصمه ولا ارهاب المستبد، بل يمضي حيث ظنَّ الحق حتى يناله؟ ذلك صنف نادر. وتحويل جماعة الاسلاميين، التي لم تغرق تماما في مستنقع السلطة، من السلبية – بأسبابها المتعددة – الى هذا الصنف النادر هو بمثابة ايقاظ لخلية نائمة في قلب الدولة. ليس من الانصاف لكثير من غير الاسلاميين ممن بذل في سبيل التغيير الشيء الكثير وبعضه الدم، أن يُصَوَّر الحل لمشكلة السودان باعتباره حكرا على الاسلاميين. هذا يبخس الناس أشياءهم وبعضهم له في سبيل البلد تضحيات مشهودة. غير أن النظام القائم وخلال تاريخه المتطاول عمل جاهدا، وبنجاح هذه المرة، على تكسير عظم المعارضين حتى أقعدهم الى حد كبير. بعض قيادات المعارضة التي طالما طالتها سياط سخط السودانيين تستحق من السخط ما نالت، فأولويتها كانت ذاتية في الغالب وهؤلاء لا بواكي لهم. لكن الحق أن كثيرين آخرين وأغلبهم من الشباب أصابهم من ظلم النظام ورهقه الكثير وهم دائما في خطر منه ولكن هذا لم ينل من عزائمهم ولهم في مناهضة القهر بطولات مخفية. غير أن الواقع يجعل من مجاهدات هؤلاء الشباب وتضحياتهم أمواجا متكسرة على صخر صلب. لا زالت مناهضة النظام بحاجة الى عنصر اضافي ليمنحها اضافة نوعية تشكل العامل الفارق لفعل التغيير وأنا أزعم أن الجماعة الصامتة من الاسلاميين يمكن أن تسُدّ هذه الفجوة. هذا الحلف لا شك عسير التكوّن وأعسر في الاستمرار لتحقيق هدفه للعوامل التي ذكرناها سابقا والتي يتوزع اللوم فيها بين الفريقين. ولكن ما لم يتفق هؤلاء مع أولئك فلا تغيير يرتجى. كنت قد ذكرت في مقال سابق أن التغيير لا يمكن أن يتم دون الجيش، إما بفعله أو برضاه، ولكن الجيش، غير أنه قد طالته بعض أدلجة النظام وأنا أزعم أنها لم تفسد قوميته بعد فالعقيدة العسكرية شديدة الصلابة، فهو أيضا بطيء التحرك لتغيير الحكومات اذا لم يحس أن الشارع يفور بالحركة. الجيش يتدخل اذا أحس أن النظام الحاكم سيلجأ الى قتل الناس بالمليشيات والأمن للمحافظة على السلطة، وهذا رغم أنه قد بدأ شيئا ما في 2013 الّا أنه سرعان ما توقف قبل أن تتسع التظاهرات بالشكل الكافي. سيكون من سخرية الأقدار أن يكون هذا النظام المستبد هو نتيجة لتحالف الاسلاميين والعسكر، ثم يكون إخراجه أيضا بتعاون بين الاسلاميين والعسكر، ما أشد الشبه وما أكثر المباينة! المعضلة الأساسية هي ايجاد تلك الشعلة التي تحرك هذه الخلية النائمة من الاسلاميين، لأنهم لم يستقيلوا الأمر الا عن يأس عظيم. سيكون على الموالين منهم التغلب على وهم الاصلاح والاقرار أن هذا أوانه قد فات ولم يبق الا التغيير. سيكون على عموم الاسلاميين الاقرار بأن العلّة في مشروع الدولة الاسلامية تمتد جذورها حتى مستوى الفكرة الأساسية وأن المراجعات لا مناص لها من التنقيب حتى تلك الاعماق قبل أن تصل الى أصل المشكلة، وعلى هذا الأساس فإن مشروع الدولة الاسلامية القائم الآن ينبغي أن يُنقَض ففكرته خطأ وفعله خطيئة. كذلك ينبغي على الاسلاميين أن يَسموا فوق عصبياتهم الايديولوجية ولا يعتزلوا فعل التغيير مخافة أن يقفوا أمام خصومهم موقف المقرّ بالخطأ. لا بد أن يتجرّعوا تلك المرارة لأجل السودان، كما أن أقرانهم في التيارات الأخرى ينبغي أن يَسموا لمستوى التحدي ويحرّروا النفوس من الغبن والشماتة. اذا كانت المركب تغرق فخير للمرء أن يسد خرقها بدلا من أن يذكر الناس أنه حذرهم من الغرق! كذلك فإن الخروج عن نظام مستبد حتى في أوقات زنقته ليس قلةَ مروءة ولا قفزا من مركب غارق فالحق أحق أن يتبع ولو متأخرا، والاصرار على اسناد الظالم حين تشتد عليه العواصف ليس رجولة بل هو غاية الظلم. هذه الفئة من الاسلاميين تنقصها القيادة الملهِمة بعد أن تفرقت بهم مواعين السياسة. والتطلع الى قيادة ملهمة في عصر المؤسسات هو ردّة ورجوع، أنا أقرُّ بهذا، ولكنه في واقع الاسلاميين الآن حقيقة وليتهم يجدونها! لا شك أنه لو ظهر بينهم صاحب سابقة في الحركة يثقون في نزاهة يده وحسن تدبيره لبُعِثوا ملبّين كما يُبعث الأموات، فتلك الاشواق (على ما بها من علل!) لا زالت متّقدة في صدور غالبهم والأمل في اصلاح ما فسد باسمهم سيزيدهم حماسا وخروجا. ولكن أنّى لهم مثل هذه القيادة الآن؟! فكل الاسماء الآن تحمل تصنيفا وكل تصنيف يجرّ معه سخط الآخرين. رغم ذلك فالاسلاميون سيتعلقون بالأمل، وربما لو جروء أحدهم أو جماعة منهم على خطاب جديد يخرج عن خلافاتهم القديمة ويدعو الى ما قد يجمعهم، وباعتبار ما آل اليه حال البلد من خراب، ربما عندها يفلحون في الخروج كجماعة واحدة لها مهمة واحدة: تغيير النظام. حتى لو افترضنا أن هذا الأمر على عسره تحقق، فالنظام لن يتغير ببساطة. لقد أتقن البشير لعبة كسب الوقت فصار يلجأ الى تغيير الوجوه المستمر الهاءً لعموم الناس وممارسة للترغيب والترهيب للطامحين، فلا يزال يقيل اسما كبيرا ليعود بعد سنوات باسم كبير آخر فيترك الناس في شغل بصلاح هذا وفساد ذاك، متعاليا يهذا عن الملامة بينما هو الملوم الاول! لذلك فلا بد أن تصل الرغبة في التغيير الى أقرب الدوائر من السلطة الحاكمة الآن وتحديدا العسكريين. لا غرابة أن البشير كلما حَزَبَه أمر فزِع الى العسكريين في الجيش والأمن وغيرهم فهم موطن الحذر ومن بيده السلاح. هنا تظهر معضلة بروتوس. لا بد أن يُغَلّب بعض أصحاب النفوذ في الدولة من العسكريين والسياسيين حب البلد على حب القائد كما فعل بروتوس وأعوانه. غني عن القول هنا أن المقصود هو الضغط على الرئيس للتنازل أو إزاحته عنوة وليس الاغتيال كما فعل بروتوس والمحررون فهذا ليس شيمة السودانيين. وللأمانة فإن ما فعله المحررون لم يأت بخير على روما حيث اشتعلت فيها حرب أهلية ثم تحولت الى امبراطورية. ولكن للسودان سابقة في تعاون الجيش مع السياسيين نقلت البلاد من حكم نميري القهري الى الديموقراطية بأمان دون انزلاق في حروب أهلية ولا اقامة مقاصل ثورية للمايويين. عموم السودانيين ليسوا متحمسين للخروج هذه المرة بسبب البطش الزائد للنظام والخوف من النماذج في سوريا وغيرها. ولكن الواقع أنّ الضيق هذا ليس طارئا وسيزيد طالما بقي النظام. المسألة لا تعدو أن تكون وقتية قبل انهيار الحال الى وضع لا يحتمله الناس فيخرجون مفضلين الموت على القعود، عندها سيكون التغيير بالشكل الذي نخافه الآن ولات حين مناص! الاسلاميون هم من أدخل البلد في هذا المأزق وإنها لمسؤوليتهم أمام الله وأمام الناس أن يصلحوا ما أفسدوه باخراج هذا النظام من الحكم بشكل آمن وتسليم البلد الى أهلها. والعسكريون شأنهم في المسؤولية كشأن المدنيين. صحيح أن طاعة القائد قاعدة راسخة في العرف العسكري ولكن اذا تعارضت مع مصلحة البلد العليا فللقاعدة استثناء وعلى هذه المؤسسات ان تقدر الأمر بمسؤولية وفي الوقت المناسب. لقد اختلف الناس على فِعلة بروتوس والمحررون بين وصفها بالخيانة أو البطولة وربما يكون هذا مفهوما لأن قيصر كان رغم جبروته قائدا فذا ساهم في صناعة روما كاحدى أعظم الدول في التاريخ الانساني. ولكن ما بال هذا!!
4166
| 26 فبراير 2018
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); هناك ثلاث فئات من النخب التي يمكن أن تكون في طليعة أي حركة إصلاحية تنويرية في المجتمع: 1. النخبة المغلوبة: وهي نخبة معيارية حسب النموذج الذي قدمناه، بمعنى أنها استوفت معايير مميزة لها في المجتمع ولكنها لم تصل إلى موقع النخبة العليا التي تبتغيها، هذا قد يكون بسبب أنها تميزت بمعايير غير معتبرة في المجتمع أو لأنها غلبت إلى مواقع القمة المجتمعية من أندادهم عدلاً أو جوراً. فعالم الفيزياء سيكون أحرص الناس على تعديل المعيار المجتمعي ليقدر العلم بدلاً عن الشعوذة والسحر الذي رفع الدجالين إلى مكانه في النخبة العليا وأبقاه مع العامة. والذي يرغب في كثرة المال أو الشهرة سيعمل للوصول إلى النخبة العليا لتحقيق هذه الرغبات، فإذا وجِّه مثل هذا إلى المعايير الصحيحة أصبح سلاحاً في يد الوعي، كلا المثالين يعملان بدافع ذاتي ولكنه يصب في النفع العام كما تقول فكرة اليد الخفية.2. النخبة المثالية: هؤلاء هم أصحاب الدوافع المثالية الذين تحركهم القضايا الإنسانية أو الأيديولوجية، وسعيهم إلى تغيير المجتمعات ونشر الوعي – وإن لم يخل من الدوافع الذاتية بالكلية – فهو مشحون بدوافع قيمية صادقة وهؤلاء يمكن أن يوجدوا ضمن النخبة العليا ولكن دون تأثير قاعدي واضح، أو يمكن أن يكونوا بين النخبة المعيارية. فإذا جمعتهم هذه القيم والمثل في شكل تنظيمات مجتمعية، كالأحزاب السياسية، أو المنظمات الطوعية، أو ما شابه ذلك، أمكن لهم أن يكونوا سنداً كبيراً في معركة نشر الوعي والتنوير.3. النخبة الصاعدة: وهم الذين يمثلون مستقبل النخبة في البلد، هم المتفوقون في المدارس والجامعات وأصحاب المواهب والإمكانات الذاتية العالية من الشباب الذين لم يدخلوا الحياة العملية بعد، هؤلاء طاقة تغيير هائلة لا تزال كامنة، والتحدي أمام النخبة العاملة للتنوير – النوعين سابقي الذكر – أن يعملوا على استيعاب هذه الفئة إلى صفهم، فالشاب الذي لا يزال لديه فرصة الاختيار الأول يمكن أن يُرشد منذ البداية إلى المعايير الصحيحة وطريق الوعي فلا يعبد صنماً في حياته قط! والمجد والمال والقيم كلها يمكن تحصيلها في دروب الوعي.هذه الفئات الثلاث من النخب كلها غير مستفيدة من الوضع الحالي في المجتمع، وإن كان بعضهم مستفيداً بانتمائه إلى النخبة العليا، فهو لن يخسر بحركة التنوير، لذلك يمكن حساب هذه الفئات كجبهة واحدة في معركة نخبوية هدفها تحرير المجتمع من الجهل الذي تحرسه نخبة منتفعة. الصراع الذي سينشأ بين هاتين النخبتين لن يعني بالضرورة نصراً لحركة التنوير ولكنه سيضمن على الأقل وجود تنوع فكري في المجتمع يمنحه فضيلة الاختيار التي كانت ضعيفة جداً في السابق بسبب سيطرة تيار تجهيلي على المجتمع. هذا التنوع يعطي الفرصة لانتخاب طبيعي لكي يحصل ويفعّل قانون البقاء للأصلح. على الأقل هذه الآلية تنفي أشكال التحيز الذي قد يبدو في تصنيفي للوضع الراهن بأنه ضلالي ومتأخر، فإن لم يكن كذلك حقاً استمر لأنه الأصلح أو لإجماع الأمة عليه، ولكن المهم هو أن نضمن تعريضه لمنافسة مستمرة تختبر معدنه وقدرته على الصمود في هذا العصر.لا يفوت علينا الانتباه أن النخبة التي ستعمل كحركة تنوير لن تسلم من التنافس الداخلي فيما بينها، وسيكون جوهرياً لنجاح هذه الحركة ألا يعمد المتنافسون إلى العودة القهقرى، ينبغي أن يدفع هذا التنافس الحركة إلى الأمام في شكل لولب متصاعد وليس هابطاً، ينبغي أن تعمل هذه النخبة على أن تتشكل جوائزها التي تنالها على تميزها ونخبويتها في اتجاه حركتها نحو الوعي وليس بالردة نحو الجهل.إن الشعوب القابعة الآن في قاع الأمم لن يعجزها أن توزع الملام على الجغرافيا البائسة أو التاريخ المجحف أو قهر الجبارين أو كيد الأقربين أو ظلم الحكام وفساد المسؤولين، أو ربما لاموا ببساطة الحظ ، ولكن ستظل الحقيقة الثابتة هي أن الإنسان هو عدو نفسه الأول وشيطانها الألد، وهو بذلك مناط الإصلاح وأداته وهو أول دركات السقوط وأول درجات الصعود، وهو بذلك قلب الأمة الذي إن صلح صلحت الأمة وإن فسد فعليها السلام.
1325
| 23 يناير 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ساقية الجهلإذا امتنعت النخبة في المجتمعات المتأخرة عن نشر الوعي للأسباب التي ذكرنا آنفاً، فإن المجتمع سيظل يدور في دورة من الجهل تشبه ما عرفناه في الثقافة الشعبية بساقية جحا. فقلال الماء تغرف الماء من النهر لتعيده إلى النهر. المجتمع الذي ينتشر فيه الجهل يفعل ذات الشيء، فكل إنسان في المجتمع يقضي القسم الأول من حياته متلقياً للمعارف كتلك القلال الغارفة، ثم القسم الأخير من حياته معطياً كتلك القلال الصابّة، ومنطقي أن يعطي المرء ما يتلقى، فالطفل الذي ينشأ في مجتمع متأخر سيتلقى معارفه من والديه ومن النظام التعليمي ومن مجتمعه المحيط، وحيث إن المجتمع متأخر فالمعارف التي سيتلقاها من كل هؤلاء لن تكون متقدمة ولا منيرة، وعندما يرشد الطفل ويتحول إلى حياة العطاء فيصبح والداً أو معلماً أو فقيهاً أو اقتصادياً أو سياسياً، سيعطي المجتمع من جنس ما منحه من قبل، هذه هي دورة الجهل الخبيثة.الخروج من دورة الجهل1. الظرف التاريخي: يذكر التاريخ أن بعض الشعوب تمكنت من النهوض والتقدم عندما هيأ لها التاريخ ظروفاً مواتية واستطاع إنسانها استغلال تلك الظروف لإحداث النهضة. فالحضارة الأولى قامت، بحسب جاريد دايموند في كتابه الشهير "بنادق، جراثيم، وفولاذ"، عندما مرّ الصيادون الأوائل بمنطقة الهلال الخصيب والتي كانت – كما يوحي اسمها – ذات أرض خصبة واكتشفوا هناك الزراعة فاستقروا بها وتمكنوا من استئناس الحيوان، فنشأت بذلك أول المجتمعات المستقرة، أول الحضارات. كذلك تشير المراجع التاريخية إلى أن بعض الشعوب حظيت في فترة تاريخية معينة، ومن قبيل الصدفة فقط، بعدد كبير من المواهب الفذّة كانت سبباً في نهضة شاملة. قالوا ذلك عن اليونان في عصرها الذهبي وقالوه عن بداية النهضة الأوروبية في فلورنسا في القرن الرابع عشر الميلادي بوجود أسماء كمايكل أنجلو وليوناردو دافنشي وغيرهم.هناك ظروف تاريخية أخرى يذكر المؤرخون أنها ربما كانت سبباً في إحداث نهضات لبعض الأمم، مثال ذلك الموقع الجغرافي لبعض المدن الساحلية والتي تزداد أهميتها في فترة ما فتصبح ملتقى تجارياً عالمياً مهماً كمينائي الإسكندرية في العهد الروماني أو فلورنسا في عهد التنوير الأوروبي.وأخيراً تنسب بعض التحليلات أسباب النهضة إلى توفر الوسائل كدور اختراع المطبعة في عهد التنوير أو دور حركة الترجمة في الحضارة الإسلامية خصوصاً في العصر العباسي وفي الأندلس. كل هذه التحليلات هي اجتهادات المؤرخين لفهم أسباب النهضات المختلفة في إطار ظرفي، أي الظروف التاريخية أو الجغرافية التي ساعدت أمة من الأمم على النهوض ولكن لا يوجد من هذه الدراسات ما يشير إلى هامشية دور الإنسان في النهضة، بل هي محاولات لفهم الظروف التي قد تشكل البيئة الأنسب لاستثمار الجهد الإنساني في النهوض.2. الخروج الثوري.. حركة التنوير والنهضةالشكل الآخر من أشكال الخروج من دورة التخلف هو ذلك الخروج الذي يكون بعمل منظم وقاصد، كأنه مشروع للنهضة يقوم به قائد ملهم أو نخبة طموحة أو مزيج من الاثنين مع تهيئة ظرفية تساعد على تعجيل الخروج. هذا النوع من الخروج استفاد من أدوات العصر الحديث كتطور وسائل الاتصال والنشر والحركة بالإضافة إلى رسوخ قيم ضرورية كالحريات وحسن التعايش بين المختلفين وتطور المجتمعات المدنية ومؤسساتها بشكل عام. كل ذلك ساعد على تحول المجتمعات من التخلف إلى الحضارة في غضون ثلاثة أو أربعة عقود فقط. وهو ما شهدناه في ألمانيا واليابان ما بعد الحرب وكوريا الجنوبية ثم نمور آسيا ونهضة أمريكا اللاتينية. وهي نهضات لا تقتصر فقط على التحول إلى دول صناعية بل هي حركة تغيير شاملة في المجتمع تشمل تحسن مستوى دخل الفرد ومستوى التعليم والوعي إضافة إلى نمط الإنتاج والعلاقات الاجتماعية. لم تعد الشعوب بعد ثورة التكنولوجيا والاتصالات والعولمة تحتاج قروناً طويلة لإحداث النهضة، كما أن النهضة المنشودة لم تعد كتلك القفزات الإنسانية الكبرى كالرسالات السماوية أو حتى اكتشاف الكهرباء، بل تبسط الأمر ليعني ذلك النموذج الحضاري المعاصر والذي ركيزته الأساسية هي كفالة العيش الكريم للناس.إذا أردنا إحداث النهضة في بلادنا بفعل قاصد – مشروع نهضوي – دون انتظار للنهضة التي يأتي بها الظرف التاريخي، فلابد من قيام حركة تنويرية عامة تقود البلاد للخروج من دورة الجهل والتأخر إلى الوعي والتقدم. هذه الحركة قد يقودها قائد ملهم أو جماعة منظمة أو مجموعة منظمات مجتمعية تشكل تياراً عاماً في المجتمع، قد تكون مشروعاً سياسياً لحزب طموح أو حالة ثورية لجيل متمرد على المسلمات القديمة، وقد تأخذ دون ذلك أشكالاً من الحراك الاجتماعي لا نتصورها الآن ولكن تؤتي ذات الثمار. ولكن أياً كان شكل هذا الحراك الاجتماعي فلابد له كي يتمكن من الاستمرار والنمو، لابد له من تهيئة، لابد من مساعدته بإزالة العوائق من أمامه قدر الإمكان على طريقة اللعبة الأمريكية الشهيرة. وأنفع تهيئة يمكن أن تدعم حراك الإصلاح والنهضة هي تحويل النخبة من فئة عاملة ضد الوعي على ما ذكرنا سابقاً، إلى فئة عاملة له، وذلك ليس استناداً بالضرورة على وازع أخلاقي أو خيري – وهو دائماً مرحب به عندما يوجد – وإنما على حافز بنفع يعود على النخبة من نشر الوعي عوضاً عن النفع الذي عاد عليها من كبته.
924
| 16 يناير 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إصلاح الإنسان.. إشكال الوعي من رحمة الله بالإنسانية أن وصفة النهضة والإصلاح ليست سراً حصرياً على فئة من الناس دون غيرهم، بل هي فكرة شائعة يعرفها كل الناس: العنصر الأهم للنهضة هو الإنسان، ومحاولات الالتفاف على هذا المسار باستخدام الثروات الطبيعية والعلاقات الاتكالية التي ذكرناها سابقاً هي من قبيل البحث عن الحلول السهلة وليس جهلاً بمركزية الإنسان. كذلك، فكون إصلاح الإنسان يعتمد أساساً على تمليكه الوعي والمعرفة أمر شائع ومعروف، ولكن الإشكال في كيفية تحقيقه.معلوم أن الشعوب التي تعيش في ظلام الجهل تبدأ أولى خطوات التنوير عندما يتهيأ لنخبة منها سانحة لتلقي العلوم والمعارف ثم العمل على نشر التنوير بين شعوبها فتتسع دائرة الوعي تدريجياً في دورة مستمرة من تلقي المعرفة ثم منحها حتى إذا حصل المجتمع على قدر كاف من الوعي بدأ حركة كلية نحو الأعلى تزداد وتيرتها بازدياد الوعي بين أفراد المجتمع. هذه هي الوصفة النظرية لنهضة الأمم، ولكن على الصعيد العملي فهناك عقبات ستعترض هذا المسار وأولى هذه العقبات هي النخبة نفسها التي يفترض بها أن ترود النهضة.مصلحة النخبة في كبت الوعيقبل بيان مصلحة النخبة في كبت الوعي ينبغي علينا تعريف النخبة، وهذا يكون من وجهين: الوجه الأول هو ما يمكن تسميته بالنخبة العليا، وهي تلك الفئة القليلة من الناس التي تتفوق على العامة في أي أمر من الأمور، وهي تقاس عادة كنسبة إلى العامة كأن نقول (أغنى 10% من المجتمع) أو (أكثر 5% تعليماً) أو ما شابه ذلك. هذه الفئة لا تحدد برقم معين ولا تستوجب مستوى معينا أو حدا أدنى من أي شكل. فمثلاً إذا كان شعب مكون بالكامل من الفقراء الذين لا يعيشون على أكثر من دولارين في اليوم فإن أعلى هؤلاء دخلاً هم النخبة الغنية رغم أنهم لا يعيشون على أكثر من دولارين في اليوم.الوجه الثاني لتعريف النخبة هو ما يمكن تسميته بالنخبة المعيارية، وهي أي مجموعة من الناس تستوفي معياراً معيناً بغض النظر عن نسبتها إلى باقي الناس، كأن نقول كل من يحمل درجة الدكتوراه هو من النخبة، فهؤلاء يمكن أن يكونوا عُشر الناس أو ثلثهم ليس مهماً، وإنما المهم استيفاء المعيار لكي يتم التصنيف ضمن النخبة. والذي يمنع أن يفوق الذين يستوفون المعيار غيرهم فتكون النخبة أكثر من العامة بما يناقض مفهوم النخبة نفسه، هو أن المعيار عادة ما يكون عالياً فلا يستوفيه إلا نخبة من الناس.يمكننا الآن أن نتصور المجتمع على أنه هرم كبير غالب أهله في القاعدة ويقلون بالتدريج كلما اتجهنا نحو القمة، ونزوع حركة الناس هو إلى أعلى نحو قمة الهرم باستمرار. هذا الهرم تتعدد فيه معايير مختلفة لتقييم الناس تقطعه أفقيا في شكل خطوط موازية للقاعدة، بعض هذه المعايير يحمل عدداً من الناس الذين يستوفونه، وكلما كثر عدد الناس على المعيار دفعوه بثقلهم نحو القاعدة، وكلما قل عدد المستوفين للمعيار، خفّ وزنه وصعد نحو القمة. فمثلاً سنجد أن معيار حملة البكالوريوس أو امتلاك ألف جنيه سيكون أقرب إلى القاعدة منه إلى القمة، بينما حملة الدكتوراه أو من يمتلكون مليون جنيه سيكون أقرب إلى القمة وأبعد من القاعدة لقلة عدد الناس المستوفين لهذا المعيار بالنسبة لعموم المجتمع.المعايير التي يسعى الناس إلى استيفائها والتقرب بها إلى قمة المجتمع هي المعايير التي يعترف بها المجتمع ويقدرها كالعلم والدين والمال. هذا يعني أن الذي يتميز على غيره في معيار غير معترف به في المجتمع لن يجد الرفعة الاجتماعية المنشودة، فالذي يتفوق على غيره في طول شاربه لن يصل إلى صفوة المجتمع رغم أنه إحصائياً فريد فيه ولكن طول الشارب ليس من المعايير المعتبرة في المجتمع. وليست كل المعايير المعتبرة في المجتمع هي بالضرورة معايير صحيحة، وهذا سيكثر في المجتمعات المتأخرة فربما يكون بعض المشعوذين من صفوة هذه المجتمعات المتخلفة بينما لا يكون علم الفيزياء معياراً للصعود، فيجد عالم الفيزياء نفسه مع العوام إلا أن يستخدم الفيزياء باعتبارها سحراً فيترقى عندئذ!يمكننا الآن أن نرى كيف يكون لبعض النخبة منفعة في كبت الوعي، فلو أمكن بعضهم أن يدفع الناس عن معياره دفعاً ليخفف من ثقل الناس عليه ويرتفع إلى أعلى لفعل. وكل من يجد نفسه على قمة المجتمع بسبب معيار خاطئ فلن يعمل على تصحيحه لئلا يهوي به في عموم الناس. وكل معيار خاطئ هو محتل لمكان معيار صحيح. وكل شخص في النخبة بسبب معيار خاطئ، هو محتل لموضع شخص في القاعدة.دعونا نضرب أمثلة واقعية لبيان الأمر أكثر. الملك على مملكة ما يكون قد صعد إلى قمة المجتمع معتمداً على معيار خاطئ، معيار الملك. بينما المعيار الصحيح هو معيار الاختيار الشعبي الحر، وحتى إن كان على قدر من الوعي وعلم أنه صعد على معيار خاطئ فلن يعمل – في الغالب – على تصحيح المعيار لأن ذلك سيذهب بملكه. شيخ الطريقة الصوفية وكل من صعد على معيار الإرث سيفعلون ذات الشيء. وعالم الدين لو تبين له خطأ مذهبه لربما سكت عليه حتى لا يسحب سلمه من تحت قدميه. وحتى الذين ارتقوا على معايير صحيحة، كحملة الدرجات العلمية أو رجال الأعمال، إذا عجزوا عن الارتقاء في مرحلة ما فسيسرهم أن لا يصل من كانوا تحتهم إليهم، فيحجب صاحب العلم علمه وصاحب الصنعة سر صنعته، وإن عجزوا بذلك عن منع ارتقاء الآخرين لربما عمدوا إلى تكسيرهم إن استطاعوا. باختصار، فإن كثرة الوعي تعني للكثيرين ذهاب التميّز، وهؤلاء يفضلون كلباً من الخواص على أسد من العوام، فما الذي سيخرج مجتمعاً كهذا من الجهل إلى الوعي؟.
915
| 09 يناير 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تفكيك مفهوم الإنسان ليس كافياً أن نقول إن الإنسان هو الركيزة الأساسية للنهضة، فقد طال التشويه حتى مفهوم الإنسان وصارت المفردة مشحونة بدلالات ليست أصيلة خصوصاً إذا استخدمت في سياق قطري. فمثلاً، ما المقصود إذا قلنا: إنسان سوداني؟ هل الإشارة إلى الإقامة الجغرافية أم الدم أم الثقافة أم ماذا؟ إن محاولة نسبة النهضة إلى إنسان مخصوص ينطوي على القول إن الشعب المعين هو بالضرورة جماع إنساني متميز ويمكن أن يقوم وينهض على أساس هذا التفرد والصفات التي تميزه عن غيره من الشعوب. هذه الفكرة ربما كان يسندها بعض المنطق عندما كانت الشعوب هي تجمعات قبلية تربطها أواصر الدم بما يحمله من مشتركات جينية، كما تربطها ثقافة مشتركة وتاريخ طويل. ولكن الشعوب بعد الدولة القطرية فقدت في كثير من الأحيان – خصوصا في الدول حديثة التكوين – ذلك الرابط الدموي والتجانس الثقافي القائم على تاريخ مشترك طويل. لذلك فإنه ينبغي عند الحديث عن النهضة المعتمدة على الإنسان أو الشعب الذي هو مجموع من الأناسي في البلد الواحد، ينبغي أن نكون حذرين من تعميم صفات إنسانية معينة على الشعب واعتبارها رصيداً يمكن التعويل عليه لبناء النهضة على أكتاف الناس. وحتى يستبين الأمر بشكل أفضل نضرب مثلاً بالشعب السوداني وما يظن أنه هو وما يظن أنها صفاته وخصائصه، ولنبدأ بتفكيك المصطلح.• ما هو الشعب؟ الشعب بحسب القواميس العربية هو إشارة إلى التفرق وبعضهم قال إنه يشير إلى التفرق والتجمع معاً فهو من الأضداد، ويطلق على القبيلة الكبيرة. بينما يعرف قاموس أوكسفورد كلمة شعب (people) بأنه مواطنون ينتمون إلى بلد معين أو أعضاء أمة أو مجتمع أو اثنية معينة. على هذا فإن الشعب السوداني هو مجموع الأفراد التي تنتمي إلى القبيلة أو مجموعة القبائل السودانية، أو هو مجموع المواطنين الذين ينتمون إلى دولة السودان، وهذا يستدعي أن نعرف ما هو السودان.• ما هو السودان؟ معلوم أن السودان هو اسم أطلق عبر التاريخ على مساحات جغرافية مختلفة وظل إشارة إلى أرض السود. وقد أطلق في فترة على طول الخط الإفريقي جنوب الصحراء، ثم أطلق على شريط النيل جنوب أسوان حتى منابع النيل في يوغندا، ثم أطلق على الجمهورية التي رسمها الانجليز وشملت دارفور وسواكن و(الجنوب)، ثم أخيراً أطلق على ما تبقى من ذات البلد بعد انفصال الجنوب. وكلمة الشعب السوداني أو السودانيين كانت تطلق على قاطني هذه المساحات المختلفة ما يعني أن الكلمة لم تحمل معنى ثابتاً بل كانت تتغير بتغير الجغرافيا والتاريخ.كل هذا يدعونا لإعادة النظر في (شخصنة) الشعوب القُطرية بشكل عام، والشخصنة أعني بها إطلاق صفات شخصية على عموم الشعب بحيث يصوَّر وكأنه مكون من مجموعة أفراد يحملون صفات (شخصية) عامة متكررة وهامش لبعض الاختلافات الفردية. بتعبير آخر، شخصنة الشعب هي نحت لقالب ثقافي يشكل الملامح الثقافية الأساسية للشخصية وتصوير الشعب على أنه مجموع من اللبنات التي تأخذ جميعاً شكل ذلك القالب حتى وإن اختلفت المادة المكونة لكل لبنة.مثال ذلك هو أن نقول إن الشعب السوداني يمتاز بالشجاعة والكرم والكسل وقلة احترام الوقت، ما الذي يجعل فرداً من الحلفاويين وآخر من البجا وآخر من الفور وآخر من الأنقسنا جميعاً يحملون هذه الصفات؟ لا شيء، سوى أن الحس القومي لدى مواطني أي قطر يدفعهم لتصوير اجتماعهم الشعبي على أنه يقوم على أكثر من مجرد التقسيم الجغرافي الذي أجراه الأوروبيون أو غيرهم في فترة تاريخية معينة، بل يقوم – كما يصورونه – على مشتركات عنصرية وثقافية وتاريخية راسخة تجعل منه خليطاً متجانساً، والاختلافات التي تبدو عليه يصورونها على أنها تنوع يثري هذا الاجتماع ولا يعكره، مجرد أوهام فرضتها الحاجة لإيجاد جوامع لأخلاط من الناس المختلفين غير جامع القطر السياسي، ولكن هذه الأوهام تكذبها الوقائع باستمرار. فالشعب السوداني ظل حتى وقت قريب يشمل القبائل الجنوبية، ما يعني أن (الشخصية السودانية) بصفاتها المتصورة كانت تشمل الدينكاوي والاستوائي، ولكن بعد أن انفصل الجنوب أصبح الجنوبي في حل من صفات هذه الشخصية ويمكن للجنوبيين أن يصوروا شخصية أخرى تجمع شتاتهم، بينما يعدل المخيال السوداني صورة الشخصية السودانية على استحياء ليحذف منها صفات القبائل الجنوبية العنصرية أو الثقافية ويقدم الشخصية المعدلة على أنها راسخة الثقافة وشديدة التجانس رغم التنوع الشديد فيها!.المفارقة بين المطلوب والواقع هو أن الناس في الواقع تجمعهم دول قطرية لم تراع في نشأتها درجة التجانس بين الناس في الدولة الواحدة بالشكل الذي يمنحها شيئاً قريباً من الشخصية المشتركة. وحيث إن الناس في عالمنا المتأخر قريبو عهد بالقبلية فقد صوروا الشعب القُطري على أنه قبيلة كبيرة كما تقول المعاجم، فاعتبروا أن ذات الجوامع التي تجمع القبيلة الصغيرة يمكن أن تجمع القبيلة الكبيرة كالدم والثقافة والتاريخ المشترك ما يعني أن الصفات التي يمكن أن تعمم على القبيلة الصغيرة، كالقول إن بني مخزوم يتصفون بالشجاعة، يمكن كذلك أن تعمم على القبيلة الكبيرة كالقول إن الشعب السعودي يتصف بالشجاعة. والقول الأول تعميم مقبول ولكن القول الثاني تعميم غير مقبول ويقوم على شخصنة الشعب القُطري دون أسس جامعة تشكل هذه الشخصية المشتركة.أما المطلوب فهو الإقرار بأن مفهوم الشعب القُطري هو مفهوم ديناميكي غير ثابت، وبالتالي فإن الصفات التي تميز هذا الشعب هي في الغالب صفات إنسانية عامة نجدها في كثير من الشعوب، وأن هناك تناسباً عكسياً بين مقدار التنوع في مكونات الشعب القُطري وحداثة القطر من ناحية، وإمكانية شخصنة هذا الشعب أو وصفه بصفات شخصية مشتركة من ناحية أخرى.بالعودة الآن إلى موضوع النهضة واستخلاصاً للشاهد من النقاش أعلاه، فإن الشعب الذي يبتغي النهضة في هذا العصر سيكون في الغالب مقيداً بالدولة القطرية وإشكالات السيادة. بمعنى أن التغيير الذي سيحدثه أو سيرغب في أحداثه أي شعب سيكون محصوراً فيما له فيه سيادة من سلطة سياسية أو مؤسسات مدنية، وأن تجاوز حدود الدولة القطرية يمكن فقط أن يأتي في إطار حراك شعوبي متفق أو تأثير ينتج عنه اقتداء. وحيث إننا فصلنا في القول إن الشعب في الدولة القطرية ليس له في الغالب شخصية خاصة مميزة عن من حوله من الشعوب، وأن تميزه محدود حتى عن عامة شعوب الأرض، فإن إصلاح الإنسان لأجل النهضة لا يكون مبنياً على خصوصية هذا الإنسان القطرية، فمشروع النهضة السودانية لن ينبني على صفات الشخصية السودانية كالكرم والشجاعة والأمانة وحسن الخلق، هذه ليست صفات سودانية بل هي صفات إنسانية يتفاوت الناس فيها بعوامل كثيرة ولكن أقل هذه العوامل هو الدولة القطرية كما أبنت أعلاه.النهضة السودانية ينبغي أن تقوم على الإنسان السوداني بغض النظر عن صفات (الشخصية السودانية) المتوهمة، أما الإنسان السوداني، فهو ذلك الإنسان بصفاته الإنسانية العامة الذي يستوطن السودان بغض النظر عن جغرافيته الآنية، هذه الوصفة ستكفل الاعتماد على الإنسان للنهضة في أي تاريخ أو جغرافيا وبغض النظر عن العنصر أو حتى الدين، فالإنسان الناهض لا يفلح في نهضته لكونه مسلماً أو مسيحياً، بل لكسبه وأخذه بالأسباب المؤدية إلى النهوض والرفعة، فالنهضة إذا تقوم على الإنسان الذي يكافئ مطلوباتها، أما الصفات التي تلحقه دون ذلك فهي سراب في صحراء التخلف، شديدة اللمعان عديمة الري!.
1184
| 02 يناير 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ضلالة الصداقة الدوليةطبيعة الضعيف هي أنه يبحث دائماً عن أحلاف يستقوي بها ويأمن على نفسه العدوان والنوائب، والذي يميز ضعيف الظرف عن ضعيف النفس هو أن الأول يرى ضعفه على أنه حال فرضته ظروف تاريخية وهو يعمل على تخطيها، وفي تلك الأثناء يتخذ أحلافاً تمنع عنه وتسنده في فترة الضعف مقابل مصالح معينة، إذ يستبعد أن تقوم أحلاف بين الدول دون أن تكون المصلحة متبادلة. هذا يختلف عن ضعيف النفس الذي يرى ضعفه أصلاً فرضته قسمة قدرية لأقدار الأمم، وهو في حال بحث مستمر عن المانع والمجير ويعمل على استدامة كل حلف قدر المستطاع حتى إذا انقضى حلفه مع زيد لأي سبب لجأ إلى عبيد وهكذا ينصب جهده على إيجاد المجيرين بدلاً من أن ينصب على الاستغناء عن الإجارة. فضعيف الظرف كالذي أصابته جرثومة فمرض وضعف جسمه وذهب يتقوى عليها بالدواء حتى ارتفعت مناعته وتغلب على الجرثومة وتعافى. بينما ضعيف النفس هو كالمريض بسبب ضعف خلقي لا علاج له سوى المسكنات أو المقويات – كالسكري مثلاً – فهو لا يأمل في التعافي التام وإنما يقبل درجة من العافية ينالها بدواء مستمر لا يتوقف.لا شك أن الدول لن تكون كلها في سباق نحو المركز الأول، فهذا سيجعل العالم مضطرباً جداً وهو غير ممكن في حق كثير من الدول بشكلها القطري الحالي إلا أن تدخل في حروب توسعية وهو ما لم يعد مقبولاً الآن. السباق نحو القمة أصبح هاجس دول قليلة جداً كأمريكا والصين وروسيا، ولكن الكثير من الدول ارتضت أن تكون جزءًا من حلف قوي كأوروبا، حيث ترتبط الدول الأوروبية مع بعضها بشبكة من المصالح والثقافة والتاريخ والجغرافيا تجعل من كل دولة في هذا التحالف – رغم التفاوت – عنصراً أساسياً في استقراره.هذا لا يشبه إطلاقا حالة الولاء التي نراها عند الدول الضعيفة تجاه الدول القوية، حيث نرتمي في أحضان الصين حين نعجز عن إرضاء أمريكا. ولكن ما هي طبيعة العلاقة بيننا وبين الصين حقيقة؟ الصين كانت لوقت مضى – قبل الانفصال – تستورد 8% من نفطها من السودان، ولكن هل هذا يمكن اعتباره تحالفاً يشبه الحالة الأوروبية مثلاً؟ لم يصدق هذا إلا السذج وهم عندنا كثر، ما إن انفصل الجنوب حتى أدارت الصين لنا ظهرها، وحتى قبل الانفصال حين استنجد بها الساسة في معاركهم مع مجلس الأمن خذلتهم إلا قليلاً. وليس العجب من قلة تعاطف الصينيين، وإنما العجب من استنكار الساسة عندنا لهذا الصد، والسؤال هو ما الذي يدفع الصين لنصرة السودان أصلاً؟ قد تكون للصين مواقف في السياسة الخارجية تخالف تلك الأمريكية وهي تفعل ذلك بناء على مصالحها الذاتية دون نظر إلى كون دولة في إفريقيا ربما تطالها بعض الفائدة من ذلك. أما كون السودان يبقى في فلك هذه الدولة ينتظر تلك السانحة الفلكية التي تتعامد فيها مصلحته مع مصلحة الصين أو غيرها فهو العجز بعينه.المقصود هو أن النهضة لا يمكن أن تقوم على العلاقات الاتكالية، حيث يسعى بلد متخلف لأن يكون في معية بلد أو بلاد متقدمة فيكون مثلهم. ولن يرفع بلد ناهض آخر قاعدا ليصل إلى المراقي على أكتافه. ولا ينبغي لنا أن نتصور أن العلاقة بين ضعفاء الاتحاد الأوروبي وأقويائه – كالعلاقة بين ألمانيا واليونان مثلاً – تمكن مقارنتها بالعلاقة بين السودان والصين، فألمانيا تدفع من أموالها الشيء الكثير لإنقاذ اليونان من عثراتها الاقتصادية، لأن الاتحاد الأوروبي بوجود اليونان يصب في صميم مصلحة ألمانيا. وحتى يأتي الوقت الذي يمكننا فيه قول الشيء ذاته عن السودان والصين، ستبقى العلاقة في أساسها ضعيفة وستكون بذات الضعف مع أمريكا وروسيا وأوروبا ولذات الأسباب. وقد بلغ بنا الهوان أن تقلص طموحنا من نيل السند الأمريكي أو الصيني إلى السند العربي الذي يباهي هو ذاته بالحماية الأمريكية.هذه الأحوال لن تتبدل حتى نيأس من فكرة النهوض بالوكالة ونستيقن أن النهضة لن تقوم إلا على أكتافنا وحدنا، وهو حمل على ثقله، لابد أن يحمل.خلاصة القول في حقيقة ركائز النهضة هو أن كل محاولة لتخطي عنصر الإنسان في عملية النهضة لن تؤدي إليها. صحيح أن إصلاح الإنسان هو أقسى أنواع الإصلاح وأكثرها احتياجاً للصبر والزمن، ولكن الإنسان هو الشرط الضروري والكافي للنهضة، فلا غنى عنه ويمكن الاستغناء به للنهضة. لذلك فإن الانصراف عنه بحثاً عن طرق مختصرة نحو النهضة كالاعتماد على الثروة الطبيعية أو العلاقات الاتكالية أو حتى بعض الضلالات التي لم نفصل فيها كالإرث التاريخي وعقائد الخلاص، هذه الانصرافات هي فعل المنبت، تهلك الجهد ولا تصل إلى الغاية.
1040
| 26 ديسمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); سبقت الإشارة إلى مركزية الإنسان في أي عملية نهضة حضارية، وأشرت إلى أن هناك اتفاقا عاما على هذا الأمر، ولكن رغم ذلك نجد كثيرا من الشعوب – السودان من بينها – تنصرف حين تهم بالإصلاح لأجل النهضة عن الإنسان لما ينطوي عليه إصلاحه من صعوبة وحاجة للصبر الطويل، فينصرفوا نحو ما يظنونه ركائز فرعية يمكن أن يتصوب جهد الإصلاح تجاهها حتى تقوم النهضة عليها عوضاً عن إصلاح الإنسان المضني. لذلك، وقبل أن نخوض في أمر إصلاح الإنسان، علينا أن نفند بعض الضلالات التي تشكلت في وعينا العام عن النهضة وسبل الوصول إليها.• ضلالة الثروة الطبيعية: الإنسان بطبعه مجبول على القعود عن بذل الجهد والعمل ما لم يستفز إليه أو يضطر، لذلك فإن الذي يرث مالاً عن أهله قلما ينهض لعمل إلا أن ينفد منه المال. وربما لم يختلف هذا السلوك إذا كان المرء موعوداً بالإرث حتى دون أن يقبضه، وهذا يشبه حالنا اليوم.لا أدري متى ولا كيف انتشرت ضلالة أن السودان هو من أغنى الدول في موارده الطبيعية ولكنها الآن أصبحت شديدة الرسوخ إلى درجة عقائدية ما يجعل البحث عن أصل هذه الخرافة مثيراً للاهتمام، ولكن ذلك بحث يخرج عن الإطار الحالي، ويمكن الاكتفاء بالإشارة إلى أمرين قد يساعدا على فهم هذا الإشكال.الأمر الأول هو أن الخرافة بدأت في السودان القديم الذي حوى بعض البترول إضافة إلى صيت الطبيعة الغنية لكل أرض استوائية وذلك الغموض الذي يحيط بكل ما هو إفريقي وبدائي، والذي يخبئ وراءه في العادة كنوزاً كبيرة لا يعرف الإفريقي – لبدائيته – كيف ينفقها، حتى يأتي الحضري الأبيض مغامراً ومتخطياً مجاهيل الغابة الإفريقية وشعوذة أهلها ليفوز بالكنز! هذه الصورة النمطية ربما تكون فيها شيء من المبالغة ولكنها لن تخلو من قدر من الحقيقة. والسودان الذي غلبت عليه الثقافة العربية رأى نفسه بمنظارها الذي اعتاد الصحراء والقفر فرآها جنة وارفة وهو كذلك بالنسبة لمنابع ثقافته. ثم إن العرب الذين ينظر إليهم السودانيون بشيء من الإعلاء يعجبهم في السودان ما يفقدوه عندهم، بعض الماء والخضرة، وذلك إعجاب تدفعه ربما الحاجة أكثر من دفع السياحة والنظر فصارت هذه الميزة السودانية على العرب – المستعلين بثقافتهم – ثمينة جداً وفريدة فأسرف السودانيون في تعظيمها طلباً للمباهاة مع العربي.الأمر الثاني هو ذلك النزوع الطبيعي نحو الدعة والسكون الذي ذكرته في مبتدأ الفصل، والذي يعوز الدافع نحو النهضة لن ينهض. فالنهضة ليست تلقائية وليست يسيرة، بل تستدعي جهداً كبيراً وتعباً ما يعني أنها تستدعي حافزاً عالياً، وليس ثمة أمر محبط للحافز ومقعد لهمة الإنسان سوى سهولة المال والاستغناء عن العمل. ولكن كيف يتنزل هذا الإحباط لمستوى الفرد فيؤثر على همته الذاتية؟ بتعبير آخر، هل سيمتنع الفرد عن العمل بجد لكسب العيش الطيب لأن البلد غنية بالبترول والذهب؟ إذا وجد الضمان لمعاشه سيمتنع في الغالب إلا أن تكون له همة فطرية ونشاط. ولكن التعقيد يكون عندما ينعدم الضمان، أي عندما لا يجد كافلاً من الدولة أو غيرها إذا قعد عن العمل، فهل سيؤثر عليه كون البلد ذات ثروة طبيعية كبيرة أو لا؟ نعم سيتأثر. العنصر الذي يغفله كثير من الناس في دراسة الاقتصاد وأحوال المعاش والاجتماع هو عنصر الثقافة الاقتصادية وأخلاق العمل. وهو العنصر الذي قد يغيب تأثيره عند النظر على مستوى الفرد ولكنه شديد الوضوح من المنظور الكلي. مثال ذلك نجده في نظرية ماكس فيبر عن تأثير الأخلاق البروتستانتية على ولادة الرأسمالية في أوروبا دون غيرها. وليس عسيراً ملاحظة أن بعض الشعوب اعتادت إتقان العمل أكثر من غيرها حتى إذا استوى الأجر، لأن الإتقان أصبح طبيعة وثقافة عند هذه الشعوب ولم يعد متوقفاً على قدر الأجر المقابل. ذات الأمر نجده معكوساً عند الشعوب التي تحرص مثلاً على تحضير الطعام بما يزيد على الحاجة وإكثار الأصناف، ليس لسعة في المال، بل أحياناً يكون هذا في ضائقة، ولكن لأن الأمر أصبح ثقافة، ثقافة تفسر من السلوك الإنساني ما يعجز المنطق الاقتصادي البسيط عن تفسيره.إن مثل هذه الشعوب التي تعيش على أمل الرفاه من ثروتها الطبيعية كمثل الابن الذي يعيش على أمل الغنى من إرث والده العجوز البخيل، فهو يعيش في حال بسيط لبخل والده ويمضي في حياته كالناس، يدخل المدارس ثم يخرج ليبحث عن عمل، ولكنه في كل ذلك ضعيف الالتزام، يده في الواجب الذي بين يديه وعينه على ثروة أبيه، وهو في حاضره لا يبذل ما ينبغي من جهد تجاه واجباته ولا يحسنها لظنه أنه قريباً لن يحتاجها وسيستغني بإرث أبيه. هذه هي الثقافة الفاشية في شعوبنا إلى حد كبير، ثقافة الخلاص القدري وليس الكسبي، حيث يهبط قدر من السماء أو يخرج من الأرض فيخلص الناس من معاناتهم، والمهدي المنتظر والبترول في هذا الأمر سواء.بهذا الفهم ظل الناس يلقون اللائمة على الحكومات باعتبارها عاجزة عن إدارة هذه الثروة وايصالها لهم بينما هم يدبرون أحوالهم بأقل مجهود ريثما يأتي الفرج. وبذات الفهم فإن الحكومات تنفق من الموارد الطبيعية باعتبارها مالاً وليس باعتبارها رأسمال، فالمال يستهلك بينما رأس المال يستثمر، ولكن اختلط الأمر على الحكومات فظنت أن إخراج الثروة من الأرض هو غاية الاستثمار وأن ما أخرجته هو النقد الذي تمضي به إلى السوق. هذا ما فعلته الحكومة بالبترول وتفعله الآن بالذهب وكانت وستظل تفعله بالزراعة حتى يفتح الله على هذه البلاد بمن يدرك مفهوم الصناعة والقيمة المضافة.أقول هذا طعناً في منهج الاعتماد على الثروات الطبيعية إن وجدت فكيف أن لم توجد! الحقيقة التي ذكرتها في غير مرة هي أن السودان بلد محدود الموارد وليس غنياً بها، فباستثناء الثروة الحيوانية والتي لا يحسن استغلالها، فالسودان لا يصنف غنياً في أي مورد من الموارد الطبيعية الأساسية، لا في المحروقات ولا في المعادن ولا في المياه العذبة، وكل ما يقال عن أن هذه الأرض تحوي كنوزاً كبيرة هو إما مبالغة أو خرافة. ولكي ندرك خطورة استمرار هذه الضلالة على مستقبل بلادنا نسترجع مثال الابن الذي أضاع عمره دون أن يحسن التعلم أو العمل طمعاً في الاستغناء بثروة أبيه، ثم اكتشف أن أباه فقير معدم، هذا هو حال السودانيين اليوم، غفلة تستدعي عاجل الانتباه.
655
| 19 ديسمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); طال الزمان بالسودانيين والشعوب من حولهم منذ أن كانوا في طليعة الشعوب وكانوا سادة بين الأمم، فقد غادرت الريادة الحضارية هذه الأرض منذ آلاف السنين ولم تعد، بل إن اللحاق بالأمم الطليعة أيضاً لم يحصل عندنا منذ ذلك الحين وهو ما لا يشبه حال الحضارات في العالم. فالريادة الحضارية قامت في أوروبا في اليونان وروما ثم غادرتها إبان العصور المظلمة ثم عادت إليها مع عصر النهضة. ذات الأمر حصل مع الحضارات الآسيوية في الصين والهند حيث تأرجحت درجة الحال الحضاري لدى هذه الأمم صعوداً وهبوطاً عبر التاريخ دون أن تفقد في أوقات الهبوط ذلك النزوع نحو الترقي والسبق. ما الذي حجب هذا التوق والنزوع الحضاري عن شعوبنا وألبسها لباساً من القناعة وأحالها إلى القعود الطويل؟ فشعوب هذه البلاد ومنذ أن فقدت النوبة تاج العظمة والتقدم، بقيت تراوح مكانها الحضاري المتخلف بإصرار مدهش! لا يزال أهلها يعيشون في الغالب على الزراعة والرعي وظلوا حتى وقت قريب يركبون الدواب ويتقاتلون بالسيوف وتجمعهم العشائر والقبائل ويعبدون الأوثان. حتى عندما دخلت الأديان السماوية بأبعادها الحضارية، شوهوها بالتحريف حتى شابهت ما كانوا عليه من وثنية، فأدخلوا فيها الدجل والاسترقاق الروحي والصفوية الدينية والطوطمية والسحر بينما غابت حرية التفكير والفلسفة واللاهرمية. وعندما قفزت الإنسانية قفزتها الكبرى بالثورة الصناعية وازدادت المسافة بين الشعوب الصناعية وغيرها من شعوب الحرف القديمة، لجأت النخبة في الشعوب المتأخرة إلى تبرير أوضاعها بمبررات واهية خلقت حالة تصالح نسبي مع التخلف. فأهل الدين قدسوا الموروث فجمدوا الدين على حال قديم بما فيه من علل، وأهل الثقافة تذرعوا بخصوصيتها فصوروا العلل والإشكالات على أنها اختلافات وتنوع، وزالت بذلك الرغبة في التغيير والتحسين. وأهل الاقتصاد برروا إهلاكهم لثرواتهم الطبيعية واستمرارهم في الزراعة والرعي كأساس للاقتصاد، بأنه استخدام لما يسمونه (الميزة التفضيلية) وهي فكرة أسيء فهمها والعمل بها وتركونا في هامش الشعوب، هم يستنسخون البقر ونحن نستولدها ونظن أننا وهم سواء! وذات الأمر نجده في السياسة حيث تلظت شعوبنا بنيران القهر تحت مسميات الدولة الملوكية والقومية والإسلامية وأنكروا الديمقراطية لكونها ليست من تراثنا العربي أو الإسلامي فخسرنا بكل ذلك الحرية والوعي معاً.لا أحسب أن جدلاً سيقوم حول مركزية الإنسان في أي نهضة أو انتقال حضاري لأي أمة من الناس، غير أن الإشكال يظهر عند التفصيل، حيث درج الناس على تسمية الخطوات الأولى في درب النهضة الطويل بـ(الإصلاح) وفيه إشارة إلى الترميم أو البناء على قواعد قديمة ثابتة. هنا يسهل الانزلاق إلى ذات الوحل القديم عندما يستدعي الناس ذات المفاهيم الخاطئة باعتبارها تلك القواعد الثابتة التي ينبغي البناء عليها لا هدمها.سأبين في هذه الورقة بعض الإشكالات في مفهوم الإصلاح ومفهوم الإنسان المصلح. سأتناول مشكلة إصلاح الإنسان نفسه وإشكال الوعي حيث يدور الإنسان المتأخر في دورة جهل يعطي فيها من بعده ما يتلقاه ممن قبله، وكيف أن بعض النخب تجد منفعة في كبت الوعي بدلاً عن نشره. وأخيراً سأرسم ملامح عامة لكيفية الخروج من دورة الجهل والتأخر عبر نشر الوعي والتنوير وكيف أن هذا الخروج – والذي ينبغي ألا ينتظر مداً قدرياً – ولكي تنهض الأمة بفعل قاصد، لابد لها من ثورة تنويرية تخرج الناس من ظلمة امتدت لزمن يصعب عدّه، حتى لم يبق من أثر الحضارة في بلادنا سوى ركام يتداعى تحت الرمال منذ آلاف السنين.
1231
| 12 ديسمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قصة كوريا يحكيها هاجوون:ولد هاجوون تشانق في كوريا الجنوبية عام 1963 في وقت كانت كوريا فيه واحدة من أفقر دول العالم (متوسط دخل الفرد في 1961 كان 82 دولارا في حين كان في غانا 179 دولارا في السنة). انتمى هاجوون لأسرة من الطبقة المتوسطة العليا حيث كان أبوه – خريج هارفارد – موظفاً حكومياً كبيراً في الدولة رغم ذلك كان يسكن في شقة من غرفتين بلا دورة مياه (حمام بلدي!). ذكر هاجوون أن أحد أقربائهم زارهم يوماً وسأل والدته عن ماهية (الدولاب الأبيض) الغريب في صالتهم، كانت تلك هي الثلاجة! وكان الجيران يخزنون اللحم الغالي عندهم كما لو كان بنكاً. عندما دخل هاجوون إلى المدرسة في 1970 كان الفصل يزدحم بـ65 تلميذاً (كفصلي عندما دخلت المدرسة) ولكن مدرسة هاجوون كانت خاصة، المدرسة العامة بجوارهم كان الفصل يضيق بـ 90 تلميذاً. يذكر هاجوون أن الجنرال بارك حاكم كوريا في ذلك الوقت أعلن عن خطة للنهوض بمستوى دخل الفرد إلى 1000$ بحلول عام 1981 والذي كان يعتبر هدفاً مبالغاً في الطموح. في عام 1973 قام الجنرال بارك بإطلاق مشروع برنامج الصنعنة الكيميائية والثقيلة (HCI) حيث أسس أول مصنع للحديد الصلب وباحة لصناعة السفن وبدأ إنتاج أول سيارة محلية التصميم (وإن كانت الأجزاء معظمها مستوردة). ثم توالى إنشاء المصانع للإلكترونيات والماكينات والكيماويات وغيرها من الصناعات المتقدمة. في الفترة ما بين 1972 و1979 فقز دخل الفرد بأكثر من خمسة أضعاف واستطاع الجنرال بارك الوصول إلى هدف الـ 1000$ قبل الموعد بأربع سنوات، وقفزت الصادرات الكورية في ذات الفترة تسعة أضعاف. يذكر هاجوون أن هوس البلاد بالنهضة الاقتصادية كان منعكساً حتى في التعليم (وهو ما رجوته في بداية هذا الفصل للتعليم عندنا). يقول إنه وفي ظل الشح والحاجة الماسة في البلاد للعملة الحرة كان التبليغ عمن يُرى وهو يدخن سجائر أجنبية واجبا وطنيا. كانت العملة الصعبة هي "العرق والدم لجنودنا الصناعيين الذين يخوضون معركة الصادرات في مصانع البلاد" يقول هاجوون. (قارن هذا بما نصرفه نحن على السيارات – الكورية للمفارقة! – والشوكولاته والفواكه وكريمات الزينة!)كان الذين يصرفون المال في مواد استهلاكية رفاهية في كوريا يُنظر إليهم على أنهم غير وطنيين بل ومجرمون، وكانت الدولة تمنع استيراد البضائع الكمالية أو تفرض عليها جمارك عالية. بل إن السفر كان ممنوعاً حفظاً للعملة الصعبة ما لم يكن بإذن الحكومة لعمل أو دراسة. يقول هاجوون إنه لهذا السبب لم يخرج من كوريا حتى بلغ 23 عاماً حين خرج للدراسة في كامبردج.كانت كوريا في مطلع الثمانينيات قد تمكنت من تقليد الكثير من المنتجات الصناعية المتقدمة ولكنها لم تتمكن في ذلك الوقت من الابتكار والإبداع لتحتفل ببراءاتها العلمية وماركاتها التجارية العالمية. اليوم تعتبر كوريا واحدة من أكثر الدول إبداعاً حيث تصنف من الخمسة الأوائل عالمياً في عدد البراءات العلمية، بينما كانت في الثمانينيات تعيش على (الهندسة العكسية)، وتعتبر من (عواصم القرصنة) في العالم. بنهاية الثمانينيات ثبتت كوريا مكانتها كإحدى أفضل الدول متوسطة الدخل (upper-middle-income) وكان أبرز دليل على ذلك أن الدول الأوروبية أعفت الكوريين من طلب تأشيرة الدخول، فالكوريون لم يعد لديهم ما يدفعهم إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. في عام 1996 انضمت كوريا إلى نادي الدول الغنية OECD. انتقلت كوريا في أقل من 40 عاماً من تصدير خام التنجستان والأسماك والشعر المستعار إلى تصدير السيارات والسفن والهواتف الذكية (انتهى كلام هاجوون).إذا قارنا التجربة الكورية بالحال السوداني فإننا نجد أن السودان كان في الستينيات يصدر المنتجات الزراعية وهو اليوم كذلك يصدر المنتجات الزراعية بالإضافة إلى الذهب (أيضاً مادة خام!). قارن ذلك بالانتقال من تصدير الشعر المستعار إلى هواتف سامسونج الذكية. كان مستوى دخل الفرد في السودان في 1961 هو 157$ وهو اليوم 1500$ أي حوالي 10 أضعاف في خمسين سنة. قارن ذلك بالانتقال الكوري من 82$ إلى 33.000$ أي حوالي 400 ضعف! ليست الغاية هنا هي بث مزيد من الإحباط فقد نلنا منه الكفاية، ولكن بث الأمل، فكل ما يظن السودانيون اليوم أنه يمنعهم من النهوض كان مثله في كوريا في الستينيات أو أسوأ منه سواءً كان من الراهن الاقتصادي أو الثقافة الشعبية أو حتى السياسة (كوريا ظلت ديكتاتورية حتى 1987).لا شيء يمنعنا من النهوض كغيرنا من الأمم، نحتاج أن نثق في هذه الحقيقة ثقة تامة أولاً، ثم ننظر في واقعنا بعين مجردة من الأوهام والخرافات سواءً كانت عن منح لا نملكها أو موانع ليست فينا. وأكرر، السودان ليس غنياً بالموارد بالشكل الذي نتصوره بل هو فقير في غالبها، ولكن السودانيين أيضاً ليسوا شعباً ذا مناعة فطرية من التمدن والصناعة، ولا ينبغي أن يقعد بنا الكسل أو التنوع الإثني أو قلة احترام الوقت أو قلة القدرة على العمل الجماعي أو النظام، كل هذه الصفات قيلت عن من هم طليعة الشعوب اليوم في النشاط واحترام العمل والوقت والدقة والمهارة في العمل والنظام. بل ربما يكون للسودانيين خصيصة حيث إن أحد الأكاديميين ذكر في ورقة كتبها عن ثقافة شعب الملايو المتهم بالكسل وعن قدرتهم على النهوض، ذكر ما أسماه قصة مشهورة عن ميكانيكي سوداني تمكن من إصلاح عطل كبير في عربة بـ (توليفة) ذكية تدل على حس حِرفي وصناعي عال لدى هذه الشعوب (شعوب الدول الفقيرة).الذي نحتاجه الآن هو نشر الوعي بين الناس وزرع الثقة في النفوس. فالنهضة متاحة لكل الشعوب إلا من أبى، والذي يأبى هو الذي يقعد ممسكاً بمنجل ورسن حمار ويتوعد شعوب العالم بالسبق إلى المجد! الذي يأبى هو من يقعد على بداية الطريق ينظر إلى الأفق الأغبش فيصيبه اليأس حين لا تنجلى له الأنوار من مكانه ويقول هذا أمر لا طاقة لنا به وإنا ههنا قاعدون. لذلك فإن علينا ألا ندع قيادَنا بأيدي أمثال هؤلاء، بل ندعه لأصحاب البصائر والخيال الذين لا تعجزهم الرؤية من خلال الغبش ولا يقعدهم طول الطريق.
682
| 19 يونيو 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); 1. الآفاق الاقتصادية: الخطوة الأولى نحو اقتصاد سوداني مزدهر هي تغيير الثقافة الاقتصادية عن السودانيين. لابد أن تزول أسطورة السودان بلد الموارد الطبيعية من أذهان الناس ولنبدأ بتغيير الضلالات التي تدرس للأطفال في المدارس من شاكلة "سلة غذاء العالم" وما شابهها، ويا حبذا لو وضعت مكانها فكرة (لعنة الموارد) وهي المفهوم الاقتصادي الصحيح الذي يحكي حالة التدهور الاقتصادي للدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية. حبذا لو درس أطفالنا قصة (المرض الهولندي) بدلاً من إضلال أفكارهم بالكلام عن طول نهر النيل أو قدوم محمد علي باشا إلى السودان بحثاً عن الذهب. حبذا لو تعلم أولادنا أن الدول إنما تنهض بالعمل الجاد الدءوب وأن الموارد ليست شرطاً ضرورياً للنهوض والأمثلة كثيرة. ينبغي أن ندرك جميعاً أن الصناعة ليست ثقافة غربية وأن الزراعة ليست ثقافة شرقية وأن تبادل المصنوع بالمزروع ليس هو الميزة النسبية بل هو كسل اقتصادي لا يغتفر!إن التغيير المطلوب في ثقافتنا الاقتصادية لا يقف على مشكلات الإنتاج بل إنه يشمل سيئات استهلاكية غرست جذورها عميقاً في ثقافتنا وتحصنت بمسميات زائفة كالكرم. ينبغي علينا أن نعيد تعريف مفهوم الكرم لدينا بناءً على العقل والدين، وأن نميز بين الكرم وبين السرف والتباهي. فدعوة ما يزيد على الألف من وجهاء القوم للعشاء هو سرف وتباهي بغض النظر عن المناسبة. وإكثار أصناف الطعام في وجبة واحدة سرف. والتعارك بالأيدي لدفع الحساب في مطعم فاخر ثم تدافع عجوز تطلب إحساناً بعد الخروج من المطعم هو مزيج من التباهي والنفاق والبخل. ذات المنطق يسري على الملبس والمفرش والزينة. إن البخل في الإنتاج و(الكرم) في الاستهلاك هو عنوان ثقافتنا الاقتصادية المقلوبة، ولن تتحقق لنا أي نهضة اقتصادية ما لم نبدأ بهذه المفاهيم.إذا أقررنا أن الثقافة قابلة للتغيير فإن ما سواها هيّن، ولنسأل الآن: ما الذي يمنع السودان من النهوض كما نهضت الكثير من الأمم؟ ما الذي يمنعه من أن يحاكي النموذج الكوري مثلاً؟ لا شيء، لا شيء إطلاقاً. وقبل أن أحكي لكم قصة النجاح الكوري على لسان أحد أبنائها، وحيث إنني في معرض تصحيح المفاهيم الخاطئة، سأتناول المزيد منها بالتفنيد على لسان ذات الشخص.يقول الكوري الجنوبي أستاذ اقتصاد التنمية بجامعة كامبردج هاجوون تشانق في كتابه الناجح "23 شيئاً لا يقولونها لك عن الرأسمالية" إن أحد المفاهيم المتداولة الآن عن إفريقيا هو أن قدرها ألا تنمو وتنهض وذلك لأسباب منها: مناخها الاستوائي الموبوء بالأمراض، جغرافيتها القطرية حيث العديد من الدول ليس لها موانئ بحرية، غناها بالموارد الطبيعية (لم يذكر السودان!) ما يجعل أهلها كسالى يفشي فيهم الفساد، وهي منقسمة عرقياً ما يعيق إدارة أهلها، ضعف مؤسساتها، وأخيراً مشكلة الثقافة حيث لا تشجع الثقافة الإفريقية على العمل الجاد أو التعاون أو الادخار. هذه المفاهيم رد عليها هاجوون رداً وافياً في كتابه وأدعو الناس للاطلاع عليه حيث لا مجال هنا لهذا التفصيل. ولكن ما أود التركيز عليه هو المانع الثقافي الذي يظن كثير من السودانيين أنه يحول دونهم والنهوض (لا التفات هنا إلى من يقولون بالنهوض الزراعي!). وهذه الخصائص الثقافية تشبه كثيراً ما يقال عن الأفارقة بشكل عام وكثيراً ما يجلد بها السودانيون ذواتهم: الكسل والانفعال وعدم النظام وقلة القدرة على التعاون والعمل الجماعي وما شابه ذلك. هذا باعتبار أن هذه الصفات لا تصلح للنهوض بالاقتصاد وأنها إن كانت جزءًا من الثقافة فقد حُكِم على الناس بالشقاء لأن الثقافة لا تتغير، ولكن هل هذا صحيح؟يحكي د. هاجوون في كتابه "السامريون الأشرار Bad Samaritans" إن مستشاراً استرالياً طاف عدداً من المصانع في دولة نامية ثم قال لموظفي الدولة المرافقين له إنه بطَل عجبه من رخص العمالة في بلدهم عندما رأى الناس في العمل وإنه لا عجب من قلة رواتبهم لأن إنتاجهم قليل، وقال "عندما رأيت رجالكم في العمل أحسست أنكم قوم قنوعون جداً وسهلو المراس تظنون أن الزمن ليس مشكلة. عندما تحدثت إلى بعض المديرين أخبروني أنه من المستحيل تغيير عادات هي من الإرث القومي". بتعبير آخر – تعبير هاجوون – القوم كانوا كسالى. المدهش هو أن هذا البلد النامي هو اليابان في 1915! والأسترالي لم يكن وحده، فأحد المبشرين المسيحيين الأمريكان وصف اليابانيين بأنهم "كسالى لا يكترثون لمرور الوقت إطلاقاً!". وبريطانية اشتراكية اسمها بياتريس ويب وصفتهم بأنهم "ميالون للدّعة ولديهم استقلالية شخصية لا تطاق". كل هذه الصفات لا تشبه بأي حال صفات اليابانيين اليوم، فقد اشتهروا بالدقة في العمل واحترام الوقت وتقديس العمل الجماعي والنشاط. أذكر أنني قرأت قبل سنوات أن متوسط زمن التأخير للقطارات الداخلية في طوكيو كان 15 ثانية! هذه دقة متناهية في الزمن، فمن يصدق أن ذات القوم كانوا قبل أقل من مائة عام يوصفون بالكسل وقلة احترام الوقت! ذات الصفات التي نوصف – أو نصف أنفسنا - بها الآن.والدهشة لا تقف على اليابان، فالألمان أيضاً – ولدينا في السودان احترام زائد لكل ما هو ألماني – لم يحوذوا في الماضي ذات السمعة التي لديهم اليوم. كان الانجليز في بدايات القرن التاسع عشر (نهضة الألمان الاقتصادية بدأت في منتصف القرن التاسع عشر) يصفون الألمان بأنهم أغبياء وخاملون! وذكر هاجوون أن أحد أصحاب المصانع الفرنسيين وصف عماله الألمان بأنهم "يعملون كيف ومتى يشاءون!". مجدداً ذات الصفات التي تطلق علينا الآن. وهذه الصفات أطلقت على اليابانيين والألمان قبل أقل من ثلاثين سنة من انطلاقتهما الاقتصادية، فلا حجة إذا بأن هذا التغيير سيستغرق وقتاً طويلاً وإن صح هذا فإنه يوجب علينا البداية فوراً لا ترك الأمر برمته.
1201
| 18 يونيو 2014
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
13392
| 20 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1788
| 21 نوفمبر 2025

شخصيا كنت أتمنى أن تلقى شكاوى كثير من...
1386
| 18 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1173
| 20 نوفمبر 2025

القادة العظام يبقون في أذهان شعوبهم عبر الأزمنة...
1134
| 18 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
978
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
912
| 20 نوفمبر 2025

نعيش في عالم متناقض به أناس يعكسونه. وسأحكي...
804
| 18 نوفمبر 2025

في مدينة نوتنغهام الإنجليزية، يقبع نصب تذكاري لرجل...
756
| 23 نوفمبر 2025

يُعد البيتومين (Bitumen) المكون الأساس في صناعة الأسفلت...
708
| 17 نوفمبر 2025
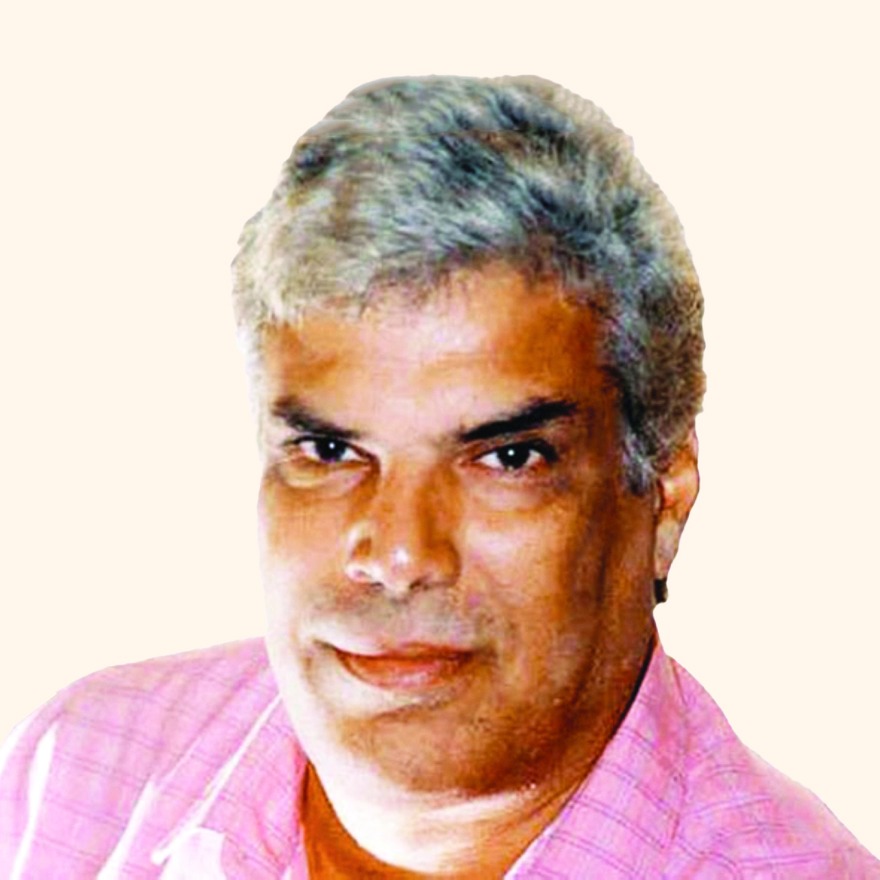
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
654
| 20 نوفمبر 2025

المترجم مسموح له استخدام الكثير من الوسائل المساعدة،...
621
| 17 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







