رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لم تكن الأمسية الشعرية التي قدّمتها بروين حبيب في معرض الكويت الدولي للكتاب الأسبوع الماضي مجرّد لقاء أدبي عابر، بل بدت كما لو أنّها نافذة أوسع على روحٍ تتوهّج كلّما اقتربت من النار، وتهدأ كلّما صعدت بها اللغة إلى مقامٍ أعلى من احتمال المرء. كانت بروين، في تلك الليلة، تحضر بكامل هشاشتها وقوّتها معًا، بكامل ما في صوتها من غناءٍ مكسور، وما في قصائدها من قدرةٍ على تحويل الخسارات إلى معنى، والمعنى إلى دفقة حياة. كنت أعرف مسبقًا أنّ بروين لن تقدّم قصائد تُسمَع فحسب، بل قصائد تُعاش. ذلك النوع من الشعر الذي لا يمرّ على سطح القلب، بل يغوص مباشرةً في طبقاته البعيدة، ويترك هناك أثرًا لا يزول بسهولة. كلّ قصيدة ألقتها تلك الليلة كانت كأنّها شرفةٌ مفتوحة على عالمٍ آخر؛ عالم تسكنه الأمّهات المكلومات، والطفلات المقطوعات من دفء العالم، والرجال الذين غابوا قبل أن تكتمل حكاياتهم، والنساء اللواتي يتقاسمن مع الليل أسرارهنّ ويتركن للقصيدة مهمّة البوح، وعن وجع القلب كله «غزة»! في قصيدتها عن يوسف، ذلك الطفل الذي تفتّش عنه أمٌّ تحت القصف، بدا المشهد أكبر من جغرافيا القصيدة. كان يشبه صرخةً طويلة تمدّ يدها نحو العالم ولا تعود. تسأل الأمّ: “هل رأيتم ولدي؟”، وكأنّ كلّ أمّ فقدت ابنًا في غزة أو في أي أرضٍ مماثلة تجلس خلف الصوت وتردّد السؤال ذاته. شعر بروين في هذه اللحظة لا يصف الطفل، بل يعرّي الفاجعة نفسها. فالحليب البارد على المائدة، والشموع التي لم تُشعل، والدفتر الذي بقي بلا نجمة نصر… كلّها تتحوّل إلى شواهد صغيرة على غياب أكبر من أن يُفهم. أمّا في “بواكي حمزة”، فقد استعادت بروين حكاية قديمة لتقول جرحًا حديثًا. أخذت من التاريخ جملة النبي صلى الله عليه وسلم: “ولكنّ حمزة لا بواكي له”، ووضعتها في فم طفلة فلسطينية تخاطب أباها الشهيد، فتتشابك الأصوات والحقب، ويصبح الماضي طريقًا للمستقبل لا مرآةً له. فجأةً رأينا الطفلة تنوب عن نساء الأنصار، تنوح عنهم جميعًا، وتفتح للقصيدة نافذة على كلّ القبور التي لا تجد صوتًا يبكيها. وفي قصائد أخرى؛ مثل “أربع رسائل من فروغ”، كانت بروين تفتح دفترها الداخلي، الدفتر الذي لا يُقرأ عادةً إلّا على حافة الألم. تعود إلى علاقاتٍ إنسانية محطّمة، إلى عشّاق يتعثرون في طرقهم الموحلة، وإلى نساء يسقطن ويقمن، وكأنه لا خلاص إلا في الكتابة. تلك الرسائل، التي تنساب مثل نهرٍ حزين، تحمل في طيّاتها سيرة أنثى تتحدّى قدرًا لا يرحمها، وتصرّ مع ذلك على أن تجرّب كل أشكال الحب حتى نهاياته الموجعة. وفي قصيدة “البدينات الجميلات”، التي استحضرت فيها محمود درويش، تقلب بروين المعايير، وتقف ضدّ النظرة القاسية التي تُمارَس على أجساد النساء. هناك، هي واحدة من أكثر قصائدها طزاجةً ومرحًا، تتمازج فيها السخرية بالبهجة، وتتحوّل فيها الأنوثة إلى احتفال ممتدّ لا يخشى الوزن ولا المقاييس. وفي “عشتار” و “الأوراق السومرية”، ظهرت بروين في هيئتها الأسطورية؛ امرأة تخرج من عمق الميثولوجيا لتعيد كتابة مصيرها بيدها، وتواجه الوحشة بحبّ لا ينطفئ ولا يتراجع. خرجتُ من الأمسية أحمل معي شعورًا غريبًا: كأنّ بروين لم تقرأ قصائد بقدر ما رفعت ستارةً عن نفسها، وتركتنا نرى ما خلفها. كانت القصائد تضيء وتجرح وتضمّد في اللحظة نفسها، وكانت بروين، بتوازن جميل، تكتب عن الحب كما لو أنّه وطن، وعن الوطن كما لو أنّه حبيب، وعن الفقد كما لو أنّه الطريق الوحيد الذي تعلّم الشعراء المشي فيه. ولعلّ أجمل ما في الأمسية أنّها لحظة تذكّرنا بأن الشعر ما يزال قادرًا على تقليب الهواء من حولنا، وعلى إعادة تشكيل أرواحنا في كل مرّة نقف فيها على عتبة بيت من أبيات القصيدة. وهذا وحده، يكفي لتكون الأمسية واحدة من ليالي المعرض التي لا تُنسى.
249
| 01 ديسمبر 2025
كل نسخة من معرض الكويت الدولي للكتاب تُشعرني بأنني أدخل بيتًا قديمًا أعرف تفاصيله، لكنني أكتشف في كل زيارة أن الضوء تغيّر، وأن الكتب التي اعتدت المرور عليها صارت تُحدّق فيّ بطريقتها الخاصة، كما لو أنها تنتظر هزيمتي أو انتصاري، أو على الأقل تنتظر ما الذي تبقى مني. لا أعرف سر هذا الارتباط. ربما لأن المعرض لم يكن يومًا مجرد قاعة ممتلئة برفوف وبشر، بل كان مساحة تتقاطع فيها مسارات العمر؛ تلك التي أضعتُها، وتلك التي ما زلتُ أبحث عنها بإصرار يليق بمن يعرف أن الكتب أحيانًا أكثر رحمة من الحياة. هناك دائمًا كتابٌ ما يبحث عن قارئه المفقود، وناشرٌ ما زال يؤمن بأن الحرف قادر على أن يغيّر مصير المرء حين يلامس جرحه أو حلمه، أو يوقظه من غفوته الطويلة. كنت أمشي بين الدور وكأنني أتحسس وجهي القديم. شيء في الهواء يعيد ترتيب الروح، ويجعل التعب يتراجع خطوة كي يسمح للجمال بأن يتقدم بثقة. هنا تتنفس الروح بحبر جاد، حبر يعرف أن الكلمات لا تُكتب لكي تتكدس، بل لكي تفتح شقًا صغيرًا في عتمة ما، أو لتضيء ركنًا أهمله المرء وهو يركض في حياته من دون أن يلتفت. كنت أتجول في معرض هذا العام، بلا نية واضحة ولا خريطة محددة، فقط أترك قدميّ تقودانني حيث تشتهي الورقة. وفجأة، ومن بين آلاف العناوين، لمحته: ديواني الأول، في طبعة قديمة، صادرة عن دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، نسخة من الطبعة الثانية تحديدًا، تلك التي وافق صدورها لحظة كنت أحاول فيها أن أجد مكاني في العالم، أو على الأقل مكاني أمام اللغة. توقفت. شعرت للحظة بأن الوقت يبتلع كل الأصوات من حولي، وأن الرف الذي يحمله قد انحنى قليلًا ليقترب مني، كأنه يريد أن يهمس بشيء لم يعد أحد ينتبه له. مددت يدي بحذر غريب، كما لو أن الكتاب جسد حيّ يتنفس، أو طفل تركته قبل خمسة وثلاثين عامًا في مهد من الورق، وعدتُ فجأة لأجده يكبر بطريقته، دون أن ينتظرني. كان غلافه كما تركته تقريبًا: بسيطًا، خجولًا، لكنه يحمل عناد بداياتي وارتباكاتها، ورغبة فتاة كانت تظن أن الشعر قادر على أن يرمم ما لا يرممه العالم. أمسكته، وداهمتني كل الشجون دفعة واحدة. رأيت تلك التي كنتها: فتاة ترتجف وهي تقدّم مخطوطها الأول، تظن أن النقد يمكن أن يلتهمها، وأن المدح قد يخونها، وأن الشعر وحده هو المكان الذي لا يطرد أحدًا. تذكرت الصحف التي كتبت عن الديوان آنذاك، وتذكرت القراء الذين التقيتهم مصادفة وهم يتحدثون عنه بينما كنت أقف بينهم مجهولة. تذكرت الخوف، والفرح، والارتباك الذي رافق تلك السنوات الأولى، حين كنت أتعلم كيف أضع قلبي على الورق دون أن أنهار. الغريب أنني حين فتحت الكتاب الآن، بعد هذا العمر، لم أقرأه بعين الكاتبة التي أصبحتها، بل بعين المرء الذي يدرك أن الكلمات القديمة لا تفقد قيمتها لمجرد أن الزمن مرّ فوقها. وجدت بين الصفحات ما يشبه رسائل لم أكتبها لأحد، بل كتبتها لأحمي نفسي من هشاشتي، من ضياعي، ومن كل ما كنت أظنه أكبر من احتمالي. وكنت أبتسم كلما قرأت بيتًا أعرف أنني لم أعد أكتبه بالطريقة نفسها، لكنني لا أستطيع أن أخونه أيضًا، فهو شاهد على امرأة كانت تقف في بداية الطريق، بشجاعة لا تتكرر. لم يعد الأمر مجرد مصادفة. كان أشبه بموعد مؤجل مع ذاتي الأولى. المعرض كله اختفى في تلك اللحظة، وبقيت أنا والكتاب الذي بدأت به رحلتي، الكتاب الذي حمل بصمتي الأولى قبل أن تتشعب الأصوات وتتغير الأساليب وتتباين التجارب. شعرت بأن السنوات الطويلة انحنت أمام تلك اللحظة، وأن شيئًا بداخلي يربّت على كتفي قائلاً إن الطريق مهما طال يبدأ دائمًا بصفحة واحدة. وضعت الكتاب فوق صدري، بلا مبالغة، كمن يعيد شيئًا إلى مكانه الأصلي. ورغم ازدحام القاعة حولي، كنت أسير وفي داخلي سكون نادر. سكون يشبه اعترافًا مؤجلًا بأن المرء لا ينجو إلا حين يعود إلى النقطة التي بدأ منها، لا ليبقى فيها، بل ليطمئن أن تلك الشرارة الصغيرة التي أشعلت بداياته لم تنطفئ بعد، وأن الشعر، مهما تبدّل العالم، ما زال قادرًا على حمله إلى حيث يحسّ أنه حي بحق.
246
| 24 نوفمبر 2025
منذ أن عرفت معنى الانتباه لداخل جسدي، أدركت أن الشيخوخة ليست تلك التجاعيد التي تسللت على مهل إلى وجهي، ولا خطواتي التي أصبحت تحتاج إلى مهلة أطول مني كي تستقيم، بل هي شيء أخفى من كل ذلك، شيء يشبه انطفاء مصباح صغير كان يضيء ليلي الداخلي ويمنحني سببًا إضافيًا لأواصل السير بثبات لا يخلو من عناد. هناك لحظة لا ننتبه إليها إلا بعد أن تقع، لحظة تنطفئ فيها شرارة ما؛ فإذا بالحياة تتغير في عينَي المرء من دون أن يدري كيف حدث هذا التحول. أعرف وجوهًا كثيرة ظلت محافظة على ملامح الشباب رغم السنوات، لكنها تحمل في نظراتها عتمة مَن فقد شيئًا لم يستطع تسميته. وأعرف أيضًا رجالًا ونساءً تقدم بهم الزمن واشتعل رأسهم شيبًا، ومع ذلك تلمع أرواحهم كمن خرج للتو من بداية جديدة. ليس العمر ما يصنع هشاشتنا، بل ذلك الإهمال البطيء الذي يطال أرواحنا حين نتوقف عن الإصغاء لما يجعلنا أحياء بالفعل. المرء يشيخ حين يخون نفسه، وحين يتواطأ مع التعب، وحين يتراجع عن حلم كان يحرّك الدم في عروقه، أو حين يسلّم لرتابة لا تشبهه في شيء. أحيانًا يلوّح القدر بمصباحه في وجوهنا، كأنه يحاول أن ينبّهنا لشيء ما نخفيه أو نهرب منه. وقد يمر هذا الوميض من دون أن نلحظه لأننا أصبحنا مشغولين بتبرير ما نخسره، بدلاً من التساؤل عن المساحة التي يتسرب منها الضوء الهارب. الروح تحتاج إلى رعاية أكثر مما يحتاجه الجسد، لأنها إن انطفأت فلن ينفعها أي تجميل خارجي يعيد إلى صاحبها ملامح الحياة. هناك من يحافظ على بريقه رغم كل شيء لأنه يعرف كيف يحمي تلك الشعلة القصية بداخله، يعرف أن الاستسلام هو الشيخوخة الحقيقية، وأن النبض حين يخفت لا يعود بقرار، بل بحاجة إلى مصالحة مع الذات، واستعادة ما ضاع منها خطوة بعد أخرى. وحين يجلس المرء مع نفسه بصدق، يتفحص داخله كما يتفحص بائع خبير حجرًا كريمًا، يكتشف فجأة أين تفقد أرواحنا لمعانها. ربما في تسوية غير عادلة قبلنا بها، أو في علاقة استنزفت ما لدينا من محبة ولم نملك شجاعة الانسحاب، أو في عمل يلتهم أيامنا دون أن يترك أثرًا يستحق البقاء. وربما يشيخ المرء في اللحظة التي يتوقف فيها عن الغضب تجاه الظلم، أو حين يتكاسل عن الدفاع عن ذاته، أو حين ينسى ذلك الطفل الذي كان يهرع خلف الفراشات مسحورًا بقدرة الأشياء على أن تدهشه كل يوم. ومع ذلك، ثمة ما يبعث على الاطمئنان؛ الضوء لا يموت تمامًا مهما انطفأ. قد يخفت ويتراجع ويختبئ خلف طبقات من الخيبة، لكنه يظل هناك ينتظر فرصة للعودة. يكفي أن نفتح نافذة صغيرة ليدخل من جديد، ويكفي أن نتذكر أننا لم نُخلق كي نتكيف مع العتمة، بل كي نحافظ على ذلك الوميض الذي يجعل حياتنا تستحق أن تُعاش. الشيخوخة الحقيقية ليست قدرًا محتومًا، بل خيار نرتكبه حين نتوقف عن حماية أرواحنا من البلادة، وحين ننسى أن الضوء لا يُترك وحيدًا بلا وصايا. لذلك، حين نشعر بثقل غير مفهوم، وحين يتسلل إلينا شعور بأن الأيام فقدت طعمها القديم، فلنبحث عن الشرارة التي أضعناها في زحمة الانشغالات. قد تكون كلمة صغيرة تجاهلنا قولها، أو رغبة مؤجلة تراكم عليها الغبار، أو طريقًا لم نجرؤ على عبوره. وعندما نجدها، سنعرف فورًا أن الزمن لا يستطيع أن يشيّخ الروح ما لم نسمح له بذلك، وأن الضوء، مهما خفت صوته، قادر على النهوض من جديد إذا وجد قلبًا يصغي إليه.
204
| 17 نوفمبر 2025
ليست الرحمة امتيازًا يمنحه المرء لمن يشاء ويمنعه عمّن يشاء، بل هي سرّ إلهيّ يودعه الله في بعض القلوب ليمتحن بها طهرهم، لا ليتباهوا بها، ولا ليحكموها كما يشاؤون. ومع ذلك، كم من يدٍ بشرية توهّمت امتلاك مفاتيح الرحمة، فأغلقت بها أبوابًا على آخرين، متصورة أن العدل والانتقام وجهان لنفس القيمة! يُخيفني دائمًا أولئك الذين يتحدثون عن «الرحمة» وكأنها مشروع شخصيّ، يمنحونه لمن يرضون عنه ويحجبونه عمن خالفهم أو أخطأ في حقّهم. كأن الرحمة سُلطة لا شعور، وكأنهم ورثة الله في أرضه يملكون حقَّ العفو والعقوبة. بينما الحقيقة البسيطة التي يغفل عنها الكثيرون أن الرحمة ليست بيدك، لا تُستعار ولا تُستولد، ولا تُستدعى ساعة الغضب لتجمّل مظهرك أمام الناس. إنها بيد الله وحده، وهو وحده من يعرف أين يضعها ومتى يسكبها، ولمن يمنحها. يحدث أحيانًا أن يمرّ المرء بتجربة تُشبه صفعة الوعي، حين يرى قسوة الناس على بعضهم، فيكتشف أن بعض القلوب تجفّ رغم وفرة الكلام عن الإيمان. تجد من يرفع شعار الرحمة، ثم لا يتورع عن كسر قلبٍ ضعيف، أو التشهير بوجعٍ لم يُخلق ليُعرّض في العلن. كأن القسوة تمنحهم شعورًا زائفًا بالقوة، في حين أنها تكشف خواءً عميقًا في دواخلهم. الرحمة لا تُمارس من علٍ، ولا تُلقى من فوق، بل تُنسج من الداخل حين يختبر المرء ضعفه الحقيقي أمام الله، حين يتذكّر أنه هو نفسه نجا بفضل رحمةٍ لم يكن يستحقها. لذلك، حين تجرّب أن تضع نفسك موضع الله، لتوزّع رحمته أو تمنعها، فأنت في الحقيقة تُعلن عجزك عن أن تكون عبدًا متواضعًا. كم من علاقة انكسرت لأن أحدهم قرر أن يملك الرحمة بيده، فحجبها عن الآخر، ناسيًا أن الله وحده هو الذي يمحو ويغفر ويعفو. وكم من قلبٍ احترق لأنه التمس من بشرٍ شفقةً كان يجدر أن يلتمسها من السماء. فاحذر أن تُقيم نفسك قاضيًا على أرواح الآخرين، فالحساب ليس لك، ولا الرحمة من نصيب سلطتك. تصرّف بما في يدك فقط: بالحبّ، بالعطاء، باللطف الممكن. وامنح ما تستطيع من دفءٍ وإنسانية دون أن تُفسدها بادعاء القداسة. أمّا ما بيد الله، فاتركه لله، لأنك مهما ظننت نفسك عارفًا أو منصفًا، فإنك تجهل من خفايا القلوب ما يعلمه وحده. الرحمة ليست ضعفًا، بل قُدرة على أن ترى الألم دون أن تحكم، وأن تتذكّر أن وراء كل خطأ روحًا تتألم، ووراء كل قسوةٍ خوفًا، ووراء كل غلظةٍ حكاية لم تُروَ. حين تفهم ذلك، تدرك أن أجمل ما يفعله المرء في هذه الحياة أن يردّ الرحمة إلى صاحبها، وأن يكتفي هو بأن يكون سببًا صغيرًا في جريانها، لا حاجزًا يعترضها. الرحمة بيد الله، ولعل أجمل مظاهر الإيمان أن تُدرك أنك لا تملكها، وأنك مهما عظمت فهي تظلّ ظلًّا خفيفًا من رحمته التي وسعت كل شيء. فلا تُحاول سرقة ما لا يُسرق. فالرحمة ليست غنيمة تُنتزع من يد الله، ولا سُلطة تُمارسها باسم الفضيلة، بل نفحة من سرّه يمنحها لمن يشاء. وحاشا لله أن يُمكن أحدًا من أخذ شيءٍ من خزائنه، أو أن يترك لضعف البشر سلطانًا على رحمته الواسعة. إنما يُختبر المرء حين يتوهم القدرة على ذلك، فيسقط في وهم السيطرة على ما لم يُخلق له، وينسى أن كل ما بين يديه عارية مؤقتة. لذلك، لا تمدّ يدك إلى ما بيد الله، ولا تتعالى على رحمته، بل اكتفِ بأن تكون مرآة صغيرة تعكسها، لا سارقًا يحاول احتكارها.
882
| 10 نوفمبر 2025
كل شاعر، مهما بدا هادئًا أو مطمئنًا في موقعه، يحمل في داخله جناحين قلقين، لا يطيقان البقاء طويلًا في أمان الجماعة. كأن الشعر نفسه لا يتنفس إلا في العزلة، ولا يضيء إلا في المسافة الفاصلة بين الصوت والصدى. تلك المسافة التي تفصل الطائر الشاعر عن السرب، وتمنحه في الوقت ذاته حريته وخوفه، مجده ووحدته، انتصاره وانكساره. ليس من المصادفة أن يشبَّه الشعراء بالطيور، فهما يشتركان في شهوة التحليق، وفي حاجتهما إلى العلو كي يريا الأشياء من زاوية مختلفة. السرب يمنح الطائر حمايةً ودفئًا، لكنه يسلبه خصوصية النغمة. أما حين ينفرد بالطيران، فإنه يعرّض جناحيه للريح، لكنه يستعيد صوته الأصيل، الذي لا يشبه سواه. تلك المفارقة هي قدر الشعراء منذ أول من قال بيتًا في البراري القديمة، وحتى آخر من همس بقصيدته في عتمة غرفة صغيرة. الشاعر، في جوهره، لا يحتمل التكرار. يرفض أن يقول ما قيل، أو أن يرضى بما اتُّفق عليه، أو أن يقتات على ما يراه الآخرون كافيًا. إنه كائن قلق، يختبر اللغة كما يختبر الطائر الهواء، يختبر مقاومته قبل أن يسلم له جناحيه. كل قصيدة هي تجربة طيران جديدة، وكل خطأ في المدى يُكسبه خبرةً في التحليق أعلى. لذلك لا يكتب الشاعر ليُعجب أحدًا، بل ليكمل نقصًا في الكون لا يراه سواه، أو ليمنح نفسه فرصة النجاة من ثقل الأرض. لكن الخارج من السرب لا يعود كما خرج. من يتذوق طعم الحرية اللغوية لا يستطيع بعدها أن يتكلم بلغة الجماعة. تصبح الكلمات عنده كائنات لها أرواحها الخاصة، لا تقبل القيد ولا تنصاع للعرف. وحين يعود إلى السرب، يجد أن النغم تغيّر، وأنه لم يعد يطيق ترديد ما يتردد على الألسنة. لذلك يُتهم الشاعر دائمًا بالغموض، أو بالغرابة، أو بالتعالي. وما هو في الحقيقة إلا أكثر الناس صدقًا في إنصاته إلى الأصوات الخفية في داخله، تلك التي يخاف الآخرون من سماعها. أن تكون شاعرًا يعني أن تعيش على الحافة بين الخطر والجمال. الحماية تغري، لكنها تُخدّر. الجماعة تمنح الطمأنينة، لكنها تسرق الصوت الخاص. أما الانفراد فهو مغامرة مفتوحة على الاحتمالات: قد يسقط الشاعر في فراغ المعنى، وقد يكتشف في ذلك الفراغ سماءه الحقيقية. وما يميز الشعراء الكبار عن غيرهم، ليس مهارتهم في نظم الكلام، بل جرأتهم في ترك السرب حين يضيق بهم، وثقتهم بأن أجنحتهم ستقودهم إلى حيث لا خرائط ولا أوامر طيران. كثيرون يرون في السرب رمزًا للأمان. لكن الشعر لا يزدهر في الأمان، بل في القلق الجميل الذي يرافق كل بحث عن صوت جديد. فحين يطمئن المرء أكثر مما ينبغي، يفقد دهشته. والشعر، في جوهره، دهشة متجددة. لذلك يظل الشاعر أقرب إلى الطيور التي تعرف أن الطريق إلى العلو محفوف بالتيه، لكنها تطير رغم ذلك، لأن التيه جزء من طقوس الوصول. ولعل أعذب ما في الشعر أنه يجعل من الغرابة وطنًا مؤقتًا. لا يكتب الشاعر ليكون مقبولًا، بل ليكون صادقًا. ولا يغرد خارج السرب من رغبة في التفرد فحسب، بل لأنّ ما يراه من موقعه المختلف لا يمكن أن يُرى من مكان آخر. كل شاعرٍ يحمل في صوته سرًّا لا يُقال إلا إذا ابتعد قليلاً عن الضجيج العام، ليستمع أولًا إلى الصمت. والصمت هو أول القصائد، ومنه تبدأ اللغة رحلتها نحو المعنى. ربما ينسى السرب سريعًا ذلك الطائر الذي غادرهم ذات فجر بحثًا عن نغمة جديدة، لكن القصيدة لا تنساه. القصيدة تحفظ له أثر الجناحين في الهواء، وارتجافة القلب حين قرر أن يخرج من الاصطفاف. وما الشعر في النهاية إلا تلك اللحظة التي يجرؤ فيها المرء على أن يكون وحيدًا من أجل أن يقول الحقيقة كما يراها هو، لا كما يتوقعها الآخرون. كل الشعراء طيور، نعم، لكنّ بعضهم يختار الغناء في مواجهة الريح، لا في ظلّها. هؤلاء وحدهم يخلّدهم الصوت، لأنهم حين غادروا السرب لم يغادروا الوفاء، بل عادوا إليه بأغنية أوسع من الأجنحة نفسها، وأعمق من فكرة الحماية، وأصدق من أي تصفيق يأتي من الخلف.
366
| 03 نوفمبر 2025
يحدث أحيانًا أن يجلس الكاتب أمام بياض الورق أو فراغ الشاشة كمن يقف في مفترق لا يعرف أي طريقٍ يسلك. الكلمات التي كانت يومًا تتدافع من بين أصابعه كجدولٍ صغير، تجف فجأة، ويتحوّل الحبر إلى غبار ولوحة المفاتيح إلى صخرة. إنها تلك اللحظة التي يسمّيها البعض “حبسة الكتابة”، ويسميها آخرون “خيبة اللغة”. غير أني أراها لحظةَ صدقٍ مؤلمة، حين ترفض اللغة أن تكون شاهد زور على ما لم ينضج بعد في الداخل. الكتابة ليست آلة تعمل بالأوامر، ولا فكرة تُساق بالعنف نحو الصفحة. إنها كائن خجول، يختبئ حين يشعر بأن الكاتب يطارده بعصبية أو خوف. أحيانًا يكفي أن نسترخي قليلًا، أن نكفّ عن التفكير في النتائج، أن نتوقف عن انتظار النص الكامل أو الفكرة العظيمة، وأن نبدأ من أبسط ما يمرّ بنا؛ رائحة قهوة، صوت جهاز تكييف، ظلّ شجرة على نافذة، أو حتى جملة عابرة قالها أحدهم في المقهى ثم مضى. الحبسة ليست عدوًّا كما يظن الكثيرون، بل هي طريقة اللغة في أن تقول لنا؛ «تمهّل، هناك شيء لم تفهمه بعد”. إنها تلك الوقفة التي تتيح للكاتب أن يستمع إلى ما لم يُقل، أن يلتفت إلى ما يتوارى خلف صخب اليوميّ. فحين تصمت الكلمات، يتكلم الشعور. وحين تتوقف الكتابة، يبدأ الوعي بالكتابة. جرب أن تكتب بلا خوفٍ من الخطأ، وبلا قلقٍ من المقارنة، وبلا محاولةٍ لإبهار أحد. اكتب كما تتنفس؛ ببطءٍ، بصدقٍ، بلا تكلف. اكتب ما تراه لا ما يُنتظر منك أن تراه. اكتب حتى لو كانت الجملة الأولى مرتبكة، وحتى لو بدت الثانية بلا معنى، لأن الكتابة تشبه الرياضة فعلًا؛ لا تعود العضلات إلى لياقتها إلا بالحركة، ولا تعود اللغة إلى سحرها إلا بالممارسة. في اللحظة التي تكتب فيها كلمة واحدة، تكون قد بدأت هدم الجدار بينك وبين ذاتك. كل كلمةٍ تفتح بابًا، وكل جملةٍ تُزيح غبارًا تراكم بينك وبين ما تشعر به حقًا. فلا أحد يولد كاتبًا، ولكن كلّ من تجرّأ على الصمت الداخلي وأصغى لنداءٍ خفيّ في داخله، صار واحدًا منهم. الكلمات ليست حجارة تبنى بها الجمل، بل كائنات حيّة تحتاج إلى هواءٍ ومسافةٍ وصبر. لا تُكرهها على الخروج، بل هيّئ لها المناخ المناسب لتأتي طواعية. لا تراقبها بعين المحاسب، بل احتضنها بعين المحبّ. فالحبسة لا تُهزم بالعنف، بل تُروّض بالرفق. وحين تشعر بأنك لا تملك ما تكتبه، اكتب عن ذلك الشعور نفسه، عن العجز، عن الخوف من العجز، عن محاولتك الفاشلة في الكتابة. ذلك وحده كافٍ ليعيدك إلى جوهر الكتابة وهو الصدق. ولعل أجمل النصوص وُلدت من لحظاتٍ كهذه، حين جلس كاتبٌ في الليل يحدّق في ورقةٍ بيضاء لا تقول شيئًا، فكتب عنها، فتكلمت معه، ثم تكلمت عنه. فلا تخف من الصمت، ولا من البياض، ولا من التوقف المؤقت. الكتابة كالحياة، لا تحتاج أكثر من أن تبدأ، والبداية أحيانًا ليست فكرة، بل نبضة. ولأن الكتابة تشبه المرآة أكثر مما تشبه النافذة، فإنها لا تُريك ما في الخارج بقدر ما تكشف لك ما في داخلك. وحين تتعثر يدك عن الكتابة، فربما لأنك لوهلةٍ لم تعد ترى نفسك بوضوح، أو لأنك تكتب بعينٍ تخاف الخطأ بدل أن تشتاق إلى الحقيقة. دع النص يرى وجهك الحقيقي، بارتباكه وضعفه وتردده، فالنصوص المدهشة لم تولد من اكتمالٍ مصطنع، بل من هشاشةٍ صادقةٍ قاومت الخوف وكتبت رغم كل شيء.
480
| 27 أكتوبر 2025
لم نكن لنتخيل أن الغباء له هذا الحضور الطاغي بيننا، وأن التفاهة تملك هذا العدد الهائل من الأنصار. كنا نظنها حالات فردية تمرّ في الهامش، لا أثر لها سوى بعض الضحك العابر، حتى جاءت وسائل التواصل الاجتماعي وكشفت ما كنا نغضّ الطرف عنه طويلاً. أخرجت الناس من صمتهم، لكنها في الوقت نفسه أخرجت أسوأ ما فيهم. فجأة صار السخف مادة يومية، وصار الصوت الأعلى هو الذي يربح دائمًا، لا لأنه أذكى أو أصدق، بل لأنه أكثر ضجيجًا. لم تعد هناك حاجة للفكر أو المعرفة أو حتى الذوق، بل يكفي أن تثير ضجة صغيرة كي تتحول إلى “مؤثر”، ويكفي أن تقلد غيرك أو تسخر من شيء ما لتصبح “ترندًا”. تلك المنصات التي وُعدنا بأنها ستمنح الجميع فرصة التعبير، تحولت إلى مسرح كبير للعبث، يصفق فيه الجمهور لكل ما يثير الغرائز أو يقتل الوقت. لكن المشكلة ليست في التقنية نفسها، بل فينا نحن. في جوعنا للانتباه، وفي رغبتنا أن نُرى مهما كان الثمن. كل شخص يحمل هاتفًا صار يظن أنه يملك جمهورًا ينتظره، وأن من حقه أن يملأ الفضاء بالكلام. ومع الوقت، تلاشت الحدود بين ما يستحق أن يُقال وما يجب أن يُترك في الصمت. صارت التفاهة أسلوب حياة، وصار الغباء خيارًا يُمارَس بوعي!. من يتأمل هذا المشهد لا يمكنه إلا أن يشعر بالأسى. لأن هذا الطوفان من اللاجدوى ليس مجرد تسلية، بل هو إضعاف حقيقي للوعي العام. حين يتعوّد الناس على المحتوى الفارغ، يصعب عليهم تذوّق أي شيء آخر. وحين يصبح المعيار الوحيد هو عدد المتابعين، تضيع القيمة، ويصبح كل شيء قابلًا للاستبدال، حتى العقل نفسه. تلك المنصات التي بدأت كمساحة للتواصل، تحولت إلى ساحة منافسة محمومة على الظهور. لم يعد المحتوى يعني شيئًا، بل المهم أن تكون حاضرًا، مهما كان ثمن الحضور. نرى أشخاصًا يبنون شهرتهم على الإساءة، أو على تقليد الآخرين، أو على عرض تفاصيل لا تخص أحدًا، ثم يتعاملون مع كل ذلك كأنه إنجاز. ومع الوقت، يصبح المشهد مألوفًا إلى حد الخطر، حتى لم نعد نستغربه. ورغم كل ذلك، لا بد من الاعتراف بأن وسائل التواصل لم تخلق هذه الحالة من العدم، بل كشفتها فقط. كانت موجودة منذ زمن، لكنها لم تكن تملك منبرًا بهذا الاتساع. ما نراه اليوم هو انعكاس لما كنا نرفض الاعتراف به: أن الثقافة العامة تعاني هشاشة حقيقية، وأننا تركنا الذوق الجمعي يتراجع حتى صارت الرداءة عادية، بل ومحبوبة أحيانًا. ربما نحتاج إلى شجاعة مضاعفة لنقول إن المشكلة ليست فيهم فقط، بل فينا أيضًا. في صمتنا الطويل، وفي تهاوننا مع القبح حين كان صغيرًا. كل مرة سكتنا فيها عن السخف، ساهمنا في تضخيمه. وكل إعجاب نضغطه بلا تفكير، يمنح الغباء عمرًا أطول. ومع ذلك، لا ينبغي أن نفقد الأمل. فكما أن هذه المنصات جعلت التفاهة مرئية، فقد منحت الوعي أيضًا فرصة لأن يُسمع. الفرق أن الوعي لا يصرخ، ولا يستعجل النتيجة، ولا يبحث عن تصفيق. الوعي يزرع، حتى في أرض صلبة. هناك دائمًا من يبحث عن المعنى وسط هذا الضجيج، ومن يقدّر الكلمة الصادقة حين يجدها. نعم، لولا وسائل التواصل الاجتماعي لما صدقنا أن جمهور التفاهة بهذا الحجم وهذه القوة وهذا الإصرار على ممارسة الغباء. لكنها في الوقت نفسه منحتنا فرصة نادرة لنرى حجم ما ينتظرنا من عمل طويل وشاق لاستعادة الذوق والعقل والاتزان. لا سبيل لذلك إلا أن نتوقف عن المشاركة في الكرنفال اليومي للسطحية، وأن نحمي أنفسنا من أن نصبح جزءًا من هذا الجمهور الذي يصفق لما يطفو، لا لما يستحق أن يبقى.
870
| 20 أكتوبر 2025
أتابع مشاهد العائدين إلى بيوتهم أو ما تبقّى منها في شمال ووسط غزة، وأشعر أن قلبي ينهض واقفًا أمام هذا الطوفان البشري المفعم بالعزم. رجالٌ ونساءٌ وأطفالٌ يسيرون في طرقٍ ربما لم تعد تعرفهم كما كانت وكما كانوا، بين حجارة فقدت ترتيبها، وجدرانٍ تهاوت لكنها ما زالت حية. كل خطوة من خطواتهم تشبه اعترافًا صامتًا بالحياة، وكل التفاتة نحو الخلف تقول: «ها نحن لم نُمحَ ولم نباد». ليست العودة هنا إلى البيوت فحسب، بل إلى معنى الوجود ذاته. فهؤلاء الذين غادروا تحت القصف، وعادوا تحت الهدنة، لم يعودوا كما كانوا. في عيونهم شيء من الرماد وشيء من الضوء، وفي أصواتهم ما يشبه صدى الأمهات اللواتي ما زلن ينادين أبناءهنّ من تحت الركام. كأنّ غزة كلّها تمشي الآن على قدمَي ذاكرةٍ تحاول أن تتذكّر شكلها قبل الألم. البيوت التي كانت قبل الحرب تحتضن أحلام الصغار، تحوّلت إلى خرائط من الغياب. ومع ذلك، ترى أهلها يقتربون منها بخشوعٍ غريب، كمن يزور مقامًا مقدّسًا، يلمسون الجدران المتهاوية بأطراف أصابعهم كأنهم يعتذرون منها عن الغياب، أو يشكرونها لأنها صمدت إلى هذا الحدّ. امرأةٌ تمسح على غبار نافذةٍ مهدّمة، كأنها تمسح على وجه ابنٍ لم يعد. طفلٌ يبحث بين الأنقاض عن لعبته القديمة، ربما لأنه يريد أن يقنع نفسه أن الطفولة ما زالت ممكنة ولو من شظية. أفكّر في هذا الصبر الذي لا تفسير له إلا أنه نسيجٌ من الإيمان والكرامة، لا يتعلّمه المرء في مدرسة، بل يُورّث كما يُورّث الاسم والتراب. هناك في تلك الأزقة الضيقة، يضع الناس على أكتافهم خساراتٍ أثقل من العمر، ومع ذلك يمشون برؤوسٍ مرفوعة، وكأنهم يعرفون أن الانكسار لا يليق بهم. لقد تعلّم الفلسطيني أن يحيا في قلب العاصفة، وأن يصنع من الألم جسراً يعبر عليه نحو الغد. رحم الله الشهداء الذين بدمائهم أوقفوا دوران القتل ولو إلى حين، وجعلوا لهذه الهدنة معنى يتجاوز السياسة، معنى يُشبه استراحة الروح من صخب الفقد. أولئك الذين رحلوا لم يذهبوا عبثاً، فها هم اليوم يفتحون الطريق للعائدين إلى بقايا بيوتهم، يرافقونهم بنسيمٍ خفيف يمرّ بين الركام، يذكّرهم أن الأرض تعرف أبناءها حتى وإن تغيّر وجهها. وها هو الشعب الجبّار يبرهن من جديد أن الحياة ليست نقيض الموت، بل امتداده في شكلٍ آخر. أن يُعيد المرء بناء بيتٍ سقط، أو يزرع زهرة في فناءٍ مهدوم، أو يرفع علمًا فوق جدارٍ مائل، كلّها أفعال مقاومة بقدر ما هي أفعال حبّ. فليس أعظم من أن يصرّ المرء على أن يعيش رغم كل ما يُفقده الحياة معناها. أمام مشاهد العائدين، أشعر أن العالم كلّه مدعوٌّ ليتعلّم من هذا الشعب درسه الكبير؛ أن الكرامة لا تُقصف، والأرض، مهما تهدّمت، تظل تلد أبناءها من تحت الركام. في وجوههم المضيئة برماد الحريق أرى ما هو أعمق من الانتصار العسكري وأصدق من الشعارات السياسية؛ أرى معنى الإنسان حين يتمسّك بحلمه الأخير، أن يكون حيّاً، فقط حيّاً، فوق أرضه التي تشبهه. وما بين رائحة الرماد وصوت المؤذّن في المساء، تنهض غزة كما تنهض القصيدة بعد آخر بيتٍ موجع. لا تطلب شفقة العالم ولا تصدر بيانًا للعزاء، بل تكتفي بأن تفتح عينيها على نهارٍ جديد، كأنها تقول للسماء: “ما زلتُ هنا”. هناك، حيث ينفض الناس الغبار عن أرواحهم قبل ثيابهم، تتجلّى البطولة في أبسط أشكالها: في امرأة تشعل موقدًا من حجارةٍ مهدّمة، في طفلٍ يضحك من قلب الفراغ، في رجلٍ يزرع نبتة صغيرة بجوار قبرٍ حديث. تلك ليست تفاصيل عادية، بل إعلان حياةٍ يتجاوز اللغة نفسها، كأن غزة تكتب بفعلها ما لا تستطيع البشرية أن تعبّر عنه بالكلمات.
297
| 13 أكتوبر 2025
في غزة، ليس ثمة خيارات متاحة بالمعنى المألوف للكلمة، ولا مسارات آمنة يمكن أن يسلكها المرء ليتفادى كلفة القرار. هناك، كل خطوة محسوبة بدم، وكل نفس مرهون بإرادة لا تضعف، حتى حين تبدو محاصرة بين موتٍ معلن وحياةٍ مؤجلة. في غزة، الهدوء ليس استراحة، والهدنة ليست طمأنينة، والحرب ليست فقط ساحة رصاص وقنابل، بل امتحان مستمر لجوهر المعنى نفسه: معنى أن تكون، ومعنى أن تصمد، ومعنى أن تحمل الحقيقة على كتفيك ولو أثقلتك الأرض كلها. حين تُعرض على غزة هدنة طويلة، يُسأل أهلها عن ثمن الصمت؛ كيف يرضون بتجميد جرح مفتوح، وحين يرفضون الهدنة ويمضون في خيار الحرب، يأتي السؤال من الضفة الأخرى؛ ماذا عن دماء الشهداء الذين يسقطون كل ساعة؟ أما إذا قرروا أن يتشبثوا بصمود صامت، لا اتفاق فيه ولا هدنة ولا مساومة، فيُتهمون بأنهم يلقون بمصير الأبرياء إلى المجهول. غزة دائمًا في قفص الأسئلة. وكلما أجابت على سؤال، تفرّع منه سؤال جديد، بينما الذين يلقون هذه الأسئلة يجلسون في مأمن بعيد، لا يصل إليهم الدخان ولا يلامس وجوههم الرماد، ومع ذلك يوزّعون شهادات النصر والهزيمة وكأنها أوراق امتحان. لكن، من يملك حق وضع معايير النصر أصلًا؟ هل يكفي أن يتوقف القصف حتى يُقال إنهم انتصروا؟ أم أن النصر هو الثبات على الحق، ولو هُدمت البيوت فوق ساكنيها؟ أم أن الانتصار الحقيقي يتجلى حين تتحول الشهادة إلى معنى يتجاوز الموت، ويصير الدم مدادًا يكتب التاريخ بدل أن يُمحى به؟ في غزة، كل هذه الأسئلة تتشابك، حتى يفقد المرء القدرة على التمييز بين هدنة وانفجار، بين صفقة واستمرار، وبين ما يُكتب على الورق وما يُكتب بالدم. الهدنة قد تمنح لحظة تنفس، لكنها قد تحمل أيضًا سمّ الانتظار الطويل. والحرب قد تكون دفاعًا عن كرامة، لكنها تفتح أبواب الفقد على مصاريعها. والصمت قد يبدو حيادًا، لكنه في غزة يصبح لغة أخرى للمقاومة، لغة لا تُترجم بسهولة للغرباء. في غزة، لا تُقاس الأمور بميزان الربح والخسارة كما يفعل المحللون الباردون في نشراتهم المسائية، بل بميزان أثقل؛ بوزن الطفل الذي يعود جثةً بين ذراعي أمه، أو بوزن أمٍّ تقرأ أسماء أولادها على لائحة الشهداء، أو بوزن شيخٍ يفتح باب بيته المهدّم كأنه ما زال بيتًا، ويجلس أمامه ليعلن أن المكان ما زال قائمًا ما دام قلبه يخفق. ما لا يفهمه كثيرون أن غزة لا تبحث عن الانتصار في تعريفات الآخرين، ولا تنتظر ختمًا دوليًا يمنحها شرعية الصمود. غزة تعرّف النصر بطريقتها الخاصة؛ أن يظل طفلها يحلم، وأن تظل شوارعها قادرة على استقبال الأقدام ولو غمرها الركام. النصر في غزة لا يُقاس بالمساحات التي تُسترد، بل بالمعنى الذي يُسترد من قلب الموت.وربما لهذا السبب، لا يمكن أن تُحاصر غزة حقًا، حتى لو أحاطتها الجدران والأسلاك. فثمة مساحة في داخلها لا يستطيع أحد الوصول إليها؛ مساحة الإيمان بأن للحق وزنًا أثقل من كل الدبابات، وأن الدم حين يسيل يصبح ملكًا للتاريخ، لا لقاتله. هناك، يصبح الصبر لغة يومية، ويتحول الانتظار من فعل سلبي إلى طقس حياة، ويتحوّل الخوف نفسه إلى شجاعة متجددة. نعم.. لا يملك أهل غزة إلا أن يستمروا في اختبار هذه المعاني، مرة بعد مرة. يُدركون أن طريقهم مليء بالفقد، لكنهم يعرفون أيضًا أن لا شيء يضيع حين يتحوّل الموت نفسه إلى معنى جامع للحياة. فغزة لا تعيش لتنتصر بالمعايير الجاهزة، بل لتُبقي معنى الانتصار حيًّا، متجددًا، عصيًّا على المصادرة. هكذا، يظل المرء في غزة بين ثلاثة احتمالات؛ أن يصمد وينتصر، أن يستشهد وينتصر، أو أن ينتظر وينتصر. وكل احتمال منها، على قسوته، لا يُختصر بكلمة واحدة، بل يتوسع ليشمل تاريخًا كاملاً من المقاومة والمعنى. أما الآخرون، فسيظلون يسألون ويحللون، من بعيد، غير مدركين أن غزة ليست مجرد قضية مطروحة على الطاولة، بل تجربة وجودية تتجاوز حدود الجغرافيا. تجربة تُلزم كل من ينظر إليها أن يعيد النظر في معنى النصر، ومعنى الحياة نفسها.
417
| 06 أكتوبر 2025
هناك لحظات تفاجئ المرء في منتصف الطريق، لحظات لا تحتمل التأجيل ولا المجاملة، لحظات تبدو كأنها قادمة من عمق الذاكرة لتذكره بأن الحياة، مهما تزينت بضحكاتها، تحمل في جيبها دائمًا بذرة الفقد. كنتُ أظن أني تعلّمت لغة الغياب بما يكفي، وأنني امتلكت مناعة ما أمام رحيل الأصدقاء، لكن موتًا آخر جاء هذه المرة أكثر اقترابًا، أكثر إيغالًا في هشاشتي، حتى شعرتُ أن المرآة التي أطل منها على وجهي اليوم ليست إلا ظلًّا لامرأة كانت بالأمس بجانبي. قبل أيام قليلة رحلت صديقتي النبيلة لطيفة الثويني، بعد صراع طويل مع المرض، صراع لم يكن سوى امتحان صعب لجسدها الواهن وإرادتها الصلبة. كانت تقاتل الألم بابتسامة، كأنها تقول لنا جميعًا: لا تسمحوا للوجع أن يسرقكم من أنفسكم. لكن ماذا نفعل حين ينسحب أحدهم فجأة من حياتنا تاركًا وراءه فراغًا يشبه هوة بلا قاع؟ كيف يتهيأ القلب لاستيعاب فكرة أن الصوت الذي كان يجيب مكالماتنا لم يعد موجودًا؟ وأن الضحكة التي كانت تفكّك تعقيدات أيامنا قد صمتت إلى الأبد؟ الموت ليس حدثًا يُحكى، بل تجربة تنغرس في الروح مثل سكين بطيئة، تجبرنا على إعادة النظر في أبسط تفاصيل حياتنا. مع كل رحيل، يتقلص مدى الأمان من حولنا. نشعر أن الموت، ذلك الكائن المتربّص، لم يعد بعيدًا في تخوم الزمن، بل صار يتجوّل بالقرب منا، يختبر خطواتنا، ويتحرّى أعمارنا التي تتقارب مع أعمار الراحلين. وحين يكون الراحل صديقًا يشبهنا في العمر، ويشاركنا تفاصيل جيل واحد، تصبح المسافة بيننا وبين الفناء أقصر وأكثر قسوة. لم يعد الموت حكاية كبار السن، ولا خبرًا يخص آخرين، بل صار جارًا يتلصص علينا من نافذة الجسد والذاكرة. صديقتي الراحلة كانت تمتلك تلك القدرة النادرة على أن تراك من الداخل، وأن تمنحك شعورًا بأنك مفهوم بلا حاجة لتبرير أو تفسير. لهذا بدا غيابها ثقيلاً، ليس لأنها تركت مقعدًا فارغًا وحسب، بل لأنها حملت معها تلك المساحة الآمنة التي يصعب أن تجد بديلًا لها. أفكر الآن في كل ما تركته خلفها من أسئلة. لماذا نُفاجأ بالموت كل مرة وكأنها الأولى؟ أليس من المفترض أن نكون قد اعتدنا حضوره؟ ومع ذلك يظل الموت غريبًا في كل مرة، جديدًا في صدمته، جارحًا في اختباره، وكأنه يفتح جرحًا لم يلتئم أبدًا. هل نحن من نرفض التصالح معه، أم أنه هو الذي يتقن فنّ المداهمة حتى لو كان متوقعًا؟ ما يوجعني أكثر أن رحيلها كان درسًا لا يمكن تجاهله: أن العمر ليس سوى اتفاق مؤقت بين المرء وجسده، وأن الألفة مع الحياة قد تنكسر في لحظة. كل ابتسامة جمعتها بنا، وكل كلمة قالتها في محاولة لتهوين وجعها، تتحول الآن إلى شاهد على شجاعة نادرة. رحيلها يفضح ضعفنا أمام المرض، لكنه في الوقت ذاته يكشف جمال قدرتها على الصمود حتى اللحظة الأخيرة. إنها واحدة من تلك الأرواح التي تترك أثرًا أبعد من وجودها الجسدي. صارت بعد موتها أكثر حضورًا مما كانت عليه في حياتها. حضور من نوع مختلف، يحاورنا في صمت، ويذكّرنا بأن المحبة الحقيقية لا تموت، بل تعيد ترتيب نفسها في قلوبنا. وربما لهذا نشعر أن الغياب ليس غيابًا كاملًا، بل انتقالًا إلى شكل آخر من الوجود، وجود نراه في الذكريات، في نبرة الصوت التي لا تغيب، في اللمسة التي لا تزال عالقة في الذاكرة. أكتب عن لطيفة رحمها الله اليوم ليس لأحكي حكاية موتها، بل لأواجه موتي القادم. كلما فقدت صديقًا أدركت أن حياتي ليست طويلة كما كنت أتوهم، وأنني أسير في الطريق ذاته، بخطوات متفاوتة، لكن النهاية تظل مشتركة. وما بين بداية ونهاية، ليس أمامي إلا أن أعيش بشجاعة، أن أتمسك بالبوح كما كانت تفعل، وأن أبتسم رغم الألم كما كانت تبتسم. نعم.. الحياة ليست سوى فرصة قصيرة لتبادل المحبة، وأن أجمل ما يبقى بعدنا ليس عدد سنواتنا، بل نوع الأثر الذي نتركه في أرواح من أحببنا. هكذا فقط يمكن أن يتحول الموت من وحشة جارحة إلى معنى يفتح فينا شرفة أمل، حتى ونحن نغالب الفقد الثقيل. مثواك الجنة يا صديقتي.
4683
| 29 سبتمبر 2025
ليستْ مجرد صورةٍ عابرةٍ تلك التي يُنتجها الذكاء الصناعي لتُظهر المرء وهو يعانق طفولته. للوهلة الأولى تبدو اللعبة بريئة، ظريفة، وربما مثيرة للعاطفة؛ لكن ما إن يطيل المرء النظر حتى تتكشف طبقات من الرعب المختبئ في هذه التقنية التي تُعيد تركيب الأرشيف الشخصي على نحو يتجاوز الحقيقة. ما الذي يعنيه أن ترى نفسك جالساً إلى جانب طفلٍ كنتَه ذات يوم؟ أهو استدعاء للذاكرة أم اقتحامٌ لها؟ هل نحن أمام لحظة حنينٍ حميمة أم أمام تزويرٍ صامت للتاريخ الشخصي؟ الفارق بين تأمُّل صورةٍ قديمةٍ لك محفوظةٍ في صندوق العائلة، وبين رؤية صورةٍ أُقحِمت قسراً في سياقٍ جديد لم يحدث أبداً، هو الفارق ذاته بين شهادةٍ صادقةٍ وروايةٍ مُختلقة. صنعت لي إحدى المتابعات صورةً من هذا النوع. رأيت فيها نفسي أحتضنُ ذاتي الصغيرة، فارتجفت. لم يكن الخوف من فرط الغرابة بقدر ما كان من فرط الحقيقة المزوَّرة. بدت الصورة كما لو أنّها التقطت فعلاً في زمنٍ بعيد، كأنها أرشيفٌ مهمل عُثر عليه فجأة، مع أني أعلم يقيناً أنني لم أكنها يوماً. لحظة الارتباك تلك كافية ليفتح المرءُ أبواباً واسعة من الأسئلة حول علاقتنا بالذاكرة وبالصور. في الصور القديمة يبقى الأرشيف شاهداً صادقاً، حتى حين يفضح هشاشتنا ويكشف آثار الزمن على ملامحنا. أما في صور الذكاء الاصطناعي، فيُستدعى الأرشيف ليخضع لسيناريو جديد لا وجود له في السيرة. هنا لا نُستعاد ذواتنا بل نؤلّف نسخةً هجينة عنها، نصفها حلم ونصفها تزوير. إنها محاولةٌ لخلق «مصالحةٍ بصرية» مع الذات الطفلة، لكنها مصالحةٌ مشبوهة. كأن المرءَ يحتاج إلى برهانٍ ملموس على أنه ما يزال يحتفظ بصلته بالطفولة، في حين أن هذه الصلة الحقيقية تعيش في القلب والذاكرة، تلمع بلا إنذار، لا في صورةٍ مصطنعة. والمخيف أن هذه الصور قد تتحوّل بمرور الوقت إلى جزءٍ من أرشيفنا الفعلي، فيختلط الحقيقي بالوهمي، ويصبح تاريخُ المرء عرضةً للتلاعب الجمالي. فإذا ضاعَت الحدود بين ما كان حقاً وما كان مجرد تركيبٍ ذكي، فلن نعرف بعد سنواتٍ أيُّ الصور توثّق حياتنا حقّاً وأيها اختراع بارد. ولا يتوقف الأمر عند الذاكرة الفردية فحسب، بل قد يتسع ليطال الذاكرة الجماعية أيضاً. تخيّلوا أن يُعاد تركيب صورٍ لأحداث كبرى، أو أن تُزرع في الأرشيف البصري لشعبٍ ما مشاهدُ لم تقع أصلاً. عندها لا تكون القضية مجرد لعبةٍ عاطفيةٍ شخصية، بل مشروعاً خطيراً لإعادة كتابة التاريخ على مقاس الخيال المصطنع. ومع ذلك، لا يمكن إنكار جاذبية هذه الصور الغامضة. تستفز فينا حلماً دفيناً باللقاء المستحيل؛ أن يلتقي المرء بنفسه قبل أن يبتلعه العمر، أن يضع ذراعيه حول طفولته ليحميها من قسوة ما سيأتي. وربما لهذا السبب لا نقدر على تجاهلها سريعاً، رغم شعورنا بالقلق منها. إنها تجمع بين الرغبة في الاطمئنان والرهبة من الاصطناع، بين الحنين إلى الأصل والفضول تجاه النسخة. هكذا تتحول الصورة المولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى اختبارٍ فلسفي لعلاقتنا بالذاكرة. هل نحتاج فعلاً أن نزور طفولتنا كي نتصالح مع حاضرنا؟ أم أن الأرشيف، بما فيه من فجواتٍ وندوبٍ ونقصان، أجمل حين يظلّ على حاله؛ صادقاً، هشّاً، وغير مكتمل؟ كأن الذكاء الاصطناعي حين يصنع لنا هذه الصور لا يُقدّم مجرد لعبةٍ بصرية، بل يضعنا أمام سؤالٍ وجودي ملحّ؛ هل نحن بحاجة إلى اختلاق صورةٍ لنشعر أننا ما زلنا نملك طفولتنا؟ أم أن الطفولة الحقيقية لا تُستعاد إلا بما تركته فينا من دهشةٍ وجرحٍ وحنين؟ ربما يكمن الجمال في أن تبقى تلك المسافة قائمة بيننا وبين صغارنا الذين كناهم يوماً، مسافة تجعل اللقاء مستحيلاً لكنه حاضرٌ أبداً في الذاكرة؛ لتبقى الطفولة حية لأنها ضاعت، لا لأنها استُعيدت في صورة مستعارة.
699
| 22 سبتمبر 2025
ثمة لحظة تتفجّر فيها الرغبة بالكتابة كما لو أنها حاجة جسدية لا تحتمل التأجيل. لحظة تشبه انفتاح نافذة في غرفة خانقة، يدخل منها هواء جديد يوقظ الروح من سباتها، ويمنحها فرصة أن تتأمل وجهها في مرآة اللغة. الكتابة ليست استعراضًا لغويًا ولا عرضًا لإبهار جمهور مجهول؛ إنها، قبل كل شيء، امتحان عميق للذات، ووسيلة لاكتشاف ما يختبئ في الزوايا المظلمة من وعينا، حيث تتكدس الأسئلة والخيبات والأحلام المؤجلة. حين يضع المرء قلمه على الورق، فإنه يتخلى عن كثير من الأقنعة التي يلبسها في الحياة اليومية. الكلمات تتسلل إلى ما وراء الحذر الاجتماعي والتمثيل المفروض، لتصل إلى جوهره الصافي. الكتابة بهذا المعنى ليست طقسًا من طقوس التجميل، بل فعل مواجهة. مواجهة مع الذات أولًا، ثم مع العالم. لكنها مواجهة بلا سيوف ولا شعارات، مواجهة حقيقية تحدث في صمت الورقة وهدوء اللحظة، حيث يكون الكاتب عاريًا من كل تزييف، محاطًا فقط بحروفه التي تحاكمه وتمنحه في الوقت نفسه فرصة النجاة. ما يكتبه المرء ليُرضي الآخرين يفقد حرارته سريعًا، لأنه لا يشبهه. يظل أشبه بوجهٍ مزيّنٍ بمساحيق مؤقتة، ينهار عند أول قطرة مطر. بينما الكلمات التي تنبع من الداخل، حتى لو جاءت بسيطة أو مرتجفة، فإنها تحمل صدقًا لا يمكن تزويره، وتظل قادرة على ملامسة الآخر، لأنها كتبت بدم صاحبها لا بحبر زائف. وحده الصدق يملك هذه القدرة السحرية على العبور من قلب إلى قلب، ومن تجربة فردية ضيقة إلى أفق إنساني واسع. الكتابة تشبه الرسم بألوان شخصية لا تتكرر. كل جملة لون، وكل فكرة خط، وكل صمت مساحة بيضاء تحتمل احتمالات لا حصر لها. الكاتب الحقيقي لا يستعير ألوان الآخرين، بل يصنع لوحته الخاصة، حتى لو لم تنل إعجاب أحد. فالإعجاب الخارجي زائل بطبيعته، أما اللوحة التي تخرج من عمق الذات فتبقى جزءًا من هوية المرء، شاهدة على أنه كان هنا ذات يوم، يحاول أن يقول شيئًا يخصه وحده. قد يظن البعض أن الكتابة وسيلة للتجمّل أمام القراء أو لادعاء الحكمة، لكن التجربة الحقيقية تكشف عكس ذلك. الكتابة تجعل صاحبها يكتشف ضعفه قبل قوته، ارتباكه قبل يقينه، وتردده قبل قراراته الكبرى. إنها مرآة بلا رحمة، لكنها أيضًا مرآة كريمة، لأنها تمنح من يتأملها فرصة إعادة التشكل، وترتيب الفوضى الداخلية بطريقة أكثر إنسانية. من يكتب لن يخرج من النص كما دخل إليه؛ يخرج مختلفًا، محمّلًا بمعرفة جديدة عن ذاته وعن معنى أن يكون حيًا في هذا العالم المليء بالتناقضات. لهذا، لا يجوز أن تُختزل الكتابة في محاولة كسب إعجاب عابر. إن أعظم ما تمنحه هو تلك اللحظة التي يرى فيها المرء صورته الحقيقية منعكسة على بياض الصفحة. صورة ربما لم يكن يجرؤ على مواجهتها في المرايا التقليدية. صورة تحمل شروخه الصغيرة، جراحه القديمة، وكذلك بقايا الضوء الذي لم ينطفئ فيه رغم كل شيء. في تلك اللحظة يدرك أن الكتابة لم تكن ترفًا، بل ضرورة وجودية، وأن كل نص يكتبه ليس سوى محاولة لإنقاذ نفسه من الغرق في صمت لا يطاق. إن الكتابة، في جوهرها، ليست سوى سعي دائم للعثور على الذات بين الكلمات. ليست درسًا في البلاغة ولا استعراضًا للنصوص المحفوظة، بل تجربة حميمة، تبدأ بجرأة الاعتراف وتنتهي بحكمة الاكتشاف. ومن يمارسها بصدق، سيكتشف أن النص الحقيقي لا يشبه إلا صاحبه، وأن أعظم جائزة يمكن أن ينالها الكاتب ليست تصفيق الآخرين، بل تلك الطمأنينة العميقة التي تأتيه حين يجد نفسه أخيرًا وجهًا لوجه مع صورته في مرآة الكلمات.
546
| 15 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية

بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله...
2373
| 30 نوفمبر 2025

ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الانطلاق المنتظرة لبطولة...
1125
| 01 ديسمبر 2025

في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه...
654
| 02 ديسمبر 2025

في زمنٍ تتزاحم فيه الأصوات، وتُلقى فيه الكلمات...
642
| 28 نوفمبر 2025

يحكي العالم الموسوعي عبد الوهاب المسيري في أحد...
564
| 30 نوفمبر 2025

كل دولة تمتلك من العادات والقواعد الخاصة بها...
495
| 30 نوفمبر 2025

في كلمتها خلال مؤتمر WISE 2025، قدّمت سموّ...
483
| 27 نوفمبر 2025

للمرة الأولى أقف حائرة أمام مساحتي البيضاء التي...
447
| 26 نوفمبر 2025

استشعار نعمة الأمن والأمان والاستقرار، والإحساس بحرية الحركة...
447
| 27 نوفمبر 2025

يقول المثل الشعبي «يِبِي يكحّلها عماها» وهي عبارة...
438
| 30 نوفمبر 2025

أكدت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، في المادّة...
429
| 28 نوفمبر 2025
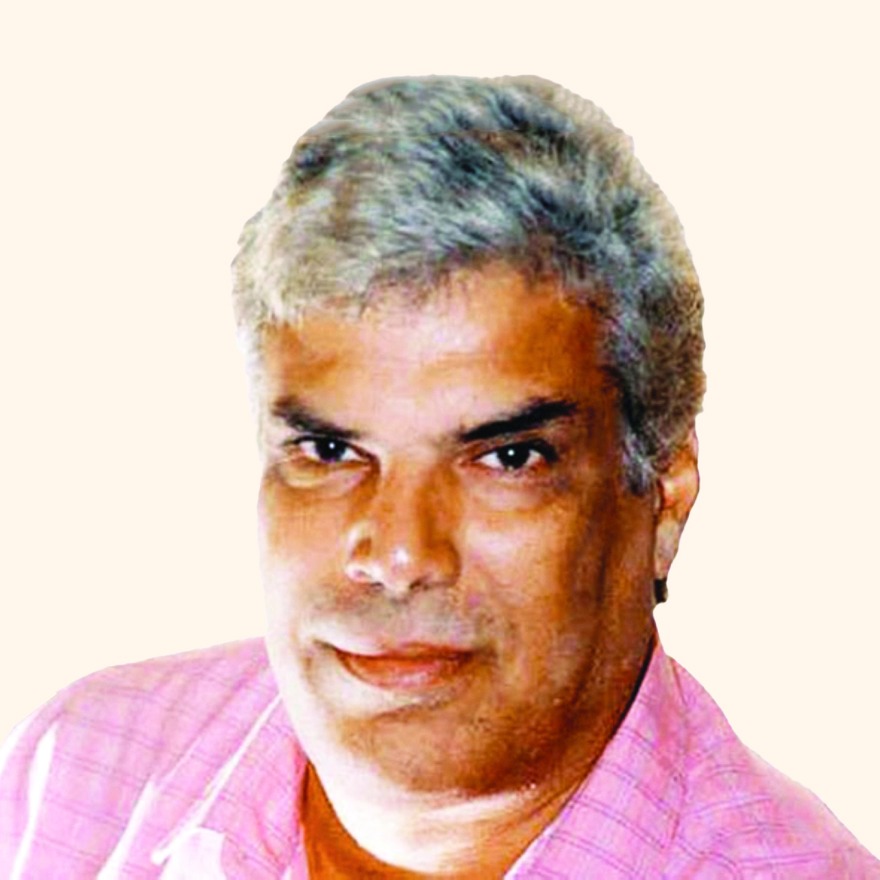
شاع منذ ربع قرن تقريبا مقولة زمن الرواية....
414
| 27 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







