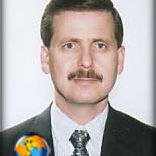رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منذ أيام، كان رئيس ائتلاف المعارضة السورية أحمد الجربا الضيف الخاص في قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي كلمته أمام القادة الخليجيين قال الجربا: "المشاركة في جنيف2 لا تعني بأننا ذاهبون إلى ندوة سياسية مع مجموعة من النظام، بل تعني لنا بوضوح أننا ذاهبون لتخليص بلدنا من الدمار والإجرام والحصول على الدولة السورية، واستقلال القرار الوطني، فنعم لجنيف2 وفق الأسس والمعطيات التي حددناها في رؤية الائتلاف الوطني، والتي حددناها في لقاء لندن الأخير، أي وفقا لمؤتمر جنيف الأول". ومن ناحية أخرى، شدد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة ألا يكون لـ"أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري أي دور في الحكومة الانتقالية أو المستقبل السياسي في سوريا". هذا الاتفاق الكامل بين الطرفين على الثوابت المتعلقة بمؤتمر جنيف2 أمرٌ في غاية الأهمية للثورة السورية في هذا المفرق الحساس، لكنه يدل أيضاً على إدراك دول الخليج العربي لحقائق تتعلق بدورها ودور سوريا المستقبل في المنطقة. وعلى إصرارها على لعب هذا الدور بغض النظر عن مواقف المجتمع الدولي، خاصة أمريكا التي تعتقد أنها تفهم المنطقة، لكن الوقائع والأحداث أثبتت مرةً تلو الأخرى عكس ذلك. والاعتقاد بأن أمريكا تفهم المنطقة سائدٌ في أمريكا لكنه سائدٌ أيضاً خارجها. فمن الانطباعات الشائعة في العالم العربي والإسلامي أن أمريكا قادرةٌ على فهم هذين العالمين بشكلٍ كامل. ولتبرير مصداقية هذا الانطباع تُطرح المقولات عن وجود مؤسسات الدراسات ومراكز الأبحاث التي (ترصدُ كل صغيرةٍ وكبيرة) في المجتمعات العربية والإسلامية، كما يؤكد على الدوام أصحاب تلك الانطباعات. هذا فضلاً عن تهويلهم بقدرة أجهزة الأمن والتجسس الأمريكية (الخارقة) على متابعة وتحليل متغيرات الواقع في تلك المجتمعات، بحيث يمكن لها إعطاءُ صورةٍ دقيقة عن ذلك الواقع للإدارة السياسية الأمريكية. والحقيقة أن هذه الآراء تحمل من التعميم والخيال ما يتجاوز الحقائق التي يُظهرها الواقع على الدوام. وقد يتمثّلُ أبرز مثال على ذلك في التصورات الخاطئة تماماً، والتي كانت سائدةً في إدارة بوش الابن قبل غزو العراق عن هذا البلد وعن ثقافته وتركيبته الاجتماعية والثقافية، والتي تبيّن مع الأيام درجةُ مجانبتها للواقع على الأرض. لا نقللُ هنا من قدرة مراكز البحث والتحليل الأمريكية المدنية والأمنية والعسكرية على رصد الواقع العالمي ومتغيراته، وعلى طرح سيناريوهات متعددة للتعامل معه بما يحقق المصالح الأمريكية. لكننا بالتأكيد نرفض ذلك التعميم القاطع بقدرة هذه المراكز على رسم صورةٍ دقيقة عن الواقع العربي والإسلامي في كل زمان ومكان وعلى رسم سياسات صائبة تجاهها. ويأتي في هذا الإطار الصورةُ التي كانت سائدةً في الأوساط السياسية الأمريكية عن دول مجلس التعاون الخليجي العربي على وجه التحديد. إذ لا نكشف سراً حين نقول إن تلك الصورة كانت مبنيةً على رؤية المنطقة من منظور كونها خزاناً استراتيجياً للنفط أولاً وقبل كل شيء آخر. وبالتالي، فإن علاقة أمريكا مع تلك الدول كانت محصورةً في صياغة سياساتِ تعاون تُرّكزُ على أمن المنطقة، واستمرار قدرتها على ضخ النفط في شرايين الاقتصاد العالمي. لهذا، لم تأخذ تلك السياسات بعين الاعتبار لعقودٍ طويلة التأثيرَ الممكن لدول الخليج في السياسات الإقليمية وحتى العالمية، إلا من خلال ذلك الجانب الوحيد، أي المسألة النّفطية. تغيّرت هذه النظرة إلى حدٍ ما بعد أحداث سبتمبر المعروفة، لكن المدخل كان أيضاً جزئياً حين تمّ اختزالهُ في موضوع التعاون على مكافحة الإرهاب. لكن الغالبية العظمى من المراكز التي نتحدث عنها غفلت، ومعها الإدارات الأمريكية، عن عنصرٍ استراتيجي جديد وحساس يتمثل في الدور الثقافي والإعلامي والتعليمي المتصاعد لدول الخليج، ليس في المنطقة العربية فقط، وإنما في العالم الإسلامي وخارجه في بعض الأحيان. وقد صاحب هذا أيضاً التأثير السياسي الذي جعل دورها يزداد وضوحاً. حصلَ هذا بتأثير الانفتاح الثقافي المتزايد في المنطقة من جانب، وبمساعدة الإمكانات والموارد الاقتصادية المتميزة التي تملكها من جانبٍ آخر. واليوم، بمناسبة ما يجري في سوريا، تُعيد دول الخليج العربي تأكيد دورها السياسي في المنطقة، وهو دورٌ مبنيٌ على فهمها لمخاطر (المجازفات) الكامنة في الموقف الدولي عامةً، والأمريكي تحديداً، من الثورة السورية وتطوراتها، خاصةً في الآونة الأخيرة. ثمة لحظةٌ تاريخية فاصلة تمرﱡ بها المنطقة، وما يجري في سوريا محورها الأكبر. ودول الخليج العربي تُدرك حساسيتها ونتائجها أكثر من غيرها بكثير. لهذا، ليس غريباً أن تمضي الدول المذكورة في ممارسة دورها بقوةٍ ووضوح، وأن تشجع المعارضة السورية على التمسك بثوابتها فيما يتعلق بجنيف وغير جنيف، بغض النظر عما يعتقده الآخرون. ببساطة، لأن أهل مكة أدرى بشِعابها.
544
| 15 ديسمبر 2013
بعيداً عن ضغط التفكير الأيديولوجي، وانطلاقاً من واقعية يتطلبها الحال، ويقول بضرورتها السوريون جميعاً على اختلاف انتماءاتهم المتنوعة. يمكن التأكيد أن (الإسلام) سيكون، بأي شكل من الأشكال، عاملاً مؤثراً في مسار الثورة الراهن وفي رسم صورة سوريا الجديدة، ليس فقط على مستوى الهوية الوطنية، بل وعلى مستوى التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. المؤسف في الموضوع إن غالبية عظمى ممن لا (يقبضون) الإسلام من السوريين مثقفين ونُشطاء، وأقولُها بالعامية لدلالاتها، يتعاملون مع هذه الحقيقة باستخفاف وسطحية لا يحتملهما المقام. فهم أولاً وآخر يعيشون هاجس الهوس بكيفية تخفيف ذلك التأثير أو إلغائه، في محاولةٍ هي أشبه ما تكون بالغرق في أحلام النهار. يأتي هذا للأسف على صورة مناورات سياسية، وتحالفات محلية وإقليمية ودولية، بل وأحياناً على شكل تقية أصبح الجميع ماهراً في استعارتها وتطبيقها من المذهب الشيعي الذي يشكون منه. ونادرة جداً هي المحاولات من قبل تلك الشريحة لقبول الحقيقة المذكورة أعلاه، ولفهم خلفياتها المُعقدة، والتعاون على استيعابها، بحيث يكون الإسلام المطلوب في سوريا إسلاماً حقيقياً يُطلق طاقات البناء والتعمير، ويؤكد معاني العدل والحرية والكرامة والمواطنة والتعددية، ويكون تصديقاً عملياً لقيمه الحضارية الكبرى. في مقابل هذا، نركزُ بشكل متزايد في هذه المقالات على كل ما يتعلق بالمُراجعات في الفكر الإسلامي بأي طريقة، وصولاً لتحقيق الهدف المذكور أعلاه. ويأتي في هذا الإطار استعادة أدبيات قديمة نسبياً لتلك المراجعات، كان يمكن لها أن تصل بنا لواقع مختلف اليوم، لو أن أهل الحركة وأصحاب الجماعات والتنظيمات أولوها شيئاً من الاهتمام والتفكير في وقتها.. وهذا موضوع نعود إليه لاحقاً. من هنا، نقتبس فقرات مطولة نسبياً من تقديم الأستاذ عمر عبيد حسنة لكتاب بعنوان (في فقه الدين فهماً وتنزيلاً) للدكتور عبدالمجيد النجار نُشر قبل خمسةٍ وعشرين عاماً! ليتأمل المهتمون من السوريين في دلالاته ويعملوا بمتطلباته، خاصة منهم القوى الفاعلة على الأرض عسكريين ومدنيين. يقول الكاتب: "لقد كان المجتهد جزءا من الحياة يتعامل معها ويحترف بحرفها ويخوض معاركها ويكون لمشاهداته ومعاناته الميدانية نصيبٌ كبير من فقهه، أما عندما انفصل المجتهد عن مجتمعه، وابتعد عن هـمومه فقد فاته الإدراك الواعي لمشكلاته، فجاءت اجتهاداته اجتهادات نظرية مجردة، تنطلق من فراغ، وتسير في فراغ، مما جعل بعض المفكرين يطلقون عليها مصطلح (فقه الأوراق) لأنها تكونت بعيدا عن واقع الناس وميدان نشاطهم. فأي قيمة للحكم تبقى إذا لم ينزل على محله وكيف يعرف محله دون دراسة وعلم؟! لذلك نرى من لوازم الاجتهاد اليوم، الاستيعاب المعرفي الشامل للواقع الإنساني، وهذا لا يتأتى كله من مجرد المعايشة، والنزول إلى الساحة - الأمر الذي لابد منه - وإنما النزول، والتزود قبله، بآليات فهم هـذا الواقع، من العلوم الاجتماعية التي توقفت في حياة المسلمين منذ زمن، ذلك أن عدم الاستيعاب والتحقق بهذه الشروط اللازمة لعملية الاجتهاد، أدى إلى انفصال أصحاب المشروع الإسلامي، عن واقع الحياة، وإن لم ينفصلوا عن ضمير الأمة، التي لا تزال ترى في المشروع الإسلامي بوارق الأمل للإنقاذ والتغيير. والتغيير لابد له من إدراك المراد الإلهي أولا ومن ثم آليات فهم المجتمع بالمستوى نفسه، حتى يتم الإنجاز. لقد تعاظم المد الإسلامي إلى آفاق لم تكن بالحسبان، لكن لابد من الاعتراف بأن حركة الاجتهاد لترشيد تدين هـذا المد، ووضع البرامج والأوعية الشرعية لحركته، لم تكن بالمستوى المطلوب، ولا الموازي لحركة المد الإسلامي، ذلك أن الجماهير المسلمة آمنت بالإسلام، لكنها لم تبصّر بالواقع وكيفية التعامل معه، وتقويمه بنهج الدين. لقد امتُلكت القاعدة الإسلامية العريضة وافتُقدت القيادة الواعية الرشيدة الفقيهة، فلحقت بها إصابات بالغة ليست كلها بسبب أعدائها، وهذا يقتضي ديمومة النظر وبذل الجهد والاجتهاد في كل وقت وعصر للإفادة من الخطاب الإلهي في تقويم مسالك الناس ومعالجة مشكلاتهم وفق الهدي الديني، ذلك الاجتهاد (الفقه) الذي يمكن أن نمثل له بدور الطبيب، الذي يدرس حالة المريض، ويحدد أسباب المرض وآثاره، ويختار له من مجموعة الأدوية المحفوظة في الصيدلية، ما يناسبه ويعالج حالته، دون أن يكون لذلك آثار جانبية قد تعيق شفاء المريض، أو تضاعف مرضه، أو تفضي إلى الإصابة بمرض آخر. فالصيدلي الذي يحفظ الدواء ويعرف مركباته يبقى عاجزا عن المعالجة؛ لأن المعالجة لا تكفي فيها معرفة الدواء، وإنما تتطلب المعرفة الدقيقة بحالة المريض وما يناسبه وما لا يناسبه من الدواء، والمقادير المطلوبة، والزمن المقدر، والتوازن بين أكثر من دواء إلخ. فمنهج النقل والحفظ للخطاب الإلهي أقرب ما يكون إلى عمل الصيدلي، ومنهج الفهم والفقه من هـذا المنقول أقرب ما يكون شبها بعمل الطبيب، وقد لا تفيد كثيرا كثرة الصيادلة، ومعامل الدواء، إذا انعدم وجود الأطباء؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى وضع الدواء في غير محله، فيهلك المريض من حيث يراد له الشفاء والنجاة. هـذه هـي المشكلة اليوم التي يعاني منها الواقع الإسلامي، وهي مؤشر مؤرق بسبب غياب فقهاء المجتمعات، وفقهاء التربية، وفقهاء التخطيط، وفقهاء استشراف آفاق المستقبل، وفقهاء علوم الإنسان، فقهاء الحضارة عامة، الذين يشكلون عقل الأمة، ويعرفون كيف يغترفون من هـذا الإسلام، لمصلحة الأمة في واقعها المعاصر، وكيف يتعاملون مع هـذا الإسلام، ويعودون بالأمة إليه. ويصير الأمر أكثر لزوما بعد الإحباطات الكثيرة التي تعرض لها العمل للإسلام، بسبب العجز الواضح في فقه الحركة والميدان، وإبداع البرامج العملية التي تترجم القيم والمبادئ الإسلامية وتنزلها على واقع الناس المعاصر، في ضوء رؤية ذات دراية وفقه، وتتأكد وتتعاظم مسؤولية المشتغلين بالقضية الإسلامية في أن يطرحوا الأمر بجدية وموضوعية، بعيدا عن الحماس والتوثب، وخروجا على الأسوار الحزبية وممالأة الجماهير، وردود الأفعال، والأساليب التعبوية، التي أدت دورها كاملا في مرحلة إعادة الانتماء للإسلام والتي باتت لا تفيد كثيرا في مرحلة الانطلاق إلى الأمام". انتهى النقل ويبقى تعلقٌ لابد منه: ثمة من يريدون إقامة "دولة إسلامية" اليوم قبل الغد في سوريا، وحري بهؤلاء تحديداً، وكل من يفكر بالإسلام حلا بشكل عام، أن يفكروا كثيراً في دلالات الكلام السابق ومقتضياته، بعيداً عن الحماس والاندفاع تحت أي مسمى من المسميات.
569
| 08 ديسمبر 2013
رغم أن العالم العربي بعيدٌ عن أمريكا بالجغرافيا الطبيعية، إلا أن أقدار الجغرافيا السياسية تجعل هذه المقولة التي أطلقها مفكرٌ مكسيكي عن بلادهِ تنطبق على العرب بشكلٍ أو بآخر. ففي هذه الأيام، تُذكرك ممارساتُ أمريكا والدول الغربية الكبرى، بمستوى الهزل واللامسؤولية الذي يكمن في النظام الدولي المعاصر. ورغم أن هذا النظام يحاول تغطية مساوئه بين حينٍ وآخر، وغالباً من خلال الشعارات الرنانة، إلا أن رائحة المساوئ المذكورة تعود لتظهر بقوة بسبب عَفَنها الشديد الذي لايمكن الهروب منه في نهاية المطاف. يأتي هذا الكلام في معرض التعليق على الاتفاق الإيراني مع مجموعة الخمسة زائد واحد، الأسبوعَ الماضي. والذي باتَ بكل وضوح، وبعيداً عن المُجاملات الدبلوماسية، حلقةً أخرى في مسلسلٍ قبيح تتالى حلقاته في الفترة الأخيرة، ويتمثل في التجاهل الكامل لمصالح الدول العربية، ولمصالح دول الخليج العربي تحديداً. ربما يفيدنا التاريخ لنفهم حقيقة هذا النظام من خلال مواقف البعض وأقوالهم فيه. ففي يومٍ مضى، كان وزير الخارجية الأمريكي الحالي جون كيري مُرشحاً لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال حملته الانتخابية، أطلق وعداً من تلك الوعود التي يُطلقها الساسة ليتلاعبوا بها بمشاعر المواطنين، وهم يعلمون أنهم لن ينفذوها على الأغلب. فقد وعدَ السيد كيري الأمريكيين يومها بكل ثقة بأنه إذا ما تم انتخابه رئيساً، فإن البترول السعودي لن يجد طريقه إلى الأسواق الأمريكية! لم يكن ممكناً على الإطلاق طبعاً تنفيذ مثل هذا الوعد وقتَها، كما يستحيل تماماً تنفيذه ولو جزئياً الآن أو في المستقبل. وتظل هذه حقيقة رغم كل التسريبات المدروسة من هنا وهناك عن اكتشافات النفط الجديدة في أمريكا، وعن إمكانية استغنائها عن النفط العربي بشكلٍ عام، والسعودي تحديداً. كل ما في الأمر أن هذه الحادثة تُذكرنا بحقيقة وجوهر السياسة الدولية القائم في كثيرٍ من الأحيان على المناورات والكذب والخديعة والتخويف، قبل أي شيءٍ آخر. ورغم أن السياسي الأمريكي يوجين ماكارثي قال يوما إن "من الخطير على مرشحٍ لمنصب فيدرالي أن يقول شيئا يمكن أن يتذكره الناس"، إلا أننا نتذكر ما حصل بالرئيس جورج بوش الأب حين أشار بإصبعه في حملة إعادة انتخابه إلى فمه قائلاً "اقرؤوا شفاهي ، لن تكون هناك ضرائب جديدة" . ثم إنه عندما أصبح رئيساً وجد نفسه مضطراً إلى فرض ضرائب جديدة، الأمر الذي جعل المرشح المنافس يومها بيل كلينتون يستخدم تلك (الكذبة) كواحدةٍ من أمضى الأسلحة في حملته الانتخابية الناجحة ضد بوش الأب. السياسة سوقٌ وسيركٌ وغابة، كما يقول أحد الكتاب. لكن من الواضح أنها يمكن أن تكون أكثر وأسوأ من ذلك فيما يبدو. فمنذ عقود، لخص الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، المعروف بصراحته، رأيه في السياسة بهذه العبارة: "من المفترض في السياسة أن تكون ثاني أقدم مهنة في العالم، ولكنني أدركتُ مع الوقت أن هناك شبهاً كبيراً بينها وبين أقدم مهنة".. ربما يرفض الكثيرون هذا الرأي، وربما يجرحُ الكلامُ البعضَ من أصحاب المشاعر المُرهَفة، لكن المهم في الموضوع أن هذه العبارة تعبر عن تصورٍ معين للسياسة كان وما زال وسيبقى موجوداً، إلى درجة أو أخرى، ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما في غير مكان في هذا العالم فيه ساسةٌ وسياسة. وهانحن نرى مايجري اليوم في هذا العالم، خاصةً فيما يتعلق بالموقف من الشعب السوري وثورته، وهو موقفٌ لايمكن أن يذكرك إلا بكلام ريغان في توصيفه للسياسة والسياسيين. مامن شكٍ أن أمريكا حققت بعض المصالح في الاتفاق المذكور، لكنها أيضاً فتحت باباً آخر للهيمنة الإيرانية على المنطقة قد يُثبت التاريخ أنه فُتح نتيجة أخطاء في الحسابات، صارت من لوازم السياسة الأمريكية في المنطقة. وعلى سبيل المثال، يجدر بالأمريكان وغيرهم التساؤل عن أسباب ترحيب البعض بالاتفاق بشكلٍ كبير، بدءاً من حزب الله الذي اعتبر أنه "انتصار نموذجي وإنجاز عالمي نوعي تضيفه الجمهورية الإسلامية إلى سجلها المشرق بالانتصارات والإنجازات"، وصولاً إلى هيثم مناع الذي أكد أيضاً أنه انتصارٌ لإيران والدول الستة التي اتفقت معها لأنه يرسخ السلام والتهدئة في المنطقة. نعرف دائماً أن السيد مناع لايرى في كل ماجرى ويجري للشعب السوري علاقةً بموضوع السلام، لكن الأنكى أن يجدها فرصةً للحذلقة وممارسة أسلوب الترهيب والترغيب، حين يقول، من جانب، إن الاتفاق يسمح لدولٍ مثل السعودية ومصر بالدخول في النادي النووي السلمي، حسب تسميته. لكنه يعود ليهددنا ويهدد دول الخليج بقوله: "إن الخوف اليوم لم يعد محصوراً بالخوف على سوريا فقط، بل أصبح يشمل المنطقة كلها". هكذا، تسمح أمريكا، ومعها حلفاؤها وحلفاء النظام، بتهديد مصالح دول الخليج العربية عملياً بكل وضوحٍ وبساطة، في حين تمارس نظرياً سياسة بيع الشعارات والكلام المنمق إلى درجةٍ صارت سمجةً ومُملة. نحن ندرك أن العلاقات الدولية لاتُمارس بعقلية الأبيض والأسود، ولا بطريقة كل شيء أو لاشيء. لكن هذا الإدراك نفسه يجب أن يدفعنا جميعاً إلى تفكيرٍ خلاق يحفظ المصالح. وقد يتمثل المدخل الأسرعُ الآن في العمل بجديةٍ وقوة لإيجاد أمرٍ واقعٍ يفرض نفسه في سوريا لأنها باتت الساحة التي ستكون المفرق في تحديد خارطة المنطقة، كما أشارت صحيفة النيويورك تايمز الأسبوع الماضي نقلاً عن برنارد هيغل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، الذي أشار إلى أن عدم هزيمة الإيرانيين في سوريا ستأخذ المعركة بأسرها إلى المناطق الأخرى الحساسة في الإقليم.. خلال حملتها الانتخابية أيضاً، قالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: ""إن التحدي يكمن في ممارسة السياسة كفنٍ يجعل عدم الممكن يبدو وكأنه ممكن". لهذا يحاول الساسة الأمريكان أن يطبقوا القاعدة، ولكنهم يدركون في النهاية أن مايجب أن يكون سيكون، ويتعاملون معه بواقعية ومرونة بغض النظر عن تصريحاتهم السابقة. خاصةً إذا فهم الآخرون هذا الأمر، وتعاملوا معه بحكمة.. لهذا، تشيع بين الأمريكان عامةً، وبين الساسة على وجه الخصوص، عبارةٌ تؤكد على إمكانية التعامل مع كل أمرٍ واقع، وهي تقول: "سنفكر كيف نعبر ذلك الجسر عندما نصل إليه". لكن علينا أن نأخذهم إلى الجسر قبل ذلك.
490
| 01 ديسمبر 2013
كثيراً ما يَغفل بعض الملتزمين من المسلمين عن الآثار السلبية التي تنبثق (عملياً) في واقعنا من شيوع عقلية التشدد، ومن الإفراط في رسم الحدود والموانع والمُحرﱠمات. لا نتحدث هنا عن النتيجة المعروفة لتلك المشكلة، حين يؤدي تزايدها إلى التطرّف وإلى ممارسة العنف غير المشروع بأي شكلٍ من أشكاله في حقّ الآخرين من البشر، مسلمين كانوا أو غير مسلمين. فرغم أن تلك الظاهرة بحدّ ذاتها في غاية السلبية، إلا أنها معروفة ومشهورة ويجري الحديث عنها بشكلٍ كثير في أدبياتنا الفكرية والشرعية والثقافية، وقد تحدثنا عنها في أكثر من مقال. أما الحديث في هذا المقام، فإنه يتمثل في تأثير تلك المشكلة على المصابين بها أنفسهم، وليس على الآخرين. وهو ما أرجو حقاً أن يفكّر به بهدوء وتجرّد وبعيداً عن التشنّج خاصة أولئك الذين يشعرون بأن حفظ الإسلام وتحقيق مقاصده لا يُمكن أن يحصل إلا من خلال مداخل سدّ الذرائع، ومن خلال رفع سقف الضبط والربط الذي يؤدي، في اعتقادهم، إلى تمييع الدين وإفراغه من مضمونه ومعانيه. إن الإصرار على تلك الممارسات إنما يدلّ قبل أي شيءٍ آخر على إصرارٍ مؤلم للعيش في مرحلة الطفولة البشرية وفي التمسّك بأساليبها والتشبّث بوسائلها البدائية البسيطة. وهي ممارسات لن ينتج عنها غير خداع الذات، لأن أقصى ما تستطيع تحقيقه هو محاصرة النفس، ومحاصرة بعض الدوائر القريبة منها، داخل بعض الأسوار الثقافية المحلّية أو الإقليمية، في الوقت الذي تجتاحُ فيه الثقافات المنفتحة هذا العالم من مشرقه إلى مغربه، إلى درجةٍ تتآكل معها حتى تلك الدوائر المغلقة من أطرافها شيئاً فشيئاً. ولن يمضي وقت طويل حتى يجد من يحاول العيش في هذا العالم بتلك العقلية نفسه وقد اقتحمت عليه تلك الثقافات ما كان يظنه حِصنه الحصين، وسَحبت من بين يديه كل غالٍ ورخيص. إن جميع صور المبالغة التي يمكن وضعها في خانة الغلوّ والتشدّد، من المبالغة في التعلق بالغيبيات، إلى المبالغة في رسم الحدود والموانع والمحرّمات، إلى المبالغة في كبت النّفس والعقل، تدفع الإنسان إلى أن يدخل شيئاً فشيئاً في حالةٍ من الشلل الذّهني والنفسي التي يفقد معها الحيوية العقلية والقدرة على الحركة العملية، بحيث يصبح بين خيارين أمام هذا العالم المتفجر بالحيوية من حوله: فإما أن ينفجر في وجه العالم بصورةٍ من صور العنف أياً كانت، أو يبدأ في الهروب منه تدريجياً وفي الانزواء في قواقع تزداد ضيقاً من الرفض والانسحاب والعزلة، إلى درجة الاستسلام الكامل وانتظار الموت خلاصاً من هذا الواقع الأليم. ولكن ما يؤلم أكثر هو أن كلا الخيارين يمكن أن يُمارَسا، عن طيب نيّة، في لَبوسٍ خادعٍ من دعاوى وشعارات التضحية والتميّز والغربة والثبات على المبدأ، وغيرها من القيم الصحيحة في ذاتها، ولكن فقط حين تُوضعُ ضمن ذلك الإطار الواسع الذي يطرحه الإسلام عن الدين ودوره العظيم الذي يدفع الإنسان للتفاعل الدائم والمتجدد مع الحياة في كل صورها وألوانها ومتغيراتها. وحتى لا يكون في الأمر لبسٌ يؤدي إلى الإفراط في مقابل التفريط الذي نشكو منه، فإن من الضرورة بمكان التفكير في مصطلح المُبالغة ودلالاته المقصودة في هذا المقام. فالإيمان بالغيب، وبما هو وراء طاقة الإنسان على الإدراك، وبالقَدَر خيرهِ وشرّه، ليس هو المُبالغة التي نتحدث عنها على سبيل المثال، وإنما المقصودُ بها ذلك التواكل المُستكين، وتلك الظنون الفارغة والأوهام السخيفة والقراءات الخيالية للنصوص والآثار التي تتحدث عن أسباب العزة والنصر والتمكين، في مقابل البحث عن أسباب النصر الحقيقية والأخذ بها، كما يجب أن يكون الحال عليه في سوريا هذه الأيام. وكذلك، فإن الإيمان الفطري الطبيعي بالحلال البيّن والحرام البيّن ليس المبالغة التي نتحدث عنها، وإنما المبالغة تكمن في طباع التشدد والعنت والقسوة والغلاظة التي تريد أن تفرض نفسها على الرؤية الإسلامية الأصيلة، فتُحرِّم كثيراً من الطيبات ومما أحلَّ الله لعباده، وتريد أن تعيد إلى الناس شرعة الإصر والأغلال بعد أن حرّرهم الله منها. وأخيراً، فإن رفض المبالغة في كبت النفس والعقل لا يعني إطلاق العنان للشهوات والغرائز الحيوانية، ولا إغفال بعض حدود العقل أمام علم الله المطلق، ولا إنكار دلالات النص الصحيح المُحكَم، وإنما تعني رفض تقزيم العقل وتقييده ومنعه من التحليق بقوةٍ وعزيمة في آيات الأنفس والآفاق بدعوى إجلال الله. وتعني رفض ممارسات الكبت والتحريم المتعسّفة، ورفض العودة إلى الرهبانية المبتدعة والمرفوضة في أي شكلٍ من أشكالها. فهذه هي المبالغاتُ التي تؤدي إلى الشلل العقلي والنفسي والعملي، وتؤدي إلى افتقاد القدرة على العمل والحركة الفعلية بغرض تحرير الأرض والإنسان من كل القيود. وذلك هو الشلل العقلي والنفسي والعملي الذي كان يحاصر كثيراً من الجماعات والحركات في العالم العربي والإسلامي، وهو يحاصر بعض من يتحدثون باسم الإسلام في سوريا اليوم. هذه حقيقةٌ يعترف بها كل مُنصِف، ونأمل ألا يقع البعض في إنكارها لمجرّد المعاندة. كما نأمل أن تكون حقاً مجالاً لكثيرٍ من الدراسة والتفكير والمُراجعات، خاصة في معرض البحث عن الوسطية الإسلامية في سوريا المُستقبل. ويرحمُ الله الإمام سفيان بن سعيد الثوري، الذي انعقدت له الإمامة في الفقه والحديث والورع، حين قال فيما نقله عنه الإمام النووي في مقدمات المجموع: "إنما الفقهُ الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيُحسنه كل أحد".
619
| 24 نوفمبر 2013
في يومٍ مضى من تاريخنا، وتحت فصلٍ بعنوان (في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)، كتب الإمام ابن قيم الجوزية، تلميذ ابن تيمية، في أحد كتبه الكلام التالي: "هذا فصلٌ عظيم النفع جداً، وَقعَ بسبب الجهل به غلطٌ عظيمٌ على الشريعة، أوجبَ من الحَرَج والمشقّة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسُها على الحكم ومصالحِ العباد في المعاش والمعاد. وهي عدلٌ كلها، ورحمةٌ كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألةٍ خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل..... فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظلّهُ في أرضه، وحكمته الدّالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتمّ دلالةٍ وأصدقها". وكتب في مقامٍ آخر قائلاً: "ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفِهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضلﱠ وأضلﱠ، وكانت جنايتهُ على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتابٍ من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان". ثم أردف قائلاً في موقعٍ ثالث: "فمهما تجدد العُرفُ فاعتبره، ومهما سقط فألغِهِ، ولا تجمُد على المنقول في الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجلٌ من غير إقليمك يستفتيك فلا تُجرِهِ على عرف بلدك، وسَلهُ عن عُرف بلده فأجرِهِ عليه وأفتِهِ به، دون عرف بلدك والمذكور في كتبك. قالوا: فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين". هل قرأ بعض من يدﱠعون تمثيل الإسلام في سوريا اليوم هذا الكلام؟ من الواضح أن في الأمر مصيبة إذا كانوا لم يقرأوه، وأن المصيبة أعظمُ إذا كانوا قد قرأوه. كيف يمكن لأي فئةٍ أن تدﱠعيَ بأن فهمها للإسلام هو الفهم الأمثل له؟ ثم أن تَقسر الناس على اتباع هذا الفهم؟ إن كلام ابن قيم الجوزية، الذي يُعتبر جوهرياً في كيفية فهم الإسلام وتطبيقه في الواقع، يتضاربُ كلياً مع مثل ذلك الادعاء الذي يقتضي عملياً احتكار فهم الإسلام واحتكار تمثيله. صحيحٌ أن الانتماء للإسلام، والغيرة عليه وعلى أبنائه، والانشغال بحاضره ومستقبله، حقٌ لكل من ينتمي إليه بشكلٍ من الأشكال. بل ربما يمكن القول إن ذلك الأمر هو واجبٌ عليه. ولكن من الضرورة بمكان التعامل مع هذه المسألة بنوع من الحساسية والحذر والانتباه. خاصة عندما تأخذ حركة الإنسان ونشاطاته أبعاداً جماعية تخرج عن إطار دائرته الفردية، خاصة عندما يصبح لتلك الحركة وذلك النشاط تَبِعاتٌ جماعيّة، ويترتّبُ عليها نتائج تؤثر في مصائر مجموعات أخرى من البشر صغيرة كانت أو كبيرة، من المسلمين أو من غير المسلمين. إن الذي يغارُ بحق على مصير الإسلام والمسلمين يجب أن يكون أكثر حذراً في حركته ونشاطه ومواقفه وتصرفاته من غيره من الناس، لأنه يعلم أن كل تلك الحركة وكل تلك المواقف تنبني على اجتهادٍ يمكن له أن يكون اجتهاداً خاطئاً في نهاية المطاف. وبالتالي فإن الآثار التي ستترتّب على ذلك الاجتهاد يمكن لها دوماً أن تكون سلبية بشكلٍ كبير. وكلّما كانت القضية التي يتعلق بها ذلك الاجتهاد كبيرةً وحساسةً ومتشابكة الأطراف، كان الخطأ فيها سبباً للكوارث والمصائب، وسبيلاً لحصول مصائب وأهوال تلحق بالعباد والبلاد، وبشكلٍ لا ينفع في تبريره إطلاقاً صدقُ النيات وطيبةُ القلب وإخلاصُ السرائر. لأن الاجتهاد الذي تنبع عنه مثل هذه الكوارث يكون دائماً اجتهاداً في غير محلّه، ولا يمتلك صاحبه الحدّ الأدنى من نصاب الاجتهاد في قضيةٍ بهذا الحجم وهذا التعقيد. من هنا، فسيكون صاحب هذا الاجتهاد الذي لم يمتلك شروطَ القيام به موزوراً غير مأجور. وهذا تصحيحٌ لفهمٍ مُتعسف للحديث الذي يتحدث عن أجرِ من يجتهد فيُخطئ. لأن الأصل في أي اجتهادٍ يتمثل في امتلاك شروطه ومقدماته، وهذه لا تقتصر على النية بأي حالٍ من الأحوال. وإن من أغرب الأمور وأكثرها مدعاةً للتساؤل والمراجعة، تلك السهولة البالغة التي يجدها البعض في ادّعاء الاجتهاد بقضايا كبرى تمسُّ بتأثيراتها المتشعبة كثيراً من الدول والشعوب، مثلما هو الحال في بعض ما يجري في سوريا، وأن يحصل هذا بدعوى الإخلاص والتفاني والغيرة على مصلحة الدين والإنسان. وإن المصيبة الأخرى الموازية تتمثل في قبول بعض من يُسمّون أنفسهم علماء ومشايخ ومثقفين ونُشطاء بتلك الدعاوى وإقرارهم لها، ولو بالسكوت عنها، بل وفي التماس المزيد من الأعذار والتبريرات لمن يقوم بتلك الأعمال، ثم التغاضي عن النتائج الكارثية التي تنتج عنها، والقولُ ببساطة إن هذه النتائج إنما تدخل في باب الفتنة والتمحيص والابتلاء والقَدَر المقدور. بدلاً من التصدي مبكراً وبشكلٍ حازم وحاسم، وبكل الوسائل والأساليب، لكلّ من يُدخلُ سوريا وثورتها وحاضرها ومُستقبلها في هذه الأنفاق الخطيرة والمجهولة. من هنا، يُصبح مطلوباً بإلحاح تحرير مسألة فهم الإسلام وحصر تمثيله في جماعةٍ معينة، تنطلق من ظروفها الخاصة وأحوالها المُعيّنة، وتتحرك بناءً على حدود علمها التي كثيراً ما تكون في غاية القصور، لتقوم بأفعال وتصرفات، ولتتصدى لقرارات ومخططات، تتجاوز بكثيرٍ قدرتها على الإحاطة وتنتج عنها مستتبعاتٌ تؤثر على الآخرين. هذا شيء من جدية يقتضيها المقامُ في سوريا الثورة، وضرورة لوقف استخفاف كبير بالإسلام لا يليق به، ولم يعد ممكناً السكوت عليه بأي حالٍ من الأحوال.
2570
| 18 نوفمبر 2013
تحدثنا في المقال السابق عن عدم وجود أي علاقة بين أسلمة الأتراك من جانب وأسلمة العرب والسوريين من جانب آخر، وتساءلنا عن الأسباب التي يمكن أن تفسر الظاهرة المذكورة. والحقيقة أن أحد الأسباب يتمثل في اختلاف تعريف (الأسلمة)، وبالتالي في تحديد مضمونها ومراحلها وأولوياتها، بل وحتى أهدافها النهائية، خاصة في مجال الممارسة السياسية. ذلك أن أهل التجربة التركية وصلوا مع امتداد تلك التجربة زمانياً، وتميزها نوعياً، إلى رؤية ومعايشة مستوى مغاير من التحديات. وقد أفرزت هذه التحديات وتُفرز أسئلة من الواضح أنها لم تُطرح بعد في أوساط الإسلاميين العرب والسوريين تحديداً (باستثناء بصيص أمل في التجربة التونسية). لهذا يبدو أحيانا حين تقترب من العمق أن أصحاب التجربة الأتراك يعيشون في عالم آخر لا يمت بصلةٍ إلى ما يعيشه أقرانهم العرب، رغم تشابه بعض التعابير والمفردات على المستوى النظري. فالأسلمة في الحالة التركية تكاد تكون مرادفاً آخر لمفهوم (الإصلاح) و(البناء) الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، بشكل يؤكد على (العودة) إلى العصر والدخول في الزمن الراهن للعيش في (الحاضر) بدلاً من المحاولات المستمرة للهروب منه، إما إلى الماضي، أو إلى مستقبلٍ بعيد في (الآخرة) بداعي كون الحياة بكل مكوناتها (ابتلاء) و(فتنة) ما من سبيل للتعامل معهما إلا بشكلٍ عابر، تمهيداً لـ (خَلاصٍ) لن يأتي بغير انتهاء الوجود البشري الشخصي أو العام. والأسلمة في الحالة التركية تعني التعامل مع حاجات الناس وهمومهم وتطلعاتهم، وأن يحصل هذا بلغة هذا العصر وأدواته، وأن يُؤخذ بالاعتبار كل ما في العصر من حيوية وتغيير واختلاف وتناقض وتوازنات. بعيداً عن شعارات (المفاصلة) مع الواقع وإنكار حقائقه ومكوناته. بالمقابل، يؤكد التعريف الغالب لمحاولات (الأسلمة) السورية الراهنة، إضافة إلى تجميد الزمن، على محاصرة وتنميط الفعل البشري في قوالب محدّدة ومحدودة من الممارسات. وهو ما يجري بشكلٍ واضح في كثير من المناطق التي تُسيطر عليها فصائل إسلامية في سوريا بدرجاتٍ متفاوتة. ووفقاً لهذا التصور، يجب أن تسير الجماهير (خلف) الحركة التي تقود الفعل وتوجهه، وهي في وضعنا السوري. كما يجب أن يتم وفق قراءة الحركة وفهمها للدين وللعصر على حدّ سواء. بمعنى أن دور الجماهير من الفعل البشري يقتصر على الاستجابة والالتزام. وحين يتحقق هذا في أعلى درجاته تبلغ الأسلمة أوجها وتصل إلى تمامها. بالمقابل، يثق أهل التجربة التركية بالجماهير وبقدرتها هي على صناعة الحياة. لكنهم يدركون طبيعة دورهم لتحقيق ذلك الهدف. لهذا لا يرون أي معنى لمحاولة قسر الملايين على تحقيق معايير أخلاقية معينة في ظل افتقاد مقومات الشعور بالكينونة الإنسانية على المستويين الثقافي والمادي. خاصة في مجتمع تعرّض على مدى عقود لظروف سياسية واقتصادية لم تساعد على ذلك. لا يمكن بطبيعة الحال استيفاء الحديث عن تلك المقومات هنا. لكن المؤكد أن وجودها مستحيل في غياب قيم الحرية والعدل والمساواة وسيادة القانون. وفي غياب منظومة إدارية وقانونية تسمح بالحلم والطموح، وتفسح المجال لممارسة فعل بشري ولوجود تجربة إنسانية تسعى لتحقيق الحلم والطموح، مهما كانت احتمالات الخطأ والصواب في تلك التجربة. لسنا هنا إذا بإزاء حركات وأحزاب تقدم نفسها بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال على أنها (قيادة) لديها كل الإجابات.. وإنما على العكس، نحن بإزاء حزب قدّم نفسه على أنه يريد أن يكون (إدارة) للمجتمع تسعى لتمكينه من صناعة حاضره ومستقبله. لكنها إدارة تدرك أن أسئلة الواقع كثيرة وكبيرة. وأن من المستحيل الإجابة عنها إلا من خلال الفعل التراكمي للمجتمع بجميع مكوناته وشرائحه. وبالتالي، فإن دور الإدارة ينحصر في تحقيق الشروط التي تمكن المجتمع من الوصول إلى ذلك المراد عبر ممارسات وتجارب تتسع باتساع الكمون الهائل الموجود في الفعل البشري على مستوى الفرد والجماعة. إن دراسة الواقع التركي بشيء من المتابعة والمنهجية تُظهر حقاً حجم الاختلاف في تعريف مفهوم الأسلمة بين الحركات والأحزاب الموجودة في العالمين العربي والإسلامي. فخلال زيارة عمل أكاديمية لتركيا الأسبوع الماضي تصادف أن التقيت بأكاديمي إسلامي من إحدى الدول العربية. علمت من خلال الحوار أن النشاط الأكاديمي الذي يحضره الرجل كان الهدف الثاني لحضوره. في حين كانت الأولوية لمحاولة رؤية المرحلة التي وصلت إليها عملية (أسلمة) المجتمع التركي بعد سنتين من حكم حزب العدالة والتنمية. كانت هذه الزيارة الأولى للرجل وكان واضحاً تعاطفه مع التجربة التركية على الصعيد النظري لأسباب ثقافية وتاريخية معروفة. لكنه كان يبدو أيضاً متلهفاً جداً لرؤية أمثلة محددة كانت في ذهنه لنمط معين من (الأسلمة). وحيث إن هذا النمط كان يتمحور حول جملة من المؤشرات (الظاهرية)، فقد كانت خيبة أمل الرجل كبيرة. ويمكن القول إنها بدأت بمرحلة الدهشة وانتهت بمرحلة الصدمة الكاملة. كان من أكثر ما حيّره مثلاً استمرار وجود بعض المظاهر التي تتعلق بالأخلاق في المجتمع التركي، مثل وجود الحانات والملاهي الليلية وما يلحق بها ويستتبعها من مظاهر.. من هنا، تساءل الرجل عن أصل مشروعية وجود حكومة (تدّعي أنها ذات توجه إسلامي) حسب قوله إذا لم تقم بالتعامل مع تلك المظاهر حسب التعاليم الإسلامية حتى الآن. بل إنه أكد أنه حتى لو حدثت تلك الخطوة حاليا فإنها ستكون متأخرة جداً، لأن الواجب كان يقتضي أن تبدأ الحكومة بذلك منذ الأيام الأولى لها في الحكم. (هذا أقل ما يمكن أن يفعلوه) حسب قول صاحبنا. والحقيقة أن هذا هو فعلا أقل ما يمكن القيام به حسب منظري الإصلاح من الساسة الأتراك. ولهذا السبب بالتحديد فإنه قد يكون آخر ما تفكر به الحكومة. (لم يهدم الرسول الأصنام عند بعثته بالرسالة) قال لي أحد هؤلاء: (بل إنه مضى يطوف حول الكعبة في وجود الأصنام بجانبها فترة طويلة) تابع الرجل. (لقد كان وجود الأصنام في الواقع تعبيرا عن وجودها في القلوب قبل ذلك. وبالتالي فقد كانت الإستراتيجية تقتضي هدم الأصنام في القلوب أولاً عبر تغيير ثقافة عَبَدة الأصنام. حتى إذا تحقق ذلك قاموا بهدم أصنامهم بأنفسهم دون أن يجبرهم أحد على تلك المهمة). تذكرت أنني قرأت ما يشبه هذا الطرح من مثقف عربي إسلامي منذ عشرين عاما.. فهل يؤكد هذا حقيقة أن الإسلاميين الحركيين العرب لا يقرأون؟ أم أنها تؤكد حقيقة حرصهم على تجميد الزمان؟ تبدو الإجابة مؤلمة في الحالتين.
841
| 10 نوفمبر 2013
منذ أيام احتفلت تركيا بعيد الجمهورية التسعين، بدأت الاحتفالات عند ضريح أتاتورك "آنيت كبير" بالعاصمة أنقرة. هناك، وضع الرئيس التركي عبد الله جول باقة ورد على قبر أتاتورك وسط عزف الموسيقى العسكرية للنشيد الوطني، وكتب كلمة في سجل التشريفات بالضريح قال فيها: "في ظل مكاسب جمهوريتنا التي اقتربت أن تصل لذكراها المئوية، نشعر بالفخر ببلدنا ونهوضه في جميع المجالات وصعوده كمركز عالمي". شارك في المراسم عدد من رجال الدولة وكبار العسكريين الأتراك، منهم رئيس البرلمان جميل شيشك ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش ورئيس هيئة الأركان العامة التركية نجدت أوزال، بالإضافة إلى زعماء أحزاب المعارضة. في نفس اليوم، الثلاثاء الماضي، افتتح القادة الأتراك في إسطنبول، بحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه، نفقاً عملاقاً يربط بين قارتي آسيا وأوروبا تحت بحر البوسفور، مخصص للسكك الحديدية وتعتبره السلطات "ورشة القرن" وهو بطول 14 كيلو مترا، أربع منها تحت البحر، وقد تم افتتاحه بعد تسعة أعوام من العمل. وفي المساء، بلغت الاحتفالات ذروتها حين اشتعلت سماء إسطنبول فوق مضيق البوسفور بالألعاب النارية التي حضرها مئات الآلاف وهم يلوحون بالأعلام التركية، وقد اختلطت معها صور أتاتورك وأردوغان، ويغنون الأغاني الوطنية مع صوت الموسيقى التي كانت تملأ أجواء المدينة. في اليوم التالي، أشاد رئيس البنك الدولي "جيم يونج كيم" بالاقتصاد التركي والطفرة التي استطاع تحقيقها، قائلاً إن النهضة الاقتصادية التي حققتها تركيا على مدار العقد الأخير تُعتبر شيئاً جديراً بالتقدير والاحترام. جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها كيم خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الخامس الذي استضافته ولاية "إزمير" الساحلية غربي تركيا وبحضور نحو 3400 مشارك من مختلف بلدان العالم. بعدها بيوم، بادرت ثلاث برلمانيات عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى دخول قاعة مجلس الشعب التركي بالحجاب في سابقة هي الأولى من نوعها منذ حادثة طرد النائبة المحجبة "مروة قاواقجي" من البرلمان عام 1999م. فقد عمدت كلٌّ من النائبة "سودة بيازيد كاتشار"، والنائبة "نورجان دالبوداك"، والنائبة "جولاي سامانجي"، إلى حضور جلسة مجلس الشعب التي بدأ انعقادها يوم الخميس بحجابهن، مستندات إلى القرار الذي تم اتخاذه بحرية اللباس في الدوائر الحكومية ضمن حزمة الإصلاحات الديمقراطية الأخيرة. وبهذه المناسبة، قال "محرم إينجه" نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا: إنه يعتبر أن النساء المحجبات أخوات له كما هو الحال بالنسبة لغير المحجبات، مُشيراً إلى أن شقيقته هي الأخرى ترتدي الحجاب دون أن يعارضها. وبدورها، أعربت "برفين بولدان"، النائبة عن حزب السلام والديمقراطية، الذراع السياسية لمنظمة حزب العمال الكردستاني، عن امتنانها العميق لإيجاد حل لقضية النائبات المحجبات في البرلمان. وأخيراً، صرح وزير العدل التركي "سعد الله أرجين" أن تركيا تنوي إلغاء قانون مكافحة الإرهاب فور ظهور نتائج مفاوضات السلام الحالية. مؤكداً أن بلاده كانت تنوي إبطال القانون في عام 2005م، وذلك عقب بدء العمل بالقانون الجزائي التركي، ولكن العمليات الإرهابية التي ظهرت آنذاك أدت إلى استمرار العمل به، موضحًا أن الحكومة كانت تلغي مادة أو مادتين من القانون المذكور في كل حزمة إصلاحات ديمقراطية تعلنها، وكانت تهدف إلى إلغائه وتعطيل العمل به تمامًا، إلا أن العمليات الإرهابية أعاقت هذا الأمر. وأشار أرجين إلى أن البلاد لا تعيش الآن أي صراعات أو مواجهات مع الإرهابيين بسبب مفاوضات السلام الجارية، إلا أن التهديد الإرهابي لا يزال موجودًا والسلاح لم يتم التخلي عنه بعد، منوهًا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب سيتم إلغاؤه فور ظهور نتائج المفاوضات الحالية. لا يزال البعض هنا وهناك يتحدث عن عملية (أسلمة) لتركيا يقوم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهناك من يتحدث بهذا بلغة (الاتهام) والتشكيك، وكل ما يندرج تحت عقلية التفسير التآمري للوقائع والأحداث. لا يمكن حين تستقرئ معاني الأحداث المذكورة أعلاه إلا أن تشعر بالأسى على كل من يستخدم هذا المدخل للتعامل مع الظاهرة التركية. ينطبق هذا على أجزاء من النظام الدولي السياسي العالمي، كما ينطبق على جماعات وأفراد تؤكد على هويتها (الليبرالية العلمانية)، من العرب عموماً ومن السوريين على وجه الخصوص. نترك هؤلاء في الفضاء الذي يُشكلونه من الفوضى العربية والسورية الراهنة، حيث يتضاءل الأمل في أن يكونوا جزءاً من الحل، وننتقل للحديث عن فوارق ومفارقات الأسلمة التركية، إن صحﱠ هذا (الاتهام) الموجه لتركيا، خاصة حين يتعلق الأمر بالأسلمة التي يحلم بها غالبية الإسلاميين العرب والسوريين. فثمة مائة دلالة ودلالة في الأحداث التي شهدتها تركيا خلال ثلاثة أيام فقط الأسبوع الماضي على عدم وجود أي علاقة بين أسلمة الأتراك من جانب وأسلمة العرب والسوريين من جانب آخر. لماذا وكيف حصل هذا ويحصل؟ نتابع في المقال القادم.
528
| 03 نوفمبر 2013
بغض النظر عن الهياكل والمُسميات، يجب أن يبقى فكرُ الغلو والتطرف مرفوضاً في سوريا على جميع المستويات، ويجب أن يُعلِن كل من يستطيع الإعلان عن رفضه لهذه الظاهرة في كل مكان. يسري هذا على الأفراد كما يسري على المؤسسات، ويسري على السوريين في الخارج كما يسري على كل من يستطيع منهم في الداخل. وكلما كان الإنسان، أو المؤسسة، أقرب للعمل العام، أصبح الإعلان المذكور أكثر وجوباً في حقهِ وحقها. لا مجال هنا للتذرع بشبهة تشتيت الأنظار عن المواجهة مع النظام، لأن صعود التطرف نفسَهُ بات أكبرَ ورقةٍ في يد هذا النظام إعلامياً وسياسياً واجتماعياً، يستعمُلها ضد الثورة وأهلها داخلياً وإقليمياً وعالمياً، وصار أكبر عائقٍ داخلي يخلق الكوابح والمطبات في كل ما يتعلق بالثورة وأدواتها وحاضنتها. لا فُسحة أيضاً لخوفٍ زائف بأن رفض الغلو يأتي استجابة لرغبات الغرب أو أمريكا أو أي طرفٍ من الأطراف. فبعض هذه الأطراف يطربُ أصلاً لوجود الغلو ويعتبره عنصراً رئيسياً في تبرير الاستقالة السياسية والأخلاقية للنظام الدولي من (الهم) السوري. والمتضررُ الأولُ والأكبرُ من كل ما له علاقة بالتطرف والغلو هو سوريا وثورتها، وإسلامُها الأصيل. ما هذا الذي يجري في بعض أرجاء سوريا؟ أيﱡ دينٍ هذا الذي أصبح مُختزلاً في التحريم والمنع والإجبار وملاحقة الناس وضمائرهم ومصادرة حقوقهم؟ ما علاقة سوريا والإسلام بواقعٍ أصبح فيه الإسهامُ في التحريم، والإبداعُ في الضبط، والتفننُ في المنع، وظيفةً وإنجازاً وطريقاً لتحقيق أهداف الثورة؟! لماذا حميت المنافسة، واحتدم السباق في هذه القضايا، حتى صار هناك ملكيون أكثر من الملك. ولم يعد التحريم في الدين موقوفاً على عالم دين، بل شارك فيه كل من حفظَ آيةً وحديثين وأطلق لحيةً طويلة؟ كيف خرجت مفاهيم وأدوات الضبط الاجتماعي والثقافي والأخلاقي والأدبي والفني من دائرة أهل العلم والاختصاص، وتجاوزتهم إلى كل من هبَّ ودبَّ؟ من الذي أباح لنفسه توسيع دوائر المحرﱠمات والمُقدﱠسات حتى باتت هي الأصلَ في الدين وصارت محورَ تنزيله على حياة الناس وواقعهم؟ نسي البعض أن كتاب عقيدتهم يُوصف عندما يُذكر بالـ (كريم) وليس بالمُقدّس. وأن نبيهم أيضاً يُوصف عندما يُذكر بالـ (كريم) وليس بالمقدﱠس. لم ينتبهوا إلى دلالات الفرق المعرفي والفلسفي العميق بين استخدام وصف (المقدس) للإشارة إلى الكتب والأنبياء في اللغات الأخرى، وعدم استخدامه في اللغة العربية. غفلوا أن ذلك الكتاب لا يدعو الناس إلى (تقديسه)، وإنما يدعو بدلاً من ذلك إلى النظر والتفكر والتدبر والسعي والعمل والرحمة. تجاوزوا حقيقة أن الكعبة (مُشرّفة) وليست (مقدّسة). قفزوا فوق المعاني الكامنة وراء عدم إمكانية استخدام تصريف (القدُّوس) إلا للإشارة إلى الخالق. لم يدركوا الإشارات الكامنة وراء الحرص الشديد على تجنّب التقديس للأشخاص وللأماكن وللمظاهر في النص الصحيح نظرياً، وفي العصر النقي الأول عملياً. امتلأ قاموس الحياة في بعض مناطق سوريا بالمحرمات حُكماً وعُرفاً. ووصلنا إلى درجة تشبه ما قصده الشاعر حين قال: (حمارُ الزعيمِ زعيمُ الحمير). فبات الناس يخشون حتى من الحديث عن ذلك الحمار. وما بين تحريم الحديث عن الزعيم وتجريم الحديث عن حماره، تكاثرت مواضيعُ التحريم ومواضِعُهُ كالأرانب. عَمَرَ قاموس الأخلاق والعادات الاجتماعية بجميع مصطلحات ومشتقات العيب والحرام. تمّت محاصرة معاني الحرية، وجرى تضييق معاني الاستقلالية والاختيار الشخصي، حتى بات مطلوباً من الإنسان السوري ألا يختلف عن الآلة سوى في قدرته على الطعام والشراب والإنجاب. توقف الإبداع في مجالات الفكر والثقافة والأدب والفن، حتى لو كان لخدمة الثورة! صار سهلاً وصفُ كل إبداع بأنه ابتداع، واتهامُ كل تجديد بأنه طعنٌ للأصالة، وأيﱢ خروجٍ على المألوف بأنه منكرٌ وخطيئة، وكل رأي آخر بأنه مخالفٌ للإجماع. لا يُدرك من يمارس هذه الطريقة في فهم الإسلام وتنزيله بأن توسيع دائرة المحرﱠمات بشكل سرطاني هو الوصفة المثالية لقتل عقلية الوقوف عند الحدود بشكلٍ نهائي، وهي عقليةٌ ضرورية، بتوازناتها، لاستمرار الحياة نفسها. لا يعرف هؤلاء أن جهلهم بالموضوع ليس عذراً مقبولاً على طريق صناعة مستقبل الجماعات البشرية. وأن الضغط يولد الانفجار، وأن كل ممنوعٍ يُصبح مرغوباً. وأن من المستحيل عزل السوريين ومحاصرتهم في القرن الحادي والعشرين الميلادي في أقفاص زجاجية مُحصنة، ولو كانت تتسمى بأسماء دولٍ وإمارات إسلامية. ينسى هؤلاء أنهم يعيشون في عصرٍ عاصف، ولا يعرفون شيئاً عن حيوية الإنسان بشكلٍ عام، وفي هذا الزمن تحديداً. لا يفهمون طلاقة الحياة البشرية، حيث يمكن أن تتشكل دوماً ظروف تدفع المجتمعات للانتقال من النقيض إلى النقيض. ويُمكن لممارسات الضبط والمنع والتحريم والتقليد والإجبار على (نمطٍ) معين في التفكير والحياة أن تجعل (التغيير) في حد ذاته هدفاً، وأن يريد أولئك (المُجبَرون) تجربة كل شيءٍ كان محرﱠماً عليهم، بأي طريقةٍ وبأي ثمن. الأهمﱡ من هذا كله، ينسى البعض في غمرة انغماسهم بنشوة حمل رشاش أو ركوب عربة (بي كي سي) أن السوريين ثاروا على أعتى نظامٍ في العالم، إن لم يكن في تاريخ الإنسانية، وأن ثورتهم كانت أولاً وقبل كل شيء بحثاً عن الحرية والكرامة. وأن هؤلاء قد يصبرون على ممارساتهم بُرهةً من عمر الزمان لأسباب متفرقة، لكنهم لن يقبلوا في نهاية المطاف بأن يعيشوا دون حريةٍ وكرامة، وسينقلبون بكل طريقةٍ، قد لا تخطر ببال أحد، على مثل ذلك الواقع، حتى لو تمت تغطيته بأسماء وشعارات إسلامية، والإسلامُ منها براء.
509
| 27 أكتوبر 2013
لا يختلف اثنان على درجة تعقيد العناصر المؤثرة في الثورة السورية، والاتفاق كبير على كثرة الحاجات المطلوبة، ليس فقط لخدمة الثورة ونصرها، وإنما أيضاً لإقامة سوريا الجديدة التي تمثل الهدف النهائي لذلك الانتصار. من هنا، يظل مطلوباً على الدوام البحث عن المداخل والأساليب لفهم ذلك التعقيد والتعامل معه والاستجابة لتلك الحاجات وتلبيتها. وما من سبيل للإجابة عن الأسئلة المطروحة إلا باستخدام مفردتين من لغة هذا العصر وأداتين من أدواته: التخصص والمؤسسات. ولا تبدو الحاجة لاحترام التخصص كما تبدو في حالة الثورة السورية اليوم، فمن علم الاجتماع إلى علوم الإدارة والتنظيم، ومن علم السياسة إلى العلوم العسكرية، يظهر واضحاً افتقاد الغالبية العظمى من العاملين في هذه الحقول إلى الخبرة المطلوبة للعمل فيها بفعالية. بل إن كثيراً ممن يتصدون للعمل يُسيئون بنشاطاتهم وقراراتهم إلى الثورة أكثر بكثير مما يقدمونه من فائدة. ما هي التحولات الاجتماعية التي نتجت عن الثورة السورية وملابساتها؟ كيف يمكن تشكيل هوية وطنية جامعة تلمﱡ ما تفرق من شمل شرائح المجتمع السوري؟ وهل هذا التشكيل ممكنٌ أصلاً؟ وما هي بدائله إن لم يكن ممكناً؟ لماذا فشلت تقريباً كل المنظمات والهيئات والمؤسسات التي يُفترض أنها وُجدت لخدمة الثورة وأهلها؟ لماذا تكثر هذه التشكيلات في المجال السياسي والعسكري والإغاثي والخدمي وتكثرُ معها المشكلات؟ أين المؤسسات التي تدﱠعي العمل لتمثيل الشعب السوري سياسياً من الفكر السياسي المحترف والممارسة السياسية المحترفة؟ ماذا يفعل وكيف يُخطط أكثر من 150 ألف مقاتل يُقال لنا بأنهم يحملون السلاح ضد النظام؟ هذه وغيرها أسئلةٌ كثيرة لا توجد لها اليوم إجابات حقيقية. ولو وُجدت مثل تلك الإجابات لكان وضع الثورة مختلفاً إلى حد كبير. نفهم كل ما يُقال عن وحشية النظام، وعَون أصدقائه الكثيف له، وخُذلان السوريين من قبل (أصدقائهم) مالياً وسياسياً وعسكرياً، لكن من المعيب حصر تفسيرنا لواقع الثورة السورية اليوم بتلك المقولة. خاصة أننا لا ننحو في هذا المقال إلى التخوين والطعن في نيات أحد، وإنما حسبُنا الإشارة إلى عنصرٍ نعتقد أنه السبب الأكبر في الوضع الراهن يتمثل في غياب احترام التخصص. فالثورة السورية اليوم ظاهرةٌ مشاع. وكل إنسان يُقحم نفسه في شأنٍ من شؤونها بغض النظر عن درجة معرفته وخبرته واختصاصه في ذلك الشأن. هنا تبرز الجوانب المأزومة من الثقافة الشائعة، من عقلية (أبو فهمي) الذي يفهم في كل شيء ويعتمد على شطارته وفهلوته وخبرته في الحياة معتقداً أنها تؤهله للعمل في السياسة والحرب والتنظيم والإدارة، مروراً بآفات حب الظهور والتصدر والتشاوف بأي طريقة ممكنة، وصولاً إلى التسامح السلبي المتبادَل بين أبناء المجتمع لتمرير مثل هذه الظواهر وعدم الحسم في إلغائها ومنعها لأسباب متنوعة، منها الإهمال، ومنها المحسوبية العائلية أو المناطقية أو الأيديولوجية، ومنها الفساد والرغبة في تبادل المصالح والانتفاع من الثورة. لقد تنوعت معارف الإنسان في هذا العصر واتسعت آفاقها وأصبح ازديادها من ناحية الكم وعمقها من جهة الكيف هائلاً وسريعاً إلى درجة تكاد تكون عسيرة على التصور والإدراك. وفي حين كانت العوامل التي تؤثر في حياة الأمم والشعوب في الماضي معدودة ومحصورة في بيئتها الجغرافية وواقعها الخاص. تزايدت تلك العوامل بصورة متوازية مع تقدم العلوم الإنسانية في كل مجال حتى أصبحت اليوم مجموعة هائلة لا حصر لها في العلوم والفنون والآداب والصناعات. وفي حين كان العلماء فيما مضى يتصفون بصفة الموسوعة، فنجد أحدهم عالماً في الدين واللغة والاجتماع والفلك والطب والكيمياء وما إليها.. صارت غايةُ المنى لعلماء اليوم أن تكفي حياتهم للإحاطة الشاملة الدقيقة ليس بعلمٍ واحد من العلوم، بل بموضوعٍ مُحدد من ذلك العلم. ومن أهم ملامح هذا العصر أن كثيراً من تلك العمليات العفوية التي كانت تمارسها المجتمعات أو يقوم بها الأفراد في الماضي صارت اليوم علوماً تُدرس في المدارس والجامعات وتُكتب فيها المقالات والكتب والأبحاث وتُقام لها حلقات البحث والندوات والمؤتمرات. لم يعد شيء يتعلق بالإنسان عفوياً في هذا الزمان، وإذا ظن أحد ذلك فإنما ينتج شعوره عن جهلٍ بهذا العصر وبهذا العالم. وإذا كان هذا ينطبق على حياة المجتمعات في الظروف الطبيعية، فإنه أولى بالاهتمام في ظل الأوضاع الاستثنائية، كتلك التي تمر بسوريا اليوم. لن يستطيع سوري أن يخدم قضيته اليوم ما لم يدرك تلك الحقيقة الكبرى أولاً، ثم يعمل على ممارستها على أرض الواقع. والاعتراف بها والعمل من خلالها يمثل الحد الأدنى من الجدية والاحترام لتضحيات الشعب السوري الكبيرة، وهذا وحده الذي سيُمكن السوريين من توظيف طاقاتهم الهائلة ومخزونهم الحضاري لتحقيق أهداف الثورة. إن التعامل مع العالم والعصر من خلال رفع الشعارات والحديث عن المبادئ واستخدام العواطف والنيات الحسنة أمر في غاية السهولة، إلا أن عملية إثبات الوجود في وسط هذا العالم الذي تموج فيه الزوابعُ والعواصفُ والأعاصيرُ بالأمم والدول يتطلب فهماً آخر ووعياً آخر وجهداً آخر مختلفاً تماماً عن تلك الطريقة. وإذا كان لأحدٍ أن يفكر في تصحيح مسيرة الثورة فإن عليه أن يبدأ من احترام الاختصاص في كل مجالٍ من مجالاتها، بحيث يُبنى على هذا الاحترام موقفٌ عملي يؤكد على وضع الإنسان المناسب في الموقع المناسب، لتظهر المُخرجات المناسبة للثورة في نهاية المطاف.
528
| 13 أكتوبر 2013
لننتقل في هذا المقال إلى جانب آخر من جوانب الأزمة يتجنب الكثيرون الحديث فيها. ماذا يعني أن توجد في صفوف الثورة السورية عشرات، بل مئات، الفصائل العسكرية التي تندرج في خانة الوصف بأنها إسلامية، وأن تستمر هذه الظاهرة ابتداء من الأيام المبكرة لانتقال الثورة إلى الكفاح المسلح وصولاً إلى هذه المرحلة؟ هل يمكن تفسير هذا الوضع بأنه نتيجة لجهلهم بواحدة من القواعد الأساسية المندرجة في أسباب النصر بالمفهوم الإسلامي، والمتمثلة في ضرورة تجنب الفرقة والتنازع اللذين يؤديان بالضرورة إلى (الفشل وذهاب الريح). إذا كانت هذه الفصائل لا تُدرك فعلاً أهمية هذه القاعدة، فتلك مصيبةٌ تُلقي ظلالاً كبيرةً من الشك على فهم الإسلام في مجال يتعلق بنشاطهم تحديداً، ولا يُتصور أن يمتلك أهليةَ العمل فيه من توجد فيه مظنةُ الجهل بتلك القاعدة. أما إذا كانت الفصائل تُدركها لكنها لا تستطيع العمل بها فالمصيبة أكبر؛ لأن من أعجب الظواهر في الثورة حتى الآن عدم قدرة أهل تلك الفصائل، ليس فقط على الاتحاد والاندماج، بل وحتى على مجرد التنسيق والتعاون بشكل (جبهوي)، كما تشهد بذلك المحاولات المتكررة والمعروفة، ويظهر عمق المشكلة بشكل أوضح حين نتذكر أننا نتحدث عن فصائل توجد بينها تقاطعات ومُشتركات واسعة جداً فيما يتعلق برؤيتها الإسلامية، بل إن بعضها يكاد يكون نُسخاً متكررة عن بعضها الآخر. وهذه ظاهرةٌ تحتاج بدورها إلى تفسير. لا نريد الحكم على النيات أو الدخول في استقراء مكنون الضمائر، لكننا بإزاء ظاهرة اجتماعية ثقافية لها مُستتبعات، ليست فقط أمنية قصيرة المدى على المجتمع حولها، بل وإستراتيجية تؤثر في مصير سوريا، بحيث لا يمكن أن نتجاهل وجودها، ويمكن بكل صراحة التفكير بتفسيرات منطقية لها. وتتوزع هذه التفسيرات بين التنافس على المواقع والنفوذ والقوة، أو الطاعة العمياء لمصادر التمويل، أو في كون فهم هذه الفصائل للإسلام وطريقة تنزيله على الواقع متبايناً جداً، حتى لو ظهر خارجياً أن رؤيتها مُتقاربة. بمعنى أن كلاً منها ينطلق من (إسلام) يختلف عن الإسلام الذي ينطلق منه الآخر، وأن كلاً منها يحسبُ أن (إسلامه) هو الإسلام الصحيح دون غيره. هذه ظاهرةٌ خطيرة تُعبر عن نفسها بلسان الحال، ولو لم تعبر بلسان المقال، والمخلصون لأهداف الثورة من أهل الفصائل مدعوون بقوة للتفكير بها بكل جدية. بالنسبة لنا، لا مفر من وجود تفسير لهذه الظاهرة، والتفسيرات الثلاثة المطروحة أعلاه تقذف، مُنفردة أو مجتمعة، في وجوهنا جميعاً أسئلة تعيد إحالتنا إلى الأزمة التي نتحدث عنها فيما يتعلق بفهم الإسلام. وفي جميع الأحوال، يبدو واضحاً أننا أمام حالة إما أنها لا تُدرك ترتيب الأولويات في مجالات العلاقة بين المصالح العامة المتعلقة بالبلاد والعباد، والمصالح الخاصة المتعلقة بالفصيل وقياداته. أو أنها تُدرك حتمية تغليب معاني التجرد والإخلاص في هذا المجال الحساس تحديداً، لكنها لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية من خلال العمل بمقتضى تلك المعاني بدرجات عالية من الجدية والصدق والعزيمة. هكذا، نجدُ أنفسنا أمام تجليات الأزمة مهما حاولنا أن نبحث عن تفسير لظاهرة فرقة الفصائل الإسلامية، بل وتنازعها واختلافها، أحياناً إلى درجة الاقتتال، وأحياناً أخرى على شكل الخذلان والتخلي عن الأخ أمام من يُفترض أنه العدو المُشترك، وفي مواقف وأحداث حاسمة ومصيرية. ويبرز هنا تساؤلٌ كبير: أين المراجع الشرعية بشكلٍ عام؟ وأين الهيئات الشرعية التي تمتلكها الفصائل من هذه المشكلة الأساسية التي لا تقتصر مستتبعاتها على حرمان الثورة السورية من تحقيق أهدافها؟ وكيف تتجاهل هذه الهيئات مثل هذه القضية الكبرى، وتنشغل بهمةٍ وعزيمة في ملاحقة ظواهر أخلاقية واجتماعية فردية شاذة تُصبح وحدَها المدخلَ لتطبيق تعاليم الإسلام في المناطق التي تقع تحت سيطرتها؟! لماذا لا تتوقف الفصائل الإسلامية عند هذه القضية بكل أبعادها للتفكير في دلالاتها الخطيرة؟ لماذا تقفز فوق وقفة صدق مع النفس تتعلق بهذا الموضوع للإجابة على التساؤلات الكبرى التي يطرحها؟ ألا تستحق الثورة السورية، التي يريد أهل هذه الفصائل تقديم الغالي والنفيس لها، شيئاً من جهدهم الفكري والنظري التأصيلي للموضوع بكل ما يستحقه من جدية يتطلبها الموقف؟ لا تقتصر المشكلة بطبيعة الحال على الجسم العسكري وإنما تمتد لتشمل الجسم السياسي الذي يحمل صفة إسلامية. فقد تعاملَ هذا الجسم مع السياسة على أنها ساحة مناورات داخلية بين العاملين في الحقل السياسي المُعارض، وأنها فضاءٌ لإظهار المهارة في إقامة التحالفات وتغييرها وصولاً إلى تحقيق هدف أساسي هو السيطرة على الهياكل السياسية، بحيث أصبح هذا الهدف هو الهاجس الأكبر. وبمعزلٍ عن امتلاك القدرة على توظيف هذه الهياكل لتحقيق الأدوار الحقيقية المطلوبة منها. بل إن وضع المخططات المنهجية التي تمكن الهياكل المذكورة من خدمة الثورة وتحقيق أهدافها لم يكن أبداً أمراً ذا أولوية، هذا فضلاً عن إظهار قدرة على صياغة مثل تلك المخططات ابتداء. وبهذا الفهم وتلك الأولويات، لا يعود مهماً أن تظهر (البراغماتية) في أكثر تجلياتها بُعداً عن القيم الإسلامية، ويكون طبيعياً أن تُبررَ الغايةُ الوسيلةَ أياً كانت. ويسير العمل بنوايا مُضمرة يتم إقناعُ النفس، والقواعد، بها، تؤكدُ على ضرورة استمرار السيطرة والتحكم بأي طريقة في هذه المرحلة وإلى أن يتم إسقاط النظام، ثم يمكن استعادة القيم بعد استخدام السيطرة الحالية لتأمين سيطرة مستقبلية، ويمكن استدعاؤها آنذاك لتأكيد الصفة الإسلامية للعاملين. لا يُظهر هذا التحليل الوجه الأخلاقي والالتزامي السلبي لأزمة الجسم السياسي الإسلامي فقط، بل يُظهر أزمةً أخرى على مستوى الفكر السياسي الذي يختزل مفهوم السياسة وممارساتها في مثل الدوائر المذكورة أعلاه من النشاطات. فهنا يغيب مفهوم تفكير رجال الدولة الذين يجب أن تمتد اهتماماتهم إلى إدراك المجالات الواسعة في إطار قيادة الأمم والشعوب نظرياً. وإن صحﱠ هذا في وقت السلم فإنه أولى بالاعتبار في ظرف الثورة الاستثنائي، فحجم المهمات والوظائف السياسية التي يُطلب تغطيتها يُصبح أوسع وأكثر تعقيداً. ودرجة الجهد والتخطيط والإحاطة وإيجاد الرؤى ورسم السياسات ووضع الهياكل المطلوبة تكون أكثر إلحاحاً. وتجاوز هذا كله، يُعتبر مؤشراً واضحاً على غياب فكرٍ سياسي معاصر يزاوج بوسطية بين فهم مقاصد السياسة الشرعية من جانب وبين المعرف من فنون السياسة بمفهومها المعاصر من جانب آخر. ويبرز أيضاً هنا السؤال عن دور المؤسسة الشرعية التقليدية، حيث لم ولا يظهر لها تأثير على الفصائل العسكرية الإسلامية التي لا تكاد تعترف بأي صفة مرجعية لأهل تلك المؤسسة، إلا في حالات نادرةٍ جداً، لا تتجاوز اسماً أو اسمين، وفي مناطق مُحددة لا تشمل الأرض السورية بأسرها. أما ما يزيدُ الظاهرة غرابةً ويبينُ حجم الأزمة فيبدو في لجوء تلك الفصائل بشكلٍ مُكثف إلى مرجعيات خارجية، ليس لها أي علمٍ بالتعقيد الاجتماعي والثقافي والسياسي للواقع السوري الذي يُفترض أنها تعمل على تنزيل تعاليم الدين فيه. وهذا خرقٌ أساسي للقواعد المنهجية الأصيلة في الإسلام في هذا الموضوع، حيث ينبغي أن يكون (المُفتي والعالم) مُدركاً لتفاصيل الواقع الذي يحاول تنزيل أحكام الدين فيه، انطلاقاً من مجموعة من الأصول المنهجية قد يكون أكثرها شيوعاً أن (الحكمَ على الشيء فرعٌ عن تصوره). لماذا لم تستطع المؤسسة الشرعية التقليدية أن تؤثر بأي درجة في توجه وممارسات ورؤية وسياسات الفصائل العسكرية؟ ألا يدلُ هذا على قصورها في تلبية حاجات وخصوصيات هذه الشريحة والتعامل مع حاجاتها والإجابة على أسئلتها؟ ومن جهة أخرى، ألا تدل العلاقة المفقودة، تأثراً وتأثيراً، بين هذه المؤسسة وبين الجسم السياسي الإسلامي على وجود فصامٍ كامل بين الطرفين لا يمكن فهمه. لأن مثل هذا الفصام قد يكون مفهوماً في حالة اختلاف مرجعية وهوية وتطلعات الطرفين بشكلٍ كامل. أما في واقعٍ يفترض أن توجد فيه دوائر مشتركة كثيرة للمرجعية والهوية والتطلعات، فإن مثل ذاك الفصام يُعتبر ظاهرةً شاذةً وفي غاية الغرابة. بهذا العرض، يتضافرُ واقع الفصائل العسكرية الإسلامية وواقع الجسم السياسي الإسلامي وواقع المؤسسة الشرعية التقليدية، والعلاقة بين الأطراف الثالثة، لتُبين بشكلٍ واضح حجم الأزمة المتعلقة بفهم الإسلام وتنزيله على الواقع في أحداث الثورة السورية. لأن واقع هذه الأطراف يُظهر للأسف أن نتائج ممارساتها تصب في التأزيم وزيادة الإشكاليات أكثر بكثير من مساهمتها في إيجاد الحلول. لسنا هنا في مجال التهجم واتهام النيات، والتعاملُ مع هذا التحليل من ذلك المدخل لن يكون إلا تجلياً آخر من تجليات الأزمة، فنحن كما هو واضح نطرح أعلاه أسئلة تكاد تكون بديهية، وهي تستند إلى وقائع على الأرض يعرفها كثيرٌ من المهتمين، وإن تردد الكثيرون في فتح ملفاتها لسببٍ أو لآخر. كل ما نريد قوله إن الحركة في أي مسار من مسارات الثورة السورية باسم الإسلام تفرض على أصحابها مسؤوليةً كُبرى. ولما كانت جدية الموقف لا تسمح بالنصيحة في السر، فإننا نؤكد علناً على ضرورة الاختيار بين تحمل تلك المسؤولية أو العمل بطريقةٍ أخرى لا تظلم أصالة الإسلام وقيمه الحضارية الكبرى. وإذا كان العرض أعلاه لا يزال في جزءٍ كبيرٍ منه يطرح جوانب الأزمة ويعمل على توصيفها بقدر ما يمكن من الإحاطة والشمول، فإن هذا يأتي حرصاً على فتح ملفٍ يجب ألا يبقى مُغلقاً وينبغي أن يُشارك في حواراته كثيرون من أصحاب الاهتمام وأهل النُهى والألباب. أما مقدمات الثورة الثقافية المطلوبة الآن، والتي ستكون بمثابة حاضنة لإنتاج مقدمات تُساعد على صياغة البديل الذي تبحث عنه الثورة في هذه المرحلة، فسيكون مجال اهتمامنا القادم بشكلٍ كبير، وهو مجالٌ ينبغي ألا يقف عند الجهد الفردي وأن تتصدى للعمل به على أكثر من مستوى جهود جماعية ومؤسسية.
499
| 06 أكتوبر 2013
بمعناها الأكبر، أظهرت الثورة السورية قرار الشعب بالرفض القاطع والنهائي لواقعٍ كان مفروضاً عليه، وأكدت، عبر تضحياتٍ قياسية في تاريخ الشعوب، تصميمه على الانخلاع من ذلك الواقع والخروج منه دون عودة. لكن ما وصلت إليه الثورة اليوم يبدو مؤشراً على دخولها في مرحلة البحث عن البديل، أكثر من كونه دليلاً على تحقيق أهداف الثورة. المفارقة أن ملامح هذا البديل لا يمكن أن تظهر في معزلٍ عن ثورةٍ ثقافية داخلية تُؤمن الشروط المطلوبة للتعامل مع التحديات المذكورة. وتلك ثورةٌ لا مفر منها، وستبقى تتعايش حتماً مع كل مشاعر الألم تجاه ما يجري، لكنها لا يمكن أن تقع فريسة الضغوط العملية والنفسية التي توحي بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة ليس لها وجود في هذا المسار الطويل. لقد دخلت المآسي التي نتجت عن ممارسات النظام كل بيتٍ تقريباً في سوريا. بمعنى أن الشعور بـ (الضغط) لم يعد مُقتصراً على الوعي الجَمعي العام، وإنما بات يتجاوز ذلك إلى المجال الشخصي الحميم. وفي حين يُفترض أن يكون هذا أدعى لتوسيع شرائح العاملين والمزيد من العمل والإنجاز، إلا أن الواقع يعطينا مؤشراتٍ على اتساع دوائر الشعور بالعجز وما يستتبع ذلك من مقتضيات نفسيةٍ وعملية. هنا نعود إلى استكشاف أبعاد ملامح الأزمة الثقافية التي كنا نعاني منها على مدى عقود، حيث لم تتشكل لدينا الأدواتُ والأساليب اللازمة للتعامل مع تحديات العصر في أيام السلم، فكيف يكون الوضع في خضمﱢ حالةٍ في غاية التعقيد والتشابك، يجب أن نعترف أننا لم نكن مهيئين للتعامل معها بشكلٍ منهجيٍ فعالٍ ومحترف؟ ليس هذا جلداً للذات، والأهمُ من ذلك التوضيحُ بأن الحديث عن الأزمة لا يعني على الإطلاق وقوعاً في الانهزامية التي يرتكسُ إليها البعضُ ليقول بأن انطلاق الثورة كان أمراً خاطئاً أصلاً. فهؤلاء لا يظلمون الشعب السوري وثورته العظيمة فقط، بل يُثبتون قبل كل شيءٍ آخر كونهم دليلاً على الأزمة التي نتحدث عنها. خاصة حين يتعلق الأمر بفهمهم لحياة الشعوب والحضارات، وصيرورة تطورها من مرحلةٍ إلى أخرى، تفاعلاً مع متغيرات الزمن، واستجابة لمتطلبات تلك المتغيرات. وأن تتحدث عن أزمةٍ في ثقافة الشعب لا يعني القول بأن هذا الشعب ميت. ثمة فرقٌ شاسعٌ جداً بين الأمرين، وثورة الشعب السوري هي بذاتها الدلالةُ الكبرى على أنه شعبٌ مُشبعٌ بالحياة. وحين يُقدم كل هذه التضحيات للبحث عن واقعٍ جديد تُصبح فيه للحياة معنى فهذا برهانٌ ساطعٌ على تلك الحقيقة. وكما أوضحنا في المقال السابق، تَظهر صدقية هذا التحليل من واقع الشهور الأولى للثورة، حين استخرج المجتمع السوري كل العناصر الإيجابية في ذخيرته الحضارية العريقة، وحين استعملها لتكون بمثابة المحددات العامة التي ترسم ملامح الثورة وطبيعتها، بينما كانت ردود فعل النظام، على سوئها، لا تزال تسمح بذلك. لكن (الذخيرة) الثقافية قصُرت بعد ذلك عن تمكين مجتمع الثورة من القيام بالواجبات والوظائف الجديدة التي تتطلبها حربُ تحريرٍ شعبية طويلة، ووقائعُ مُعقدة فرَضتها ممارسات النظام، ومن خلفِها ممارسات النظامين الإقليمي والدولي، في حين استمرﱠت روحُ العطاء العفوية، تُذكي لهيبها في الأعماق مشاعرُ البحث عن واقعٍ يُعطي الحياة قيمةً حقيقية. فكانت هذه الروح من ناحية سبب استمرار الثورة، وكان ذلك القصور من ناحيةٍ أخرى سبب ظهور تحدياتها الراهنة. ونحن حين نتحدث عن تلك الذخيرة الثقافية فإننا لا نتحدث عن نوعٍ من الترف الفكري يشبه ما قام به كهنة وفلاسفة روما حين كانوا يناقشون جنس الملائكة بينما مدينتُهم تحترق، وإنما نتحدث عن مُقدماتٍ فكرية تُحدد طبيعة الفعل البشري على أرض الواقع، وتكون منطلق المواقف والمشاريع والسياسات، وترسم مدى كفاية الاستجابات العملية للتحديات المطروحة. وبما أن الصفة (الإسلامية) على تفاوت تعبيراتها وتبايُن دلالاتها صارت مُلازمةً للثورة، فستكون الإشارة هنا إلى ما يتعلق بهذا الموضوع من جوانب. فقد كنا نعيش في سوريا أزمةً كبرى في فهم الدين وفي طريقة تنزيله على الواقع، كما هو الحال مع بقية الشعوب العربية، لكن ظروف ما قبل الثورة و(القوانين) الفكرية والاجتماعية السائدة في تلك الفترة لم تكن تسمح بطرح هذه الإشكالية بكل درجات الوضوح والصراحة والشمول المطلوبة لمناقشتها، فضلاً عن تقديم حلول حقيقية لها. كانت الإشكاليات كبيرةً في فهم الدين، وجاءت، بالتالي، عملية تنزيل الدين وتطبيقه على الواقع مشوهةً إلى حدٍ كبير. فقد كان نادراً جداً أن يكون الدينُ عِلماً وتخطيطاً وتنميةً وإدارةً وتنظيماً وفهماً للعالم واهتماماً بالشأن العام وتركيزاً على قراءة سنن إعمار الأرض، بينما كان شائعاً جداً أن يكون الدينُ كماً هائلاً من فتاوى ودروس ومواعظ تُركز على كل ما هو شخصي ورمزي وشعائري. بمعنى أن الجهد كان قليلاً لربط الشخصي بالعام ولربط الرمزي والشعائري بالمقصد والمناط.. هذا فضلاً عن دور (أهل الدين) بتبرير الواقع القائم في كثير من الأحيان بقصدٍ أو دون قصد.. إذ لم يمتدﱠ النظر والتحليل إلى واقع الظلم والفساد والتخريب الممنهج في كل مجالات الحياة، والذي كان يُمارس على البلاد بأسرها وعلى المجتمع بإجمال. لم تُربَ الأجيال في معظمها على أن هذا الواقع والممارسات التي تقف وراءه هي في حقيقتها أكبرُ انتهاكٍ لتعاليم الدين، وأعظمُ في تأثيرها السلبي من انتهاك بعض أوامره ونواهيه على المستوى الفردي. وإنما انحصر الاهتمام في الحفاظ على تركيبات اجتماعية واقتصادية محدودة، هي أشبه بمجتمعات منعزلة ومُكتفية ذاتياً داخل سوريا الوطن، تُحيط ببعض الدعاة والعلماء، وتُوفرُ الشعور بالرضا لمن فيها على اختلاف أدوارهم، وقد توفر في طريقها بعضاً من لقمة عيشٍ يُقدمها (المُحسنون) لفقراء يعيشون بالصدفة على هوامش تلك المجتمعات. لا ينفعنا في شيء تلك (الهمسات) التي كانت تتم هنا وهناك، والتي تُعبر عن (استنكارٍ) تقليدي للواقع، يجري التعبير عنه في دوائر مُغلقة وضيقة للغاية. إذ لم يجرِ الربط الواعي، في أذهان الجماهير الواسعة، بينها وبين الدور الحقيقي للدين كأداةٍ كبرى للتحرير والإعمار. من هنا، اقتصر ما يُسمى بـ (العودة) الجماعية للدين بين السوريين، مع تطور أحداث الثورة وكثرة تحدياتها، على المعاني العامة المتعلقة بالإيمان والتوكل والتسليم، وغابت تجليات دينٍ يتمثل جوهرهُ في امتلاك أدواتٍ تعين أصحابها على التعامل الفعال مع الفضاء العام، ومن مدخل عالم الأسباب. وللمراجعات بقية.
460
| 29 سبتمبر 2013
لم يكن ثمة بدٌ من انطلاق الثورة السورية، بنَسقها المعروف إلى الآن، لكي يمكن الانتقال إلى مرحلةٍ أخرى، لن نكون مُبالغين إذا أطلقنا عليها وصف الثورة الثانية. فالثورة، في واقعها الراهن، تُصيب السوريين بدرجات متفاوتة من الحيرة واليأس. وهي، بمآلاتها وتفاصيلها الحالية، تُثير من الأسئلة أكثر مما توحي بالإجابات. وسنظل جميعاً مُحتارين في فهم الظاهرة، فضلاً عن التعامل معها، ما لم نُدرك، بعد سنتين ونصف من عمر الثورة، بعض الحقائق الصعبة، وما لم نعترف بها بكل وضوحٍ وصراحة. لم تنطلق الثورة السورية من تراكمٍ ثقافي وحضاري وصل إليه الإنسان السوري ودَفعهُ إلى الدخول الواعي والمُخطَط في عملية تغييرٍ كُبرى. ليست هذه طبيعة الثورات في جميع الأحوال. والذين يعيبون على السوريين تشبيههم ثورَتهم بالثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية يقفزون بِدَورهم فوق حقيقة تبدو بديهية. فالتاريخ يُخبرنا أن الثورات كانت دوماً مراحل انتقالية. وأنها نتجت عن مزيجٍ من عنصرين: وصولُ بعض المجتمعات إلى درجةٍ من الاحتقان لم يعد ينفع التعاملُ معها من قبل سلطة الأمر الواقع بواسطة المؤسسات والهياكل التقليدية، ووجودُ شرائح من تلك المجتمعات امتلكت مؤهلات صارت تدفعها دفعاً للخروج بشكلٍ صاخب من الواقع السائد، دون أن يكون لديها بالضرورة تصورٌ نهائي ومُتكامل لطبيعة البديل المطلوب. بهذا المعنى، تكون الثورة الحقيقية خروجاً من مشهدٍ للاجتماع البشري لم يعد استمرارهُ ممكناً وفق قوانين ذلك الاجتماع وسُننه التاريخية، ودخولاً في عملية بحثٍ جدﱢية عن مشهدٍ يمكن أن يستوعب المستجدات والمتغيرات التي لا تنفك تتكرر في التاريخ الإنساني. الثورة هنا عملية (انخلاع) جذرية من حاضرٍ صار مرفوضاً على جميع المستويات، وكلما كان الحاضرُ مصراً على الاستمرار بأي ثمن، كانت عملية الانخلاع منه أكثر عُنفاً وصخَباً. أما الرفض الذي نتحدث عنه فهو في جوهره رفضٌ نفسيٌ عميقٌ جداً يطرح على أصحابه التساؤلات حول جدوى الوجود والحياة في ذلك الحاضر أصلاً. وعندما تصل الشعوب إلى هذه المرحلة يُصبح لديها دافعٌ قويٌ للقبول بتضحياتٍ لا يمكن تفسيرُها على الإطلاق في الأوضاع العادية. فهنا، يُضحي الأمل في بديلٍ مستقبليٍ، وفي محاولة إيجاده، أكبرَ من الحرص الآني على الوجود وعلى الحياة نفسها في حاضرٍ انتهى احتمالُ وجود معنىً للحياة فيه. في حين أن هناك (احتمالاً) في أن يكون لدى البديل المنشود ما يُعطي للوجود والحياة معنىً وقيمة. لهذا تكون الثورة الحقيقية طويلة. ولهذا تكون على مراحل. ولهذا تكون عنيفة. وهذا ما حدثَ في الثورة السورية إلى درجةٍ كبيرة. حين اجتمعت مجموعة عناصر لم يكن ممكناً انطلاقُ الثورة إلا باجتماعِها. فمن جهة، وصلَ الواقع السوري مع حكم البعث بشكلٍ عام، وفي السنوات الأخيرة تحديداً، إلى درجة من الاهتراء في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بمواضيع أساسية كان النظام يحاول أن يبني مشروعيته بالتركيز (النظري) عليها: التنمية، والحرية، والتحرير (بمعنى استعادة الأرض والمقاومة وما إليها من شعارات). ففي حين كانت الآلة الإعلامية والسياسية للنظام تُمطر المواطن السوري ليل نهار بمقولات وسياسات ومشاريع يُقال إنها تتمحور حول تحقيق الأهداف الثلاثة المذكورة، كان الاتجاه العام لممارسات النظام يسير في الاتجاه المعاكس تماماً. فبعد صبرٍ طويل ومعاناةٍ لا يعرف تفاصيلها وحقيقتها إلا السوريون تحديداً، لم يجد ذلك المواطن في الواقع العملي حولَه إلا ما يؤكد غياب كل ماله علاقة (حقيقية) بالتنمية والحرية والتحرير. ولئن اشتركت المدينة والقرية في نصيبها من معاناة غياب الحرية ودَفْعِ ثمن التحرير المزعوم، فقد كانت وطأة غياب التنمية ثقيلة جداً على ملايين السوريين ممن لا يعيشون في مدن كبيرة قد تنحصر عملياً في دمشق وحلب التي شهدت عمليات تجميل (تنموية)، بينما كان الإهمال يشمل ما يفُترض أنه مدنٌ سورية كبرى من دير الزور إلى درعا وغيرها. ومن جهة ثانية، جاءت التطورات العالمية مع ثورة الاتصالات والمعلومات، خلال العقدين الماضيين، لتفتح آفاقاً ثقافية وعملية لشرائح في المجتمع تتوزع على كامل التراب السوري، بحيث بات هؤلاء يُدركون ثقافياً حجم الهوة بين واقعهم وواقع العالم، ويشعرون نفسياً بالحاجة الماسة إلى التغيير، ويملكون قدرةً على استخدام أدواتٍ يمكن أن تُساهم في إحداث التغيير، خاصةً في مجال التواصل والمعلومات. ثم ظهرت مؤشراتٌ عملية على إمكان حصول التغيير المذكور تيمناً بما جرى في تونس وغيرها، فكانت هذه الشرارةَ المطلوبة لاكتمال عناصر المعادلة. لم يكن ممكناً بعد هذا إلا أن تنفجر الثورة. يُغذيها، على مستوى الحاضنة، قهرٌ عامٌ وطاغٍ عاشه أكثر من 20 مليون سوري. وتُحاول تنظيمها، على مستوى القيادة، تلك الشرائح التي تفتحت أمامها بعضُ آفاق التغيير وامتلكت بعض أدواته. وتُعطيها الأمل النتائجُ السريعة لما جرى في تونس ومصر وغيرها. ثمة عنصرٌ آخر أعطى الثورة في بداياتها الزخم والتألق المعنوي والأخلاقي، ثم إنه مع طول الزمن وشدة الضغط أصبح سبباً رئيساً من أسباب مخاضها الصعب ومآلاتها المُلتبسة، ويتمثل في الثقافة السائدة في المجتمع. ففي الأشهر الأولى للثورة، استخرج المجتمع السوري كل العناصر الإيجابية في ذخيرته الحضارية العريقة. وكانت ردود فعل النظام، على سوئها، لا تزال تسمح لتلك العناصر بأن تكون بمثابة المحددات العامة التي ترسم ملامح الثورة وطبيعتها. فكان التركيزُ على المعاني والقيم الجامعة، وكانت الممارسات العملية التي تؤكدُ على التعاضد والتعاون والوحدة في مقابل (عدوٍ) مُشترك ولتحقيق هدفٍ مشترك. لكن الثورة واجهت ساعة الحقيقة حين واجهت مع نهاية عام 2011 تقريباً، وبشكلٍ واضحٍ وجلي، حقيقة النظام السوري وحقيقة النظام الدولي، وأصبحت في موقع التعامل مع التحديات الصعبة التي عمل النظامان المذكوران على خلقها بمهارةٍ وصبر على مدى الأشهر السابقة.. أين وصلت الثورة اليوم إذاً؟ وما هي طبيعة المرحلة القادمة في مسيرتها؟ هذا موضوع المقال التالي.
447
| 22 سبتمبر 2013
مساحة إعلانية

حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد...
3354
| 04 نوفمبر 2025

كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق...
2580
| 30 أكتوبر 2025

اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال...
2097
| 03 نوفمبر 2025

8 آلاف مشارك بينهم رؤساء دولوحكومات وقادة منظمات...
1803
| 04 نوفمبر 2025

نعم… طال ليلك ونهارك أيها الحاسد. وطالت أوقاتك...
1554
| 30 أكتوبر 2025

من الطرائف العجيبة أن تجد اسمك يتصدر أجندة...
1230
| 04 نوفمبر 2025

تُعدّ الكفالات البنكية بمختلف أنواعها مثل ضمان العطاء...
897
| 04 نوفمبر 2025

تسعى قطر جاهدة لتثبيت وقف اطلاق النار في...
843
| 03 نوفمبر 2025

أصدر مصرف قطر المركزي في التاسع والعشرين من...
789
| 05 نوفمبر 2025

ما من ريبٍ أن الحلم الصهيوني لم يكن...
768
| 02 نوفمبر 2025

أحيانًا أسمع أولياء أمور أطفال ذوي الإعاقة يتحدثون...
759
| 30 أكتوبر 2025

مضامين ومواقف تشخص مكامن الخلل.. شكّل خطاب حضرة...
675
| 05 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية