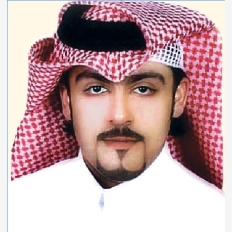رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عقودٌ مرت، والأمة تبحث عن قلبٍ ينبض بآمال وأحلام شعوبها، فشاء الله أن تكون قطرُ هذا القلبَ الكبيرَ الذي احتضن العرب والمسلمين، وأحيا في نفوسهم الفخر والاعتزاز، هذا القلبُ الذي كانت شرايينه الشعوب، ودماؤه إنجازات منتخب المغرب الشقيق. عشرون يوماً منذ انطلاقة المونديال، ووطننا العربي الإسلامي الكبير على موعد متجدد مع أطياف طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين ومحمد عبد الكريم الخطابي وهي تقود جيوشاً مُظفَّرةً من الإرادة والعزيمة والسعادة التي أهداها أحفادهم لاعبو المنتخب المغربي لأمتنا. عشرون يوماً، والشعوب تنام على أمل، وتصحو على إنجاز رياضي يوحِّد أبناءها الذين أصبحوا، كلُّهم، مواطنين مغاربة بقلوبهم وأرواحهم. وكأنما شمس أمجادنا العربية الإسلامية تشرق من مغربنا، وتنشر ضياء الأخوَّة في ديارنا، وتبعث الحياة في نفوسٍ كريمةٍ حيةٍ لشعوب تتعطش لفرحٍ يجمعها من المحيط الأطلسي، مروراً بالخليج العربي، وصولاً إلى إندونيسيا. قطرُ الحبيبة، بتنظيمها للمونديال، أكدت على التزامها بعقيدة الأمة وأخلاقها السامية، ونفثت في القلوب اشتياقاً لعهودٍ سادت فيها أمتنا الدنيا بحضارتها ونُبلها وعلومها. ثم جاءت إنجازات المنتخب المغربي لتكتب سطوراً من مجدٍ في سجلات كرة القدم، فاكتملت الصورة الرائعة للإنسان العربي المسلم التي نجحت بلادنا في تقديمها للعالم. الناس، في وطننا العربي الكبير، طيبون ومثقفون وإنسانيون، وفيهم روعةٌ ومشاعرُ نبيلةٌ. وعندما وجدوا في قطر الحبيبة متنفساً للتعبير عما يجمعهم، وعثروا على إنجاز يفخرون به، أهدوا لبلادنا حباً ودعماً عظيمين، ثم التفوا حول ممثلهم في البطولة؛ المنتخب المغربي، وأحاطوه بحبهم له، واعتزازهم به، وآزروه في الملاعب، وخرجوا يحيونه في مسيرات ضمت عشرات ومئات الآلاف في شوارع وميادين المدن والبلدات والقرى في ديار العروبة والإسلام. الناس، في وطننا الكبير، كالتربة الخصبة التي ساق الله لها سُحُبَ نجاح بلادنا في تنظيم المونديال، فنزل عليها غيثُ إنجازات المنتخب المغربي، فاخضرَّتْ ربوعها بأفراح لم تعرف مثيلاً لها منذ زمن بعيد، فأخذ أبناؤها بترديد أهازيج أشقائنا المغاربة التي يتغنون فيها بحب فلسطين التي خرج أبناؤها يهتفون للمغرب وأهله ومنتخبه، ويتغنون بحبهم لقطر التي أتاحت لشعوب الأمة أن تؤكد على ثبات التزامها بالقضية الرئيسة لها؛ قضيتنا الفلسطينية. كلمة أخيرة: مرت مائة عام على الانتصار العسكري العظيم للمغاربة على الإسبان في معركة "أنوال"، واليوم، ينتصر أحفاد أولئك الكرام على إسبانيا والبرتغال وأوروبا في ميادين كرة القدم، فنعمَ الأجداد والأحفاد، ونعمَ الأمة التي تجمعنا معهم. كاتِـبٌ وَإِعْـلاميٌّ قَـطَـرِيٌّ
987
| 12 ديسمبر 2022
منذ انطلاقة المونديال، ونحن نعيش حالةً من الأمل العظيم، حيث إن أربعة منتخبات تمثِّل أمتنا العربية فيه، وكل فوزٍ لأحدها هو فوزٌ لنا جميعاً. وقد رأينا ذلك من خلال ملامح الفرح التي أشرقت بها وجوه سمو الأمير المفدى وأنجاله، والسعادة التي هزت النفس الكريمة لسمو الأمير الوالد، عندما حقق منتخب المغرب الشقيق فوزه التاريخي على المنتخب البلجيكي. وكم كان رائعاً شعورنا بالعروبة تسري في أرواحنا بينما كان سمو الأمير الوالد يُردد النشيد الوطني التونسي مع مشجعي منتخب تونس الشقيقة. إن المشاعر النبيلة، لا تحيا إلا في القلوب النبيلة النابضة بحب أمتها، والمحتضنة لشعوبها، والساعية لتحقيق آمالها وطموحاتها. هذه الحالة النقية في نُبلها، ستكون حاضرةً مع جماهيرنا في استاد البيت، وسنقف مع منتخبنا حتى اللحظة الأخيرة في مباراته الأخيرة، ونحن مؤمنون بأن ذلك جزءٌ من حبنا لبلادنا، ودليلٌ على وعينا بدورنا الحضاري في تمثيلها لأمتينا العربية والإسلامية. للأوطان أرواحٌ، ولها قلوبٌ ومشاعرُ، وهو ما نلمسه في قطر الغالية منذ انطلاقة المونديال، حيث نرى طيف وجهها الحبيب في كل الميادين والشوارع، ونشعر بقلبها يحتضن أبناءها بفخرٍ واعتزازٍ، وينبض بالترحيب بأشقائنا العرب والمسلمين، وبأخوتنا في الإنسانية الذين اجتمعوا على ترابها في صورةٍ إنسانيةٍ حضاريةٍ قلَّ مثيلها. اليوم، سينبض قلب بلادنا في استاد البيت، مع قلوب أبنائها الذين سيغصُّ بهم، ويملأونه هتافاً وأهازيج تشجيعاً لمنتخبنا في مباراته الثالثة التي ستشهد من لاعبينا روحاً رياضيةً حماسيةً، وأداءً فنياً رفيعاً، بحيث نقول، جماهيرَ ولاعبين: إن الإنسان القطري يدرك أن فوزه الأعظم كان في النجاح العظيم لتنظيم المونديال، وأن هدفنا الرئيس هو إبراز الصورة الحضارية الرائعة للإنسان العربي المسلم. لأول مرةٍ، أهتم بالتدقيق في وجوه أبناء بلادنا حيثما التقيتهم، وحيث جمعتني بهم الأماكن، فأرى في عيونهم بريقَ اعتزازٍ وفَخْرٍ، وأسمع قلوبهم تنبض بالنُّبل وكرم الأخلاق والسمو الروحي، وكأنما كل واحد منهم سفيرٌ لبلادنا مقيمٌ فيها. وسيكونون، اليوم، سفراء لقطر الحبيبة في استاد البيت، حيث سيتحدث العالم عن وطنيتنا التي لا تتأثر بنتائج المباريات، وإنما تتعاظم وتكبر كلما كان اسم قطر منقوشاً بالمجد على رايات الاعتزاز. هناك كَمٌّ هائلٌ من السعادة في قطرنا وديارنا العربية والإسلامية، لأننا نجحنا في تقديم الصورة الحقيقية عن شعوبنا في وعيها وتحضُّرها ومَدَنيتها. سعادةٌ، نراها في الوجوه، ونلمسها في الكلمات، ونشعر بها في الهواء والتراب والأشجار والمباني، وكأنما كلُّ شيءٍ يشعر بالفرح والاعتزاز بقطر العروبة والإسلام. وستكون هذه السعادة، وذاك الاعتزاز دافعاً لنا، جميعاً، للالتحام بمنتخبنا، لنقول للعالم إن الشعب الذي نظَّمَ البطولة شعبٌ حيٌّ راقٍ ينبض قلبُ بلاده في قلوب أبنائه. كلمة أخيرة: "الله، يا عمري قطر"، عبارةٌ ترددها قلوبنا، وتمتزج بأرواحنا، وتُضفي على وجودنا روعةً وأَلقاً ومجداً. كاتب وإِعـلامي قطـري
8331
| 29 نوفمبر 2022
قلوبُ الكرامِ هي منازلُ للكرام، وقد كانت قلوب كرام أمتنا هي منازلنا التي فاض النُّبْلُ والكرمُ فيها علينا، ففاضت قلوب القطريين بالاعتزاز بإسلامهم وعروبتهم، واجتمعت الأمة للمرة الأولى، منذ عقودٍ، على إنجازٍ حضاريٍّ عظيمٍ تمثل في المونديال الذي كان عربياً خالصاً، وكانت عبارة سمو الأمير في افتتاحه: "من قطر.. من بلاد العرب"، إشارةً إلى اعتزازنا بتمثيل أمتنا في تنظيمه. منذ انطلاقة المونديال، قبل 7 أيام، وبلادنا تنشر في العالم، كله، روعة الإسلام الحنيف ونُبل العروبة، وتُبرز الصورة الإنسانية والحضارية للإنسان العربي المسلم الذي يستطيع تحقيق المعجزات عندما توجد لديه قيادةٌ ملتزمةٌ بعقيدة وقضايا أمتها، وتدرك أن الأوطان لا تُحددها الجغرافيا، وإنما تمتد على مساحات شاسعة من مشاعر الانتماء لحضارةٍ وتاريخٍ مجيدين، وحاضرٍ يجب بناؤه على أسس من التأثير الإيجابي في الآخر، وتنويره بقيمنا وأخلاقنا التي لا يمكن لأحد أن يشوِّهها، ولا أن يفرض علينا ما يخالفها. اثنا عشر عاماً، وبلادنا تتحصن بالإسلام والعروبة وهي تُعدُّ للمونديال، وتتصدى بهما لكل الحملات المُغرضة، لأن قدرنا، في قطرنا الحبيبة، أن نكون إحدى القلوب النابضة بالحياة في جسد أمتنا العظيمة التي تتعطش قلوب أبنائها لفرحةٍ توحِّدهم، وأملٍ يجمعهم. أمتنا التي وقفت معنا، كالعهد بها، فكانت الحصن المنيع الذي تحطمت عليه كل الدَّعاوى والأكاذيب، فكان التنظيم الرائع للمونديال هو الهدية التي قدمتها بلادنا لها. كم كانت رائعةً تلك اللمسة الإنسانية، في افتتاح المونديال، التي رأيناها في علاقة الابن البار بأبيه الكريم، عندما فاجأ سمو الأمير المفدى والده؛ سمو الأمير الوالد بقميصٍ ارتداه في مقتبل شبابه، ويطلب من سموه التوقيع عليه، وكأنما يقول له: إن الآمال العظيمة التي كانت في قلبك، يا أبي، قد تحققت، وازدانت بلادنا بالإنجازات الحضارية الكبرى، وها هي، اليوم، تجمع العالم فيها، وتنبض بالإسلام والعروبة. الوجوه الحبيبة للأشقاء العرب والمسلمين، تبعث في قلوبنا سعادةً لا حدود لها. وجوهٌ طيبةٌ تنطق بالاعتزاز ببلادنا التي جمعت قلوبهم قبل أن يجتمعوا بأجسادهم فيها. وحين نلتقي بالسعودي والمغربي والتونسي، ونشاركهم آمالهم بالفوز في مباريات منتخباتهم، تتدفق مشاعرهم النبيلة تجاه بلادنا، فتهتز قلوبنا فرحاً بانتمائنا لأمة عظيمة نسعى للإسهام في نهضتها بما نستطيع. عندما تحدث المسؤولون عن الدراسات الشرقية في جامعات العالم عن المونديال، قالوا إنه أعظم حَدَثٍ يُقدِّم للعالم الحضارة العربية الإسلامية بصورةٍ لم يسبق لأمتنا أن قدمتها بهذا المستوى الرفيع من الرؤى والإدارة الفعالة لكل ما يتصل بالبطولة؛ لأن بلادنا مارست سيادتها، ولم تقبل تمرير أي شيء يمس بعقيدتها وقيمها، وكان تجاوب الأمة معها أساساً في الاستمرار في رسمِ ملامح عهد جديد من العلاقات بين الحضارات والثقافات، لا توجد فيه حضارةٌ متفوِّقةٌ تريد أن تفرض قيمها على العالم، وإنما توجد حضاراتٌ متمايزةٌ ينبغي احترام خصوصية كلٍّ منها، بحيث تنتهي فكرة مركزية الحضارة الغربية، بغثِّها وسمينها. إن المونديال في قطر هو النقطة التي سيبدأ التغيير منها لصالح الحضارة الإنسانية بوجود دور هائل للحضارة الإسلامية والعربية فيها. كلمة أخيرة: أمرٌ رائعٌ أن نكون، نحن القطريين، عرباً مسلمين، والأروع أن يكون وطننا الأكبر هو قلوب وضمائر الكرام من أبناء أمتنا. كاتب وإعلامي قطري
2193
| 27 نوفمبر 2022
من المعجزات أن فلسطين اتسعت لمئات ملايين الأرواح والقلوب التي احتضنت ذرات ترابها، وكرام الأمة من أبنائها طوال معركة المجد والعزة، التي خاضها كرام الأمة في غزة والقدس والخليل وكل فلسطين، ثم تدفقت تلك الأرواح والقلوب مع مئات آلاف الفلسطينيين الذين احتفلوا بالنصر حول الأقصى وكل المدن والبلدات والقرى في الديار التي باركها الله، وتكفَّل بأهلها، وظللتها ملائكة الرحمة بأجنحتها. اثنان وسبعون عاماً على النكبة، وشعوبنا تنام على ألمٍ وحسرةٍ لتصحو على مواجعَ ويأسٍ، وكلما تنفست أملاً، تعلو أصوات الخاذلين المتخاذلين، وتتكاثر طعنات الغدر في الظهور، فتنشغل الشعوب بدماء وأشلاء أبنائها. لكن كرام الأمة في غزة لم يرضوا بمرور العيد حزيناً، فأهدونا نصراً عظيماً أشرقَ كالشمس في سماء أمتينا العربية والإسلامية، فكانت أنواره نسمات فرح ملأ الدنيا، ونيراناً أحرقت أوهام المارين بفلسطين وأمتنا كالكابوس. في فلسطين، خلال أيام المعركة المجيدة، شاهدنا مثالاً حياً لغزوة بدر؛ فالمؤمنون قلةٌ والعدو كثير العدد، مُدجَّجٌ بالأسلحة، ويُسانده المُرْجفون الذين يتمنون لو سحق الفئة القليلة التي يكشف طُهْرُها نفوسَهم المُدَنَّسة ببُغض المؤمنين، لكن المعادلة على أرض الواقع لم تكن بهذه البساطة؛ فهناك إيمانٌ بالله وإرادةٌ وكرامةٌ وفداءٌ يتسلح المقاومون بها، بينما المعتدي لا يقاتل إلا من وراء الجدران، وعندما يفتك الرعب بقلبه، يندفع ليلوذ بنفس الجدران خوفاً من الموت، الذي كان مطلباً للمقاومين لأنه شهادةٌ وحياةٌ أبديةٌ في جنان الخُلد. اللافتُ للنظر، أن تلك الحرب جمعت الشعوب كلها على نُصرةِ فلسطين لأول مرةٍ بهذه الصورة الرائعة، فقد اعتادت الشعوب على البكاء مع الثكالى والأيامى واليتامى في كل عدوان سابق، لكنها هذه المرة شاهدت أطياف وجوه صلاح الدين وعز الدين القسام وأحمد ياسين في سماء فلسطين، وبدت خلفها وجوه عبدالكريم الخطابي وعمر المختار وعبدالقادر الجزائري ويوسف العظمة وكوكبةٌ من رجالات أمتنا العظام، كان المشهد جليلاً، فالسماء والأرض مع المقاومين، والشعوب تدعو لهم بالنصر، وتنتظر أن يكون نصرهم بدايةً لحياةِ الأمة ونهضتها، فما الذي اختلف في تلك المعركة عن سابقاتها؟. في السابق، كان الرد على العدوان محصوراً في الدفاع عن غزة، لكنه في معركة المجد والنصر الأخيرة، كان رداً على عدوان على مقدسات الأمة في القدس، فجاء إطلاق الصواريخ من غزة مفاجئاً، وأصبح المشهد مختلفاً؛ فقد أصبحت المقاومة صاحبة اليد العليا؛ تحدد ساعات التجول للصهاينة، وتدفعهم إلى الملاجئ في معظم الأوقات، مما جعل كثيرين منهم يتحدثون عن (عودتهم لبلدانهم الأصلية)، وجعل شعوب العالم تقف مع الحق الفلسطيني، وتتحدث عن الكيان الصهيوني كدولة مُصطَنَعَةٍ تمارس الجريمة الإنسانية بلا رادع أخلاقي. لقد حطمت غزة خرافة الجيش الصهيوني الذي لا يُقهر، وفضحت معظم الجيوش العربية التي لم تُقدِّم لشعوبها سوى الهزائم والاستبداد والتخلف الحضاري، وكشفت الوجه الحقيقي للعلمانيين العرب الذين لا قضية عندهم إلا معاداة الإسلام وشرذمة المسلمين، بينما ينعمون هم بفتاتِ موائد الديكتاتورية التي لا يستطيعون الحياة إلا في ظلالها. وبالطبع، لم يكن مستغرباً أن ترتفع أصوات الحفنة القليلة من المتصهينين في وسائل التواصل الاجتماعي، والذين أخذوا يدعون الله بأن ينصر الصهاينة على العرب المسلمين في غزة الكرامة، فقد أُصيب المتصهينون إصاباتٍ مميتةٍ في أوهامهم بأن الشعب الفلسطيني البطل قد استكان للاحتلال، وأن الأمة نسيت فلسطين والأقصى، لكن هَبَّة المقدسيين ثم فزعة غزة لهم، فشموخ الأمة نُصرةً لهم وفرحاً بهم، كلُّ ذلك جعل الحلم المتصهين يذوي ويتلاشى. إن فلسطين ليست أرضاً كسواها، وإنما هي جزءٌ أصيلٌ من عقيدة الأمة ووجودها وحضارتها، ولا يمكن لعاقلٍ أن يظن أن فرح الأمة بالنصر لا يعكس الروح الحقيقية لها؛ روح الإرادة والوحدة والكرامة التي انبعثت عندما شمخ المارد الفلسطيني بقامته، وأثبت الكرام الفلسطينيون في غزة وكل فلسطين أنهم خيرُ أجنادِ الأرض، لأن الخَيرية تعني الانتصار للعقيدة، والفداء للأمة، والتضحية بالأرواح في سبيل تحرير وتطهير الأرض من الغاصبين. اليوم، تُسمع من الأقصى تكبيرات النصر والكرامة التي تخبر الدنيا بأن صحوة الأمة وانبعاث كرامتها وإرادتها هما قَدَرٌ محتومٌ، وأنْه لا أحد يستطيع أن يقف في وجه تحقيق الوعد الإلهي بالنصر والتمكين. كاتِـبٌ وَإِعْـلاميٌّ قَـطَـرِيٌّ [email protected]
4316
| 25 مايو 2021
عيوننا وقلوبنا، يا قدس، لم تعد ترحل إليكِ كلَّ يوم، لأنها ساكنةٌ فيكِ، ممتزجةٌ بترابكِ، تحتضنُ دماء الشهداء والمصابين ودموع اليتامى والأيامى والثكالى، تبكيهم معكِ، وتلوذ بجدرانِ أقصاكِ المباركِ علَّها تجدُ فيها نفحاتٍ من النور الإلهي الذي يَحِفُّ بها، وتسمعُ أصداء تكبيرات الأنبياء والرُّسلِ، عليهم السلام، وترى أطياف المعجزةِ الكبرى في إسراء المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وعُرُوجه إلى السماوات العُلا. لم يُشَرْ إلى فلسطين والمسجد الأقصى في القرآن الكريم إلا متبوعين بالمُبارَكة الإلهية لهما، ولم يُذكَرِ الأقصى في الأحاديث النبوية إلا مرتبطاً بالبشارات أو محفوفاً بالإجلال؛ ولم ترتبط الأحداث التاريخية الكبرى بموضعٍ كما ارتبطت بالقدس، كما في الحروب الصليبية قديماً، والاحتلال الصهيوني في عصرنا. ظنَّ كثيرون أن الأرضَ المبارَكة قد مُحيتْ من التاريخ بصفقة القرن وتوابعها السياسية، لكن أهلها الكرام أعادوا للأمة كلها كرامتها وعِزَّتها عندما جعلوا أرواحهم صفحاتٍ يكتبون فيها بدمائهم عباراتِ الإيمان والإرادة غير عابئين بِمَنْ خذلَهم، ولا يستنصرون إلا الله في جهادهم الشرعي والمشروع، ولا يطلبون من الأمة إلا دعمهم بالكلمة التي أصبحت، للأسف، أعظم الجهاد في زماننا، وأصبح قائلوها يحسبون حساباً عظيماً لتَبعاتها عليهم. لم يبدأ الأمر بحي الشيخ جرَّاح في القدس، وإنما كانت له جذورٌ تعود لسنة 1917م، عندما أعطى مَن لا يملك وعداً لمَنْ لا يستحقُّ بتمكينه من أرضٍ يسكنها مالكوها الأصليون والأصيلون منذ قرون طوال، وصولاً إلى نكبتنا في سنة 1948م، عندما أُنشئ الكيان الصهيوني على جزء من فلسطين، مروراً بنكسة 1967م التي مَكَّنَتِ الكيان من الاستيلاء عليها كلها مع أراضٍ شاسعةٍ من مصر وسوريا والأردن، فصار الأمل الأكبر هو الرجوع إلى ما قبل النكسة. ولكن ذلك كله هو تاريخ أنطمةٍ عربيةٍ، أما الشعوب، فقد حالَ الاستبداد والديكتاتورية دون سماع صوتها، فكانت كامب ديڤيد وما تلاها من اعترافات بالكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، وعقيدتنا الإسلامية، وتاريخنا، وحاضرنا، ومستقبلنا. لكن الأرض المباركة لم تَسْتَكِنْ؛ فروحها تسري في أبنائها الكرام البَرَرَةِ أبداً. منذ أسابيع، والفلسطينيون يواجهون وحدهم أبشع عدوان وحشي عليهم، بل إنهم يواجهون تياراً صغيراً ذا صوت عالٍ في أمتنا ينصر الصهاينة عليهم، وهم يستمسكون بالعروة الوثقى، ويقدمون مواكب الشهداء مصحوبةً بالتكبير والتهليل. إلا أن هذا المشهد يخفي مشهداً يُصدِّعُ قلوبنا حزناً، ويُذيبها كمداً؛ فهناك ركامُ دمارٍ هائلٍ تبدو تحته ملامح وجوه الضحايا الأحياء الذين ينتظرون موقفاً عربياً صغيراً لمساندتهم وإغاثتهم ونُصرتهم يتخطى بيانات الشجب والاستنكار التي تساوي بين الجلاد وبينهم. عندما تهون فلسطين ويهون أقصاها علينا، فهذا يعني أن عقيدتنا قد هانت علينا، وأننا أحياءٌ نعيش فقط ولكننا لا نحيا، ولا نؤثِّر، ولا يكون لنا دور في مسيرة الإنسانية. وقد أدركت الشعوب هذه الحقيقة، فالتفَّتْ حول فلسطين والفلسطينيين الذين بعثوا الروح فيها، وأعادوا لها نَبْض الكرامة والإرادة عندما هَبَّتْ غزة الحبيبة لردع العدوان بما تملكه من سلاح بسيط إذا ما قِيس بسلاح الصهاينة، إلا أنه أعظم منه لأنه سلاح مبارَكٌ أوجع الصهاينة، ونَبَّهَ الأمة إلى ضعفهم وإمكانية هزيمتهم. ستكون المعركة الحالية انتصاراً عظيماً مهما كانت نتائجها، لأن الجميع فهموا معادلة الصراع، ولم تعد المُسكِّنات السياسية تنفع في تهدئة النفوس التي رأت عمر بن الخطاب شامخاً بقامته في القدس، وصلاح الدين يقود الجموع، وراية الحق خفَّاقةً في الأرض المبارَكة، حين شمخت قامة الشعب الفلسطيني البطل، وتقزَّمَ أمامها الصهاينة في مشهد لن يُمحى من ذاكرة الأمة والعالم أبداً. نحن، أبناء الأمة وبناتها، علينا واجبٌ مقدَّسٌ هو نصرةِ أشقائنا بالكلمة، والذَّود عنهم بما نستطيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، لنُشْعِرَهُم أننا معهم، وأننا نُقدِّرُ عالياً أنهم يدافعون عن وجودنا وعقيدتنا، وأننا سنبذل أرواحنا رخيصةً لو أُتيح لنا تقديمها فداءً لفلسطين والأقصى. وهذا أقل ما يمكننا القيام به في زمانٍ يُصَدَّقُ فيه الكذوبُ، ويُكَذَّبُ فيه الصادقُ، ويشمت فيه بعض المسلمين في إراقةِ دماء المسلمين بغياً وعدواناً. كم نشعر بالخزي من أنفسنا، يا فلسطيننا وقدسنا وأقصانا، عندما نرى كرام أمتنا من أبنائكِ يُسَطِّرون بدمائهم وأرواحهم أعظم ملاحم تاريخنا، ونحن جالسون نشاركهم في بطولاتهم بمشاهدة نهر دمائهم الزكية في القنوات الفضائية. [email protected]
5076
| 18 مايو 2021
عند قراءة التاريخ، تكون فيه شخصيات لا حدود لتواجدها الزمني؛ إذ تُذكَرُ في كل العصور مُحاطةً بالإجلال والمحبة، كالفاروق، رضي الله عنه. والسؤال هو: لماذا يذكر المسلمون الفاروق؟ وما سر محبتهم له؟، وتكون الإجابة صحيحةً إن قيل إنه من الصحابة، أو إنه من الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم، لكنها ليست كافيةً؛ لأن ذِكْرَهُ طاغٍ، والاستدلالَ به كثيرٌ، فكأنه حاضرٌ بين الناس، أو كأنهم ينتظرون قدومه وهم يتحدثون عنه. وهذا الأمر ليس غريباً، فمعظم شعوبنا تحلم بالعدالة السياسية والاجتماعية، وبكرامة الإسلام ونُبل العروبة، وسواها من أمور تفتقدها في ظلال الاستبداد والقمع والتهميش والمتاجرة بقضايانا العادلة في سوق النخاسة السياسية، مما يجعلها تلتف حول قامةٍ تاريخيةٍ قباديةٍ شامخةٍ حققت ذلك، كلَّه، كالخليفة العادل عمر، رضي الله عنه. لننظر بعيون قلوبنا إلى السنة السادسة للبعثة النبوية، حين كان المسلمون مستضعفين في مكة المكرمة، يحيط بهم المشركون، ويؤذونهم أذى عظيماً، ونرى الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، يدعو الله تعالى قائلاً: (اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، بِأَبِي جَهْلٍ، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّاب)، فكانت إجابةُ الدعاء هي إسلامُ عمر، الذي كان بداية لإعلان المسلمين إيمانهم، والجَهْرِ به دون خوفٍ من المشركين، فسماه الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالفاروق، لأن إسلامه فرَّقَ بين الحق والباطل، وأعزَّ الله به دينه الحنيف. ولننتقل إلى المدينة المنورة، في عهد خلافة عمر، ونتابع الرجل الكهل، طويل القامة، الذي كانت الدولة الوليدة التي يقودها تدك حصون طغيان أعظم إمبراطوريتين في زمانه: الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، ونراه يمشي في شوارع المدينة ليلاً، وإذ به يسمع بكاء صِبْيَةٍ جياعٍ تغلي لهم أمهم الماء لتُوهمهم بأنه طعام، فيتصدَّعُ قلبه خوفاً من الله، وحناناً بهؤلاء المساكين، شفقةً عليهم، فيهرع إلى بيت المال ليُحضر لهم طعاماً، ويطبخه لهم. ثم تكون هذه الحادثة بدايةً لأمرٍ عظيمٍ هو بمفاهيم عصرنا، حق الشعب كلِّهِ في أن ينال نصيبه من المال العام للدولة، وأن الحاكم مؤتمنٌ على هذا المال، وليس مالكاً له. وننظر، الآن، إلى القدس الشريف في السنة السادسة عشرة للهجرة، وقد اجتمع قساوستها ورُهبانها والنصارى من أهلها ينتظرون دخول خليفة المسلمين إليها، وهم مطمئنون إلى عدالته. ثم نرى الفاروق، رضي الله عنه، يدخلها وكأنه واحدٌ من عامة المسلمين، رغم أن اسمه، وحده، كان يُزلزل قلوب قادة أعظم دول الاستبداد في عصره، فيعطي النصارى الضمانات على حريتهم المدنية والدينية، فيما عُرفَ تاريخياً بالعُهدة العُمرية التي لو قرأناها بدقةٍ فستبكي قلوبنا على القدس وقد سيطر عليها واستباحها الذين نصَّت العُهدة على أن لا يدخلوها. أما المنظر الأخير الذي سنراه بعيون قلوبنا، فهو اجتماع المسلمين في المسجد النبوي لصلاة الفجر، في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة من السنة الثالثة والعشرين للهجرة، يؤمُّهم الفاروق الذي لم يكد يُكبِّرُ للصلاة حتى عاجله أبو لؤلؤة المجوسي بطعنتين من خنجرٍ ذي نَصلين، إحداهما في عنقه، والأخرى في خاصرته، فقال {وَكَانَ أَمرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقدُوراً}. ومرت أيامٌ على الجريمة قبل وفاة الفاروق، وهو مستبشر بشهادته، وقُرب لقائه بالمصطفى، صلى الله عليه وسلم، ثم يتذكر مسؤولياته الجسام في خلافته، فيضع وجهه على التراب، وتتحدر دموعه من خشية الله، ويقول: "ويلٌ لعمرَ، ويلٌ لعمرَ، إنْ لم يغفرْ له ربُّه غداً". عند الاطلاع على تاريخنا، فسنجد أن معجزة الإسراء والمعراج كانت إلى ومن المسجد الأقصى في القدس، في شهر رجب من السنة العاشرة قبل الهجرة، وفتح المسلمون القدس ودخلوها، بقيادة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في شهر رجب من السنة السادسة عشرة للهجرة، وحررها صلاح الدين الأيوبي، رحمه الله، من الصليبيين في شهر رجب من سنة 583 للهجرة، فكأننا، دائماً، على موعد مع حَدَثٍ عظيمٍ في هذا الشهر. أما الأمر اللافت للنظر في الهجمات التي يقوم بها بعض المحسوبين على أمتنا، فهو ارتكازها على إنكار معجزة الإسراء والمعراج، وتشويه سيرة عمر وصلاح الدين، مما يجعلنا نزداد يقيناً بأن استهداف عقيدتنا وقادتنا العظام لا هدف من ورائه إلا محو القدس وفلسطين من التاريخ. كاتِـب وَإِعْـلامي قَـطَـرِى [email protected]
7909
| 27 أبريل 2021
معظم الناس يموتون بموت أجسادهم، فتندثر سيرتهم، ويَمَّحى أثرهم بعد دفنهم، لكن قلةً منهم، يكون موتهم بدايةً لحياةٍ جديدةٍ في الدنيا؛ فتبقى سيرتهم عطرةً في النفوس، ومحبتهم عظيمةً في القلوب، وتمر القرون تلو القرون وكأنهم يعيشون بيننا، فيتحدث عنهم المسلمون في غابات أندونيسيا المطيرة، وقرى السنغال، وبلدات الشيشان، وجبال الجزائر، وصحاري شبه الجزيرة العربية، ومعظم هؤلاء المسلمين لم يقرأوا كتب هؤلاء الموتى الأحياء، ولا يعرفون بدقةٍ ما قدموه لدينهم وأمتهم، ولكنهم يذكرون أجزاء من تضحياتهم ومواقفهم التي حفظت للأمة دينها، وجعلت للشعوب ركيزةً تستند إليها عند مواجهة الطغيان، ومن هؤلاء الكرام، الشيخ الجليل، والعالم الفقيه أحمد بن حنبل، رحمه الله. كان بإمكان ابن حنبل أن يكون غنياً غنى فاحشاً، ويتبوأ مكانةً رفيعةً في الدولة، لو أنه قَبِلَ بتنكيس رايات الإسلام قليلاً، ورضيَ بتمرير الأفكار المنحرفة المخالفة للشريعة السمحاء، لكنه آثَرَ أن يُقدِّمَ لحياته الباقية، فضحى تضحيات هائلة في حياته الفانية، ففي بدايات القرن الثالث الهجري، ظهرت بدعة خَلْقِ القرآن التي تقول إن القرآن مخلوقٌ، والخطورة فيها أنها تعني أن ما يمر على المخلوقات من وجودٍ وشبابٍ وكهولةٍ وشيخوخةٍ ثم موتٍ، تنطبق على كتاب الله، فيصبح هيناً على الناس القول إن أحكامه تصلح لأزمانٍ انقضت، لكنها لا تصلح للحاضر والمستقبل، ورغم الحجج التي ساقها القائلون بخلقه، وادعاءاتهم بشأن عدم المساس بقدسيته، إلا أنهم لم يستطيعوا التغلُّبَ على الاعتقاد الصحيح للمسلمين بأن القرآن كلام الله وليس مخلوقاً؛ لأن قوماً كراماً كابن حنبل وقفوا وقفةَ الإيمان بالله، والاعتزاز بالإسلام، ورفضوا تمرير هذه المقولة. يتثاقف البعض بالقول: هل كان ابن حنبل سيُخلَّدُ في سجلات التاريخ لو لم تظهر تلك البدعة؟، وهو سؤال افتراضي؛ بمعنى أنه يفترض أمراً ثم يبني عليه فكرةً بهدف الغَضِّ من شأن الشيخ الجليل، والجواب بسيطٌ: فتضحيات ابن حنبل كانت مبنيةً على علمٍ وفقهٍ وإيمانٍ في مواجهة حَدَثٍ وقع بالفعل، مما يجعل من السؤال مجرد لغوٍ لا يؤثر في مكانة الشيخ في النفوس والعقول، ولا في دوره كعالمٍ فقيهٍ مُجدِّدٍ. من الأمور اللافتة للنظر، أن التاريخ يُغفلُ ذِكْرَ ملايين المنحنين للطغيان، خوفاً وطمعاً، لكنه يُخَلِّدَ بضع عشراتٍ من الذين شمخوا بقاماتهم وسط هؤلاء المنكسرين، فحين صمتَ علماء السلاطين عن الباطل في مقولة خَلْقِ القرآن، وأخذ الناس يتخبطون في عقيدتهم، برز ابن حنبل وقال: لا، فكانت هذه الـ "لا" الحبل الذي اعتصم الناس به، فسِيقَ إلى السجن، وعُذِّبَ عذاباً هائلاً، وبقي صامداً أبياً، فلا استطاعت سياط الظَّلَمةِ أن تنال من قوة إيمانه، ولا سيوفهم أن توهن عزيمته، ولا جدران السجن أن تمنع روحه من التمتع بالحرية الحقة في رضا الله وطاعته. الملاحَظ، في شعوبنا الإسلامية، أن أبطالها عابرون للحدود والقوميات، فهي ترى فيهم جزءاً من ذاتها، وتَعكس في سِيَرِهم أفضل ما فيها، أو تُجَسِّدُ فيهم ما تتمناه لها في حاضرها المضطرب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ومن هذا المنطلق، لا يمكن دراسة الوجود التاريخي الممتد للشيخ الجليل في إطار فقهه وعلمه اللذين كانا خطوةً هائلةً في إيجاد البناء العلمي والفقهي للشريعة الإسلامية، وتطبيقاتها في كل نواحي الحياة، وإنما يجب أن ننظر إليه كإنسان متفرِّدٍ في شموخه وإصراره على الحق حتى لو كان الثمن حياته، إنه رمزٌ إسلاميٌّ؛ لأن الفكر والعلم عنده اقترنا بالإيمان والعمل، ولم يكونا رفاهاً أو أداةً لتحقيق منافع دنيوية، لقد مَثَّل للمسلمين تجسيداً لانتصار الإرادة مهما تعاظمت قوة واستبداد الذين يريدون كسرها وتحطيمها، فعاش في نفوسهم حياً في حياته، وحياً بعد وفاته. نستلهم، نحن المسلمين، من سيرته زاداً لإيماننا بأن الضعف الطارئ لا يعني موت الأمة، وأن كثرة المصفقين للباطل لا تعني زوال الحق، وأن الصبر على الابتلاء، والتمسُّكِ بالثوابت الإسلامية، هما إحدى ركائز النهضة العظيمة التي ربما لن يشهدها جيلنا، لكننا نبذر بذورها في تربة الإيمان لتتمتع بها أجيالٌ تأتي بعدنا، فتذكرنا بالخير، وتستلهم مثلنا قبساً من كرامة الإسلام وعزته في سيرة الشيخ الجليل أحمد بن حنبل، رحمه الله. [email protected]
4861
| 20 أبريل 2021
ها قدْ أقبلَ رمضانُ الـمُباركُ ترافقُـهُ الرحمةُ والبركةُ، وتُظِـلُّ الدنيا فيه مشاعرُ الإيثارِ والـمَـوَدَّةِ، وتحلوالحياةُ بالإيمانِ الخالصِ والعملِ الصالحِ. فمليارٌ وسبعمائةُ مليون مسلمٍ ينتظرونه وقد أعدوا له قلوبهم الضارعة إلى الله برفع الابتلاء عن المسلمين، والبلاءِ عن العالم أجمع. في رمضانَ، نلتفتُ أكثرَ إلى معاناةِ أشقائنا في الإسلامِ والعروبةِ، لنشاطرَهُم مواجعَـهُم، فنسعى لتخفيفِ وَطأتِها عليهم، ونَتَلَـمَّسُ آمالَـهُم في حياةٍ آمنةٍ كريمةٍ، فنهبُّ لاحتضانِـها داعينَ اللهَ تعالى بالخيرِ لهم في كلِّ شؤونِهِم. فهم أشقاؤنا الذينَ لهم في قلوبِـنا مكانُ الصَّـدارةِ، ولهم علينا حَقُّ النُّصرةِ بما نستطيعُ، بالـمالِ والكلمةِ الطيبةِ والتَّجاوزِ عن الصغائرِ التي تثيرُ الضغائنَ وتُوغِـرُ الصدورَ. في رمضانَ، ننظرُ بعيونِ أرواحِـنا إلى فلسطينَ الحبيبةِ، وسوريا الحبيبةِ، واليمنِ الحبيبِ، والعراقِ الحبيبِ، وليبيا الحبيبةِ، وتَضْـرَعُ قلوبُنا بالدعاءِ لها بالاستقرارِ والأمنِ لتكونَ واحاتٍ للحضارةِ الإسلاميةِ،ومراكزَ إشعاعٍ للعروبةِ. وندعو لأشقائِـنا فيها بالتعاضُدِ فيما بينهم من أجلِ أوطانِـهِم وأبنائهم. في رمضانَ، نُجَـدِّدُ العهدَ ببذلِ أقصى الجهدِ في سبيلِ قطرَ الغاليةِ التي تمتدُّ في نفوسِنا على مساحاتٍ لا مُتناهياتٍ منَ الحبِّ والفداءِ والإيثارِ. قطرُ التي تنبضُ في قلبِ سمو الأمير الـمفدى، بالـمجدِ والحضارةِ والـمَـدَنيَّـةِ، وتَنْعَـمُ وإنسانُها الـمواطنُ برؤى سموِّهِ لـمستقبلهما في ظلالِ الرفاهِ والأمنِ والتَّقَـدُّمِ والنَّـماءِ. آخر الكلام: ما الذي سيتغيرُ بالنسبةِ لي ككاتبٍ وإعلاميٍّ في الشهر المبارك ؟.. ستتغيرُ توجهاتي لتنتقلَ إلى ملامسةِ حالةِ الإيمانِ النقي التي ستَعْمُرُ القلوبُ بها، وأحاولُ أنْ أنقلَ الناسَ من حالةِ الخوفِ والشعورِ بالاحتجازِ والعُزلةِ، إلى حالةِ الاطمئنانِ والشعورِ بالحريةِ المطلقةِ من خلالِ العمل الصالح ومعونةِ المحتاجين.. أعتقدُ جازماً أن الشهرَ الكريمَ سيجعلُنا نفكرُ بالذين أدى جلوسُهُم في البيوت إلى وصولهم إلى حافةِ الفقرِ والفاقةِ، أكثرَ من تفكيرنا في السِّمْنةِ والمللِ بسبب الحَجْرِ الاختياري في منازلنا. كاتب وإعلامي قطري [email protected]
2607
| 13 أبريل 2021
توجدُ مساحةٌ حولَ السيارةِ لا يمكنُ للمرآةِ أنْ ترصدَها، تُسمى بالنقطةِ العمياء، التي تُعَـدُّ سبباً في كثيرٍ منْ حوادثِ السيرِ. ولو نظرنا حولَنا للاحظنا أنَّ معظمَنا توجدُ في حياتِـهِم نقاطٌ عمياءُ تُسبِّبُ مشكلاتٍ أُسريةً واجتماعيةً تنتجُ عنها اضطراباتٌ نفسيةٌ، وانحرافاتٌ أخلاقيةٌ وسلوكيةٌ. والأمرُ الـمُستغربُ أنَّ أكثرَنا يعتقدونَ أنَّها موجودةٌ في الآخرينَ فقط، وكأنَّها مثلُ الـموتِ الذي يهربون من خوفِهِم منه بافتراضِهِم أنَّـهُ شيءٌ يحدثُ لسواهم، رغم إيمانِهِم بأنَّهُ أمرٌ لا مفرَّ لجميعِ الأحياءِ منه. وهذه الحالةُ منْ الهروبِ النفسيِّ نجدُها في كلِّ مجالاتِ الحياةِ الخاصةِ والعامةِ. عندما نبحثُ في أسبابِ جنوحِ الأحداثِ، فسنجدُ أنَّ معظمَها ناتجٌ عن خللٍ في العلاقاتِ بينَ الزوجينِ، وعلاقاتِهِما بأبنائِهِما. فمثلاً، بعضُ الأزواجِ يُبصرونَ كلَّ الصفاتِ الرائعةَ في نساءِ الأرضِ، وينظرونَ بإعجابٍ شديدٍ إلى أدبِ وذكاءِ أبناءِ الآخرينَ، أما جمالُ ورِقَّـةُ وطيبةُ زوجاتِهِم، وأدبُ وذكاءُ ومواهبُ أبنائِهِم، فإنَّها أمورٌ تقعُ في الـمساحةِ التي لا تُغطيها النقطةُ العمياءُ في نفوسِـهِم وعقولِهِم. وأيضاً، تلعبُ نفسُ النقطةِ عندَ الزوجةِ دوراً كبيراً في تحطيمِ وجودِ الأبِ في نفوسِ الأبناءِ، عندما تندبُ حظَّها الذي جعلَـهُ زوجاً لها، وتُصِـرُّ على أنَّها لم تَـرَ منه أبداً ما يُسعـدُها، ولا تنظر إلى حنانِهِ وسعيه الدائمِ لرعايةِ أسرتِـهِ، وضمانِ ما يُحقق لها حياةً كريمةً طيبةً. وبالطبعِ، فإنَّ ذلك، يؤثر سلباً وبشدةٍ على الاتزانِ النفسيِّ للأطفالِ، ويجعلُهُم يهربونَ من واقعِهِم الـمريرِ إلى العُزلةِ، أو السلوكِ العنيفِ الذي يتحدُّونَ به قِـيَـمَ الـمجتمعِ وضوابطَهُ الأخلاقيةَ. وهذا يؤدي إلى جُنوحِهِم الـمُبكرِ. وفي حياتِنا العامةِ، نجدُ أشخاصاً لا يَفصلونَ بينَ الخاصِّ والعامِّ في تعامُلِهِم معَ الآخرينَ. فمنهم مَنْ يثورُ إذا كانَ يقودُ سيارتَـهُ ثم رأى شخصاً في سيارةٍ مجاورةٍ ينظرُ إليه، فتمنعُهُ نقطتُهُ العمياءُ منْ تقديرِ الأمرِ منطقياً، ويعتبرُهِ جريمةً انْـتُهِـكَتْ بها خصوصيتُهُ. ومنهم مَنْ يتعاملُ معَ الـمُراجعينَ في موقعِ عملِـهِ وكأنَّهُم أناسٌ مُزعجونَ عليهم إطاعتُـهُ دونَ نقاشٍ، ولا ينظرُ إليهم كبشرٍ لهم مصالحُهُم التي ترتبطُ بأدائِـهِ مهامَّ عملِـهِ على أكملِ وجهٍ، وبإجابتِـهِ عن استفساراتِـهِم بصبرٍ. وفي الـمقابلِ، نجدُ أنَّ النقاطَ العمياءَ لبعضِ الـمراجعينَ تَحولُ بينهم وبينَ الالتزامِ بالنظامِ، فيرونَ في الـموظفِ أو العاملِ شخصاً لابدَّ من التعاملِ معه بجلافةٍ وكأنَّـهُ ألةٌ لا مشاعرَ فيها. أما النقطةُ العمياءُ الأشدُّ خطراً، فهي التي تمنعُ أولياءَ الأمورِ من رؤيةِ الخللِ في تنشئتِهِم لأبنائِـهِم، ورعايتِهِم لهم. فنجدُهم يَشنُّونَ الحملاتِ الظالـمةَ على الـمُدرسينَ، ويحَـمِّلونَهُم تراجعَ الـمستوى الدراسيِّ لأبنائِهم. وإذا قلنا لهم إنَّ الخللَ في الأسرةِ، اتَّسَعَتْ مساحةُ النقطةِ لتَشملَنا، فنُصبحُ في نَظَرِهِم أغبياء مُدَّعينَ. والضحايا، في هذا الصراعِ، هم الأبناءُ الذين يتضاءلُ احترامُهُم للمُدرسينَ، فيُهملونَ في دراستِهِم اعتماداً على أنَّ أولياءَ أمورِهِم في صفِّهِم مطلقاً. كلمةٌ أخيرةٌ: إذا لم نَسعَ بجدٍّ للتوعيةِ بثقافةِ النقدِ الذاتيِّ فلن نتمكنَ منَ التَّغَلُّبِ على نقاطِنا العمياءِ، وسنظلُّ قابعينَ في قواقعِ الأنا الـمُتَضَخِّـمةِ في نفوسِنا بعيداً عنْ مفاهيمِ احترامِ الآخرِ، وتقديرِهِ، وتَفَهُّمِ ما يقولُهُ ويفعلُهُ. كاتِـب وَإِعْـلامي قَـطَـرِي [email protected]
3630
| 06 أبريل 2021
في الأساطيرِ الإغريقيةِ، كان أَخيل ابناً لـلملكِ بيليوس، من إحدى حورياتِ البحرِ وتُدعى ثِيتس. وأرادتْ أمُّهُ أنْ تجعلَـهُ خالداً، فَغَمَرَتْـهُ في نهرِ استيكس الـمُقَدَّسْ، وهي مُمْسِـكَةٌ بكعبِـهِ، فصارَ جسدُهُ مَحْمياً منَ الجراحِ الـمُمِيتةِ ما عدا كعبَـهُ. ولَـمَّا حاصرَ اليونانيونَ مدينةَ طروادةَ، كان في صفوفِهِم، وقَتَـلَ كثيراً منَ الطرواديين، حتى رماهُ أحدُهُم بسَهْمٍ مسمومٍ في كعبِـهِ، ولَقِـيَ مَصرعَهُ، فصارَ كعبُـهُ رمزاً لنقاطِ الضَّعْفِ القاتلةِ في الإنسانِ. لو دَقَّـقْـنا النَّظَـرَ في نفوسِـنا، فسنجدُ أنَّ لكلِّ واحدٍ منا نقطةَ أو نقاطَ ضعفٍ نحرصُ على ألَّا يعرفَ الآخرونَ شيئاً عنها، رغم أنَّ بعضَها ليس إلا أوهاماً تَضَخَّمَتْ حتى صارتْ كالحقيقةِ نعيشُها في اللاشُعور. فَـمِـنَ الأشخاصِ، مَنْ يكونُ ذا مكانةٍ في المجتمعِ، وبين أخوتِـهِ وأهلِـهِ لأنَّهُ حصلَ على شهادةٍ دراسيةٍ عليا، وشَغَلَ لسنواتٍ طوالَ وظيفةً مرموقةً. وعندما تقاعدَ، شعرَ بأنَّـهُ يندثرُ، وتَوَهَّمَ أنْ لم يَبقَ في الحياةِ مُتَّسَـعٌ ليُقَـدِّمَ جديداً، أو أنْ يسيرَ في طريقٍ يستثمرُ فيه علمَهُ وخبراتِـهِ وعلاقاتِـهِ لإفادةِ الناسِ بجديدٍ في مجالِ تخصصِـهِ. وهنا، يَتَّخِـذُ صراعُـهُ النفسيُّ صوراً عدَّةً يُخفي وراءها كَعْبَ أخيل الذي هو شعورُهُ الوهميُّ بانتهاءِ دورِهِ في الحياةِ. فيبدأُ بانتقادِ الشبابِ الـمُتميِـزينَ بوعيهم وثقافتِهم، وانتقاصِ ما يقدمونهُ منْ إبداعٍ أدبي أو فكري أو فني. وتَتَضَخَّمُ مُعاناتُهُ، بمرورِ الأيامِ، فيفرُّ منها بتضخيمِ الأنا في نفسِهِ حتى لا يكادُ يرى سوى نفسِـهِ. وأحدُ الأشخاصِ تَعَرَّضَ لتجربةِ زواجٍ مَريرةٍ معَ زوجةٍ مُتَـنَمِّرَةٍ لم يجدْ منها إلا احتقاراً لكل ما يفعلُـهُ. وعندما طَلَّقَها أصبحَ زواجُهُ الفاشلُ كَعْبَ أخيل الذي يحاولُ سترَهُ عنِ العيونِ كي لا يُتَّخَـذَ سبيلاً للسخريةِ منه. وصارَ يعيشُ حياتينِ، أولاهما معَ الناسِ كشخصٍ سَوِي مُتَّزنٍ ذي شخصيةٍ قويةٍ، والثانية مع نفسِـهِ التي يجلدُها ويَقسو عليها بشعورِهِ بدُونيَّتِـهِ. وإحدى الفتياتِ الـمُراهقاتِ، لم تُساعدُها بيئتُها الأُسَريةُ الـمُتَصَدِّعةُ على تكوينِ شخصيةٍ متماسكةٍ كإنسانةٍ ذاتِ رأيٍ ومواقفَ مستقلَّةٍ، فأخذتْ تُخفي حقيقةَ مُعاناتِها الأُسَرِيَّةِ، وتعيشُ في عالمٍ معزولٍ خاص بها، تداوي به كَعْبَ أخيل في نفسِها بالأحلامِ والهروبِ منَ الواقعِ. بل إنَّها قد تبحثُ عنِ التعويضِ العاطفيِ في أشخاصٍ لا إيمانَ يَعصمُهـم، ولا قِـيمَ تجعلُهُم يرونَ فيها إنسانةً مسكينةً، منَ الخطيئةِ الإضرارُ بها. وفي حالتِها، يكونُ الكعبُ حفرةً بلا قاعٍ، مملوءةً بالمصائبِ والبلايا التي تتهدَّدُها في شرفِها وسُمعتِها. والصراعُ النفسيُّ بسببِ نقاطِ الضعفِ الحقيقيةِ والـمُفْتَرَضَةِ ليس مجردَ صراعٍ داخلي لا يبدو للعينِ الـمُدَقِّـقَةِ، وإنما يتخذُ صوراً سلوكيةً تدلُّ عليه. فالشخصُ الذي له أبٌ مدمنٌ على الـمخدراتِ أو معاقرةِ الخمرِ نجدُهُ في حالتينِ: الأولى؛ كشخصٍ انعزاليٍّ يخشى مخالطةَ الناسِ خوفاً من أنْ يكونوا عارفينَ بسيرةِ أبيه، فينظرونَ إليه بدونيةٍ، ويَتخذونَها سبيلاً لتجريحِـهِ والغَضِ من شأنِـهِ. والثانيةُ؛ كشخصٍ انفعالي مرحٍ جداً، يقولُ نكاتاً عن والدِهِ، ويسخرُ من نفسِـهِ، و له شعبيةٌ بين رفاقِـهِ الذين لا يدركون أنَّـهُ يتألمُ بشدةٍ، ويتمنى لو لم يكنْ أبوه هذا الرجلَ الـمُنحرفَ. وفي كِـلْـتَا الحالتينِ، نجدُ أنَّ كعبَ أخيل الذي يُخفيه عن الناسِ هو تَـمَنِّـيهِ موتَ أبيهِ، وهو أمرٌ يُفْزِعُـهُ كثيراً، فيهربُ منه إلى مزيدٍ منَ العُزلَـةِ أو الانفعالِ الـمُبالَغِ فيه. ولكن، ما هو دورُنا في التخفيفِ من تأثيراتِ كعبِ أخيل الـموجودِ في نفوسِ كثيرينَ منا؟. الإجابةُ، بالطبعِ، ليستْ بالبساطةِ التي نعتقدُها، لأنَّنا لا نستطيعُ الهروبَ من مواجهةِ حقيقةٍ تقولُ إنَّ جزءاً من ثقافتِنا الـمُجتمعيةِ فيه قسوةٌ وأنانيةٌ تتناقضانِ مع روحِ وإنسانيةِ الإسلامِ الحنيفِ. فنجدُ أنَّ التَّشَفِّي بروايةِ القصصِ الـمُضَخَّمَةِ عن المُعاناةِ النفسيةِ لفلانٍ و فلانةٍ، أمرٌ طبيعيٌّ في مجالسِنا، والـمُصيبةُ، أنَّنا نُخفي تَشَفِّـينا بغلافٍ منَ التعاطفِ، ولا ندرك كم نحنُ خاطئونَ. إذن، لابدَّ منْ إسهامِ كلِّ واحدٍ منا في نَشْـرِ مفاهيمِ القبولِ بالآخرِ، واحترامِ خصوصيتِـهِ، وصولاً إلى ترسيخِ ثقافةِ التَّعدديةِ الـمجتمعيةِ التي تنهضُ بها الشعوبُ والأممُ. كلمة أخيرة: قد تكونُ كلمةٌ طيبةٌ نقولُـها هي بذرةُ الأملِ التي نُلقيها في نفسِ شخصٍ، فتنمو، وتُزهِـرُ، وتُثمرُ بالخيراتِ، وتُغيِّرُ مسارَ حياتِـهِ. كاتِـبٌ وَإِعْـلاميٌّ قَـطَـرِيٌّ [email protected]
2851
| 30 مارس 2021
في القانونِ الجنائيِّ، عندما يقومُ شخصٌ بإطلاقِ النارِ على آخرَ فيقتلُهُ، فإنَّ جريمتَـهُ تكونُ إيجابيةً، أيْ توفرَ لها الفِـعلُ: إطلاقُ النارِ، والنتيجةُ: مقتلُ إنسانٍ. أما عندما يمتنعُ شخصٌ عن القيامِ بأمرٍ فيُسبِّبُ امتناعُهُ موتَ إنسانٍ، كأنْ تمتنعُ الأمُّ عن إرضاعِ صغيرِها فيموتُ، فإنَّ الجريمةَ تكونُ سلبيةً. وفي الحالتينِ، تكونُ العقوبةُ واضحةً مُفَصَّلَةً، ويتمُّ إيقاعُها بالـمجرمِ وحدَهُ دونَ أنْ يُضارَّ الذينَ لا ذَنْبَ لهم. أما في حياتِنا، فكثيرٌ منَ الجرائمِ الاجتماعيةِ لا ينالُ مرتكبوها عقوبةً، رغم أنَّها تُحطِّمُ سُمعةَ إنسانٍ، وتُدَمِّـرُ أُسَراً. وأسوأُ نتائجِها تكونُ شعورَ ضحاياها بالعَداءِ تجاهَ الـمجتمعِ وقِـيَـمِـهِ. لننظرْ، مثلاً، إلى ما يحدثُ لشابٍّ ارتكبَ جريمةً، كتعاطي الـمخدراتِ، وعُوقِـبَ بالسَّجنِ، وعُولِجَ وصَلُحَ حالُـهُ، لنرى كيفَ يقومُ أفرادٌ كُثْرُ في الـمجتمعِ بمعاقبتِـهِ، ومعاقبةِ أسرتِـهِ، بقسوةٍ ولؤمٍ مُفرطَينِ. فنجدُهُم لا يُبالونَ ببحثِ الأسبابِ التي دفعتهُ لتعاطي الـمخدراتِ، ولا بالآلياتِ التي عُولجَ بها منَ الإدمانِ، وإنما يأخذونَ بانتقادِهِ، والتشكيكِ به، ووَصْفِ أسرتِـهِ بالفسادِ. وهنا، يجدُ أفرادُ الأسرةِ أنفسَهُم في مواجهةٍ ظالـمةٍ معَ مجتمعٍ لا يستطيعُ بعضُ أبنائِـهِ أنْ يَتَحلوا بالروحِ الإنسانيةِ للإسلامِ الحنيفِ. ولننظرْ إلى قيامِ شابٍّ تافهٍ بالإساءةِ لسُمعةِ فتاةٍ، فيذكرُها بالاسمِ، ويروي عنها أموراً يختلقُها، لنرى كيفَ يُنَصِّبُ بعضُ الأفرادِ أنفسَهُم قُضاةً، فيحكمونَ عليها وعلى أسرتِها بالفسادِ. بل، ويقومونَ بروايةِ قصصٍ لا منطقَ فيها عنها وعن أخواتِها، لدرجةِ أنَّ الذينَ تربطُهُم بأسرتِها علاقاتُ جوارٍ طيبةٍ يشعرونَ بالخطرِ على بناتِـهم وأُسَرِهِم، فينضمونَ إلى قافلةِ الظلمِ الاجتماعيِّ، بلا تفكيرٍ، ويعاقبونَها بالعَزْلِ وإظهارِ الكراهيةِ لها. فماذا ننتظرُ من هاتِـهِ الـمظلوماتِ اللاتي صارَ مصيرُهُنَ بائساً، ولم يَعُدْ بإمكانِـهِنَّ مجردَ الحلمِ بحياةٍ زوجيةٍ هانئةٍ كسواهُنَّ منَ الفتياتِ؟. الـمجتمعُ، في الحالتينِ وسواهما، يقومُ بالجريمةِ السلبيةِ، لأنَّ كثيراً منْ أبنائِـهِ يمتنعونَ عن القولِ والعملِ الكفيلينِ بفَضْحِ ومعاقبةِ الـمجرمينَ الإيجابيينَ الذين ينشرونَ أموراً تُؤثِّرُ سلباً وبشدةٍ على مصائرِ أناسٍ أخطأوا وتابوا، أو اتُّهِموا بالخطيئةِ. وترجعُ سلبيتُهُ إلى أنَّ النهضةَ الاجتماعيةَ، والتَّحضُّرَ، والتَّمَدُّنَ لم ترافقها تنميةٌ أخلاقيةٌ كافيةٌ تستندُ إلى الروحِ الإنسانيةِ، والرحمةِ، والعدالةِ في ديننا الإسلاميِّ الحنيفِ. لكنَّ الجيلَ الشابَّ في بلادِنا الحبيبةِ بدأ في ممارسةِ دورِهِ في تلك التنميةِ عَبْرَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ، مما يجعلُنا نشعرُ بالاطمئنانِ إلى الغدِ الاجتماعيِّ والأخلاقيِّ لـمجتمعِنا. كلمةٌ أخيرةٌ: منهجُنا في حياتِنا الاجتماعيةِ يستندُ إلى حديثِ الأغلى منْ حياتِنا ودُنيانا، ﷺ: (كُلُّ بَنِـيْ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْـرُ الخَطَّائِـيْـنَ التَّـوَّابُونَ إبْراهِـيْـمُ فَـلامَـرْزِي كاتِـبٌ وَإِعْـلاميٌّ قَـطَـرِيٌّ [email protected]
3176
| 02 مارس 2021
ذكرَ عالمُ الاجتماعِ الكبيرُ؛ كلود ليڤي ستراوس، أنَّ الساحرَ في القبائلِ الـمعزولةِ عنِ العالَمِ في أمريكا الجنوبيةِ يقومُ بإلقاءِ لعنةٍ بالـموتِ على شخصٍ، وكيفَ يتقبَّلُ الشخصُ مصيرَهُ وكأنَّـهُ قَدَرٌ محتومٌ، فتتلاشى إرادتُهُ، ويبدأُ في رَفْضِ الطعامِ والشرابِ، ويذوي جسدُهُ بالتزامُنِ مع اضمحلالِ نزعتِـهِ للحياةِ حتى يموتَ فعلاً. وهذه الحالةُ من استلابِ الإرادةِ، والخضوعِ لأشخاصٍ لهم قدراتٌ خارقةٌ، معروفةٌ في ثقافاتِ كلِّ الشعوبِ مع اختلافٍ في صورِها ودرجاتِ تَقَبُّلِها. ففي هذه الثقافاتِ، توجدُ قصصٌ شعبيةٌ عن بيوتٍ قديمةٍ وأراضٍ بعيدةٍ عن العمرانِ تسكنُها مخلوقاتٌ كالجنِّ، أو كائناتٌ مُخْتَلَقَـةٌ كالأرواحِ الشريرةِ والأشباحِ. والـمُلاحَظُ فيها أنَّ جميعَها تُروى نقلاً عن فلانٍ أو فلانة، وقلَّما يكونُ الراوي طرفاً قد عاشَ إحداها، فينقلُ إلى الناسِ خبراتِـهِ ومشاهداتِـهِ. وبالطبعِ، فإنَّ الحديثَ في هذا الجانبِ ممتعٌ يجذبُ الناسَ لسماعِـهِ كنوعٍ منَ الرغبةِ في الخوفِ أو زيادةِ نسبتِـهِ في النفسِ بالتطرُّقِ لأشياء لا يمكنُ التعاملُ معها بالعقلِ والـمنطقِ، وتوحي بالشرِّ الـمُطْـلَقِ الذي لا تحكمُهُ مشاعرُ الرحمةِ. والبعضُ يلجأونَ إليه كنوعٍ منَ الهروبِ من واقعٍ مريرٍ يضغطُ عليهم ولا يستطيعونَ مواجهتَهُ، فينشغلونَ بعوالمَ مجهولةٍ تعيشُ فيها كائناتٌ لا تخضعُ للقوانينِ الطبيعيةِ، ويتمنونَ لو تواصلوا معها وأخضعوها لتفعلَ لهم أموراً كالخوارقِ والـمعجزاتِ، وبذلك تنشأ الشعوذةُ وينشطُ الـمُشَعْوِذونَ في استغلالِ سعي الناسِ لتحقيقِ أمنياتِهِم. على سبيلِ الـمثالِ، في إحدى الـمناطقِ يوجدُ بيتٌ معروفٌ لكثيرينَ باسمِ مُستأجرِهِ، يجتمعُ فيه رجالٌ وشبابٌ في ليالٍ بعينِها، فيعلو قَـرْعُ الطبولِ، ورنينُ الصَّاجاتِ، والغناءُ، حتى منتصفِ الليلِ. ويروي الناسُ عنه أموراً تُخيفُ الأقلَّ وعياً وتعليماً وثقافةً، كإقامةِ حفلاتِ الزَّارِ، وحلولِ الجنِّ في أجسادِ بعضِ الحاضرينَ الذينَ يأخذونَ بالصُّراخِ الهستيريِّ وهم يتواثبونَ راقصينَ بجنونٍ، أو يتمرغونَ بالأرضِ كالممسوسينَ. وذات يومٍ، كنتُ أقفُ مع صديقٍ لي في شارعٍ داخليٍّ قريبٍ إلى هذا البيتِ، فمرَّ بنا رجلٌ كهلٌ طويلُ القامةِ، نحيفٌ، يرتدي ثوباً لم يُكْـوَ منذُ أيامٍ، وينتعلُ نعالاً بلاستيكياً، وهو يدخنُ لفافةَ تبغٍ بشراهةٍ. وإذ بصديقي يقول لي إنَّ الرجلَ هو مستأجِـرُ البيتِ، وإنَّهُ معروفٌ بعلاقاتِهِ بالعالمِ السفليِّ. فنظرتُ إلى هذا الشخصِ الذي يعتقدُ الناسُ بقدراتِـهِ على التواصلِ معَ الجنِّ والسيطرةِ عليهم، فرأيتُ فيه شخصاً أقلَّ منْ عاديٍّ، ومنَ الأشخاصِ الذين لا نتذكرهم إلا إذا رأيناهم، وننساهم بمجردِ ذهابِـهِم. وتذكرتُ ما رواه ستراوس، ووصلتُ إلى نتيجةٍ تقولُ إنَّ ما نقبلُ به بإرادتِنا هو الذي يصنعُ قوةَ الـمُشَعْوِذينَ التي يهيمنونَ بها علينا. في دينِنا الحنيفِ، لا وجودَ لهؤلاءِ الـمُشَعْوِذينَ، ولا لأكاذيبِ السَّحَـرَةِ. بل إنَّ الـمصطفى، ﷺ، أخبرنا بأنَّ قراءةَ الـمُعَوِّذَتَينِ والدعاءَ كافيانِ لتحصينِنا منْ كلِّ الشرورِ، لكنَّ بعضَنا يجعلونَ للهِ شركاءَ فيصدقونَ أنَّهم قادرونَ على التحكُّمِ في مصيرِ إنسانٍ، والسيطرةِ على إراداتِ الآخرينَ. وهذا، بالطبعِ، جانبٌ مُهْمَلٌ جزئياً في البحوثِ والدراساتِ الاجتماعيةِ والنفسيةِ، ولا يجدُ توعيةً دينيةً وعلميةً مُختصةً لإزالتِهِ منَ العقلِ الجمعيِّ. كلمةٌ أخيرةٌ: لو كانَ هؤلاءِ الـمُشَعْوِذونَ صادقينَ، لَكانَ منَ الواجبِ على الدولِ التوقُّفُ عن تطويرِ السلاحِ، وإعدادِ الجيوشِ، وأنْ تستعينَ بهم، فتوفِّـرَ موازناتٍ ضخمةً للتنميةِ والإعمارِ. كاتب و إعلامي قطري [email protected]
1987
| 02 فبراير 2021
مساحة إعلانية

ربما كان الجيل الذي سبق غزو الرقمنة ومواقع...
6525
| 15 فبراير 2026

في ركنٍ من أركان ذاك المجمع التمويني الضخم...
963
| 16 فبراير 2026

لقد نظم المُشرع القطري الجرائم التي يتم ارتكابها...
786
| 16 فبراير 2026

مرحبًا رمضان، رابع الأركان وطريق باب الريان. فالحمد...
771
| 18 فبراير 2026

أخطر ما يهدد المؤسسات اليوم لا يظهر في...
606
| 16 فبراير 2026

الحرب هي القتال والصراع ومحاولة إلحاق الأذى بالعدو...
468
| 13 فبراير 2026

تحتل سورة الفاتحة مكانة فريدة في القرآن الكريم،...
465
| 13 فبراير 2026

يشهد قطاع التعليم تحولاً رقمياً متسارعاً يهدف إلى...
465
| 16 فبراير 2026

انبلاجُ الوعي اليومي لا يقدّم الجسد بوصفه حضورًا...
462
| 19 فبراير 2026

شهر رمضان ليس مجرد موعدٍ يتكرر في التقويم،...
453
| 17 فبراير 2026

حتى وقت قريب، لم تكن الفضة من الأصول...
411
| 15 فبراير 2026

منذ توقيع معاهدة ويستفاليا عام 1648، وُضع الأساس...
396
| 16 فبراير 2026
مساحة إعلانية