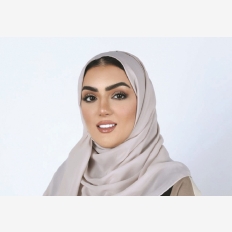رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في عالم العمل الحديث، لم يعد تحديد الأجور وتوزيع المسؤوليات مسألة تقديرية تعتمد على الانطباع أو الخبرة الشخصية، بل عملية علمية دقيقة تُعرف اليوم بـ تقييم الوظائف، وهي العملية التي تضمن أن يحصل كل موظف على أجر عادل يتناسب مع طبيعة وظيفته، حجم مسؤولياته، المهارات المطلوبة لأدائها، وظروف العمل المرتبطة بها. إنها ليست مجرد خطوة إدارية… بل نظام يُعيد ترتيب ميزان العدالة داخل المؤسسة. أهمية تقييم الوظائف تنبع من كونه حجر الأساس لـ العدالة الداخلية، فهو الذي يحدد قيمة كل وظيفة مقارنة بالوظائف الأخرى داخل المنظمة، ويمنع الفجوة التي قد تُنشئ صراعات بين الموظفين أو شعورًا بعدم المساواة، وكلما كانت المنظمة واضحة في تصنيف الوظائف وربطها بالأجور، زادت الثقة وقلّ الدوران الوظيفي، وارتفع مستوى الرضا. وتتجلى العلاقة الوثيقة بين تقييم الوظائف والوصف الوظيفي في أن التقييم لا يمكن أن يكون دقيقًا دون وصف واضح يحدد المهام، المسؤوليات، الجهد المطلوب، المهارات، العلاقات الوظيفية، وبيئة العمل. فالوصف هو “الصورة”، والتقييم هو “الحكم” على هذه الصورة. وحين يغيب الوصف أو يكون ناقصًا، تصبح عملية التقييم مجرد اجتهاد شخصي. ولكي يكون نظام تقييم الوظائف ناجحًا وفعّالًا، فهو يمر بعدة خطوات تبدأ بتحديد من سيقوم بالتقييم، مرورًا باختيار طريقة مناسبة، ثم وضع خطة تنفيذ وجداول زمنية، وصولًا إلى تسعير الدرجات وربطها بسلم الرواتب. ولا يكتمل النظام دون مراجعة مستمرة ومرونة في التحديث. أما عوامل النجاح، فهي تمتد من اقتناع الإدارة بأهميته، إلى توفير بيانات دقيقة عن الوظائف، مرورًا بوجود خبراء قادرين على تحليل الوظائف بموضوعية، وصولًا إلى القدرة المالية لتطبيق نتائج التقييم. فالعملية ليست ورقية… بل تحتاج إلى ثقافة مؤسسية تحترم العدالة وتؤمن بأن الرواتب ليست قرارات عاطفية، بل نتيجة حسابات مهنية. وتظهر طرق التقييم بأنواعها — الوصفية وغير الوصفية — لتمنح المؤسسات خيارات تتناسب مع احتياجاتها، بدءًا من “الترتيب البسيط” إلى “النقاط” و“مقارنة العوامل” ، وعلى الرغم من اختلاف الطرق، إلا أنها تجتمع في هدف واحد: إعطاء كل وظيفة قيمتها الحقيقية. وفي النهاية، تقييم الوظائف ليس نظامًا إداريًا فقط… بل رسالة تقول للموظف: “نحن نراك، نعرف حجم عملك، ونقدّر جهدك بما يستحق.” وحين تسود العدالة… يسود الانتماء.
45
| 08 يناير 2026
في بيئة العمل، لا شيء يُبنى بالكلمة بقدر ما يُهدم بها. فالكلمات التي تُقال يوميًا - ولو دون قصد - قادرة على تشكيل وعي الموظف بنفسه، وثقته بقدراته، ونظرته لقيمته داخل المؤسسة. فهناك كلمات تشعل الحماس، وأخرى تطفئه إلى الأبد. كثير من المديرين أو الزملاء يظنون أن النقد المتكرر يحفّز الموظف، لكنه في الحقيقة يُضعف شخصيته ببطء، فحين يسمع الموظف باستمرار أنه «مقصّر»، أو «غير كافٍ»، يبدأ داخله في تصديق ذلك، حتى يفقد دافعه للمحاولة، النقد البناء مطلوب، لكنه يجب أن يُوجَّه لـ «الفعل» لا للشخص، وللموقف لا للقيمة الإنسانية، فالتقويم شيء، والتحطيم شيء آخر. الكلمة التي تُقال في لحظة انفعال قد تزرع داخل الموظف شكًّا طويل الأمد في نفسه، والأخطر أن بيئة النقد المستمر تخلق موظفين صامتين لا مبدعين، لأن الخوف من الخطأ يغلب الرغبة في المحاولة، بينما المؤسسات الناجحة تُفرّق بين النقد الذي يُصلح، والكلمات التي تجرح. أما الموظف نفسه، فعليه أن يتعلم فن تقييم الذات دون جلدها، أن يسأل نفسه: هل ما أفعله يعبّر عن أفضل نسخة مني؟ هل أتعلم من أخطائي؟ فالتقييم الذاتي هو ميزان التطور الحقيقي، لكنه لا يكون باللوم، بل بالوعي والتحسين المستمر. وأخيرا…. من الخطأ أن يربط الإنسان قيمته بآراء الآخرين أو بمقارنات سطحية؛ فالقيمة الحقيقية لا تُقاس بالثناء أو الانتقاد، بل بالجهد، والأخلاق، والنية، والاستمرارية. الكلمات تصنع بيئة العمل بقدر ما تصنعها الخطط، فاختر كلماتك كما تختار قراراتك، لأنها تُشكّل ثقافة كاملة، قلل النقد، وزد الدعم، وتعلّم أن تُقيّم لتبني لا لتُحبط. ففي النهاية، الموظف الذي يسمع كلمة ثقة… يعطي ضعف ما كان يُطلب منه.
510
| 01 يناير 2026
الصداقة في بيئة العمل تبدو في ظاهرها أمرًا جميلًا؛ أن تجد من يشاركك همومك اليومية ويخفف عنك ضغوط المهام، لكنها في عمقها سلاح ذو حدّين، فقد تكون مصدر دعم حقيقي يرفع الإنتاجية ويزيد من الارتباط بالعمل، وقد تتحول إلى عبء يضعف الموضوعية ويشوّش القرارات إن لم تُدار بحكمة. الصداقة في مكان العمل لا تُمنع، ولكن يجب أن تُضبط، ومن الإيجابيات أن العلاقات الطيبة تخلق بيئة مريحة وتشجع على التعاون والثقة، خصوصًا حين تُبنى على الاحترام والصدق والمهنية، والموظف الذي يشعر بالأمان مع زملائه يكون أكثر استعدادًا للمشاركة والتفاعل والإبداع، فالصديق في العمل قد يكون السند في الأوقات الصعبة، وشريك النجاح في الأوقات المزدهرة. لكن الوجه الآخر لا يقلّ أهمية، فحين تتجاوز الصداقة حدودها الطبيعية، وتتحول إلى محاباة أو مجاملة، تبدأ الخطورة، القرارات تفقد حيادها، والتقييمات تفقد دقتها، وقد يجد بعض الزملاء أنفسهم خارج دائرة العدالة، والأسوأ من ذلك أن انكسار الصداقة قد يتحول إلى صراع مهني يُفسد بيئة العمل بأكملها، الذكاء في التعامل مع هذا النوع من العلاقات أن نحافظ على التوازن. كن ودودًا لا متودّدًا، قريبًا دون أن تفقد الحياد. حافظ على أسرارك المهنية، ولا تخلط بين الصداقة والواجبات فالعمل يقوم على العدالة والاحترام، بينما الصداقة تقوم على العاطفة والمشاركة، وإذا طغى أحد الجانبين على الآخر اختلّ الميزان، وأخيرًا الصداقة في العمل ليست خطأ، لكنها تحتاج إلى وعي. فاحترم موقعك، وافصل بين القلب والعقل، وكن قادرًا على وضع الحدود دون قسوة. الصديق الحقيقي في بيئة العمل هو من يحترمك في حضورك وغيابك، ويذكّرك بالاحتراف حين تغلبك العاطفة. فحين توازن بين القلب والمهنة… تكسب الصداقة ولا تخسر العمل.
234
| 12 ديسمبر 2025
الهيبة ليست مظهرًا خارجيًا ولا نغمة صوت مرتفعة، بل حالة من الاتزان والوعي تنبع من الداخل. إنها حضور هادئ يجبر الآخرين على احترامك دون أن تطلبه، وثقة تنعكس في نظراتك، وكلماتك، وحتى صمتك. والهيبة لا تأتي صدفة، بل تُبنى من عادات صغيرة تُمارس كل يوم حتى تصبح أسلوب حياة. أولى هذه العادات هي الانضباط؛ أن تفي بوعودك، وتحترم وقتك ووقت الآخرين. الشخص المنضبط يفرض احترامه دون أن يتحدث، لأن دقته تعكس احترامه لنفسه أولًا. ومن الهيبة أيضًا أن تتحدث بوعي، فالكلمة التي تخرج منك تمثلك، فلا تُكثر الحديث، ولا ترفع صوتك لتثبت حضورك. فالهدوء قوة، والصمت أحيانًا أبلغ من الخطابة. ومن العادات التي تصنع الهيبة: الاهتمام بالمظهر دون مبالغة، فالنظافة والترتيب البسيط يمنحانك حضورًا لائقًا، لأن التفاصيل الصغيرة تصنع الانطباع الأول. كذلك، العناية بالجسد والعقل جزء من الهيبة؛ فالطاقة المتوازنة، والنوم الكافي، والتفكير الواضح كلها تبعث رسالة غير منطوقة بأنك متزن وقادر على القيادة. احترام الذات أيضًا عادة يومية. لا تُقلل من نفسك، ولا تسمح لأحد أن يتجاوز حدودك. من يعرف قيمته لا يحتاج إلى أن يرفع صوته أو يثبت مكانته، لأن هيبته تتحدث عنه. كما أن الاستماع الجيد من علامات النضج، فالقائد الحقيقي يُنصت أكثر مما يتكلم، ويختار متى يتحدث ومتى يصمت. وأخيرًا، تذكّر أن الهيبة لا تُشترى ولا تُفرض، بل تُكتسب من نقاء القلب، وصدق النية، وثبات المبدأ. إنها نتاج تربية داخلية، واحترام ذاتي، واتزان نفسي يجعل حضورك مهيبًا حتى في أبسط المواقف. هيبتك ليست في حجم صوتك. بل في عمق عقلك، واتزانك، وثقتك التي لا تهتز.
306
| 05 ديسمبر 2025
لا يمكن لأي مؤسسة أن تبني مستقبلها على ما تعرفه اليوم فقط. في عالم تتسارع فيه التغيّرات، يصبح الاستثمار في التدريب والتطوير أكثر من مجرد ميزة تنافسية، بل ضرورة استراتيجية تضمن استمرارية النمو وتحقيق الأهداف. لكن التحدي الأكبر لا يكمن في تنفيذ البرامج التدريبية، بل في فهم الاحتياج الحقيقي لها وربطها بتحقيق التحفيز والتطوير المتوازن لكافة الفئات، من الموظف الجديد وحتى أصحاب القرار. إن الخطأ الشائع في بعض البيئات المؤسسية هو حصر التدريب في فئة دون أخرى؛ وكأن التعلم حكر على الجدد فقط، أو على من يعاني من قصور في الأداء. بينما الحقيقة أن العلم لا يعرف سقفًا، والتطوير لا يتوقف عند درجة وظيفية معينة. فكل موظف، مهما بلغ من الخبرة أو المنصب، يحتاج إلى أن يغذي عقله، ويُحدث أدواته، ويخرج من منطقة الراحة، ليبقى متجددًا وقادرًا على الإبداع والمساهمة الفاعلة. العقل البشري بطبيعته بحاجة إلى تنمية مستمرة، تمامًا كما تحتاج العضلات إلى تمرين كي تبقى مرنة وقوية. من جهة أخرى، يجب ألا يُنظر للتدريب كحدث عابر أو إجراء شكلي، بل كمسار متكامل يبدأ من تشخيص الاحتياج الحقيقي للفرد والفريق، ويُبنى على أسس واضحة تعكس التحديات الفعلية التي تواجهها المؤسسة. فحين يشعر الموظف أن البرنامج التدريبي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاته، ويرتبط مباشرة بتحقيق أهدافه المهنية، يتحول التدريب من مجرد جلسة إلى تجربة محفزة تنعكس آثارها على سلوكه وأدائه. أما القادة والمديرون فهم أحوج من غيرهم إلى التدريب؛ لأنهم يقودون التغيير، ويصنعون ثقافة التعلم، ويؤثرون على الآخرين من خلال سلوكهم. القائد الذي يتعلم باستمرار، يرسل رسالة ضمنية لفريقه مفادها أن الاحتراف الحقيقي هو في استمرار التعلم، وليس الاكتفاء بشهادة أو منصب. وختامًا، إن بناء ثقافة تدريبية متجذرة في المؤسسة، تقوم على الاحتياج الواقعي والتحفيز الداخلي، وتؤمن أن التدريب حق للجميع وليس امتيازًا لفئة، هو استثمار طويل الأجل ينعكس على الإنتاجية، والروح المعنوية، والولاء المؤسسي. فكما تحتاج الأجسام إلى غذاء، تحتاج العقول إلى تطوير، وتحتاج المؤسسات إلى عقول متجددة لا تشيخ مهما طال بها الزمن.
207
| 27 نوفمبر 2025
النجاح لا يصنعه العمل فقط، بل الإنسان الذي يقف خلف العمل. فقبل أن نطالب أنفسنا بالإنتاج والإبداع، علينا أن نسأل: هل نحن بخير؟ هل جسدنا، ونفسنا، وعقلنا في توازن يسمح لنا بالعطاء؟ الإهمال في الصحة النفسية والجسدية والعقلية هو أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان، لأنه لا يسلبه طاقته فحسب، بل يسلبه القدرة على أن يعيش ويعمل بشغف. الجسد المرهق لا يستطيع أن يبدع، والعقل المزدحم لا يفكر بوضوح، والنفس المثقلة لا تملك الحماس. من يرهق نفسه بالضغوط ولا يمنحها راحة، سيضعف تركيزه ويخطئ في قراراته. ومن يهمل جسده سيفقد قوته في العمل وفي البيت، لأن التوازن لا يتحقق إلا عندما تكون الصحة أولوية لا خيارًا. فكل ضعف داخلي ينعكس خارجًا: على طريقة التفكير، على الأداء، وعلى العلاقات. والموظف الذي لا يعتني بنفسه لن يستطيع أن يعتني بعمله، لأن الإنجاز يبدأ من الداخل لا من المكتب. الصحة النفسية والعقلية ليست رفاهية، بل هي أساس الإتقان. حين تكون متصالحًا مع نفسك، ومرتاحًا في جسدك، ومنسجمًا مع فكرك، تصبح أكثر قدرة على التركيز، وأكثر إنتاجًا وابتكارًا. لذلك فإن الاعتناء بالنوم، بالغذاء، بالهدوء، وبالراحة الذهنية ليس ترفًا… بل استثمار في جودة العمل والحياة معًا. وأخيراً…… كل مؤسسة قوية تبدأ بأفراد متوازنين من الداخل، وكل نجاح حقيقي يُبنى على عقلٍ واعٍ ونفسٍ مطمئنة وجسدٍ سليم. فمن أراد أن يُتقن عمله، فليبدأ أولًا بإتقان العناية بنفسه. فالصحة ليست مجرد حياة بلا مرض، بل طاقة، ووضوح، وقدرة على العطاء… هي الجذر الذي تُثمر منه كل إنجازاتنا.
147
| 20 نوفمبر 2025
في عالم مليء بالتحديات والتقلبات، يظهر القادة الحقيقيون من بين الصفوف لا حين تسير الأمور بسلاسة، بل حين تضطرب الأمواج وتتعثر الخطى. القادة الذين يتركون بصمة لا تُمحى ليسوا أولئك الذين لم يسقطوا يومًا، بل أولئك الذين عرفوا كيف ينهضون من سقوطهم أقوى، وأعمق، وأكثر فهمًا للحياة والناس. هؤلاء القادة لا يرون في الفشل نهاية، بل بداية جديدة مليئة بالدروس. ينظرون لكل عثرة باعتبارها فرصة لفهم نقاط الضعف، ومراجعة الخطط، وتصحيح المسار. فهم لا يخجلون من الخطأ، بل يتعاملون معه كأداة تدريب مجانية، تقوّي عزيمتهم، وتفتح عقولهم على زوايا لم يرَها الآخرون. ومن أسرارهم كذلك، أنهم لا يُغرقون فرقهم في الإحباط عند أول خطأ، بل يصنعون بيئة عمل تحفّز على المحاولة والتجريب. فهم يعلمون أن العقول المقيدة بالخوف لا تُنتج، وأن بيئة تتقبل الفشل المؤقت هي وحدها القادرة على إنجاب ابتكار دائم. ولذلك، يشجّعون فرقهم على خوض المخاطر المحسوبة، ويكافئون التعلم لا النتائج فقط. كما أن من أبرز أسرار قادة التميز، امتلاكهم لما يُعرف بـ “المرونة القيادية”، أي قدرتهم على إعادة التكيف، وتغيير الرؤية عندما تستدعي الظروف، دون أن يشعروا بأنهم خسروا السيطرة. فالقائد المتميز لا يُصر على طريقة واحدة، بل يبحث دومًا عن الأفضل، ويتقبّل التغيير كجزء طبيعي من النمو، لا كتهديد. وأخيرًا، فإن القائد الملهم لا يصنع النجاح لنفسه فقط، بل يصنعه لفريقه معه. لا يقف على قمة الإنجاز وحده، بل يمسك بأيدي الآخرين ليصعدوا معه. يشاركهم المعرفة، ويحفزهم على القيادة، ويؤمن أن النجاح الحقيقي هو أن تترك خلفك من يستطيع إكمال المسيرة دونك، وبالطريقة التي غرستها فيهم. في زمن التغيير السريع والضغوط المستمرة، قد نحتاج أن نتعلّم من هؤلاء القادة كيف نُحوّل لحظات الشك إلى دفعة، وكيف نرى في كل فشل نافذة، وفي كل نقد مرآة، وفي كل تحدٍّ فرصة ذهبية لاكتشاف ما لم يكن ظاهرًا فينا. فهكذا يصنع التميز… وهكذا يبقى القائد قائدًا، حتى في أحلك الظروف.
345
| 14 نوفمبر 2025
كثيرون يظنون أن نجاحهم ثمرة اجتهادهم وحدهم، وأن كل ما وصلوا إليه جاء نتيجة تعبهم وساعات عملهم الطويلة. لكن الحقيقة الأعمق تقول إن الاجتهاد وحده لا يكفي. فهناك خيط خفي من البركة، إن وُجد زاد الجهد قيمة، وإن غاب ضاع التعب في زحام الأيام. البركة لا تهبط صدفة، بل تبدأ من الداخل… من البيت، من القلب، من النية، من العلاقة الصافية مع من حولنا. بركة العمل لا تأتي من المكتب ولا من الاجتماعات، بل من دعوة أمّ راضية، وابتسامة أبّ فخور، ودعاء زوج او زوجة، ورضا أبناء يشعرون بحبّك واهتمامك رغم انشغالك. فحين يكون الداخل مستقيمًا، يفيض الخارج نورًا وتوفيقًا. والبركة ليست في الإنجاز فقط، بل في التقرب إلى الله، والصدق في النية، والإخلاص في العمل. هي في الوقت الذي يكفي، وفي الجهد الذي يُثمر، وفي العمل الذي يُراد به وجه الله. فالله لا يبارك في عملٍ لم يُرد به وجهه، مهما عَظُم في أعين الناس. أما العمل الذي يبدأ بنية طيبة، فهو وإن بدا صغيرًا، يُثمر بركة تتجاوز التوقعات. قد تبذل الكثير من الجهد، وتجد أن النتائج لا توازي ما قدّمت، لأنك فقدت البركة في الطريق. وقد تعمل بهدوء وصدق وتجد أن الله يسخّر لك الأسباب ويقرّب إليك الفرص، لأنك بدأت من المكان الصحيح — من الداخل. فكل توفيق حقيقي يبدأ من نية طيبة، ومن قلبٍ لا يحمل إلا الامتنان لمن حوله. العمل المتقن ليس في المهارة وحدها، بل في النية التي تُحرّكه. والنجاح ليس في المال ولا المناصب، بل في البركة التي تمنح لأعمالنا معنى ودوامًا. فبركة اليوم تبدأ من رضا الوالدين، وبركة الطريق تبدأ من حسن النية، وبركة العمل تبدأ من الصدق مع النفس قبل السعي وراء النتائج. وأخيرًا، فلنتذكر دائمًا أن كل جهد بلا بركة هو جهد ناقص، وكل تعب بلا رضا هو طريق طويل بلا ثمرة. فلنبدأ من الداخل؛ من إصلاح علاقتنا بأهلنا، وبأنفسنا، وبربّنا. فحين تكون القلوب مطمئنة والبيوت راضية، تتفتح أبواب الرزق والتوفيق بلا استئذان. البركة لا تُرى… لكنها تُشعرك أن القليل يكفي، وأن الجهد يؤتي ثماره، وأن الحياة تبتسم لك من حيث لا تحتسب.
573
| 07 نوفمبر 2025
في كثير من المؤسسات، تتحول برامج التدريب من وسيلة تطوير حقيقية إلى مجرد إجراء روتيني يُنفّذ لتعبئة التقارير واستكمال عدد الدورات التدريبية المطلوبة سنويًا. نرى موظفين يُرسلون إلى دورات لا تمت بصلة لمهامهم اليومية، ولا تضيف شيئًا إلى أدائهم أو مسارهم المهني. والنتيجة؟ هدر في الوقت والميزانية والجهد، دون أثر ملموس على الإنتاجية أو جودة العمل. التدريب الحقيقي لا يُقاس بعدد الشهادات، بل بمدى تغيّر السلوك وتحسّن الأداء، وهنا تكمن المسؤولية الكبرى في يد المدير المباشر، فهو الأقرب لموظفيه والأقدر على تحديد ما يحتاجه كل فرد من تطوير، فبدل أن يُنزل الموظف عشوائيًا في أي برنامج متاح، يجب أن تُبنى خطة التدريب على تحليل دقيق للاحتياجات، يشارك فيها المدير بالتعاون مع إدارة التدريب والتطوير. بهذا الشكل يصبح التدريب موجّهًا ومؤثرًا، لا شكليًا أو متكررًا. من المؤسف أن بعض المؤسسات تُرسل موظفيها في الدورات فقط لإكمال العدد المطلوب في النظام، دون النظر إلى القيمة المضافة أو الارتباط بالمسار المهني، وكأن الهدف أصبح “الكمّ” لا “النوع”. بينما المؤسسات الناضجة تُدرج النقاط التدريبية ضمن خطة التقييم السنوي للموظف منذ بداية العام، بحيث تكون مرتبطة بأهداف الأداء، وتُراجع بشكل دوري لمعرفة مدى تحققها. ويجب ألا يُغلق العام إلا بعد إتمام هذه الخطة بفاعلية ونتائج ملموسة، لا بمجرد حضور شكلي أو تقرير مكتوب. المنظمات التي تؤمن بالتطوير الحقيقي تعرف أن التدريب ليس جائزة تُمنح، ولا عقوبة تُفرض، بل حق ومسؤولية مشتركة بين الموظف وإدارته. فحين يتم تحديد نقاط الضعف بدقة، وتصميم برامج تدريبية لمعالجتها، يصبح التدريب استثمارًا في الإنسان لا في الورق. بل أكثر من ذلك، يصبح التدريب أحد أعمدة التحفيز الداخلي، لأنه يُشعر الموظف أن المؤسسة ترى فيه قيمة قابلة للنمو، لا مجرد رقم في الميزانية. وأخيرًا، إذا أردنا أن نصنع بيئة عمل تتطور بوعي، فعلينا أن نعيد تعريف التدريب داخل مؤسساتنا. هو ليس دورة في جدول… بل خطوة في رحلة التميز. هو ليس حضورًا إلزاميًا… بل مشاركة في بناء المستقبل. وحين ندرك هذه الحقيقة، لن نحتاج إلى عدد كورسات لإثبات أننا نتطور، بل سنرى التطوير واقعًا حيًا في عقول الناس وأدائهم كل يوم.
342
| 30 أكتوبر 2025
في كل صباح، هناك من يأتي إلى عمله ليؤدي ما اعتاد عليه، وهناك من يأتي ليصنع فرقًا. الفارق بين الاثنين ليس في المكان ولا في المهام، بل في الهدف. فالحياة العملية لا تُقاس بعدد السنوات التي نقضيها خلف المكاتب، بل بما نُنجزه خلالها، وبما نضيفه لأنفسنا ولمنظمتنا كل يوم. النجاح لا يحدث صدفة، بل نتيجة أهداف واضحة تُرسم بخطوات صغيرة ومتتابعة. الهدف اليومي هو الوقود الأول الذي يدفعك لتتحرك، والهدف الأسبوعي هو اختبار لاستمرارك، أما الهدف الشهري فهو انعكاس حقيقي لقدرتك على الالتزام. حين تُخطط ليومك بدقة، لن يضيع أسبوعك. وحين تلتزم بأهدافك الأسبوعية، ستجد أن شهرك أصبح إنجازًا متكاملاً. وهكذا تتحول التفاصيل الصغيرة إلى نجاحات عظيمة. فهذه الأهداف الصغيرة التي تضعها وتحققها بانتظام، هي التي تبني في النهاية أهدافك الكبرى وتقرّبك من رؤيتك البعيدة خطوة بخطوة. لكن المشكلة أن بعض الموظفين يقضون سنوات طويلة دون أن يسألوا أنفسهم: ما الذي أريد تحقيقه هذا الأسبوع؟ هذا الشهر؟ هذا العام؟ يعيشون كل يوم كما لو أنه نسخة مكرّرة من اليوم الذي سبقه، دون أي تغيير أو نمو. منطقة الراحة هي أخطر مكان يمكن أن يطيل بقاءك دون أن يطورك. هي الدائرة التي تُخدرك بالاستقرار، لكنها تسلب منك النمو والطموح والإبداع. الموظف الذي يكتفي بما يعرفه اليوم، سيجد نفسه غدًا خلف من كانوا بالأمس يتعلمون منه. القوة الحقيقية لا تأتي من كثرة العمل، بل من وضوح الاتجاه. كل يوم يمر دون هدف هو فرصة ضائعة للتطور. ضع لنفسك هدفًا حتى لو كان بسيطًا: أن تتعلم مهارة جديدة، أو تحسّن طريقة عملك، أو تقدم فكرة واحدة تفيد فريقك. لا تنتظر من مديرك أن يدفعك دائمًا، فالموظف المتميز هو من يُحفز نفسه بنفسه، ويصنع طاقته من إيمانه بأن الركود موت بطيء والطموح حياة مستمرة. تذكّر دائمًا: العقول التي لا تُغذّى بالتحديات تذبل، والمواهب التي لا تُستخدم تصدأ، والأحلام التي لا تتحرك تموت. ابدأ من اليوم بخطة صغيرة… اكتب أهدافك اليومية، راجعها كل أسبوع، قِس تقدّمك كل شهر، واحتفل بإنجازاتك مهما كانت بسيطة، لأن من يتقن بناء الأهداف الصغيرة، سيجد نفسه يومًا قد حقق أهدافًا كبرى لم يكن يظنها ممكنة. وأخيرًا، لا تنتظر أن تتغير الظروف… بل كن أنت التغيير. فالموظف الذي يطور نفسه اليوم، هو القائد الذي سيقود غدًا. أما من اختار البقاء في منطقة الراحة، فسيستيقظ يومًا ليجد أن الفرص قد مضت، وأنه ما زال في المكان نفسه… بلا هدف، وبلا أثر.
588
| 23 أكتوبر 2025
في أروقة التوظيف ومجالس اتخاذ القرار، يتكرر سؤال محوري: هل تكفي الشهادة الأكاديمية لتحديد من يستحق المنصب؟ أم أن الشهادة يجب أن تقترن بكفاءة حقيقية تُثبتها الممارسة والخبرة؟ في زمنٍ تتسارع فيه التغيّرات وتزداد فيه متطلبات النجاح، لم يعد الامتياز الأكاديمي وحده ضمانة للجودة، بل أصبح الجمع بين المؤهل والكفاءة هو المعيار الحقيقي للاستحقاق. الشهادة تفتح الباب، لكنها لا تكفي للبقاء داخله، فالسوق اليوم يبحث عن من “يُنجز” لا من “يحمل اللقب”. كم من موظف تولّى منصبًا إداريًا أو قياديًا لمجرد حصوله على مؤهلٍ أكاديمي دون أن يمتلك خبرة فعلية في الميدان، ليكتشف لاحقًا أن المقعد أكبر من قدراته. وما يزيد الأمر تعقيدًا، أن بعض المؤسسات تُعين حديثي التخرج مباشرة في مناصب عالية، وتكرر موقف تولي المناصب بعد فترة تدريب قصيرة تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم تثبيتهم وتمنحهم مناصب قيادية بحجة الشهادة، رغم افتقارهم للخبرة العملية في التعامل مع المواقف اليومية وإدارة الأفراد. هذه الممارسات تُفرغ فكرة الكفاءة من معناها، وتُفقد الفريق توازنه، لأن القيادة ليست منصبًا إداريًا بل مسؤولية تحتاج إلى نضج وتجربة. الكفاءة الحقيقية لا تُقاس بعدد الأوراق أو الألقاب، بل بقدرة الشخص على اتخاذ القرار، وقيادة الفريق، وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة. والمؤسسات التي تفصل بين الشهادة والكفاءة تُجازف بسمعتها وأدائها، لأن من يفتقر إلى الخبرة العملية لن يستطيع إدارة من يملكها. فالمعادلة الصحيحة ليست “شهادة مقابل كفاءة”، بل “شهادة تدعم كفاءة”. الكرسي لا يُمنح لمن يحفظ المصطلحات، بل لمن يملك البصيرة، ويُتقن القيادة، ويُترجم علمه إلى إنجاز. ولهذا يجب أن تتحول فلسفة التوظيف من الاكتفاء بالسؤال: «ما مؤهلك؟» إلى السؤال الأعمق: «ماذا أنجزت؟» ومن النظر إلى الشهادة كغاية إلى اعتبارها وسيلة تمكّن الكفاءة من الظهور. فحين يُمنح المنصب لمن يجمع بين العلم والخبرة، يصبح الكرسي وسيلة للتطوير، لا مكافأة مؤقتة. ختاما المؤسسات التي تريد البقاء لا تكتفي بالمؤهل الأكاديمي، بل تبحث عمّن يستطيع تحويل المعرفة إلى قيمة. الشهادة مهمة، لكنها تفقد معناها إن لم تسندها كفاءة تليق بالمسؤولية. والكرسي، في نهاية الأمر، لا يُثبت بالورق، بل بالفعل. فالأجدر به ليس من نال شهادة أعلى، بل من يترك أثرًا أعمق.
504
| 16 أكتوبر 2025
حين نسمع كلمة «سمعة الشركة»، يتبادر إلى الأذهان فورًا أقسام العلاقات العامة، المؤتمرات الصحفية، الحملات الإعلانية، وصفحات التواصل التي تعرض أخبارًا وإنجازات لامعة. صحيح أن هذه كلها أدوات مهمة لصناعة الصورة العامة، لكنها وحدها لا تكفي؛ فالأصل في السمعة يبدأ من الداخل، من أروقة الشركة نفسها، في مكاتبها وبين موظفيها، هناك حيث تُبنى القصص الحقيقية وتنطلق الانطباعات التي لا تستطيع أي حملة إعلانية تزييفها مهما بدت جذابة. كل موظف في مؤسستك هو مرآة صغيرة تعكس صورتها، وكل تفاعل يومي معه — سواء أكان تقديرًا أم تجاهلًا، دعمًا أم ضغطًا مبالغًا فيه — يسهم في تشكيل قصته الداخلية عن الشركة. وهذه القصة لا تبقى حبيسة الجدران، بل تنتقل إلى أصدقائه وعائلته وتظهر على ملامحه حين يُسأل: «كيف العمل معكم؟» موظف يبتسم ويتحدث بفخر عن بيئته ينشر صورة إيجابية أقوى من أي إعلان، بينما موظف متذمر يشعر بالضغط أو الظلم أو غياب التقدير، يهدم بحديثه البسيط كثيرًا مما يُصرف على بناء صورة المؤسسة. الجميل أن بناء هذه السمعة يبدأ من تفاصيل صغيرة لكنها عميقة الأثر؛ مثل قائد يقدّر جهود موظفيه علنًا، أو إدارة تستثمر بصدق في تطوير كوادرها، أو سياسة مرنة تسمح للأمهات بمواءمة ساعات عملهن مع التزامات أسرهن. هنا يشعر الموظف أن المؤسسة تراه إنسانًا لا مجرد أداة أداء، فيخرج للناس صادقًا حين يتحدث عن مكان عمله، لا مجبرًا على تلميع صورة لا تعبر عن الحقيقة. وأخيرًا، تذكّر أن سمعة شركتك ليست مجرد شعار يعلّق على الجدران ولا قصة تُسجّل في تقارير الإعلام، بل هي حقيقة يعيشها موظفوك كل يوم ويحكونها بطريقتهم حين يخرجون من مكاتبهم. إذا أردت أن يراك السوق مؤسسة موثوقة ومحترمة، ابدأ بأن تكون كذلك فعلًا في عيون فريقك. هؤلاء الناس ينقلون قصتك الحقيقية إلى بيوتهم وأصدقائهم وحتى إلى منافسيك دون أن تشعر. قد تكون حكايتهم عنك مليئة بالفخر والرضا، أو مليئة بالاستياء والخذلان — والفرق هنا يصنع كل شيء. ابحث عن إرثك في قلوب موظفيك أولًا، وستجد أن صورتك الخارجية ستتبع ذلك من تلقاء نفسها.
1047
| 10 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية

غدًا، لن نخوض مجرد مباراة في دور الـ16...
1653
| 04 يناير 2026

امشِ في الرواق الفاخر لأي مجمع تجاري حديث...
924
| 07 يناير 2026

في عالم يتغيّر بإيقاع غير مسبوق، ما زال...
900
| 07 يناير 2026

في نسخة استثنائية من كأس الأمم الإفريقية، أثبتت...
819
| 08 يناير 2026

لا شكّ أن الجهود المبذولة لإبراز الوجه الحضاري...
768
| 04 يناير 2026

يشتعل العالم، يُسفك الدم، يطحن الفقر الملايين، والحروب...
717
| 05 يناير 2026

عندما نزلت جيوش الروم في اليرموك وأرسل الصحابة...
567
| 04 يناير 2026

في بيئة العمل، لا شيء يُبنى بالكلمة بقدر...
510
| 01 يناير 2026

الطفل العنيد سلوكه ليس الاستثناء، بل هو الروتين...
495
| 02 يناير 2026

مع مطلع عام 2026، لا نحتاج إلى وعود...
492
| 06 يناير 2026

كما هو حال العالم العربي، شهدت تركيا هي...
471
| 05 يناير 2026

بعودة مجلة الدوحة، التي تصدرها وزارة الثقافة، إلى...
444
| 06 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل