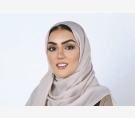رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
615
مها الغيثالعربي اليهودي: سيرة هوية لا تقبل القسمة 2-2
..... نواصل الحديث حول كتاب « Three Worlds: Memoir of an Arab-Jew» لمؤلفه/ Avi Shlaim يتطرق المؤرخ إلى نظرة الازدراء التي وُجهت له كـ (مزراحيم) أو -عبرياً- كيهودي شرقي ينحدر من أصول عراقية، لا سيما في المدرسة بين أقرانه ومع معلمة يهودية من أصل ألماني ناصبته العداء، ما ولّد لديه شيئا من عقدة النقص، وجعل منه طالباً خجولًا يفتقر للثقة وللتحصيل الدراسي المطلوب، إضافة إلى عوائق اللغة العبرية والإنجليزية اللتين لم يتقنهما سريعاً في البداية، الأمر الذي دفع والدته -وهي تحمل الجنسية البريطانية- إلى استخدام المحسوبية -كما كانت تفعل بذكاء في العراق- وبما توفّر لدى العائلة من مال، إرساله إلى بريطانيا للدراسة حيث يعيش أخوها، وكان حينها قد بلغ سن الخامسة عشرة! وبعد أن يُسهب المؤرخ في الحديث عن شؤون دراسته وسكنه وتنقلاته ونفقاته وظروف حياته اليومية التي لم تكن بالهينة، يسترجع من ذاكرته عودته للالتحاق بالجيش «الإسرائيلي» واستيفاء الخدمة الإلزامية لمدة عامين، وقد بلغ الثامنة عشرة من عمره، وذلك قبل بدء دراسته الجامعية في كامبريدج، وهو الجيش الذي وجده كـ (بوتقة انصهار) استوعب جميع اليهود القادمين من أرجاء العالم، وذلك على النقيض مما خبره في المجتمع «الإسرائيلي» عندما كان صغيراً.
وعلى الرغم من أن تجربة الخدمة العسكرية تلك قد ولّدت لديه شعورا وطنيا عارما تجاه «إسرائيل»، فقد شكلت حرب الأيام الستة -التي أراد المشاركة فيها طواعية- وضاعفت ثلاثاً من مساحة الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها، متمثلة في الجولان وسيناء والضفة الغربية، نقطة تحوّل تاريخية عززت لديه رؤية «إسرائيل» كقوة استعمارية ضد العرب، فضلاً عن مزاعم أحقيتها التاريخية في أرض فلسطين!
والمؤرخ وقد تم تصنيفه ضمن (المؤرخين الجدد) الذين برزوا في أواخر الثمانينيات، وتبنوا رؤية مغايرة للتاريخ اليهودي والحركة الصهيونية وأعادوا قراءة سرديتهما، وأثاروا من حولهم العداء، يفنّد الادعاءات التي تصف اليهود كقوة مستضعفة في ميزان القوى أمام الجحافل العربية زمن النكبة، وادعاءات هجرة الفلسطينيين الطوعية لأرضهم امتثالاً لأوامر قادتهم، ويدحض مزاعم (التعنت العربي) في مجريات مفاوضات السلام في حين يثبت تعنت الجانب «الإسرائيلي»، ويكشف عن التواطؤ البريطاني-الصهيوني في تقسيم فلسطين والذي امتدت اجتماعاته قبيل انتهاء الانتداب البريطاني، وعن عدم جدية العرب في خوض الحرب فضلاً عن مصالحها المتضاربة وأطماعها التوسعية الخاصة وشعارات القومية الرائجة آنذاك.
لذا، يستقي المؤرخ من هذه الخبرات المعقدة عبر التاريخ البعيد-القريب، رؤيته الخاصة حول نشأة الصراع العربي- «الإسرائيلي» وتطوراته حتى اللحظة، لا سيما وقد اتخذ مع نكسة عام 1967 موقفاً مناهضاً لـ «إسرائيل» الذي تحوّل جيشها في نظره من قوة نظامية للدفاع عن النفس ضد خطر الجيوش العربية المحيطة والمهددة برميها في البحر، إلى سلطة احتلال قمعية تمارس التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين، وتحمي أمنها الخاص وحسب، فضلاً عن خططها الاستعمارية منذ البداية، وقد تحوّل إلى ناقد جريء لسياساتها التي صيّرت حال الفلسطينيين المضطهدين واللاجئين والمهجرين منذ النكبة، كالمصير الذي آل إليه اليهود بعد محرقة الهولوكوست، مؤكداً على أن التمييز بين البشر ونزع الصفات الإنسانية حسب الدين أو اللون أو العرق أمر محظور تماماً، بل إن الجميع في رأيه يستحق الحياة في سلام وأمان وحرية! يقول في مذكراته: «من خلال تعمقي في تاريخ عائلتي في العراق، اكتسبت فهماً أعمق لطبيعة الصهيونية وتأثيرها العالمي. درست الحركة الصهيونية بعمق، ولكن بشكل رئيسي فيما يتعلق بتأثيرها على الفلسطينيين. كانت الصورة العامة حركة استعمار استيطاني سارعت بلا هوادة نحو هدفها المتمثل في بناء دولة يهودية في فلسطين، حتى لو انطوى ذلك على تهجير السكان الأصليين».
وهو إذ يتخذ من ذكرى الماضي معيناً لتصوّر مستقبل أفضل في ظل تشابك الهويات ومحاولة الحفاظ عليها، لا يعتقد المؤرخ بأن ما كان من تعايش العرب واليهود أمراً متخيلاً لاح له ولعائلته، بل كان واقعاً معاشاً في بلده وفي بقية البلاد العربية، وهو يؤمن بقدرة الشعوب في التصرف على نحو أكثر عقلانية لا سيما وقد استنفدت جميع البدائل المتاحة، مؤكداً على أن تجاوز المأزق الحالي لن يتم دون إحياء روح التسامح الديني وإعادة تصوّر الحوار المتحضر بين اليهود والعرب الذي ساد في العراق قبل قيام دولة «إسرائيل»!
وهو إذ يستشرف المستقبل محاولاً إيجاد آفاق لحلول عملية لإنهاء الصراع «الإسرائيلي»-الفلسطيني، يجد نفسه -رغم تشاؤمه نحو التقدم على المدى القصير- أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التوصل إلى حل سلمي على المدى البعيد. أما الحل الذي ينادي به، هو حل الدولة الواحدة! فعلى الرغم من أنها فكرة لم تجذب ابتداءً سوى قلة من المثقفين، إلا أنها اكتسبت تدريجياً تأييداً واسعاً لا سيما من الجانب الفلسطيني الذي تلاشت لديه آمال الاستقلال التام وتحوّلت مساعيه نحو إرساء حقوق متساوية في ظل الوضع القائم، حيث يُصبح تأسيس دولة ديمقراطية واحدة، تتمتع بحقوق متساوية لجميع مواطنيها بغض النظر عن العرق أو الدين، هو أكثر الحلول عدلاً وواقعية!
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
شذرات للصائمين

إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
حلت السكينة

علي بن راشد المحري المهندي
-
رمضان شهر التطهير الروحي

عبدالرحمن الشمري
-
خطب مكررة... وقضايا تنتظر المنبر

جاسم إبراهيم فخرو
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 هل سلبتنا مواقع التواصل الاجتماعي سلامنا النفسي؟
ربما كان الجيل الذي سبق غزو الرقمنة ومواقع التواصل الاجتماعي هو الأكثر إدراكًا لحجم التباين بين الزمنين فيما يتعلق بالسلام النفسي، بين زمن كان الإنسان يقترب من حقيقة نفسه بلا زينة مصطنعة، وزمن تصطاد هذه الشبكة روحه ووقته وسكينته وتبعده عن ذاته كما بين المشرقين. على الرغم من محاسنها التي لا يستطيع أحد إنكارها، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي عالمًا بديلًا للإنسان، فالحياة فيها، والرضا من خلالها، والتعاسة أيضًا، والإشباع الروحي يتحقق بعلامات الإعجاب ويُستجدى بتعليقات المتابعين. لقد أصبحت صفحات المرء وعدد متابعيه هي هويته المعبرة عنه، بطاقته التعريفية بصرف النظر عن تقييم المحتوى الذي يقدمه، فانقلب تعريف الإنسان من جوهره إلى ظاهره. مواقع التواصل آخر عهده بالليل، وأول عهده بالصباح، وبينهما نوم قد يعرض له انعكاساتها على نفسه التعسة، تتدفق فيه الأسئلة: كيف أبدو أمامهم، كيف أرضي أذواقهم، كيف أزيد من الإعجابات والتعليقات، كيف أبرز نفسي وألمعها، كيف أتخطى بأعداد المتابعين فلانًا وفلانًا، بل ويجعل تفاعل الجماهير هي الميزان الذي يزن بها نفسه، فإن قل اضطرب قلبه وتوهم النقص في قيمته وأنه خسر شيئًا من ذاته. أصبح هناك ولع غير مبرر بعرض التفاصيل اليومية من المطبخ، وبيئة العمل، والمواصلات، وأماكن التنزه والسفر، واللحظات الرومانسية بين الأزواج كأنهم يقومون بتمثيل عمل درامي، وقد يكون بينهما من الأزمات ما الله به عليم. غدت تلك الصفحات سوقًا للمتاجرة بالأحزان والأزمات، وأضحت ميدانًا للنقاشات والجدل العقيم الذي لا يراد من خلاله إلا إثبات الذات. مواقع التواصل الاجتماعي خلقت للإنسان بيئة صورية يصنع مفرداتها كما يحب، على حساب الانسحاب من بيئته في الواقع، فأصبح تواصله محصورًا مع عناصر هذه البيئة الجديدة، في الوقت الذي ينقطع عن أهل وذويه في البيت الواحد. وإن من المشاهد المضحكة المبكية، أن ترى أفراد الأسرة كل منهم يجلس على هاتفه دون أن يشعر بالآخر على مدى ساعات، بينما تجده غارقا في عالمه الافتراضي يتفاعل مع المتابعين بعلامات الإعجاب والتعليقات. ومن أشد مثالبها استلاب الرضا من القلوب، فعندما يعرض الناس أجمل لحظاتهم وألوان النعم التي يعيشون فيها وأحسن ما في حياتهم، يرى الناظر هذه الصورة البراقة، فيحسب أن الناس جميعا سعداء إلا هو، وأنهم بلغوا القمم بينما لا يزال هو قابعًا في السفح، فتولد لديه هذه المقارنة شعورًا بالمرارة ومنها ينبت الحسد أو اليأس، وكلاهما نار تأكل السلام النفسي أكلًا. مواقع التواصل عودت النفس على العجلة، فالإيقاع سريع، وكل شيء فيها يجري جريًا، الخبر، الصورة، والرأي، لا تدع للإنسان فرصة للتأمل الذي يستلزم حضوره السكون، فالسلام النفسي لا يولد في الضجيج والصخب والزحام، بل ينشأ في لحظات الصمت عندما يجلس المرء مع نفسه للمصارحة والمكاشفة. لقد جعلت هذه المواقع الإنسان في حال دائم من التمثيل والتصنع والتكلف، يختار كلماته وصوره وأطروحاته ليس على أساس الصدق والفائدة المرجوة، بل على أساس تحقيق القبول لدى الناس، فيطول عليه الأمد فينسى وجهه الأول، ويعيش بشخصيتين إحداهما على الشاشة والأخرى في الخفاء، وهذا الانشطار لا شك يصيبه بالاضطراب. الرضا لا ينال بالتصفيق ولا يشترى بعدد المتابعين، لكنه ثمرة معرفة الإنسان لنفسه وقبوله بعيوبها ومحاسنها، وسعيه إلى إصلاحها لا تجميل صورتها. وأنا ها هنا لا أرمي إلى إظهار مواقع التواصل كآلة آثمة، لأن العيب في اليد التي تسيء استخدامها، فهي كالسيف يكون أداة عدل أو أداة ظلم، بحسب من يحمله. وحتى يسترد المرء سلامه النفسي في زمن الشاشات، فعليه أولًا أن يدرك أن ما يراه ليس كل الحقيقة، وأن الحياة أوسع بكثير من هذه الصورة، وأعمق من سطر في منشور. عليه أن يفتش عن قيمته الحقيقية في إنجازه الحقيقي لا في حضوره الافتراضي. عليه أن يدرك أنها مجال لا حياة، حيّز للزيارة لا للإقامة، فمن ثم يضع لها حدًا معلومًا من وقته، فلا يتركها تأكل يومه، ويقتل لهفته تجاه التعرف على الإعجابات والتعليقات الجديدة كل دقيقة، فيجدر به أن يدرب نفسه على الفصام الجزئي مع هذه المواقع، ويصغي إلى نفسه حتى لا تذوب في أصوات الخارج.
6522
| 15 فبراير 2026
- 2 «تعهيد» التربية.. حين يُربينا «الغرباء» في عقر دارنا!
راقب المشهد في أي مجمع تجاري في عطلة نهاية الأسبوع. ستري عائلة خليجية صغيرة تتمشى. الأب والأم يمشيان في الأمام بكامل أناقتهما، وخلفهما بمسافة مترين تمشي «المربية» وهي تحمل الطفل، وتدفع العربة، وتحمل حقيبة الحفاضات. وإذا بكى الطفل، لمن يمد يده؟ إلى المربية. وإذا نطق كلماته الأولى، بأي لغة (أو لهجة مكسرة) يتحدث؟ بلغة المربية. هذا المشهد، رغم تكراره حتى أصبح مألوفاً، هو «جرح» غائر في كرامة الأسرة الخليجية. نحن، وبدافع الحاجة والرفاهية وانشغالنا في وظائفنا، لم نستقدم عمالة لتساعدنا في «أعمال المنزل» فحسب، بل ارتكبنا خطأً استراتيجياً فادحاً: لقد قمنا بـ «تعهيد» (Outsourcing) مهمة التربية. لقد سلمنا «مفاتيح» عقول وقلوب أطفالنا لأشخاص غرباء. المشكلة ليست في وجود المساعدة، فالدين والواقع يبيحان ذلك. المشكلة تكمن في «تداخل الأدوار»..... «الدريول» (السائق) لم يعد مجرد سائق يوصل الأبناء، بل أصبح هو «الأب البديل» في السيارة، يسمع أحاديثهم، ويختار موسيقاهم، وربما يغطّي على أخطائهم. و»المربية» لم تعد منظفة، بل أصبحت «الأم البديلة» التي تطعم، وتناغي، وتمسح الدمعة، وتلقن القيم (أو غيابها). نحن نشتكي اليوم من أن أبناءنا «تغيروا»، وأن لغتهم العربية ركيكة، وأن «السنع» عندهم ضعيف. ولكن، كيف نلومهم ومعلمهم الأول في سنوات التأسيس (من 0 إلى 7 سنوات) لا يملك أياً من هذه القيم؟ كيف نطلب من طفل أن يكون «ابن قبيلة» أو «ابن عائلة» وهو يتربى على يد ثقافة مختلفة تماماً في الدين واللغة والعادات؟ إن «السيادة» لا تكون فقط على الحدود الجغرافية للدولة، بل تبدأ من «السيادة على المنزل». هناك مناطق «محرمة» لا يجب أن يدخلها الغريب مهما كنا مشغولين. أن تروي قصة قبل النوم، هذا «مفتاح» لا يُسلم للمربية. أن توصل ابنتك المراهقة وتستمع لثرثرتها في السيارة، هذه «فرصة ذهبية» لا تتركها للسائق. وإذا كنا نتفق جميعاً على أن القيم هي أول الهرم التربوي، فلا خلاف على أن القرآن الكريم يتربع على قمة هذا الهرم بلا منازع. وهنا، يجب أن نتوقف للمصارحة: هل يكفي أن نوكل مهمة ربط أبنائنا بكتاب الله إلى «المحفّظ» أو «المحفّظة» فقط؟ نحن لا ندعو -بالتأكيد- لترك حلقات التحفيظ، ولكن العقد لا يكتمل في صدور أبنائنا إلا إذا وضعنا نحن لمساته. كيف تهون علينا أنفسنا أن يسبقنا غريبٌ إلى تعليم فلذة أكبادنا «سورة الفاتحة»؟ هذه السورة هي «أم الكتاب»، وهي الأساس في حياة كل مسلم، ولا تجوز الصلاة إلا بها. ألا تطمع أن يكون لك أنت «أجر» كل مرة يقرأها ابنك طوال حياته؟ ألا تغار أن يكون هذا الحبل السري الروحي موصولاً بغيرك؟ لن يكتمل «عقد القرآن» في صدور أبنائنا ما لم نضع نحن، الآباء والأمهات، لبناته الأولى. فلتكن أصواتنا هي أول ما يتردد في آذانهم بآيات الله، ليكبروا وهم يحملون «القرآن» في صدورهم، و»صوت الوالدين» في ذاكرتهم. الرفاهية الحقيقية ليست في أن يخدمك الناس، بل في أن تملك الوقت والجهد لتخدم أهل بيتك، وتصنع ذكرياتهم. الطفل لن يتذكر نظافة الأرضية التي مسحتها الخادمة، لكنه سيتذكر طوال عمره «لمسة يدك» وأنت تمسح على رأسه، وصوتك وأنت تعلمه «المرجلة» أو «الحياء» أو «الفاتحة». دعونا نستعيد «مفاتيح» بيوتنا. لتبقَ المساعدة للمساعدة في «شؤون البيت» (التنظيف، الغسيل)، أما «شؤون القلب» و»شؤون العقل» و»شؤون الروح»، فهذه مملكتكم الخاصة التي لا تقبل الشراكة. لا تجعلوا أطفالكم «أيتاماً» والوالدان على قيد الحياة.
1965
| 12 فبراير 2026
- 3 المتقاعدون.. وماجلة أم علي
في ركنٍ من أركان ذاك المجمع التمويني الضخم المنتشر في معظم مناطق قطر، حيث يرتاده كثيرٌ من أبناء الجاليات الآسيوية الكريمة، كان “راشد بن علي” يجلس مع صديقه الهندي “رفيق سراج”. عشرون عاماً ورفيق يعمل “سائقاً”، واليوم حانت لحظة الوداع. قبل أن يحزم حقائبه عائداً إلى بلاده، أراد أن يودّع “مديره السابق” بلمسة وفاء، فدعاه إلى قهوة على حسابه في هذا المجمع المعروف. راشد (مبتسماً): “رفيق، أنت يعرف، أنا ما في يجي هذا مكان، هذا كله عشان خاطر مال أنت.” رفيق (يهز رأسه): “شكرا، ما شاء الله نفر قطري كل زين، كل في طيب،… بابا راشد في سؤال: أنت وين روح اشتري أغراض بيت مال أنت؟” راشد: “أنا روح دايم (الميرة)، هذي شركة مال دوحة، لازم أنا سوي دعم.” رفيق: “أنت نفر واجد سيده، لازم يسوي دعم بلاد مال أنت.” غرق الاثنان في بحر الكلام والذكريات. وعند الوداع، غادر رفيق بدموع الوفاء، وبقي راشد وحيداً يتصفح رسائله على هاتفه. وفجأة… تيت تيت… بيب بيب… وصل “أمر العمليات” من القيادة العليا؛ “أم علي” نصيرة “الميرة”، والمنتج الوطني، قائمة طويلة من طلبات البيت لا أول لها ولا آخر، تبدأ بنص الرسالة: “إذا رحت (الميرة) جيب لنا ونبي………” نظر راشد حوله؛ الوقت ضيق والساعة متأخرة ليلاً، وهذا المجمع الذي يجلس فيه يوفر كل شيء. لكنه كان يتلفت يمنةً ويسرةً يخشى أن يُضبط متلبساً بـ”خيانة تموينية”. تلثم بغترته وقال في نفسه: “سامحيني يا أم علي يا أم الخير”. أخذ عربة التسوق متلثماً، وعند “الكاونتر” وضع الأغراض، فظهر المبلغ: 1500 ريال. ابتسم المحاسب الآسيوي وبدأ الحوار: المحاسب: “بابا، أنت في قطري؟” راشد (مستغرباً): “نعم، قطري، ليش رفيق…؟” المحاسب: “أنت في متقاعد؟” راشد: “نعم، Why…؟” المحاسب: “بابا، جيب بطاقة مال تقاعد.” أخرج راشد البطاقة متردداً وهو يتساءل، مرّرها المحاسب، وفجأة انخفض الرقم على الشاشة! المحاسب: “ما شاء الله بابا، واجد زين! أنت في خصم 5%.” توقف راشد لحظة صمت ودهشة وتلعثم… 75 ريالاً خُصمت في عملية واحدة فوراً تقديراً للمتقاعد القطري! فكّر في هذا المجمع التمويني التسويقي الخارج عن حسابات “أم علي” وتقديراتها، وكيف وجد فيه ترحيباً وتكريماً وتقديراً لم يتوقعه أبداً للمتقاعد القطري، وهو الذي لم يدخله يوماً من باب الولاء للمنتج الوطني. رفع يده للسماء وقال: “الله يسهّل عليك في حلالك يا يوسف بن علي… وجزاك الله ألف خير نيابةً عن كل المتقاعدين القطريين… عز الله إنك شنب ”. خرج راشد متلثماً ومعه “ماجلة أم علي ” إلى البيت، وهو “يحنحن” ويهوجس: أحياناً تسوقنا الأقدار إلى أماكن نتجاهلها ولم نعتدها، لنكتشف أن التقدير قد يأتي من حيث لا نحتسب… ومن “الغريب” قبل “القريب”. الأرض واسعة والناس شتى، والرزق عند الله لا عند البشر.
960
| 16 فبراير 2026