أعلنت وزارة العمل، تنظيم ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال الشهر رمضان الفضيل، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر وطبيعته الروحانية. وأوضحت الوزارة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
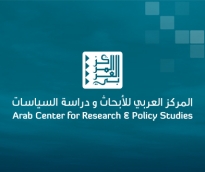
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتابا جديدا بعنوان قضايا المنهج: في علوم السياسة والتاريخ والقانون والديموغرافيا. ويتضمن الكتاب بحوثا بارزة في حقول شتى، تنتمي وتتفرع عن أصول أربعة هي: السياسة والتاريخ والقانون والديموغرافيا، وهو مؤلف جماعي لثلاثة عشر باحثا وباحثة عربا متخصصين في حقول العلوم السياسية، والتاريخ والحضارة، والأدب الألماني، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وحوار الحضارات، والدراسات الأمنية، والأنثروبولوجيا، وعلم الآثار، والتاريخ الحديث، والفكر العربي الحديث، وتاريخ الأفكار، والعلاقات الدولية. وقد حرر مراد دياني مادة الكتاب الذي يقع في 504 صفحات، شاملة ببليوغرافيا وفهرسا عاما. وتساهم بحوث كتاب بعض قضايا المنهج، في الربط منهجيا بين التطلعات العلمية لتخصص العلوم السياسية ومتطلبات معالجة الشأن السياسي بشمولية أكبر، وبين الحاجة الملحة إلى درء ظاهرة الحشو المنهجي في الأطاريح البحثية لمصلحة ما قل ودل، وكذلك درء التحيزات الأيديولوجية في علم السياسة، وتجاوز ثنائية الفهم/ التفسير المانوية في العلاقات الدولية باستدماج منظور السببية والنظر في بدائل نظرية الاختيار العقلاني المهيمنة.
500
| 15 يونيو 2023

قواتها في سوريا ضمان للقضاء على داعش.. ** المساعدة في تحقيق نهاية تفاوضية للنزاعات أبرز الأولويات ** أمريكا تريد تسوية سلمية شاملة بين جميع الأطراف في اليمن ** من الصعب صياغة وصفة واحدة لمعالجة مشاكل لبنان ** تقليص التمثيل الدبلوماسي يقلل من القدرة على مساعدة العراق أكد تقريرالمركز العربي - واشنطن دي سي- أنه مع اقتراب عطلة رأس السنة الإدارية، تهدف السلطات التشريعية والتنفيذية الأمريكية إلى إيجاد حلول لقضايا لسلسلة الأزمات والثورات الجارية في الشرق الأوسط التي ينفق البيت الأبيض الكثير من الوقت والطاقة في التفكير في كيفية حلها والتقليص من تداعياتها. وأبرز التقرير الذي ترجمته الشرق أن الولايات المتحدة تعمل على وضع إستراتيجية متماسكة لوجودها العسكري في المنطقة حيث يفكر البنتاغون في إرسال 14000 جندي إضافي - وهو ما يضاعف فعليًا عدد الأفراد العسكريين الذين تم نشرهم في المنطقة منذ مايو 2019 - وقد شكك مسؤولو وزارة الدفاع في هذا الرقم، لكن وكيل وزارة الدفاع للسياسة جون رود أخبر لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن البنتاغون يقيم حالة التهديد، ويمكن للوزير، إذا اختار ذلك، اتخاذ قرارات لنشر قوات إضافية على أساس ما يراقبه هناك . سوريا واليمن أورد التقرير أنه بغض النظر عن عدد القوات، هناك أسئلة مشروعة يجب طرحها حول الغرض من أي نشر إضافي للقوات. ففي سوريا، حيث تحدث الرئيس الأمركي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا عن تقليص الوجود العسكري الأمريكي، فإن عدم استقرار عدد القوات سيؤدي إلى مزيد من الخلط في فهم سياسة واشنطن. قال وزير الدفاع مارك إسبر في منتدى الدفاع الوطني إن الولايات المتحدة موجودة في سوريا بشكل صارم لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش وأن عدد القوات المتمركزة حاليًا في سوريا تكفي لإنجاز المهمة مع مساعدة من شركاء الولايات المتحدة. هل ضمان الهزيمة الدائمة لـ داعش هو الهدف الوحيد للحفاظ على وجود عسكري في سوريا؟ و تابع التقرير: فيما يتعلق بموضوع سوريا، قالت دينيس ناتالي مساعد وزير الخارجية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار أن إحدى الأولويات الرئيسية للولايات المتحدة هي المساعدة في تحقيق نهاية تفاوضية للنزاع. وكررت أن هدف واشنطن ضمان هزيمة داعش. وقالت إن وزارة الخارجية تأمل في نهاية المطاف إيجاد طريق للمضي قدماً في اتفاقية سلام محتملة. وأكدت التوجه نفسه بخصوص الأزمة المستمرة في اليمن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تريد تسوية سلمية شاملة بين جميع الأطراف. الصعوبة التي واجهتها واشنطن في اليمن - وإلى حد ما في العراق كذلك - تتمثل في كيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة. وإلى أن تتمكن الولايات المتحدة وشركاؤها من دمج هذه الميليشيات المسلحة بنجاح في المفاوضات، أوضح ناتالي أنه سيكون من الصعب الوصول إلى التسوية الشاملة. فيما ذهب النائب آدم سميث إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الانسحاب من الصراعات في كل من سوريا واليمن،، لكن عليها صياغة شكل أفضل وأكثر ذكاءً لحل النزاعات الراهنة في المنطقة - بما في ذلك في اليمن، والتفاوض مع الميليشيات المسلحة - للمساعدة في حل الأزمات. في اليمن، على وجه التحديد، قال سميث إنه لا يوجد تشريع يمكن للكونجرس أن يقره لإنهاء الحرب وأن الولايات المتحدة يجب أن تظل موجودة من أجل الضغط على جميع الأطراف للتفاوض على حل للصراع. أورد التقرير أن مجموعة من المشرعين ومسؤولي إدارة ترامب يراقبون باهتمام بالغ ردود الولايات المتحدة المناسبة على الاحتجاجات الشعبية الهائلة التي عصفت بلبنان والعراق في الأسابيع الأخيرة. عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب جلسة استماع لبنان والعراق. حول احتجاجات لبنان والعراق، بينما عقد نظيره في مجلس النواب جلسة ركزت على العراق بشكل منفرد. حضر كلتا الجلستين جوي هود، نائب مساعد الوزير الأول لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية. فيما يتعلق بلبنان، انتقد أعضاء اللجنة الفرعية، قرار الإدارة الأمريكية السابق بتجميد المساعدات الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية. من الصعب صياغة أي وصفة واحدة لسياسة الولايات المتحدة لمعالجة المشاكل التي يواجهها لبنان، كما تشهد بذلك لجنة من الخبراء في المركز العربي بواشنطن العاصمة، لكن أعضاء مجلس الشيوخ كانوا واثقين تمامًا من أن تقويض إحدى المؤسسات اللبنانية الأكثر احتراماً واستقرارًا من خلال تجميد التمويل هو نهج غير حكيم. فيما يخص العراق، قام أعضاء اللجنتين الفرعيتين باستجواب هود حول نقص موظفي وزارة الخارجية داخل العراق. كما لاحظوا إن تقليص التمثيل الدبلوماسي يقلل من قدرة واشنطن على مساعدة العراق في هذا الوقت المضطرب. وكان المشرعون يصرون أيضًا على أن الإدارة الأمريكية كانت بحاجة إلى النظر في استخدام عقوبات قانون جلوبال ماجنيتسكي لمعاقبة المسؤولين العراقيين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال إصدار أمر بحملة عنيفة ضد الاحتجاجات السلمية. فيما عقد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، مؤتمرا صحفيا هذا الأسبوع للإعلان عن فرض عقوبات بموجب سلطات جلوبال ماجنيتسكي. وفقًا لوزارة الخزانة، تمت الموافقة على ثلاثة أسماء مواطنين عراقيين كانوا مدرجين في قائمة قادة الميليشيات،، لدورهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يبدو أن الولايات المتحدة لم تضع بعد سياسة متماسكة ومثمرة للتفاعل مع المحتجين في كل من هذه البلدان. من الجدير بالذكر أن هؤلاء المتظاهرين منشغلون إلى حد كبير بالمخاوف المحلية ولا يريدون بالضرورة مشاركة الولايات المتحدة. ومع ذلك، قررت الإدارة الأمريكية أن استخدام العقوبات يمكن أن يوقف حملة القمع الحكومية الدموية التي يتعرض لها المحتجون في الشرق الأوسط.
1237
| 23 ديسمبر 2019

5 سنوات من الإعداد وإنجاز 7 قرون في دراسة تاريخ الألفاظ المعجم منبر للنقاش العلمي الجاد في قضايا اللغة التاريخية والدراسات المعجمية المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات في قطر يطلق البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ويشكل المعجم الأم للغة العربية كما يعد أضخم مشاريع المركز، وبالإمكان أن تستخلص منه كل المعاجم المعاصرة من قبيل معاجم المصطلحات والعلوم وفي الفنون والعلوم والآداب وغيرها. وذكر تقرير لتلفزيون قطر أنّ المعجم امتد على مدى 7 قرون وسيمتد الى عصرنا الحالي، وبدأ من عام 500 قبل الهجرة وحتى 200 بعد الهجرة، وسيمتد إلى العصر الحالي. وقد استغرق إنجاز تلك المراحل قرابة 5 سنوات، وحوالي سنة ونصف السنة قبل ذلك، وشارك في إعداده 300 خبير وأستاذ جامعي من مختلف الدول العربية، وتشرف عليه هيئة تنفيذية في قطر. ولا يقتصر المعجم على كونه أول معجم تاريخي للغة العربية فحسب، إنما معجم فريد من نوعه من حيث حجم المعلومات، ويستعرض علاقة المفردات بنظيراتها في اللغات السامية التي عايشت اللغة العربية في العصور الأولى. وكان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بمعهد الدوحة للدراسات العليا قد احتفل بأهم حدث تاريخي لمعجم الدوحة التاريخي. مراحل التأسيس وتم العمل على المرحلة الأولى منه منذ مايو عام 2013 وحتى تدشينه، أي ما يقارب السنوات الخمس، كما يعتبر أول معجم يؤرخ ألفاظ اللغة العربية ومعانيها، ويتوقع بعد أن يكتمل المشروع وصول عدد مفرداته إلى ما يربو على المليار كلمة تقريباً، وفي وقت قياسي. وقد تطرق إلى الكثير من المعاجم اللغوية في اللغات الأخرى على سبيل المثال الألمانية والانجليزية والفرنسية، وجميعها أخذت عقوداً ومنها ما زاد على القرن ونيف، أما اللغة العربية فهناك محاولات لم تتكلل بالنجاح لعدم توافر الدعم الكافي من مادة ومتخصصين، وهو ما تم توفيره لإنجاز معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وفي وقت قياسي والعمل جارٍ على استكمال المشروع حتى النهاية وبتدشين الموقع الإلكتروني لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، يتمكن الباحث أو الزائر للموقع من معرفة ألفاظ اللغة العربية بمعانيها ومبانيها وبما ورد منها في النقوش مع التأصيل، وذلك بحسب ثلاثة أنواع: هي الترتيب التاريخي، والترتيب بالأبنية الصرفية، والترتيب الألف بائي. كما يقدم موقع المعجم صيغة البحث في المدونة النصية عن الكلمة في السياقات التي وردت فيها مرتبة بترتيب تاريخي موثقة المصادر، بالإضافة إلى الأخبار التي يقدمها الموقع عن أنشطة مؤسسة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ليكون منبراً للنقاش العلمي الجاد في قضايا المعجم التاريخي والدراسات المعجمية والكثير من الأمور ذات الصلة، وذلك انطلاقا من كون المعجم مشروع أمّة يستوجب مساهمة المعنيين باللغة العربية، والأهم أن بالإمكان تعديل الموقع وفق الحاجة، مع إمكانية المتابعة والاستفسار والإضافة من قبل الجمهور عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك. تاريخ التأسيس فقد أنشأ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤسسة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وبين نظامها الأساسي وأهدافها ووسائلها، وهيكلها الإداري ومكوناتها واختصاصاتها والعلاقات القائمة بينها. وتقوم الخطة العامة لانجاز المعجم على تقسيم تاريخ اللغة العربية تقسيما إجرائيا إلى خمس مراحل، تمتد منذ أقدم نص عربي موثق إلى نصوص عصرنا الراهن، حيث تقف المرحلة الأولى عند العام 200 للهجرة، أما المرحلة الثانية فتقف عند العام 500 للهجرة، فيما تقف الثالثة عند العام 800 للهجرة، وهكذا.. كما يرتبط بكل مرحلة بناء مدونتها اللغوية على أساس بيبلوغرافيا المرحلة، وفهرسة ألفاظها بصورة تكون فيها مجموعة من حزم اشتقاقية ومربوطة بسياقاتها، ومرتبة ترتيبا تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث، ثم تخضع للمعالجة المعجمية فالمراجعة، فالتحرير، فالنشر بعد الاعتماد، كما تعمل بموازاة ذلك لجان وظيفية، كلجنة إعداد البيبلوغرافيا وتحديد أفضل طبعات المصادر ولجنة تدقيق تواريخ وفيات الشعراء والمؤلفين ومن في حكمهم، ولجنة النقوش ولجنة التأصيل. الحاسوبية للمعالجة المعجمية تتضمن المنصة الحاسوبية قاعدة بيانات المدونة اللغوية، وقاعدة بيانات البيبلوغرافيا والحزم الاشتقاقية المربوطة بسياقات ورودها، والجذاذة الالكترونية، وأدوات المعالجة كالدليل المعياري للمعالجة المعجمية، ودليل التحرير، والمصادر المرجعية والمعاجم وغيرها، كما تتيح إجراء عدة عمليات من: معالجة، ومراجعة وتحرير، ومراقبة سير جميع العمليات، وتقدم إحصاءات ومعلومات عن سير العمل، والفرق المعجمية، وغير ذلك، وتوجد في نسختين: نسخة مربوطة بالانترنت، ونسخة مفصولة عن الانترنت.
877
| 28 ديسمبر 2018

أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، في الحفل الذي أقامه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في معهد الدوحة للدراسات العليا صباح اليوم. حضر الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والأكاديميين والمثقفين، ونخبة من أساتذة الجامعات والخبراء وعلماء اللغة والمعاجم في عدد من الدول العربية. وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم عقب ذلك تم عرض عدد من الأفلام، تتحدث عن أهمية معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ومراحل تطور العمل فيه، وخصائص المرحلة الأولى التي تم إنجازها منه، إضافة الى معلومات حول البوابة الإلكترونية للمعجم. وقد ألقى المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وعدد من أعضاء المجلس العلمي للمعجم كلمات بهذه المناسبة، أوضحوا فيها القيمة التاريخية واللغوية لهذا المعجم. من جانبه قال د. علي أحمد الكبيسي (عضو المجلس العلمي للمعجم) في كلمة افتتاحية للحفل:يعد هذا المعجم نقلة نوعية في خدمة اللغة العربية، وهو أول محاولة عربية ناجحة. وقال د. عزمي بشارة: يمكن اعتبارُ معجم الدوحة التاريخي للغة العربيّة سَبْقًا، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي أيضًا، على الرغم من خصوصية الصعوبات التي تُميز العربية؛ وهي صعوبات تفوق أيَّ لغةٍ أخرى أُرّخ لها معجميًا. وأضاف: لقد قطعنا شوطًا في جمع مدونات المراحل المقبلة وتنسيقها وترتيبها، وسوف نواصل الطريق من عام 200 للهجرة حتى يومنا هذا، وسيكون الإيقاعُ أسرعَ رغم ضخامة مدونة المراحل التالية التي ستفوق مليار كلمةٍ كما يقدّر خبراء المدونة حاليًا. وقال د.بشارة : لقد قررنا في المركز العربي للأبحاث أن نسميَه معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، لأن مشروعنا هو أيضًا هديةٌ ثمينةٌ للغاية من الدوحة إلى الأمة جمعاء. ومنذ اليوم، كل من يريد أن يعرف دلالة لفظ عربي في مرحلة زمنية محددة سوف يزور معجم الدوحة التاريخي. فيما قال د. عز الدين البوشيخي (المدير التنفيذي للمعجم): أن يكون لأمةٍ معجم تاريخي للغتها، معناه أن تكون قادرة على أن تجمع تراثها الأدبي والديني والعلمي والثقافي المبثوث في النصوص جمعًا واحدًا، مهما امتدّ في الزّمان أو انتشر في المكان، ومهما تضخّم حجمه وتفرّعت فنونه. مضيفا: تقتضي أمانةُ الوصف الإشارةَ إلى أن معجمنا في مرحلته الأولى عمل تأسيسيّ مُنفتح على المراحل الموالية، وقابلٌ للتّحديث المُستمر، ومفتوح أمام مشاركة العلماء والباحثين باقتراح التّصويب والتّعديل والإغناء. وقال: إننا نشرف اليوم بتفضّلكم بإطلاق البوّابة الإلكترونيّة لمعجم الدّوحة التّاريخيّ للّغة العربيّة، ونعلن في حضوركم استعدادنا التّام للشّروع في العمل بالخطّة التّنفيذيّة للمرحلة الموالية ببداية العام الجديد. ويعتبر المعجم الذي بدأ العمل فيه منذ شهر مايو 2013 أول معجم يؤرخ لألفاظ اللغة العربية ومعانيها، وقد حظي المشروع بتوجيه ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ كان وليا للعهد ضمن رؤية سموه في المحافظة على اللغة العربية وهوية الأمة.
1570
| 10 ديسمبر 2018

افتتح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم مؤتمرًا بعنوان "المسيحيون العرب في المشرق العربي الكبير: عوامل البقاء، والهجرة، والتهجير"، الذي تجري أعماله على مدى يومين في معهد الدوحة للدراسات العليا بمشاركة 20 باحثًا من مختلف التخصصات في العلوم السياسية والاجتماعية من دول عربية عديدة. وافتتح المؤتمر بمحاضرتين، الأولى، لوزير الخارجية الأردني السابق كامل أبو جابر، تناول فيها "الدور الغربي في تسهيل هجرة المسيحيين من المشرق العربي"، عرج فيها على العلاقة بين المسيحية الشرقية والمسيحية الغربية، ومايز بينهما. ووجد بأن الغرب تاريخيًا لم يكن صديقًا للعرب؛ مسحيين ومسلمين. أما المسيحيون العرب فلم يطلبوا الحماية من الغرب يومًا، بل كانوا مندمجين دائمًا في المجتمع الإسلامي. كما أن المسلمين لم يتسامحوا مع المسيحيين، بل قبلوا العيش مع المسيحيين؛ فالتسامح يعني الرضا بالعيش المشترك إكراهًا، أما القبول، فيعني التساوي في حقوق العيش على أرض واحدة طواعية من المسلمين والمسيحيين. وذهب المحاضر إلى أن تهجير المسيحيين من المشرق العربي، هو عداء للقومية العربية بحد ذاته، وهو ما يصب في خدمة إسرائيل؛ لأن القومية العربية تجمع بين المسلم والمسيحي وجميع العرب، بغض النظر عن دينهم، فضلًا عن أن هذا التهجير هو ما سيحرم الحضارة العربية الإسلامية من جوهرها الأساسي المتمثّل في التعددية. ولذلك، فإن هجرة المسيحيين العرب ليست مشكلة مسيحية فحسب، وإنما عربية إسلامية عامة. وكانت المحاضرة الثانية للمؤرخ وجيه كوثراني: "في مأزق مشروع المواطنة وتعثّر الانتقال من نظام الرعية والملة إلى الدولة الوطنية: أوهام التسامح والحماية"، وقد وجد فيها أن أمرين أو مسارين مترابطين رافقا عملية التحوّل التاريخي للدولة في البلدان العربية، ولا سيما تلك البلدان التي ارتبط تاريخها بتاريخ السلطنة العثمانية هما: مسار التحوّل من دولةٍ سلطانية، (أي إمبراطورية متعددة الأديان والإثنيات) إلى دول/ أمم، ومسار يضرب بجذوره عميقًا في التجربة التاريخية الإسلامية، ويتعلّق بمسألة "أهل الذمة" في الدولة المسمّاة "دولة إسلامية". وخلص المحاضر إلى أن الاستشهاد بنظام الملل بصفته "نظامًا متسامحًا" حيال المسيحيين، عملًا بقاعدة عهود "أهل الذمة" في التاريخ الإسلامي، لا يصلح البتة لأنظمة تقول دساتيرها "بحقوق المواطنة" و"المساواة" بين المواطنين. واقع المسيحيين العرب قبل الدولة الوطنية تضمنت الجلسة الأولى من المؤتمر ثلاث مداخلات عن واقع المسيحيين قبل نشوء الدولة الوطنية العربية الحديثة. قدم فيها يوسف كرباج مداخلة بعنوان "المسيحيون العرب في الإمبراطورية العثمانية: من معركة مرج دابق إلى معركة عين دارة"، وجد فيها أن تعداد المسيحيين كان يقارب 7 في المئة من سكان المشرق العربي، عندما ورث العثمانيون الهلال الخصيب من المماليك. وبعد ثلاثة قرون، شكلت هذه النسبة نحو 30 في المئة (ولكن 8 في المئة فقط في مصر). بعد بضعة قرون من السلطة العثمانية السنية، تضاعفت الطائفة المسيحية أربع مرات بفضل مواردها الديموغرافية: الولادية والوفاتية، وليس من خلال مساهمة الهجرة الأجنبية كما هو الحال في ظل الحروب الصليبية. وأكملت الباحثة حلا نوفل في محاضرتها التسلسل التاريخي الذي بدأه يوسف كرباج، في مداخلة لها بعنوان: "المسيحيون العرب في الإمبراطورية العثمانية: من معركة عين دارة إلى الحرب العالمية الأولى". فقد أثرت معركة عين دارة في العام 1711 في التركيبة الاجتماعية في جبل لبنان؛ إذ هاجر الدروز، المنقسمون بين قيسيين ويمنيين، على نطاق واسع إلى الداخل السوري في حوران وحل محلهم بالتدريج المسيحيون الموارنة. كما استفاد المسيحيون من عدم تدخل السلطة العثمانية في شؤون الجبل اللبناني والجماعات المسيحية في كامل بلاد الشام، إلى درجة أنهم جعلوا السلطة المحلية تنتقل إلى أيدي مسيحيين مثل أسرة شهاب التي اعتنقت المسيحية. وقد تبع ذلك هجرة مسيحيين من دمشق إلى لبنان بعد دخول جيش محمد علي باشا دمشق؛ ما عزز النفوذ السياسي للمسيحيين في لبنان لعوامل تتعلق بالنمو الديموغرافي وتعزيز سلطتهم السياسية، وهو ما مهد للعنف الطائفي في بلاد الشام عام 1860. أما المداخلة الثالثة، فكانت للباحثة فدوى نصيرات، بعنوان "أوضاع العرب المسيحيين الاجتماعية في مصر وبلاد الشام". تناولت فيها الأوضاع العامة للمسيحيين العرب في ظل الحكم العثماني 1516-1918، ومن ثم أوضاعهم الاجتماعية قُبيل حكم محمد علي باشا لمصر وبلاد الشام وخلاله. كما بحثت في الآثار التي تركها حكم محمد علي في الأوضاع الاجتماعية للمسيحيين العرب، ووصفت الباحثة أحوالهم الاجتماعية في ظل التنظيمات العثمانية. واختتمت مداخلتها بالآثار التي تركتها الإرساليات التبشيرية في حياة العرب المسيحيين الاجتماعية. وتستمر أعمال المؤتمر بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين العرب؛ إذ تناقش الجلسة الثانية الأوضاع السياسية والقانونية للمسيحيين العرب في المشرق العربي. أما الجلسة الأخيرة في أعمال اليوم، فتبحث في المسألة المسيحية في الخطاب الإسلامي المعاصر.
581
| 21 أكتوبر 2017

يواجه الوجود المسيحي في المنطقة العربية "لحظةً مفصليةً"، فبعد نحو ألفي سنة، تخلّلها تعايش المسيحيين وتفاعلهم مع الإسلام ودوله المتعاقبة، يبدو هذا الوجود معرّضًا للفناء مع تسارع "نزيف الهجرة إلى الغرب". وتتوقع بعض مراصد الحركة الديموغرافية في المشرق العربي، الذي تُقدّر أعداد المسيحيين فيه بنحو 14 مليونًا، أنه لن يبقى فيه سوى 6 ملايين مسيحي خلال أقلّ من عقد من الزمان. ولذلك، يبدو من المهم إعادة نقاش موضوع الوجود المسيحي في المنطقة، ودراسة واقع المسيحيين وأسباب هجرتهم. واستمرارًا لنهجه في رصد التحولات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية في العقد الأخير، ينظّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً بعنوان "المسيحيون العرب في المشرق العربي الكبير: عوامل البقاء، والهجرة، والتهجير"، وذلك في المبنى الثقافي لمعهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة 21-22 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. ويشارك في الندوة مجموعة من الباحثين العرب والمختصين في موضوع العرب المسيحيين، إذ ستجري دراسة الواقع التاريخي والاجتماعي للمسيحيين في المشرق العربي الكبير، والأسباب الاقتصادية والسياسية لهجرتهم إلى الدول الأخرى.
305
| 16 أكتوبر 2017

تصاعدت حدة التصريحات العدائية بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية إلى مستوى غير مسبوق، ووصل الأمر حدّ التهديد المتبادل بحرب نووية. فقد بدأ التصعيد مع إجراء كوريا الشمالية تجربتي إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات في تموز/ يوليو الماضي، تزامنًا مع صدور تقدير استخباري أميركي يرجح نجاح بيونغ يانغ في تطوير رؤوس نووية صغيرة يمكن تحميلها على صواريخ عابرة للقارات؛ وهو ما يعني تجاوز عتبة رئيسة في طريق تحول بيونغ يانغ إلى قوة نووية كاملة. كما أشار تقدير استخباري أميركي آخر إلى أن كوريا الشمالية قد تكون رفعت مخزون ترسانتها من القنابل النووية إلى ستين، وأصبحت تملك القدرة على إنتاج محركات صواريخ، وأنها وصلت، أو اقتربت من الوصول، إلى القدرة على ضرب البر الأميركي. في حين بات مؤكدًا الآن أن الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية قادرة على ضرب جزر أميركية في المحيط الهادئ، مثل هاواي وغوام. تصعيد أميركي في ضوء هذه التقديرات، بادرت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد الضغوط على كوريا الشمالية؛ ففي الخامس من آب/ أغسطس الجاري، وردًا على تجربتي إطلاق الصاروخين الباليستيين الشهر الماضي، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجماع أعضائه، بمن فيهم روسيا والصين، عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وتستهدف هذه العقوبات تخفيض عائدات الصادرات الكورية، والتي تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنويًّا، بنحو الثلث. وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم حظر صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد الخام والرصاص الخام والمأكولات البحرية. كما أنه يحظر على الدول استقبال أعداد أكبر من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، ويحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية. ومثلت موافقة بيجين على هذا القرار ضربة كبيرة لنظام بيونغ يانغ؛ إذ تُعدّ الصين أكبر شركائه التجاريين، وقد جاءت الموافقة الصينية في ظل تهديدات إدارة ترامب للصين بالتصعيد معها في ملف العلاقات التجارية المختلة بين الطرفين. وجدت بيونغ يانغ العقوبات الجديدة "مفتعلة"، وحذرت مما "سيتبعها من إجراءات عنيفة"، كما أشارت إلى أن تجربتي الصاروخين العابرين للقارات اللتين أجرتهما في تموز/ يوليو الماضي تثبتان أن الولايات المتحدة بكامل أراضيها أصبحت داخل نطاق صواريخها، وأن هذه الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس. وردّ ترامب على ذلك بقوله: إن تهديدات كوريا الشمالية ستواجه "بنار وغضب وقوة لم يرها العالم من قبل قط"، لتنطلق بذلك حرب تصريحات وتهديدات متبادلة وغير مسبوقة في حدتها. فقد رأت كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة تسعى لشن "حرب نووية استباقية" عليها، وهددت بأنها قد تطلق أربعة صواريخ باليستية نحو جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ على أن تسقط على بعد 30 إلى 40 كيلومترًا منها. وتقع غوام على بعد نحو 3000 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من كوريا الشمالية، ويقطنها نحو 163 ألف نسمة وبها قاعدة عسكرية أميركية تشمل أسطولًا من الغواصات وقاعدة جوية ومجموعة من خفر السواحل. وعلى الرغم من أن التهديد الكوري لم يأت على ذكر استخدام صواريخ نووية موجّهة نحو غوام، كما أنه كان واضحًا بأنها لن تضرب الجزيرة مباشرة، فإن ترامب رد بتهديد مقابل قال فيه: "إذا تفوّه [كيم] بتهديد واحد ... أو إذا فعل أي شيء فيما يخص غوام أو أي مكان آخر يتبع الأراضي الأميركية أو حليفًا لأميركا فسيندم". النزول عن الشجرة مع وصول التوتر إلى هذا المستوى، تصاعد القلق، إقليميًا، وداخل الولايات المتحدة، من احتمال نشوب حرب نووية نتيجة حسابات خاطئة من أحد الطرفين أو كليهما. فبدأت التحركات الساعية لتهدئة التوتر. ففي الخامس عشر من الشهر الجاري أعلنت كوريا الشمالية أن كيم أرجأ قرار إطلاق صواريخ صوب جزيرة غوام الأميركية في انتظار ما ستفعله أميركا. وفي اليوم التالي، امتدح ترامب كيم لقراره "الحكيم" هذا. وكان وزير الخارجية ريكس تيلرسون يكرر منذ بدء الأزمة أن الولايات المتحدة لا تمانع إقامة حوار مع كوريا الشمالية، إذا أوقفت تجارب إطلاق الصواريخ. كما أعلن ترامب في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد اجتماع مع مجلس الأمن القومي بأنه يتمنى أن ينجح الجهد الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، مضيفًا: "لا أحد يفضل حلًا سلميًا أكثر من الرئيس ترامب". وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان كتبا في مقال مشترك لهما في صحيفة وول ستريت جورنال في الثالث عشر من الشهر الجاري أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في بيونغ يانغ، وبأنها تهدف إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية. وفي مؤشر على أن الولايات المتحدة تبحث عن حلول سلمية عبر توظيف الضغطين الاقتصادي والدبلوماسي على بيونغ يانغ، أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن الطرفين يجريان اتصالات سرية عبر "قناة دبلوماسية خلفية". وأشارت تلك التقارير إلى أن جوزيف يون مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشؤون كوريا الشمالية يفاوض الدبلوماسي البارز من كوريا الشمالية في الأمم المتحدة باك يونج إل. غير أن مسؤولين أميركيين آخرين أكدوا أن هذه الاتصالات تتم منذ عدة أشهر ضمن ما يعرف بـ "قناة نيويورك". دوافع الطرفين للتهدئة من الواضح أن آخر شيء يريده نظام كيم جونغ أون هو الدخول في حرب مع الولايات المتحدة نتيجتها معروفة، سواء أكانت على المستوى التقليدي أم تطورت إلى استخدام أسلحة نووية. لذلك مال إلى التهدئة من خلال إعلانه إرجاء إطلاق الصواريخ باتجاه غوام. أما أميركيًا، فيمكن تلخيص أسباب التهدئة في التالي: المواقف الإقليمية المعارضة للتصعيد من جهة حلفاء واشنطن في المنطقة وغيرهم؛ فقد اعترضت كوريا الجنوبية على التصعيد ودعوات الحرب؛ إذ صرح رئيسها، مون جيه - إن، بأن بلاده لن تسمح بأي عمل عسكري في شبه الجزيرة الكورية، وبأن قرارًا في هذا الصدد تتخذه كوريا وحدها ولا يمكن لأي طرف آخر، في إشارة إلى الولايات المتحدة، أن يقرره نيابة عنها. ويمكن تفهّم القلق الكوري الجنوبي؛ بما أن الحرب ستعني سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في كوريا الجنوبية، حتى من دون استخدام كوريا الشمالية الأسلحة النووية. الأمر نفسه ينطبق على اليابان بحكم قربها الجغرافي من كوريا الشمالية ووقوعها في مدى قذائفها وصواريخها قصيرة المدى. كما عارضت الصين التصعيد؛ لأن الحرب قد تؤدي إلى سقوط حليفها نظام كوريا الشمالية، وموجات نزوح بشرية هائلة نحو حدودها. وبحسب افتتاحية لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تمثل الموقف الرسمي الصيني، فإنه يتعين على الصين أن توضح أنه إن بادرت كوريا الشمالية بشن هجوم صاروخي على الأراضي الأميركية، وردّت الولايات المتحدة عليه عسكريًّا، فإن الصين ستكون محايدة. أما إن بادرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشن ضربات استباقية ومحاولة إطاحة النظام في بيونغ يانغ، فإن الصين ستمنعهما من ذلك. معارضة المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية الأميركية لشن حرب على كوريا الشمالية قبل استنفاد الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية جميعًا؛ وهو ما أشار إليه وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان في مقالهما المذكور سابقًا. وتدرك تلك المؤسسات أن في مرمى صواريخ كوريا الشمالية قرابة 130 ألف مواطن أميركي يقيمون في كوريا الجنوبية، وقرابة 30 ألف جندي أميركي آخرين منتشرين في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، فضلًا عن وقوع 170 ألف مواطن أميركي و12000 جندي آخرين في جزيرة غوام الأميركية في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية. خاتمة يبدو واضحًا أنّ طرفي الأزمة نجحا في احتوائها في هذه المرحلة، وقد حقق كل منهما مكاسب منها؛ فقد تمكنت إدارة ترامب من دفع بيونغ يانغ إلى التراجع عن تهديداتها بضرب محيط جزيرة غوام، فضلًا عن نجاحها في فرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية عبر مجلس الأمن، بموافقة روسيا والصين. لكنّ كوريا الشمالية تمكنت هي الأخرى من إثبات قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ الباليستية وإطلاقها، والتي باتت تصل إلى مدى أبعد، وتهديد أراضٍ أميركية، ولو بعيدًا عن البر الأميركي الرئيس، من دون أن تدفع ثمنًا كبيرًا في المقابل، بل يبدو أن بيونغ يانغ نجحت في جر واشنطن إلى حيث تريد؛ أي بدء مفاوضات جدية تأمل في نهايتها أن تحصل على اعتراف أميركي بنظامها ونفوذها بصفتها قوة إقليمية في شرق آسيا، كما تأمل في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع واشنطن ورفع العقوبات الاقتصادية عليها، وفق ما جاء في نموذج الاتفاق النووي الإيراني في مرحلة باراك أوباما. فهل تقبل إدارة ترامب ذلك؟ لا يبدو هذا واضحًا الآن، لكن الواضح أن كوريا الشمالية أصبحت من أبرز التحديات أمام إدارة ترامب المثقلة بالمشكلات سواء في الداخل أو الخارج.
380
| 21 أغسطس 2017

ورقة تقدير موقف حول رؤية ترامب للصراع العربي الإسرائيلي.. يخطئ العرب إذا تجاهلوا المواقف الأمريكية الداعمة لليمين الإسرائيلي طهران ستلجأ لاستخدام الملف الفلسطيني كإحدى أدوات الصراع مع ترامب لم يقدم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب رؤية متماسكة لسياسته الخارجية حتى الآن، فضلًا عن أنّ مواقفه التي عبّر عنها حتى اليوم، يشوبها كثير من الغموض والمفارقات. وتؤكد ورقة تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي لا يمثل استثناءً في هذا المشهد، فقد سبق لترامب أنّ عبّر عن الموقف ونقيضه مرات عدة؛ فقد اعتبر نفسه الشخص الأكثر تأهيلًا لتحقيق "السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأنه سيكون "محايدًا" بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وفي المقابل أشار إلى أن إسرائيل لا تريد السلام. وبعد ذلك، تبنى الأجندة اليمينية الإسرائيلية بالكامل، ووعد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكنه يعود ويؤكد أنه سيعمل على تحقيق "سلام" فلسطيني إسرائيلي عبر تعيين زوج ابنته الشاب، جاريد كوشنر، مشرفًا على عملية السلام في الشرق الأوسط. 4 ملفات وتحاول الورقة تلمّس ما قد تكون عليه سياسة إدارة ترامب نحو الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي من خلال أربعة ملفات، هي: العلاقة مع إسرائيل، والموقف من المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاستيطان. وازاء العلاقة مع إسرائيل لا توجد معلومات عن علاقات خاصة ومتميزة جمعت ترامب بإسرائيل، وهو ما بدا واضحًا خلال حملته الانتخابية الرئاسية؛ إذ إن أقصى ما استطاع أن يتودّد به لليهود الأمريكيين كان شهادات تقدير حصل عليها من منظمات صهيونية، مثل صندوق النقد اليهودي الذي أسبغ عليه "جائزة شجرة الحياة" عام 1983، وهي جائزة تمنح "لأفراد تقديرًا لخدماتهم المجتمعية وتفانيهم في موضوع الصداقة الأمريكية — الإسرائيلية"، وشارك في "احتفال يوم إسرائيل" عام 2004 في نيويورك، كما حصل على شهادة تقديرية مطلع عام 2015 من منظمة صهيونية أمريكية محافظة. ويمكن أيضًا الإشارة هنا إلى أن ثمة علاقة خاصة جمعت بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، إذ قام بتسجيل فيديو خاص لحضّ الإسرائيليين على دعم حملة ترشّح نتنياهو عام 2013. غير أنّ علاقة ترامب الخاصة بنتنياهو، وبعض الجوائز التقديرية من منظمات يهودية أمريكية وإسرائيلية، لم تترجم إلى مواقف سياسية واضحة في دعم إسرائيل وسياساتها، مما أثار شكوكًا حوله بين اليهود الجمهوريين واليهود الأمريكيين عمومًا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية مع تكراره مراراً أنه "يحب إسرائيل". تبني اليمين المتطرف وتؤكد الدراسة أن مواقف ترامب من إسرائيل، شهدت تغييراً كبيراً منذ مارس 2016، وذلك عندما ألقى خطاباً أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية — الإسرائيلية "إيباك" في واشنطن، أعلن فيه أنه "في اليوم الذي سأصبح فيه رئيساً، فإن معاملة إسرائيل كمواطن من الدرجة الثانية ستنتهي". كما تعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب "إلى العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، القدس". وأكد ترامب أنه سيجتمع مع نتنياهو في حال انتخابه رئيساً "للعمل معاً على تحقيق الاستقرار والسلام في إسرائيل والمنطقة بأسرها". ومنذ ذلك الحين، انتقل ترامب مباشرة إلى تبني مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف، وثبت في مواقفه وتصريحاته الداعمة لإسرائيل وللتأكيد على أنه ملتزم بوعوده، تحادث ترامب هاتفياً مع نتنياهو بعد يومين من تنصيبه رئيساً، فأكد التزامه بعلاقات وثيقة مع إسرائيل "والتزامه غير المسبوق بأمنها"، ودعاه إلى زيارة البيت الأبيض مطلع فبراير. الاستفراد بالفلسطينيين تضيف الدراسة أن أكثر القضايا غموضاً في مقاربة ترامب للصراع الفلسطيني — الإسرائيلي تكمن في موقف إدارته المتوقع من العملية التفاوضية وما ينبغي أن تفضي إليه، إذ إن تصريحاته ودائرته الضيقة في هذا الموضوع تصل حدَّ التناقض. فمن جهة، ترى إدارته "أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يتحقق عبر التفاوض المباشر بين الطرفين فقط" (وهذا يتطابق مع موقف اليمين الإسرائيلي الذي يهدف إلى الاستفراد بالفلسطينيين وإخضاع التفاوض معهم لميزان القوى الثنائي)؛ بمعنى إبعاد أي وصاية أخرى، بما في ذلك مرجعية الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وأن دور الولايات المتحدة سينحصر في العمل "بشكل وثيق مع إسرائيل لتحقيق تقدم". غير أنه، من جهة أخرى، أعلن في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بعد نجاحه في الانتخابات أنه يريد أن يكون "الشخص الذي حقق سلاماً بين إسرائيل والفلسطينيين". ويؤيد بعض المسؤولين الكبار في إدارته مثل مرشحه لمنصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير دفاعه جيمس ماتيس، وسفيرته إلى الأمم المتحدة نيكي هالي، اتفاق سلام فلسطينيا — إسرائيليا يفضي إلى دولة فلسطينية. ولتحقيق ذلك، فإن ترامب يعتبر أن زوج ابنته كوشنر هو الشخص الأنسب لتحقيق ذلك، مع أن كوشنر لا يملك أي خبرة دبلوماسية، فضلًا عن أن نزاهته محل شك كبير، فهو ينتمي لعائلة يهودية متدينة معروفة بدعم إسرائيل والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. كما أن ديفيد فريدمان، الذي اختاره ترامب ليكون سفيراً لبلاده في إسرائيل، معروف بدعمه المطلق لإسرائيل والاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. بل إن فريدمان ينافح صراحة عن "حق" إسرائيل في ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية لإسرائيل. نقل السفارة إلى القدس وتشير الدراسة إلى مسألة نقل السفارة الامريكية الى القدسن موضحة أنه قبل يوم واحد من تنصيبه رئيساً، أكد ترامب أنه سيفي بتعهده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ولكن، بعد تحذيرات من مسؤولين أمريكيين ودول حليفة، أوروبية وعربية، من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنطقة كلها، وتؤثر في المصالح والأمن القومي الأمريكي، يبدو أن إدارة ترامب آثرت التريث، وهو ما عبّر عنه الناطق باسم البيت الأبيض، عندما قال إن الإدارة لا تزال "في المراحل الأولى في مناقشة هذا الموضوع". بل ثمة مؤشرات على أن إسرائيل نفسها قد لا تكون متحمسة لهذا الموضوع الآن، لأنها غير مستعدة لتفجّر عنفٍ محتملٍ جراء مثل هذه الخطوة في وقت تريد أن ينصبّ التركيز فيه على احتواء إيران. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن نتنياهو لم يسع إلى الضغط على ترامب خلال المحادثة الهاتفية بينهما للحصول على التزام منه بشأن نقل السفارة ولا حتى على جدول زمني لتحقيق ذلك. دعم الاستيطان وحول الاستيطان، تضيف الدراسة أنه لا يوجد موقف واضح لإدارة ترامب من موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي لا يزال — بحسب الموقف الرسمي الأمريكي — غير شرعي، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذا الموضوع لن يكون نقطة توتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل كما كان عليه الحال في ظل إدارة أوباما. فمن ناحية، ندّد ترامب بقرار مجلس الأمن رقم 2334. كما أن زوج ابنته، كوشنر، داعمٌ للاستيطان، وكذلك سفيره المقترح لإسرائيل ديفيد فريدمان. وفي مؤشر على الاطمئنان الإسرائيلي لإدارة ترامب، أعلنت بلدية القدس عن المضي قدماً في مشروع بناء 550 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية يوم تنصيب ترامب رئيساً. وحسب نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، فإن "قواعد اللعبة تغيرت بعد وصول ترامب". بل إن الأحزاب الأكثر يمينية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل اليوم، مثل حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت، تضغط من أجل ضمّ مستوطنة معاليه أدوميم، في الشمال الشرقي من القدس، إلى إسرائيل، مما سينهي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، لأنها تصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. ومن الواضح أن إدارة ترامب سوف تتسامح مع التوسع الاستيطاني ولن تراقبه، بغض النظر عن الموقف الرسمي، وأن ما يسمى بحركة السلام الإسرائيلية التي تنحصر مهمتها منذ سنوات بانتقاد الاستيطان ومراقبته وتقديم تقارير حوله، لن تجد حليفاً داخل إدارة ترامب. ونوهت الورقة بما قاله نتنياهو حول مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد في 15 كانون الثاني/ يناير 2017، والذي قاطعته حكومته، من أن هذا المؤتمر ينتمي إلى عهد سابق، وأن العالم سوف يشهد عهداً جديداً. وتختتم الدراسة بالإشارة الى انه يبدو واضحاً أنّ الموقف الأمريكي من الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي قد يتعرّض لتغييرات كبيرة، ويخطئ العرب خطأً فادحاً إذا تجاهلوا المواقف الأمريكية الداعمة لليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن القدس والمستوطنات، وإذا تركوا قضية فلسطين مرةً أخرى للاستخدام الإيراني، لا سيما وأنّ العلاقات الإيرانية — الأمريكية في مرحلة ترامب ستدفع إيران للبحث عن أدوات للصراع.
476
| 29 يناير 2017

مثّل فوز رجل الأعمال الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في الثامن من نوفمبر 2016 مفاجأةً كبيرةً داخل الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، فقد جاءت النتائج مخالفة لبيانات استطلاعات الرأي وتوقعات أكثر الخبراء ووسائل الأعلام. ودلت النتائج على عمق التغييرات التي شملت المجتمع الأميركي خلال السنوات القليلة الماضية، كما كشفت شروخًا عميقةً داخل هذا المجتمع وفي النظام السياسي الأميركي عمومًا. ونظرًا إلى أهمية الموضوع والتداعيات المرتقبة لفوز ترامب على الوضع داخل الولايات المتحدة، وعلى سياستها الخارجية وتأثيراتها في مجمل الأوضاع العربية والأزمات الإقليمية والعلاقات الدولية، يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً أكاديميةً حول تداعيات هذا الحدث، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2016 في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا. تتناول الندوة الأسباب والعوامل التي أدت إلى فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وظاهرة صعود اليمين في الولايات المتحدة وأثرها في النظام السياسي الأميركي والعلاقات بين مختلف المكونات الاجتماعية والعرقية والإثنية والدينية. وبالنظر إلى التغييرات المرتقبة في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب، تسعى الندوة أيضًا إلى استكشاف عمق هذه التغييرات تجاه مختلف القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية والعلاقات مع مصر ودول الخليج وإيران، كما تتناول التحولات المحتملة في علاقة الولايات المتحدة بالقوى الكبرى في النظام الدولي. ويشارك في الندوة نخبة من الباحثين والمختصين في الشأن الأميركي والسياسة الخارجية وفي مواضيع العلاقات الدولية في المنطقة. وتضم قائمة المشاركين كلًا من: عزمي بشارة، خليل جهشان، مهران كمرافا، سامر شحاتة، مروان قبلان، جو معكرون، عبد الوهاب الأفندي، خليل العناني، إبراهيم فريحات، مارك فرحة. وتندرج هذه الندوة ضمن الندوات التي يعقدها المركز العربي، وتخصص لمناقشة موضوعات راهنة، تهدف إلى إحاطة المواطن العربي بمقاربات وتحليلات معمقة عن قضايا تهمه، وذلك بمشاركة باحثين وجامعيين من المنطقة العربية والعالم.
284
| 08 ديسمبر 2016

* ياسر معالي: المعهد مشروع نهضوي عربي * هند المفتاح: المشروع حظى بدعم كامل من صاحب السمو * البوشيخي: خمسة آلاف مدخل لفظي ضمن معجم الدوحة للغة العربية تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح معهد الدوحة للدراسات العليا التابع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الكائن بمنطقة لوسيل صباح اليوم. سموه تفقد المبنى الجديد واستمع لعرض شامل عن "معجم الدوحة التاريخي للغة العربية" وقام سموه بجولة في المبنى الجديد للمعهد، واستمع إلى شرح مفصل عن أقسامه وبرامجه ورسالته الأكاديمية، وما سوف يضطلع به من أبحاث ودراسات. كما استمع سموه إلى عرض شامل عن "معجم الدوحة التاريخي للغة العربية"، الذي يتتبع تاريخ الألفاظ العربية على مدى عشرين قرنا، ويستغرق إنجازه نحو 15 عاماً. من جانبه، أكد الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة بالوكالة أن معهد الدوحة للدراسات العليا مشروع نهضوي عربي يسعى إلى تكوين جيل من الباحثين الشباب في مجالات الدراسات الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، مشدداً على أن المعهد هدية من قطر لأمة العرب جميعاً. صاحب السمو خلال جولة في معهد الدوحة للدراسات العليا من جانبها، قالت الدكتورة هند المفتاح نائبة رئيس معهد الدوحة للشؤون الإدارية والمالية: إن مشروع معهد الدوحة للدراسات العليا قد حظي منذ انطلاق فكرته بدعم كامل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فقد رآه من خلال رؤية قطر الوطنية وخريطة طريقها نحو بناء رأس المال البشري والهوية في قطر، وأيضاً من خلال رؤيته لأهمية دور النخبة الثقافية والمهنية العربية، ومساهمتها في التنمية البشرية على المستوى العربي. وكشف الدكتور عزالدين البوشيخي المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية عن أول مخرجات المشروع بانتهاء فريق المعجم من إنشاء خمسة آلاف مدخل لفظي ضمن المعجم، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حققه أي من المشاريع السابقة في الوطن العربي لإعطاء اللغة العربية معجمها التاريخي الذي يرصد نشأة المفردات والمصطلحات وتطورها التاريخي، في انتظار استكمال جميع مداخل المعجم والمدونة اللغوية، بعد أن سبق إعداد بيبليوغرافيا الإنتاج المعرفي والفكري العربي لأزيد من 20 قرناً. جانب من جولة صاحب السمو خلال افتتاح معهد الدوحة للدراسات العليا صرح أكاديمي وبدأ مشروع إنشاء المعهد بمرحلةٍ تشاورية تأسيسية أطلقها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في أواخر عام 2011. وقد استمر الجهد حتى عام 2013 حين شُكِّل أولُ مجلسِ أمناءَ لمعهد الدوحة للدراسات العليا، كما أُنجز تصميمُ حرمِ المعهد عام 2014 بشكلٍ يتناسقُ مع رؤيته. وفُتح بابَ القبولِ للسنة الجامعية الأولى 2015-2016 في تسعةِ برامج للماجستير،هي: العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفلسفة، والتاريخ، واللسانيات والمعجمية العربية، والأدب المقارن، والإعلام والدراسات الثقافية، والإدارة العامة، والسياسة العامة، واقتصاديات التنمية، وبدأت الدراسة للفوج الأول من طلبة المعهد في أكتوبر من عام 2015 في حرم جامعة قطر، وانطلق الفوج الثاني لطلبة المعهد من حرم معهد الدوحة اعتباراً من أكتوبر 2016. سد الفجوة كما انطلقت رؤية معهد الدوحة للدراسات العليا من ضرورةِ سدِ نقصٍ ناتجٍ عن بعض السياسات التعليمية الخاطئة والتصدي لفكرةٍ سائدةٍ في مجتمعاتنا عن عدم جدوى التخصص في العلوم الإنسانية والاجتماعية أو الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وبناءً عليه، فإنّ رسالةَ معهدِ الدوحة للدراسات العليا هي بناءُ مؤسّسةٍ أكاديميّةٍ مستقلّةٍ للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامّة واقتصاديات التنمية وإدارة النزاع والعمل الإنساني، ويسعى المعهدُ لتحقيق أهدافه الأكاديمية من خلال تكاملِ التعليمِ والتعلّمِ مع البحث العلمي على نحوٍ يؤهلُ خريجيه كي يصبحوا أكاديميّين باحثين في تلك التخصصات، ومهنيين متمكنين قادرين على الدفع قُدُماً بالمعرفة الإنسانية والاستجابة إلى حاجاتنا في سبيل التطوّر الفكري والاجتماعي والمهني، ويتبنّى المعهدُ استخدامَ اللغةِ العربية لغةً رئيسةً للدراسةِ والبحثِ مدعومة باللغات الحيّة الأخرى. صاحب السمو خلال افتتاح معهد الدوحة للدراسات العليا وضم أولِ فوجٍ من طلاب معهد الدوحة للدراسات العليا 155 طالباً وطالبة من أصل 903 طلبات جرى تقديمها من قطر والدول العربية والخليجية والأوروبية، وفي السنة الجامعية الثانية 2016-2017، تقدم 2788 طالباً من 30 دولةً، وجرى قبول 239 طالباً جديداً، وتعاقدُ المعهد مع أساتذة عرب من أهم الجامعات وأعرقها على مستوى العالم؛ ممن أنجزوا أبحاثًا مهمة وآمنوا برؤية المعهد، بدأنا بـ 34 أستاذا وبلغ عددهم اليوم 55 أستاذاً. مشروع أمة كما أطلق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في عام 2013 مشروع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ليصبح بعد ثلاث سنوات أحد أبرز المشاريع التي يضمها معهد الدوحة في مقره الذي دشن أمس رسميا. المعجم التاريخي للغة العربية هو المعجم الذي يتضمّن "ذاكرة" كلّ لفظٍ من ألفاظ اللّغة العربيّة، من بدايات استعماله، فتحوّلاته البنيوية والدِّلاليّة، ومستعمليه في تحوُّلاته تلك، مع توثيق تلك "الذّاكرة" بالنّصوص التي تشهد على صحّة المعلومات الواردة فيها. وهو يرصد أطوار حياة ألفاظ اللغة العربية؛ ظهورا أو كمونا، إعمالا أو إهمالا، تشقُّقا أو تقوقعا، انتشارا أو انحسارا. وتقوم الخطة العامة لإنجاز المعجم على تقسيم تاريخ اللغة العربية تقسيما إجرائياً إلى خمس مراحل، تمتد منذ أقدم نص عربي موثق إلى نصوص عصرنا الراهن، تقف المرحلة الأولى عند عام 200 للهجرة، وتقف المرحلة الثانية عند عام 500 للهجرة، وتقف المرحلة الثالثة عند عام 800 للهجرة، وهكذا دواليك حتى مرحلة عصرنا الراّهن. صاحب السمو خلال افتتاح معهد الدوحة للدراسات العليا فهرسة إلكترونية تُجمَعُ مصادر كل مرحلة في بيبليوغرافيا، وتُجمع نصوص المصادر المُرقمَة في مدونة لغوية إلكترونية، ثم تخضع ألفاظ النصوص بعد فهرستها إلى المعالجة المعجمية التي تُحدِّد تحوّلاتها الصرفية والدلالية في سياقاتها اللغوية الحيّة على مدى تاريخها. ومن المتوقع أن يستغرق إعداد هذا المعجم ما ينيف على خمس عشرة سنة. وقد أنجز من مراحل المشروع إلى غاية الآن بيبليوغرافيا تشمل الإنتاج العربي المعرفي على امتداد عشرة قرون (من القرن الخامس قبل الهجرة إلى نهاية القرن الخامس بعد الهجرة)، وكذا بناء مدونة لغوية إلكترونية تتضمن نصوص المرحلة الأولى (الممتدة من القرن الخامس قبل الهجرة إلى سنة 200 للهجرة)، وبناء منصة حاسوبية للمعالجة المعجمية تتيح للخبراء اللغويين القيام بعمليات المعالجة المعجمية والمراجعة والتدقيق والتحرير. وجرى وضع الدليل المعياري للمعالجة المعجمية لتوحيد الفهم والعمل بين المعالجين، ودليل التحرير المعجمي. وجرى الانتهاء من إعداد خمسة آلاف مدخل معجمي كاملة لعينة مختارة من ألفاظ اللغة العربية.
1809
| 04 ديسمبر 2016

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الرابع من "أسطور للدراسات التاريخية" وحمل العدد كلمةً كتبها نائب رئيس التحرير عبد الرحيم بنحادة في موضوع حياة المؤرخ الفقيد عضو هيئة تحريرها وأحد أعمدة لجنتها العلمية الدكتور محمد الطاهر المنصوري وإنجازاته العلمية، إضافةً إلى آخر دراسة زود بها الفقيد المجلة، إلى جانب عدد من مراجعات الكتب. كما تنشر على نحو خاصّ، تحية للفقيد، مراجعتين لأحدث كتبه: "تونس في العصر الوسيط.. إفريقية من الإمارة التابعة إلى السلطنة المستقلة"، كان قد أعدها الباحث شمس الدين الكيلاني الباحث المقيم في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وياسين اليحياوي أحد طلبة معهد الدوحة للدراسات العليا. وقدم العدد مختارات من الدراسات وعروض الكتب المتنوّعة ومناقشاتها، لنخبة من المؤرخين العرب، منهم وجيه كوثراني، وحياة عمامو، والطاهر المنصوري، وعبدالله حنا. إضافةً إلى عدد من الباحثين المتميزين. وقد جمع هذا العدد بين البحوث النظرية المتعلقة بالكتابة التاريخية في أوروبا أثناء نهاية القرن التاسع، في ترجمة متميزة لمدخل كتاب هايدن وايت "تاريخ التاريخ: المخيّلة التاريخية في أوروبا.. القرن التاسع عشر" بعنوان "شعرية التاريخ"، و"التاريخ والذاكرة والكتابة التاريخية" للمؤرخ وجيه كوثراني، إضافةً إلى عدد من الدراسات في مواضيع التاريخ الحضري والسياسي والديني المعتمد أساسًا على الأرشيف والوثائق التاريخية للحقبة المدروسة. ضم هذا العدد أيضًا عددًا من مراجعات الكتب ووثيقةً بعنوان "من هو الحكيم أندراد الإشبيلي مؤلف كتاب "في طبيعة الخيل وأنواعها المختلفة وأفعالها"، وشهادات شفاهيةً للمهمشين في سوريا أجراها المؤرخ السوري المتمرس بالتاريخ الاجتماعي والشفهي عبدالله حنا في أواخر القرن العشرين، وباب "مسارات" الذياشتمل على مقابلة مع المؤرّخ وجيه كوثراني، و"ندوة أسطور" التي كانت بعنوان "إشكاليات البحث في التاريخ العربي"، والتي شارك فيها عدد من الباحثين والمؤرخين العرب.
479
| 04 سبتمبر 2016

استضاف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات د.حسين السوداني في محاضرة بعنوان "العرب واللسانيات: قراءة في قنوات هجرة المعرفة"، وذلك في إطار لقاءاته الدورية لاستضافة باحثين عرب وأجانب لتقديم محاضرات في اختصاصاتهم. ويعرف عن د. السوداني أنه يعمل أستاذًا للسانيات بالجامعة التونسية وخبيرًا بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية. أقام د.السوداني محاضرته على مراوحة طريفة بين إطارين معرفييْن هما النظريات اللسانية الحديثة في منشئها الغربيّ من جهة وتطوّر البحوث اللغوية العربية من جهة ثانية. وفي سير المحاضرة أشار د.السوداني إلى أن هدفه هو ضبط الخطوط العامة لخريطة زمنية ترصد تطوُّرَ البحوث اللغوية العربية المعاصرة، وذلك باقتفاء ملامح التجديد في مقاربة الظواهر اللغوية منذ مطلع القرن التاسع عشر، أي منذ المنعرج المهمّ في الدراسات اللغوية في ألمانيا. ووزع د.السوداني بحثه على ثلاثة محاور كبرى؛ الأول جعله لاستقراء بوادر التجديد في البحث اللغوي العربي في القرن التاسع عشر، واستغرق منه هذا القسم بحثًا معمقا وتدقيقا في الكتب غير المتخصّصة في اللغة لاقتناص بوادر الاطلاع على النظريات الغربية الرائجة وقتئذ. وتركّز البحث على غايتين: الأولى تتمثّل في توصيف بوادر التجديد نفسها، وأما الثانية فتتعلّق باستقراء خلفيات تحقق هذا التجديد، فأجاب عن أسئلة نحو: هل تحقّق التجديد بفعل اطلاعٍ على النظريات الجديدة في البحث اللغوي أم بفعل تطوّر ذاتيّ داخليّ؟ وهل كان التجديد استجابة لاحتياجات علمية وعملية أم كان وجهًا من وجوه التجديد الذي وسم الفكر العربي فيما أصبح يسمى فكر عصر النهضة؟ وسيّج د.السوداني هذا القسم من محاضرته بميثاق منهجيّ أساسه أنّ المسألة على درجة من اللطف والدقة تقتضي من الباحث أن يحذر من الإسقاط من جهة أو التحيّز من جهة ثانية. وفي المحور الثاني من الورقة، نظر د.السوداني في ملابسات التجديد في مطلع القرن العشرين؛ فركز نظره في هذا القسم على ملابسات التجديد في الدراسات اللغوية في المشرق العربي بدرجة أساسية. ويتعلق المحور الثالث من الورقة بظروف نشأة بحث لساني في المغرب العربي، وهو الحدث الذي يرتبط باستقلال دول المغرب العربيّ وتأسيس الجامعات فيها في أواسط القرن العشرين. وختم د.السوداني ورقته برصد الملامح العامة التي تَسِم البحث اللغويّ في أواخر القرن العشرين؛ وذلك باعتبار ما استقرّ في هذه الفترة في المشرق والمغرب العربييْن من أعراف واتجاهات في البحث، ومن ملامح ذلك أمران: أولهما ظهور كتب يسعى أصحابها إلى تقديمِ نظريات واتجاهات لسانية بعينها، والثاني هو نشأة اتجاه بحثي يروم مراجعة الرصيد العربي من المعرفة اللسانية الحديثة. وفي آخر النقاش زفّ د.السوداني للحضور من المشتغلين باللغة واللسانيات بشرى هي قرب انتهائه من تأليف معجم متخصص في اللسانيات هو "قاموس فردينان دي سوسير"، وسيصدره هذه السنة بمناسبة احتفال العالم بمئوية فردينان دي سوسير الأب المؤسس لعلم اللسانيات. ولعل ما يضفي على بحث د.السوداني بعدا استثنائيا حقيقيا هو اشتغاله الطريف والمؤسِّس في هذا المقام على مفهوم "قنوات هجرة المعرفة"، وهو مفهوم ذو بعد ابستيمولوجيّ دقيق وحريّ بأن يكون أداةً لانخراط عربيّ حقيقيّ في "المشهد العلمي الكوني"، وذلك قياسا على عبارة نحتها الدكتور السوداني نفسه في محاضرة طريفة قدّمها مِنْ قبْل في المؤتمر العلميّ الذي ترأَّسه بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وجعلها بعنوان "اللغة العربية والمشهد اللغويّ الكوني". عقّب د.حيدر سعيد على محاضرة د.السوداني لما بينهما من تقاطع في الاهتمامات اللسانية، فكلاهما أنجز رسالة عن فردينان دي سوسير الأب المؤسس لعلم اللسانيات، وكان تدخل د.حيدر على درجة من العمق تناغمت مع التبصر الذي أبداه د.السوداني بقضايا اللغة واللسانيات الحديثة.
634
| 05 أبريل 2016

في خطوةٍ مفاجئة ٍ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب الجزء الأكبر من قواته من سورية ابتداءً من الثلاثاء الموافق 15 آذار/ مارس 2016. وقد ورد في البيان الصادر عن الكرملين أنّ قرار الانسحاب "جاء بعد أن حققت القوات الروسية الجزء الأكبر من أهدافها". وقد أعد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورقة تقدير موقف لهذه الخطوة رأت انه يتعين عدم الذهاب بعيدًا في قراءة الخطوة الروسية ؛ وعلى الرغم من أنّ ديمتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي نفى أن يكون قرار سحب القوات الروسية من سورية يستهدف ممارسة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد للانخراط بصورة جدّية في العملية السياسية التي يؤمل أن تؤدي إلى حلٍ، فإنّه أكّد أنّ "المهمة الرئيسة لموسكو في سورية تكمن، في المرحلة الراهنة، في المساهمة بمنتهى الفاعلية في عملية التسوية". سياق التدّخل الروسي وتقول الورقة انه مع أنّ موسكو أعلنت أنّ الهدف الرئيس من تدّخلها العسكري في سورية، الذي بدأ في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 هو مواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بدلًا من انتظار قيامه بشنّ هجمات داخل روسيا، في ظل معلومات عن التحاق مئاتٍ من حملة الجنسية الروسية بالتنظيم، فإنّ الغارات الجوية التي شنّها سلاح الجو الروسي خلال الشهور الماضية تركزت على قوات المعارضة المسلحة، وهو ما يشير إلى أنّ هدف روسيا الفعلي من التدخل كان يتمثّل في وقف انهيار الجيش السوري واستعادة التوازن على الأرض بما يسمح بإطلاق عملية سياسية لا يخرج منها النظام مهزومًا. لكنّ هذه المهمة لم تكن يسيرة كما اعتقدت موسكو، إذ اتضح للروس منذ البداية مدى الإنهاك والعطب الذي أصاب الجيش السوري بعد خمس سنوات من القتال، وتمثّل في عجزه أول الأمر عن استعادة أي جزءٍ صغيرٍ من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة على الرغم من كثافة القصف الروسي. وقد مثّلت معارك ريف حماة الشمالي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، حين استخدمت المعارضة صواريخ "تاو" الأميركية لمواجهة دبابات النظام ومدرعاته، إحراجًا كبيرًا لموسكو؛ ما دعاها إلى استدعاء الأسد لمناقشة الموقف. مسار سياسي وبالتوازي مع الحملة الجوية التي قادتها لوقف تقدّم المعارضة قبل دفعها إلى التراجع، قامت موسكو بفتح مسارٍ سياسي يستهدف منع انزلاقها أو جرّها إلى حرب استنزاف في سورية، وبما يسمح في الآن نفسه بفتح حوارٍ مع واشنطن يؤدي إلى تكريسها شريكًا رئيسًا في معالجة جملة من القضايا في المنطقة، وعلى رأسها سورية. وبعد شهرٍ فقط من بدء الحملة الجوية الروسية، انطلقت مسيرة فيينا التي بدأت رباعية (روسيا — الولايات المتحدة — تركيا — السعودية) قبل أن تتوسع لتشمل 17 دولة من ضمنها إيران في إطار ما أصبح يعرف "بمجموعة دعم سورية". لكنّ هذا المسار، لم يلبث أن انتهى ثنائيًا في ظل توجّه موسكو وواشنطن للتوصّل إلى تفاهمات مشتركة بينهما تستبعد جميع الأطراف الأخرى مثل الأوروبيين، وكذلك إيران التي طالما أصرّت روسيا على إشراكها في محادثات حلّ الأزمة السوريّة. أسفر مسار فيينا عن التوصّل إلى اتفاقٍ عُرف باتفاق فيينا الذي قدّم خريطة طريق لحلّ الأزمة السورية جرى تضمينها في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحمل الرقم 2254 بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2015، ونصّ على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكم /حكومة شاملة وذات طابع غير طائفي، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة. وبعد فشل الجولة الأولى من مفاوضات "جنيف 3" التي انطلقت في 29 كانون الثاني/ يناير 2016، في ظل استمرار القصف الروسي ومحاولة النظام وحلفائه استثمار المفاوضات غطاءً لتحقيق نتائج على الأرض، تمكّن الروس والأميركيون في 11 شباط/ فبراير من التوصل إلى اتفاقٍ لوقف "العمليات العدائية" في سورية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، على الرغم من استمرار الخلاف حول شموليته والفصائل التي ستستبعد منه، إلى أن بدأ تنفيذه في 27 شباط/ فبراير بعد تذليل آخر العقبات أمامه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وأوباما في 22 شباط/ فبراير 2016. وخلال الأسبوعين اللذين أعقبا إعلان وقف إطلاق النار، ومع حصول خروقات كبيرة من النظام وحلفائه، فإنّ الاتفاق ظلّ صامدًا، ليعكس إصرارًا روسيًا على إنجاحه مع إعلان فرنسا أنّ القوات الروسية توقفت في الأثناء عن استهداف فصائل المعارضة المسلحة. خلاف الأجندات جاء القرار الروسي بالانسحاب الجزئي من سورية متزامناً مع استئناف المفاوضات في جنيف، وقد بدا واضحًا أنّ الرئيس بوتين اكتفى بإبلاغ الأسد بقراره هاتفياً؛ ما يعكس استياء روسيا من محاولة نظامه التملّص من التفاهمات الروسية — الأميركية التي تمّ التوصّل إليها وشملها قرار مجلس الأمن 2254 وكذلك القرار 2268 بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2016، والذي تضمّن شروطًا وآليات مراقبة وقف إطلاق النار في سورية. وقد بدأت الخلافات بين النظام السوري وموسكو تطفو على السطح بوضوح في الفترة الأخيرة؛ إذ اعتبر السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين تصريحات الرئيس الأسد، من أنه سيواصل القتال حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، بأنها تسيء إلى الجهد الدبلوماسي المبذول للتوصّل إلى تسوية سلمية، وأنّ "روسيا استثمرت كثيرًا في هذه الأزمة، سياسيًا ودبلوماسيًا، والآن عسكريًا، وبالتالي تريد بالطبع أن يأخذ بشار الأسد هذا الأمر بعين الاعتبار". وشكّل إعلان النظام السوري عزمه إجراء انتخابات تشريعية في نيسان/ أبريل القادم من دون التشاور مع الروس مادةً أخرى للخلاف؛ إذ اعتبرت روسيا أنّ هذه الخطوة تخالف ما جرى النص عليه في القرار 2254 لجهة أن تكون أي انتخابات جزءًا من الاتفاق النهائي على حل الأزمة. وأثناء زيارة أخيرة قام بها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى طهران، أبلغه الإيرانيون أنهم يدعمون موقف الأسد بشـأن إجراء انتخابات تشريعية، وهو موقف أزعج الروس وأظهر أنّ الأسد يحاول الاستثمار في اختلاف المصالح والسياسات الروسية والإيرانية في الأزمة السورية. الأسد ليس خطاً أحمر تؤكد الورقة ان كل هذا يدفع للاعتقاد بأنّ قرار الرئيس الروسي بسحب الجزء الأكبر من قواته من سورية عشية بدء مفاوضات جنيف جاء على خلفية اتساع حجم الخلافات مع الأسد وإيران بشأن العملية التفاوضية والنتائج المتوقعة؛ إذ لا يُخفي النظام السوري المدعوم إيرانيًا رفضه أي حلٍ سياسي لا يضمن بقاء الأسد وسيطرته على القرار الأمني والعسكري في أي صيغة حكم مستقبلية؛ وهو الأمر الذي عبّر عنه وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عندما قدّم تفسيره لمعنى الانتقال السياسي في القرار 2254، فقال: المرحلة الانتقالية "في مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد، ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر". وتعليقًا على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا حول ضرورة أن تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون 18 شهرًا من تشكيل حكم شامل غير طائفي، أضاف المعلم بأنّ الأخير غير مخولٍ الحديث أو البحث في إجراء انتخابات رئاسية في سورية لأنّ "بشار الأسد خط أحمر". وفيما تبدي روسيا ميلًا نحو تحقيق حلٍ سياسي ينطلق من موقعها كمتحكّم سياسي وعسكري بالمشهد السوري، ويكرس شراكة مع واشنطن تستند إلى قدرتها على العمل معها ولو من منطلق "شريك أصغر" Junior Partner لضبط الفوضى الإقليمية، فإنّ إيران والنظام السوري يظهران إصرارًا على هزيمة المعارضة عسكريًا وسياسيًا. وفيما تتمسك موسكو بإنجاح الهدنة، يسعى حلفاؤها لكسرها اعتقادًا منهم أنهم باتوا قادرين على تحقيق نصرٍ ميداني كامل. من هنا، يستمر النظام والميليشيات الداعمة له بحشد قواتهم في أكثر من منطقة، وخاصة في حلب، استعدادًا لإعلان انهيار الهدنة واستئناف القتال. كل هذا يجري في الوقت الذي بات معه الأسد متشككًا بنيات الروس حيال بقائه على رأس النظام وحول ماهية التفاهمات التي توصلوا إليها مع الأميركيين بشأن مصيره. القرار الروسي والمفاوضات تضيف الورقة ان الجولة الحالية من المفاوضات بدأت في 14 آذار/ مارس 2016، وسط خلاف على جدول الأعمال؛ إذ يصرّ النظام على مكافحة الإرهاب أولًا قبل الانتقال إلى بحث القضايا السياسية، فيما تصرّ المعارضة على البدء بتشكيل هيئة حكم/ أو حكم انتقالي وفق القرار 2254، وأنّ هذه الهيئة يجب أن تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية بما في ذلك تشكيل الحكومة الانتقالية واتخاذ إجراءات وضع دستور جديد والاستفتاء عليه وإصدار قانون الانتخابات الجديد وإدارة الانتخابات بمراقبة دولية. ويتمسّك وفد المعارضة برفضه مناقشة أية قضية أخرى قبل التوصل إلى اتفاق حول هيئة الحكم الانتقالي، كما لا يقبل إضافة أي طرفٍ ثالثٍ للمفاوضات بوصفه ممثلًا للمعارضة. وقد تلقّى وفد المعارضة دعمًا لموقفه بإعلان دي مستورا أنّ جوهر كل قضايا البحث في جنيف هو الانتقال السياسي، وأنّ هدف جولات المفاوضات الثلاث القادمة هو التوصّل إلى خريطة طريق لبلوغ الهدف الرئيس. من هنا، اعتبر دي مستورا أنّ قرار الانسحاب الروسي يخدم مفاوضات السلام في جنيف، أما المعارضة فقد ترجمته بالمنحى ذاته إذا كان يهدف إلى ممارسة ضغط على النظام للدخول في مفاوضات جدية تؤدي إلى تجنيب سورية المزيد من السيناريوهات الكارثية في حال استمرار الصراع. ارادة دولية وتؤكد الدراسة انه على الرغم من التوقعات بعدم تحقيق الجولة الحالية نتائج ملموسة على صعيد الحلّ، فإنّه من الواضح وجود إرادة دولية للدفع باتجاه الحل السياسي، وهو ما لم يكن يتوافر في السابق. إنّ ذلك يفتح الباب نحو بدء جولةٍ ثانيةٍ بعد استراحةٍ قد تمتد أسبوعين آخرين. وسوف تساعد هذه الجولة في سبر حقيقة النيات الروسية بصورة أفضل، وفي الإضاءة على طبيعة الحلّ الذي يسعى له الروس في سورية، وحقيقة التفاهمات التي توصلوا إليها مع الولايات المتحدة. انسحاب غير كامل بناء عليه، يتعين عدم الذهاب بعيدًا في قراءة الخطوة الروسية؛ فهي لا تعني أنّ الروس قد تخلوا بالمطلق عن النظام السوري، فانهياره سيمثل ضربةً لهم بعد أن استثمروا كل هذا الجهد لإنقاذه. كما أنّ انسحابهم لن يكون كاملًا؛ إذ سيستمر الروس في الاحتفاظ بوجودٍ عسكري مهمٍ في سورية وبخاصة في قاعدة حميميم الجوية وميناء طرطوس. إنّ خروجهم بصورة كلية من سورية يعني التضحية بنفوذهم الذي كلفهم الكثير، وتقديم هدية مجانية لإيران. وفي الوقت نفسه، يبدو أنّ موسكو قد أجرت حسابات أيضًا لوقوع الأسوأ، فاختارت الوقت المناسب للخروج خشية أن يتحوّل وجودها في سورية إلى ورطةٍ إذا فشلت المفاوضات ولجأت الدول المنافسة إلى خطة بديلة قوامها تحويل سورية إلى أفغانستان روسيّة جديدة. فروسيا ليس بوسعها التورط عسكريًا لمددٍ طويلة في مناطق بعيدة، وثمة حدود لقدرتها الاقتصادية على التحمّل، ولكنّها لا تريد انهيار النظام بل الدفع باتجاه تسوية تحافظ على مؤسسات الدولة والجيش في الوقت ذاته.
324
| 16 مارس 2016

في جلستين منفصلتين، ناقش المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية اليوم قضية الحرية في الفكر العربي المعاصر. وكانت الجلسة الاولى بعنوان "الحرية الدينية وحرية المعتقد"، والثانية بعنوان "الحرية ضمن سؤال الحداثة والنهضة". وقدم الدكتور عبد الوهاب الأفندي ورقة بحثية بعنوان "ثمن الحرية: اقتصاديات الحرية والتحرّر في صراعات الحداثة العربية" أكد فيها على أن الحرية قضية شائكة في الواقع العربي، مشيرا إلى أنها تجلّت في الغرب الذي كان له ريادة في تقديم مبدأ الحرية على غيره من المبادئ، وتعميمه على البشرية كافة، وكيف وصلت إلى تحرير الاقتصاد وجعل التعامل مع المسألة الاقتصادية أساس مسألة الحرية. وقال الأفندي إن هذا الدور الحاسم الذي قامت به الليبرالية في الدفاع عن الحرية جعل "من المستحيل تموقع التفكير في الحرية خارجًا عنها أو بالقفز حولها"، على الرغم من أنّها قد تحتاج إلى إعادة صوغ، بخاصة في صورتها المتعولمة التي تقدّم حرية الاستطاعة على حرية الإرادة. وهو ما يطرح بدوره سؤال "تبيئة" الحرية في المجتمعات غير الغربية، وفي مقدّمتها المجتمعات العربية الإسلامية. وأضاف بأن أحد الأسئلة المحورية التي تطرحها هذه الورقة هو، بافتراض صحة ما يقال عن المجتمعات العربية، وكونها لا تزال تحفل بتضمينات ما قبل الحداثة، من قبلية وطائفية وغيرها، وهو: كيف يمكن "بناء الحرية" في مثل هذه المجتمعات بما يضمن التناسق فيما بينها وتنظيم الصراع بحيث يظل سلميًا ومؤسسيًا بدلًا من أن يتحول إلى العنف أو الفوضى؟ وشدد على أنّ مفهوم الحرية "الفردية" لا معنى له ولا وجود له خارج إطار منظومة اجتماعية معيّنة، ولا ينفصل عن مفهوم الجماعة التي تشكّل هذه المنظومة، وأنّ هذا المفهوم متأصّل في كلّ الثقافات، بما في ذلك الثقافة العربية قبل الإسلام وبعده، تعمد الورقة إلى مناقشة "الليبرالية الإسلامية" بوصفها طريق المستقبل، وضمانة التحول الديمقراطي في البلدان ذات الغالبية الإسلامية. الحرية في الاسلام من جانبه، قدم الباحث معتز الخطيب ورقة "الحرّيّة الدينية وقتل المرتد: مدخلٌ لإعادة التفكير في الاجتهاد الفقهي" عالج فيها الحرّيّة الدينية في التفكير الإسلامي بتشعّباته المتعدّدة، ومفاهيم الحرّيّة في التراث والقرآن. والإضافة التي يقّدمها هذا البحث تتمثّل بثلاث جهات الأولى أنه يوضح "النظام الفقهي" ومبناه في تقرير عقوبة الردّة، والثانية أنه يوضح كيف أنّ عقوبة الردّة الفقهية تصلح مثالاً نموذجيًا لضرورة إعادة التفكير في الاجتهاد الفقهي وآلياته، والثالثة أنه يوضح أثر تبدل القيم الأخلاقية (الإكراه على الدين "الحق") وتطوّر المفاهيم (الحرّيّة) على التفكير الفقهي وأحكامه. وقدّم الباحث صورة مفصّلة عن النقاشات المختلفة حول الحرّيّة الدينية والإكراه على الدين في مرحلتين: المرحلة الكلاسيكية والمرحلة الحديثة والمعاصرة. كما أوضحَ أبعاد الجدل حول قيمة الحرّيّة الدينية والأسس التي استند إليها القول بأخلاقية الإكراه على الدين أو لا أخلاقيته. كما بحث في السياقات التاريخية التي ولّدت تلك النقاشات المختلفة. وجعل الخطيب من مسألة الحرّيّة الدينية وحكم المرتدّ مثالاً نموذجيًّا قدّم من خلاله مقاربة منهجية للتفكير الفقهي، وبيّن أسسه ومبناه وأدواته في الاستنباط والحِجاج. كما قدّم بالمقابل مقاربة نقدية ثلاثية الأبعاد للمنهج الفقهي تمثّلت بالأبعاد المنهجية، والتاريخية، والأخلاقية. ثقافة عالمية بدورها قدمت الباحثة السودانية محاسن يوسف عبدالجليل ورقة "الحرية في التمثلات الاجتماعية: بين الثقافة العالِمة والثقافة الشعبية، من صلب الحلاج إلى إعدام محمود محمد طه" قالت فيها إن كثيرًا ما تتناول مفهوم الحرية، وما تأسس عليه من مقاربات وأسئلة حول التقدم والحداثة في المجتمع العربي، وكأنه قد تشكل بالأساس من خلال تمثّلات"الثقافة العالمة" التي بادر إليها وهيأ لها خطاب رواد النهضة العربية؛ وهو تأويل فيه كثير من مطابقة الواقع، غير أنه يبدو نافيًا لمساهمة "الثقافة الشعبية" ووعيها في بناء هذا الخطاب. وأشارت إلى وجود أكثر من خطاب فاعل حول الحرية في الواقع العربي، تعبر جميعها عن فاعلية اجتماعية وفاعلين اجتماعيين، وتتبدى جميعها كتجليات لتمثلات منتجة ومعبرة عن أنساق متعددة داخل الحقل الاجتماعي، ومعبرة في آنٍ عن مستويات متفاوتة داخل النسق الواحد، كما أنها تبرز بحق طبيعة التمثل الاجتماعي، كتركيب لديناميكية مؤلفة من التصورات المتنافسة للهيمنة على الرأسمال الرمزي، إذ تتجلى هنا التمثلات الاجتماعية كنمط من التفكير التطبيقي الموجه نحو التواصل والقهر والتحكم في المحيط الاجتماعي. جدل غير موجود فيما قال الباحث سعيد أقيور إن الحرّيّة الدينية لم تثير نقاشًا أو جدلًا في النسق الفكري والسياسي العربي التقليدي، وذلك لتمكن المسلمين من حكم بلاد واسعة، ووجود مضمون عقدي مثّل أساسًا لحضارة صاعدة، ووضوح الاعتبارات الاسلامية في معاملة المسلمين لغيرهم. فقبول الآخر المختلف حتى في العقيدة كان مبدأ مقررًا عند العلماء المسلمين ولا خلاف حوله، ومن ثمّ فهي قضية خارجة عن الإكراه. أما تخلّي المسلم عن دينه لأي سبب فقد حسمه الفقهاء بادعاء الإجماع حول قتل المرتد. ونوهت إلى أن دخول العرب في أزمنة الحداثة قلب هذه المعادلة رأسًا على عقب، وشهدت كل الأطروحات التي كانت تعتقد أنها متينة وبعيدة عن النقد، الكثير من الجدالات والانتكاسات، وأحدثت استقطابات حادة على مستوى النخب العربية لتشهد ولادة تيارات أيديولوجية عدة بمقاربات مختلفة لعلاقة الدين بالحرّيّة؛ وفي مقدمة هذه التيارات التي في الأغلب رسمت بينها حدودًا فاصلة، من دون تخوم واصلة، التيار الديني والتيار العلماني. من جانبه قال الباحث سامر عكاش إن سؤال غياب "الحرّيّة" في العالم العربي اليوم هو سؤال عن إخفاق المشروع النهضوي العربي في تحقيق أحلامه التنويرية ومبادئه الإصلاحية، نظرًا لأن الحاضر هو من صنع الأمس، وأن ثقافة القمع والاستبداد هي من صناعة النهضة العربية تحديدًا، ليس بآمالها العريضة الواعدة طبعًا، وإنما بإخفاقاتها المتكررة على الأصعدة الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية.
2347
| 13 مارس 2016

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ويستمر حتى بعد غد الاثنين بفندق الريتز كارلتون. ويناقش المؤتمر موضوعين رئيسيين هما "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". وفي محاضرة تأسيسية في موضوع الحرية تحت عنوان "أسئلة الحرية: هنا..الآن"، أكد الكاتب فهمي جدعان أن "الحرية" وأسئلتها لاتزال مثار نقاش كبير على مختلف الصعد بين المفكرين والفلاسفة والسياسيين. وشهد اليوم الأول من المؤتمر أربع جلسات في كل واحدة من موضوعيه الرئيسين، ففي موضوع "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر" قدم المشاركون في الجلستين الأوليين عروضا تحليلية ونقدية عن الحرية في الإنتاج الفكري والفلسفي العربي المعاصر.. ونوقشت من خلالها أفكار وطروحات حسن حنفي وراشد الغنوشي والمنصف المرزوقي، مثلما جرى تناول مفهوم الحرية في الفكر الفلسفي العربي عموما. أما الجلسة الثالثة فتناولت في هذا الموضوع مفهوم الليبرالية والنزعة الليبرالية في المقاربات الفكرية العربية الحديثة للحرية.. وخصصت الجلسة الرابعة لمناقشة البيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية العربية وتأثيرها في الحرية، وتناولت إحدى أوراق هذه الجلسة حرية المرأة في المغرب في ضوء الجدل بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية. أما في الموضوع الثاني للمؤتمر الخاص بـ"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة"، فقد ركزت أوراق الباحثين في الجلسة الأولى على مناقشة إشكاليات التمدين والاندماج والاغتراب، وذهبت أغلب الأوراق باتجاه ينتقد السلبيات العديدة لمسار التمدين في الدول العربية والآثار الاجتماعية والثقافية لهذه السيرورة المشوهة.. وعلى منوال مشابه نسجت الأوراق المقدمة في الجلستين الثانية والثالثة على موضوع المدينة العربية، فناقشت ورقة قيمة الجوار في المدينة العربية المعاصرة وكيف تأثرت بنمط العمران والتمدين الذي تأسست عليه مدن جديدة.. وأخذت الجلسة الرابعة في موضوع "المدينة العربية" طابعا تقنيا، إذ طرحت أوراق الباحثين المشاركين فيها حوكمة المدن والمخططات التنظيمية للمدن العربية. ويضم برنامج المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية محاضرتين رئيستين إضافة إلى المحاضرة الأولى التي قدمها فهمي جدعان في اليوم الأول، إذ سيحاضر في اليوم الثاني الدكتور عزمي بشارة، فيما يقدم الدكتور عبدالرحمن رشيق محاضرة اليوم الثالث.. ويحضر المؤتمر عدد من الضيوف المميزين من الباحثين والأكاديميين العرب. وخلال عشر جلسات في كل واحدة من موضوعي المؤتمر، يقدم نحو 61 باحثا عربيا أوراقا بحثية 61 ورقة بحثية.. ويشهد اليوم الأخير من المؤتمر حفل توزيع جوائز الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية التي تنافس فيها باحثون من مختلف الدول العربية ضمن الموضوعين المختارين للمؤتمر ذاتهما. يذكر ان المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اصبح بعد أربع دورات سابقة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية.. ويشمل برنامج المؤتمر مساهمات باحثين من 13 بلدًا عربيًا هي: مصر، المغرب، الجزائر، قطر، سوريا، السودان، تونس، فلسطين، لبنان، السعودية، الكويت، العراق، موريتانيا.. ويسجل الباحثون الشباب حضورًا لافًتا في المساهمة بأوراق بحثية في المؤتمر، كما يقدم أساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا مساهمات نوعية أيضا، مما يوفر منصة متفردة للوقوف على تطورات البحث واتجاهاته في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وكان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قد خصص مؤتمره السنوي الأول للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي عقد في الدوحة في مارس 2012 لموضوعي: "الهوية واللغة في الوطن العربي" و"من النمو المعاق إلى التنمية المستدامة: أي سياسات اقتصادية واجتماعية للأقطار العربية؟"، وفي الدورة التالية في عام 2013 في الدوحة اختار المركز العربي مناقشة موضوعي: "جدليّة الاندماج الاجتماعي وبناء الدّولة والأمّة في الوطن العربيّ"، و"ما العدالة في الوطن العربيّ اليوم؟". وعقد المركز المؤتمر السنوي الثالث للعلوم الاجتماعية والإنسانية في تونس في عام 2014، وناقش موضوعي: "أطوار التاريخ الانتقالية، مآل الثورات العربيّة" و"السياسات التنموية وتحدّيات الثورة في الأقطار العربيّة". واحتضنت مدينة مراكش في المغرب الدورة الرابعة من المؤتمر وتناولت موضوعي "أدوار المثقفين في التحوّلات التاريخية" و"الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي".
292
| 12 مارس 2016

ينطلق اليوم بفندق الريتز كارلتون المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية،في دورته الخامسة وينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الفترة 12 — 14 مارس. ويعد المؤتمر من أهمّ الأنشطة العلمية في الأجندة السنوية للمركز، وفضاء متفردا يجمع الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية ويطرح الإشكاليات البحثية الرئيسية التي تواجه المجتمعات العربية. ويشهد المؤتمر توزيع الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2015/2016 على الفائزين. يضم برنامج المؤتمر ثلاث محاضرات رئيسية يلقيها كل من الدكتور عزمي بشارة والدكتور فهمي جدعان والدكتور عبد الرحمن رشيق، ويحضر المؤتمر عدد من الضيوف المميزين من الباحثين والأكاديميين العرب. ستقدم في جلسات المؤتمر هذا العام 61 ورقة بحثية ضمن الموضوعين المختارين، وهما:"سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". و دأب المركز العربي من أجل تعزيز الثراء الأكاديمي للمؤتمر على اقتراح موضوعين على الباحثين للمساهمة بأوراق بحثية فيهما، وهما الموضوعان اللذان يجري التنافس فيهما أيضا في الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. وأصبح المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعد أربع دورات سابقة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويشمل برنامج المؤتمر مساهمات باحثين من 13 بلدًا عربيًا: مصر، المغرب، الجزائر، قطر، سورية، السودان، تونس، فلسطين، لبنان، السعودية، الكويت، العراق، موريتانيا. ويسجل الباحثون الشباب حضورًا لافًتا في المساهمة بأوراق بحثية في المؤتمر، كما يقدم أساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا مساهمات نوعية. 10 جلسات و20 موضوعا ويعقد المؤتمر 10 جلسات خلال ايام انعقاده حيث تتناول الجلسة الاولى قضية الحرية في الفكر العربي المعاصر. وتناقش موضوع الحرية في الإنتاج الفكري والفلسفي العربي المعاصر) ويرأس الجلسة: ياسر سليمان معالي ويتحدث فيها علي الصالح مُولَى: الحرية في كتابات راشد الغنّوشي: بحث في النسق والأصالة وشاكر الحوكي: مسألة الحرية عند راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي ونابي بوعلي: الطبيعة التطورية لمفهوم الحرية من خلال مشروع التراث والتجديد لحسن حنفي. وفي الجلسة الاولى الموازية حول المدينة العربية وتحديات التمدين في المجتمعات العربية تناقش موضوع المدينة العربية وإشكاليات التمديُن والاندماج والاغتراب وترأس الجلسة: هند المفتاح ويتحدث فيها عبدالله حمد الدليمي: معالجة بعض إفرازات ظاهرة التمدين على تطور لغة الخطاب الديني في المجتمع وإدريس مقبول: المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيو — لسانية في أعراض مرض التمدّن وفتحي محمد مصيلحي: المدينة العربية وتحديات التمدين في مجتمعات متحولة: القاهرة الكبرى نموذجًا. الحرية الفكرية وتناقش الجلسة الثانية الحرية في الإنتاج الفكري والفلسفي العربي المعاصر ويرأس الجلسة: عبد الله محمد الجسمي ويتحدث فيها عبد الرزاق بلعقروز: حرية المفهوم الفلسفي في الفكر العربي المعاصر: بحث في شروط إمكان العقل الحر والمنجي السرباجي: ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟ عبد اللطيف المتدين: الحريات الفردية في عالم متغير: الفرد ضد المجتمع.وتناقش الجلسة الموازية قضية التغيرات المورفولوجية في المدينة العربية المعاصرة ويرأس الجلسة: يوسف العبدالله ويتحدث فيها نورية سوالمية: قيمة الحوار في المدينة العربية المعاصرة: دراسة سوسيو — أنثروبولوجية للعلاقات الاجتماعية بين الجيران في حي الهضاب بمدينة أرزيو بوهران والكبير عطوف: التمدين والهجرة والتحولات الاجتماعية في الدار البيضاء في ظلّ إكراهات الماضي وتحديات الحاضر: 1912 — 2014 وعبدوتي محمد أحمد: مسارات التحولات في عاصمة عربية فقيرة ومآلاتها: دراسة حالة نواكشوط. الليبرالية.. مقاربات وتناقش الجلسة الثالثة قضية الليبرالية في مقاربات الفكر العربي الحديث للحرية ويرأس الجلسة: منير كشو ويتحدث فيها رجا بهلول: الحرية ومعوقات الفعل: التأسيس لمفهوم ليبرالي للحرية في الفكر العربي ومهند مصطفى: سياسة الاعتراف والحرية: سجال وإطار نظري تحت طائلة السياق العربي وثناء فؤاد عبد الله: الحرية الليبرالية في السياق العربي وتناقش الجلسة الموازية موضوع المدينة العربية وإشكالية التهميش والاقصاء ويرأس الجلسة: عبد الله بادحدح ويتحدث فيها حسن ضايض؛ بوشتى الخزان: الدينامية المجالية لمدينة فاس وتعدّد أشكال الإقصاء والتهميش والهادي بووشمة: المدينة العربية وأزمة التحضر: مقاربة سوسيو — مجالية في علاقة العشوائيات الحضرية بالهجرات القبلية وهاني خميس أحمد عبده: المدن المُسيّجة في المجتمع المصري خلال الألفية الجديدة بين النمو الحضري والمكانة الاجتماعية: دراسة سوسيولوجية. بيئة الحريات وتناقش الجلسة الرابعة موضوع الحرية في البيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية العربية ويرأس الجلسة الدكتور محمد المسفر ويتحدث فيها عبد الله محمد الجسمي حول: الحرية والثقافة وجواد رضواني حول: هل يمكن الحديث عن حرية فكرية عربية في إطار وجود ثقافة عربية حتمية؟ وإبراهيم القادري بوتشيش حول: حرية المرأة بالمغرب في ضوء الجدل والتدافع بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية وتناقش الجلسة الرابعة الموازية قضية حوكمة المدن والمخططات التنظيمية للمدن العربية ويرأس الجلسة: عبد الله باعبود ويتحدث فيها أحمد مالكي: حوكمة المدن وإشكالية التخطيط الحضري: حالة مخططات التهيئة بالمغرب وأحمد حضراني: حوكمة المدن وإشكالية البطء المؤسسي للمخططات التنظيمية للمدن العربية: حالة مدينة الدار البيضاء بالمغرب وصالح النشاط: حوكمة المدينة من خلال فاعلية التخطيط الإستراتيجي ونجاعة التنفيذ المندمج. حرية الاعتقاد وتناقش الجلسة الخامسة الحرية الدينية وحرية المعتقد ويرأس الجلسة: عبد الوهاب الأفندي ويتحدث فيها معتز الخطيب: الحرية الدينية وقتل المرتد: مدخلٌ لإعادة التفكير في الاجتهاد الفقهي وسعيد أقيور: حرية المعتقد في العالم العربي من السجال الفكري إلى التنزيل الدستوري ومحاسن عبد الجليل: الحرية في التمثّلات الاجتماعية، بين الثقافة العالِمة والثقافة الشعبية: من صلب الحلاج إلى إعدام محمود محمد طه وتناقش الجلسة الموازية موضوع المدينة العربية والتحوّلات الاجتماعية — الاقتصادية وترأس الجلسة: إيليا زريق ويتحدث فيها د. كلثم علي الغانم؛ وعبد الله بادحدح: تقييم الأثر الاجتماعي للتنمية العمرانية المكثفة: دراسة مقارنة ما بين سكان المباني العالية والمنخفضة في قطر وخليفة عبد القادر: إعادة تشكل البنيات الاجتماعية في مدن الصحراء الجزائرية وعبدالعزيز حسن البصير: أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية في البناء الاجتماعي للمدن السودانية: دراسة حالة مدينة ودمدني. بين الحداثة والنهضة وتناقش الجلسة السادسة موضوع الحرية ضمن سؤال الحداثة والنهضة وترأس الجلسة: نجمة حجار ويتحدث فيها عبد الوهاب الأفندي: ثمن الحرية: اقتصاديات الحرية والتحرّر في صراعات الحداثة العربية وسامر عكاش: «شريعة الحريّة »: الحريّة والتمدّن الجديد في التجربة النهضويّة وعبد الرحيم العلام: التّأسيس للحريّة من خلال كشف نقائضها: مقاربة في متن لا بويسي والكواكبي وتناقش الجلسة الموازية التغييرات المرفولوجية في المدينة العربية المعاصرة ويرأس الجلسة: خالد زيادة ويتحدث فيها هتون أجواد الفاسي: تحديات المحافظة على هوية الحرمين المقدسين ومهدي مبروك: نفايات المدينة في سياق تحول ديمقراطي: إستراتيجيات الهوية والمجال؛ دراسة حالة مدينة جربة والحسن المحداد، لكبير أحجو، محمد جداوي: تحولات المدينة العربية وتحديات المنظومات المائية الحضرية: حالة مدن ساحل المحيط الأطلسي العربي بالمغرب وموريتانيا وتناقش الجلسة السابعة الحرية والمشروعية السياسية والتحرّر الوطني ويرأس الجلسة: محجوب الزويري ويتحدث فيها محمد الحاج محمد: دلالة مقصد الحرية على المشروعية السياسية في الإسلام.
1154
| 11 مارس 2016

صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة "ترجمان"، الترجمة العربية للطبعة الثانية من كتاب " نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع"، من تحرير: تيم دان، ميليا كوركي، وستيف سميث، وترجمة: ديما الخضرا. ويقع الكتاب الذي صدر عن دار مطبعة جامعة أكسفورد للنشر في 863 صفحة من القطع الكبير. وقال خالد وليد محمود رئيس قسم الإعلام في معهد الدوحة للدراسات العليا إن الكتاب يشتمل على مقدمة و15 فصلًا لإسهامات أبرز وأهم المفكرين في حقل العلاقات الدولية، موزعة كالآتي: التنوعية والتخصصية في نظرية العلاقات الدولية، العلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية، النظرية المعيارية في العلاقات الدولية، الواقعية الكلاسيكية، الواقعية البنيوية، الليبرالية، الليبرالية الجديدة، المدرسة الإنجليزية، الماركسية والنظرية النقدية، البنائية، النظرية النسوية، ما بعد البنيوية، ما بعد الاستعمارية، النظرية الخضراء، نظرية العلاقات الدولية والعولمة، وآخر الفصول جاء بعنوان: أما زال في الإمكان اعتباره تخصصًا بعد كل هذه المناقشات؟. لقد جُمع هذا الكتاب المهم بطريقة تتيح للدارسين والمعلّمين والطلاب والباحثين في حقل العلوم السياسة والعلاقات الدولية على وجه الخصوص أن يقرأوا الفصول كأنها مستقلة بحد ذاتها. حيث تم إثراء الكتاب بمروحة واسعة من الوسائل التعليمية التي تساعد الباحث أو الطالب في الإبحار في المادة النصية وتقوية معلوماته في نظرية العلاقات الدولية. وقد تم تزويد الطالب بمجموعة من الأسئلة التي طُوِّرت بعناية فائقة لتساعده في تقييم استيعابه للمواضيع الأساسية، كما يمكنه استخدام هذه الأسئلة كأساس للنقاشات التي تُطرح في الحلقات الدراسية، وكذلك للواجبات الدراسية والأبحاث والتقارير والمقالات التي يُطلب من الطلبة القيام بها خلال الفصل الدراسي. وأضيف إلى ذلك قوائم من القراءات كدليل إرشادي لاكتشاف المزيد عن القضايا المطروحة ضمن كل موضوع في الفصل، ولتساعد أيضًا في تحديد الأدبيات الأكاديمية الرئيسية للمجال. لا شك أن أهمية اقتناء هذا الكتاب "الموسوعي" في مجاله، تزداد عند النظر إلى أهمية المؤلفين والمحررين، وهم أساتذة وخبراء في تخصص العلاقات الدولية يعملون في أهم الجامعات العالمية المرموقة، ولكون هذا الكتاب صادرًا عن أبرز دور النشر العالمية العريقة وهي " دار جامعة أكسفورد للنشر". كما يُقدر للمترجم المجهود الكبير الذي بذله لإخراجه للقارئ العربي ولتوضيح الكثير من النقاط التي كانت غامضة حول التفكير التقليدي في نظرية العلاقات الدولية ومقارباتها. حيث ركزّت دراسة العلاقات الدولية تقليديًا على تحليل أسباب الحرب وظروف السلام، ولكن ليست أسباب الحرب والسلام هي المسائل الوحيدة التي تحتل موضوع الاهتمام وليست الأسئلة الوحيدة التي تسبب الشقاقات والخلافات في دراسة العلاقات الدولية اليوم كما جاء في هذا الكتاب، حيث أثارت أنواع مختلفة من المسائل الحيرة بشكل متزايد لدى الطلبة والباحثين المعاصرين في العلاقات الدولية. دليل القارئ يقوم دليل القارئ الموجود في بداية كل فصل بالتمهيد للمواضيع والقضايا التي ستتم مناقشتها لاحقًا في الفصل، كما يشير إلى نطاق تغطيته لكل من المواضيع في الفصل. يلي ذلك التحليل وهو القسم الرئيسي من الفصل، حيث يقوم فيه المساهمون في إعداد الكتاب بدراسة الأفكار المحدِّدة للنظرية المطروحة، بالإضافة إلى بحثهم في الفجوات الرئيسية المتضمنة في كل واحد من المواقف. وفيما يعترف هذا الكتاب بأن هناك قضايا فلسفية معيّنة يجب عدم تهميشها، فإنه يعترف أيضًا بأهمية استعراض تطبيق النظرية على المشاكل السياسية الواقعية. فتقوم دراسات الحالات بتسهيل المناظرات والمناقشات الصفية، وتساعد في الربط بين النظرية والتطبيق. كما جرى الاعتماد على مراجعات لكتب أو مقالات رئيسية لتعريف الطلبة بالأعمال البارزة في المجال، وتوسيع معارفهم بالأدبيات الفكرية المتاحة.
2222
| 09 مارس 2016
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة

أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أنه اعتبارا من 25 فبراير 2026، فإن أغلب القادمين لزيارة المملكة المتحدة (باستثناء المواطنين البريطانيين والإيرلنديين، بمن فيهم...
9142
| 13 فبراير 2026
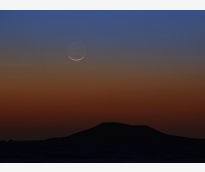
يترقب المسلمون في العالم حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، ومتى سيكون يوم الرؤية (التحري) لتحديد أول أيام الشهر الفضيل...
8804
| 13 فبراير 2026

أعلنت 3 دول أن يوم الخميس المقبل 19 فبراير، سيكون أول شهر رمضان . وإلى جانبسلطنة عمان، أعلنت كل من تركيا و سنغافورة...
7392
| 13 فبراير 2026

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
الأكثر رواجاً
- 1 مصر.. إصابة 75 شخصاً بـ "العمى الجماعي" وتحويل 10 مسؤولين للمحاكمة
كشفت تحقيقات للنيابة في مصر عن إصابة 75 مريضاً بـالعمى الجماعي، عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، في...
6030
| 13 فبراير 2026
- 2 وزير التربية والتعليم: جائزة قطر للتميز العلمي منصة وطنية لتجسيد التعليم كخيار إستراتيجي لبناء الإنسان
أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن جائزة قطر للتميز العلمي تحمل هذا العام دلالة...
5148
| 15 فبراير 2026
- 3 تعديل قانوني بتنظيم قيد المواليد والوفيات
صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل وضمّ عدداً من المراسيم والقوانين وتعديلات القوانين والقرارات الوزارية. في القانون رقم 1...
2170
| 13 فبراير 2026



