رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
2903
جابر الحرميمدرسون غير مؤهلين.. وطلبة ضائعون
يعاني قطاع التعليم عندنا من فوضى اسناد المقررات والمواد التدريسية إلى مدرسين ومدرسات غير مؤهلين علميا وتربويا للتعامل مع الطلاب، خاصة في المراحل التعليمية الأولى، والسعي لإلصاق تدريس مقررات إلى مدرسين ومدرسات هم اساسا خريجو تخصصات اخرى غير التي يقومون بتدريسها!
وعلى الرغم من التطرق السابق لمثل هذه الظواهر السلبية في مدارسنا، فإن الوضع - وللاسف الشديد - مازال على حاله، دون ان نجد تفاعلا من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، ووقف «مهزلة» اسناد تدريس المواد إلى غير المتخصصين، خاصة تلك التي يرفض اساسا من تسند إليه هذه المهمة القيام بها، الا تحت « التهديد» وقفه عن العمل، أو إحالته إلى المساءلة.
لايكفي ان وزارة التربية في وقت من الاوقات عمدت إلى ارغام خريجي كليات الانسانيات والشريعة والعلوم للعمل كمدرسين، على الرغم من ان الغالبية العظمى من هذه الشريحة ليست لديها الرغبة اساسا في التدريس، وليس هذا فقط بل ان خريجي هذه الكليات لم يؤهلوا ليكونوا مدرسين، فالتدريس بحاجة إلى تخصص وفن واسلوب في التعامل يختلف عن العمل في الوظائف الحكومية الاخرى، خاصة في المراحل التأسيسية الأولى، وهي المرحلة الابتدائية التي هي بأمس الحاجة إلى مدرسين ومدرسات متخصصين في المواد، ومؤهلين تربويا ونفسيا واجتماعيا للتعامل مع هذه الشريحة، التي هي في بداية حياتها العلمية، مما يتطلب تأسيسا صحيحا.
نماذج مختلفة تم تحويلها من المجال الذي تقوم بتدريسه أو متخصصة به الى مجالات اخرى، فهناك مثلا مدرسة تعمل منذ اكثر من عشر سنوات في تدريس المادة الشرعية، وهي خريجة شريعة، لكن تم تحويلها لتدريس مادة اللغة العربية، دون سابق انذار، أو سبب مقنع، وان كانت جميع الاسباب اصلا غير مقنعة.
هذه المدرسة رفضت في البداية الانصياع لهذه الاوامر، ولكن في النهاية انصاعت وهي مرغمة، فماذا يمكن ان ينتظر من عطاء أو ابداع من هذه المدرسة، التي اشعر انها تذهب إلى المدرسة صباح كل يوم، كأنها تساق إلى سجن يسمى «المدرسة»، تقضي ساعات فيه وهي بانتظار لحظة الانصراف.
السبب الذي سيق لتحويل هذه المدرسة من تدريس مادة الشرعية، التي هي اساسا خريجة هذا القطاع، ومرتاحة اليه جدا، ومبدعة في عملها، دون تقصير طوال السنوات العشر...، السبب هو ان هناك نقصا في مدرسات اللغة العربية! والشيء الغريب ان « طوابير» الفتيات خريجات اللغة العربية ينتظرن التعيين منذ سنوات، وليس هذا فقط بل ان الجامعة قامت بإغلاق تخصص اللغة العربية، لان هناك اكتفاء، ولكن يظهر ان الأمر غير ذلك.
انني اتساءل كيف يمكن خلق بيئة للابداع والتميز في قطاع التدريس، اذا ما كان المنتسبون إلى هذا القطاع مرغما بعضهم، فيما الآخر يعمل بعيدا عن تخصصه، وتبقى فئة هي التي تحترق ألما كونها لا تستطيع ان تفعل شيئا للارتقاء بالعملية التعليمية، في أوضاع يسودها الإحباط في جوانب مختلفة؟!
فلا غرابة اذن من التحول الكبير لأولياء الامور نحو المدارس الخاصة، وتحمل الاعباء المالية الكبيرة من اجل الحاق ابنائهم في تلك المدارس، فما الذي يدفع ولي امر إلى دفع الآلاف سنويا في سبيل الحاق ابنه في مدرسة خاصة، اذا ما كان التعليم الحكومي لا يقل مستوى بالنسبة لخريجيه في المدارس الخاصة؟!
ان فوضى اسناد المقررات والمناهج إلى كل من يحمل صفة مدرس أو مدرسة، دون النظر في تخصصاته، يجب ان تتوقف، وان يعاد النظر في هذه القضية، وان يتم التركيز في اسناد المواد إلى المتخصصين، ونركز بالدرجة الأولى على المرحلة الابتدائية التي اهملت بصورة كبيرة، حتى اصبحت ملاذا للبعض ممن يرغب في الحصول على راتب آخر الشهر، دون النظر إلى كفاءته العلمية والمهنية والتدريسية والتربوية.
اننا نأمل خلال الاعوام الدراسية القادمة، بدءا من العام المقبل ان تختفي مثل هذه الظواهر التي تعمل على هدم العملية التعليمية، وتمثل تراجعا في المسيرة التعليمية، في بلد يستنهض كل قدراته وإمكاناته، ويسخرها من أجل التعليم.
هذا ما نأمله حرصا على تعليم نوعي جيد ومرض في مجتمعنا.
اقرأ المزيد
 اعترافات
اعترافات
وحدها قطر من تلتفت لأوضاعنا العربية الغارقة في الأزمات والعواصف السياسية التي لا يبدو لها مخرج قريب للأسف،... اقرأ المزيد
12
| 21 يناير 2026
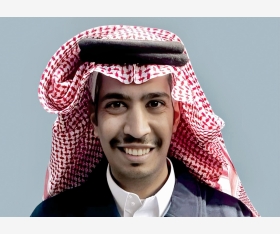 دعائم البيت الخليجي
دعائم البيت الخليجي
المتأمِّل الفَطِن في المسار العام للسياسة السعودية اليوم يجد أنه مسارٌ مرنٌ ومنضبطٌ في آنٍ معًا؛ مرنٌ من... اقرأ المزيد
15
| 21 يناير 2026
 راحة المسافرين.. نحو تجربة سفر أكثر سهولة
راحة المسافرين.. نحو تجربة سفر أكثر سهولة
يُعد مطار حمد الدولي أحد أبرز المعالم الحضارية لدولة قطر، نموذجًا متقدمًا للمطارات المدنية الحديثة على مستوى المنطقة... اقرأ المزيد
9
| 21 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
قطر.. التزام ثابت بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي

رأي الشرق
-
غزة على حافة البقاء

هديل رشاد
-
خذلتنا الأنوار وبقيت غزة

عادل الحامدي
-
اعترافات

ابتسام آل سعد
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 إبراهيم دياز قتل طموحنا
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
1878
| 20 يناير 2026
- 2 أهمية الدعم الخليجي لاستقرار اليمن
بعد أسابيع عصيبة عاشتها بلادنا على وقع الأزمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما رافقها من إجراءات أحادية قام بها المجلس الانتقالي ( المنحل ) أربكت المشهد السياسي والأمني، ومن الواضح أن اليمن يتجه اليوم بعزم وإرادة، نحو مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.هذه الفترة رغم قصر مدتها إلا أنها كانت حافلة بالأحداث التي شكلت اختبارا صعبا لتماسك الدولة وقدرتها على الصمود، وأيضا لحكمة القيادة السياسية في إدارة لحظة شديدة الحساسية، داخليا وإقليميا.إن خطورة ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة لم يكن مقتصرا على تعميق الانقسام الاجتماعي أو إثارة الحساسيات المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى تهديد وحدة البلد ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، وإضعاف جبهة الشرعية برمتها في لحظة لا تحتمل فيها البلاد أي تصدّعات إضافية. هذا الوضع الصعب مثل تحديا حقيقيا كاد أن ينعكس سلبا على المسار السياسي العام، وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوجودية التي لا تزال قائمة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي وانقلاب جماعة الحوثي. وخلال هذه الأزمة، برز بوضوح مدى أهمية الموقف الدولي، الذي ظل رغم كل التعقيدات قائما على مقاربات موضوعية ومسؤولة تجاه الملف اليمني. فقد حافظ المجتمع الدولي على موقف موحد داعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وهو مكسب سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية كان مهددا بالتآكل نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة. ومن المهم التأكيد على أن الحفاظ على هذا الدعم والزخم الدولي المساند للحكومة لم يكن نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي منظم وواع، أدرك حساسية المرحلة وخطورة أي انزلاق غير محسوب نحو الصراع داخل مظلة الحكومة، مرسخا قناعة دولية بضرورة دعم الشرعية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على استعادة الدولة وصون الاستقرار. اليوم تمضي القيادة السياسية والحكومة في مسار تصحيحي شامل، يستهدف احتواء تداعيات الأزمة ومعالجة جذورها، وهو مسار يحظى بتأييد شعبي واسع، ودعم كامل وواضح من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن دعم أشقائنا في مجلس التعاون بقيادة السعودية فإنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساندة ظرفية مرتبطة بأحداث معينة، بقدر ما هو ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي، وتشابك المصالح بين اليمن ومحيطه الخليجي. نعم، إن أهمية الدعم الخليجي لليمن تتجاوز بطبيعتها البعد الاقتصادي أو الإنساني، لتتصل مباشرة بجوهر المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة. فاستقرار اليمن والاستثمار في دعم مؤسساته الشرعية يظل الخيار الأكثر حكمة لضمان أمن جماعي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة. ولكي تتمكن الحكومة ومجلس القيادة من استعادة زمام المبادرة، وتعزيز حضور الدولة، فإن اليمن أحوج ما يكون اليوم إلى موقف خليجي داعم على مختلف المستويات، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، لأن هذا الدعم يشكّل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار الأوضاع، واستعادة الثقة، وانتشال اليمن من أزماته المتراكمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المعالجات التي لا تنفذ إلى جوهر المشكلات التي تعاني منها بلادنا. وعلى المستوى الداخلي، شكلت الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تذكير جميع المكونات والقوى السياسية بأولويات اليمن الحقيقية، وبالمخاطر الأساسية المحدقة به. فالصراع الجانبي، وتغليب الحسابات الضيقة، لا يخدم سوى مشاريع التقسيم والإنفلات ومشروع الحوثي، الذي لا يزال التهديد الأكبر لمستقبل اليمن، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع للتحرك وفق برنامج واضح، يعيد ترتيب الأولويات، ويضع إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في صدارة الأهداف، وصولا إلى مرحلة لا يكون فيها اليمن رهينة للسلاح أو المشاريع الخارجة عن الدولة، وإنما دولة مستقرة، شريكة لمحيطها، وقادرة على إدارة شؤونها بإرادة وطنية جامعة.
1752
| 14 يناير 2026
- 3 ضحكة تتلألأ ودمعة تختبئ
بين فرحة الشارع المغربي وحسرة خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، جاءت ليلة نصف النهائي لتؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والقتال على أرض الملعب. قدمت مصر أداءً مشرفًا وأظهرت روحًا قتالية عالية، بينما كتب المغرب فصولًا جديدة من مسيرته القارية، مؤكدًا تأهله إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية مع نيجيريا امتدت إلى الأشواط الإضافية وحسمت بركلات الترجيح. المباراة حملت طابعًا تكتيكيًا معقدًا، اتسم بسرعة الإيقاع والالتحامات القوية، حيث فرض الطرفان ضغطًا متواصلًا طوال 120 دقيقة. المنتخب المغربي تعامل مع هذا الإيقاع بذكاء، فحافظ على تماسكه وتحكم في فترات الضغط العالي دون ارتباك. لم يكن التفوق المغربي قائمًا على الاستحواذ وحده، بل على إدارة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى. تجلّى هذا التوازن في الجمع بين التنظيم الدفاعي والقدرة على الهجوم المنظم. لم يغامر المغرب دون حساب، ولم يتراجع بما يفقده زمام المبادرة. أغلق اللاعبون المساحات وحدّوا من خطورة نيجيريا، وفي المقابل استثمروا فترات امتلاك الكرة لبناء الهجمات بهدوء وصناعة الفرص، ما منحهم أفضلية ذهنية امتدت حتى ركلات الجزاء. في لحظة الحسم، تألق ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي جزاء حاسمتين بتركيز وثقة، وهو ما منح المغرب بطاقة العبور إلى النهائي وأثبت حضوره في اللحظات المصيرية. على الصعيد الفني، يواصل وليد الركراكي تقديم نموذج المدرب القارئ للمباريات بإدارة متقنة، ما يعكس مشروعًا قائمًا على الانضباط والواقعية الإيجابية. هذا الأسلوب أسهم في تناغم الفريق، حيث أضاف إبراهيم دياز لمسات فنية ومهارات فردية ساعدت على تنويع الهجمات وصناعة الفرص، بينما برز أشرف حكيمي كقائد ميداني يجمع بين الصلابة والانضباط، مانحًا الفريق القدرة على مواجهة أصعب اللحظات بثقة وهدوء، وخلق الانسجام التكتيكي الذي ساعد المغرب على التقدم نحو ركلات الجزاء بأفضلية ذهنية واضحة. ولا يمكن فصل هذا الإنجاز عن الجمهور المغربي، الذي شكّل سندًا نفسيًا هائلًا، محولًا المدرجات إلى مصدر طاقة ودافع مستمر. كلمة أخيرة: الآن يستعد المغرب لمواجهة السنغال في النهائي، اختبار أخير لنضج هذا المنتخب وقدرته على تحويل الأداء المتزن والطموح المشروع إلى تتويج يليق بطموحات أمة كروية كاملة.
1446
| 16 يناير 2026




