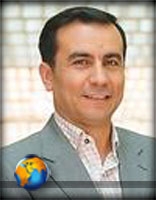رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
877
خالد الحروبصادق جلال العظم.. تكريم مُستحق
يستحق صادق جلال العظم، الكاتب والمفكر السوري، أن نحتفي قبل ومع احتفاء الألمان به هذا الأسبوع في مدينة فيمار، ويُمنح بها في احتفال مهيب في قلعتها، ميدالية الشاعر الألماني الكبير "جوته"، ابن مدينة فيمار وأحد أهم مشاهيرها. ليس هذا غريبا على قلم العظم الذي اجترح الشجاعة وسار ضد التيار ولم ينجرف وراء الأدلجة الشعبوية طيلة سنوات طويلة من الكتابة والفكر.
لم يتوقف هذا العقل المفكر عن الإنتاج والسجال وخوض معارك التحديث والنقد طيلة نصف قرن، وفي اللحظات شديدة الاختبار التي يواجهها كل مثقف وكاتب، وتضغط عليه أصناف الإكراهات والمساومات العديدة، وقف العظم مع ضميره الفكري، وصرح عنه من دون مواربة. في نقده للهزيمة "النقد الذاتي للهزيمة"، نفض الكسل التحليلي التآمري الذي كان (وما زال) يلقي باللائمة على الغرب والآخرين ويعلق على مشجب الخارج كل الهزائم والتخلف الذي نرتع فيه. في نقده لسيطرة الدين على الفضاء العام وتفشي "ذهنية التحريم" كسر الخطوط الحمر وقدم نقدا من داخل منظومة العقل الديني. وفي نقده لنمط آخر من الكسل الفكري أنتجته مقولات "الاستشراق" الإدوارد سعيدية، قال إن شطب عمل الاستشراق والمستشرقين دفعة واحدة، وهو النتيجة التي لم يردها أو يدعو إليها سعيد أساسا، يعني تعزيز فكر المؤامرة، وتوفير عتاد رخيص وكسول للفكر الرجعي والظلامي كي يتمترس وراءه في نقد كل شيء له علاقة بالغرب. إنه "استشراق معكوس" بحسب عنوان مقاربته في نقد "الاستشراق" لسعيد. وعندما يتعلق الأمر بحرية الفكر والتفكير والنقد ينطلق العظم ليقف في النقطة القصوى من الحريات، وليكون ذات تاريخ واحدا من الأسماء العربية النادرة التي وقعت بياناً أدان فتوى الخميني الداعية لقتل الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي.
لم تتكلس ثقافة العظم عند القناعات اليسارية التي ظلت تشكل الدافعية الأخلاقية والإنسانوية في مقارباته، ولم يقع أسيرا لأيديولوجيا تتجمد عند مقولاتها أو حتمياتها ولا تعترف بحركة التاريخ. بل عن اليسار العربي نفسه يقول العظم إنه تفرع بعد عقود طويلة إلى ثلاث مجموعات، إحداها البقية الباقية من الأحزاب الماركسية العربية التي تفتت إلى درجة قريبة من الاختفاء، وثانية احتفظت ببرامج أحزاب ماركسية الحرب الباردة واقتربت في العقدين الأخيرين من الإسلام السياسي الجهادي، وثالثة وهي الأكثر عددا والأوسع حضورا تراجعت إلى خط الدفاع الثاني نحو إحياء المجتمعات المدنية وتبني خطابات ديمقراطية في مواجهة المد الأصولي والرجعي. وكذا يرى العظم الإسلاموية السياسية التي تتفرع بدورها إلى إسلام سياسي تستغله الدول وآخر تستغله التنظيمات، وأسهم ذلك كله في انبعاث الطائفية والتعصب.
فرح العظم بالربيع العربي واحتفى به فكريا ووجدانيا وسياسياً، حيث رأى فيه عودة السياسة إلى الناس وعودة الناس إلى السياسة بعد عقود طويلة من الجمود والاستبداد. رفض الاستقرار الظاهري الذي يتفاخر بإحلاله الاستبداد واسماه "استقرار القبور". رأى في لحظة "ميدان التحرير" عودة التاريخ إلى المنطقة، وظل متفائلا حتى اللحظة، ورغم كل السوداوية التي هبطت على الثورة الأقسى في بلاده سوريا. وعن سوريا نفسها كتب ونطق بأجرأ ما قد ينطق به مثقف في موقعه، وعبر عما كان يجول في عقول الكثيرين، لكن الخشية من الاتهام بالطائفية أسكتتهم. وعبر في محاضرة شهيرة له عما أسماه "العلوية السياسية" والتي تعني وقوع سوريا الطويل في قبضة نظام اشتغل على إعادة إنتاج البلد العريق وفق نظام اعتمد الطائفية العلوية وقوض بها الأكثرية السنية، واستأثر بالحكم، والاقتصاد، والمال، والأمن عبر فئة زبائنية أقلوية.
انتقد العظم التوجهات الغربية التي تصاعدت بعد الثورة السورية بزعم الدفاع عن الأقليات في سوريا، وقال إن سوريا وتاريخها لم يشهدا أي حروب أهلية إثنية أو طائفية تستدعي هذا النفير المزيف للدفاع عن الأقليات، وكأن الأكثرية السنية تنتظر اللحظة السانحة لتبطش بالجميع. على العكس من ذلك، قال إن الشريحة الأعرض التي واجهت ولا تزال تواجه الحد الأقصى من القتل والدم والتهجير والتدمير هي الأكثرية السنية. لأي كان أن يختلف مع العظم في تحليله وتقديمه لمفهوم "العلوية السياسية" وأن يوجه له النقد على ذلك ويناقشه، لكن تجاوز الاختلاف والنقد المقبول إلى الاتهام بالطائفية والشحن الطائفي، كما حملت بعض الردود على العظم بسبب فكرة "العلوية السياسية" يتحول إلى نكتة سمجة. يقف العظم في أرضية إنسانوية صلبة متجاوزة للإثنيات والطوائف والأديان، ومن يحشره في "الطائفة السنية السورية" يكشف ضحالة الوعي، تثير التساؤل حول مدى الفهم والإدراك العميق عند مُطلق الاتهام.
في سنوات الهزيع الأخير من القرن الماضي وبدايات القرن الحالي انخرط العظم في السجال العريض حول العولمة، وكان من المفكرين العرب القلائل الذين أثارتهم هواجسها، ومنحنياتها، وتهديمها للحدود القومية، وتسويتها الأرض لارتحال رأس المال بلا قيود، ومعه أنماط وقيم وحيوات جديدة. كان من أوائل من لاحظوا أن الجوهري في العولمة الحديثة وما يجعلها مفترقة عما سبقها من عولمات هو في ارتحال مراكز الإنتاج، وليس ارتحال رأس المال فحسب. رأس المال لم يتوقف عن التعولم منذ أن عرف البشر السفر: من طريق الحرير، إلى الممرات البحرية التي طافت حول القارة السمراء، ثم وصولا إلى العالم الجديد كانت التجارة هي المعولم (السلمي) الأساسي للعالم، إلى جانب الحرب معولمة العسكري. في العولمة الغربية التي تفاقمت بعد انهيار الحرب الباردة تعولمت مراكز الإنتاج رغم أن معظمها بقي غربي المركز والسيطرة. صارت الرساميل الغربية تنتج في آسيا وإفريقيا وغيرها، بينما مقراتها الأساسية في الغرب.
بين فيمار وبرلين تولدت اللحظة اللوثرية التقدمية في الغرب، والتي أرادت تحرير الفرد من هيمنة الكهنوت الكاثوليكي. ترافقت لحظة الصعود تلك مع لحظة ارتكاس حاد في العالم الإسلامي وفي فهم الدين. يمكن أن نقول إن اللحظتين اختطا اتجاهين متعاكسين تماماً، حيث تكرست في الفضاء الإسلامي كاثوليكية إسلاموية، هي الأب الروحي للسلفيات المعاصرة، عبر إكمال هيمنتها على الفرد. مارتن لوثر أراد أن يحرر الفرد في علاقته مع الله، في تحد كبير للمؤسسة الكنسية الدينية، في حين أن الفرد في العالم الإسلامي كان يزداد خضوعا لسيطرة المؤسسة الدينية التي كانت قد اختطفت المباشرة بين الفرد والله، وقطعت طرق التواصل المباشر معه. اللحظة اللوثرية كانت تنهي المسيحية السياسية، واللحظة المناظرة لها عندنا كانت تؤسس للإسلام السياسي اللاحق. العظم يرى في هذا الأخير كارثة على السياسة والدين، ويدعو إلى لحظة لوثرية تعلي من شأن التدين العفوي والشعبي الذي حفل بالتعايش والإبداع طيلة قرون مديدة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
اعتراض أسطول الصمود العالمي

رأي الشرق
-
اعتراف دولي بدولة فلسطين.. ماذا بعد!

جاسم الشمري
-
الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا من أوروبا؟

د. أحمد القديدي
-
القيادة الإدارية في ضوء السيرة النبوية

لولوة المضاحكة
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 في وداع لطيفة
هناك لحظات تفاجئ المرء في منتصف الطريق، لحظات لا تحتمل التأجيل ولا المجاملة، لحظات تبدو كأنها قادمة من عمق الذاكرة لتذكره بأن الحياة، مهما تزينت بضحكاتها، تحمل في جيبها دائمًا بذرة الفقد. كنتُ أظن أني تعلّمت لغة الغياب بما يكفي، وأنني امتلكت مناعة ما أمام رحيل الأصدقاء، لكن موتًا آخر جاء هذه المرة أكثر اقترابًا، أكثر إيغالًا في هشاشتي، حتى شعرتُ أن المرآة التي أطل منها على وجهي اليوم ليست إلا ظلًّا لامرأة كانت بالأمس بجانبي. قبل أيام قليلة رحلت صديقتي النبيلة لطيفة الثويني، بعد صراع طويل مع المرض، صراع لم يكن سوى امتحان صعب لجسدها الواهن وإرادتها الصلبة. كانت تقاتل الألم بابتسامة، كأنها تقول لنا جميعًا: لا تسمحوا للوجع أن يسرقكم من أنفسكم. لكن ماذا نفعل حين ينسحب أحدهم فجأة من حياتنا تاركًا وراءه فراغًا يشبه هوة بلا قاع؟ كيف يتهيأ القلب لاستيعاب فكرة أن الصوت الذي كان يجيب مكالماتنا لم يعد موجودًا؟ وأن الضحكة التي كانت تفكّك تعقيدات أيامنا قد صمتت إلى الأبد؟ الموت ليس حدثًا يُحكى، بل تجربة تنغرس في الروح مثل سكين بطيئة، تجبرنا على إعادة النظر في أبسط تفاصيل حياتنا. مع كل رحيل، يتقلص مدى الأمان من حولنا. نشعر أن الموت، ذلك الكائن المتربّص، لم يعد بعيدًا في تخوم الزمن، بل صار يتجوّل بالقرب منا، يختبر خطواتنا، ويتحرّى أعمارنا التي تتقارب مع أعمار الراحلين. وحين يكون الراحل صديقًا يشبهنا في العمر، ويشاركنا تفاصيل جيل واحد، تصبح المسافة بيننا وبين الفناء أقصر وأكثر قسوة. لم يعد الموت حكاية كبار السن، ولا خبرًا يخص آخرين، بل صار جارًا يتلصص علينا من نافذة الجسد والذاكرة. صديقتي الراحلة كانت تمتلك تلك القدرة النادرة على أن تراك من الداخل، وأن تمنحك شعورًا بأنك مفهوم بلا حاجة لتبرير أو تفسير. لهذا بدا غيابها ثقيلاً، ليس لأنها تركت مقعدًا فارغًا وحسب، بل لأنها حملت معها تلك المساحة الآمنة التي يصعب أن تجد بديلًا لها. أفكر الآن في كل ما تركته خلفها من أسئلة. لماذا نُفاجأ بالموت كل مرة وكأنها الأولى؟ أليس من المفترض أن نكون قد اعتدنا حضوره؟ ومع ذلك يظل الموت غريبًا في كل مرة، جديدًا في صدمته، جارحًا في اختباره، وكأنه يفتح جرحًا لم يلتئم أبدًا. هل نحن من نرفض التصالح معه، أم أنه هو الذي يتقن فنّ المداهمة حتى لو كان متوقعًا؟ ما يوجعني أكثر أن رحيلها كان درسًا لا يمكن تجاهله: أن العمر ليس سوى اتفاق مؤقت بين المرء وجسده، وأن الألفة مع الحياة قد تنكسر في لحظة. كل ابتسامة جمعتها بنا، وكل كلمة قالتها في محاولة لتهوين وجعها، تتحول الآن إلى شاهد على شجاعة نادرة. رحيلها يفضح ضعفنا أمام المرض، لكنه في الوقت ذاته يكشف جمال قدرتها على الصمود حتى اللحظة الأخيرة. إنها واحدة من تلك الأرواح التي تترك أثرًا أبعد من وجودها الجسدي. صارت بعد موتها أكثر حضورًا مما كانت عليه في حياتها. حضور من نوع مختلف، يحاورنا في صمت، ويذكّرنا بأن المحبة الحقيقية لا تموت، بل تعيد ترتيب نفسها في قلوبنا. وربما لهذا نشعر أن الغياب ليس غيابًا كاملًا، بل انتقالًا إلى شكل آخر من الوجود، وجود نراه في الذكريات، في نبرة الصوت التي لا تغيب، في اللمسة التي لا تزال عالقة في الذاكرة. أكتب عن لطيفة رحمها الله اليوم ليس لأحكي حكاية موتها، بل لأواجه موتي القادم. كلما فقدت صديقًا أدركت أن حياتي ليست طويلة كما كنت أتوهم، وأنني أسير في الطريق ذاته، بخطوات متفاوتة، لكن النهاية تظل مشتركة. وما بين بداية ونهاية، ليس أمامي إلا أن أعيش بشجاعة، أن أتمسك بالبوح كما كانت تفعل، وأن أبتسم رغم الألم كما كانت تبتسم. نعم.. الحياة ليست سوى فرصة قصيرة لتبادل المحبة، وأن أجمل ما يبقى بعدنا ليس عدد سنواتنا، بل نوع الأثر الذي نتركه في أرواح من أحببنا. هكذا فقط يمكن أن يتحول الموت من وحشة جارحة إلى معنى يفتح فينا شرفة أمل، حتى ونحن نغالب الفقد الثقيل. مثواك الجنة يا صديقتي.
4503
| 29 سبتمبر 2025
- 2 الكلمات قد تخدع.. لكن الجسد يفضح
في ظهوره الأخير على منصة الأمم المتحدة، ملامحه، حركاته، وحتى ضحكاته المقتضبة لم تكن مجرد تفاصيل عابرة؛ بل كانت رسائل غير منطوقة تكشف عن قلق داخلي وتناقض صارخ بين ما يقوله وما يحاول إخفاءه. نظراته: قبل أن يبدأ حديثه، كانت عيونه تتجه نحو السلم، وكأنها تبحث عن شيء غير موجود. في لغة الجسد، النظرات المتكررة إلى الأرض أو الممرات تعكس قلقًا داخليًا وشعورًا بعدم الأمان. بدا وكأنه يراقب طريق الخروج أكثر مما يراقب الحضور، وكأن المنصة بالنسبة له فخّ، والسلم هو طوق النجاة. يداه: حين وقف أمام المنصة، شدّ يديه الاثنتين على جانبي البوديوم بشكل لافت إشارة إلى أن المتحدث يحتاج إلى شيء ملموس يستند إليه ليتجنب الارتباك، فالرجل الذي يقدّم نفسه دائمًا بصورة القوي الصلب، بدا كمن يتمسك بحاجز خشبي ليمنع ارتعاشة داخلية من الانكشاف. ضحكاته: استهل خطابه بإشارات إلى أحداث جانبية وبمحاولة لإضحاك الجمهور حيث بدا مفتعلًا ومشحونًا بالتوتر. كان الضحك أقرب إلى قناع يوضع على وجه مرتبك، قناع يحاول إخفاء ما لا يريد أن يظهر: الخوف من فقدان السيطرة، وربما الخوف من الأسئلة التي تطارده خارج القاعة أكثر مما يواجهه داخلها. عيناه ورأسه: خلال أجزاء من خطابه، حاول أن يُغلق عينيه لثوانٍ بينما يتحدث، ويميل رأسه قليلاً إلى الجانب ويعكس ذلك رغبة لا واعية في إبعاد ما يراه أو ما يقوله، وكأن المتحدث يحاول أن يتجنب مواجهة الحقيقة. أما مَيل الرأس، فكان إشارة إلى محاولة الاحتماء، أو البحث عن زاوية أكثر راحة نفسيًا وسط ارتباك داخلي. بدا وكأنه يتحدث إلى نفسه أكثر مما يخاطب العالم. مفرداته: استدعاؤه أمجاد الماضي، وتحدثه عن إخماد الحروب أعطى انطباعًا بأنه لا يتقن سوى لغة الحروب، سواء في إشعالها أو في إخمادها. رجل يحاول أن يتزين بإنجازات الحرب، في زمن يبحث فيه العالم عن من يصنع السلم. قناعه: لم يكن يتحدث بلسانه فقط؛ بل بجسده أيضًا حيث بدا وكأنه محاولة لإعادة ارتداء قناع «الرجل الواثق» لكن لغة جسده فضحته، كلها بدت وكأنها تقول: «الوضع ليس تحت السيطرة». القناع هنا لم يخفِ الحقيقة بل كشف هشاشته أكثر. مخاوفه: لعلها المخاوف من فقدان تأثيره الدولي، أو من محاكم الداخل التي تطارده، أو حتى من نظرات الحلفاء الذين اعتادوا سماع خطاباته النارية لكنهم اليوم يرون أمامهم رجلاً متردداً. لم نره أجبن من هذا الموقف، إذ بدا أنه في مواجهة نفسه أكثر من مواجهة الآخرين. في النهاية، ما قدّمه لم يكن خطابًا سياسيًا بقدر ما كان درسًا في لغة الجسد. الكلمات قد تخدع، لكن الجسد يفضح.
3369
| 29 سبتمبر 2025
- 3 ماذا يعني سقوط الفاشر السودانية بيد قوات الدعم السريع؟
بعض الجراح تُنسي غيرها، ليس بالضرورة أن تكون أعمق، لكن الوجدان لا يتحمل كل هذه الأوجاع. في الوقت الذي نقف في قلب الحسرة ونحن نطالع ذلك الجرح النازف في غزة دون أن نستطيع إيقاف نزفه، يتملكنا الشعور أحيانًا بأنها المأساة الوحيدة في أمتنا وذلك من فرط هولها وشدتها، ويسقط منا سهوًا الالتفات إلى مصائبها الأخرى، تأتي أزمة السودان في صدارة هذه المآسي. أوجاع السودان كثيرة ومتعددة، كلها بحاجة لأن تكون حاضرة دائما في الوجدان العربي الإسلامي، لكن أولاها في الوقت الراهن مأساة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تخضع منذ العاشر من يونيو/حزيران 2024 لحصار خانق فرضته قوات الدعم السريع للضغط على الجيش الوطني السوداني. سكان مدينة الفاشر يفتك بهم الجوع والقصف المدفعي اليومي الذي يحول دون دخول المساعدات الإنسانية، في ظل ضعف التعاطي العربي مع القضية وتجاهل دولي تام لهذه المأساة، على الرغم من أنها تقترب من الإدراج في صفحات الإبادة الجماعية. قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) التي تحاصر الفاشر، تسيطر على أربع ولايات من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور، لذا تقصف بوحشية مدينة الفاشر عاصمة الولاية الخامسة (شمال دارفور)، التي تمثل أكثر من نصف مساحة الإقليم وتعادل حوالي 12 بالمائة من مساحة السودان، وذلك بهدف إتمام السيطرة على الإقليم بأسره. إضافة إلى الوضع الكارثي للمدنيين في الفاشر بسبب الحصار والقصف الهمجي، ينذر سقوط الفاشر ووقوعها بقبضة ميلشيات الدعم السريع، بكارثة عظمى للسودان بشكل عام. الفاشر ليست مدينة عادية في أهميتها، فهي مفتاح السيطرة على مساحات إستراتيجية واسعة تصل إلى حدود تشاد وليبيا، وهي كذلك تقع على الطرق المؤدية بين شرق وغرب السودان، بما يعني أن سيطرة قوات الدعم عليها سيحول دون قيام دولة مركزية، وفرض واقع عسكري يتحكم في جغرافيا المنطقة، إضافة إلى أن السيطرة عليها ستؤمن لقوات الدعم ممرات تهريب الأسلحة. سيطرة قوات حميدتي على الفاشر يؤمن لها كذلك خطوط الإمداد ويقوي شوكتها ويجعل الولاية مركزا لمهاجمة الولايات الأخرى والسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني. لذا نستطيع الجزم، بأن الفاشر هي آخر الخطوط الفاصلة بين سودان موحد وسودان مجزأ، ولن يكون مجرد سقوط مدينة، بل انهيار وحدة الدولة السودانية، والذي سيتحول إلى شمال مركزي تحت سيطرة الجيش، وغرب تحت سلطة الميلشيات، وشرق تتجاذبه الانقسامات والنزعات القبلية، وجنوب منهك مهمش. إذا سقطت الفاشر، فإن الخطورة ستتجاوز حينئذ القتال بين الجيش وميليشيات الدعم، فمن أخطر تداعيات سقوط الفاشر – لا قدر الله - انفجار الصراع الإثني في السودان الذي يكتظ بالتنوع الإثني والقبائل المسلحة مختلفة الولاءات، لأن هذا البلد يرقد على بركان تسليح الهوية، وفي هذه الحال سيمتد الصراع الإثني بلا شك إلى الدول المجاورة. الدول العربية، والدول المحيطة بالسودان وعلى رأسها مصر، منوطة بالعمل الفوري الجاد على منع سقوط الفاشر والذي يعني تفتيت وحدة السودان وما له من تداعيات على الجوار، وذلك عبر مسارين، الأول هو كسر هذا الحصار على المدينة وإدخال المساعدات، والثاني تقدم الدعم العسكري واللوجستي للجيش السوداني المنهك لفرض سيطرته التامة على ولاية شمال دارفور ومنع سقوطها في أيدي حميدتي، والضغط كذلك على الدول والجهات التي تدعم ميلشيات الدعم السريع المتمردة. وعلى المستوى الشعبي، يتعين على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وضع مأساة الفاشر والملف السوداني بشكل عام في بؤرة الاهتمام، وتسليط الضوء على الأحوال الكارثية التي يعانيها أهل المدينة، وأهميتها الإستراتيجية وخطورة سقوطها في أيدي قوات الدعم على وحدة السودان، لتكوين رأي عام عربي ضاغط على الأنظمة والحكومات العربية لسرعة التدخل، إضافة إلى لفت أنظار الشعوب الغربية إلى هذه المأساة لإحراج حكوماتها والعمل على التدخل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية.
1341
| 28 سبتمبر 2025