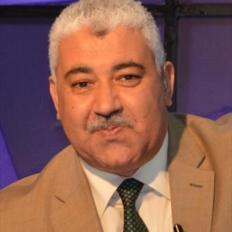رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
909
صالح عطيةالدستور والمسار الديمقراطي في تونس:البحث عن المعادلة المستحيلة !
ثمة إشكالية دستورية وسياسية في آن معا، لا تبدو مبحثا أساسيا صلب القانون الدستوري، ولا ضمن العلوم السياسية: هل الدساتير هي التي تنشئ الحياة السياسية، أم أن المشهد السياسي بصراعات الأحزاب وجماعات الضغط واللوبيات المالية، ومكونات المجتمع المدني والحراك الشعبي، هو الذي يصنع الدساتير ويضع نصوصها؟ وإلى أي مدى سيحافظ الدستور والحياة السياسية على ذلك التناغم المأمول؟
إشكالية،،، حاول مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية في تونس طرحها على بساط النقاش مؤخرا، وسط جدل لم يحسم حول: من يصنع من؟ وهل تواجه الحياة السياسية في تونس، مشكل نصّ دستوري بدا للبعض غامضا و"حمال أوجه"، أم أن "دستور الثورة" يحمل إجابات وصياغات لمشكلات النخب في علاقة بممارساتهم السياسية، داخل الحكم ومن خارجه؟
في الحقيقة لا تبدو هذه الإشكالية تونسية المنشأ.. فقد عانت إيطاليا من قطيعة بين نصها الدستوري وحياتها السياسية، بما أنتج ذلك الوجه الفاشي الذي طبع جزءا من تاريخها المعاصر.. وهو نفس الوضع الذي عرفته ألمانيا في الحقبة الهتلرية، عندما ارتدت إلى نازية مقيتة..
حتى في فرنسا العريقة ديمقراطيا وحقوقيا، وجدت طبقتها السياسية نفسها في مواجهة مشكل "التعايش" بين اليمين واليسار صلب الحكم، على عهد شيراك وجوسبان، منتصف تسعينيات القرن المنقضي.. وهي معادلة لم يتحدث عنها الدستور الفرنسي، ذو النظام الرئاسي، لكن إرادة الناخبين، فرضت هذا الخيار على الطبقة السياسية الفرنسية، وطوّعت النص لهضم واقع جديد..
أما في السياق العربي الحديث، فالأمثلة كثيرة عن ارتدادات وحالات نكوص، وانقلابات فاضحة على هواجس دول "الاستقلال الوطني" بتعدد تسمياتها وتجاربها..
سياقات الصراع
لا شك أن دستور جانفي 2014 في تونس، صيغ في ظروف غير مسبوقة تاريخيا.. كان ثمة دم سياسي سال، واحتجاجات واعتصامات وإضرابات ومحاولات انقلابية حيكت، و"إرهاب مصنّع" من الداخل والخارج، يتحرك بين الجميع ويؤشر لحرب أهلية، كانت تطل برأسها بين الفينة والأخرى.. فيما المجلس الوطني التأسيسي، كان يناقش ويجادل ويكتب هذا النص، تحت وقع تجاذبات وصراعات، ظاهرها سياسي، وباطنها إيديولوجي عقائدي، وغلافها حقوقي، وسياقاتها وطنية مشحونة ببعد إقليمي مركّب ومعقّد..
عكس هذا النص الدستوري حينئذ، صراعات مرحلة، لكنه ترجم كذلك هواجس النخبة وجزءا هاما من تطلعات الطبقة السياسية، التي حرصت على وضع مخاوفها المختلفة والمتناقضة أحيانا في نصّ الدستور..
فالمعارضة، عملت على محاصرة "الترويكا" الحاكمة بقيادة حزب النهضة، من خلال "فرملة" ما كانت تسميه "تغولا في الحكم"..
وحركة النهضة وحليفاها في الحكم، الذين كانوا يراهنون على النظام البرلماني، حرصوا على تضييق الخناق على صلاحيات رئيس الجمهورية، وعلى تحجيم دور المعارضة، ونتف كل ما أمكن من أجنحتها..
كلاهما حرص على إدراج "شهوته" في الدستور، بالشكل الذي يضمن مصالحه ووجوده ودوره، في حرب مواقع كادت أن تأتي على الأخضر واليابس برمته.. لا أحد منهما فكر في تغير موقعه، أو في إمكانية أن ينزاح النظام السياسي التونسي باتجاه استبداد جديد، أو أن تجد المعارضة نفسها بلا هامش أو مساحة تسمح لها بأن تنظم فعل الرفض والمعارضة أصلا..
هكذا كان الدستور الجديد، ترجمة لصراعات سياسية وحزبية، وتصفية لمعارك إيديولوجية قديمة، ردمها النظام المخلوع لعقدين من الزمن، وجاءت ثورة 14 يناير لكي تعيدها إلى سطح الصراع الفكري والسياسي، مع تلك الرغبة الجامحة في الوصول إلى السلطة، التي كان كل طرف يرى في نفسه الأقدر على أن يكون على رأسها..
نحو النظام الرئاسي..
الإشكال الذي تواجهه النخبة التونسية اليوم، هي مخرجات الانتخابات الماضية بشقيها التشريعي والرئاسي.. فقد أفرزت هذه الاستحقاقات، طرفا سياسيا أساسيا في الحكم، هو حزب نداء تونس، الذي يصفه البعض بـ "الجهاز المرسكل للنظام القديم".. لقد أصبح هذا الحزب في الرئاسات الثلاث: القصر الجمهوري ورئاستي الحكومة والبرلمان، وبالتالي ففرضيات الصراع بين السلطة التنفيذية والبرلمان، والتي استخدمت الأطراف السياسية بيمينها ويسارها، جميع الأدوات لتكريسها في الدستور، لم تعد متوفرة، بما يجعل السؤال الأهم مطروحا بقوة: هل دخلت تونس طور النظام الرئاسي، خصوصا مع وجود الباجي قايد السبسي، على رأس الدولة، وهو المشبع بثقافة النظام الرئاسي وسياقاته المختلفة؟ وإذا ما كان الحبيب الصيد، رئيس الحكومة الحالي، مجرد أداة تنفيذية ـ كما يردد البعض ـ فهل تنزلق التجربة مجددا إلى النظام الرئاسي؟ وهنا يطرح أمامنا السؤال المؤرق فعلا: هل تونس تعيش "في نظام هجين لا يشبه شيئا"، كما ذهب إلى ذلك جوهر بن مبارك، أحد أساتذة القانون الدستوري؟
لا أحد في تونس يمكن أن يشك لحظة في أن المسار في غير الوجهة التي طمح إليها التونسيون بثورتهم، خصوصا أمام مشاريع القوانين التي مررتها الحكومة إلى البرلمان، و"التعلميات" الصادرة عن السلطة التنفيذية في علاقة بقضم الحريات، وعودة الأمن إلى سطوته الماضية، بل استئناف الميكانيزمات القديمة في العمل من جديد، وكأن البلاد لم تعرف ثورة، ولم تشهد زلزالا ذات 14 يناير 2011 !
هل نحن بإزاء ردّة سياسية تلبس قناع "الانتقال الديمقراطي"، أم هو مخاض تسوية كتبت أحرفها قوى إقليمية ودولية، ورفعت لواءها "قوى" داخلية بأمانة وبدم بارد أحيانا ؟
في كل الأحوال، يبدو النص الدستوري، بل حتى النظام السياسي الذي تمخض عنه، في منطقة "الأوف سايد" حاليا، وسط مخاوف يطلقها كثيرون، من قلب الحزب الحاكم قبل المعارضة، بوجود مؤشرات لعودة الحياة السياسية إلى نقطة الصفر، نقطة ما قبل سقوط رأس النظام السابق، خصوصا أمام نكوص الإعلام على عقبيه، وتراجع حراك المجتمع المدني، وصمت المعارضة التي تشهد بداية تآكل رصيدها، بفعل عوامل كثيرة ليس هنا مجال عرضها..
هل تشهد تونس حقيقة، لحظة "فكّ ارتباط" أو قطيعة بين النص الدستوري وواقع سياسي جديد، أبرز علاماته، إمكانية عودة الاستبداد بأدوات وعناوين وأسماء "ديمقراطية" أو هكذا تقدم نفسها؟
للأسف،،، مؤشرات عديدة تصبّ في هذا الاتجاه وتدعمه يوما بعد يوم.. والذريعة، بل الذرائع موجودة ومتوفرة وعلى قارعة الطريق، ما يجعل "دستور الثورة" رقما خارج المعادلة السياسية الراهنة تماما..
اقرأ المزيد
 قراءة أولية لسيناريوهات الفائدة
قراءة أولية لسيناريوهات الفائدة
في الأسابيع التي سبقت اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، شهدت التوقعات تقلبات غير معتادة. فقد تأرجحت... اقرأ المزيد
84
| 07 ديسمبر 2025
 الإسلام منهج إصلاح لا استبدال
الإسلام منهج إصلاح لا استبدال
يُتهم الإسلام زورًا وبهتانًا بأنه جاء ليهدم الدنيا ويبنيها من جديد، أو أنه جاء ليسبح بالبشرية عكس اتجاه... اقرأ المزيد
282
| 07 ديسمبر 2025
 توم باراك والهندسة الخفية لإعادة ترتيب النفوذ - 1
توم باراك والهندسة الخفية لإعادة ترتيب النفوذ - 1
في عالمٍ تتزاحم فيه القوى الدولية فوق خرائطنا، وتتداخل فيه خيوط الاقتصاد والسياسة والأمن في نسيجٍ واحد، لا... اقرأ المزيد
138
| 07 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
«أنا الذي حضر العربي إلى ملعبي»

أحمد علي
-
بعض المعارك في خسرانها شرف

د. أحمد المحمدي
-
فن التعامل مع المخالفين

الشيخ د. سعود بن ناصر آل ثاني
-
قراءة أولية لسيناريوهات الفائدة

فهد عبدالرحمن بادار
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 شاطئ الوكرة
في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول شعاع يلامس مياه الخليج الهادئة، من المعتاد أن أقصد شاطئ الوكرة لأجد فيه ملاذا هادئا بعد صلاة الفجر. لكن ما شهده الشاطئ اليوم لم يكن منظرا مألوفا للجمال، بل كان صدمة بصرية مؤسفة، مخلفات ممتدة على طول الرمال النظيفة، تحكي قصة إهمال وتعدٍ على البيئة والمكان العام. شعرت بالإحباط الشديد عند رؤية هذا المنظر المؤسف على شاطئ الوكرة في هذا الصباح. إنه لأمر محزن حقا أن تتحول مساحة طبيعية جميلة ومكان للسكينة إلى مشهد مليء بالمخلفات. الذي يصفه الزوار بأنه «غير لائق» بكل المقاييس، يثير موجة من التساؤلات التي تتردد على ألسنة كل من يرى المشهد. أين الرقابة؟ وأين المحاسبة؟ والأهم من ذلك كله ما ذنب عامل النظافة المسكين؟ لماذا يتحمل عناء هذا المشهد المؤسف؟ صحيح أن تنظيف الشاطئ هو من عمله الرسمي، ولكن ليس هو المسؤول. والمسؤول الحقيقي هو الزائر أولا وأخيرا، ومخالفة هؤلاء هي ما تصنع هذا الواقع المؤلم. بالعكس، فقد شاهدت بنفسي جهود الجهات المختصة في المتابعة والتنظيم، كما لمست جدية وجهد عمال النظافة دون أي تقصير منهم. ولكن للأسف، بعض رواد هذا المكان هم المقصرون، وبعضهم هو من يترك خلفه هذا الكم من الإهمال. شواطئنا هي وجهتنا وواجهتنا الحضارية. إنها المتنفس الأول للعائلات، ومساحة الاستمتاع بالبيئة البحرية التي هي جزء أصيل من هويتنا. أن نرى هذه المساحات تتحول إلى مكب للنفايات بفعل فاعل، سواء كان مستخدما غير واعٍ هو أمر غير مقبول. أين الوعي البيئي لدى بعض رواد الشاطئ الذين يتجردون من أدنى حس للمسؤولية ويتركون وراءهم مخلفاتهم؟ يجب أن يكون هناك تشديد وتطبيق صارم للغرامات والعقوبات على كل من يرمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، لجعل السلوك الخاطئ مكلفا ورادعا.
3813
| 05 ديسمبر 2025
- 2 سابقة قضائية قطرية في الذكاء الاصطناعي
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2664
| 30 نوفمبر 2025
- 3 في رحيل الشيخ محمد بن علي العقلا
فجعت محافل العلم والتعليم في بلاد الحرمين الشريفين برحيل معالي الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن علي العقلا، أحد أشهر من تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والحق أنني ما رأيت أحدًا أجمعت القلوب على حبه في المدينة المنورة لتواضعه ودماثة أخلاقه، كما أجمعت على حب الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحماته، وأسكنه روضات جناته، اللهم آمين. ولد الشيخ العقلا عليه الرحمة في مكة المكرمة عام 1378 في أسرة تميمية النسب، قصيمية الأصل، برز فيها عدد من الأجلاء الذين تولوا المناصب الرفيعة في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس الدولة. وقد تولى الشيخ محمد بن علي نفسه عمادة كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1428، فكان مكتبه عامرا بالضيوف والمراجعين مفتوحًا للجميع وجواله بالمثل، وكان دأبه الرد على الرسائل في حال لم يتمكن من إجابة الاتصالات لأشغاله الكثيرة، ويشارك في الوقت نفسه جميع الناس في مناسباتهم أفراحهم وأتراحهم. خرجنا ونحن طلاب مع فضيلته في رحلة إلى بر المدينة مع إمام الحرم النبوي وقاضي المدينة العلامة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ وعميد كلية أصول الدين الشيخ عبد العزيز بن صالح الطويان ونائب رئيس الجامعة الشيخ أحمد كاتب وغيرهم، فكان رحمه الله آية في التواضع وهضم الذات وكسر البروتوكول حتى أذاب سائر الحواجز بين جميع المشاركين في تلك الرحلة. عرف رحمه الله بقضاء حوائج الناس مع ابتسامة لا تفارق محياه، وقد دخلت شخصيا مكتبه رحمه الله تعالى لحاجة ما، فاتصل مباشرة بالشخص المسؤول وطلب الإسراع في تخليص الأمر الخاص بي، فكان لذلك وقع طيب في نفسي وزملائي من حولي. ومن مآثره الحسان التي طالما تحدث بها طلاب الجامعة الإسلامية أن أحد طلاب الجامعة الإسلامية الأفارقة اتصل بالشيخ في منتصف الليل وطلب منه أن يتدخل لإدخال زوجته الحامل إلى المستشفى، وكانت في حال المخاض، فحضر الشيخ نفسه إليه ونقله وزوجته إلى المستشفى، وبذل جاهه في سبيل تيسير إدخال المرأة لتنال الرعاية اللازمة. شرفنا رحمه الله وأجزل مثوبته بالزيارة إلى قطر مع أهل بيته، وكانت زيارة كبيرة على القلب وتركت فينا أسنى الأثر، ودعونا فضيلته للمشاركة بمؤتمر دولي أقامته جامعة الزيتونة عندما كنت مبتعثًا من الدولة إليها لكتابة أطروحة الدكتوراه مع عضويتي بوحدة السنة والسيرة في الزيتونة، فكانت رسالته الصوتية وشكره أكبر داعم لنا، وشارك يومها من المملكة معالي وزير التعليم الأسبق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الوالد الشيخ عبدالله بن صالح العبيد بورقة علمية بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة السنة النبوية» ومعالي الوالد الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، العضو السابق بهيئة كبار العلماء في المملكة، وقد قرأنا عليه أثناء وجوده في تونس من كتاب الوقف في مختصر الشيخ خليل، واستفدنا من عقله وعلمه وأدبه. وخلال وجودنا بالمدينة أقيمت ندوة لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود حضرها أمير المدينة يومها الأمير المحبوب عبد العزيز بن ماجد وعلماء المدينة وكبار مسؤوليها، وحينما حضرنا جعلني بعض المرافقين للشيخ العقلا بجوار المستشارين بالديوان الملكي، كما جعلوا الشيخ جاسم بن محمد الجابر بجوار أعضاء مجلس الشورى. وفي بعض الفصول الدراسية زاملنا ابنه الدكتور عقيل ابن الشيخ محمد بن علي العقلا فكان كأبيه في الأدب ودماثة الأخلاق والسعي في تلبية حاجات زملائه. ودعانا مرة معالي الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري في الحرم المكي لتناول العشاء في مجلس الوجيه القطان بمكة، وتعرفنا يومها على رئيس هيئات مكة المكرمة الشيخ فراج بن علي العقلا، الأخ الأكبر للشيخ محمد، فكان سلام الناس عليه دليلا واضحا على منزلته في قلوبهم، وقد دعانا إلى زيارة مجلسه، جزاه الله خيرا. صادق العزاء وجميل السلوان نزجيها إلى أسرة الشيخ ومحبيه وطلابه وعموم أهلنا الكرام في المملكة العربية السعودية، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم تقبله في العلماء الأتقياء الأنقياء العاملين الصالحين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
1704
| 04 ديسمبر 2025