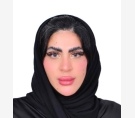رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
309
د. محمد عبدالله المطرظاهرة ترجمة الدراسات الإسلامية للعربية رائعة.. ولكن!
شهدت حركة ترجمة الكتب الفكرية والدينية عن الإسلام تطوّرًا ملحوظًا خلال العقدين الأخيرين، خصوصًا مع صعود دور نشر عربية متخصّصة، فهذه المرحلة تختلف عن عصر الاستشراق القديم؛ وهي لا تركّز على ترجمة أعمال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بل تهدف إلى نقل الدراسات الأكاديمية الحديثة التي تنتجها الجامعات الغربية اليوم وقد برز في هذا المجال مترجمون عرب معاصرون، وللمثال د. أسامة السيد (رحمه الله) وأ. عمرو بسيوني وأ. أسامة غاوجي وغيرهم، ممن قدّموا ترجمات عالية القيمة العلمية أعادت إحياء النقاش حول قضايا التراث والتجديد، وحول هذا الموضوع أحب أن أسلط الضوء على إيجابيات الظاهرة وسلبياتها، وهي:
أولاً: الإيجابيات
١ - فتح آفاق معرفية جديدة: من أبرز الأمثلة كتاب «المرجع في علم الكلام” الصادر عن الباحثة «شامكته” الألمانية، الذي ترجمه د. أسامة السيد، رحمه الله، فقد قدّم أطروحات جديدة في علم الكلام المقارن، وربط بين النقاشات القديمة والجوانب المنهجية الحديثة، كما حاز جائزة الشيخ حمد للترجمة في قطر، فهذا النوع من الترجمات يكشف للباحث العربي كيف تُقرأ موضوعات العقيدة والكلام اليوم في الجامعات الغربية بمناهج تحليلية مركّبة، ومثال آخر مهم هو كتاب «ابن تيمية” للمؤرخ الأمريكي «جون هوفر»، وترجمه أ. عمرو بسيوني، الذي يُعد من أهم الأعمال الغربية المتخصصة في تحليل فكر ابن تيمية بمنهج نقدي - تاريخي حديث وغيرهما.
٢ - نقل مشاريع بحث كبرى إلى العربية: تأتي أيضًا ترجمات كتب مثل «مغامرة الإسلام” «لمرشال هودجسون» وترجمة أسامة غاوجي، التي جرى تداولها عربيًا في السنوات الأخيرة، وهي من أعمق الدراسات التاريخية حول تطور الحضارة الإسلامية.
وأما «معاجم أكسفورد”، فقد اهتمت بترجمتها كثير من الدور في دراسة ما نتج عنهم من المواضيع المتعلقة بالدراسات القرآنية، والفقهية، والنفسية، والفلسفة وغير ذلك، ولا شك أن فيها قيمة كبيرة للباحث والمهتم وغيرهما.
ثانيًا: السلبيات
١ - التحيزات في التقييم دون تمحيص: بعض الترجمات تأثرت بالاستشراق القديم فنقلت رؤى مشبعة بمناهج مثل «التسييس التاريخي” أو القراءة الفينومينولوجية (تأسيس العلوم على ظواهر سابقة) للتراث الإسلامي، وهي مناهج تحتاج إلى نقد وتفكيك، وإلا تحوّلت إلى مرجعية غير منصفة لدى القراء، ولا يخفى تأثير هذه الدراسات حتى على الحداثيين العرب، كما تكمن أبرز الأخطاء في تناول الشريعة في صور منها: نَسْبُ ممارسات اجتماعية للإسلام (كما تفعل أيان هيرسي علي بخلط العادات القبلية مع الشريعة)، واقتطاع النصوص من سياقها لتصوير الجهاد كحرب مطلقة (كما يفعل سام هاريس) وغير ذلك.
٢- عدم توازن في موضوع الحركات الإسلامية: إن الكتب الغربية التي ناقشت الحركات الإسلامية في العقود الأخيرة لم تكن دائمًا على درجة عالية من النزاهة العلمية، مما جعل الصورة المقدَّمة للقارئ العربي غير متوازنة، يرجع ذلك إلى طبيعة المناهج الغربية في دراسة الظواهر السياسية والدينية، والتي تميل أحيانًا إلى التفسير الأمني الصارم، على حساب الجوانب العقدية والفقهية الداخلية للحركات!، ولكن تميز بعضهم بحياد جيد وثراء بحثي خاصة من الذين كانت دراساتهم مبنية على اللقاءات الشخصية وبذل الجهد فيها مثل (ستيفن لاكروا) في كتابه «زمن الصحوة» وغيره.
٣- خطر تراجع التأليف العربي: تدفّق الترجمات قد يُغري بالاعتماد على الإنتاج الغربي بدل إنتاج معرفة عربية أصيلة، مما يهدد مشروع بناء مدرسة فكرية عربية مستقلة، ويضعف الإبداع عند الكاتب المسلم والعربي الذي ينشغل غالباً بالدراسات التقليدية أو ترك البحث أصلاً!.
إن الأمل الأكبر مع أهمية الترجمة للدراسات الأجنبية هو أن تتوازى هذه العملية مع مشروع ترجمة الإنتاج العربي إلى اللغات العالمية، وذلك حتى يستمر الفكر الإسلامي مقدماً للأعمال المستجدة والتجديدية.
مقالات ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
د. محمد عبدالله المطر
- باحث كويتي في الفكر الإسلامي
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
السلام.. بوصفه تخلياً

خولة البوعينين
-
«أخلاقنا تبدأ من البيت» تعزيز لدور الوالدين

رأي الشرق
-
في حديث الهوية.. على أمل الحرية

عصام بيومي
-
الشرع والواقعية السياسية

د. فاتن الدوسري
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 الإقامة للتملك لغير القطريين
في عالم تتسابق فيه الدول لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار تبنّت دولة قطر نموذجًا قانونيًا لمنح فرص الإقامة للأجانب بضوابط قانونية محددة، أبرزها ما ورد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 والذي ينظم منح الإقامة للأجانب من خلال التملك العقاري في قطر، فقد فتحت الباب أمام غير القطريين للحصول على الإقامة عبر تملك العقارات أو الانتفاع بها، وفق شروط دقيقة. ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار العقاري، وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقارية المحلية، ويساهم في تحقيق رؤية قطر التنموية التي تسعى لجعل البلاد وجهة إقليمية رائدة للاستثمار والعيش الكريم. من شروط الحصول على الإقامة العقارية في دولة قطر لملاك العقارات غير القطريين، وأن يكون مؤهلاً للحصول على إقامة دائمة، كما وضع القانون شروطا واضحة ولابد من توافرها، بأن يشترط أن يقيم المستثمر داخل دولة قطر مدة لا تقل عن 90 يومًا في السنة، سواء كانت إقامة متصلة أو متقطعة حتى تستمر الإقامة في سريانها، ولاسيما أن تكون قيمة العقار لا تقل 730 ألف ريال قطري ويتم تقييم العقار وفقًا للقيمة السوقية المعتمدة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ولا يقتصر ذلك فقط على قيمة الشراء المتفق عليه بين الطرفين، وإضافة على ذلك إذا بلغت قيمة العقار 3 ملايين و650 ألف ريال قطري أو أكثر فإن المالك المنتفع به يُمنح امتيازات إضافية لحاملي الإقامة الدائمة وتشمل التعليم الحكومي والرعاية الصحية وبعض التسهيلات الاستثمارية، وتظهر هذه الشروط ضمان جدية المستثمر. ويشدد القانون على أهمية إقامة مالك العقار في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من كل عام متصلة أو متواصلة، ويُقصد من هذا الشرط ضمان ارتباط حامل الإقامة العقارية فعليًا بدولة قطر، وعدم الاقتصار على التملك من الخارج دون تواجد فعلي، وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها على المالك تحقيق شرط الـ90 يومًا بسبب ظروف قاهرة أو ضرورات خاصة تتيح اللوائح إمكانية تقديم طلب استثناء أو عذر رسمي للجهات المعنية، على سبيل المثال يمكن للمالك التقدم بطلب “تصريح عودة مقيم” لدى وزارة الداخلية إذا اضطر للبقاء خارج قطر مدة طويلة تتجاوز المسموح به، وذلك حفاظًا على صلاحية إقامته، يمنح تصريح العودة للمقيم فرصة عدم إسقاط إقامته عند تجاوز المدة المحددة للبقاء خارج البلاد والتي تكون عادة 6 أشهر كحد أقصى للإقامة العادية، حيث يتم توضيح أسباب الغياب وتقديم المستندات الداعمة للحصول على موافقة استثنائية، وبهذا الإجراء القانوني يمكن للمالك الحفاظ على إقامة العقار الخاصة به رغم عدم استيفائه شرط 90 يومًا في السنة في بعض الحالات الاستثنائية، شريطة موافقة الجهات الرسمية المختصة على العذر المقدم وفق الأصول القانونية. وفي سياق تحديد قيمة العقار المعتمد لهذا الغرض، أوضح القانون أن المرجعية تكون للقيمة السوقية التي تعتمدها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وليس فقط سعر الشراء المُعلن، بمعنى آخر تحتسب أهلية العقار لمنح الإقامة بناءً على تقييم رسمي يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان النزاهة وعدم التحايل في تقدير قيمة العقارات المطلوبة للحصول على الإقامة، وفي حال اختلف التقييم الرسمي عن سعر الشراء بشكل يؤثر على استيفاء شرط الحد الأدنى للقيمة، يمكن للمستثمر العقاري التقدم بطلب اعتراض أو إعادة تقييم لدى الجهات المختصة، لتصحيح أي تفاوت محتمل في تقدير قيمة العقار، وتتم عملية الاعتراض عبر تقديم المستندات والبيانات اللازمة لإعادة تقييم العقار من قبل إدارة التسجيل العقاري، حرصًا على أن يحصل المالك على حقه في التقييم العادل الذي يؤهله للإقامة العقارية إذا انطبقت الشروط. أما في حال قيام المالك ببيع العقار الذي منح بموجبه الإقامة، فإن رخصة الإقامة العقارية المرتبطة بهذا العقار تصبح مهددة بالإلغاء تلقائيًا لزوال سبب منحها، ولتفادي فقدان الإقامة فورًا حددت السلطات مهلة زمنية تمنح للمالك السابق من تاريخ بيع العقار، وذلك ليقوم خلالها إما بشراء عقار بديل يستوفي الشروط أو بتغيير وضع إقامته إلى كفالة أخرى مشروعة، وتبلغ مدة المهلة الممنوحة 3 أشهر من تاريخ بيع العقار، فإذا تمكن خلالها من شراء عقار بديل للقيمة المحددة 730 ألف ريال قطري على الأقل ونقل ملكيته باسمه، يستطيع حينها نقل الإقامة العقارية إلى العقار الجديد والاستمرار بالتمتع بها دون انقطاع، أما إذا انقضت المهلة دون شراء عقار جديد للشروط أو ترتيب كفالة إقامة بديلة مثل الانتقال لكفالة عمل، فإن الإقامة العقارية تُلغى بانتهاء تلك المهلة لانتهاء سبب استحقاقها، هذا التنظيم يمنح المستثمر الجاد فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه دون إخلال فوري باستقراره في البلاد، وفي الوقت ذاته يضمن عدم بقاء الإقامة بدون أساس قانوني مستمر. الجدير بالذكر أن القانون نفسه ميّز امتيازات إضافية للمستثمرين العقاريين الذين تبلغ قيمة ممتلكاتهم العقارية حدًا أعلى، فبحسب المادة (7) سالفة الذكر، إذا وصلت القيمة السوقية للعقار الذي يمتلكه الأجنبي إلى 3,650,000 ريال قطري أو أكثر ما يعادل مليون دولار أمريكي تقريبًا، فإن مالك العقار يحظى بامتيازات إقامة دائمة مماثلة لتلك التي يتمتع بها حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وتشمل هذه الامتيازات التعليم والصحة المجانية في المؤسسات الحكومية لأفراد أسرته، إضافة إلى تسهيلات في مجال الاستثمار والمعاملات التجارية، وبذلك يعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين الراغبين في مزايا طويلة الأمد.
9933
| 13 نوفمبر 2025
- 2 تصحيح السوق أم بداية الانهيار؟
وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام ارتفاعًا في تقييماتها دفعها إلى منطقة الفقاعة. فقد وصلت مضاعفات الأرباح المتوقعة إلى مستويات نادرًا ما شوهدت من قبل، لذلك، لم يكن التراجع في التقييمات منذ منتصف أكتوبر مفاجئًا. وقد يعكس هذا الانخفاض حالة من الحذر وجني الأرباح. وقد يكون مؤشرًا على تراجع أكبر قادم، أو مجرد استراحة في سوق صاعدة طويلة الأمد تصاحب ثورة الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، لا يُعدّ الهبوط الأخير في سوق الأسهم أكثر من مجرد "تصحيح" محدود. فقد تراجعت الأسواق في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم الاثنين 10 من الشهر نفسه، لكنها عادت وانخفضت في نهاية الأسبوع. وما تزال السوق إجمالاً عند مستويات مرتفعة مقارنة بشهر أبريل، حين شهدت انخفاضًا مرتبطًا بإعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال: تراجعت أسهم شركة إنفيديا بنحو 10% في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها بقيت أعلى بنحو 60% مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط. مؤشر S&P 500 انخفض إلى 6700 في الرابع عشر من نوفمبر، مقارنة بذروة بلغت 6920، وما زال أعلى بنحو سبعين بالمئة مقارنة بنوفمبر 2022. هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على القيمة السوقية الإجمالية أصبحت واضحة. فمع نهاية أكتوبر، ورغم ارتفاع المؤشر طوال العام، باستثناء التراجع في أبريل، شهدت نحو 397 شركة من شركات المؤشر انخفاضًا في قيمتها خلال تلك الفترة. ثماني من أكبر عشر شركات في المؤشر هي شركات تكنولوجية. وتمثل هذه الشركات 36% من إجمالي القيمة السوقية في الولايات المتحدة، و60% من المكاسب المحققة منذ أبريل. وعلى عكس ما حدث لشركات الدوت كوم الناشئة قبل 25 عامًا، تتمتع شركات التكنولوجيا اليوم بإيرادات قوية ونماذج أعمال متينة، حيث تتجاوز خدماتها نطاق الذكاء الاصطناعي لتشمل برمجيات تطبيقات الأعمال والحوسبة السحابية. وهناك حجّة قوية مفادها أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يأتي من شركات كبرى مربحة تتمتع بمراكز نقدية قوية، ما يجعل هذه الاستثمارات أقل عرضة للمخاطر مقارنة بموجات الحماس السابقة في قطاع التكنولوجيا. غير أن حجم الاستثمارات المخطط لها في مراكز البيانات أثار مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن هناك 10 شركات ناشئة خاسرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها مجتمعة بنحو تريليون دولار. وهناك ايضاً تراجع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل شهره الثاني، فلم تُنشر أي بيانات وظائف رسمية منذ 5 سبتمبر، ما دفع المحللين للاعتماد على بيانات خاصة. هذه البيانات أظهرت أعلى مستوى لتسريح الموظفين منذ 2003 في أكتوبر. كما جاءت نتائج أرباح بعض الشركات التقليدية مخيبة، حيث هبط سهم مطاعم تشيبوتلي بنحو 13% في نهاية أكتوبر بعد إعلان نتائج دون توقعات السوق.
2370
| 16 نوفمبر 2025
- 3 برّ الوالدين.. عبادة العمر التي لا تسقط بالتقادم
يحتلّ برّ الوالدين مكانة سامقة في منظومة القيم القرآنية، حتى جعله الله مقرونًا بعبادته في قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، فجمع بين التوحيد والإحسان إليهما في آية واحدة، ليؤكد أن البرّ بهما ليس مجرّد خُلقٍ اجتماعي، بل عبادة روحية عظيمة لا تقلّ شأنًا عن أركان الإيمان. القرآن الكريم يقدّم برّ الوالدين باعتباره جهادًا لا شوكة فيه، لأن مجاهد النفس في الصبر عليهما، ورعاية شيخوختهما، واحتمال تقلب مزاجهما في الكبر، هو صورة من صور الجهاد الحقيقي الذي يتطلّب ثباتًا ومجاهدة للنفس. قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15]، فحتى في حال اختلاف العقيدة، يبقى البرّ حقًا لا يسقط. وفي الآية الأخرى ﴿وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 24]، يربط القرآن مشاعر الإنسان بذاكرته العاطفية، ليعيده إلى لحظات الضعف الأولى حين كان هو المحتاج، وهما السند. فالبرّ ليس ردّ جميلٍ فحسب، بل هو اعتراف دائم بفضلٍ لا يُقاس، ورحمة متجددة تستلهم روحها من الرحمة الإلهية نفسها. ومن المنظور القرآني، لا يتوقف البرّ عند الحياة، بل يمتدّ بعد الموت في الدعاء والعمل الصالح، كما قال النبي ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... « وذكر منها «ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم). فالبرّ استمرارية للقيم التي غرساها، وجسر يصل الدنيا بالآخرة. في زمن تتسارع فيه الإيقاعات وتبهت فيه العواطف، يعيدنا القرآن إلى الأصل: أن الوالدين بابان من أبواب الجنة، لا يُفتحان مرتين. فبرّهما ليس ترفًا عاطفيًا ولا مجاملة اجتماعية، بل هو امتحان للإيمان وميزان للوفاء، به تُقاس إنسانية الإنسان وصدق علاقته بربه. البرّ بالوالدين هو الجهاد الهادئ الذي يُزهر رضا، ويورث نورًا لا يخبو.
1296
| 14 نوفمبر 2025