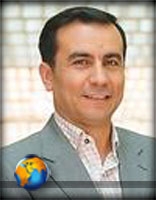رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
973
خالد الحروبفي تبلور الهُويّة الوطنية الفلسطينية
خضعت تمظهرات الهُويّات الفلسطينيّة لتحوّلات عميقة وجذريّة في التاريخ المعاصر في سياق حقبة ما بعد الاستعمار الغربيّ للمنطقة، واستمرار السياق الاستعماريّ الصهيونيّ في فلسطين. في السياق الإقليميّ، تنافست هُويّات قوميّة وحديثة تحيط بفلسطين على استبدال وَ/أو إعادة إنتاج مزيج الهُويّات المتبقّية من الماضي البعيد والماضي القريب، نحو الهُويّات (وتفرّعات الهُويّات) الدينيّة والإسلاميّة والعروبيّة والقَبَليّة والإقليميّة.
استنزفت النخب الحاكمة في الدول القوميّة الوليدة في الشرق الأوسط طاقاتها في سعيها لتأسيس (أو-بالأصحّ- تخليق) هُويّات وطنيّة متميّزة حول ما يُفترض أن تدور حولها "القوميات" الوليدة و"مواطَنتها". وبعد عقود على نشوء الدول الوطنية (القطرية) العربية لم تتم بعد تسويةُ التوتّرات بين المركّبات المختلفة (والمتضاربة أحيانًا) لهذه الهُويّة الموحّدة المنشودة، والتي تدور في المقام الأوّل حول صدارة مكوّناتها الدينيّة أو القوميّة.
بعض تلك التوترات يجد صداه في عمليّات تشكيل وإعادة تشكيل الهُويّة الفلسطينيّة. بدءًا من نهاية القرن التاسع عشر حتّى يومنا هذا، يمكن النظر إلى الجدال والتنافس والتصالح وَ/أو الصراع بين "القوميّ" و"الدينيّ" كمسار تكامليّ في عمليّة صياغة الهُويّة الفلسطينيّة، وكجزء من عمليّة تدوين تاريخ هذه الهُويّة.
رغم ذلك، تبقى فكرتا "القوميّ" و"الدينيّ" عاجزتين عن توفير فهم شامل لنشوء وتشكيل الهُويّة الفلسطينيّة بالمنظور التاريخيّ. رغم الطبيعة النافذة لهذين الآليتين في تأسيس الهُويّات، فقد جرى تطويعهما -كما ستدّعي هذه المقالة- لسياق وسيرورة أقوى، ألا وهي المقاومة.
وعلى خلاف الحالات العربيّة/ الشرق أوسطية الأخرى، تجاوز السياق الاستعماريّ المتواصل في فلسطين الإطار الزمنيّ للتجارب الاستعماريّة الأخرى، بحضوره الشامل وبالجهاز التمييزيّ الوحشيّ المفروض على الفلسطينيّين، هذا السياق مازال يقوم بدور المصمّم المطلق للهُويّة الفلسطينيّة وللواقع الفلسطينيّ السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ.
الردّ الفلسطينيّ الذي لا ريب فيه لهذا السياق على امتداد القرن الأخير كان المقاومة. فكرة المقاومة أدّت دورًا عظيمًا في التأثير على مفهوم الفلسطينيّين لذاتهم الجماعيّة، وفي خلق "فلسطينيّتهم". وبوعي أو دون وعي، تحوّل فعل المقاومة إلى "مانح" الشرعّية المركزيّ، وأُجبِرَ حتّى "القوميّ" و"الدينيّ" على تقديم (وإعادة تقديم) أنفسهما للجماهير من منظور المقاومة. الملاحظات سوف تركز على مرحلة ما بعد الحرب. اقترابا من سؤال: وماذا بعد؟
الهوية الوطنية national identity مفهوم جديد في التاريخ السياسي للجماعات البشرية ومرتبط عضويا بمفهوم "الدولة الأمة" nation state. وربما يمكن اعتبارها الشقيقة التوأم للدولة الحديثة. في مرحلة ما قبل الدولة الوطنية لم يكن ثمة حاجة لهذا المفهوم الذي صار له أن يتطور خلال القرنين الماضيين. متوازياً. مع تكرس فكرة السيادة القومية. ليحتل مكانة قريبة من المقدس. كانت المجموعات البشرية والأقوام وفي سياق الأنظمة الإمبراطورية العابرة للحدود الجغرافية والديموغرافية معرفة بقواسم ومميزات لكل منها يتمثل في الاشتراك في الجغرافيا. وكثافة العلاقات التبادلية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية والمكونات المشتركة. مقارنة ببعضها البعض. وما ينتج عن ذلك من وعي رخو بذات جمعية متعينة.
العوامل المشتركة التاريخية والثقافية والاجتماعية تلك. وإلى جانب طبيعة العلاقة مع "الآخر" والرغبة في التمايز عنه. وقفت وراء تبلور الهويات الوطنية كنتاج سيرورات مركبة وظروف مختلفة. طبيعة العلاقة مع الآخر في فضاءات عريضة من العالم حددتها تجربة الكولونيالية الغربية التي أسهمت في بروز واستقواء هويات وطنية في البلدان المُستعمرة. لكن هذه الهويات لم تكن نتاجا حصريا لهذه الكولونيالية. بل هي إعادة استحضار لمكونات تاريخية وجغرافية وثقافية وتشغيلها في إنتاج "هوية وطنية" مقاومة للاستعمار. وهكذا فإن "المقاومة" اشتغلت عمليا على إعادة صوغ تصور الجماعة الوطنية عن نفسها وأصبحت الآلية الأهم في تشكل الهوية الجمعية. وفي الوقت نفسه لا يمكن القول إن المقاومة هي الآلية والمكون الحصري للهوية الوطنية حتى لو كانت تلك الهوية قيد الاستعمار.
ويمكن تصور عبور الهوية الوطنية في العصر الحديث وفي السياق الكولونيالي وما بعد الكولونيالي في مرحلتين: الأولى هي انتزاع "الوطنية" والتحرر من المستعمر. ثم انتزاع "المواطنة" من النظام السياسي في مرحلة الاستقلال. معنى ذلك أن التحرر من الاستعمار لا يجلب معه التحقق الكامل للهوية الوطنية. بل تخلصها من السيطرة الخارجية فقط. بينما لا تُنجز تماما إلا من خلال تحقيق "المواطنة" في المرحلة الاستقلالية التالية.
ومن المهم مفهوميا كسر حصرية المقاومة بالكفاح المسلح. فإضافة إلى هذا الأخير فهي تتضمن الأفكار والآليات والممارسات والجهود التي تتوجه أساسا نحو رفض النظام الفوقي للاستعمار أو القوة الأجنبية المسيطرة والتمرد عليه والتخلص منه. وهذه كلها تشكل مع الزمن وتكرس الفعل المقاوم الوعي بالذات الجمعية. ويصبح الالتزام بها. سواء عبر الممارسة المباشرة أو الإقرار بشرعيتها. هو المُعرف الأساسي لمعنى الانتماء لقوم ما. على ذلك قد تكون المقاومة. في السياق الفلسطيني مثلاً. الكفاح المسلح. أو المقاومة السلمية. أو النضال ضد السياسات العنصرية (كما في حالة فلسطيني الداخل).
وخلال مرحلة التحرر من الاستعمار فإن المقاومة (على المستوى الفلسطيني وغيره) وتبعا لتعقلها بكونها مؤسسا تكوينيا مرتبطا بالهوية تشتغل على عدة مستويات مهمة. أولها. أنها تعمل على منح الشرعية وحجبها للأفكار والممارسات التي تنشأ تحت الحكم الكولونيالي. فمن (وما) يلتزم بالمقاومة وأهدافها وينخرط فيها ينتمي لـ"الجماعة الوطنية" ويتصف بـ"هويتها". وثانيها. كونها تصبح أحد أهم معايير التأثيم الفردي والجماعي بدءاً من الحد الأدنى وهو الشعور بالتقصير لعدم الانخراط فيها وممارستها. ووصولا إلى الحد الأعلى وهو الطرد من الهوية الوطنية في الحالات القصوى كالخيانة والتخابر مع العدو. وثالثها. أنها تعمل على شرعنة الفعل النظري والعملي. السياسي. والديني. والاقتصادي. والفني. والثقافي. وتعطيه رخصة مزاولة الحياة الاجتماعية: وينشأ تبعا لذلك "الاقتصاد المقاوم" و"الفن المقاوم" و"الدين المقاوم". وكأن أيا من هذه الأنشطة لن يتمتع بممارسة الشرعية الكاملة ما لم يرتبط بالمشروع الأعلى "المقاوم".
تطورت مركزية المقاومة في سيرورة تشكل الهوية الفلسطينية ومرت في حقب متلاحقة. خاصة في أعقاب بروز حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي. وشبه التماهي بين المقاومة والهوية. وظلت كذلك إلى توقيع اتفاق أوسلو. عندها توقفت المقاومة (كإطار جامع للهوية والفاعلية الفلسطينية) وانتقل الوضع الفلسطيني إلى الغموض الخطر. ومكمن الخطر في هذه الحقبة يتمثل في الوقوف في منتصف الطريق حيث أخرجت المقاومة ذاتها من المعركة ضد المستعمر قبل إنهاء مهمتها الطبيعية وهي التحرر والاستقلال. وقبل الانتقال إلى الدولة الحاضنة الحديثة للهوية الوطنية. أدى ذلك إلى بروز مشروعين متناقضين "المقاومة عند حماس" و"الحل السلمي" عند الفصائل الوطنية. وبذلك لم تعد المقاومة هي المشروع الناظم والجامع للفاعلية والهوية الفلسطينية. خلال الحقب الزمنية راكمت منظمة التحرير وحركة حماس "رأسمال مقاومي". تم استنزافه في مشروعين غير متجانسين: المفاوضات. والأسلمة. رصيد فصائل منظمة التحرير من سنوات الستينيات وحتى أوسلو. تم استنزافه في مشروع المفاوضات وبناء السلطة الفلسطينية. ورصيد حماس المقاومي تم استنزافه في مشروع الأسلمة المجتمعية. ومع نفاد الرصيد المقاومي بأكمله عند الطرفين تنكشف المشروعات الخلافية وتصطدم ببعضها البعض وتتحرك من دون إقناع وفي غياب غطاء المقاومة.
مقالات ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
أمة التطور

طه عبدالرحمن
-
استيراد المعرفة المعلبة... ضبط البوصلة المحلية على عاتق من؟

الدكتورة حصة حامد المرواني
-
إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني أولوية قصوى

رأي الشرق
-
الأخضر يوحد القلوب الخليجية

بدور المطيري
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 كبار في قفص الاتهام.. كلمة قطر أربكت المعادلات
في قاعة الأمم المتحدة كان خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله مشهدا سياسيا قلب المعادلات، الكلمة التي ألقاها سموه لم تكن خطابًا بروتوكوليًا يضاف إلى أرشيف الأمم المتحدة المكدّس، بل كانت كمن يفتح نافذة في قاعة خانقة. قطر لم تطرح نفسها كقوة تبحث عن مكان على الخريطة؛ بل كصوت يذكّر العالم أن الصِغَر في المساحة لا يعني الصِغَر في التأثير. في لحظة، تحوّل المنبر الأممي من مجرد منصة للوعود المكررة والخطابات المعلبة إلى ساحة مواجهة ناعمة: كلمات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وضعتهم في قفص الاتهام دون أن تمنحهم شرف ذكر أسمائهم. يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودًا ويخططون لاغتيال أعضائها.. اللغة العربية تعرف قوة الضمير، خصوصًا الضمير المستتر الذي لا يُذكر لفظًا لكنه يُفهم معنى. في خطاب الأمير الضمير هنا مستتر كالذي يختبئ خلف الأحداث، يحرّكها في الخفاء، لكنه لا يجرؤ على الظهور علنًا. استخدام هذا الأسلوب لم يكن محض صدفة لغوية، بل ذكاء سياسي وبلاغي رفيع ؛ إذ جعل كل مستمع يربط الجملة مباشرة بالفاعل الحقيقي في ذهنه من دون أن يحتاج إلى تسميته. ذكاء سياسي ولغوي في آن واحد».... هذا الاستخدام ليس صدفة لغوية، بل استراتيجية بلاغية. في الخطاب السياسي، التسمية المباشرة قد تفتح باب الردّ والجدل، بينما ضمير الغائب يُربك الخصم أكثر لأنه يجعله يتساءل: هل يقصدني وحدي؟ أم يقصد غيري معي؟ إنّه كالسهم الذي ينطلق في القاعة فيصيب أكثر من صدر. محكمة علنية بلا أسماء: لقد حول الأمير خطابًا قصيرًا إلى محكمة علنية بلا أسماء، لكنها محكمة يعرف الجميع من هم المتهمون فيها. وهنا تتجلى العبارة الأبلغ، أن الضمير المستتر في النص كان أبلغ حضورًا من أي تصريح مباشر. العالم في مرآة قطر: في النهاية، لم يكن ضمير المستتر في خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله - مجرد أداة لغوية؛ بل كان سلاحًا سياسيًا صامتًا، أشد وقعًا من الضجيج. لقد أجبر العالم على أن يرى نفسه في مرآة قطر. وما بين الغياب والحضور، تجلت الحقيقة أن القيمة تُقاس بجرأة الموقف لا باتساع الأرض، وأن الكلمة حين تُصاغ بذكاء قادرة على أن تهز أركان السياسات الدولية كما تعجز عنها جيوش كاملة. فالمخاطَب يكتشف أن المرآة وُضعت أمامه من دون أن يُذكر اسمه. تلك هي براعة السياسة: أن تُدين خصمك من دون أن تمنحه شرف الذكر.
5568
| 25 سبتمبر 2025
- 2 بائع متجول
يطلّ عليك فجأة، لا يستأذن ولا يعلن عن نفسه بوضوح. تمرّ في زقاق العمر فتجده واقفًا، يحمل على كتفه صندوقًا ثقيلًا ويعرض بضاعة لا تشبه أي سوق عرفته من قبل. لا يصرخ مثل الباعة العاديين ولا يمد يده نحوك، لكنه يعرف أنك لن تستطيع مقاومته. في طفولتك كان يأتيك خفيفًا، كأنه يوزّع الهدايا مجانًا. يمد يده فتتساقط منها ضحكات بريئة وخطوات صغيرة ودهشة أول مرة ترى المطر. لم تكن تسأله عن السعر، لأنك لم تكن تفهم معنى الثمن. وحين كبُرت، صار أكثر استعجالًا. يقف للحظة عابرة ويفتح صندوقه فتلمع أمامك بضاعة براقة: أحلام متوهجة وصداقات جديدة وطرق كثيرة لا تنتهي. يغمرك بالخيارات حتى تنشغل بجمعها، ولا تنتبه أنه اختفى قبل أن تسأله: كم ستدوم؟ بعد ذلك، يعود إليك بهدوء، كأنه شيخ حكيم يعرف سرّك. يعرض ما لم يخطر لك أن يُباع: خسارات ودروس وحنين. يضع أمامك مرآة صغيرة، تكتشف فيها وجهًا أنهكته الأيام. عندها تدرك أن كل ما أخذته منه في السابق لم يكن بلا مقابل، وأنك دفعت ثمنه من روحك دون أن تدري. والأدهى من ذلك، أنه لا يقبل الاسترجاع. لا تستطيع أن تعيد له طفولتك ولا أن تسترد شغفك الأول. كل ما تملكه منه يصبح ملكك إلى الأبد، حتى الندم. الغريب أنه لا يظلم أحدًا. يقف عند أبواب الجميع ويعرض بضاعته نفسها على كل العابرين. لكننا نحن من نتفاوت: واحد يشتري بتهور وآخر يضيّع اللحظة في التفكير وثالث يتجاهله فيفاجأ أن السوق قد انفض. وفي النهاية، يطوي بضاعته ويمضي كما جاء، بلا وداع وبلا عودة. يتركك تتفقد ما اشتريته منه طوال الطريق، ضحكة عبرت سريعًا وحبًا ترك ندبة وحنينًا يثقل صدرك وحكاية لم تكتمل. تمشي في أثره، تفتش بين الزوايا عن أثر قدميه، لكنك لا تجد سوى تقاويم تتساقط كالأوراق اليابسة، وساعات صامتة تذكرك بأن البائع الذي غادرك لا يعود أبدًا، تمسح العرق عن جبينك وتدرك متأخرًا أنك لم تكن تتعامل مع بائع عادي، بل مع الزمن نفسه وهو يتجول في حياتك ويبيعك أيامك قطعةً قطعة حتى لا يتبقى في صندوقه سوى النهاية.
5409
| 26 سبتمبر 2025
- 3 في وداع لطيفة
هناك لحظات تفاجئ المرء في منتصف الطريق، لحظات لا تحتمل التأجيل ولا المجاملة، لحظات تبدو كأنها قادمة من عمق الذاكرة لتذكره بأن الحياة، مهما تزينت بضحكاتها، تحمل في جيبها دائمًا بذرة الفقد. كنتُ أظن أني تعلّمت لغة الغياب بما يكفي، وأنني امتلكت مناعة ما أمام رحيل الأصدقاء، لكن موتًا آخر جاء هذه المرة أكثر اقترابًا، أكثر إيغالًا في هشاشتي، حتى شعرتُ أن المرآة التي أطل منها على وجهي اليوم ليست إلا ظلًّا لامرأة كانت بالأمس بجانبي. قبل أيام قليلة رحلت صديقتي النبيلة لطيفة الثويني، بعد صراع طويل مع المرض، صراع لم يكن سوى امتحان صعب لجسدها الواهن وإرادتها الصلبة. كانت تقاتل الألم بابتسامة، كأنها تقول لنا جميعًا: لا تسمحوا للوجع أن يسرقكم من أنفسكم. لكن ماذا نفعل حين ينسحب أحدهم فجأة من حياتنا تاركًا وراءه فراغًا يشبه هوة بلا قاع؟ كيف يتهيأ القلب لاستيعاب فكرة أن الصوت الذي كان يجيب مكالماتنا لم يعد موجودًا؟ وأن الضحكة التي كانت تفكّك تعقيدات أيامنا قد صمتت إلى الأبد؟ الموت ليس حدثًا يُحكى، بل تجربة تنغرس في الروح مثل سكين بطيئة، تجبرنا على إعادة النظر في أبسط تفاصيل حياتنا. مع كل رحيل، يتقلص مدى الأمان من حولنا. نشعر أن الموت، ذلك الكائن المتربّص، لم يعد بعيدًا في تخوم الزمن، بل صار يتجوّل بالقرب منا، يختبر خطواتنا، ويتحرّى أعمارنا التي تتقارب مع أعمار الراحلين. وحين يكون الراحل صديقًا يشبهنا في العمر، ويشاركنا تفاصيل جيل واحد، تصبح المسافة بيننا وبين الفناء أقصر وأكثر قسوة. لم يعد الموت حكاية كبار السن، ولا خبرًا يخص آخرين، بل صار جارًا يتلصص علينا من نافذة الجسد والذاكرة. صديقتي الراحلة كانت تمتلك تلك القدرة النادرة على أن تراك من الداخل، وأن تمنحك شعورًا بأنك مفهوم بلا حاجة لتبرير أو تفسير. لهذا بدا غيابها ثقيلاً، ليس لأنها تركت مقعدًا فارغًا وحسب، بل لأنها حملت معها تلك المساحة الآمنة التي يصعب أن تجد بديلًا لها. أفكر الآن في كل ما تركته خلفها من أسئلة. لماذا نُفاجأ بالموت كل مرة وكأنها الأولى؟ أليس من المفترض أن نكون قد اعتدنا حضوره؟ ومع ذلك يظل الموت غريبًا في كل مرة، جديدًا في صدمته، جارحًا في اختباره، وكأنه يفتح جرحًا لم يلتئم أبدًا. هل نحن من نرفض التصالح معه، أم أنه هو الذي يتقن فنّ المداهمة حتى لو كان متوقعًا؟ ما يوجعني أكثر أن رحيلها كان درسًا لا يمكن تجاهله: أن العمر ليس سوى اتفاق مؤقت بين المرء وجسده، وأن الألفة مع الحياة قد تنكسر في لحظة. كل ابتسامة جمعتها بنا، وكل كلمة قالتها في محاولة لتهوين وجعها، تتحول الآن إلى شاهد على شجاعة نادرة. رحيلها يفضح ضعفنا أمام المرض، لكنه في الوقت ذاته يكشف جمال قدرتها على الصمود حتى اللحظة الأخيرة. إنها واحدة من تلك الأرواح التي تترك أثرًا أبعد من وجودها الجسدي. صارت بعد موتها أكثر حضورًا مما كانت عليه في حياتها. حضور من نوع مختلف، يحاورنا في صمت، ويذكّرنا بأن المحبة الحقيقية لا تموت، بل تعيد ترتيب نفسها في قلوبنا. وربما لهذا نشعر أن الغياب ليس غيابًا كاملًا، بل انتقالًا إلى شكل آخر من الوجود، وجود نراه في الذكريات، في نبرة الصوت التي لا تغيب، في اللمسة التي لا تزال عالقة في الذاكرة. أكتب عن لطيفة رحمها الله اليوم ليس لأحكي حكاية موتها، بل لأواجه موتي القادم. كلما فقدت صديقًا أدركت أن حياتي ليست طويلة كما كنت أتوهم، وأنني أسير في الطريق ذاته، بخطوات متفاوتة، لكن النهاية تظل مشتركة. وما بين بداية ونهاية، ليس أمامي إلا أن أعيش بشجاعة، أن أتمسك بالبوح كما كانت تفعل، وأن أبتسم رغم الألم كما كانت تبتسم. نعم.. الحياة ليست سوى فرصة قصيرة لتبادل المحبة، وأن أجمل ما يبقى بعدنا ليس عدد سنواتنا، بل نوع الأثر الذي نتركه في أرواح من أحببنا. هكذا فقط يمكن أن يتحول الموت من وحشة جارحة إلى معنى يفتح فينا شرفة أمل، حتى ونحن نغالب الفقد الثقيل. مثواك الجنة يا صديقتي.
4434
| 29 سبتمبر 2025