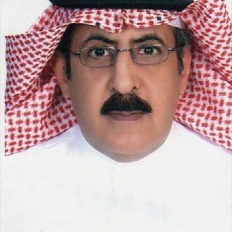رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
806
حمد عبدالرحمن المانعيجب أن تتضافر الجهود لمحاربة قطع غيار السيارات المقلدة
يتخذ الحديث عن السيارات جانباً مؤثراً لما لهذا المنتج الحضاري المبهر من أهمية بالغة من حيث الاستخدام، والذي أحدث طفرة في عالم النقل سريعة ومتوسطة وثقيلة إضافة إلى التطور التقني الذي واكب هذه الصناعة وما زال حيث أصبحت أشبه بغرف متنقلة لما تحتويه من عناصر الرفاهية ما انعكس بطبيعة الحال على مقتنيي المركبة ومستعمليها، وبقدر ما ترتبط السيارات بعوامل في غاية الأهمية بقدر ما تحمله أيضاً من مخاطر نتيجة لسوء استخدام هذا المنتج وما تلحقه من أضرار إذ إنها لا تتوانى في حصد الأرواح متى ما غاب التعقل في استخدامها، ومن ضمن المخاطر التي تهدد صحة الإنسان ولا ريب المركبات، ففي الوقت الذي يهب العالم بأكمله في الحرص على تطوير أدوات السلامة يبرز ما يهدد هذه الجهود بل ويصيبها في مقتل ألا وهي قطع الغيار المقلدة، والحديث عن قطع غيار السيارات أو بالأحرى عصب الحركة الصناعية في هذا المجال إذ إنه يمس وبصورة مباشرة الحياة الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء وقطع غيار السيارة قد تتجاوز الـ 50 ألف صنف على اختلاف المواصفات وهذا يحتم على الوكيل تأمينها في كل الحالات طبقاً لالتزامه بالأنظمة المرعية بهذا الخصوص ومن منطلق التزامه الأدبي وحرصه على سمعة المنتج وتسويقه. وإذا كانت الوكالات ملتزمة التزاما كاملاً بتأمين قطع الغيار للمنتج للاعتبارات سالفة الذكر، فإن مسألة التحكم في هذا الكم الهائل من الأصناف التي يتم استيرادها ومن ثم تأمينها للعميل تواجه في بعض الأحيان مصاعب، ورغم مساهمة الكمبيوتر الفاعلة في هذه الناحية إلا أنها تخضع لعدة عوامل، فعلى سبيل المثال عند هطول الأمطار يكون الطلب مضاعفاً لأصناف محددة ما يساهم في تكدس قطع غير مباعة لتشكل عبئاً على الوكالة في حين أن أنواع القطع تختلف من صنف لآخر من حيث الحركة، فهناك ما يتحرك منها بشكل سريع وهناك المتوسط وهناك البطيء إضافة إلى القطع التي ربما تطلب في السنة مرة واحدة وكذلك قطع ربما لا تطلب بتاتاً ويتم تأمينها من الوكيل من واقع التزامه بتأمينها، وهذه القطع الراكدة غير المباعة والتي يتم تصنيعها بدقة في نهاية الأمر تباع على شكل حديد لتنصهر تحت ألسنة اللهب غير مستفاد منها مشكلة جانباً للهدر والسؤال الذي أود طرحه حقيقة عن مدى إمكانية الاستفادة من هذه القطع وإعادة تدويرها ومن جانب آخر فإن استهلاك السيارات ليس كباقي المنتجات الأخرى ينتهي بمدة محدودة إذ يمتد إلى سنوات بل عقود ما يتطلب أيضاً الحضور الدائم للوكيل بحكم ارتباطه الوثيق بالمورد والتزامه أيضاً بتقديم خدمة ما بعد البيع حتى وإن كان البيع قد تم قبل عقدين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. وجود الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المنتج نواة لاستمرار الأفكار الخلاقة وتجسيدها واقعا على الأرض، التدريب عامل رئيس في صقل المدارك ومحاكات الاستيعاب من واقع التجارب المختلفة ولا ريب أن وكالات السيارات أسهمت وبشكل كبير في أداء أدوار إيجابية وفق تمرير الثقافة الصناعية لاسيَّما في مجال السيارات، والوكالات المختلفة تحرص على عامل الجودة ولاشك أن التنافس في هذا المضمار خلق تفاعلا انسيابيا منسجما مع المتطلبات وما يستجد سواء من ناحية صيانة المنتج أو من ناحية الإضافات وفق ما يطرأ على كل موديل من مستجدات واختلاف للمواصفات في الموديل الواحد فضلا عن ما يواكب التصنيع من عيوب في بعض الحالات وهي نادرة وسهولة اتصال الوكالة بعملائها بات يسيرا. والحد من مخاطر القطع المقلدة تحديدا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حيث إن المركبة مرتبطة بالمخاطر كما أسلفت بشكل مباشر، ولا يخفى على الجميع سلبية انتشار القطع المقلدة للسيارات، ورغم الجهود التي تبذل بهذا المجال إلا أنه قد يتم تسريبها بشكل أو بآخر ومدى خطورتها خصوصا فيما يتعلق بالمكابح والمساعدات، وكذلك الزجاج ورداءة تصنيعه ما قد يتسبب في إلحاق الأذى بقائد المركبة ومن معه، وكثيراً ما نشاهد سيارات محترقة نتيجة لاستخدام القطع الكهربائية المقلدة والتي تعتبر المتاجرة بها أو ترويجها أو استخدامها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون في بعض الدول، وفي تقديري فإن مشاركة الوكالات بتفعيل الجانب التوعوي وأيضاً الفروقات بين الأصلي والمقلد ما يساهم بإذن الله في الحد من انتشارها ومكملاً للجهود المبذولة بهذا الخصوص وصولاً إلى اختفاء هذه القطع والحد من مخاطرها. ولما للنشرات التوضيحية من أهمية قصوى فإن الوكالات تستطيع المساهمة وحماية الناس ومنتجاتها، إن التكامل الموضوعي مطلب ملح لمواجهة هذا الخطر الذي يتربص بالناس وممتلكاتهم وأعني بذلك أن يكون التعاون معبرا لتحقيق الأمان والاطمئنان فحماية المستهلك وإدارة المرور والجمعيات المعنية بالنقل ووسائله ووكالات السيارات بتجاربها وكوادرها الفنية بالتعاون مع الصانعين يستطيعون بإذن الله تفعيل إستراتيجية فاعلة وملموسة في النهوض بتعزيز الجانب الوقائي لمخاطر الصناعة من خلال نشرات توضح الفروقات بين الأصلي والمقلد وبالتالي فإن المستهلك هو من يسهم في حماية نفسه ومركبته كأن توضع النشرات التوضيحية لاسيَّما المرتبطة بالسلامة مع كل سيارة ناهيك عن ما يتعلق بمواعيد تغيير السوائل وأنواعها، وكذلك مواعيد الصيانة ما يساهم وبشكل فاعل في تفادي الأعطال التي تنتج للمركبة من جراء الإهمال وعدم الالتزام بمواعيد التغيير تلك، فإذا كانت هذه التعليمات الأساسية قد أدرجت بخط كبير واضح ووضعت في مكان بارز داخل المركبة فإنها ستجد الاهتمام. إن تفعيل التواصل بين الوكالات والجهات ذات العلاقة في إطار الوقاية من الأهمية بمكان والتعاون المثمر البناء من شأنه بناء جسر ثقة والعمل جنباً إلى جنب في المحافظة على السلامة فالسلامة هي الهدف. أدام الله على الجميع السلامة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
قطر والأمم المتحدة.. احتفاء بالشراكة في ذكرى تأسيس المنظمة

رأي الشرق
-
الاضطراب الجماعي.. مجتمع ينخره الرعب!

جاسم الشمري
-
صدقت يا صاحب السمو.. وطنياً وعربياً ودولياً

د. أحمد القديدي
-
تأهيل ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمع

فيصل محمد
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 الكرسي الفارغ
ليس الفراغ في الأماكن، بل في الأشخاص الذين لم يتقنوا الجلوس في أماكنهم. كم من مقعدٍ امتلأ جسدًا، وظلّ فارغًا فكرًا، وإحساسًا، وموقفًا. الكرسي لا يمنح الهيبة، بل من يجلس عليه هو من يمنح المكان معناه. المدرب… حين يغيب التأثير: المدرب الذي لا يملأ مقعده، هو من يكرّر المعلومات دون أن يُحدث تحولًا في العقول. يشرح بجمود، ويتحدث بثقة زائفة، ثم يغادر دون أن يترك بصمة. الحل أن يفهم أن التدريب رسالة لا مهنة، وأن حضوره يقاس بتغيير الفكر والسلوك بعده. وعندما يغيب هذا الإدراك، يتحول التدريب إلى ترفٍ ممل، ويفقد المجتمع طاقاته الواعدة التي تحتاج إلى من يشعل فيها شرارة الوعي. المدير… حين يغيب القرار: المدير الذي لا يملأ كرسيه، يهرب من المسؤولية بحجة المشورة، ويُغرق فريقه في اجتماعات لا تنتهي. الحل: أن يدرك أن القرار جزء من القيادة، وأن التردد يقتل الكفاءة. وعندما يغيب المدير الفاعل، تُصاب المؤسسة بالجمود، وتتحول بيئة العمل إلى طابور انتظار طويل بلا توجيه. القائد… حين يغيب الإلهام: القائد الذي لا يملك رؤية، لا يملك أتباعًا بل موظفين. الحل: أن يزرع في فريقه الإيمان لا الخوف، وأن يرى في كل فرد طاقة لا أداة. غياب القائد الملهم يعني غياب الاتجاه، فتضيع الجهود، ويضعف الولاء المؤسسي، ويختفي الشغف الذي يصنع التميز. المعلم… حين يغيب الوعي برسالته: المعلم الذي يجلس على كرسيه ليؤدي واجبًا، لا ليصنع إنسانًا، يفرغ التعليم من رسالته. الحل: أن يدرك أنه يربّي أجيالًا لا يلقّن دروسًا. وحين يغيب وعيه، يتخرّج طلاب يعرفون الحروف ويجهلون المعنى، فيُصاب المجتمع بسطحية الفكر وضعف الانتماء. الإعلامي… حين يغيب الضمير: الإعلامي الذي لا يملأ كرسيه بالمصداقية، يصبح أداة تضليل لا منبر وعي. الحل: أن يضع الحقيقة فوق المصلحة، وأن يدرك أن الكلمة مسؤولية. وعندما يغيب ضميره، يضيع وعي الجمهور، ويتحول الإعلام إلى سوقٍ للضجيج بدل أن يكون منارة للحق. الطبيب… حين يغيب الإحساس بالإنسان: الطبيب الذي يرى في المريض رقمًا لا روحًا، ملأ كرسيه علمًا وفرّغه إنسانية. الحل: أن يتذكر أن الطب ليس مهنة إنقاذ فقط، بل مهنة رحمة. وحين يغيب هذا البعد الإنساني، يفقد المريض الثقة، ويصبح الألم مضاعفًا، جسديًا ونفسيًا معًا. الحاكم أو القاضي… حين يغيب العدل: الحاكم أو القاضي الذي يغفل ضميره، يملأ الكرسي رهبة لا هيبة. الحل: أن يُحيي في قراراته ميزان العدالة قبل أي شيء. فحين يغيب العدل، ينهار الولاء الوطني، ويُصاب المجتمع بتآكل الثقة في مؤسساته. الزوج والزوجة… حين يغيب الوعي بالعلاقة: العلاقة التي تخلو من الإدراك والمسؤولية، هي كرسيان متقابلان لا روح بينهما. الحل: أن يفهما أن الزواج ليس عقداً اجتماعياً فحسب، بل رسالة إنسانية تبني مجتمعاً متماسكاً. وحين يغيب الوعي، يتفكك البيت، وينتج جيل لا يعرف معنى التوازن ولا الاحترام. خاتمة الكرسي ليس شرفًا، بل تكليف. وليس مكانًا يُحتل، بل مساحة تُملأ بالحكمة والإخلاص. فالمجتمعات لا تنهض بالكراسي الممتلئة بالأجساد، بل بالعقول والقلوب التي تعرف وزنها حين تجلس… وتعرف متى تنهض.
5067
| 20 أكتوبر 2025
- 2 من يُعلن حالة الطوارئ المجتمعية؟
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتصارع فيه المفاهيم، باتت القيم المجتمعية في كثيرٍ من المجتمعات العربية أقرب إلى «غرفة الإنعاش» منها إلى الحياة الطبيعية. القيم التي كانت نبض الأسرة، وعماد التعليم، وسقف الخطاب الإعلامي، أصبحت اليوم غائبة أو في أحسن الأحوال موجودة بلا ممارسة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يُعلن حالة الطوارئ لإنقاذ القيم قبل أن تستفحل الأزمات؟ أولاً: التشخيص: القيم تختنق بين ضجيج المظاهر وسرعة التحول: لم يعد ضعف القيم مجرد ظاهرة تربوية؛ بل أزمة مجتمعية شاملة فنحن أمام جيلٍ محاط بالإعلانات والمحتوى السريع، لكنه يفتقد النماذج التي تجسّد القيم في السلوك الواقعي. ثانياً: الأدوار المتداخلة: من المسؤول؟ إنها مسؤولية تكاملية: - وزارة التربية والتعليم: إعادة بناء المناهج والأنشطة اللاصفية على قيم العمل والانتماء والمسؤولية، وربط المعرفة بالسلوك. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: تجديد الخطاب الديني بلغة العصر وتحويل المساجد إلى منصات توعية مجتمعية. - وزارة الثقافة: تحويل الفنون والمهرجانات إلى رسائل تُنعش الوعي وتُعيد تعريف الجمال بالقيمة لا بالمظهر. - وزارة الإعلام: ضبط المحتوى المرئي والرقمي بما يرسّخ الوعي الجمعي ويقدّم نماذج حقيقية. - وزارة التنمية الاجتماعية: تمكين المجتمع المدني، ودعم المبادرات التطوعية، وترسيخ احترام التنوع الثقافي باعتباره قيمة لا تهديدًا. ثالثاً: الحلول: نحو حاضنات وطنية للقيم: إن مواجهة التراجع القيمي لا تكون بالشعارات، بل بإنشاء حاضنات للقيم الوطنية تعمل مثل حاضنات الأعمال، لكنها تستثمر في الإنسان لا في المال. هذه الحاضنات تجمع التربويين والإعلاميين والمثقفين وخبراء التنمية لتصميم برامج عملية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب تُترجم القيم إلى ممارسات يومية، وتنتج مواد تعليمية وإعلامية قابلة للتكرار والقياس. كما يمكن إطلاق مؤشر وطني للقيم يُقاس عبر استطلاعات وسلوكيات مجتمعية، لتصبح القيم جزءًا من تقييم الأداء الوطني مثل الاقتصاد والتعليم. رابعا: تكامل الوزارات:غرفة عمليات مشتركة للقيم: لا بد من إطار حوكمة ؛ • إنشاء مجلس وطني للقيم يُمثّل الوزارات والجهات الأهلية، يضع سياسة موحّدة وخطة سنوية ملزِمة. مؤشرات أداء مشتركة • تُدرج في اتفاقيات الأداء لكل وزارة • منصة بيانات موحّدة لتبادل المحتوى والنتائج تُعلن للناس لتعزيز الشفافية. • حملات وطنية متزامنة تُبث في المدارس والمساجد والمنصات الرقمية والفنون، بشعار واحد ورسائل متناسقة. • عقود شراكة مع القطاع الخاص لرعاية حاضنات القيم وبرامج القدوة، وربط الحوافز الضريبية أو التفضيلية بحجم الإسهام القيمي. الختام..... من يُعلن حالة الطوارئ؟ إنقاذ القيم لا يحتاج خطابًا جديدًا بقدر ما يحتاج إرادة جماعية وإدارة محترفة. المطلوب اليوم حاضنات قيم، ومجلس تنسيقي، ومؤشرات قياس، وتمويل مستدام. عندها فقط سننقل القيم من شعارات تُرفع إلى سلوك يُمارس، ومن دروس تُتلى إلى واقع يُعاش؛ فيحيا المجتمع، وتموت الأزمات قبل أن تولد.
4938
| 24 أكتوبر 2025
- 3 النعش قبل الخبز
لم تكنِ المأساةُ في غزّةَ بعددِ القتلى، بل في ترتيبِ الأولويات؛ لأن المفارقةَ تجرحُ الكرامةَ وتؤلمُ الروحَ أكثرَ من الموت. ففي الوقتِ الذي كانتْ فيهِ الأمهاتُ يبحثنَ بينَ الركامِ عن فلذاتِ أكبادِهِنَّ أو ما تبقّى منهُم، كانتْ إسرائيلُ تُحصي جثثَها وتُفاوِضُ العالمَ لتُعيدَها قبلَ أن تسمحَ بعبورِ شاحنةِ دواءٍ أو كيسِ طحينٍ. وكأنَّ جُثثَ جنودِها تَستحقُّ الضوء، بينما أَجسادُ الفلسطينيينَ تُدفنُ في العتمةِ بلا اسمٍ ولا وداعٍ ولا حتى قُبلةٍ أَخيرةٍ. فكانتِ المفاوضاتُ تُدارُ على طاولةٍ باردةٍ، فيها جُثثٌ وجوعٌ وصُراخٌ ودُموعٌ، موتٌ هنا وانتظارٌ هناك. لم يكنِ الحديثُ عن هدنةٍ أو دواءٍ، بل عن أشلاءٍ يُريدونَها أولًا، قبلَ أن تَعبُرَ شُحنةُ حياةٍ. أيُّ منطقٍ هذا الذي يجعلُ الجُثّةَ أَكثرَ استحقاقًا من الجائعِ، والنّعشَ أسبقَ من الرّغيف؟ أيُّ منطقٍ ذاك الذي يُقلِبُ موازينَ الرحمةِ حتى يُصبحَ الموتُ امتيازًا والحياةُ جريمةً؟ لقد غدتِ المساعداتُ تُوزَّعُ وفق جدولٍ زمنيٍّ للموتى، لا لاحتياجاتِ الأحياء، صارَ من يُدفنُ أَسرعَ ممن يُنقذُ، وصارتِ الشواهدُ تُرفَعُ قبلَ الأرغفةِ. في غزّةَ لم يَعُدِ الناسُ يَسألونَ متى تَصلُ المساعداتُ، بل متى تُرفَعُ القيودُ عن الهواء. فحتى التنفّسُ صارَ ترفًا يَحتاجُ تصريحًا. في كلِّ زُقاقٍ هناكَ انتظارٌ، وفي كلِّ انتظارٍ صبرُ جبلٍ، وفي كلِّ صبرٍ جُرحٌ لا يندملُ. لكنَّ رغمَ كلّ ذلك ما زالتِ المدينةُ تَلِدُ الحياةَ من قلبِ موتِها. هُم يَدفنونَ موتاهم في صناديقِ الخشبِ، ونحنُ نَدفنُ أحزانَنا في صدورِنا فتُزهِرُ أملًا يُولَدُ. هُم يَبكونَ جُنديًّا واحدًا، ونحنُ نَحمِلُ آلافَ الوُجوهِ في دَمعَةٍ تُسقي الأرضَ لتَلِدَ لنا أَحفادَ من استُشهِدوا. في غزّةَ لم يكنِ الوقتُ يَتَّسِعُ للبُكاءِ، كانوا يَلتقطونَ ما تَبقّى من الهواءِ لِيَصنَعوا منه بروحِ العزِّ والإباء. كانوا يَرونَ العالمَ يُفاوِضُ على موتاهُ، ولا أَحدَ يَذكُرُهم بكلمةٍ أو مُواساةٍ، بينما هُم يُحيونَ موتاهُم بذاكرةٍ لا تَموتُ، ومع ذلك لم يَصرُخوا، لم يَتوسَّلوا، لم يَرفَعوا رايةَ ضعفٍ، ولم يَنتظروا تلكَ الطاولةَ أن تَتكلَّمَ لهم وعَنهُم، بل رَفَعوا وُجوهَهم إلى السماء يقولون: إن لم يكن بك علينا غضبٌ فلا نُبالي. كانتِ إسرائيلُ تَحصُي خَسائِرَها في عَدَدِ الجُثَث، وغزّة تَحصُي مَكاسِبَها في عَدَدِ مَن بَقوا يَتَنفَّسون. كانت تُفاخر بأنها لا تَترُكُ قَتلاها، بينما تَترُكُ حياةَ أُمّةٍ بأَكملها تَختَنِقُ خلفَ المَعابِر. أيُّ حضارةٍ تلكَ التي تُقيمُ الطقوسَ لِموتاها، وتَمنَعُ الماءَ عن طفلٍ عطشان؟ أيُّ دولةٍ تلكَ التي تُبجِّلُ جُثَثَها وتَتركُ الإنسانيّةَ تحتَ الرُّكام؟ لقد كانتِ المفاوضاتُ صورةً مُكثَّفةً للعالمِ كُلِّه؛ عالمٍ يَقِفُ عندَ الحدودِ يَنتظر “اتِّفاقًا على الجُثَث”، بينما يَموتُ الناسُ بلا إِذنِ عُبورٍ. لقد كشفوا عن وجوهِهم حينَ آمَنوا أن عودةَ جُثّةٍ مَيتةٍ أَهمُّ من إِنقاذِ أرواحٍ تَسرِقُ الأَنفاس. لكن غزّة كالعادة كانتِ الاستثناءَ في كلِّ شيءٍ وصَدمةً للأعداءِ قبل غيرِهم، وهذا حديثهم ورأيهم. غزّة لم تَنتظر أَحدًا ليُواسيَها، ولم تَسأَل أَحدًا ليَمنَحَها حَقَّها. حينَ اِنشَغَلَ الآخرونَ بعدَّ الجُثَث، كانت تُحصي خُطواتها نحو الحياة، أَعادت تَرتيبَ أَنقاضِها كأنها تَبني وطنًا جديدًا فوقَ عِظامِ مَن ماتوا وُقوفًا بشموخ، وأَعلَنَت أنَّ النَّبضَ لا يُقاس بعددِ القلوبِ التي توقَّفَت، بل بعددِ الذين ما زالوا يَزرَعونَ المستقبل، لأنَّ المستقبل لنا. وهكذا، حين يَكتُب التاريخُ سطره الأخير، لن يَقول من الذي سلّم الجُثَث، بل من الذي أَبقى على رُوحه حيّة. لن يَذكُر عددَ التوابيت، بل عددَ القلوب التي لم تَنكسِر. دولةُ الكيان الغاصب جَمَعَت موتاها، وغزّة جمَعَت نَفسها. هم دَفَنوا أَجسادَهم، وغزّة دَفَنَت بُذورَ زيتونِها الذي سَيُضيء سَنا بَرقه كل أُفق. هم احتَفلوا بالنِّهاية، وغزّة تَفتَح فَصلًا من جديد. في غزّة، لم يَكُنِ الناس يَطلُبون المعجزات، كانوا يُريدون فقط جُرعةَ دواءٍ لِطفلٍ يحتضر، أو كِسرةَ خُبزٍ لامرأةٍ عَجوز. لكن المعابِر بَقِيَت مُغلَقة لأن الأَموات من الجانب الآخر لم يُعادوا بعد. وكأنَّ الحياة هُنا مُعلَّقة على جُثّة هناك. لم يَكُن العالم يسمع صُراخَ الأَحياء، بل كان يُصغي إلى صَمتِ القُبور التي تُرضي إسرائيل أكثر مما تُرضي الإنسانية.
3699
| 21 أكتوبر 2025