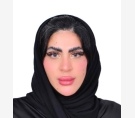رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
4775
كمال أوزتوركقوانين الحرب وأخلاق الصراعات
قوانين الحرب، هي أخلاق الصراعات.
علينا أن نكافح لنحافظ على إنسانيتنا حتى في أقسى الحروب وأكثر المعارك وحشية، لذا فإن القوانين والأخلاق، هي الرابط الذي يحافظ على بقائنا داخل حدود الإنسانية، في أكثر اللحظات التي يسيطر علينا فيها الانفعال والدوافع المتوحشة. وهنا علينا أن نتذكر دومًا بأن تمكننا من الحفاظ على الحياة الإنسانية خلال المعارك هو الذي يعلي من قدرنا، لا المحافظة على تلك الحياة في زمن السلم فقط.
هنالك سلوكيات معينة يجب انعدام تخطي حدودها زمن الحرب، تعرف باسم "قوانين الحرب"، ولعل من أبرزها، عدم قتل الأسرى، وتعريضهم للتعذيب، أو قتل الأطفال، أو اغتصاب النساء، أو ارتكاب مجازر إبادة جماعية منظمة.. وفي حال تم ارتكاب أي نوع من تلك التجاوزات، فإن مرتكبيها يدرجون في قائمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ويصنفون خارج التصنيفات المتعلقة بالجنس البشري.
إن الدين والأخلاق والأعراف، هي عناصر تحد من رغبات القتل والسحق والإزالة من الوجود، التي تكمن داخل البشر ضد أبناء جنسهم، وهي النواة المشكلة للقوانين الناظمة، لذا فإن قوانين الحرب، ولدت من رحم حاجة الإنسان لحماية نفسه من الفظائع التي يرتكبها أبناء جنسه.
داسوا على "قوانين الرب بأرجلهم"
تطرق الهولندي "هوغو غروتيوس" رائد القانون الدولي الحديث، إلى المشاكل المتعلقة بقانون الحرب، في بحثه الذي خطه عام 1625 فقال: "لقد اتبعت الأمم المسيحية في الحروب، وسائل مريعة لم يتبعها حتى البرابرة، وداست تلك الأمم خلال الحروب، على جميع القوانين سواء تلك التي شرّعها الله، أو التي وضعها الإنسان". (قانون الحرب والسلام، منشورات ساي).
ومع الأسف، فإن أوروبا لم تتمكن من إقرار ميثاق مشترك، حول قوانين الحرب، وجرائمها، والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، إلا بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها.
لقد بيّن الدين الإسلامي قانون الحرب، قبل أن تقره أوروبا بنحو 1300 سنة. كما نهت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المسلمين، عن بعض السلوكيات التي يمكن اعتبارها على أنها "جرائم ضد الإنسانية"، وشددت على ضرورة عدم قيام المسلمين بها أثناء الحرب.
كما حض الإسلام على تعزيز السلام وخلق أجوائه، ولم يحض على الحروب والأعمال التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وشدد على بعض الحدود، التي يجب على المسلمين احترامها وعدم تجاوزها، حتى في حالة تعرضهم للعدوان، فقال الله تعالى في سورة البقرة (الآية 190) "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".
وأبرز مثال على الأخلاق: الصفح عن "وحشي بن حرب"
لقد كانت السنوات الأكثر صعوبة على رسول الله، حيث كان المشركون المتفوقون عدديًا، قاب قوسين أو أدنى من سحق المسلمين، الأقل منهم عددًا وعدّة، وفي هذه الظروف، وقعت معركة أحد، التي استشهد فيها سيدنا حمزة بن عبد المطلب، عم النبي وحميه ومعينه في الشدائد.. استشهد بوحشية على يدي غلام يدعى "وحشي بن حرب"، وقطعت أوصاله، وشق بطنه، وقطِّعَ كبده.. لقد تجرد المشركون من إنسانيتهم في طريقة قتلهم لحمزة، وباتوا كحيوانٍ متوحش.
لقد أدى استشهاد حمزة، إلى قلق عميق، ممزوجٍ بالحزن والغضب في نفوس المسلمين، وتوعد بالثأر من العدو، وقتل العشرات من رجاله، وإراقة المزيد من الدماء.. فأنزل الله جل وعلا آية كريمة تؤكّد على ضرورة تحلي النبي والمسلمين بالفضيلة والإنسانية، رغم مقتل عم النبي حمزة بأكثر الوسائل وحشية على يد المشركين، حيث قال جل وعلى في سورية النحل، (آية 125 – 128): "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ (128)".
من الصعب أن يحافظ الإنسان على إنسانيته في أجواء الحرب، لكن من الأصعب أن يحافظ على إسلامه والأخلاق التي حض الإسلام على التحلي بها خلال الحرب، لقد نزلت التوصية الإلهية للنبي المكلوم والمفجوع بسبب مقتل عمه بمنتهى الوحشية، داعية إياه إلى عدم الرد بنفس الوسائل الوحشية، وإلى الصبر.. نعم الصبر وعدم الاندفاع نحو الأخذ بالثأر.. فصفح رسول الله عن "وحشي بن حرب"، ومنع الثأر.. هكذا تكون مكارم الأخلاق، وهكذا يكون الدين الطيب السمح الجميل، وهكذا يكون الإنسان.
تخيلوا لو أن عدوًا اعتدى على دياركم، وأحرق مدنكم، وقتل أهلكم، واغتصب نساءكم، فهل ستنحدرون إلى مستواه اللا إنساني في الرد بالمثل وأخذ الثأر؟، يرد عمر المختار قائلًا: "بالطبع لا.. لأنهم ليسوا معلمينا وقدوتنا في هذه الحياة".. ويقول علي عزت بيجوفيتش:"أنا دافعت ومازلت أدافع عن البوسنة في جميع المحافل الأوروبية والعالمية، لأننا لم نقترف شيئًا يدعونا للخجل، أمّا الصرب؟".. وعلاوة على كل هذا وذاك، ففي الحروب لا تستطيعون قتل العلماء والعمال ورجال الدين، ولا تستطيعون إلحاق الأذى بالشجر والمزارع.. أليس هذا ما حضنا عليه الإسلام؟
أولسنا مسلمين؟
نحن الذين حرم علينا حرق أسرى الحروب، أو قطع رؤوسهم بوحشية.. نحن من طلب منا التعامل مع الأسرى بطريقة لا تحط من قدر إنسانيتهم، والإفراج عنهم أحيانًا حتى من غير الحصول على مقابل، وتقاسم زادنا ولباسنا معهم، ذلك أن الإسلام لم ينزل ليبعث بالخوف في نفوس البشرة، بل جاء ليكون رحمة للعالمين.
ليس كل شيء مباحا في المعارك!
إذا كنّا نخوض معركة من أجل رفع الظلم ونصرة الحق وإحقاق العدل، فإن هذه المعركة محكومة بأخلاق وآداب، يجب عدم الابتعاد عنها.. فليس كل شيء مباحا في المعارك، فنحن مضطرون إلى النضال بأساليب إنسانية، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
إن تعاليم ديننا السمحة تأمرنا أيضًا بعد الدخول في التحالفات القذرة، وعدم الافتراء على الناس، وعدم نشر الأخبار الكاذبة، والابتعاد عن إهانة الناس، وتصغيرهم والحط من قدرهم، كما أن تعاليم ديننا السمحة، تأمرنا بعد التجسس على الناس، والتنصت على حياتهم الخاصة، والابتزاز.. كما لا يمكننا القيام بكل تلك الأعمال حتى لو قام أحدٌ بها ضدنا.
إذا كنّا حقيقة نتشرف بحمل نعمة الانتماء إلى الجنس البشري، والمسؤوليات التي يمليها علينا دين الإسلام، فنحن ملزمون باحترام قانون الحرب، والالتزام بأخلاقه، وعدم الإضرار بصورة الإسلام، واحترام وحرمة المسلمين في أنحاء العالم.. علينا التحلي بالمصداقية والوفاء بالوعد والالتزام بالمعاهدات التي أبرمناها، حتى في أصعب وأحلك لحظات الحرب، علينا أن نظهر موثوقيتنا ومصداقيتنا وأن نبرهن عن تمسكنا بها أمام العالم أجمع.
إن من يمتلك أخلاقًا في الحرب، يمتلك أخلاقًا في السلم أيضاً.
ومن كان عادلًا في الحرب، سيظفر بالاحترام والتبجيل في السلم.
إن محافظتنا على إنسانيتنا وعدلنا وأخلاقنا وشرفنا وعفتنا وقدرتنا على الصفح والمسامحة في الحروب والصراعات، يزيد من عزم شكائمنا وقوتنا واحترامنا لأنفسنا، واحترام الآخرين لنا.
مقالات ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
فصل جديد في الشراكة الإستراتيجية القطرية الأمريكية

رأي الشرق
-
لماذا أُخذ مادورو حيّاً؟!

د. سعد الحلبوسي
-
صدارة وجدارة

ابتسام آل سعد
-
مناورات العدالة الصينية حول تايوان

د. فاتن الدوسري
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 العرب يتألقون في إفريقيا
في نسخة استثنائية من كأس الأمم الإفريقية، أثبتت الكرة العربية حضورها بقوة بعدما بلغ كل من المغرب، ومصر، والجزائر الدور ربع النهائي، في مشهد يعكس تطور الأداء والانضباط التكتيكي للمنتخبات العربية وقدرتها على المنافسة على أعلى مستوى. هذا النجاح لم يأتِ بالصدفة، بل كان نتيجة تخطيط واضح، وعقلية محترفة، وروح تنافسية جعلت الفرق العربية قوة لا يمكن تجاهلها في البطولة. الروح التي تتحلى بها هذه المنتخبات تتجاوز مجرد الأداء البدني أو التكتيكي، فهي روح الانتماء والفخر بالعلم والهوية. يظهر ذلك في كل مباراة، حيث يتحد اللاعبون من أجل هدف واحد، ويقدمون أقصى ما لديهم، حتى في أصعب اللحظات. هذه الروح الجماعية تمنح المغرب، ومصر، والجزائر القدرة على الصمود أمام المنافسين الأقوياء، وتحويل التحديات إلى فرص لإظهار الإبداع والقوة على أرض الملعب. أما الشراسة، فهي السمة الأبرز لهذه الفرق. على أرض الملعب، يقاتل اللاعبون على كل كرة، بعزيمة وإصرار لا يلين، كأن كل لحظة من عُمْر المباراة هي الفرصة الأخيرة. هذه الشراسة ليست مجرد قوة، بل تعبير عن الانضباط والالتزام بالاستراتيجية، وحرصهم على الدفاع عن سمعة الكرة العربية. مع كل تدخل، وكل هجمة مرتدة، يظهر أن هذه الفرق لا تعرف الاستسلام، وقادرة على قلب الموازين مهما كانت صعوبة المنافس. أما الطموح فهو المحرك الحقيقي لهذه الفرق. الطموح لا يقتصر على الوصول إلى ربع النهائي، بل يمتد إلى حلم أكبر، وهو رفع الكأس وإثبات أن الكرة العربية قادرة على منافسة عمالقة القارة. ويظهر في التحضير الشامل، والاستراتيجية المحكمة، وجهود كل لاعب لإتقان مهاراته والمساهمة بانسجام مع الفريق. ويتجسد هذا الطموح أيضًا في حضور نجوم صنعوا الفارق داخل المستطيل الأخضر؛ حيث قاد إبراهيم دياز المنتخب المغربي بلمسته الحاسمة وتألقه اللافت كهداف للبطولة، بينما جسّد محمد صلاح مع منتخب مصر روح القيادة والخبرة والحسم في اللحظات المفصلية، وفي الجزائر يظهر عادل بولبينة كعنصر هجومي فعّال، يمنح الفريق سرعة وجرأة في التقدّم، ويترجم حضوره بأهداف استثنائية على أعلى مستوى، وهو ما يؤكّد أن النجومية الحقيقية لا تكتمل إلا داخل منظومة جماعية متماسكة. كلمة أخيرة: النجاح العربي في البطولة ليس مجرد نتيجة مباريات، بل انعكاس للروح، للشراسة، وللطموح المستمر نحو القمة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المغرب، ومصر، والجزائر لم تعد مجرد فرق مشاركة، بل قوة لا يمكن تجاهلها، تحمل رسالة واضحة لكل منافس: نحن هنا لننافس، لنلهم، ولننتصر.
1284
| 08 يناير 2026
- 2 «الكشخة» ليست في السعر.. فخ الاستعراض الذي أهلكنا
امشِ في الرواق الفاخر لأي مجمع تجاري حديث في مدننا، ستلاحظ شيئاً غريباً، الهدوء هنا مختلف، والرائحة مختلفة، وحتى طريقة المشي تتغير، أنت لست في سوق تشتري منه حاجاتك، بل أنت في «معبد» جديد تغذيه ثقافة الاستعراض، طقوسه الماركات، وقرابينه البطاقات الائتمانية. في الماضي القريب، كنا نشتري السيارة لتوصلنا، والساعة لتعرفنا الوقت، والثوب ليسترنا ويجملنا، كانت الأشياء تخدمنا. كنا أسياداً، وهي مجرد أدوات، لكن شيئاً ما تغير في نظام تشغيل حياتنا اليومية. لقد تحولنا، بوعي أو بدونه، من مستهلكين للحاجات، إلى ممثلين على خشبة مسرح مفتوح اسمه وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحنا لا نشتري الشيء لنستمتع به، بل لنصوره. أصبح السؤال الأول قبل أن نطلب القهوة أو نشتري الحقيبة: «هل شكلها حلو في التصوير؟». هذه «الثقافة الاستعراضية» قلبت المعادلة، لم تعد الأشياء تخدمنا، بل أصبحنا نحن موظفين عند هذه الماركات، ندفع دم قلوبنا ونستدين من البنوك، لنقوم نحن بالدعاية المجانية لشعار شركة عالمية، فقط لنقول للناس: «أنا موجود.. أنا ناجح.. أنا أنتمي لهذه الطبقة». لقد أصبحنا نعيش «حياة الفاترينات». المشكلة ليست في الرفاهية، باقتصاد، فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، المشكلة هي حين تتحول الرفاهية من متعة إلى قيد، حين تشعر بضيق في صدرك لأنك لا تملك «الترند» الجديد. حين يضغط الشاب على والده المتقاعد، أو تستدين الفتاة، لشراء كماليات هي في الحقيقة أغلال ذهبية. لقد تم صناعة رغباتنا بذكاء، حتى نسينا تعريف الوجاهة الحقيقي. في مجالسنا القديمة، كانت قيمتك بعلومك الغانمة، بأخلاقك، بوقفتك مع الصديق، ورجاحة عقلك. لم يكن أحد يسأل عن ماركة نعالك أو سعر ساعتك ليعرف «من أنت». أما اليوم، فتحاول الإعلانات والمؤثرون إقناعنا بأن قيمتك تساوي ما تلبس وما تركب. وأن الخروج من ثقافة الاستعراض يعني أنك متأخر عن الركب. نحن بحاجة لوقفة صادقة مع النفس، نحتاج أن نتحرر من هذا السباق الذي لا خط نهاية له. السباق الذي يجعلك تلهث خلف كل جديد، ولا تصل أبداً للرضا. القيمة الحقيقية للإنسان تنبع من الداخل، لا من الخارج، «الرزة» الحقيقية هي عزة النفس، والثقة، والقناعة. جرب أن تعيش يوماً لنفسك، لا لعدسة الكاميرا، اشرب قهوتك وهي ساخنة قبل أن تبرد وأنت تبحث عن زاوية التصوير، البس ما يريحك لا ما يبهرهم. كن أنت سيد أشيائك، ولا تجعل الأشياء سيدة عليك، ففي النهاية، كل هذه الماركات ستبلى وتتغير، ولن يبقى إلا أنت ومعدنك الأصيل.
1107
| 07 يناير 2026
- 3 حين لا يكون الوقت في صالح التعليم
في عالم يتغيّر بإيقاع غير مسبوق، ما زال نظامنا التعليمي يتعامل مع الزمن كأنه ثابت، وكأن عدد السنوات هو الضامن الوحيد للنضج والمعرفة. نحن نحسن عدّ السنوات، لكننا لا نراجع كفاءتها. نُطيل المراحل، لا لأن المعرفة تحتاج هذا الطول، بل لأن النظام لم يُسأل منذ زمن: هل ما زال توقيتنا مناسبًا لعصر يتسارع في كل شيء؟ الطفل اليوم يمتلك قدرة حقيقية على التعلّم والفهم والربط واكتساب المهارات الأساسية. ومع ذلك، نؤجّل بداية التعليم الجاد باسم الحذر، ثم نضيف سنوات لاحقة باسم التنظيم، ثم نقف أمام سوق العمل متسائلين: لماذا تتسع الفجوة بين التعليم والوظيفة؟ ولماذا يحتاج الخريج إلى تدريب إضافي قبل أن يصبح منتجًا؟ نتحدّث كثيرًا عن الفجوة بين التعليم وسوق العمل لكن قليلين فقط يطرحون السؤال الجوهري: ماذا لو لم تكن هذه الفجوة في نهاية المسار… بل في طوله؟ هل فعلا نحتاج جميع سنوات المراحل الدراسية بعدد سنواتها المقررة من أجيال مضت ؟ التعليم ليس عدد سنوات، بل كفاءة زمن. ليس المهم كم نُدرّس، بل متى وكيف ولماذا. حين نُطيل الطريق دون مراجعة أثره، لا ننتج معرفة أعمق بالضرورة، بل نؤجّل الإنتاج، ونؤخر الاستقلال المهني، ونضيف عبئًا زمنيًا على رأس المال البشري. ماذا لو أن جزءًا كبيرًا مما نحاول تعويضه عبر التدريب بعد التخرّج يمكن اختصاره أصلًا من سنوات دراسية مهدرة، لا تضيف كفاءة حقيقية، ولا تُعجّل النضج المهني، بل تؤجّل دخول الشباب إلى دورة الإنتاج. وهنا تظهر المفارقة الأهم: حين يلتحق الخريج مهنيًا في سن أصغر، لا يعني ذلك نقصًا في النضج، بل بداية مبكرة لتكوينه الحقيقي. النضج المعرفي والمهاري يتسارع في بيئة العمل. كلما دخل الشاب إلى السوق أبكر وهو يمتلك أساسًا علميًا ومهاريًا منضبطًا، بدأت قدرته على تحمّل أعباء العمل، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، والعمل تحت الضغط في التكوّن مبكرًا. التجربة المهنية لا تنتظر اكتمال العمر، بل تصنع النضج نفسه. وهكذا، فإن خريجًا يبدأ مساره في سن أصغر لا يصبح فقط منتجًا أسرع، بل يصل إلى مستويات أعلى من الكفاءة في وقت أقصر، لأن سنوات الخبرة تتراكم مبكرًا، وتتحول المهارات النظرية إلى ممارسة عملية في مرحلة عمرية أكثر مرونة وقدرة على التعلّم والتكيّف في الاقتصاد الحديث، الزمن ليس عنصرًا محايدًا. كل سنة إضافية خارج سوق العمل هي تكلفة غير منظورة على الفرد والأسرة والدولة. وكل سنة تأخير في التخرّج هي سنة تأخير في الإسهام والابتكار والإحلال الوظيفي وتراكم الخبرة الوطنية. ومع ذلك، ما زلنا نتعامل مع سنوات التعليم كأنها مُسلّمات لا تُمسّ ولا تُراجع؟ حين نبدأ التعليم مبكرًا، ونضغط المراحل دون المساس بالجودة، ونحوّل جزءًا من المحتوى النظري إلى مهارات عملية متدرجة، فإننا لا نختصر الوقت فحسب، بل نغيّر طبيعة العلاقة بين التعليم والإنتاج. الطالب لا يصل إلى الجامعة بعد سنوات طويلة من التلقين، بل بعد مسار أكثر تركيزًا، وأكثر ارتباطًا بالواقع، وأكثر قابلية للتحويل إلى مهارة سوقية. هذا ليس تقليصًا للتعليم، بل إعادة هندسة له حيث تتراكم المهارات في وقت أبكر، ويبدأ الاندماج المهني في مرحلة أقرب، وتُختصر تلك السنوات الرمادية التي لاتضيف كثيرا إلى الجاهزية المهنية. تسريع عجلة الإنتاجية لا يتحقق فقط عبر التكنولوجيا أو الاستثمارات، بل عبر إدارة الزمن البشري بذكاء. حين يدخل الشاب إلى سوق العمل أبكر وهو يمتلك أساسًا معرفيًا ومهاريًا متينًا، تبدأ دورة الإنتاج أسرع، ويبدأ التعلّم الحقيقي في الميدان مبكرًا، وتتحول سنوات الخبرة من عبء مؤجّل إلى رصيد متراكم. أما الإحلال في رأس المال البشري وهو أحد أكبر تحديات الاقتصادات الحديثة فلا يمكن تسريعه إذا ظلّت بوابة الدخول إلى السوق طويلة وممتدة. كل سنة إضافية في المسار التعليمي هي تأخير في ضخّ الدماء الجديدة إلى القطاعات، وتأخير في نقل الخبرة بين الأجيال، وتأخير في تمكين الكفاءات الوطنية من تولّي أدوارها. لسنا بحاجة إلى خريجين أكبر سنًا، بل إلى خريجين أكثر جاهزية. ولا نحتاج مسارًا أطول، بل مسارًا أذكى. كما لا نحتاج إلى ترميم الفجوة بعد أن تتشكّل، بل إلى منع تشكّلها من الأصل عبر إعادة النظر في زمن التعليم نفسه. حين لا يكون الوقت في صالح التعليم، يصبح الانتظار قرارًا لا ضرورة. ويغدو السؤال الحقيقي ليس: كم نُدرّس؟ بل: هل ما زال توقيتنا يخدم الإنسان والاقتصاد والمستقبل؟ التاريخ لا يتذكّر من حافظ على المدة، بل من امتلك الجرأة على مراجعتها.
1032
| 07 يناير 2026