رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
9260
علي محمد اليافعيسيف الله المسلول.. خالد بن الوليد
لو أن هناك رجلا وُلد على صهوة الخيل، ونشأ في ساحة الحرب، لكان ذلك الرجل هو خالد بن الوليد ، إنه الرجل الذي شهد زُهاء مائة زحف في جاهليته وإسلامه، كما قال هو نفسُه، كان يخوضها بقوته وإقدامه، ويخوضها أيضا بدهائه وحيلته، فقد أوتي رأيا سديدا، وفكرا ثاقبا، نتيجة عقله الحكيم المدبِّر الذي يحسن سياسة الحروب، ويجيد قيادة الجيوش، كان رجلا منذ عنفوان شبابه، وريعان أيامه، لا يعرف الراحة، ولا يحب لها طعما ولا يطيق لها وجها، بل كان يجد راحة نفسه في ميادين المصاولة، وساحات المبارزة، فهو جسور مقدام لا يهاب شيئا حتى الموت، فكيف يهاب شيئا دونه، وهو هادم كل شيء، حتى كأن قلبَ خالد قد قتل معنى الخوف فيه، ولم يعد يستطيب إلا تجشم المشاق، واقتحام الصعاب، وهو صاحب هذا القول المشهور الذي صار مثلا مأثورا أُخذ عنه: عند الصباح، يَحْمَدُ القومُ السُّرى.
كان قبل إسلامه يقاتل مع قومه قريش ضد المسلمين قتالا شديدا، دفاعا عما نشأ عليه من معتقدات موروثة باطلة، تشبث بها الآباء أخذا عن آبائهم الأولين، والتزموها اتباعا لهم على آثارهم، ومحاكاة لأفعالهم، وإن رأوا فيها خطأ ودَخَلا، وظنوا بطلانها، وأنها مجافية عن الحق، لا تغني عنهم شيئا، ولا تؤتي لهم نفعا، إلا أن الحرص عليها آتٍ من كونها مواريث ماضي الأجداد القديم التليد، وهم بأسلافهم يقتدون. ولكن رجلا كخالد بن الوليد له عقل وبصيرة لا بد له في يوم من أن ينظر الحق، ويتبين الصواب، فيهتدي من ثم إلى جادة الطريق، وإن امتد الزمن وطال، فإن ذا البصر، لا يعمى عن النور، ولو تغشاه الظلام، وذا البصيرة لا يخفى عنه الحق، ولو خدعته الأيام.
قرر خالد بن الوليد، في ذات يوم الخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى رسول الله، عليه الصلاة والسلام، ليعلن إسلامه، وقبل خروجه لقي صاحبا أراد مثل ما يريد، وهو عثمان بن طلحة، فخرجا معا، وانطلقا سَحَرا، وفي أثناء سيرهما في الطريق، تقابلا مع عمرو بن العاص، الذي كان يريد الإسلام أيضا، والذهاب إلى المدينة، فاصطحبوا جميعا، حتى بلغوا غايتهم، في شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة، وقصدوا رسول الله، الذي سُر لمقدمهم، وقال حينما رآهم: (إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها). واستقبلهم بوجهٍ طليق كما هي سنته المأثورة عنه، وأسلموا وشهدوا بالشهادتين، وفي ذلك الموقف أثنى النبي على خالد، فقال:(قد كنت أرى لك عقلا، رجوتُ ألا يسلمك إلا إلى الخير)، فقال خالد: يا رسول الله، استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله. فقال رسول الله:(إن الإسلام يجبُّ ما قبله).
منذ ذلك اليوم الذي أسلم فيه خالد، تشوقت نفسه إلى الجهاد في سبيل الدين، من أجل الذود عنه، ورفع لوائه ونشره عاليا في أفق السماء، حيث اعتاد وتمرس، حيث صهيل الخيول، وصليل السيوف، تعترك في ظلام القَتام، هنالك في ميدانه المبرَّز فيه، ميدان ساحة الحرب، وسط طليعة الجند، واتفق في تلك السنة الثامنة، أن جهز رسول الله، جيشا بلغ عدده ثلاثة آلاف مقاتل، وأمرهم بالسير إلى (مؤتة)، من بلاد الشام، للقِصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير رسوله إلى أمير بُصرى، وأمّر على هذا الجيش، زيد بن حارثة، وقال:(إن أصيب فالإمارة لجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فلعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرتضِ المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم)، أما خالد بن الوليد، فقد كان في تلك المعركة جنديا في صفوف المقاتلين.
توجه المسلمون إلى حيث أمرهم رسول الله، فواجهتهم هناك جموع الروم المحتشدة في جيش عرمرم، زاد عدده عن مائتيْ ألف جندي، وتقابل الجمعان، ودار القتال، واحتدم النزال، ولنصغِ إلى رسول الله، الذي أخبر المسلمين في المدينة أنباء المعركة في مؤتة بوحي من السماء، فقال لهم:(أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد)، وذرفت عينا رسول الله بكاءً على أصحابه الشهداء، وسكت قليلا، ثم قال:(اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره). الله أكبر، أجل هذا هو لقب خالد بن الوليد، الذي اشتهر به، واقترن باسمه في دواوين التاريخ، حتى عُرف بسيف الله المسلول.
بعد استشهاد أولئك القادة الأمراء الثلاثة، اصطلح الجنود على خالد بن الوليد، وعقدوا لواء الجيش بيمينه، ولننظر كيف استطاع خالد بدهائه وعبقريته إنقاذ جيش المسلمين، والنجاة به من موت محتوم، ومصير مشؤوم، نتيجة الكثرة الهائلة لجيش الروم، إذ رأى خالد، أن الذي ينفعهم في مأزقهم هذا هو تدبير مكيدة وحيلة، تقومان مقام الإمداد والعتاد، وكذلك كانت الحرب منذ القِدم خُدعة، ولقد قيل: رب حيلة أنفع من قبيلة. فقام بتغيير نظام الجيش، فجعل المقدمة ساقة، والساقة مقدمة، وفعل مثل هذا التبديل بين الميمنة والميسرة، مما جعل العدو يعتقد أن المسلمين قد جاءهم مدد وغوث، ثم أمر خالد الجيش بالتراجع إلى الوراء رويدا رويدا، فأرهب ذلك الروم، إذ توهموا أن المسلمين يحاولون استدراجهم إلى الصحراء، إلى حيث يكمنون لهم في بقعتهم، التي يعرفونها جيدا. هنالك تزعزعت نفوسهم، ورجعوا القهقرى مخافة المغامرة، والانجرار إلى الخداع، ومن ثم السقوط في المكيدة، وبذلك تمكن خالد من أن يبقي على الجيش، ويفلت من هلاك محقق بهذا الانسحاب المخطط المدبر، الذي بدا كأنه ليس انسحاب المهزومين، ثم عاد الجيش إلى المدينة، وفي تلك المعركة دُقّ وتكسّر في يد خالد تسعة أسياف، ولم يبق في يده إلا صفيحة يمانية، ذلك هو فعل سيف الله في السيوف.
لم يهدأ خالد من بعدُ وما استقر سيفه في غمده، فبعد وفاة النبي، استمر في حماسته من أجل الإسلام، بل إنه ازداد حماسة وصرامة، في قتال المرتدين، ثم في قتال الفرس والروم، وكان لا يوجه ضربة لعدو إلا قصمه، ولا يدخل حربا إلا أيده الله بنصره، فكان ذلك مدعاة لافتتان الناس بشخصه، وذهابهم فيه كل مذهب، حتى ظنوا أن النصر يأتي من عنده لا من عند الله سبحانه، وأن في يده سيفا لا كسائر السيوف، بل سيف أُنزل عليه من السماء. في عهد خليفة رسول الله، أبي بكر الصديق، أرسله لمقاتلة الروم، وأمّره على جيش عظيم، حارب في واقعة اليرموك العظيمة، التي حدثت فيها أورع البطولات، وأعظم التضحيات، وفيها وقع هذا الحادث لخالد بن الوليد، الذي امتحن فيه أيَّ امتحان، فتصدى له بأبدع مثال.
بينما كان خالد يدير رحى القتال، ويصدر أوامره للجيش، في أيام القتال الشديدة الضارية، على أرض اليرموك، إذ فوجئ بكتاب قادم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فيه نَعْي خليفة رسول الله، وفيه أمر بتنحية خالد بن الوليد، عن إمرة الجيش، وتقليد أبي عبيدة بن الجراح، قيادة الجيش، يا له من نبأ عظيم! فما كان من خالد إلا أن استجاب لهذا الأمر، وانقاد له وأطاع، وتقبله بصدر رحيب، وخلق متين، ولم تفتر همته، ولم تتغير نفسه، وما خمدت جذوة إخلاصه لأمته وأميره، فهو لا يعنيه أن يكون قائدا، أو جنديا في صفوف المسلمين، ما دام يقاتل في سبيل دين، فكلٌّ في ذلك سواء.
كان ذلك الأمر من عمر بن الخطاب، صدّا للناس، وحجزا عن مبالغتهم وغلوهم في مآثر خالد ومناقبه، المفتونين بها. ولكن... ولكن لله درك يا خالد.
أما آن لهذا الفارس الهُمام المقدام أن يستريح بعد إتعاب الأعداء، وإرهاق الخصوم؟ بلى. لقد كان خالد بن الوليد، يمنّي نفسه بنيل الشهادة في الموطن الذي خُلق له، وعاش فيه جلَّ حياته، في ساحة الحرب، إلا أن المقادير شاءت أن ينال الشهادة لا قتلا في الميدان، بل موتا على الفراش، وأن يَقْضي شهيدا، وإن لم يقتل، ألم يأتِ في الحديث:(من سأل الله الشهادة بحق، بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه)، غير أن خالداً توجع وتحسر على عدم موته مقاتلا والسيف في يده، وقال قولته الشهيرة الموجِعة المبكية، عند دنو أجله:(لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف، أو طعنة رمح، أو رمية سهم، ثم هأنذا أموت على فراشي حَتْف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء).
فلا نامت أعين الجبناء يا خالد، فلا نامت أعين الجبناء، ولو شئتُ لرددتها مرات ومرات، ولكن نمْ يا خالد هانئا مطمئنا، قرير العين، ولينم كذلك أمثالك من الرجال المخلصين الكرماء، في عالم الخلود، وجنان الفردوس، بإذن الله الكريم.
عجزت النساء أن يلدن مثل خالد
هكذا أُغمد سيف الله في الثرى، ولو كان للأرض قلب وضمير، ما رضيت إلا أن يكون مسلولاً منشورا، تباهى به كواكب السماء ونجومها، ذلك خالد بن الوليد، رضي الله عنه، الذي قال في نعيه عمر بن الخطاب:(عجزت النساء أن يلدن مثل خالد).
اقرأ المزيد
 اعترافات
اعترافات
وحدها قطر من تلتفت لأوضاعنا العربية الغارقة في الأزمات والعواصف السياسية التي لا يبدو لها مخرج قريب للأسف،... اقرأ المزيد
36
| 21 يناير 2026
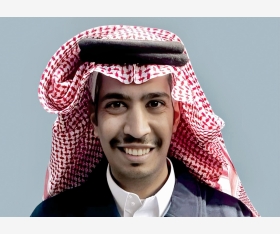 دعائم البيت الخليجي
دعائم البيت الخليجي
المتأمِّل الفَطِن في المسار العام للسياسة السعودية اليوم يجد أنه مسارٌ مرنٌ ومنضبطٌ في آنٍ معًا؛ مرنٌ من... اقرأ المزيد
117
| 21 يناير 2026
 راحة المسافرين.. نحو تجربة سفر أكثر سهولة
راحة المسافرين.. نحو تجربة سفر أكثر سهولة
يُعد مطار حمد الدولي أحد أبرز المعالم الحضارية لدولة قطر، نموذجًا متقدمًا للمطارات المدنية الحديثة على مستوى المنطقة... اقرأ المزيد
27
| 21 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
قطر.. التزام ثابت بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي

رأي الشرق
-
غزة على حافة البقاء

هديل رشاد
-
خذلتنا الأنوار وبقيت غزة

عادل الحامدي
-
اعترافات

ابتسام آل سعد
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 إبراهيم دياز قتل طموحنا
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
1878
| 20 يناير 2026
- 2 أهمية الدعم الخليجي لاستقرار اليمن
بعد أسابيع عصيبة عاشتها بلادنا على وقع الأزمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما رافقها من إجراءات أحادية قام بها المجلس الانتقالي ( المنحل ) أربكت المشهد السياسي والأمني، ومن الواضح أن اليمن يتجه اليوم بعزم وإرادة، نحو مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.هذه الفترة رغم قصر مدتها إلا أنها كانت حافلة بالأحداث التي شكلت اختبارا صعبا لتماسك الدولة وقدرتها على الصمود، وأيضا لحكمة القيادة السياسية في إدارة لحظة شديدة الحساسية، داخليا وإقليميا.إن خطورة ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة لم يكن مقتصرا على تعميق الانقسام الاجتماعي أو إثارة الحساسيات المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى تهديد وحدة البلد ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، وإضعاف جبهة الشرعية برمتها في لحظة لا تحتمل فيها البلاد أي تصدّعات إضافية. هذا الوضع الصعب مثل تحديا حقيقيا كاد أن ينعكس سلبا على المسار السياسي العام، وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوجودية التي لا تزال قائمة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي وانقلاب جماعة الحوثي. وخلال هذه الأزمة، برز بوضوح مدى أهمية الموقف الدولي، الذي ظل رغم كل التعقيدات قائما على مقاربات موضوعية ومسؤولة تجاه الملف اليمني. فقد حافظ المجتمع الدولي على موقف موحد داعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وهو مكسب سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية كان مهددا بالتآكل نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة. ومن المهم التأكيد على أن الحفاظ على هذا الدعم والزخم الدولي المساند للحكومة لم يكن نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي منظم وواع، أدرك حساسية المرحلة وخطورة أي انزلاق غير محسوب نحو الصراع داخل مظلة الحكومة، مرسخا قناعة دولية بضرورة دعم الشرعية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على استعادة الدولة وصون الاستقرار. اليوم تمضي القيادة السياسية والحكومة في مسار تصحيحي شامل، يستهدف احتواء تداعيات الأزمة ومعالجة جذورها، وهو مسار يحظى بتأييد شعبي واسع، ودعم كامل وواضح من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن دعم أشقائنا في مجلس التعاون بقيادة السعودية فإنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساندة ظرفية مرتبطة بأحداث معينة، بقدر ما هو ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي، وتشابك المصالح بين اليمن ومحيطه الخليجي. نعم، إن أهمية الدعم الخليجي لليمن تتجاوز بطبيعتها البعد الاقتصادي أو الإنساني، لتتصل مباشرة بجوهر المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة. فاستقرار اليمن والاستثمار في دعم مؤسساته الشرعية يظل الخيار الأكثر حكمة لضمان أمن جماعي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة. ولكي تتمكن الحكومة ومجلس القيادة من استعادة زمام المبادرة، وتعزيز حضور الدولة، فإن اليمن أحوج ما يكون اليوم إلى موقف خليجي داعم على مختلف المستويات، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، لأن هذا الدعم يشكّل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار الأوضاع، واستعادة الثقة، وانتشال اليمن من أزماته المتراكمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المعالجات التي لا تنفذ إلى جوهر المشكلات التي تعاني منها بلادنا. وعلى المستوى الداخلي، شكلت الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تذكير جميع المكونات والقوى السياسية بأولويات اليمن الحقيقية، وبالمخاطر الأساسية المحدقة به. فالصراع الجانبي، وتغليب الحسابات الضيقة، لا يخدم سوى مشاريع التقسيم والإنفلات ومشروع الحوثي، الذي لا يزال التهديد الأكبر لمستقبل اليمن، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع للتحرك وفق برنامج واضح، يعيد ترتيب الأولويات، ويضع إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في صدارة الأهداف، وصولا إلى مرحلة لا يكون فيها اليمن رهينة للسلاح أو المشاريع الخارجة عن الدولة، وإنما دولة مستقرة، شريكة لمحيطها، وقادرة على إدارة شؤونها بإرادة وطنية جامعة.
1752
| 14 يناير 2026
- 3 ضحكة تتلألأ ودمعة تختبئ
بين فرحة الشارع المغربي وحسرة خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، جاءت ليلة نصف النهائي لتؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والقتال على أرض الملعب. قدمت مصر أداءً مشرفًا وأظهرت روحًا قتالية عالية، بينما كتب المغرب فصولًا جديدة من مسيرته القارية، مؤكدًا تأهله إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية مع نيجيريا امتدت إلى الأشواط الإضافية وحسمت بركلات الترجيح. المباراة حملت طابعًا تكتيكيًا معقدًا، اتسم بسرعة الإيقاع والالتحامات القوية، حيث فرض الطرفان ضغطًا متواصلًا طوال 120 دقيقة. المنتخب المغربي تعامل مع هذا الإيقاع بذكاء، فحافظ على تماسكه وتحكم في فترات الضغط العالي دون ارتباك. لم يكن التفوق المغربي قائمًا على الاستحواذ وحده، بل على إدارة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى. تجلّى هذا التوازن في الجمع بين التنظيم الدفاعي والقدرة على الهجوم المنظم. لم يغامر المغرب دون حساب، ولم يتراجع بما يفقده زمام المبادرة. أغلق اللاعبون المساحات وحدّوا من خطورة نيجيريا، وفي المقابل استثمروا فترات امتلاك الكرة لبناء الهجمات بهدوء وصناعة الفرص، ما منحهم أفضلية ذهنية امتدت حتى ركلات الجزاء. في لحظة الحسم، تألق ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي جزاء حاسمتين بتركيز وثقة، وهو ما منح المغرب بطاقة العبور إلى النهائي وأثبت حضوره في اللحظات المصيرية. على الصعيد الفني، يواصل وليد الركراكي تقديم نموذج المدرب القارئ للمباريات بإدارة متقنة، ما يعكس مشروعًا قائمًا على الانضباط والواقعية الإيجابية. هذا الأسلوب أسهم في تناغم الفريق، حيث أضاف إبراهيم دياز لمسات فنية ومهارات فردية ساعدت على تنويع الهجمات وصناعة الفرص، بينما برز أشرف حكيمي كقائد ميداني يجمع بين الصلابة والانضباط، مانحًا الفريق القدرة على مواجهة أصعب اللحظات بثقة وهدوء، وخلق الانسجام التكتيكي الذي ساعد المغرب على التقدم نحو ركلات الجزاء بأفضلية ذهنية واضحة. ولا يمكن فصل هذا الإنجاز عن الجمهور المغربي، الذي شكّل سندًا نفسيًا هائلًا، محولًا المدرجات إلى مصدر طاقة ودافع مستمر. كلمة أخيرة: الآن يستعد المغرب لمواجهة السنغال في النهائي، اختبار أخير لنضج هذا المنتخب وقدرته على تحويل الأداء المتزن والطموح المشروع إلى تتويج يليق بطموحات أمة كروية كاملة.
1446
| 16 يناير 2026




