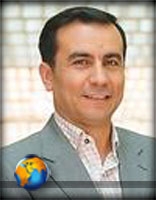رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
420
خالد الحروبنحو فهم المراهقة السياسية في مصر
إعادة البناء أسهل ألف مرة من التفكيك. وإقامة نظام سياسي ديمقراطي فاعل وناجز أصعب ألف مرة من إزالة نظام سياسي ديكتاتوري. ما بعد الديكتاتورية حقبة بالغة الصعوبة كونها تحديات كبيرة كل منهما أصعب من الآخر. وتتصدرها ثلاثة أساسية. الأول هو التخلص من الإرث القديم الذي تكون الديكتاتورية قد رسخته وجذرته في السياسة والمجتمع والثقافة والأنظمة السائدة ونمط العلاقات الناظم لكل شيء في البلد المعني. والثاني هو تحقيق سقف التوقعات المرتفع للشعب والأفراد والشرائح المجتمعية بعد تخلصها من إرث الاستبداد. وانسياقها وراء طموحات متسرعة وغير واقعية في حدوث التغيير. والتحدي الثالث هو ضمور الخبرة السياسية عند الطبقة السياسية الصاعدة سواء من وصل منها إلى الحكم. أو من احتل مقاعد المعارضة. تتداخل هذه التحديات وغيرها وتشتغل بقوة تثير الإحباط والمرارة في دول ثورات الربيع العربي: في مصر. وتونس. وليبيا. واليمن. وتجعل كثيرا من الناس يتحسر على الأنظمة الزائلة لأنها كانت توفر في نظرهم وعلى أقل تقدير استقرارا صار مفقودا وعزيزا هذه الأيام.
ما نراه في مصر هذه الأيام من فوضى سياسية وشارعية وتخبط في الطبقة السياسية الصاعدة. سواء من هم في الحكم أم من هم في المعارضة. يؤشر بقوة وإدهاش إلى التحدي الثالث. لكن قبل مناقشته ببعض التوسع من المهم تفنيد بعض الإحباطات ونقض فكرة التحسر على الأنظمة الزائلة واستبدادها الذي أقام لعقود طويلة. وأنهك البلاد وثرواتها وناسها. الاستقرار المُتحسر عليه كان استقرار الاستبداد والحكم البوليسي. وهو استقرار موهوم ومؤقت وإن وفر على السطح الخارجي مظهرا مستقرا وآمنا. هو الاستقرار الذي حققه ويحققه المُستبدون في التاريخ البشري بقوة النار. ورأسماله الخوف والتخويف وقمع الأفراد. في هذا النمط من الاستقرار يتم إزاحة كل المشكلات التي يواجهها أي مجتمع تحت السطح لأنه لا أحد يجرؤ على مناقشتها. وهناك تحت السطح تعتمل وتتقرح تلك المشكلات وتتراكم فوق بعضها البعض حتى تصل إلى درجة الانفجار الذي لا بديل عنه فتندلع في وجه المُستبد دفعة واحدة. وهذه سيرورة ما حدث في بلدان الربيع العربي: تراكم المعضلات وتفاقهما والتغاضي عنها قاد إلى ثورات عارمة في أوساط الناس. الاستقرار البديل والحقيقي والمستديم هو استقرار الحرية وهو على الضد من استقرار الاستبداد. استقرار الحرية يقوم طوعا واختيارا ومشاركة وليس بالقمع والحديد والنار. استقرار الحرية يقوم على أساس احترام كرامة الناس وشعورهم بالمسؤولية وعلى أساس كونهم شركاء في وطنهم وسياسته واقتصاده وصناعة مستقبله. وليسوا أجراء أو قطيعا مهملا لا يجيد سوى السمع والطاعة والخضوع.
الانتقال من مرحلة استقرار الاستبداد إلى استبداد الحرية مخاض صعب ومعقد تواجهه معيقات وتحديات كثيرة. منها الثلاث المذكورة هنا. ونموذج الانتقال المصري بالغ الدلالة على هذه الصعوبات وتعقيداتها. لكن هذه الصعوبات والمخاطر والمرارات يجب أن تُرى من منظور تاريخي وليس من زاوية الحدث اليومي فحسب. يقول لنا المنظور التاريخي إن التحولات الكبرى تحتاج إلى وقت طويل كي تستقر. وإن أكثرها احتياجا للوقت ذاك الذي يخط مسارا جديدا بالكلية ويقطع مع المسار القديم. على ذلك فإن ما يحدث في مصر وغيرها لا يخرج عن طبيعة الأمور رغم ما يثيره من إحباط وخوف. ورغم أن هذا الكلام ونسبته إلى المنظور التاريخي قد لا تقنع ولا تفيد المواطن المسكين الذي ينتظر تغييرا مباشرا. ولا يقدم وظيفة لباحث عن عمل. ولا أمنا مطلوبا للجميع.
في هذا السياق. أي سياق الرؤية التاريخية. يمكن مناقشة التحدي الثالث الخاص بضمور التسيّس وشبه انعدام الخبرة الممارسة السياسية في الحقبة الجديدة في مصر. ما نراه في مصر وفي وسط طبقتها الحاكمة ونخبتها المسيرة مراهقة سياسية لم تتلمس طريق النضج بعد. محاولة تقليب جوانب وأسباب هذه المراهقة قد تقودنا إلى فهم أعمق لسيرورتها. في المقام الأول هناك خلفية العقود الطويلة التي اشتغلت فيها النخبة السياسية الحالية. أو عاشت فيها. وهي عقود كانت بعيدة عن التسيس الصحي والاشتغال في السياسة بحرية. الأحزاب والمجموعات والشرائح النشطة في مصر الآن. خاصة التقليدية وقادة الأحزاب والنخب التي في الخمسينات من عمرها وأكبر. تنحصر خبرتها في السياسة تحت سقف الاستبداد. وعلاقتها بفكرة الدولة والحكم علاقة عدائية موروثة – وتكاد تكون في الجينات. من هم في الحكم ومن هم في المعارضة كانوا معارضين في ظل نظام ديكتاتوري. وكانت معارضتهم محدودة ولا يسمح إلا لقليلها بالتعبير عن نفسه. عقود المعارضة الطويلة أنتجت أجيالا وأفرادا معارضين أكثر منهم صُناع سياسة حتى لو وصلوا الحكم. الأجيال الأقل عمرا والتي كانت قد قادت الثورة بالفعل تنقصها الخبرة أيضا. صحيح أن "شباب الثورة" امتلكوا قدرات عظيمة في الحشد والتجميع والمناورة كما شهدت على ذلك عبقرية "ميدان التحرير" إلا أن تلك القدرات تقف عند حدود إسقاط النظام. وليس بناء نظام جديد. وهذه الشرائح العريضة التي رفعت سقف توقعاتها وتوقعات الناس العاديين إلى مستويات لا يمكن تحقيقها بسرعة تلجأ إلى المهارة شبه الوحيدة التي تتقنها. وهي الحشد والتجميع والخروج إلى الشارع. ولأنها تتفوق على غيرها وعلى جيل السياسيين التقليديين في هذه المهارة فإن ذلك الجيل يتبعها ويلحق بها على اعتبار أنها تمثل الحراك الشعبي. وعوض أن يلعب الجيل الأكبر من السياسيين دور العقل في هذه المرحلة نراه يلهث وراء حركة الشارع ويريد أن يشارك في لعب دور العضلات. على ذلك فإن بدت ممارسات حكم الإخوان المسلمين في مصر مراهقات سياسية بامتياز. خاصة لجهة الاستئثار بالحكم. وخلع الوعود ثم نقضها. وتنفير أقرب الحلفاء السياسيين. فإن ممارسات المعارضة لا تقل مراهقة عن ذلك أيضا. فالمعارضة. شيبا وشبانا. تنساق وراء نوستالجيا ميدان التحرير و"إسقاط النظام". والغريب أن يصبح إسقاط النظام مطلبا للمعارضين وهو نظام مُنتخب أيا كانت درجات الامتعاض منه أو المعارضة له. وعندما أحس عدد من قادة تلك المعارضة أن مطلبا كهذا يعني نقضا لمسار التحول الديمقراطي. الذي يتيح إسقاط أي نظام بطرق ديمقراطية انتخابية وحسب. تحول المطلب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وهو مطلب أكثر معقولية. لكن حتى هذا المطلب تُبنى عليه توقعات وآفاق كبيرة وكأن المعضلات البنيوية الكبرى التي لا يتيح الساسة المصريون لأنفسهم أي فسحة زمنية لمواجهتها وهم محمومون في صراعاتهم الحزبية سوف تحل لو تغير وزير هنا أو هناك في الحكومة. ليس هناك من طريقة لحرق مرحلة المراهقة والبلوغ إلى النضوج سريعا. لكن كل الطرق مفتوحة لعقلانية سياسية تجعل تلك المرحلة قصيرة وسريعة.
مقالات ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
العنابي يصنع التاريخ

إبراهيم فلامرزي
-
إنجاز رياضي باهر وتكريم مستحق

رأي الشرق
-
الرئيس الزاهد والقائد الصفوح

إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
يوم لا ينفع مال ولا بنون
د. عبدالله العمادي
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 العدالة التحفيزية لقانون الموارد البشرية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
9027
| 09 أكتوبر 2025
- 2 مؤتمر صحفي.. بلا صحافة ومسرح بلا جمهور!
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
6540
| 13 أكتوبر 2025
- 3 من فاز؟ ومن انتصر؟
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت الطائرات عن التحليق، وصمت هدير المدافع، لكن المدينة لم تنم. فمن تحت الركام خرج الناس كأنهم يوقظون الحياة التي خُيّل إلى العالم أنها ماتت. عادوا أفراداً وجماعات، يحملون المكان في قلوبهم قبل أن يحملوا أمتعتهم. رأى العالم مشهدًا لم يتوقعه: رجال يكنسون الغبار عن العتبات، نساء يغسلن الحجارة بماء بحر غزة، وأطفال يركضون بين الخراب يبحثون عن كرة ضائعة أو بين الركام عن كتاب لم يحترق بعد. خلال ساعات معدودة، تحول الخراب إلى حركة، والموت إلى عمل، والدمار إلى إرادة. كان المشهد إعجازًا إنسانيًا بكل المقاييس، كأن غزة بأسرها خرجت من القبر وقالت: «ها أنا عدتُ إلى الحياة». تجاوز عدد الشهداء ستين ألفًا، والجراح تزيد على مائة وأربعين ألفًا، والبيوت المدمرة بالآلاف، لكن من نجا لم ينتظر المعونات، ولم ينتظر أعذار من خذلوه وتخاذلوا عنه، ولم يرفع راية الاستسلام. عاد الناس إلى بقايا منازلهم يرممونها بأيديهم العارية، وكأن الحجارة تُقبّل أيديهم وتقول: أنتم الحجارة بصمودكم لا أنا. عادوا يزرعون في قلب الخراب بذور الأمل والحياة. ذلك الزحف نحو النهوض أدهش العالم، كما أذهله من قبل صمودهم تحت دمار شارك فيه العالم كله ضدهم. ما رآه الآخرون “عودة”، رآه أهل غزة انتصارًا واسترجاعًا للحق السليب. في اللغة العربية، التي تُحسن التفريق بين المعاني، الفوز غير النصر. الفوز هو النجاة، أن تخرج من النار سليم الروح وإن احترق الجسد، أن تُنقذ كرامتك ولو فقدت بيتك. أما الانتصار فهو الغلبة، أن تتفوق على خصمك وتفرض عليه إرادتك. الفوز خلاص للنفس، والانتصار قهر للعدو. وغزة، بميزان اللغة والحق، (فازت لأنها نجت، وانتصرت لأنها ثبتت). لم تملك الطائرات ولا الدبابات، ولا الإمدادات ولا التحالفات، بل لم تملك شيئًا البتة سوى الإيمان بأن الأرض لا تموت ما دام فيها قلب ينبض. فمن ترابها خُلِقوا، وهم الأرض، وهم الركام، وهم الحطام، وها هم عادوا كأمواج تتلاطم يسابقون الزمن لغد أفضل. غزة لم ترفع سلاحًا أقوى من الصبر، ولا راية أعلى من الأمل. قال الله تعالى: “كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ”. فانتصارها كان بالله فقط، لا بعتاد البشر. لقد خسر العدو كثيرًا مما ظنّه نصرًا. خسر صورته أمام العالم، فصار علم فلسطين ودبكة غزة يلفّان الأرض شرقًا وغربًا. صار كلُّ حر في العالم غزاويًّا؛ مهما اختلف لونه ودينه ومذهبه أو لغته. وصار لغزة جوازُ سفرٍ لا تصدره حكومة ولا سلطة، اسمه الانتصار. يحمله كل حر وشريف لايلزم حمله إذنٌ رسمي ولا طلبٌ دبلوماسي. أصبحت غزة موجودة تنبض في شوارع أشهر المدن، وفي أكبر الملاعب والمحافل، وفي اشهر المنصات الإعلامية تأثيرًا. خسر العدو قدرته على تبرير المشهد، وذهل من تبدل الأدوار وانقلاب الموازين التي خسرها عليها عقوداً من السردية وامولاً لا حد لها ؛ فالدفة لم تعد بيده، والسفينة يقودها أحرار العالم. وذلك نصر الله، حين يشاء أن ينصر، فلله جنود السماوات والأرض. أما غزة، ففازت لأنها عادت، والعود ذاته فوز. فازت لأن الصمود فيها أرغم السياسة، ولأن الناس فيها اختاروا البناء على البكاء، والعمل على العويل، والأمل على اليأس. والله إنه لمشهدُ نصر وفتح مبين. من فاز؟ ومن انتصر؟ والله إنهم فازوا حين لم يستسلموا، وانتصروا حين لم يخضعوا رغم خذلان العالم لهم، حُرموا حتى من الماء، فلم يهاجروا، أُريد تهجيرهم، فلم يغادروا، أُحرقت بيوتهم، فلم ينكسروا، حوصرت مقاومتهم، فلم يتراجعوا، أرادوا إسكاتهم، فلم يصمتوا. لم… ولم… ولم… إلى ما لا نهاية من الثبات والعزيمة. فهل ما زلت تسأل من فاز ومن انتصر؟
5733
| 14 أكتوبر 2025