اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
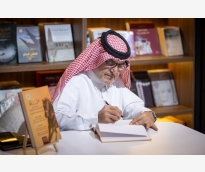
وقع الدكتور عمر العجلي، بجناح دار كتارا للنشر بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ34، كتاب الزردقة في معرفة الخيل وأجناسها وأمراضها وأدويتها الذي قام بتحقيقه نقلاً عن مخطوطة قديمة بالاشتراك مع زميله الدكتور محمد خالد الرهاوي. وأوضح الدكتور عمر العجلي أن الكتاب هو عبارة عن تحقيق لمخطوطة بعنوان: (شرح المقامة الصلاحية في الخيل والبيطرة والفروسية)، أُلِّفت بأمر من السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي (589 هـ) والتي تضيء جانباً مهملاً من حلقة مهمة في تاريخ العلوم عند العرب، وتعرّف بجوانب مشرقة من تراثنا العلمي الغني. وأكد أن هذه النسخة المحققة من المخطوطة القيمة بذل فيها المحققون غاية الجهد لإخراج نصها خالٍ من التصحيف والتحريف وفق منهج التحقيق العلمي، واعتمادا على خمس نسخ خطية مختلفة، معرباً عن أمله في أن يشكل الكتاب إضافة قيمة للمكتبة العربية، وأن يجد فيه القارئ ما يُثري معرفته ويحفّزه على استكشاف مزيد من كنوز التراث، وأن يشكل بداية لمزيد من الأعمال التي تخدم هذا المجال المعرفي. واعتبر كتب التراث ليست مخطوطات قديمة فحسب، بل هي كنوز تحمل في طياتها الحكمة والخبرة والتجارب التي أبدعها الأجداد وتناقلتها الأجيال، مشددا على أن تحقيق هذه الكتب ونشرها ينفض الغبار عنها، وينقلها من ظلمات الخزائن إلى نور الحياة، ويبقي هذا التراث حياً ومتجدداً، ويفتح أبواب المعرفة أمام الباحثين والمهتمين للمساهمة في الجهود التي تحفظ هوية الأمة وتعزز مكانتها بين الأمم.
294
| 16 مايو 2025

استعرض أكاديميون من كلية المجتمع مساء أمس قضية المنتج الثقافي في ظل العصر الرقمي ومن أجل قراء أكثر، وذلك في ندوة شهدها المسرح الرئيس بمعرض الدوحة للكتاب، وشارك في الندوة كل من د. عمر العجلي أستاذ مشارك في قسم العلوم الانسانية، ود. كمال المقابلة أستاذ مشارك في قسم اللغات والآداب، ود. أشرف بيومي أستاذ مشارك بكلية المجتمع، وأدارها سعد بورشيد، أستاذ مشارك بكلية المجتمع. وتناول د. عمر العجلي في ورقته العلمية البناء المعرفي في المنتج الثقافي المعاصر من خلال مجموعة من المحاور، مشيرا إلى أن المنتج الثقافي العربي يفرض علينا وقفة تأمل، كما يفرض المشاركة بالفكر والرأي. واستعار تعريف اليونسكو المنتج الثقافي يجب أن يكون حاملا للهوية، وعاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مضيفا: المنتج الثقافي العربي يمر بحالة مرض سريري من خلال الأرقام الصادمة، مقارنة بالأمم الناهضة من حولنا. مشيرا إلى أن اللغة العربية تم اختراقها، والهوية بدأت تتزعزع، وتتعرض الى هزات تشكيكية من الجيل الرقمي. وقدم د. العجلي أرقاما لتوضيح المحتوى الثقافي الذي يحتاج الى مزيد من الجهد، مؤكدا أن 40 الف مخطوطة توجد في المكتبة البريطانية، وعشرات الآلاف من المخطوطات في الأرشيف العثماني، وغيرها الكثير. مضيفا: المنتج الثقافي العربي غني ولكن حصل بيننا وبينه طلاق منذ العقود الستة الماضية. ولفت الى أن هناك من يتهم اللغة بالقصور وهذا غير صحيح، مؤكدا أن لغتنا العربية لا تتطور ولكن تتكيف مع واقعها. من جانبه أوضح د. كمال المقابلة في ورقة بعنوان حضور المشهد الثقافي القطري في المشهد الثقافي العربي: دعم الابداع انموذجا أن قطر خطت خطوات رائدة في دعم الإبداع العلمي والثقافي والاقتصادي والأدبي، وخص حديثه عن الدعم الثقافي الذي بدأ قبل عقود،الى جانب الابتعاث الدراسي الذي بدأ هو الآخر في وقت مبكر. واستعرض د. كمال المقابلة عددا من المؤسسات التي تدعم المنتج الثقافي. مؤكدا أن التطور الذي تشهده المؤسسات الثقافية في الدولة ينسجم مع التطور الرقمي والتكنولوجي. وأكد أن قطر حرصت بوعي تام على الخروج من البيئة المحلية الى البيئة العالمية من خلال خطة استراتيجية وضعتها وزارة الثقافة. من جانبه تحدث د. أشرف بيومي عن مدى دعم التواصل الاجتماعي للمنتج الثقافي، وتوقف عند بعض المقولات المعروفة من بينها: قيل لأرسطو: كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب: اسأله كم كتابا يقرأ وماذا يقرأ؟. ثم طرح مجموعة من الأسئلة .
887
| 19 يناير 2022

دعا المؤرخ الدكتور عمر العجلي، أستاذ محاضر في كلية المجتمع، إلى ضرورة أن يكون للمشهد الثقافي حضوره في عملية التدوين، وذلك فيما يضمه من قصص وأمثال وأشعار، لما يمثله هذا الجانب من أهمية كبيرة. وشدد في حديثه لـ الشرق على أهمية الحاجة للدراسات البحثية بالنسبة للحياة الأدبية، فضلاً عن دعوته إلى ضرورة تسليط الضوء على تاريخ الزبارة، وإبراز أثرها الفكري والثقافي، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من كتب التراجم للشخصيات المحلية خلال القرن المنصرم. كما تحدث د. عمر العجلي عن جوانب أخرى متعلقة بالتاريخ المحلي، وأبرز مكامن مصادره، بالإضافة إلى تناوله لأهمية التدوين، وما يمثله في التأريخ للأحداث المختلفة، بجانب حديثه عن أعمية التوثيق والتدوين، فضلاً عن محاور أخرى، طرحت نفسها على مائدة الحوار التالي: * ما أهمية التوثيق والتدوين وكيف تنظر إليه تاريخياً؟ ** ارتبط التوثيق قديماً بمحاولات الإنسان الأولى في التعبير الصوري عن منطوقه ثم رمزياً عن أفعاله ومسمياته وخواطره، ثم صوتيا في ضبط معانيه المقصودة ليكون توثيق الأحداث والأسماء وكذلك المعاني التي لها قيمة في المعتقدات والأخلاق والمقدسات، وجاء اختراع الكتابة ليكون توثيقاً للموروث الشفوي، أي نقل الموروث من السماع إلى الرؤية من خلال التدوين. والعرب وثّقوا تاريخَهم من خلال الشعر الذي وصفه ابن عباس بأنه ديوانُ العرب، حيث سجّل الشعر مراحل التوثيق عند العرب من حفظ الوقائع والأحداث والأنساب إلى ترجمة الجانب الوجداني والعاطفي ومظاهر التطور الفعلي لحياة العرب قبل الإسلام. وبلغ هذا الاستعداد نقلة نوعية غير مسبوقة عند توثيق كلام الوحي الربّاني بأبسط الطرق البدائية للتوثيق، تألّقت بمحصلتها ذات الأهمية التاريخية وهي توثيق القرآن الكريم في عهد الخليفة عثمان بنسخته الوحيدة التي يتداولها المسلمون إلى يومنا هذا، فتأكدَّ لدينا أروع مثال لتدوين المقروء الشفهي ليكون موثقاً مكتوباً بدقةٍ متناهية أذهلت جامعة أكسفورد عند عثورها على صفحات من القرآن الكريم مع الاعتقاد الجازم بأنها من عهد عثمان رضي الله عنه. * ما الحافز في عملية توثيق الأحداث الاجتماعية التي شهدها المجتمع المحلي منذ القدم؟ ** الحافز بلا شك يعود إلى أنه بالرغم من كثرة الأحداث الاجتماعية وأطوارها المتنوعة في حياة المجتمع خلال القرنين الماضيين، فإنها لم تأخذ نصيبها بالتدوين أو لم تشكّل الحيّز والمساحة التي تستحقها في سياق تاريخ قطر الحديث أسوة بوقائع التاريخ السياسي الذي أخذ مسارُه يقترب من الوضوح لدى الباحثين والمهتمين بهذا الشأن. فجوات التدوين * يرى البعض أن هناك فجوات في عملية تدوين مثل هذه الأحداث، فما هذه الفجوات، وما أسبابها؟ عندما نتحدث عن الفجوات في تسلسل الأحداث والوقائع في تاريخ قطر - في الأقلّ - خلال القرنين الماضيين، فإن ذلك لا يعني حصراً وتخصيصاً بقطر وحدها، بل إن ذلك يشمل جزيرة العرب وسواحل خليجها، ويعود ذلك إلى شح المعلومات التاريخية المدونة ربما لعقود من الزمن، كما لم تكن هناك إمكانيات للتوثيق - كما في العصر الحالي- كالتصوير أو الصحف، كذلك ندرة المؤرخين والمدونين ذوي الحسّ الإعلامي وعدم ظهور راوٍ مدوّن على شاكلة المنقور والفاخري وفصيح بن صبغة الله الحيدري، وغيرهم. كما أن وثائق تاريخ قطر المختلفة ركّزت على الأحداث السياسية مع إشارات محدودة للجانب الثقافي والاجتماعي، ويسري هذا الوصف على معظم الكتب والدراسات التي تناولت تاريخ قطر الحديث. * عندما نتحدث عن تاريخ قطر الحديث، كيف ترجّح الوثائق الأصيلة التي تختص بقطر أكثر من غيرها؟ ** الوثائق تتفاوت من حيث أهميتها النسبية حسب نقاط معينة معروفة، لكن هنا نودّ أن نلفِتَ النظر إلى معلومة تستحق الاهتمام بخصوص تدوين تاريخ قطر خلال الحقبة الممتدة من 1871م ولغاية 1913م، لتكون المرجعية الأساس هي للوثيقة العثمانية، لتأتي بعدها الوثائق الأخرى المتنوعة، بريطانية كانت أو تدوينات من مؤرخين معاصرين إن وجدت. مصادر التاريخ * في هذا السياق، أين تضع مكامن مصادر تاريخ قطر الحديث؟ ** نعم، لعلّ كثيرا ما يُطرح التساؤل حول هذه المصادر وهل هي كافية لتوصيف المشهدين الثقافي والاجتماعي وغيرهما كي تتشكّل منه الرواية المعتمدة والصالحة للرجوع إليها؟ الجواب.. من خلال الإشارة إلى أهم الموارد (الأولية) المفترضة للتاريخ القطري المعاصر، وهي: الوثائق المنشورة وغير المنشورة، ومنها اﻷرشيف العثماني الذي يضم ما يزيد على 150 مليون وثيقة ومخطوطة، منها ملايين شديدة الأهمية حول تاريخ المنطقة العربية على مدى أربعة قرون، لذا فهو مائدة ضخمة للباحثين والمؤرخين، وأحتفظ بأكثر من مائة وثيقة حصلت عليها مباشرة من إدارة الأرشيف العثماني بعضها تضمّنها كتابي: قطر.. رحلة التأسيس - قراءة وثائقية للمشهد السياسي في القرن التاسع عشر الميلادي، والبعض الآخر لم يُترجم بعد. إضافة إلى ذلك، فهناك الأرشيف البريطاني، علاوة على الأرشيف الهندي، ويحفل الأرشيف المصري بخزينٍ لا بأس به من الوثائق محفوظة في دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. كما كتب الرحالة الذين طافوا وجابوا منطقة الخليج العربي وتردّدوا عليها فكان منهم شهودَ عيان على أحداثها، ووصفوها وصفاً دقيقاً جغرافياً واجتماعياً، كما يوجد أكبر خزين للتاريخ العربي بأرشيف المكتبات الأوروبية، وهناك الدوريات ووثائق الدوائر الرسمية وغير الرسمية والمراسلات بأنواعها المختلفة، فضلاً عن الكتب المعاصرة التي وإن كانت تُعدّ مصادر ثانوية لكن في العموم لها مساهمتُها في الربط والنقد والتحليل لمجمل المعلومات والسرديات الواردة في المصادر الأولية المشار إليها أعلاه. مضامين تاريخية * هل ترى أن هذه المصادر كافية لتوصيف المشهد المحلي، وبالأخص الثقافي؟ ** نعم.. لكن تظل الحاجة إلى استكمال الجانب الثقافي، من خلال الرجوع إلى المعمّرين واستفراغ ذاكرتهم كما فعلت متاحف مشيرب، ومن ثمّ تدوين الحوادث المشهودة والقصص والأمثال والأشعار. ومن المهم أن تقوم الجامعات بتشجيع الباحثين وطلبة الدراسات العليا لتكون مصادر رسائلهم الجامعية من المورث الشفهي وتوجيههم نحو بحوث أصيلة ومنتخبة حول مضامين التاريخ القطري لتغطية جوانب محتملة عن التعليم والحياة الأدبية والأحوال الاجتماعية، ومراكز المدن التي تحوّلت أهميتها بتقادم السنين وانحسار بعضها كمدينة الزبارة كي نحصل على خلاصات خضعت جيداً للنقد والتحقيق. ويجب الاستفادة من كتب التراجم للشخصيات القطرية خلال المائة الأخيرة، ففيها الكثير من الإشارات والتفاصيل النافعة لتسلسل التاريخ القطري وانتظامه، التي يمكن أن نلتقط منها الوقائع والأحداث التي تشكّل حلقاتٍ مفقودة في الرواية الرئيسية أو تأتي تعضيدا لخللٍ أو ضعفٍ في توثيق حقبةٍ ما. كذلك من المهم تسليط الضوء على تاريخ الزبارة وأثرها الفكري والثقافي، والمكتبة الوطنية تحفل بالكثير من الوثائق والمدونات بهذا الخصوص. كما هناك أشعار المؤسس الشيخ جاسم بن محمد، رحمه الله، إذ فيها توثيق للحوادث والمسميات، إلى جانب أنها تمثّل سقفا فكرياً وعقائدياً مميزاً في رؤية المشهد السياسي والاجتماعي من خلال عيون إسلامية خالصة. وهناك تاريخ التعليم في قطر ودراسة دور المدارس الأولى (المدرسة الأثرية والمدرسة الحمدية والمدرسة النسائية الأولى آمنة الجيدة)، ودورها في إرساء قواعد للتعليم ومناهج فيها من الرصانة والحصانة ما نفتقر له في عصرنا الحال الموروث الشفهي. * إلى أي حد يُعتبر الموروث الشفهي أصيلاً في تدوين التاريخ المحلي، أو رافداً له؟ ** نعم.. يُعد علم التراث الشفهي عقدة الاتصال للمشتغلين بالتاريخ، وكذلك المتخصصين بالاجتماع واللغة والأنساب، فالراوي الشفهي هو أيضا مؤرخُ بدرجة نسبية معينة، لكن لم تُتَحْ له الفرصة والإمكانية الثقافية للتدوين والكتابة الأصولية المعتادة. من المعلوم أيضاً اختلاف الباحثين والمهتمين بعلوم التاريخ والاجتماع حول أهمية التراث الشفهي أو الشعبي، فمنهم مَن عارض أن يكون مصدراً للتاريخ المدوّن، بالرغم من كونه يعكس الصورة الحضارية للمجتمع وذاكرته الفكرية والعاطفية في مراحله الزمنية المتعاقبة. كما هناك عزوف للمؤرخين عن الموروث الشفوي لاعتقادهم أنه حصة التراث الشعبي، وغالبا ما يستوحي منه الأدباء والفنانون كما يظهر في اللوحات الفنية ومقاطع التمثيل المصوّرة. هذا الموروث ينبغي الالتفات إليه واسترجاعه من مصنفات التراث الشعبي واعتباره مادةً تاريخية تستحقُّ العناية والنقد والإضافة ليكون رافداً في تغطية مساحاتٍ ليست قليلة في تاريخ قطر الحديث، فالموروث الشفوي غالبا ما يكون مزيجاً من لطائف الأحداث وعجائب السّير ذات الأبعاد الأدبية والقصصية، ويعتبر خزينا نافعا يسدّ الفجوات ويصل المقطوعات، ويسعف الباحثين في تعضيد ما ضَعُفَ من الروايات أو ما كان منها مضطربا ومتناقضا. توعية الأجيال * كيف يمكن توعية الجيل الحالي والأجيال الأخرى اللاحقة بأهمية التاريخ واستيعابه في ظل ما يُنظر إليه على أنه مادة للحفظ والتلقين؟ ** من أجل هذا الهدف لابد من الاستعانة بعلوم النفس والاجتماع وفنّ الإعلام في تعديل النمطية في تلقين التاريخ للنشء الحالي والأجيال اللاحقة من خلال تواصل نشاط المنظومة التعليمية ومؤسساتها المتدرجة مع الجهات المعنية، وتشكيل لجنة دائمة من العناوين المشار إليها لتحديد الثوابت ولإثراء مفردات التاريخ القطري وتكامل جوانبه الثقافية والاجتماعية المبثوثة في الكثير من المراسلات والوثائق والكتب. ولتعزيز هذا الهدف نحو مراميه المثالية الرصينة، لابد من تشجيع طلبة الدراسات العليا وتوجيههم نحو بحوث أصيلة ومنتخبة حول جوانب التاريخ القطري الحديث بالاستعانة بالموروث الشفوي المسجَّل أو من استفراغ ذاكرة المعمرين الأحياء، كلُّ هذا معلوم بالضرورة لكل الباحثين والمشتغلين في توثيق التاريخ القطري الحديث.
11731
| 31 أكتوبر 2020

استضاف مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية د.عمر العجلي، المحاضر بكلية المجتمع، في ندوة عن "هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية"، الذي استهل الندوة بالإشارة إلى أن العباسيين ورثوا دولة واسعة مترامية الأطراف، تمتد حدودها من الصين شرقًا إلى شاطىء المحيط الأطلسي غربًا، ومن بحر قزوين وجبال القوقاز شمالًا إلى بلاد النوبة جنوبًا، وكانت تضمّ 14 إقليمًا كبيرًا، وتشتمل على ثلاثٍ وثمانين كورة. وقال إن الخلفاء الأمويين والعباسيين كانوا يحظرون التعامل بالنقود البيزنطية والساسانية، ونقشت الدنانير والدراهم بالخط الكوفى البسيط. وضربت من هذه الدنانير أجزاء لتسهيل المعاملات التجارية فى الأسواق مثل النصف والثلث. ومكتوب عليها "بسم الله.. ضرب هذا النصف أو الثلث في مدينة كذا وبسنة كذا من الهجرة". وأضاف د.العجلي أن النظام الاقتصادي للدولة العباسية عرف الصكوك والسفاتج، كما عرفت الدولة بيت المال، وبيت مال الخاصة، وهي مؤسسات تعود إلى أصحاب الأموال الذين يوظفون أموالهم ونقودهم كلها أو بعضها في قضايا مصرفية كالائتمان وحفظ الودائع والاقتراض. وعرفت الدواوين والإشراف والرقابة عليها. ثم انتقل لتناول النشاط التجاري في الدولة العباسية، واستعرض سوق بغداد مثالًا، فتناول السلع المتداولة بالأسواق، ووحدات الكيل والوزن والأذرع، وأسلوب التعامل التجاري في الأسواق، والتجارة بين العاصمة بغداد والبلدان الأخرى.
2320
| 25 مايو 2017
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة


انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
15890
| 26 أكتوبر 2025

أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
13078
| 25 أكتوبر 2025
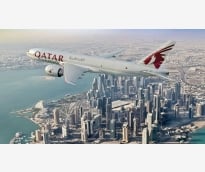
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
8860
| 24 أكتوبر 2025

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
الأكثر رواجاً
- 1 الداخلية تكشف سبب حريق مراكب الصيد بفرضة الوكرة وتحيل المتهمين إلى النيابة
قالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة، فقد أظهرت المعاينة الفنية وما تم...
7690
| 26 أكتوبر 2025
- 2 السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة تسيير المركبات غير المرخصة مع انتهاء مهلة الداخلية
انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
5346
| 27 أكتوبر 2025
- 3 متسابقة مصرية تتعرض لإصابة خطيرة في بطولة العالم للدراجات (فيديو)
تعرضت لاعبة منتخب مصر للدراجات، ابتسام زايد، لإصابة قوية خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء ببطولة العالم المقامة في تشيلي، بعد سقوطها العنيف...
4430
| 24 أكتوبر 2025


