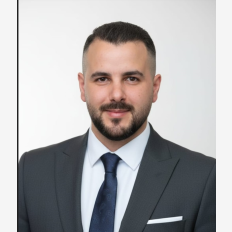رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
258
م. عمران ياسينلا تأمن لنفسك أمام ChatGPT
في السنوات الأخيرة، تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي من أدوات تجريبية محدودة الوظائف إلى أنظمة قادرة على تحليل النصوص، وصياغة الأفكار، والتفاعل مع المستخدمين بطريقة تشبه البشر. هذا التطور السريع جعل أدوات مثل شات جي بي تي رفيقًا يوميًا لملايين الأشخاص حول العالم، سواء في العمل أو الدراسة أو البحث أو حتى في القرارات الشخصية. فمنهم من جعله مستشاراً مالياً أو نفسياً أو صحياً أو حتى تعليمياً أو قانونياً لما يمتلكه من سرعة فائقة في اقتراح الحلول والنصائح والإرشادات التي تروق للبعض في تحدٍّ خطير عجز عن فعله البشر في نفس الآن.
فالبشر بشكل عام يميلون للانفتاح على الأدوات التي تبدو ذكية ومتفهمة، وقد يكشفون لها ما لا يكشفونه لغيرها، مما يؤدي إلى أن يصبح الذكاء الاصطناعي مساحة تسرّب غير معلن للمعلومات. وهنا تكمن الحاجة الملحّة إلى وضع دستور أخلاقيات واضحة من باب احترام سياسة خصوصية المستخدم وليس من باب الخوف ومنع أنفسنا من السلوك المفرط في الثقة تجاهها. الإعلان من قبل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، أثار زيادة كبيرة في الوعي العام عندما ذكر بشكل خاص أن ChatGPT يمكن تدريبه أو استخدامه لمشاركة المحادثات للتطوير أو التدريب، ما لم يقم المستخدم بتعطيل هذه الخدمة أو الخاصية أو الالتزام بإعدادات الخصوصية المشددة. هذا الاعتراف العام أعاد انتباه الجميع إلى السؤال الجوهري: هل نتواصل مع روبوت محايد؟ أم نترك علامات وبصمات رقمية قد تُستخدم لاحقًا كبيانات للعرض أو التحليل أو الإساءة أو الاستفادة منها؟
نظرًا لأن المحادثات يمكن مراجعتها لتحسين نموذجها، فإن مشاركة المعلومات الخاصة - سواء كانت مالية أو قانونية أو شخصية - يمكن أن تكون خطرًا حقيقيًا، ليس فقط للخصوصية ولكن للأمن الرقمي أيضًا. لذا، من الضروري للمستخدمين أن يفهموا أن الشاشة التي يكتبون عليها ليست صندوقًا مغلقًا، بل هي مكان يمكن اختراقه للتحليل ومساحة قابلة للوصول والأشياء التي يكتبونها يمكن أن يحاكموا عليها في سياقات غير متوقعة. ومع ذلك، يجب ألا يتحول الحديث عن المخاطر إلى حالة خوف غير مدروسة. فلا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي عدواً، بل هو أداة قوية للغاية تتطلب إدارة فعالة تمامًا كما هو الحال مع أي تقنية جيدة وناجحة. يمكن أن تكون قدرات الذكاء الاصطناعي في التحرير وإعادة الصياغة والبحث واتخاذ قرارات أفضل ومفيدة للمستخدمين بطريقة أو بـ أخرى دون التفريط بخصوصيتهم. معرفة أن هناك حدودا كافية، وتجنب المعلومات الحساسة/ أو بيانات قابلة للتتبع، وأن يتأكد من إعدادات الخصوصية قبل استخدام أي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الوعي هو السلاح الأقوى، فهو الذي يضمن لنا علاقة متوازنة مع التكنولوجيا، فلا نبالغ في الثقة ولا نبالغ في الخوف. إن الذكاء الاصطناعي بوضعه الحالي لا يمتلك نية ولا إرادة، لكنه يعمل وفق ما يُقدَّم له، ومن هنا تأتي أهمية أن نكون نحن أكثر حرصًا حين نقدّم له معلوماتنا. في النهاية، الأخلاقيات ليست مسؤولية الشركات فقط، بل مسؤولية المستخدم أيضًا في أن يعرف ماذا يشارك، ولماذا يشارك، وأين يمكن أن تذهب كلماته بعد أن يضغط زر الإرسال.الأخلاقيات خلقت للبشر وميزتهم عن غيرهم لوجود العقل، فاعرف أين تكتب كلماتك واعلم لمن تشارك معلواتك وإني كنت لكم من الناصحين.
مقالات ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
م. عمران ياسين
• باحث أكاديمي ومتخصص في الذكاء الاصطناعي
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
سلمان المالك.. صدق بروح الإبداع

عبدالله المطاوعة
-
بين منصات التكريم وهموم المعيشة

جاسم إبراهيم فخرو
-
جهود قطرية مكثفة لتجنيب الشعوب تبعات التصعيد

رأي الشرق
-
الطلاق.. جرحٌ في جسد الأسرة

د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 وثائق إبستين ووهْم التفوق الأخلاقي
عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب العالم أنه النموذج الأخلاقي والقيمي الأرقى، قوانين متقدمة، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، عدالة اجتماعية، وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية، وجعل لنفسه حق التدخل في شؤون الدول التي لا تساير تلك المنظومة المُعلنة. بيد أن وثائق جيفري إبستين التي كشف عنها وأحدثت زلزالًا تتجاوز آثاره كونها حالة جنائية، إلى النظر إليها والتعامل معها على أنها جرائم سياسية وأخلاقية، تزاوجت في تنفيذها السلطة والمال والنفوذ. تلك الوثائق قد نسفت ادعاءات الغرب في تفوقه الأخلاقي، وأبرزت أن هذه القيم التي يترنم بها قيم نسبية مرهونة بالمصالح والنفوذ، ذلك لأنها ليست خطيئة فردية، بل هي جريمة منظمة ممنهجة ممتدة متشابكة. أظهرت الوثائق أن القيم تتبدد أمام إغراءات المال والسلطة، ولم يكن إبستين مجرد رجل يستغل النظام القضائي والإعلامي والسياسي من أجل تحقيق أطماعه في استعباد النساء والأطفال، بل هو صنيعة ونتاج منظومة الفساد الأخلاقي والقيمي. سيكون من السطحية والسخف أن تختزل هذه الفضيحة في شخص إبستين، فهو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي شهدها الغرب، ولذا جرى التهاون القضائي مع الرجل لأنه يعلم جيدًا أن من كان في مثل موضعه من السلطة والمال لن يُحاكم بنفس المعايير التي يحاكم بها غيره. لم يتجل السقوط الأخلاقي للغرب من خلال الفضيحة ذاتها وما ارتبطت به من أسماء ما يمكن أن نسميه «إدارة العالم» فحسب، بل من خلال تأخير الكشف عنها، فلم تكن هذه الحقائق مجهولة، بل كانت مؤجلة، فأصبحت هذه الحقيقة مجرد توثيق لحسابات النهاية، فالعدالة الحقيقية هي تلك التي تأتي في الوقت المناسب، فلماذا لم يتم الكشف عنها حينها؟ كأن الحقيقة قد سمح لها بالظهور فقط بعدما أصبحت فاقدة للقدرة على التغيير.ثم لنا أن نتساءل عن سر التهاون القضائي مع إبستين، وما تفسير حادث موته في السجن بكل ما يتعلق به من سلوكيات مريبة كتعطيل الكاميرات وغياب المراقبة لشخصية من المفترض أن تحظى بالرقابة الصارمة؟ الوثائق كشفت أن العدالة طبقية وانتقائية في النموذج الغربي، وليست سوى عمليات تفاوضية على الصياغة، وعلى ما يقال وما يترك، تجلى ذلك في الصفقات القانونية التي أبرمت، والتخفيف غير المبرر في الأحكام القضائية الصادرة، وتأجيل المحاسبة، بما يجعلنا نقول إن القانون يفسر وفقا لموقع المتهم لا حجم الجريمة، وهذا يؤكد انهيار ركيزة المساواة أمام القانون التي هي إحدى أهم ركائز أية منظومة قيمية. الوثائق كذلك عرّت الإعلام الغربي الذي يفاخر بالحرية والاستقلالية والشفافية والموضوعية وأظهرت ضلوعه في التواطؤ لخدمة السلطة والمال، وذلك بالتغطية على الجريمة، وأبرز طبيعته الاستهلاكية التي يقاس نجاحها بالمشاهدات وعوائد الإعلانات، كما أظهرت كذلك خضوع هذا الإعلام لنفوذ المال والسياسة وتمحوره حول حماية الأقوياء.. حتى في التناول الإعلامي للقضية، جرى التعامل الانتقائي الطبقي، حيث تم تهميش الضحايا وكأنهم مجرد أرقام تُذكر في السياق العام للجريمة، أو خلفية حزينة للأسماء اللامعة. من دواعي السخرية أن هذه الإدارة العالمية التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هي نفسها التي نصّبت نفسها مراقبًا على حقوق المرأة والطفل والحريات في عالمنا العربي والإسلامي، هي نفسها التي تتدخل في تربية أطفالنا وتسعى لتجريم تأديب الأبناء، وتؤجج الحركات النسوية لدفعها للتمرد على قيم وثقافات المجتمعات، وتبتز الحكومات بملفات الحرية وحقوق الإنسان، بما يؤكد أن الغرب يتعامل مع القيم باعتبارها سلاحًا سياسيًا. فصل الأخلاق عن السلطة، والفصل بين الخطاب السياسي والممارسة، يقوض الثقة الداخلية في الغرب ذاته، فأنّى لمجتمع يؤمن بتلك المنظومة وهو يراها تتهاوى أمام السلطة والمال، ويوقفه حائرًا أمام ذلك الثراء الذي يهب الحصانة. لعل هذا الحدث الجلل يجعل المُختطفين ببريق الغرب ويترنمون بتفوقه القيمي يراجعون أنفسهم، ويفصلون في الدعوة إلى السير على خطى الغرب بين ما يمكن أن نأخذه عنه من تقدم علمي وتكنولوجي ونحوهما، وما لسنا بحاجة إليه من قيم وأخلاقيات لنا السبق والسمو فيها، فالغرب إنما تقدم بسبب الأخذ بأسباب القوة والتقدم، لا من خلال منظومته القيمية والأخلاقية النسبية.
14430
| 08 فبراير 2026
- 2 الرياضة نبض الوطن الحي
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1443
| 10 فبراير 2026
- 3 ماذا بعد انتهاء الطوفان؟
لم يكن الطوفان حدثًا عابرًا يمكن تجاوزه مع مرور الوقت، ولا مجرد فصل جديد في صراع اعتدنا على تكراره. ما جرى كان لحظة فاصلة، كشفت الكثير مما كنا نفضّل تجاهله، ووضعت الجميع أمام واقع لم يعد من السهل الهروب منه. بعد الطوفان، لم تعد اللغة القديمة صالحة للاستخدام. لم يعد من الممكن ترديد العبارات نفسها، أو التظاهر بأن الصورة غير مكتملة. الصورة كانت واضحة، وربما كانت هذه أوضح لحظة شهدها هذا الجيل. أول ما سقط بعد الطوفان هو وهم الجهل. لم يعد أحد يستطيع الادعاء بأنه لا يعرف، أو أن الأمور بها لبس. كما سقطت فكرة النظام الدولي العادل. القانون الذي يعمل بانتقائية، وحقوق الإنسان التي تُفعّل حين تخدم المصالح وتُعطَّل حين تكون ضدها. والأهم انتهت اخطر كذبة كنا نكررها "ما باليد حيلة". وسقط أيضًا خطاب العجز الذي اعتدنا ترديده. ذلك الخطاب الذي يبرّر الصمت بحجة غياب القدرة، ويتعامل مع المأساة وكأنها قدر لا يمكن الاقتراب منه. ان تكون عاجزاً بعد الطوفان فهذا ليس بسبب الاوضاع بل بسبب اختيارك ان تكون عاجزاً. الطوفان لم يخلق قسوة العالم، لكنه كشفها بوضوح. كشف ازدواجية المعايير، وصمت المؤسسات، وبرود الخطاب السياسي أمام مشاهد لا تحتمل البرود. لكنه في الوقت نفسه كشفنا نحن، بطريقة ربما كانت مؤلمة أكثر. كشف سرعة انفعالنا، وسرعة تراجعنا. كشف كيف نغضب، ثم نتعب ثم نعتاد. كيف تتحول المأساة إلى صور، ثم إلى مقاطع، ثم إلى ذكرى بعيدة. كشف عدم قدرتنا على تحمل المناظر المؤلمة التي نراها في غزة عبر الفيديوات.. بينما اهل غزة يعيشون هذه المناظر فعلياً كل يوم ترك الطوفان أثرًا نفسيًا ثقيلًا. تعب عام، شعور بالعجز، وتقلّب مستمر بين الأمل واليأس. هذا التعب لا يُقاس بالأرقام، لكنه ينعكس في طريقة التفكير، وفي قبول الظلم باعتباره جزءًا من المشهد المعتاد. الخطر هنا ليس في الغضب، بل في الاعتياد. أن نصبح أقل دهشة، أقل صدمة. وضوح العدو لا يُعفي من مراجعة الذات. فالطوفان كشف ضعفنا في البناء الطويل، واعتمادنا المفرط على ردود الفعل. الغضب حاضر، لكن تحويله إلى مشروع مستمر، ما زال محدودًا. كما كشف تردّد النخب في تحمّل كلفة المواقف، وارتباك الجمهور بين الرغبة في الحقيقة والخوف من تبعاتها. النخب التي قال عنهم ابوعبيدة رحمه الله: انتم خصومنا امام الله. ما بعد الطوفان ليس مرحلة شعارات ولا خطابات حماسية. هو مرحلة أسئلة ثقيلة: كيف نفهم القوة؟ كيف نبني وعيًا ينهض بنا؟ إما أن يكون الطوفان نقطة تحوّل حقيقية، أو مجرد محطة أخرى في سلسلة صدمات اعتدنا أن نمرّ بها دون أن نتعلّم منها ما يكفي. ما بعد الطوفان يفرض مسؤولية أبعد من الغضب وأثقل من التعاطف. يفرض انتقالًا من حالة المشاهدة إلى موقع الفاعلية، ومن رد الفعل إلى الفعل الواعي طويل النفس. لم يعد السؤال: ماذا نشعر؟ بل ماذا سنفعل بهذا الشعور؟ لأن المشاعر التي لا تتحول إلى وعي، والوعي الذي لا يتحول إلى سلوك، ينتهي بهما الأمر وقودًا لجولة إحباط جديدة. أخطر ما قد يحدث بعد الطوفان ليس أن نُقهر، بل أن نقتنع أن أقصى دورنا هو أن نتألم ثم نعود إلى حياتنا كما كانت، وكأن الدم الذي رأيناه لم يكن اختبارًا أخلاقيًا مباشرًا لنا نحن، قبل أن يكون إدانة للعالم. بعد أن وقف اطلاق النار "الوهمي" حيث ان القصف لازال موجودا والقتل لازال موجودا ولكن الفرق هو ابتعاد الكاميرات عن غزة، بقيت الأسئلة بلا إجابات سهلة، يظل السؤال الأهم قائمًا: هل تغيّر العالم فعلًا، أم أنه كشف فقط حدود قدرتنا على التغيير؟ والأهم من ذلك.. هل تغيّرنا نحن بما يكفي؟ أم أننا ننتظر طوفانًا ودماء اكثر كي نتحرك فعلياً؟
801
| 10 فبراير 2026